عزل أبي بكر عن الصـلاة
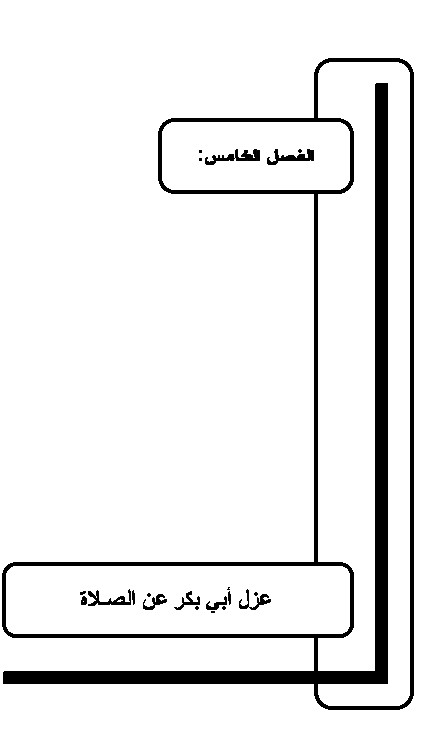
هناك روايات عديدة، متناقضة جداً تتحدث عن صلاة أبي بكر
بالناس، ونحن نورد هنا عمدتها مما روي في كتب الصحاح وغيرها.. ونذكر
منها ما يلي:
عن أنس:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لم يخرج ثلاثاً وأبو
بكر يصلي بالناس، وأن الناس بينما هم في صلاة الفجر من يوم الإثنين
وأبو بكر يصلي لهم، لم يفجأهم إلا رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد
كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، فما رأيت
رسول الله «صلى الله عليه وآله» أحسن هيئة منه في تلك الساعة، وكانت
آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» وهم صفوف في
الصلاة، ثم تبسم يضحك.
فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، فظن أن رسول الله
«صلى الله عليه وآله» يريد أن يخرج إلى الصلاة.
قال أنس:
وهمّ المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله
«صلى الله عليه وآله»، فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، فقال:
«أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا
الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ راكعاً أو
ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء،
فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم».
ثم دخل الحجرة، وأرخى الستر، فتوفي من يومه ذلك([1]).
وفي نص آخر عنه:
وتوفي من آخر ذلك اليوم([2]).
ونقول:
قد ذكرنا هذه الرواية في فاتحة الكلام عن صلاة أبي بكر،
لأنها تضمنت صورة مخففة عن موضوع الصلاة، وأشارت إلى أمور عديدة كلها
موضع شك وريب، مثل: أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان صباح يوم
الإثنين في حجرة عائشة.
كما أنها لم تشر إلى عزل النبي «صلى الله عليه وآله»
لأبي بكر عن هذه الصلاة بالذات، كما سيأتي في الروايات الصحيحة إن شاء
الله تعالى.
وتضمنت أيضاً:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» نظر إلى المصلين وهو
قائم، مع أنه سيأتي أن رجلين قد حملاه إلى المصلى، ورجلاه تخطان في
الأرض.
كما أن هذه الرواية لم تذكر إن كان رسول الله «صلى الله
عليه وآله» هو الذي أمر أبا بكر بالصلاة، أم أن الذي أمره بها شخص آخر،
ولكنها تدل على رضا رسول الله «صلى الله عليه وآله» بصلاة أبي بكر..
وأن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يشارك في الصلاة، وأن هذا الذي جرى
قد كان يوم الإثنين، وهو يوم وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله»..
وزعمت:
أن أبا بكر قد صلى بالناس ثلاثة أيام.
وقد يستشعر من هذه الرواية أيضاً أن ابا بكر قد صلى
ثلاثة أيام من دون علم رسول الله «صلى الله عليه وآله».
ولكن سيأتي أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد عزل أبا
بكر عن هذه الصلاة بالذات، فإن كان أبو بكر قد صلى بالناس ثلاثة أيام،
فلعله لعدم علم النبي «صلى الله عليه وآله» بالأمر.
وسيأتي المزيد من المناقشات لمضامين هذه الرواية
وأمثالها، فانتظر..
1 ـ
عن عائشة: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أمر أبا
بكر أن يصلي بالناس قائماً، والناس خلفه([3]).
2 ـ
وعن ابن عباس قال: ابعثوا إلى علي، فادعوه.
فقالت عائشة:
لو بعثت إلى أبى بكر.
وقالت حفصة:
لو بعثت إلى عمر.
فاجتمعوا عنده جميعاً، فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
انصرفوا فإن تك لي حاجة أبعث إليكم، فانصرفوا.
وقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
آن الصلاة؟!
قيل:
نعم.
قال:
فأمروا أبا بكر ليصلي بالناس.
فقالت عائشة:
إنه رجل رقيق فمر عمر.
فقال:
مروا عمر.
فقال عمر:
ما كنت لأتقدم وأبو بكر شاهد.
فتقدم أبو بكر، ووجد رسول الله «صلى الله عليه وآله»
خفة، فخرج فلما سمع أبو بكر حركته تأخر الخ..([4]).
3 ـ
عن إبراهيم بن الأسود عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله
«صلى الله عليه وآله» جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر
فليصلِّ بالناس.
قالت:
فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى
يقوم مقامك لا يسمع الناس (من البكاء)، فلو أمرت عمر.
فقال:
مروا أبا بكر فليصل بالناس.
قالت:
فقلت لحفصة: قولي له.
فقالت له حفصة:
يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم
مقامك لا يسمع الناس (من البكاء) فلو أمرت عمر.
فقال:
إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس.
قالت:
فأمروا أبا بكر يصلي بالناس، فلما دخل في الصلاة وجد
رسول الله «صلى الله عليه وآله» من نفسه خفة، فقام يهادي بين رجلين،
ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد.
فلما سمع أبو بكر حسه ذهب ليتأخر، فأومأ إليه رسول الله
«صلى الله عليه وآله» أن قم كما أنت.
فجاء رسول الله «صلى الله عليه وآله» حتى جلس عن يسار
أبى بكر، وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يصلي بالناس قاعداً،
وأبو بكر قائماً، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
والناس يقتدون بصلاة أبى بكر.. وقريب منه عن عائشة
([5]).
زاد في نص آخر مروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،
عن عائشة قوله: فدخلت على ابن عباس، فعرضت حديثها عليه، فما أنكر منه
شيئاً، غير أنه قال: أسمَّت لك الرجل الذي كان مع العباس؟!
قال:
لا.
قال:
هو علي بن أبي طالب
([6]).
4 ـ
وفي لفظ عن عائشة: علمت أنه لن يقوم مقامه أحد إلا
تشاءم الناس به، فأحببت أن يعدل ذلك رسول الله «صلى الله عليه وآله» عن
أبي بكر إلى غيره، فأرسل رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى أبي بكر
بأن يصلي بالناس.
وكان أبو بكر رجلاً رقيقاً، إذا قرأ القرآن لا يملك
دمعه من البكاء.
فقال:
يا عمر صلِّ بالناس.
قال:
أنت أحق بذلك.
فصلى بهم تلك الأيام.
ثم إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» وجد خفة، فخرج
يهادي بين رجلين، أحدهما العباس لصلاة الظهر، كأني أنظر إلى رجليه
يخطان الأرض من الوجع.
فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه أن لا يتأخر،
وأمرهما فأجلساه إلى جنب أبي بكر عن يساره، فأخذ النبي «صلى الله عليه
وآله» من حيث الآية التي انتهى أبو بكر إليها فقرأ، فجعل أبو بكر يصلي
قائماً ورسول الله «صلى الله عليه وآله» يصلي قاعداً([7]).
وفي رواية:
فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله، والناس يصلون بصلاة
أبي بكر([8]).
5 ـ
وعن عبيد بن عمير: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله»
لما فرغ من الصلاة يوم صلى قاعداً عن يمين أبي بكر قال: وأقبل عليهم
فكلمهم رافعاً صوته حتى خرج صوته من باب المسجد: يا أيها الناس سعرت
النار الخ..
إلى أن قال:
قال أبو بكر: يا رسول الله، إني أراك قد أصبحت بنعمة من
الله وفضل كما تحب، واليوم يوم بنت خارجة فآتها؟!
قال:
نعم.
ثم دخل رسول الله «صلى الله عليه وآله» وخرج أبو بكر
إلى أهله بالسنح([9]).
6 ـ
وعن عائشة قالت: صلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»
خلف أبي بكر قاعداً في مرضه الذي مات فيه([10]).
7 ـ
ونص آخر عن ابن عباس:
لما مرض رسول الله «صلى الله عليه وآله» مرضه الذي مات
فيه كان في بيت عائشة، فقال: ادعوا لي علياً.
قالت عائشة:
ندعو لك أبا بكر.
قال:
ادعوه.
قالت حفصة:
يا رسول الله، ندعو لك عمر.
قال:
ادعوه.
قالت أم الفضل:
يا رسول الله، ندعو لك العباس.
قال:
ادعوه.
فلما اجتمعوا رفع رأسه فلم ير علياً، فسكت.
فقال عمر:
قوموا عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»([11]).
فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال:
مروا أبا بكر يصلي بالناس.
فقالت عائشة:
إن أبا بكر رجل حصر، ومتى ما لا يراك الناس يبكون، فلو
أمرت عمر يصلى بالناس.
فخرج أبو بكر فصلى بالناس. ووجد النبي «صلى الله عليه
وآله» من نفسه خفة، فخرج يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، فلما
رآه الناس سبحوا أبا بكر، فذهب يتأخر، فأومأ إليه. أي مكانك.
فجاء النبي «صلى الله عليه وآله» حتى جلس.
قال:
وقام أبو بكر عن يمينه. وكان أبو بكر يأتم بالنبي «صلى
الله عليه وآله»، وكان الناس يأتمون بأبي بكر([12]).
قال ابن عباس:
وأخذ النبي «صلى الله عليه وآله» من القراءة من حيث بلغ
أبو بكر([13]).
ونقول:
إن
لنا مع النصوص المتقدمة، وقفات عديدة، سنكتفي منها بالأمور التالية:
ذكرت الرواية، المتقدمة:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» مرض في بيت عائشة. ونحن
لا نمانع في أن يكون مرضه قد ابتدأ في حجرة عائشة، ولكن لا ريب في أنه
«صلى الله عليه وآله» قد انتقل منها إلى بيت فاطمة «عليها السلام»،
ووافته المنية هناك وفيه دفن، لا في بيت عائشة، وستأتي الأدلة على أن
هذا هو الصحيح، وأنه لا صحة لما يزعمونه: من أنه «صلى الله عليه وآله»
قد مات ودفن في بيت عائشة..
ثم إننا لا ندري متى كان من شرط الجماعة أن يسمع الإمام
الناس.. ولذلك لم نستطع أن نفهم مراد عائشة من اعتراضها على رسول الله
«صلى الله عليه وآله»: بأن أبا بكر رجل أسيف، لا يسمع الناس..
لقد اختلفت كلمة فقهاء العامة حول إمامة القائم بالقاعد
والصحيح بالمريض اختلافاً كبيراً، وتفاوتت النقول عن كل فريق منهم بين
مؤيد ومفند، ولا نريد الدخول في تفاصيل ذلك، بل نكتفي ببعض منه، فقد
قال ابن الجوزي كما أحمد بن حنبل، وكذلك الأحناف والمالكية: إن النبي
«صلى الله عليه وآله» كان إماماً لأبي بكر، وأبو بكر كان الإمام
للمسلمين، ولعله لأجل ذلك جلس النبي «صلى الله عليه وآله» على يسار أبي
بكر. فحصلت الصلاة بإمامين كما جاء في رواية ابن عباس.
أما الشافعي والشافعية، فقالوا:
كان الإمام واحداً، وهو رسول الله «صلى الله عليه وآله»
دون سواه، أما أبو بكر فكان مأموماً، ولم يكن إماماً لأحد([14]).
قال ابن عبد البر:
«وهذه المسألة فيها للعلماء أقوال.
أحدها:
قول أحمد بن حنبل ومن تابعه، تجوز صلاة الصحيح جالساً
خلف الإمام المريض جالساً، لقوله «عليه السلام»: وإذا صلى جالساً،
فصلوا جلوساً.
والثاني:
قول الشافعي، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، وزفر، والأوزاعي،
وأبي ثور وداود: جائز أن يقتدي القائم بالقاعد في الفريضة وغيرها، لأن
على كل واحد أن يصلي كما يقدر عليه، ولا يسقط فرض القيام عن المأموم
الصحيح لعجز إمامه عنه.
وقد روى الوليد بن مسلم عن مالك مثل ذلك.
والثالث:
قول مالك في المشهور عنه وعن أصحابه: أنه ليس لأحد أن
يؤم جالساً وهو مريض بقوم أصحاء قيام ولا قعود، وهو مذهب محمد بن
الحسن، صاحب أبي حنيفة، فإن صلوا قياماً خلف إمام مريض جالس فعليهم عند
مالك الإعادة.
قيل عنه:
في الوقت.
وقيل:
أبداً.
قال سحنون:
اختلف قول مالك في ذلك، ومن أصحاب مالك من قال: يعيد
الإمام المريض معهم، وأكثرهم على أنهم يعيدون دونه.
وقال مالك والحسن بن حي، والثوري، ومحمد بن الحسن في
قائم اقتدى بجالس، أو جماعة صلوا قياماً خلف إمام جالس مريض إنها تجزيه
ولا تجزيهم»([15]).
ولو صح ما يذكرونه عن صلاة أبي بكر والنبي «صلى الله
عليه وآله» لما اختلفت أقوالهم في هذه المسألة.
فإن قيل:
للنبي «صلى الله عليه وآله» خصوصية في هذا الأمر.
فالجواب:
أنه قد كان يجب بيان هذه الخصوصية من قبل النبي «صلى
الله عليه وآله» نفسه حتى لا يقع الناس في الوهم والإختلاف في مسألة
فقهية يبتلى بها الناس بعده.
وقد ذكرت بعض روايات صلاة أبي بكر
بالناس:
أن أبا بكر قد صلى بصلاة رسول الله «صلى الله عليه
وآله» وصلى الناس بصلاة أبي بكر.. وحيث إنه لم يظهر لنا وجه مقنع لهذا
التصوير. فإننا نذكر القارئ الكريم بما يلي:
ألف:
إن هذا مجرد اجتهاد من الراوي لم يرد عن رسول الله «صلى
الله عليه وآله» ما يؤيده، ولا بيّن وجهه لنا أحد من علماء الصحابة.
ولا أقره أحد من أهل بيت النبوة «صلوات الله وسلامه عليهم» الذين هم
أحد الثقلين اللذيْنِ لا يضل من تمسك بهما، ولا حجية للإجتهاد في مثل
هذه الأمور، التي هي من موارد التعبد بالنص، والإنتهاء إليه.
ب:
إن كان أبو بكر هو الإمام، وكان النبي «صلى الله عليه
وآله» مأموماً، فمعنى ذلك أن أبا بكر لم يصلِّ بصلاة رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، بل كان الأمر على عكس ذلك.. وهذا يتناقض مع الروايات
التي صرحت بذلك..
وإن كان الإمام هو النبي «صلى الله عليه وآله»، فمعنى
ذلك أن الناس لم يكونوا قد صلوا بصلاة أبي بكر، بل صلوا بصلاة النبي
«صلى الله عليه وآله» نفسه.
وحاول بعضهم أن يدّعي أن الناس قد اقتدوا بأبي بكر،
بمعنى أنهم تحركوا بحركته، لأنهم كانوا لا يرون حركة رسول الله «صلى
الله عليه وآله» في ركوعه وسجوده، وسائر أفعاله، لأنه كان يصلي جالساً
بسبب مرضه.
وهي دعوى غير مقبولة، فإن المفروض هو أن المشاركين في
الجماعة كانوا قلة قليلة جداً، لأن معظم الناس القادرين على حمل السلاح
كانوا في جيش أسامة، ومن الواضح: أن الصف الأمامي، وبعض من في الصف
الذي بعده كان يرى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ويتحرك بحركته،
فلماذا خص الرواة أبا بكر بكونه وحده كان يرى حركة رسول الله «صلى الله
عليه وآله»؟! وجعلوه هو المحور لحركة غيره دون سواه!! مع أن الأمر لا
يحتاج إلى ذلك من الأساس.. فقد كان باستطاعة كل المشاركين بالصلاة أن
يتحركوا بحركة الصف الأول كله.
وقد ادّعى نعيم بن أبي هند:
أن الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها صحيحة، وليس
فيها تعارض([16]).
ونقول:
بل الأمر على عكس ذلك تماماً، فإن روايات صلاة أبي بكر
قد جاءت كثيرة التناقض، وقد ذكر العلامة المظفر طائفة من تناقضاتها،
ونحن نقتصر على ما ذكره «رحمه الله» وإن كان لنا تحفظ على موارد يسيرة
جداً منه، والموارد التي ذكرها هي التالية:
1 ـ
(في علاقة عمر بالصلاة)، يذكر بعضها أن النبي قال:
«مروا عمر» بعد مراجعة عائشة عن أبيها، فأبى عمر وتقدم أبو بكر([17]).
وبعضها ذكر:
أنه «صلى الله عليه وآله» ابتداءً أمر عمر، فقال عمر
لبلال: قل له إن أبا بكر على الباب. وحينئذ أمر أبا بكر([18]).
وبعضها ذكر:
أن أول من صلى عمر بغير إذن النبي، فلما سمع «صلى الله
عليه وآله» صوته قال: «يأبى الله ذلك والمؤمنون»([19]).
وفي بعضها:
أنه أمر أبا بكر أن يصلي نفس الصلاة التي صلاها عمر
بالناس([20]).
وفي بعضها:
صلى عمر، وكان أبو بكر غائباً([21]).
وفي بعضها:
أن النبي أمر أبا بكر، وأبو بكر قال لعمر: صلِّ بالناس،
فامتنع([22]).
2 ـ
(في من أمره النبي ليأمر أبا بكر)، فبعضها تذكر عائشة([23]).
وبعضها:
بلالاً([24]).
وبعضها:
عبد الله بن زمعة([25]).
3 ـ
(فيمن راجعه في أمر أبي بكر)، فبعضها تذكر أن عائشة
وحدها راجعته ثلاث مرات أو أكثر([26]).
وبعضها تذكر:
أن عائشة راجعته، ثم قالت لحفصة فراجعته مرة أو مرتين،
فلما زجرها النبي قالت لعائشة: « ما كنت لأصيب منك خيراً»([27]).
4 ـ
(في الصلاة المأمور بها)، فبعضها يخصها بصلاة العصر([28]).
وبعضها:
بصلاة العشاء([29]).
والثالث:
بصلاة الصبح([30]).
5 ـ
(في خروج النبي)، فبعضها تذكر: أنه «صلى الله عليه
وآله» خرج وصلى([31]).
وأخرى تقول:
أخرج رأسه من الستار والناس خلف أبي بكر، ثم ألقى
الستار ولم يصلِّ معهم([32]).
6 ـ
(في كيفية صلاة النبي بعد الخروج)، فيذكر بعضها: أنه
ائتم بأبي بكر، بعد أن دفع في ظهره، ومنعه من التأخر([33]).
وبعضها:
أن أبا بكر تأخر وائتم بالنبي «صلى الله عليه وآله»([34]).
وبعضها:
أن أبا بكر صلى بصلاة النبي، والناس بصلاة أبي بكر([35]).
وبعضها:
أن النبي ابتدأ بالقراءة من حيث انتهى أبو بكر([36]).
7 ـ
(في جلوس النبي إلى جنب أبي بكر) فبعضها تذكر جلوسه إلى
يساره([37]).
وبعضها:
إلى يمينه([38]).
8 ـ
(في مدة صلاة أبي بكر)، فبعضها: تجعلها طيلة مرض النبي([39]).
وأخرى:
تخصها بسبع عشرة صلاة([40]).
وثالثة:
بثلاثة أيام([41]).
ورابعة:
بستة (بسبعة)
([42]).
ويظهر من بعضها أنه صلى صلاة واحدة([43]).
9 ـ
(في وقت خروج النبي إلى الصلاة)، فبعضها صريحة في: أنه
خرج لنفس الصلاة التي كان قد أمر بها أبا بكر حسب زعمهم([44]).
وفي بعضها:
أنه خرج لصلاة الظهر بعد صلاة أبي بكر أياماً([45]).
وبعضها:
صريح بخروجه لصلاة الصبح([46]).
وهذه الإختلافات كما رأيت في جوهر الحادثة. ولم يظهر من
الأخبار تعدد أمر النبي له بالصلاة، ولا تعدد خروجه».
إلى أن قال:
«ولعل أبا بكر كان مخدوعاً في تبليغه أمر النبي، كما
جاء في الحديث: أن عبد الله بن زمعة خدع عمر بن الخطاب، فبلَّغه أمر
النبي له بالصلاة.
وأحسب أن أصل الواقعة أن النبي «صلى الله عليه وآله»
أمر الناس بالصلاة لما تعذر عليه الخروج، من دون أن يخص أحداً
بالتقديم، فتصرف متصرف، وتأول متأول.
ولما بلغ ذلك أسماع النبي التجأ أن يخرج يتهادى بين
رجلين ورجلاه تخطان الأرض من الوجع، فصلى بالناس جالساً صلاة المضطرين،
ليكشف للناس هذا التصرف الذي استُبِد به عليه»([47]).
أو ليكشف للناس أن من تصدى للصلاة لم يكن جامعاً
لشرائطها المقررة في الشرع الشريف.
وربما يكون النبي «صلى الله عليه وآله» لم يأمر بالصلاة
أصلاً، فضلاً عن أن يكون قد سمى أحداً لها، فاغتنم البعض الفرصة ليوهم
الناس: أن فلاناً بعينه هو المرضي بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
فخرج النبي «صلى الله عليه وآله» بنفسه لينقض هذا التصرف منهم..
وروى البلاذري عن علي بن أبي طالب
«عليه السلام» قال:
إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لم يمت فجأة، كان
بلال يأتيه في مرضه فيؤذنه بالصلاة، فيأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وهو
يرى مكاني، فلما قبض رسول الله «صلى الله عليه وآله» رأوا أن رسول الله
«صلى الله عليه وآله» قد ولاه أمر دينهم، فولوه أمر دنياهم
([48]).
وروى البلاذري عنه قال:
لما قبض رسول
الله «صلى الله عليه وآله» نظرنا في أمرنا، فوجدنا النبي «صلى الله
عليه وآله» قد قدم أبا بكر في الصلاة، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول
الله «صلى الله عليه وآله» لديننا، فقدمنا أبا بكر، ومن ذا كان يؤخره
عن مقام أقامه رسول الله «صلى الله عليه وآله» فيه؟!([49]).
وروى الحسن البصري عن قيس بن عباد
قال:
قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: إن رسول الله
«صلى الله عليه وآله» مرض ليالي وأياماً ينادى بالصلاة، فيقول: مروا
أبا بكر يصلي بالناس.
فلما قبض رسول الله «صلى الله عليه وآله» نظرت، فإذا
الصلاة علم الإسلام، وقوام الدين، فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله
«صلى الله عليه وآله» لديننا، فبايعنا أبا بكر([50]).
وروى البلاذري عن أبي الجحاف قال:
لما بويع أبو بكر، وبايعه الناس، قام ينادي ثلاثاً:
أيها الناس قد أقلتكم بيعتكم.
فقال علي:
والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله «صلى الله
عليه وآله» في الصلاة، فمن ذا يؤخرك؟!([51]).
وروى البلاذري ـ بسند جيد ـ:
أن عمر بن عبد العزيز بعث ابن الزبير الحنظلي إلى
الحسن، فقال له: هل كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» استخلف أبا
بكر؟
فقال الحسن:
أوفي شك؟! صاحبُك والله الذي لا إله إلا هو، استخلفه
حين أمره بالصلاة دون الناس، ولهو كان أتقى لله من أن يتوثب عليها([52]).
وروى البلاذري عن إبراهيم التيمي،
وابن سيرين قال:
«لما مات رسول الله «صلى الله عليه وآله» أتوا أبا
عبيدة بن الجراح، فقالوا: ابسط يدك نبايعك، فإنك أمين هذه الأمة على
لسان رسول الله «صلى الله عليه وآله».
فقال:
أتأتوني وفيكم الصديق ثاني اثنين؟
وفي لفظ:
ثالث ثلاثة، قيل: لابن سيرين: وما ثالث ثلاثة؟
قال:
ألم تقرأ هذه الآية
{ثَانِيَ
اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا
تَحْزَنْ إِنَّ اللَهَ مَعَنَا}([53])»([54]).
ونقول:
أولاً:
إن الإستدلال المنقول عن علي «عليه السلام» لا يمكن أن
يصدر عنه، لأنه باطل من أصله، فإن من يصلح لإمامة الجماعة في الصلاة قد
لا يصلح لقيادة الجيوش، ولا للقضاء بين الناس، ولا للإفتاء، ولا
ليعلِّم الناس الكتاب والحكمة، فضلاً عن أن يكون أهلاً للقيام بجميع
مهمات الحاكم والإمام.
ثانياً:
إذا كان الوجع قد غلب على رسول الله «صلى الله عليه
وآله» أو كان يهجر ـ كما زعمه عمر، ووافقه عليه طائفة ممن معه، حتى
صاروا يقولون: القول ما قاله عمر ـ فلا قيمة لما يصدر عن النبي «صلى
الله عليه وآله» في مثل هذا الحال.. وفق منطق من يلتزمون بقول عمر،
ويصرون على تصويبه ومتابعته فيما يقول ويفعل!!
ثالثاً:
إن الروايات قد صرحت بأن أبا بكر قد عُزل عن هذه الصلاة
أو أن ذلك محتمل بصورة قوية، كما دلت عليه الروايات الصحيحة، فلا يصح
الإستدلال بصلاة هذه حالها على الخلافة، بل هي على خلاف ما يحبون أدل.
رابعاً:
إن موقف علي «عليه السلام» من البيعة لأبي بكر معلوم
لكل أحد، وهم يقولون: إنه «عليه السلام» لم يبايع إلا بعد استشهاد
زوجته فاطمة «عليها السلام»، وكلماته «عليه السلام» في نهج البلاغة وفي
غيره، وفي كتب الحديث والرواية والتاريخ مشحونة بما يدل على اعتراضه
على أبي بكر في توليه أمراً ليس له..
خامساً:
إن نصب إنسان للصلاة، لا يعني توليته لأمور الدين
كلها.. ليس فقط لأجل أن ذلك الرجل قد لا يحسن كثيراً من أمور الدين..
لا سيما وأن هؤلاء يجيزون الصلاة خلف العالم والجاهل، والأمي والمتعلم،
بل والعادل والفاسق.. بل لأنه قد يكون هناك مانع من توليته لجميع ما
يحسنه، بل إن الإكتفاء بالتنصيص على توليته في جانب مما يحسنه، وترك
التصريح بتوليته لسائر المهام يكون أقوى في الدلالة على صرف النظر عن
التولية العامة..
سادساً:
إن علياً «عليه السلام» قد جعل أبا الأسود على الصلاة
في البصرة، وولى ابن عباس ما عدا ذلك، فلو كان نصبه للصلاة دليلاً على
ولايته، أو أحقيته بالولاية لأمور الدنيا لم يصح نصب ابن عباس على
البصرة إلى جانب أبي الأسود. أو هو على الأقل سيكون مثار تساؤل لدى
الناس!!
سابعاً:
إن إمامة الصلاة ليست من الولايات، بل هي حكم شرعي خاص
في مورده، فما معنى قياس ولاية أمور الدنيا التي تحتاج إلى إنشاء
وجعل.. على جعل إنسان إماماً في الصلاة؟!
ثامناً:
قوله: من ذا يؤخره عن مقام أقامه الله فيه غير سديد،
فإن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لم يقمه إماماً للأمة، وإنما هم
يدّعون أنه أقامه إماماً للصلاة، ولم يؤخره أحد عنها، وإنما هو تقدم
ليتولى أو ليستولي على ما عداها.
تاسعاً:
بالنسبة لمناداة أبي بكر ثلاثة أيام ليقيله الناس
البيعة نقول:
إنها مغالطة فاشلة، فإن المطلوب أن يقيلهم هو بيعتهم،
وليس العكس، فإذا أحلهم منها إنتهى الأمر، ولا تبقى حاجة لأي تصرف
منهم، لأنهم هم الذين أعطوه عهداً ببيعتهم، وصاروا يرون أنفسهم ملزمين
بالوفاء به.
عاشراً:
بالنسبة لكلام الحسن عن تقوى أبي بكر التي تمنعه من
التوثب على ما ليس له، نقول:
إنه كلام لا يجدي، لأن الوقائع هي التي تحدد لنا إن كان
قد توثب على هذا الأمر، أو لم يتوثب عليه.
على أن التوثب على هذا الأمر قد يكون لأجل ما يزعمونه
من الغيرة على الدين، والخوف على المسلمين.. فلا يتنافى مع التقوى، إلا
إذا كان قد سمع النص من رسول الله «صلى الله عليه وآله» على علي «عليه
السلام» بالخلافة والإمامة، أو بايعه في يوم الغدير، ثم نقض بيعته، كما
هو المفروض..
ولربما يُدَّعى:
أن ثمة شبهة تسوغ هذا التوثب، وتمنع من الحكم بتعمد
مخالفة أحكام الشريعة، والعهدة في ذلك على من يدَّعيه.
حادي عشر:
حديث ابن سيرين، وإبراهيم التيمي لا يصح، إذ إن أبا بكر
فقط هو الذي طرح اسم أبي عبيدة يوم السقيفة، ولا يستطيع الحسن أو
التيمي أن يذكرا لنا اسم أحد غيره فعل ذلك. وظواهر الأمور تشير إلى أنه
قد طرح اسمه ليردها عليه أبو عبيدة، الذي لم يكن أحد سوى أبي بكر وعمر
يراه أهلاً لهذا الأمر.
بل إن سعد بن عبادة، ومن معه كانوا كلهم لا يرون أبا
بكر أهلاً لهذا الأمر، فهل يرون أبا عبيدة حفار القبور أهلاً له؟!
على أن حديث الحسن وإبراهيم، لم ينقل لنا بسند متصل..
قد
دلت الروايات المتقدمة أيضاً:
على أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد مات في نفس اليوم الذي صلى فيه
أبو بكر بالناس، فقد روى ابن أبي مليكة قال:
«لما كان يوم الإثنين خرج رسول الله «صلى الله عليه
وآله» عاصباً رأسه إلى الصبح، وأبو بكر يصلي بالناس، فلما خرج رسول
الله «صلى الله عليه وآله» تفرج الناس، فعرف أن الناس لم يفعلوا ذلك
إلا لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، فنكص عن مصلاه، فدفع رسول الله
«صلى الله عليه وآله» في ظهره الخ..»
([55]).
فقد دلت هذه الرواية:
على أن خروج النبي «صلى الله عليه وآله» إلى المسجد كان
في صلاة الصبح وأن مشاركته في الصلاة كانت يوم الإثنين..
وهناك روايات عديدة دلت على أن ذلك كان نفس يوم وفاته
«صلى الله عليه وآله»، فلاحظ ما يلي:
1 ـ
عن ابن جرير، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: قال
«صلى (أي النبي) في اليوم الذي مات فيه في المسجد»([56]).
2 ـ
ويدل على ذلك أيضاً: حديث أنس، قال: «لما مرض رسول الله
«صلى الله عليه وآله» مرضه الذي مات فيه أتاه بلال فآذنه بالصلاة،
فقال: يا بلال، قد بلّغت. فمن شاء فليصلِّ، ومن شاء فليدَع.
قال:
يا رسول الله، فمن يصلي بالناس.
قال:
مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس.
فلما تقدم أبو بكر رفعت الستور عن رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، فنظر إليه كأنه ورقة بيضاء عليه خميصه سوداء، فظن أبو بكر
أنه يريد الخروج، فتأخر، فأشار إليه رسول الله «صلى الله عليه وآله»
فصلى أبو بكر. فما رأينا رسول الله «صلى الله عليه وآله» حتى مات من
يومه([57]).
3 ـ
وعن عائشة: أن بلالاً جاء صباح يوم وفاة رسول الله «صلى
الله عليه وآله» فآذنه بالصلاة، فقال لها «صلى الله عليه وآله»: مري
أباك أن يصلي بالناس([58]).
وبذلك يتضح:
أن ما زعمته بعض الروايات: من أن أبا بكر قد صلى بالناس
أياماً، غير مسلّم([59])..
إلا إذا كان المقصود:
أنه صلى بهم من دون علم رسول الله «صلى الله عليه وآله»
بالأمر.
وقد تقدم:
أن عائشة تزعم: أن الداعي لها لمراجعة النبي «صلى الله
عليه وآله» في أمر صلاة أبي بكر بالناس هو الفرار من تشاؤم الناس
بأبيها إذا صلى في مرض الرسول، لو حدث به «صلى الله عليه وآله» حدث([60])..
ولكنها في رواية أخرى تبرر مراجعتها
للنبي «صلى الله عليه وآله»:
بأن أبا بكر رجل أسيف، لا يسمع الناس بسبب بكائه.
فأي ذلك هو الصحيح؟!
وفي رواية عبد الله بن زمعة:
أنه «صلى الله عليه وآله» قال لهم: مروا من يصلي
بالناس.. ولم يعين أحداً بعينه.. فلما أمر ابن زمعة عمر بأن يصلي
بالناس أنكر النبي «صلى الله عليه وآله» ذلك حسب ما زعمته الرواية،
وقال: «يأبى الله ذلك والمسلمون»([61]).
وقد قلنا: إن هذه الزيادة باطلة، لما يلي:
1 ـ
إن المسلمين قد رضوا بعمر حسب الفرض، وقد شرع بالصلاة
بالفعل..
2 ـ
كيف يأبى الله ذلك والحال أن عمرو بن العاص كان يؤم أبا
بكر وعمر معاً في غزوة ذات السلاسل، وأمهما أيضاً عبد الرحمن بن عوف في
غزوة تبوك؟..
3 ـ
قد جاء في رواية أنس قوله «صلى الله عليه وآله»: حين
آذنه بلال بالصلاة: «يا بلال قد بلغت. فمن شاء فليصلِّ، ومن شاء
فليدع»..
فما معنى زيادة فقرة:
مروا أبا بكر فليصل بالناس([62]).
4 ـ
أن صلاة أبي بكر بالناس لا تنسجم مع كونه قد جعله في
جيش أسامة، ولم يُرِدْ إِحْدَاثَ أي خلل في عزيمة ذلك الجيش، فكيف يخرج
أبا بكر منه للصلاة بالناس بسبب شدة مرضه؟!
إن الروايات المتقدمة، ومنها روايات عائشة نفسها،
المروية في صحيحي البخاري ومسلم قد دلت على: أن النبي «صلى الله عليه
وآله» قد عزل أبا بكر في أول صلاة صلاها، لأنها صرحت بأنه قال لهم:
مروا أبا بكر فليصل بالناس..
ثم ذكرت:
أنه وجد من نفسه خفة، فعزله عنها بنفسه، فكان أبو بكر
مأموماً والنبي «صلى الله عليه وآله» إماماً.
وقوله «صلى الله عليه وآله» لنسائه:
«إنكن لصويحبات يوسف» يدل على: أن النبي «صلى الله عليه
وآله» لم يكن هو الذي أمر أبا بكر بالصلاة، لأن صويحبات يوسف لم يخالفن
يوسف في شيء، ولا راجعنه في أمر صدر عنه، وإنما فتنهن حسنه، وأرادت كل
واحدة منهن أن تنال الحظوة عنده..
وهذا ما أرادته عائشة وحفصة، فإنهن أردن الحصول على
الشرف والمقام، بالتقرب من النبي «صلى الله عليه وآله»([63])..
فقدمتا أبويهما من أجل الإفتخار والتجمل بمقام القرب من الرسول «صلى
الله عليه وآله»، أي أنهن لم ينازعنه لصرف إمامة الجماعة عن أبويهما..
وقد ذكر المعتزلي كلاماً عن شيخه أبي يعقوب، يوسف بن
إسماعيل اللمعاني، جاء فيه ما يلي:
«فلما ثقل رسول الله «صلى الله عليه وآله» في مرضه أنفذ
جيش أسامة، وجعل فيه أبا بكر وغيره من أعلام المهاجرين والأنصار. فكان
علي «عليه السلام» حينئذٍ بوصوله إلى الأمر ـ إن حدث برسول الله «صلى
الله عليه وآله» حدث ـ أوثق. وتغلب على ظنه: أن المدينة لو مات لخلت من
منازع ينازعه الأمر بالكلية، فيأخذه صفواً عفواً، وتتم له البيعة، فلا
يتهيأ فسخها لو رام ضدٌّ منازعته عليها..
فكان من عود أبي بكر من جيش أسامة ـ بإرسالها إليه،
وإعلامه بأن رسول الله «صلى الله عليه وآله» يموت ـ ما كان، ومن حديث
الصلاة بالناس ما عرف.
فنسب علي «عليه السلام» إلى عائشة أنها أمرت بلالاً
مولى أبيها أن يأمره فليصل بالناس، لأن رسول الله ـ كما روي ـ قال:
ليصل بهم أحدهم، ولم يعين. وكانت صلاة الصبح؛ فخرج رسول الله «صلى الله
عليه وآله» وهو في آخر رمق يتهادى بين علي والفضل بن العباس، حتى قام
في المحراب ـ كما ورد في الخبر ـ ثم دخل فمات ارتفاع الضحى.
فجعل يوم صلاته حجة في صرف الأمر
إليه، وقال:
أيكم يطيب نفساً أن يتقدم قدمين قدمهما رسول الله في
الصلاة.
ولم يحملوا خروج رسول الله «صلى الله عليه وآله» لصرفه
عنها، بل لمحافظته على الصلاة مهما أمكن.. فبويع على هذه النكتة التي
اتهمها علي «عليه السلام» على أنها ابتدأت منها.
وكان علي «عليه السلام» يذكر هذا
لأصحابه في خلواته كثيراً، ويقول:
إنه لم يقل «صلى الله عليه وآله»: إنكن لصويحبات يوسف
إلا إنكاراً لهذه الحال، وغضباً منها، لأنها وحفصة تبادرتا إلى تعيين
أبويهما، وأنه استدركها بخروجه، وصرفه عن المحراب، فلم يجْدِ ذلك ولا
أثّر. مع قوة الداعي الذي كان يدعو إلى أبي بكر، ويمهد له قاعدة الأمر،
وتقرر حاله في نفوس الناس، ومن اتبعه على ذلك من أعيان المهاجرين
والأنصار..
فقلت له «رحمه الله»:
أفتقول أنت: إن عائشة عينت أباها للصلاة، ورسول الله
«صلى الله عليه وآله» لم يعينه؟!
فقال:
أما أنا فلا أقول ذلك، ولكن علياً كان يقوله، وتكليفي
غير تكليفه. كان حاضراً، ولم أكن حاضراً.. الخ»([64]).
ونقول:
قد أظهرت الفقرة الأخيرة:
أن المعتزلي فاجأ اللمعاني بسؤاله، وربما يكون قد
أخافه، فاضطر إلى أن يميز نفسه عن علي «عليه السلام» في هذا الأمر، مع
إلماحه إلى أن علياً «عليه السلام» هو الذي يعيش الحدث، ويعرف تفاصيله
ـ فقد كان علي حاضراً، ولم يكن اللمعاني حاضراً ـ..
ونحن تكفينا شهادة علي «عليه السلام» حول هذا الأمر،
فقد قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «علي مع الحق والحق مع علي،
يدور معه كيفما دار» أو نحو ذلك([65]).
وتقول رواية تقدمت:
أن أبا بكر استأذن النبي «صلى الله عليه وآله» ليذهب
إلى السنح([66])،
لأن زوجته أسماء بنت خارجة كانت تنتظره..
والذي يثير عجبنا:
أن أبا بكر يرى النبي «صلى الله عليه وآله» غير قادر
على المشي من شدة المرض. ولم يستطيع الوصول إلى موضع الصلاة إلا
بمساعدة رجلين، وكانت رجلاه تخطان في الأرض. ثم هو يستأذنه ـ كما
يزعمون ـ ليذهب إلى زوجته بنت خارجة في منزله بالسنح([67]).
وهذا الغياب هو الذي جعل عمر يحتاج إلى إنكار موت النبي
«صلى الله عليه وآله»، لإشغال الناس عن أي تدبير في الأمر إلى حين حضور
أبي بكر.
ألا يدل ذهاب أبي بكر إلى السنح، حيث لم يصلِّ بالناس
صلاة الظهر يوم الإثنين. على الأقل، وهو يوم استشهاد النبي «صلى الله
عليه وآله»، لأنه استشهد بعد الزوال، كما يقوله كثيرون، كما سيأتي ـ
ألا يدل ذلك ـ على أنه قد ذهب معزولاً عن الصلاة، (وربما غاضباً) بعد
أن تصدى لها من غير إذن، ولا رضى من رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!
وإذا كانت الروايات الصحيحة تتجه لتأكيد عزل أبي بكر عن
الصلاة، فهل يمكن أن نصدق ما تضيفه بعض المرويات، من أن النبي «صلى
الله عليه وآله» قد صلى خلف أبي بكر، أو أن أبا بكر قد صلى بصلاة
النبي، والناس صلوا بصلاة أبي بكر، لأن النبي «صلى الله عليه وآله» كان
جالساً، وكان أبو بكر قائماً، فكان الناس يرونه، فيقتدون به..
علماً بأن الصف الأول والذي يليه أيضاً قادر على رؤية
شخص رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ويشاهد حركته، وركوعه وسجوده، بلا
حاجة إلى أبي بكر وسواه..
وعن دعوى ائتمام النبي «صلى الله عليه وآله» بأبي بكر
يقول ابن الجوزي: «ليس هذا في الصحيح، وإنما قد روي من طرق لا تثبت»([68]).
وسيأتي المزيد مما يبطل هذا الزعم إن شاء الله تعالى..
وعن حديث أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد صلى خلف أبي
بكر نقول:
أولاً:
إن العمدة في هذه الرواية هو ما روته عائشة([69]).
وهي إنما تجر النار إلى قرصها، بل الوقائع تثبت أنها كانت تميل مع
هواها في رواياتها وفي تصرفاتها، ولأجل ذلك لم تذكر الشخص الذي توكأ
عليه النبي «صلى الله عليه وآله» حينما خرج ـ في مرضه ليعزل أبا بكر عن
الصلاة، وهو علي «عليه السلام»، لأنها كما يقول ابن عباس: «لا تقدر على
أن تذكره بخير»([70]).
أو كما يقول معمر:
«لا تطيب نفساً له بخير»([71]).
وقد دللت على أنها كانت تتصرف برأيها في هذا المجال
أيضاً حين ذكرت أنها كانت تسعى لإبعاد حالة التشاؤم بأبيها، مع أنها
كانت تدعي للنبي «صلى الله عليه وآله» أن أبا بكر رجل رقيق لا يُسْمِع
الناس من بكائه.
ثانياً:
إن ابن الجوزي يقول: إن حديث عائشة، عند أحمد،
والترمذي، وأبي داود يدور على شبابة بن سوار.
وقد أنكر أحمد بن حنبل عليه.
وأما سائر الطرق ـ وهي سبعة ـ عن عائشة فليس فيها ما
يثبت([72]).
ثالثاً:
سيأتي أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد عزل أبا بكر عن
هذه الصلاة بالذات.
رابعاً:
حتى لو فرضنا جدلاً أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد
صلى خلف أبي بكر، فإن ذلك لا يثبت إمامة أبي بكر وخلافته على الأمة،
وذلك لما يلي:
1 ـ
إن إمامة الجماعة لا تحتاج عند أهل السنة إلا إلى أن
يكون الإمام مسلماً، محسناً للقراءة.. ولا تحتاج إلى فقه، ولا إلى علم،
ولا إلى شجاعة، ولا إلى عدالة وتقوى ولا إلى غير ذلك من الشرائط
المعتبرة في الإمامة والخلافة.
2 ـ
لو صح أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد صلى خلف أبي
بكر، فإن ذلك لا يدل على أنه يرضاه لإمامة الأمة، إذ لو دلت الصلاة خلف
أبي بكر على إمامته لدلت على إمامة عبد الرحمن بن عوف أيضاً، فإنهم
يدَّعون أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد صلى خلفه في غزوة تبوك..
حسبما تقدم..
3 ـ
لنفترض عدم صحة النقض بصلاته «صلى الله عليه وآله» خلف
ابن عوف، لأنها لم تكن في مرض موت النبي «صلى الله عليه وآله».. أو
لعدم صحتها في نفسها، فإننا نقول:
إن عمر بن الخطاب قد أبطل تأثير فعل النبي «صلى الله
عليه وآله» في الدلالة على إمامة أو خلافة أبي بكر وغيره، لأنه قال: إن
النبي ليهجر، أو غلبه الوجع.. أو نحو ذلك.. ولا يعتد بنصب أو بعزل من
يكون في حالة هذيان أو يحتمل أنه كان كذلك ـ والعياذ بالله.
4 ـ
إنه «صلى الله عليه وآله» قد أمر كثيرين من الصحابة
بقيادة الجيوش والسرايا، وجعل عدداً من أصحابه ولاة على مكة وعلى
غيرها. وكان الأمير منهم يتولى الصلاة أيضاً.. وقد جرى بين عمرو بن
العاص وبين أبي عبيدة في غزوة ذات السلال ما تقدم بيانه، فإنه أصر على
أن يكون هو الإمام لهم بمن فيهم أبو بكر وعمر، ورضخوا له، وصلى بهم..
فلماذا لا يجعل ذلك من أدلة تقدم عمرو بن العاص على أبي بكر في
الخلافة، كما تقدمه في الصلاة؟! التي كان يرى أن النبي «صلى الله عليه
وآله» هوالذي رتبه فيها.
ورووا:
عن عبد الله بن زمعة بن الأسود قال: لما اسْتُعِزَّ
برسول الله «صلى الله عليه وآله» وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعا
بلال للصلاة، فقال: مروا من يصلي بالناس.
قال:
فخرجت، فإذا عمر في الناس. وكان أبو بكر غائباً، فقال:
قم يا عمر فصل بالناس.
قال:
فقام، فلما كبر عمر سمع رسول الله «صلى الله عليه وآله»
صوته، وكان عمر رجلاً مجهراً.
قال:
فقام رسول الله «صلى الله عليه وآله» وقال: لا، لا، لا
يصلي بالناس إلا ابن أبي قحافة ـ يقول ذلك مغضباً ـ فأين أبو بكر؟ يأبى
الله ذلك والمسلمون.
قال:
فبعث إلى أبي بكر بعد ما صلى عمر تلك الصلاة، فصلى
بالناس.
قال:
وقال عبد الله بن زمعة: قال عمر لي: ويحك، ماذا صنعت بي
يا بن زمعة، والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله «صلى الله عليه
وآله» أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس.
قال:
قلت: والله ما أمرني رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
ولكن حين لم أر أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة([73]).
ونقول:
أولاً:
إذا كان المسلمون يأبون ذلك، فلماذا يأمره ابن زمعة،
ويأتم به المسلمون، ولا يعترض أحد منهم؟!
ثانياً:
إذا كان أبو بكر وعمر قد جعلهما رسول الله «صلى الله
عليه وآله» في جيش أسامة، فلماذا حضر هؤلاء النفر من المسلمين عند رسول
الله «صلى الله عليه وآله»؟
ولماذا كانت تلك الجماعة من الناس، وفيهم عمر في المكان
الذي خرج إليه ابن زمعة؟
وهل كان أبو بكر غائباً في جيش أسامة أم كان في مكان
آخر؟
فإذا كان في جيش أسامة، فهل انتظر الناس حتى جاء من
هناك إلى المسجد؟
وإذا كان في غير الجيش، فهو كان عاصياً لأمر رسول الله
«صلى الله عليه وآله» الذي أمره وأمر غيره بأن يكونوا في ذلك الجيش..
فكيف استحق من يعصي أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن يكرم هذا
الإكرام من الله ورسوله؟!
ثالثاً:
لماذا يأبى الله والمسلمون غير أبي بكر هنا، ولم يكن
هذا الإباء منهم حين صلى عبد الرحمن بن عوف بجيش قوامه ثلاثون ألفاً،
وفيهم أبو بكر وعمر وسائر الرؤساء والزعماء، ثم التحق بهم النبي «صلى
الله عليه وآله»، وائتم بعبد الرحمن بن عوف، حسب زعمهم؟!
ولماذا كان أبو عبيدة وعمرو بن العاص يصليان بأبي بكر
وعمر وغيرهما من المسلمين في غزوة ذات السلاسل.. ولم يعترض عليهما أحد
من المسلمين، ولا اهتم الله وسوله لهذا الأمر على الإطلاق؟!
رابعاً:
إذا صح أن الله والمسلمين يأبون إلا أبا بكر، فلماذا
عاد «صلى الله عليه وآله» وخرج يتوكأ على علي «عليه السلام» والعباس،
لكي يعزل أبا بكر عن تلك الصلاة بالذات؟!
خامساً:
لقد روي أنه «صلى الله عليه وآله» قال: «مروا بلالاً
فليصل بالناس»([74]).
فكيف يتلاءم ذلك مع القول: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر؟!
سادساً وأخيراً:
إن التعبير بكلمة اسْتُعِزَّ برسول الله غير لائق
أبداً، فإنما يقال: استعز بفلان إذا غُلِبَ على كل شيء، من مرض أو
غيره.
وكأنهم يريدون بذلك تأكيد مقولة عمر «إن النبي ليهجر»
أو «غلبه الوجع».. فإنا لله وإنا إليه راجعون..
وقال أبو عمر:
استعز بالعليل إذا غلب على عقله([75]).
ونقل ابن الجوزي عن أبي حاتم:
أنها كانت صلاتين، كان رسول الله «صلى الله عليه وآله»
في إحداها مأموماً، وفي الأخرى كان إماماً.
قال:
والدليل على أنها كانت صلاتين لا صلاة واحدة، أن في خبر
عبيد الله بن عبد الله عن عائشة: أن النبي «صلى الله عليه وآله» خرج
بين رجلين، يريد بأحدهما العباس، والآخر علياً.
وفي خبر مسروق عن عائشة:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» خرج بين رجلين، أو
(بريرة وميمونة)، أو (بريرة ونوبة) قال: فهذا يدلك على أنها كانت
صلاتين، لا صلاة واحدة»([76]).
ولكن ابن الجوزي رد حديث صلاة النبي «صلى الله عليه
وآله» مأموماً بعدة أوجه:
أحدها:
أن فيه شبابة، وقد نسب إلى الغلط.
والحديث الذي يجعله (أي النبي «صلى الله عليه وآله»)
إماماً لأبي بكر ولغيره مؤيد بما رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
عن عائشة، وهو مروي في الصحاح..
الثاني:
إن خروجه «صلى الله عليه وآله» بين علي «عليه السلام»
والعباس مذكور في الصحيحين.
ويمكن الجمع بينه وبين الحديث
الآخر:
باحتمال أن تكون ميمونة وبريرة أخرجتاه إلى باب الدار،
ثم تولاه علي والعباس.. خصوصاً وأنه لم يجر في العادة أن تمشي الجواري
بين الصفوف، وكان القوم في الصلاة.
الثالث:
تقول رواية بريرة وميمونة: «فكان رسول الله يصلي
جالساً، وأبو بكر قائماً يصلي بصلاة رسول الله، والناس يصلون بصلاة أبي
بكر».
فالعجب لأبي حاتم كيف يقول:
كان رسول الله مأموماً، وهو يروي في حديث بريرة
وميمونة: وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله؟!
وكيف يصلي أبو بكر بصلاة رسول الله، ويكون هو الإمام
لرسول الله؟!([77]).
انتهى كلام ابن الجوزي.
ونقول:
إننا وإن كتا نؤكد صحة قولهم:
إنها كانت صلاة واحدة.. ولكننا لا نوافق على قولهم: إن
الناس كانوا يصلون بصلاة أبي بكر، إذ لا حاجة إلى ذلك، فإن المسلمين
الحاضرين كانوا قليلين، لأن الناس كانوا في جيش أسامة، وكان الصف الأول
وبعض الصف الذي خلفه يرى رسول الله «صلى الله عليه وآله» وهو جالس..
ويرى حركته بصورة مباشرة.. فما الحاجة إلى أبي بكر إذن؟!
روى الواقدي، عن عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن عبد الله
بن أبي بكر، عن أبيه، عن عائشة: جاء رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
فاستأخر أبو بكر، فأخذ بيده، فقدمه في مصلاه، فصفا جميعاً، ورسول الله
«صلى الله عليه وآله» جالس، وأبو بكر قائم، فلما سلم، صلى رسول الله
«صلى الله عليه وآله» الركعة الأخيرة، ثم انصرف([78]).
ونقول:
أولاً:
قد طعن في الواقدي يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل،
والبخاري، وأبو حاتم الرازي، وأبو عبد الرحمن النسائي، وابن عدي. وقد
اتهمه بعض هؤلاء بوضع الحديث([79]).
وطعن أبو حاتم الرازي بعبد الرحمن بن عبد العزيز، بأنه
مضطرب الحديث([80]).
وطعن أبو زرعة وموسى بن هارون بعبد الله بن أبي بكر([81]).
ثانياً:
إن الأحاديث تشير إلى أن النبي «صلى الله عليه وآله»
أشار إلى أبي بكر بما أراد، وهذا الحديث يقول: إنه«صلى الله عليه وآله»
أخذ بيده فقدمه في مصلاه..
ثالثاً:
لا تدل هذه الرواية على أن النبي «صلى الله عليه وآله»
قد ائتم بأبي بكر، ولا على العكس، بل هي تدل على أصل وجود الإئتمام
فيما بينهما.. فما معنى قوله: «فصفا جميعاً»؟! فإن كان المقصود أنهما
كانا إمامين للناس معاً وفي عرض واحد، ولم يكن أحدهما إماماً للآخر..
فإننا لم نعهد في الشريعة جعل إمامين لجماعة واحدة..
وهذا يخالف قولهم:
إن أبا بكر قد صلى بصلاة رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، ويخالف الرواية التي تدعي: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد
ائتم بأبي بكر. وإضافة الركعة الأخيرة لا يدل على اقتدائه «صلى الله
عليه وآله» بأبي بكر..
عن أبي عبد العزيز الترمذي، يرفعه إلى عائشة:
إن رسول الله
«صلى الله عليه وآله» رفع ستراً، فرأى الناس من وراء أبي بكر يصلون،
فحمد الله وقال: «الحمد لله، ما من نبي يتوفاه الله عز وجل حتى يؤمه
رجل من أمته..» ولم يذكر أنه خرج، ولا صلى خلفه([82]).
ونقول:
أولاً:
قد تقدم في غزوة تبوك أنهم يزعمون: أنه «صلى الله عليه
وآله» صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، فلماذا لا تكون كلمته المزعومة هذه
إشارة إلى تلك المزعمة؟!.
ثانياً:
إن أبا عبد العزيز الترمذي هو موسى بن عبيدة بن نشيط،
وقد طعن
فيه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن الجنيد الحافظ، كما ذكره ابن
الجوزي، فلا عبرة بحديثه([83]).
يضاف إلى ما تقدم:
أن الحديث غير متصل بل هو من المرفوعات..
ثالثاً:
إنه لا تناسب بين هذه الكلمة المنسوبة إلى رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، وبين صلاة أبي بكر.. كما أن هذه الكلمة لا تدل
على رضاه بأن يؤم أبو بكر الناس في صلاتهم تلك أو غيرها.. بل قد تكون
على خلاف ذلك أدل. إذا لوحظ قول الرواية: «ولم يذكر أنه خرج ولا صلى
خلفه».. فلعله يريد أن يشير إلى أنه كان قد أمه رجل آخر غير أبي بكر،
ربما يكون ذلك الشخص هو علي «عليه السلام»، حيث ذكرنا في ما سبق عدم
صحة قولهم: إن ابن عوف قد أمّ النبي «صلى الله عليه وآله» في غزوة
تبوك، وعدم صحة قولهم هنا: إنه «صلى الله عليه وآله» قد صلى خلف أبي
بكر..
وآخر كلمة نقولها هنا هي:
أننا لو فرضنا أن النبي «صلى الله عليه وآله» هو الذي
أمر أبا بكر بالصلاة بالناس، فإن الروايات التي تصرح بأنه «صلى الله
عليه وآله» خرج على تلك الحال من معاناة شدة المرض، حتى كانت رجلاه
تخطان في الأرض([84])،
فعزله وصلى هو بالناس ثابتة بلا ريب.
ولا مجال لدعوى:
أن حركته هذه هي نتيجة شدة اهتمامه «صلى الله عليه
وآله» بأمر الصلاة، فإن الشدائد المرضية التي كان يعاني منها كانت توجب
عليه أن لا يتحمل هذا الجهد، فهو قد احتاج إلى رجلين ليساعداه على
الوصول إلى موضع الصلاة، على تلك الحال الصعبة من الضعف، والجهد
البالغ، حتى لقد كانت رجلاه تخطان بالأرض.
كما لا مجال لحمل ذلك على إرادة تكريم أبي بكر،فإن
تكريمه لا يكون بعزله عن الصلاة، كما أنه كان يمكن تكليمه بما لا يوجب
للنبي «صلى الله عليه وآله» هذا الجهد، فلا بد من حمله على أنه «صلى
الله عليه وآله» كان مأموراً بهذا العزل، ولعله كان مأموراً بذلك النصب
أولاً أيضاً، لأن الله تعالى أراد أن يُعْلِمَ الأمة بأن هذا الرجل ليس
أهلاً لما يطمح له من نيل الخلافة بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله».
ولعلك تقول:
إن هذا لو صح لكان عقوبة لأبي بكر قبل ارتكابه أية
جناية. وهو غير معقول، ولا مقبول، ولا سيما من الرسول الأكرم «صلى الله
عليه وآله»، الذي لا ينطق عن الهوى!!
ونجيب:
بأن القول: إن أبا بكر لم يرتكب ما يوجب هذه العقوبة
غير صحيح، فإن مساعيه لنقض التدبير الإلهي في علي «عليه السلام»، كانت
واضحة للعيان، ولم ينسَ الناس بعدُ ما فعله هو وقريش في منى وفي عرفات
في حجة الوداع.
بل إن نفس تخلفه عن جيش أسامة، ومعصيته المتواصلة لله
ولرسوله في ذلك، يكفي لمواجهته بحرمانه من نفس ذلك الذي دعاه إلى هذه
المخالفة. وهو العزل عن إمامة الصلاة، وإعلام الناس بعدم أهليته لها،
واستحقاقه للعزل عنها. فمن كان بهذه المثابة، فهل يرضاه الله للمقام
الأعظم، والأجل والأفخم؟!
([1])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص305 عن البخاري، ومسلم، والبيهقي،
والبلاذري، وابن حجر، وابن سعد. وراجع: المحلى لابن حزم ج4
ص239 والبحار ج28 ص144وصحيح البخاري ج2 ص60 وصحيح البخاري ج5
ص141 وفتح الباري ج8 ص109 وعمدة القاري ج7 ص280 وج18 ص69 وصحيح
ابن خزيمة ج3 ص75 وصحيح ابن حبان ج14 ص587 و 588 والتمهيد لابن
عبد البر ج24 ص394 وشرح مسند أبي حنيفة ص58 والثقات لابن حبان
ج2 ص130.
([2])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص246 و 305 عن البخاري، ومسلم، والبيهقي،
والبلاذري، وابن حجر، وابن سعد. وراجع: صحيح البخاري (ط دار
الفكر) ج1 ص183 وسنن النسائي ج4 ص7 والبحار ج28 ص144 وفتح
الباري ج8 ص110 وعمدة القاري ج6 ص3 والسنن الكبرى ج1 ص602 وج4
ص261 وكتاب الوفاة للنسائي ص56 ومسند أبي يعلى ج6 ص285
والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص216 وسير أعلام النبلاء ج10 ص620
والبداية والنهاية ج5 ص275 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص506.
([3])
مسند أحمد ج6 ص249 وآفة أصحاب الحديث ص85. والرسالة الشافعي
ص253 وفتح العزيز للرافعي ج4 ص320 والإقناع في حل ألفاظ أبي
شجاع للشربيني ج1 ص153 وكشاف القناع للبهوتي ج1 ص580 وكنز
العمال ج15 ص747 وشرح مسلم للنووي ج4 ص133 وعون المعبود ج2
ص219 والإستذكار لابن عبد البر ج2 ص173 والتمهيد لابن عبد البر
ج6 ص140 ونصب الراية للزيلعي ج2 ص58 والجامع لأحكام القرآن ج3
ص218.
([4])
تاريخ الأمم والملوك ج2 ص439 وشرح النهج للمعتزلي ج13 ص33 و 35
ومناقب أهل البيت «عليهم السلام» للشيرواني ص397 وسفينة النجاة
للسرابي التنكابني ص149.
([5])
مسند أحمد ج6 ص224 وعن صحيح البخاري ج1 ص182 و 183 و (ط دار
الفكر) ج1 ص162 و 175 وصحيح مسلم ج2 ص23 كتاب الصلاة، باب
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، وآفة أصحاب الحديث ص57 و 58 و
59 وسبل الهدى والرشاد ج12 ص244 و 245 والمجموع للنووي ج4 ص241
والمبسوط للسرخسي ج1 ص214 وبدائع الصنائع ج1 ص142 والبحار ج28
ص137 عن جامع الأصول، وص138 عن البخاري، ومسند أحمد ج6 ص210 و
224 وسنن ابن ماجة ج1 ص389 وسنن النسائي ج2 ص100 والسنن الكبرى
للبيهقي ج2 ص304 وج3 ص81 و 94 وعمدة القاري ج5 ص186 و 248 و
250 ومسند ابن راهويه ج3 ص831 والسنن الكبرى للنسائي ج1 ص293
وصحيح ابن خزيمة ج3 ص53 وشرح معاني الآثار ج1 ص406 وصحيح ابن
حبان ج5 ص485 و 489 و 495 وج15 ص292 وكنز العمال ج5 ص634.
([6])
آفة أصحاب الحديث ص58 و 59 و 85 والبخاري ج1 ص175 و (ط دار
الفكر) ج1 ص169 وصحيح مسلم ج2 ص21 وسنن النسائي ج2 ص102 والسنن
الكبرى للبيهقي ج3 ص81 وج8 ص151 ومعرفة السنن والآثـار = = ج2
ص359 ونصب الراية للزيلعي ج2 ص52 وإمتاع الأسماع ج14 ص455
ومسند ابن راهويه ج2 ص505 والبحار ج28 ص142 عن جامع الأصول ج11
ص382 ـ 383 وسنن الدارمي ج1 ص288 وسفينة النجاة للسرابي
التنكابني ص148 و 149.
([7])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص245 والبداية والنهاية ج5 ص254 والسيرة
النبوية لابن كثـير ج4 ص462 ونيـل الأوطـار ج1 ص306 والطرائـف
في = = معرفة مذاهب الطوائف للسيد ابن طاووس ص228 والبحار ج28
ص141 ومسند أحمد ج2 ص52 وج6 ص251 وسنن الدارمي ج1 ص287 وصحيح
البخاري (ط دار الفكر) ج1 ص168 وصحيح مسلم ج2 ص21 وسنن النسائي
ج2 ص101 والسنن الكبرى للبيهقي ج3 ص80 وج8 ص151 وعمدة القاري
ج5 ص215 والمصنف لابن أبي شيبة ج2 ص229 وج8 ص569 ومسند ابن
راهويه ج2 ص504 والسنن الكبرى للنسائي ج1 ص293 وج4 ص255 وكتاب
الوفاة للنسائي ص29 وصحيح ابن حبان ج5 ص481 ومعرفة السنن
والآثار ج2 ص358 ونصب الراية ج2 ص52 وكنز العمال ج7 ص267 وشرح
مسند أبي حنيفة ص101 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص218 والثقات
لابن حبان ج2 ص132 والبداية والنهاية لابن كثير ج5 ص254 وإمتاع
الأسماع ج14 ص454 و 463 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص462.
([8])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص245 والمجموع للنووي ج4 ص266 والشرح
الكبير لابن قدامة ج2 ص46 وبدائع الصنائع لأبي بكر الكاشاني ج1
ص142 والمغني لابن قدامة ج2 ص48 ونيل الأوطار ج1 ص306 وج3 ص184
والإفصاح للشيخ المفيد ص205 و الطرائف لابن طاووس ص228 والبحار
ج28 ص136 و 137 و 141 و 165 و 362 و مسند أحمد ج6 ص251 وسنن
الدارمي ج1 ص288 وصحيح البخاري (ط دار الفكر) ج1 ص162و 167
وصحيح مسلم ج2 ص21 و 24 وسنن ابن ماجة ج1 ص390 وسنن النسائي ج2
ص102 والسنن الكبرى للبيهقي ج3 ص80 و 82 وفتح الباري ج2 ص130 و
171 وعمدة القـاري ج5 ص187 و 207 وتحفـة الأحوذي = = ج2 ص296
والمصنف لابن أبي شيبة ج2 ص229 وج8 ص569 و مسند ابن راهويه ج2
ص110 و 504 و السنن الكبرى للنسائي ج1 ص293 ومسند أبي يعلى ج3
ص438 وصحيح ابن حبان ج5 ص481 والتمهيد لابن عبد البر ج6 ص145
وج22 ص317 و 321 والمواقف للإيجي ج3 ص610 وصحيح ابن حبان ج5
ص486 وج14 ص567 و 568 ونصب الراية ج2 ص52 و 53 و 56 وموارد
الظمآن ج2 ص61 وكنز العمال ج7 ص268 وشرح مسند أبي حنيفة ص101
والعلل ج3 ص311 والثقات ج2 ص132 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2
ص218 ومعرفة السنن والآثار ج2 ص359 والإستذكار لابن عبد البر
ج2 ص173 وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج3 ص443 وج9 ص187 وتاريخ
مدينة دمشق ج20 ص166 والكامل في التاريخ ج2 ص322 والبداية
والنهاية ج5 ص253 و 254 وإمتاع الأسماع ج14 ص463 والإستغاثة
لأبي القاسم الكوفي ج2 ص15 وج4 ص460 و 463 و السيرة الحلبية (ط
دار المعرفة) ج3 ص465.
([9])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص245 عن ابن إسحاق، وابن سعد،
والبلاذري، = = وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص440 والسيرة الحلبية
ج3 ص467 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص62 والسيرة
النبوية لابن هشام ج4 ص1068 وراجع: إمتاع الأسماع ج14 ص475.
([10])
سبل الهدى والرشاد ج8 ص194 وج12 ص245 عن أحمد، والنسائي،
والبيهقي، والترمذي وصححه، والمغني لابن قدامة ج2 ص49 وتنوير
الحوالك ص59 والشرح الكبير لابن قدامة ج2 ص49 ونيل الأوطار ج3
ص207 والبحار ج28 ص142 وحاشية السندي على النسائي ج2 ص100
وعمدة القاري ج5 ص187 ومسند أحمد ج3 ص243 وج6 ص159 وسنن
الترمذي ج1 ص226 وتحفة الأحوذي ج2 ص296 ونصب الراية ج2 ص56
والإحكام لابن حزم ج4 ص484 وتاريخ بغداد ج2 ص36 والسيرة
النبوية لابن كثير ج4 ص464 والبداية والنهاية ج5 ص254 والسيرة
الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص465.
([11])
المناقب لابن شهر آشوب ج1 ص203 والبحار ج22 ص521 عنه.
([12])
مسند أحمد ج1 ص356 وآفة أصحاب الحديث ص60 ولكنه اختصره، وسنن
ابن ماجة ج1 ص391 وتاريخ مدينة دمشق ج8 ص18 وراجع: شرح معاني
الآثار ج1 ص405.
([13])
مسند أحمد ج1 ص355 و 356 وفتح الباري ج2 ص145 والمصنف لابن أبي
شيبة ج2 ص99 ونيل الأوطار ج2 ص232 وسنن ابن ماجة ج1 ص391 = =
وعمدة القاري ج4 ص107 ونصب الراية ج2 ص59 والطبقات الكبرى لابن
سعد ج3 ص183.
([14])
آفة اصحاب الحديث ص62 ـ 64.
([15])
الإستذكار لابن عبد البر ج2 ص176.
([16])
راجع: عمدة القاري ج5 ص191.
([17])
تاريخ الأمم والملوك ج2 ص439 وراجع المصادر المتقدمة.
([18])
السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج 3 ص 462.
([19])
سبل الهدى والرشاد ج11 ص175.
([20])
السيرة النبوية لابن هشام ج4 ص1066.
([21])
مسند أحمد ج4 ص322.
([22])
فتح الباري ج11 ص51.
([23])
كنز العمال ج7 ص266.
([24])
سنن أبي داود ج1 ص214.
([25])
المواقف للإيجي ج3 ص631.
([26])
بدائع الصنائع ج1 ص142 ومسند أحمد ج6 ص34.
([27])
صحيح البخاري ج1 ص165.
([28])
سنن أبي داود ج1 ص214.
([29])
صحيح البخاري ج1 ص168.
([30])
مجمع الزوائد ج1 ص330.
([31])
مسند أحمد ج1 ص356.
([32])
مسند أبي يعلى ج6 ص250.
([33])
السيرة النبوية لابن هشام ج4 ص1068.
([34])
مسند أحمد ج5 ص336.
([35])
عمدة القاري ج5 ص215.
([36])
مسند أحمد ج1 ص355 و 356 وفتح الباري ج2 ص145 والمصنف لابن أبي
شيبة ج2 ص99 ونيل الأوطار ج2 ص232 وسنن ابن ماجة ج1 ص391 وعمدة
القاري ج4 ص107 ونصب الراية ج2 ص59 والطبقات الكبرى لابن سعد
ج3 ص183.
([37])
مسند أحمد ج1 ص231.
([38])
مسند أحمد ج1 ص356.
([39])
كتاب الأم الشافعي ج7 ص210.
([40])
تاريخ الأمم والملوك ج2 ص440.
([41])
الكامل في التاريخ ج2 ص322.
([42])
أسد الغابة ج4 ص68.
([43])
عمدة القاري ج5 ص216.
([44])
صحيح البخاري ج1 ص162.
([45])
صحيح البخاري ج1 ص168.
([46])
كتاب الأم للشافعي ج1 ص99.
([47])
السقيفة ص52 ـ 54 و (نشر مؤسسة أنصاريان) ص56 ـ 58 بتصرف يسير.
([48])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص316 عن البلاذري، وكنز العمال ج11 ص328
وتاريخ مدينة دمشق ج42 ص441 و 443 وراجع: السيرة الحلبية (ط
دار المعرفة) ج3 ص490.
([49])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص316 عن البلاذري، والتمهيد لابن عبد
البر ج22 ص129 والغدير ج8 ص36 عن الرياض النضرة ج1 ص150
والوافي بالوفيات ج17 ص166 وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج3
ص183 وتاريخ مدينة دمشق ج30 ص265.
([50])
الإستيعاب (ط دار الجيل) ج3 ص971 والبحار ج28 ص146 عنه،
والتمهيد لابن عبد البر ج22 ص129 والغدير ج8 ص36.
([51])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص317 عن البلاذري، والجامع لأحكام
القرآن ج1 ص272 وكنز العمال ج5 ص657 وأضواء البيان للشنقيطي ج1
ص31 والعثمانية ص235 وراجع: عيون أخبار الرضا «عليه السلام»
للصدوق ج1 ص201 والبحار ج31 ص621 وج49 ص192.
([52])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص317 عن البلاذري، وشرح العقيدة
الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص537 والامامة والسياسة (بتحقيق
الزيني) ج1 ص10 و (بتحقيق الشيري) ج1 ص18 راجع: التمهيد لابن
عبد البر ج22 ص127.
([53])
الآية 40 من سورة التوبة.
([54])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص317 عن البلاذري، والمصنف لابن أبي
شيبة ج8 ص573.
([55])
تاريخ الأمم والملوك ج3 ص196 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج2 ص440
والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص1068 والسيرة الحلبية (ط دار
المعرفة) ج3 ص467.
([56])
كنز العمال ج7 ص272 وراجع: سنن الدارمي ج1 ص36 وعمدة القاري ج5
ص191 ونصب الراية ج2 ص56.
([57])
كنز العمال ج7 ص 261 وراجع: مسند أبي يعلى ج6 ص264 ومختصر
تاريخ دمشق ج2 ص381 و 382 ومسند أحمد ج3 ص202 والمصنف لابن أبي
شيبة ج2 ص227 وحديث خيثمة ص140 وشرح الأخبار ج2 ص238.
([58])
كنز العمال ج7 ص266 عن أبي الشيخ.
([59])
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج3 ص276 و277 ومسند أبي عوانة ج1
ص440 وسنن النسائي ج2 ص101 وصحيح البخاري ج1 ص278 و179 ح78
وصحيح مسلم ج2 ص20 و21.
([60])
صحيح البخاري ج6 ص33 ح432 وصحيح مسلم ج2 ص22 والسنن الكبرى ج8
ص152.
([61])
الإستيعاب (ط دار الجيل) ج3 ص970 و المحلى لابن حزم ج4 ص210
وشرح الأخبار ج2 ص239 والبحار ج28 ص145 و 156 و 157 و مسند
أحمد ج4 ص322 وج6 ص106 وسنن أبي داود ج2 ص405 وعمدة القاري ج5
ص188 وعون المعبود ج12 ص273 والمعجم الأوسط ج2 ص12 والتمهيد
لابن عبد البر ج22 ص128 وكنز العمال ج11 ص550 وتاريخ مدينة
دمشق ج30 ص262 و 263 و267 والبداية والنهاية ج5 ص252 وإمتاع
الأسماع ج14 ص457 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص1067 والسيرة
النبوية لابن كثير ج4 ص459 وسبل الهدى والرشاد ج12 ص244.
([62])
تقدمت مصادر حديث أنس.
([63])
تلخيص الشافي ج3 ص30.
([64])
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج9 ص196 ـ 198.
([65])
المستدرك للحاكم ج3 ص124 والجامع الصحيح للترمذي ج3 ص166 وكنوز
الحقائق للمناوي ص70 ومجمع الزوائد ج7 ص233 وجامع الأصول ج9
ص420 وراجع: كشف الغمة ج2 ص35 وج1 ص141 ـ 146 والجمل ص36
وتاريخ بغداد ج14 ص322 ومستدرك الحاكم ج3 ص119 و 124 وتلخيصه
للذهبي بهامشه، وراجع نزل الأبرار ص56 وفي هامشه عن مجمع
الزوائد ج7 ص234 وعن كنوز الحقائق ص65 وكنز العمال ج6 ص157
وشرح النهج للمعتزلي ج2 ص297 وج18 ص72 وتاريخ مدينة دمشق ج42
ص449.
([66])
السنح: موضع بالمدينة بينه وبين منزل النبي «صلى الله عليه
وآله» قدر ميل. كان لأبي بكر منزل هناك.
([67])
راجع: تاريخ دمشق ج2 ص56 والبداية وكنز العمال ج10 ص745 وإمتاع
الأسماع ج2 ص125 وج14 ص521 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص249
والنهاية ج5 ص184 ـ 186 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج13 ص36.
([68])
آفة أصحاب الحديث ص49.
([69])
راجع: مسند أحمد ج6 ص224 وعن صحيح البخاري ج1 ص182 و 183 و (ط
دار الفكر) ج1 ص162 و 175 وصحيح مسلم ج2 ص23 كتاب الصلاة، باب
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، وآفة أصحاب الحديث ص57 و 58 و
59 وسبل الهدى والرشاد ج12 ص244 و 245 والمجموع للنووي ج4 ص241
والمبسوط للسرخسي ج1 ص214 وبدائع الصنائع ج1 ص142 والبحار ج28
ص137 عن جامع الأصول، وص138 عن البخاري، ومسند أحمد ج6 ص210 و
224 وسنن ابن ماجة ج1 ص389 وسنن النسائي ج2 ص100 والسنن الكبرى
للبيهقي ج2 ص304 وج3 ص81 و 94 وعمدة القاري ج5 ص186 و 248 و
250 ومسند ابن راهويه ج3 ص831 والسنن الكبرى للنسائي ج1 ص293
وصحيح ابن خزيمة ج3 ص53 وشرح معاني الآثار ج1 ص406 وصحيح ابن
حبان ج5 ص485 و 489 و 495 وج15 ص292 وكنز العمال ج5 ص634
ومصادر أخرى تقدمت.
([70])
تاريخ الأمم والملوك ج2 ص433 وعمدة القاري ج5 ص192 وفتح الباري
ج2 ص131 وخلاصة عبقات الأنوار ج3 ص287 والغدير ج9 ص324 وشرح
إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص 41
([71])
عمدة القاري ج5 ص192 وخلاصة عبقات الأنوار ج3 ص287 وفتح الباري
ج2 ص131وراجع: صحيح البخاري ج1 ص175 والمسترشد للطبري (الشيعي)
ص126 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص433 والإرشاد للمفيد ج1 ص311
ومناقب أهل البيت «عليه السلام» للشيرواني ص472 وقاموس الرجال
ج12 ص299 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص415.
([72])
آفة أصحاب الحديث ص50 و 51 و 75 ـ 95.
([73])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص244 عن أحمد، وأبي داود، وابن سعد،
وسنن أبي داود ج4 ص215 ومسند أحمد ج4 ص322 وج6 ص106 وتاريخ
مدينة دمشق ج30 ص262 وإمتاع الأسماع ج14 ص457 والسيرة النبوية
لابن هشام ج4 ص1066 وعون المعبود ج12 ص272 والمستدرك للحاكم ج3
ص641. وراجع: الإستيعاب (ط دار الجيل) ج3 ص970 و المحلى لابن
حزم ج4 ص210 وشرح الأخبار ج2 ص239 والبحار ج28 ص145 و 156 و
157 وسنن أبي داود ج2 ص405 وعمدة القاري ج5 ص188 وعون المعبود
ج12 ص273 والمعجم الأوسط ج2 ص12 والتمهيد لابن عبد البر ج22
ص128 وكنز العمال ج11 ص550 وتاريخ مدينة دمشق ج30 ص262 و 263
و267 والبداية والنهاية ج5 ص252 وإمتاع الأسماع ج14 ص457
والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص1067 والسيرة النبوية لابن كثير
ج4 ص459 وسبل الهدى والرشاد ج12 ص244.
([74])
بغية الطالب في تاريخ حلب لابن النديم (مخطوط في مكتبة
قبوسراي) الورقة 194 رقم 2925.
([75])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج2 ص246.
([76])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج8 ص195 و 196 وآفة أصحاب الحديث ص79
وصحيح ابن حبان ج5 ص488 وعمدة القاري ج5 ص188 وتنوير الحوالك
ص60.
([77])
راجع: آفة أصحاب الحديث ص 80.
([78])
آفة أصحاب الحديث ص86 وتنوير الحوالك ص60 ومعرفة السنن والآثار
ج2 ص360 ونصب الراية ج2 ص55 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص220
وسبل الهدى والرشاد ج8 ص196 وإمتاع الأسماع ج14 ص471.
([79])
تهذيب التهذيب ج9 ص363 و 368.
([80])
تهذيب التهذيب ج6 ص220.
([81])
لسان الميزان ج3 ص264.
([82])
آفة أصحاب الحديث ص87 والمعجم الأوسط ج4 ص365 ومجمع الزوائد ج3
ص11 وج9 ص37 وإمتاع الأسماع ج14 ص473. وراجع: تنوير الحوالك
ص59 والمغني لابن قدامة ج2 ص49 والإستذكار لابن عبد البر ج2
ص173 وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ج1 ص124
وبغية الباحث ص297 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص222 والتمهيد
لابن عبد البر ج6 ص144.
([83])
تهذيب التهذيب ج10 ص356 ـ 360 وراجع: التاريخ الصغير للبخاري
ج2 ص87 وج7 ص291 والكامل لابن عدي ج6 ص333.
([84])
مسند أحمد ج1 ص356 وج6 ص210 و 224 والمبسوط للسرخسي ج1 ص214
والمحلى لابن حزم ج3 ص64 و صحيح مسلم ج2 ص23 وسنن ابن ماجة ج1
ص389 و 391 وسنن النسائي ج2 ص99 والسنن الكبرى للبيهقي ج2 ص304
وج3 ص81 وعمدة القاري ج5 ص186 والمصنف لابن أبي شيبة ج2 ص227
ومسند ابن راهويه ج3 ص831 و السنن الكبرى للنسائي ج1 ص293
وصحيح ابن خزيمة ج3 ص53 وشرح معاني الآثار ج1 ص406 وصحيح ابن
حبان ج5 ص489 ومعرفة السنن والآثار ج2 ص356 والتمهيد لابن عبد
البر ج22 ص317 والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص179 وأسد الغابة
ج3 ص221 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص439 وإمتاع الأسماع ج14
ص453.
|