|
هــجــــرة الـحـبـشــــة
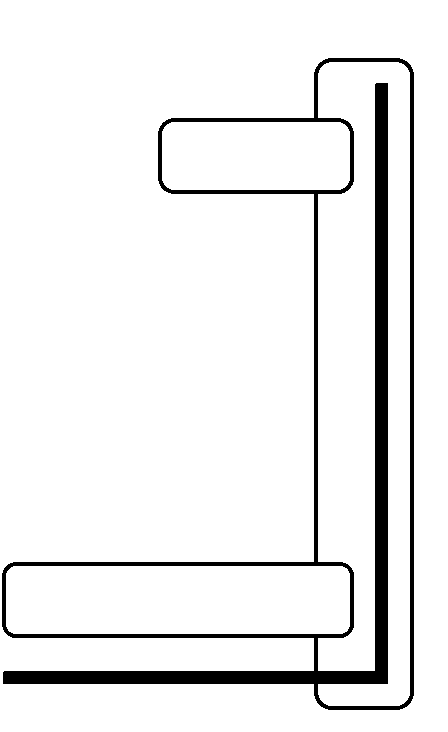
لقد استمرت قريش في تعذيب من يدخل في دين الإسلام ممن
لم يكن لهم عشيرة تمنعهم.
وكان الاستمرار في هذا الوضع غير ممكن،
فقد كان وأصبح لا بد لهؤلاء المعذبين من العثور على موضع أمل لهم،
يساعدهم على تحمل المشاق، ومواجهة الصعاب، ويجعلهم أقدر على مقاومة
الضغوط التي يتعرضون لها من قبل من رفضوا أن يعترفوا بألوهية وحاكمية
فوق ألوهيتهم وحاكميتهم، وآثروا الاستكبار والعناد على الرضوخ
والانقياد.
ومن جهة ثانية:
فإن استمرار
هذا الوضع الذي يواجهه المسلمون،
المليء بالآلام والمشاق، لسوف يقلل من إقبال الناس على
الدخول في الإسلام، ما دام أن هذا الدخول لا حصاد له سوى الرعب،
والتعذيب والمصائب.
ومن جهة ثالثة:
فقد كان لا بد
من تسديد ضربة لكبرياء قريش وجبروتها ـ ولو نفسياً ـ لتدرك: أن قضية
الدين تتجاوز حدود تصوراتها وقدراتها ـ وأن عليها: أن تفكر بموضوعية
وعقلانية أكثر،
فكان
أن اختار رسول
الله
>صلى
الله عليه وآله<
للمسلمين الهجرة إلى الحبشة.
وكانت هجرتهم إليها في السنة الخامسة من البعثة.
سر
اختيار
الحبشة:
وأما عن سر اختيار رسول الله
>صلى
الله عليه وآله<
الحبشة مهاجراً للمسلمين، فقد أشار إليه
>صلى
الله عليه وآله<
بقوله:
>إن
بها ملكاً لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق<
و >إنه
يحسن الجوار<.
وقد كان من الواضح أنه:
1 ـ
كان لا بدّ لقريش من أن تبذل محاولاتها لاسترجاع المسلمين، لتبقى هي
المهيمنة، وصاحبة الاختيار الأول والأخير في مصير هذا الدين، الذي تراه
يتهدد كبرياءها وشركها، وانحرافها.
2 ـ
لقد كان لقريش نفوذ في بلاد الروم والشام، لما كان لها من علاقات
تجارية واقتصادية معها، فالهجرة إلى هذه البلاد إذن سوف تسهل على قريش
استرجاع المهاجرين، أو على الأقل إلحاق الأذى بهم،
ولا سيما إذا كان ملوك تلك البلاد لا يلتزمون بأي من الأصول الأخلاقية
والإنسانية، ولم يكن لديهم مانع من ممارسة أي نوع من أنواع الظلم
والجور، وعلى الأخص بالنسبة لمن ينتسب إلى دعوة يرون أنها تضر بمصالحهم
الشخصية، وتهدد كيانهم وجبروتهم.
وأما بلاد اليمن، وبعض المناطق العربية والقبلية الأخرى
فقد كانت تحت نفوذ النظام الفارسي، المتجبر والظالم.
ويذكر هنا:
أن بعض
القبائل عندما عرض عليها النبي
>صلى الله
عليه وآله<
دعـوتـه
وطلب منها حمايتها له، قبلت بذلك، ولكن مما دون كسرى([1])،
وأما من كسرى، فلا.
وواضح:
أن الالتجاء إلى كسرى لا يقل خطراً عن الالتجاء إلى
بلاد الروم، خصوصاً إذا رأى: أن هذا العربي ـ وهو بطبعه كان يحتقر
العرب، ولا يرى لهم حرمة، ولا شأناً يذكر ـ لسوف يخرج في منطقة قريبة
من بلاده، وقد تسري دعوته إلى بلاده نفسها، ويؤثر ذلك على الامتيازات
الظالمة التي يجعلها لنفسه، كما يظهر من دراسة طبيعة دعوة ذلك النبي،
وأهدافها.
3 ـ
قد كان لقريش نفوذ قوي في مختلف القبائل العربية، حتى
ما كان منها تحت نفوذ الفرس والروم.
كما ربما يتضح مما ذكرناه في أوائل هذا الكتاب، فلا
نعيد.
4 ـ
ما ذكره النبي >صلى
الله عليه وآله<
من أن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد،
فإن كل ذلك يجعلنا نضع أيدينا على السر الحقيقي لاختيار بلاد الحبشة،
البعيدة عن النفوذ الفارسي والرومي والقريشي، والتي لا يمكن لقريش أن
تصل إليها على ظهر جواد أو راحلة، وإنما بالسفن عبر البحار،
ولم تكن قريش تعرف حرب السفن، فاختار الرسول
>صلى
الله عليه وآله<
هذه البلاد بالذات لتكون أرضاً لهجرة المسلمين، الذين لا يزالون ضعافاً
أمام قوة قريش وجبروتها.
ثم إننا نستفيد من قوله
>صلى
الله عليه وآله<
عن أرض الحبشة: إنها أرض صدق: أنه قد كان فيها شعب يعيش على الفطرة،
ويتعامل بالصدق والصفاء،
وربما كان
الناس في تلك المنطقة أقرب من غيرهم إلى الالتزام بما تبقى لديهم من
تعاليم السيد المسيح
>عليه
السلام<
كما ربما يستفاد مما جرى لجعفر مع ملك الحبشة في أمر عيسى،
فيمكن لهؤلاء
الثلة من المسلمين المهاجرين أن يعيشوا مع هؤلاء الناس، وأن يتعاملوا
معهم، لا سيما وأنها بلاد لم يكن فيها من الانحرافات والأفكار والشبهات
ما كان في بلاد الروم والفرس، التي كانت قد لوثتها المفاهيم والنظريات
اللاإنسانية، والأديان المنحرفة إلى حد بعيد، ولم تتعرض بلاد الحبشة
لمثل ذلك، فلم تنشأ فيها أديان، ولا كان فيها علماء وفلاسفة بالمستوى
الذي كان في دولتي الروم والفرس فكانت أقرب إلى الفطرة والحق
من غيرها.
ولكن هيمنة الفطرة على بلاد الحبشة ليس معناه خلو تلك
البلاد عن أي انحراف، فإن وجود الانحراف فيها أمر طبيعي، بل إن ذلك على
حد قولهم: أهل البلد الفلاني مؤمنون، أو شجعان، أو كرماء، فإن ذلك لا
يمنع وجود البخيل والكافر أو الفاسق والجبان فيها.
ومن الواضح:
أن المسلمين لو هاجروا إلى بلاد لا تهيمن عليها الفطرة،
وكان لها ملك لا يأبى عن الظلم فلسوف تصعب عليهم الحياة والاستمرار
فيها، ولم يكن لهجرتهم من بلادهم كبير فائدة، ولا جليل أثر.
وهاجر المسلمون بأمر من رسول الله
>صلى
الله عليه وآله<
إلى الحبشة، ذهبوا إليها إرسالاً على حسب رواية أم سلمة،
([2])
ويقال: إنه سافر أولاً عشرة رجال وأربع نساء عليهم
عثمان بن مظعون([3])،
ثم خرج آخرون حتى تكاملوا في الحبشة اثنين أو ثلاثاً وثمانين رجلاً، إن
قلنا إن عمار بن ياسر كان معهم،
وتسع عشرة امرأة عدا الأطفال.
وقد كانت هذه الهجرة في السنة الخامسة من البعثة كما نص
عليه عامة المؤرخين.
ولكن عند الحاكم:
أن هجرة الحبشة قد كانت بعد وفاة أبي طالب([4])،
وهو إنما توفي في السنة العاشرة من البعثة.
إلا إذا كان الحاكم يتحدث عن هجرة جديدة قام بها بعض
المسلمين في هذا الوقت، لعلها عودة الراجعين إلى مكة بعد سماعهم
بالهدنة، ففوجئوا بالعكس فعادوا أدراجهم،
ولكننا لا نملك شواهد تؤيد أن ذلك كان في تلك السنة بالذات.
وكيف كان فإننا نقول:
إننا نرجح:
أنه لم يكن
سوى هجرة واحدة للجميع، عليها جعفر بن أبي طالب
>عليه
السلام<،
الذي لم يكن غيره من بني هاشم فلم يكن ثمة هجرتان، عشرة أولاً، ثم
الباقون ثانياً، وإن كان خروجهم إنما كان إرسالاً حفاظاً على عنصر
السرية، وذلك بدليل الرسالة التي وجهها الرسول
>صلى
الله عليه وآله<
إلى ملك الحبشة مع عمرو بن أمية الضمري، والتي جاء فيها:
>قد
بعثت إليكم ابن عمي جعفر بن أبي طالب، معه نفر من المسلمين، فإذا جاؤوك
فأقرهم
الخ..<([5]).
وهذا هو الظاهر من رواية أخرى عن أبي موسى، قال:
>أمرنا
رسول الله >صلى
الله عليه وآله<
أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي
الخ..
<([6]).
وإن كانت هجرة أبي موسى هذه محل شك كما سنرى.
ونعتقد:
إن هجرة جعفر
إلى الحبشة، لم تكن بسبب تعرضه للتعذيب من قبل قريش، فقد كانت قريش
تخشى مكانة أبي طالب، وتراعي جانبه، وجانب بني هاشم بصورة عامة،
وإنما أرسله النبي
>صلى
الله عليه وآله<
مع المهاجرين ليكون أميراً عليهم، ومدبراً لأمورهم، ومشرفاً على شؤونهم
ومصالحهم، وحافظاً لهم من أن يذوبوا في هذا المجتمع الجديد، كما كان
الحال بالنسبة إلى ابن جحش الذي تنصر في الحبشة.
ويقولون:
إن عثمان بن عفان كان أول من هاجر إلى الحبشة بأهله، وأن النبي
>صلى
الله عليه وآله<
قد قال عنه بهذه المناسبة: إنه أول من هاجر بأهله بعد لوط
>عليه
السلام<([7]).
وقيل:
إنه كان أول خارج أيضاً([8]).
ونحن نشك في ذلك، لأنه إن أريد أنه أول من هاجر بأهله،
فإن أبا سلمة ـ كما يقولون ـ هو أول من هاجر بأهله([9]).
وإن أريد أنه أول خارج بنفسه، فإننا نجد أنهم يقولون:
إن أول خارج كان حاطب بن أبي عمر([10])،
أو سليط بن عمرو([11]).
كما أنهم يقولون:
مثل ذلك عن أبي سلمة فراجع، وستأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله تعالى.
روى الإمام أحمد بسند حسن، وغيره:
أن أبا موسى الأشعري كان في جملة من هاجر إلى الحبشة في الهجرة الأولى([12]).
ولكن الظاهر هو:
أن هذا وهم أو إدراج عمدي من الراوي، فإن أبا موسى لم يسلم إلا في
المدينة في السنة السابعة من الهجرة.
وقيل:
إنه خرج في
جماعة إلى النبي
>صلى
الله عليه وآله<
فألقتهم سفينتهم إلى الحبشة، فجاؤوا مع مهاجري الحبشة
إلى المدينة، في سنة سبع من الهجرة([13]).
ويظهر:
أن ذلك قد حدث بعد الهجرة إلى المدينة، إذ لم يكونوا ليقدموا على قصده
>صلى
الله عليه وآله<
إلى مكة، ولا ليقيموا هذه السنوات الطويلة في الحبشة.
والظاهر:
أنه التقى
بمهاجرة الحبشة في الطريق، فقد قال العسقلاني:
>صادفت
سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب، فقدموا جميعاً<([14]).
ويقولون:
إن عمر رأى المهاجرين، وهم يتهيأون للخروج إلى الحبشة،
فرقّ لهم، وأحزنه ذلك([15]).
وذلك لا يصح، لأن خروجهم كان سراً، متسللين، منهم
الراكب، ومنهم الماشي، حتى انتهوا إلى البحر فوجدوا سفينة فأقلتهم
فخرجت قريش في آثارهم حتى جاؤوا البحر، فلم يجدوا أحداً منهم([16]).
هذا كله، عدا عن شدة عمر وغلظته، التي تدعى له قبل وبعد
الهجرة إلى الحبشة على من أسلم، وتعذيبه لمن قدر عليه منهم، فإن ذلك لا
يتناسب مع ما يقال عنه هنا.
ويقولون:
إنه حين اشتد
البلاء على بقية من بمكة من المسلمين، وضاقت مكة على أبي بكر، وأصابه
فيها الأذى، خرج حين حصر المسلمون في الشعب مهاجراً إلى الحبشة، فلما
وصل إلى برك الغماد ـ موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن ـ لقيه
ابن الدغنة، سيد قبيلة
>القارة<،
وكانوا حلفاء لبني زهرة من قريش، فقال له:
أين تريد يا أبا بكر؟ فقال:
أخرجني قومي؛
فأريد أن أسيح في الأرض، وأعبد ربي، فقال ابن الدغنة: مثلك يا أبا بكر
لا يخرج؛ إنك تكسب المعدوم إلى أن قال: فارجع فأنا لك جار فرجع، ورجع
معه ابن الدغنة، فطاف عشية في أشراف قريش، وأعلمهم بأنه أجاره، فأجازوا
جواره بشرط: أن يعبد ربه في داره، ولا يستعلن.
ولكن أبا بكر ابتنى بعد مدة مسجداً في بني جمح، بجوار
داره يصلي فيه، ويقرأ القرآن، وجعل نساء المشركين وأبناؤهم يجتمعون
لسماع قراءته، حتى يسقط بعضهم على بعض.
وكان له صوت رقيق، ووجه عتيق أي جميل.
فراجع المشركون ابن الدغنة في ذلك، فأتاه فطالبه، فرد
عليه أبو بكر جواره([17]).
ونحن نشك في ذلك، إذ مع غض النظر عن:
1 ـ
أن إخراج قوم أبي بكر له لا يعني أنه قد هاجر مختاراً مع أن ظاهر
الكلام هو ذلك.
2 ـ
ومع غض النظر عن أن هذا الحديث مروي عن عائشة فقط ـ وهو عجيب!! ـ فهم
يدَّعون:
أنها كانت حينئذٍ صغيرة السن جداً لا يمكن أن تعي كل تلك الأمور
والخصوصيات، وإن كنا نعتقد: أن عمرها كان أكثر مما يقولونه بكثير، كما
سنشير إليه.
3 ـ
أضف إلى ذلك: أنها لم توضح لنا عمن روت ذلك.
ودعوى البعض:
أن
إرسال الصحابي لا يضر، لأنه يروي عن صحابي مثله؛ وهم عدول كلهم،
لا تصح، فأما بالنسبة لعدالتهم جميعاً، فقد أثبتنا عدم
صحة ذلك فراجع مقالنا: الصحابة في الكتاب والسنة، في كتابنا: دراسات
وبحوث في التاريخ والإسلام، الجزء الثاني.
وأما دعوى:
أن إرسال الصحابي إنما هو عن صحابي مثله، فهي أيضاً غير
صحيحة، لجواز أن يكون الصحابي قد روى عن غير صحابي، كما كان أبو هريرة
يروي عن كعب الأحبار([18]).
نعم، إننا مع غض النظر عن ذلك كله، نسجل هنا الأمور
التالية:
أولاً:
إن الرواية تنص على أن ابن الدغنة كان حليفاً لبني زهرة من قريش، فكيف
أجار على قريش مع أن الحليف لا يجير؟! كما اعتذر به الأخنس بن شريق،
حينما طلب منه النبي أن يجيره ليدخل مكة، حسبما يدَّعون([19]).
ثانياً:
لماذا بعد أن
رد جوار ابن الدغنة لم تؤذه قريش ولم تخرجه، وإذا كانت قبيلته قد منعته
الآن؛ فلماذا لم تمنعه أولاً؟!
وإذا كانت قد أقنعتهم تقريظات ابن الدغنة لأبي بكر،
فلماذا لم تقنعهم أولاً، حتى احتاج أبو بكر إلى جواره؟!.
ثالثاً:
لقد رد
الإسكافي على الجاحظ المدعي لهذه القضية بقوله:
>كيف
كانت بنو جمح تؤذي عثمان بن مظعون وتضربه، وهو عندهم ذو سطوة وقدر،
وتترك أبا بكر يبني مسجداً يفعل فيه ما ذكرتم؟
وأنتم الذين رويتم عن ابن مسعود:
أنه
قال: ما صلينا ظاهرين حتى أسلم عمر بن الخطاب،
والذي تذكرونه من بناء المسجد كان قبل إسلام عمر،
وأما ما ذكرتم من رقة صوته، وعتاق وجهه، فكيف يكون ذلك، وقد روى
الواقدي، وغيره: أن عائشة رأت رجلاً من العرب، خفيف العارضين، معروق
الخدين، غائر العينين أجنأ (يعني مائل الظهر)، لا يمسك إزاره، فقالت:
ما رأيت أشبه بأبي بكر من هذا،
فلا أراها دلت على شيء من الجمال في صفته([20]).
ويدل على صحة ما ذكره الإسكافي حول
جمال أبي بكر:
أن المقدسي، بعد أن ذكر: أنه لقب بعتيق لحسن وجهه وعتقه، يقول:
>كان
أبيض البشرة، مشرباً حمرة، نحيف الجسم، خفيف العارضين، معروق الوجه،
غائر العينين، ناتئ الجبهة، عاري الأشاجع، أحنى لا يستمسك إزاره،
ويسترخي عن حقويه، وكان
الخ..<
وكذا قال غيره([21]).
هذا كله عدا عن قولهم:
إنه لقب بـ
>عتيق<
لأن الرسول قال له:
>هذا
عتيق من النار<
فيومئذٍ سمي عتيقاً، وكان اسمه قبل ذلك: عبد الله بن عثمان([22])
وذلك ينافي قولهم: إنه عتيق لجمال وجهه.
رابعاً:
لقد نصت
الرواية على أن أبا بكر قد ابتنى مسجداً في بني جمح،
ولكننا نجدهم يقولون: إن مسجد قباء كان أول مسجد بني في الإسلام([23]).
ويقولون أيضاً:
إن عماراً كان أول من بنى مسجداً في الإسلام([24]).
وحاول البعض الإجابة عن هذا بأن
المقصود:
هو أن
مسجد قباء كان أول مسجد بني في المدينة،
وأن عماراً كان أول من بنى مسجداً لعموم المسلمين([25]).
وقد فاته:
أن إطلاق قوله: في الإسلام يدفع الأول، وإطلاق كون عمار
أول من بنى مسجداً يدفع الثاني، كما أن ثمة تصريحاً بأنه أول من بنى في
بيته مسجداً يتعبد فيه([26]).
وخامساً:
نحن بحاجة إلى
إجابات
على الأسئلة التالية: لماذا يترك أبو بكر يبني مسجداً في بني جمح؟.
وكيف لم يعترض الجمحيون على هذا التحدي؟.
ولماذا لم يدرك التيميون صفات أبي بكر النبيلة تلك،
ويدعونه يخرج، ثم يدركها ابن الدغنة؟!
ولماذا لم تلاحظ قريش تلك الصفات النبيلة التي أقرت بها،
وتركته يخرج؟! بل ولماذا عذبته أشد العذاب مع علمها بما ذكره ابن
الدغنة عنه؟!!.
والذي نظنه قوياً هو أنهم أرادوا:
أن يجعلوا له فضيلة سبق إليها عثمان بن مظعون؛ فإنه كما يذكره
المؤرخون: لما رجع من الحبشة مع من رجع، بعد شهرين من الهجرة، وفوجئ
بأن الأمر بين المشركين والنبي
>صلى الله
عليه وآله<
لا يزال على حاله، دخل مكة بجوار الوليد بن المغيرة.
ولكنه لما رأى ما فيه المسلمون من البلاء، وهو يغدو
ويروح في أمان،
صعب عليه ذلك، فمشى إلى الوليد فرد عليه جواره؛ فقال: يا بن أخي، لعله
آذاك أحد من قومي؟
قال:
لا، ولكني أرضى بجوار الله عز وجل، ولا أريد أن أستجير
بغيره.
قال:
فانطلق إلى
المسجد، فاردد علي جواري علانية، كما أجرتك علانية،
فانصرف معه، ورد عليه جواره علانية في المسجد([27]).
وبعد أن صحا مشركو مكة من عنف الصدمة،
>ورأت
قريش استقرارهم في الحبشة وأمنهم<،
على حد تعبير البعض([28])
ائتمرت فيما بينها، وقررت إرسال رجلين من قبلها إلى الحبشة لاسترداد
المهاجرين، ووقع اختيارهم على عمرو بن العاص، ويقال: وعلى عمارة بن
الوليد أيضاً، فأرسلوهما إلى النجاشي بهدايا له ولبطارقته،
>وجرى بين
عمارة وعمرو بن العاص في الطريق شيء مثير، يرتبط بالعلاقة بين عمارة
وزوجة عمرو فاحتملها له عمرو ليكيده في الوقت المناسب..<([29])
وادعيا أمام النجاشي: أنه
>قد
ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دينهم، ولم يدخلوا في دينك.
وجاؤوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت،
وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم، وأعمامهم، وعشائرهم لتردهم
إليهم
الخ..<.
فرفض تسليمهم إليهم حتى يسألهم عن صحة ما جاء به عمرو
وعمارة، فجاء المسلمون؛ فسألهم فقال جعفر:
>أيها
الملك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة ونأتي
الفواحش، ونقطع
الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا
على ذلك، حتى بعث الله إلينا رسولاً منا، نعرف نسبه وصدقه، وأمانته،
وعفافه؛ فدعانا إلى الله لنوحده، ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن
وآباؤنا من دونه، من الحجارة والأوثان.
وأمرنا بصدق الحديث وأداء الامانة، وصلة الرحم، وحسن
الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور،
وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وأمرنا: أن نعبد الله وحده، لا نشرك
به شيئاً، وأمرنا بالصلاة، والزكاة، والصيام
الخ..<([30]).
وقرأ عليه جعفر بعض سورة الكهف:
فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، وكذلك أساقفته.
ثم قال النجاشي:
إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة،
انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكما، ولا يكادون.
ثم غدا عمرو في اليوم التالي ليخبر النجاشي بأن
المسلمين يقولون: إن عيسى بن مريم عبد؛ فأرسل إليهم؛ فسألهم؛ فقال له
جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبينا
>صلى الله
عليه وآله<:
هو عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم
العذراء البتول، فتناول النجاشي عوداً، وقال: والله، ما عدا عيسى بن
مريم ما قلت هذا العود.
فتناخرت بطارقته، فقال:
وإن نخرتم،
إذهبوا فأنتم شيوم: أي آمنون، مَنْ سَبَّكم غَرِم ـ قالها ثلاثاً ـ ما
أحب أن لي دبراً ـ أي جبلاً ـ من ذهب وأني آذيت رجلاً منكم،
ثم رد هدايا قريش([31]).
وقد روي عن الإمام الحسين
>عليه
السلام<:
أن ابن العاص قد ذهب إلى الحبشة مرتين ليكيد المسلمين،
فرد الله تعالى كيده إلى نحره، وباء بغضب من الله تعالى([32]).
ملاحظة:
قد شكك البعض في صحة هذه الرواية، وذلك لذكر الصيام
فيها، وهو إنما شرع في المدينة([33]).
ولكنه كلام باطل؛ فإن الصيام، والزكاة، وغير ذلك كله قد
شرع في مكة، ولسوف يأتي إن شاء الله بيان ذلك في هذا الكتاب حين الحديث
على ما بعد الهجرة.
ويرى بعض الأعلام:
أن منشأ هذه
التحقيقات الرشيقة!!
لأحمد أمين، ومن هم على شاكلته، هو التشكيك في موقف يظهر بطولة جعفر،
وجراءته وحكمته، وعقله، ودرايته.
وقد ابتلي جعفر أيضاً بمثل هذا الإجحاف في حقه في مورد
آخر، وهو كونه الأمير الأول في غزوة مُؤته، فإن لهم اهتماماً خاصاً في
إبعاد جعفر عن هذا المقام والتأكيد على أن الأمير الأول هو زيد بن
حارثة
>رحمه
الله<
كل ذلك من أجل أخوته لعلي
>عليه
السلام<
وقرابته منه([34]).
حقاً
لقد كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة ضربة قاسية لقريش، أفقدتها صوابها،
وزعزعت وجودها وكيانها؛ فحاولت أن تتدارك الأمر، فلحقت بهم بهدف
إرجاعهم وإبقائهم تحت سلطتها، ولكن بعد فوات الأوان.
وكان أن اضطرت قريش للمرة الأولى لمراجعة حساباتها من
جديد، بعد أن أدركت: أن زمام المبادرة لم يعد بيدها؛ وذلك لأنها:
1 ـ
أدركت أن الاستمرار في تعذيب المسلمين، الذين أصبحوا متفرقين في مختلف
القبائل، لم يعد له كبير جدوى ولا جليل أثر، إن لم يكن سبباً في إثارة
حرب داخلية، تكون عواقبها السيئة على سمعتها وكرامتها كبيرة وخطيرة،
حينما لا توافق كل قبيلة على التصفية الجسدية للمنتمين إليها، للمنطق
القبلي الذي ما زالوا يتعاملون على أساسه، حتى في مواقفهم من هذا الدين
الجديد، ومناهضتهم لمحمد
>صلى
الله عليه وآله<،
ودعوته، رغم إجماعهم على العداء له ولها.
ويكفي أن نشير هنا إلى أنهم قد
قرروا:
أن تتولى كل قبيلة تعذيب الذين ينتسبون إليها!!.
2 ـ
لقد رأت قريش: أن محمداً
>صلى
الله عليه وآله<
يريد أن تكون دعوته إنسانية عالمية، لا تختص بعرب مكة والحجاز وأدركت
أن هجرة هؤلاء إلى الحبشة لم تكن متمحضة في الهروب من التعذيب، لأن
الكثيرين من أولئك المهاجرين لم يكن ممن يعذب.
هذا عدا عن أنهم يمثلون مختلف القبائل المكية أيضاً،
ويمثلون رصيداً يملكه الإسلام والمسلمون، ويدّخرونه
للوقت المناسب، وأصبح واضحاً لكل أحد: أن القضاء على مسلمي مكة لا يعني
القضاء على الإسلام.
3 ـ
وترى كذلك: أن معنى هجرة المسلمين هذه، وخروجهم من تحت سلطتها، هو أنها
سوف تكون أمام مواجهة شاملة، وأن مصالحها في معرض التهديد والبوار،
وقد رأت أن أبا ذر بإقامته بعسفان على طريق القوافل، وكلما أقبلت عير
لقريش احتجزها حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله
>صلى
الله عليه وآله<،
وظل على ذلك إلى ما بعد حرب أحد، قد ضايقها تلك المضايقة الشديدة مع
العلم بأن القضاء على حركته ربما يكون أسهل وأيسر، لأنه في منطقتها،
ويمكن تطويقه، والحد من نشاطه بسرعة؛ لأنه بين أمة كلها تدين لقريش
بالولاء، وتقول بمقالتها، كما أنهم ينظرون إليه على أنه غريب ومعتد.
إذن فإن وجود المسلمين، وهم من قريش في الصميم في منطقة
بعيدة عن نفوذ القرشيين وسلطانهم، وفي ملجأ أمين، ومنطلق مطمئن، ليشكل
أعظم الأخطار على قريش ومصالحها، الأمر الذي يحتم عليها التريث والصبر،
وإحكام التدبير، لا سيما وأنها لا تجد إلى تصفية النبي
>صلى
الله عليه وآله<
جسدياً حيلة، ولا إلى إسكاته سبيلاً، ما دام في حماية شيخ الأبطح، أبي
طالب >عليه
السلام<
والهاشميين، باستثناء أبي لهب لعنه الله، فأرسلت إلى النجاشي ممثلين
عنها لاسترداد المهاجرين، فرجعا إليها بالفشل الذريع والخيبة القاتلة،
فأفقدها ذلك صوابها وأصبحت تتصرف بدون وعي، ولا تدبر، فعدّت من جديد
على من تبقى من المسلمين بالعذاب والتنكيل.
وجعلت تتعرض للنبي
>صلى
الله عليه وآله<
بالسخرية، والاستهزاء، والاتهام بالجنون والسحر، والكهانة، وبأنواع
مختلفة من الحرب النفسية والأذى.
وكان وجود المسلمين في الحبشة، قد تسبب للنجاشي ببعض
المتاعب؛ حيث اتهمه أهل بلاده بأنه خرج من دينهم فثاروا عليه.
ولكنه استطاع أن يخمد الثورة بحسن إدراكه ووعيه، واستمر
المسلمون عنده في خير منزل، وخير جار، حتى رجعوا إلى المدينة، بعد هجرة
النبي
>صلى
الله عليه وآله<
إليها كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فيروي محمد بن إسحاق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال:
اجتمعت الحبشة، فقالوا للنجاشي: إنك فارقت ديننا، وخرجوا عليه، فأرسل
إلى جعفر وأصحابه، فهيأ
لهم سفناً، وقال: اركبوا فيها وكونوا كما أنتم؛ فإن هُزمت؛ فاذهبوا حتى
تلحقوا بحيث شئتم،
وإن
ظفرت فاثبتوا، ثم خرج إليهم فجادلهم في الأمر، فانصرفوا عنه([35])
وكان ذلك قبل إيفاد قريش عمرواً وعمارة، بدليل قول النجاشي لهما
>فوالله
ما أخذ الله مني الرشوة حين رد عليَّ
ملكي، ولا أطاع الناس فيَّ،
فأطيع الناس فيه، ردوا عليهم هداياهم؛ فلا حاجة لي بها، واخرجا من
بلادي، فخرجا مقبوحين<([36]).
وقد كانت هذه الفترة التي أعقبت هجرة المسلمين إلى
الحبشة قد تميزت بهدوء نسبي، ولعله استمر إلى عودة عمرو بن العاص من
الحبشة إلى مكة بالخيبة والخسران.
وتسربت أنباء الهدنة القصيرة والعفوية غير المعلنة التي
حصلت في مكة إلى مسامع المسلمين في الحبشة.
ورأى المسلمون ما جرى للنجاشي بسببهم، فارتأى فريق منهم
العودة إلى مكة، بعد شهرين، أو ثلاثة أشهر، وعاد منهم أكثر من ثلاثين
رجلاً، ودخل عثمان بن مظعون بجوار الوليد بن المغيرة، وكان ما كان من
رده جواره، ورضاه بجوار الله تعالى، حسبما تقدم.
نعم،
هذا هو السر في رجوع بعض المهاجرين من الحبشة، وليس ما ذكره أعداء
الإسلام من قصة الغرانيق التي لا شك في كذبها كما سنرى.
وملخص هذه القضية المكذوبة:
أنه بعد أن هاجر المسلمون إلى الحبشة بحوالى شهرين؛ جلس رسول الله
>صلى
الله عليه وآله<
مع المشركين، فأنزل الله تعالى عليه سورة النجم؛ فقرأها، حتى إذا بلغ
قوله تعالى:
{أَفَرَأَيْتُمُ
اللَّاتَ وَالْعُزَّى، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى}([37])،
وسوس إليه الشيطان بكلمتين، فتكلم بهما، ظاناً أنهما من جملة الوحي
وهما:
>تلك
الغرانيق([38])
العلى، وأن
شفاعتهن لترتجى<،
ثم مضى في السورة، حتى إذا بلغ السجدة، سجد وسجد معه المسلمون
والمشركون.
لكن الوليد بن المغيرة لم يتمكن من السجود، لشيخوخته،
أو لتكبره ـ على الخلاف ـ فرفع تراباً إلى جبهته فسجد عليه، وقيل: إن
الذي فعل ذلك هو سعيد بن العاص، وقيل كلاهما، وقيل: أمية بن خلف، وصحح،
وقيل: أبو لهب، وقيل: المطلب.
وأضاف البخاري سجود الإنس والجن، إلى مجموع المسلمين،
والمشركين وطار الخبر في مكة، وفرح المشركون، بل ويقال: إنهم حملوا
الرسول، وطاروا به في مكة من أسفلها إلى أعلاها.
ولما أمسى جاءه جبرائيل فعرض عليه السورة، وذكر
الكلمتين فيها؛ فأنكرهما جبرئيل؛ فقال
>صلى
الله عليه وآله<:
قلت على الله ما لم يقل؟ فأوحى الله إليه:
{وَإِن
كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلاً،
وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً
قَلِيلاً، إِذاً لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الحَيَاةِ وَضِعْفَ المَمَاتِ
ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً}([39]).
وقد استدلوا على صحة هذه الرواية
بالآية التي يدعون:
أنها نزلت بهذه المناسبة وهي قوله تعالى:
{وَمَا
أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلا إِذَا
تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللهُ مَا
يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ..}([40]).
وعدد من أسانيد هذه الروايات صحيح عند بعض الفرق([41]).
ويقولون:
إنه لما سمع
المسلمون في الحبشة بالسلام والوئام بين النبي
>صلى
الله عليه وآله<
وقريش عادت طائفة منهم إلى مكة، فوجدوا الأمر على خلاف
ذلك.
ونحن نعتقد جازمين بكذب هذه الروايات، وافتعالها،
ويشاركنا في هذا الاعتقاد جمع من العلماء، فقد قال محمد بن إسحاق حين
ما سئل عنها: >هذا
من وضع الزنادقة<،
وصنف في تفنيدها كتاباً([42]).
وقال القاضي عبد الجبار عن هذا
الخبر:
>لا
أصل له، ومثل ذلك لا يكون إلا من دسائس الملحدة<([43]).
وقال أبو حيان:
إنه نزه كتابه عن ذكر هذه القصة فيه([44]).
وأنكرها البيضاوي، طاعناً في أسانيدها، وكذا البيهقي،
والنووي والرازي، والنسفي، وابن العربي، والسيد المرتضى، وفي تفسير
الخازن: أهل العلم وهنوا هذه القصة([45]).
وقال عياض:
>إن
هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل،
وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب،
والمتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم<.
وصدق القاضي بكر بن العلاء المالكي،
حيث قال:
>لقد
بلي
الناس ببعض أهل الأهواء
والتفسير، وتعلق بذلك الملحدون، مع ضعف نقلته واضطراب رواياته، وانقطاع
أسناده واختلاف كلماته<([46]).
ونحن نؤيد ما قاله لعدة أسباب:
أولاً:
إن جميع روايات هذه القصة سوى طريق سعيد بن جبير، إما
ضعيف، أو منقطع([47])
وحديث سعيد مرسل، والمرسل عند جمهور المحدثين من قسم
الضعيف، لاحتمال أن يكون قد رواه عن غير الثقة([48]).
وأيضاً فإن الاحتجاج بالمرسل لو سلم؛ فإنما يكون في
الفرعيات وما نحن فيه يرتبط بالعقائد، التي تحتاج إلى القطع،
هذا والملاحظ لأسانيدها يراها تنتهي: إما إلى تابعي أو إلى صحابي لم
يولد إلا بعد هذه القضية.
بل إن هذه الرواية يجب ردها والقطع بكذبها، ولو كان
سندها متصلاً، لأنها مصادمة لحكم العقل كما سنرى وبهذا رد على
القسطلاني، والعسقلاني، وآخرين حيث قد حكموا بصحتها، وبأن لها أصلاً
لكثرة طرقها([49]).
ثانياً:
تناقض
رواياتها، وقد تقدم التناقض فيمن لم يسجد، ونزيد هنا: أن النبي
>صلى
الله عليه وآله<
قرأها وهو يصلي،
أو وهو جالس في نادي قومه.
حدَّث
نفسه بها..
أو جرت على لسانه،
الشيطان أخبرهم: أنه
>صلى
الله عليه وآله<
قالها،
أو قرأها المشركون،
تنبه >صلى
الله عليه وآله<
حين قراءتها،
أو
لم يتنبه إلى المساء.
بل ذكر الكلاعي:
أن الأمر لم ينكشف بهذه السرعة، بل فشا الأمر حتى بلغ
الحبشة: أن المسلمين قد أمنوا في مكة، فقدم مسلموها، ونزل نسخ ما ألقاه
الشيطان، فلما بين الله قضاءه اشتد المشركون على المسلمين([50])،
إلى غير ذلك من وجوه الاختلاف.
ويقولون:
لا حافظة لكذوب.
ثالثاً:
إن هذه
الرواية ليس فقط تنافي ما هو مقطوع به من عصمته
>صلى
الله عليه وآله<
عن الخطأ والسهو،
وعلى الأخص في أمر التبليغ، وهو ما قام عليه إجماع الأمة، والأدلة
القطعية،
وإنما هي تثبت الارتداد له
>صلى
الله عليه وآله<
نعوذ بالله من الغواية، عن طريق الحق والهداية.
رابعاً:
إن هذه
الرواية تنافي قوله تعالى:
{إِنَّ
عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ..}([51])
وقوله:
{إِنَّهُ
لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ}([52])
إلا أن يفرض هؤلاء ـ والعياذ بالله ـ أنه
>صلى
الله عليه وآله<
لم يكن من عباد الله، ولا من الذين آمنوا، ولا من المتوكلين،
وليس هذا القول إلا الكفر بعد الإيمان، كما هو ظاهر للعيان.
خامساً:
ينص الكلاعي
على أن المشركين والمسلمين قد سجدوا جميعاً لما بلغ النبي
>صلى
الله عليه وآله<
آخر السورة،
وأن المسلمين قد عجبوا لسجود المشركين؛ لأن المسلمين لم يكونوا قد
سمعوا الذي ألقى الشيطان على ألسنة المشركين مع أنه يصرح قبل ذلك
بأسطر: أن الشيطان قد ألقى تلك الكلمات على لسان النبي
>صلى
الله عليه وآله<
نفسه!!([53]).
فيرد سؤال:
إنه كيف سمع
المشركون ما ألقاه الشيطان على لسانه
>صلى
الله عليه وآله<،
ولم يسمعه المسلمون، وهم معهم، ولا بد أنهم كانوا أقرب إليه
>صلى
الله عليه وآله<
منهم؟!.
سادساً:
إن جميع
الآيات المذكورة لا يمكن
أن
تكون ناظرة إلى مناسبة هذه الروايات إطلاقاً؛ فأما:
1 ـ
آيات سورة النجم؛ فإنه تعالى قد قال عن أصنام المشركين: مناة، واللات،
والعزى:
{إِنْ
هِيَ إِلا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ
اللهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا
تَهْوَى الأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الهُدَى}([54]).
فكيف رضي المشركون بأن يذم آلهتهم بهذا النحو الحاد، ثم
فرحوا بقوله المزعوم ذاك وسجدوا معه؟!
وكيف لم يدركوا أو كيف فسروا هذا التناقض الظاهر في
كلامه، حتى حملوه ـ كما زعم ـ وطاروا به في مكة من أسفلها إلى أعلاها
وهم يقولون: نبي بني عبد مناف؟!.
والنبي
>صلى
الله عليه وآله<
نفسه، لماذا لم يلتفت إلى هذا التناقض الظاهر، وبقي غافلاً عنه إلى
الليل، حتى جاء جبرئيل فنبهه إليه؟!
فهل كان
>صلى
الله عليه وآله<
في غيبوبة طيلة تلك الفترة؟!
أم أنه كان سقيم الذهن ـ والعياذ بالله ـ إلى هذا
الحد؟!
كما أن علينا أن نتساءل عن سبب مجيء جبرئيل إلى رسول
الله
>صلى
الله عليه وآله<
في المساء؟ ولماذا عرض عليه النبي
>صلى
الله عليه وآله<
السورة؟
ثم، أليست هذه الرواية تناقض تماماً قوله تعالى في سورة
النجم نفسها، وبالذات في أول السورة بعد القسم:
{وَمَا
يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى}؟!([55])
فها هو في نفس السورة ينطق عن الهوى، بل هو يردد ما يلقيه إليه الشيطان
على أنه آيات قرآنية إلهية.
مع أن الله تعالى يقول:
{وَلَوْ
تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ، لأَخَذْنَا مِنْهُ
بِالْيَمِينِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ}([56])
فها هو يتقول عليه ولا يفعل به شيئاً([57]).
وإذا كانت هذه الآية قد نزلت بعد سورة النجم، فإن ذلك
لا يضر ما دامت الآية تعطي قاعدة كلية، ولا تشير إلى قضية خارجية خاصة.
2 ـ
وأما آية التمني، فهي في سورة الحج، التي هي مدنية بالاتفاق، ولا سيما
وأنه قد ورد فيها الأمر بالأذان في الناس بالحج والأمر بالقتال، والأمر
بالجهاد، وذكر فيها الصد عن المسجد الحرام، وكل ذلك إنما كان بعد
الهجرة، وبعضه بعدها بعدة سنوات.
هذا بالإضافة إلى أن الضحاك، وابن عباس، وقتادة، وابن
الزبير وغيرهم، قد ذكروا أنها مدنية.
وإذا كانت مدنية، فهذا يعني:
أن هذه الآية قد نزلت بعد قصة الغرانيق بسنوات عديدة، لأن قصة الغرانيق
قد حصلت!! في السنة الخامسة من البعثة، فكيف أخر الله تسلية وتهدئة
خاطر الرسول هذه السنين الطويلة؟!. على أن معنى الآية لا ينسجم مع مفاد
الرواية، فإن التمني هو تشهي حصول أمر محبوب ومرغوب فيه، فالرسول إنما
يتشهى ويتمنى ما يتناسب مع وظيفته كرسول، وأعظم أمنية لإنسان كهذا هي
ظهور الحق والهدى، وطمس الباطل وكلمة الهوى فيلقي الشيطان بغوايته
للناس ما يشوش هذه الأمنية، ويكون فتنة للذين في قلوبهم مرض، كما ألقى
فيما بين أمة موسى من الغواية ما
ألقى،
فينسخ الله بنور الهدى غواية الشيطان، ويظهر الحق للعقول السليمة.
وأما لو أردنا تطبيق الآية على ما يقولون،
فإن المراد بالتمني يكون هو القراءة والتلاوة وهو معنى شاذ غريب، يخالف
الوضع اللغوي وظاهر اللفظ، ولا نشك في أنه تفسير موضوع ومفتعل ليوافق
الرواية المزعومة.
أما الشعر المنقول عن حسان بن ثابت، كشاهد على ذلك([58]).
فنعتقد:
أنه مصنوع
ومنسوب إليه للغرض نفسه، وما أكثر ما نجده من ذلك في كتب التاريخ،
وحتى لو قبلنا أن المراد بالتمني هو التلاوة، فإن من الممكن أن يكون
معناه ما قاله المرتضى
>رحمه
الله<،
وهو: أنه إذا تلا النبي على قومه الآيات حرفوها، وزادوا ونقصوا فيها،
كما فعلت اليهود بالكذب على نبيهم فإضافة ذلك إلى الشيطان إنما هو لأنه
هو الموسوس لهم بذلك ثم يدحض الله ذلك ويزيله بظهور حجته([59]).
3 ـ
وأما بالنسبة لآيات سورة الإسراء التي يقولون: إنها نزلت في هذه
المناسبة، وهي قوله تعالى:
{وَإِن
كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ..}([60])
فإنها تناقض وتنافي هذه القضية فكيف تكون قد نزلت من أجلها؟!
وذلك لأن هذه الآيات تقول:
إنه >صلى
الله عليه وآله<
لم يركن إليهم، بل لم يقرب إلى الركون إليهم، وأن الله قد ثبته، وأنه
لو ركن لعوقب، وقضية الغرانيق تقول: إنه قد زاد على الركون، فاستجاب،
وافترى، وأدخل في القرآن ما ليس منه.
ومعنى الآية:
أن المشركين قد أصروا على أن يتركهم وشأنهم، وتفاوضوا معه، ومع أبي
طالب كثيراً، فلربما يكون النبي
>صلى
الله عليه وآله<
قد فكر في أن يمهلهم قليلاً، لعلهم يفكرون ويرجعون؛ فجاءت الآية لتقول
له: إن الصلاح في عدم الإمهال، بل في الشدة، هذا كله.
عدا عن أنهم يقولون:
إن آيات سورة الإسراء قد نزلت في ثقيف، حينما اشترطوا لإسلامهم شروطاً
تزيد في شرفهم، وقيل: نزلت في قريش حينما منعته من استلام الحجر، وقيل:
نزلت في يهود المدينة، عندما طلبوا منه أن يلحق بالشام([61])،
وقد اقتصر القاضي البيضاوي على هذه الوجوه..
سابعاً:
وأخيراً كيف
سجد المشركون عند نهاية السورة لقوله تعالى:
{فَاسْجُدُوا
لله وَاعْبُدُوا}
مع أنهم يرفضون السجود لله؟
قال تعالى:
{وَإِذَا
قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ
أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً}([62]).
ثم كيف لا يرتد أحد من المسلمين، أو يتزلزل إيمانه
حينما يعلم أن رسول الله
>صلى
الله عليه وآله<
قد مدح الأصنام، وجعل لها شفاعة؟!([63]).
وأخيراً..
فلا ندري كيف يمكن فهم وتعقل ما ذكرته بعض الروايات من أنه إنما حدث
>صلى
الله عليه وآله<
نفسه بتلك الفقرات؟
فكيف علم قومه بذلك حتى فعلوا ما فعلوا، ثم بلغ الخبر
إلى المسلمين في الحبشة، فجاؤوا.
وكذا قولهم:
إن المشركين
قد حملوا رسول الله
>صلى
الله عليه وآله<
وطاروا به في مكة من أسفلها إلى أعلاها، فكيف لم يتساءل النبي
>صلى
الله عليه وآله<
عن سر هذا التبدل العظيم في موقف قومه؟!
وقولهم:
إن هذه القضية قد كانت بعد شهرين من الهجرة إلى الحبشة،
نقول فيه، إنهم يقولون: إن عودة مهاجري الحبشة قد كانت بعد شهرين
أيضاً.
فهل وصل إليهم الخبر بالتلكس، أو بالتلفون؟! وهل جاؤا
بالطائرة، أم بسفن ارتياد الفضاء؟!
إلا أن يكون المراد:
أنهم
بدأوا بالتوجه نحو مكة بعد شهرين من هجرتهم، وإن كان هذا بعيداً
عن ظاهر اللفظ.
وكذا قولهم:
إنه لما عرض
>صلى
الله عليه وآله<
السورة على جبرائيل، وقرأ الفقرتين، أنكرهما جبرائيل فقال
>صلى
الله عليه وآله<:
قلت على الله ما لم يقل؟ فأنزل الله،
{وَإِن
كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ}.
نقول فيه:
إن الخطاب في
الآية للنبي >صلى
الله عليه وآله<:
أن الناس كادوا يفتنونه، مع أن الرواية تنص على أن الشيطان هو الذي كاد
أن يفتنه،
إلى غير ذلك من موارد الضعف والوهن والتناقض التي يمكن تلمسها في هذا
المجال.
والظاهر هو أن حقيقة ما جرى هو ما
قيل من:
أن
الكفار كانوا يكثرون اللغو واللغط حين قراءته
>صلى
الله عليه وآله<
حتى لا يسمع أحد ما يقرأ قال تعالى:
{وَقَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ
لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ}([64])
فحينما قرأ
النبي >صلى الله
عليه وآله<
سورة النجم، وانتهى إلى هذا المورد، قال المشركون تلك الغرانيق العلى
الخ..([65]).
نعم، ثم جاء القصاصون والحاقدون، ولعل منهم مسلمة أهل
الكتاب، الذين أدخلوا الكثير من إسرائيلياتهم في الإسلام ـ جاؤوا ـ
ونسجوا حولها ما يتلاءم مع مصالحهم وأهدافهم الشريرة، من الطعن بعصمته
>صلى
الله عليه وآله<،
ثم التشكيك بكل ما في القرآن، بحيث يتهيأ الجو لتطرق احتمالات من هذا
النوع في كل سورة وآية، ثم التدليل على مدى جهل النبي
>صلى
الله عليه وآله<
وعدم إدراكه حتى المتناقضات الواضحة.
ثم خضوعه لسلطان الشيطان، وعدم قدرته على تمييز ما هو
منه عما هو من غيره.
ولكننا نجدهم يقولون في مقابل ذلك،
كما تقدم:
إن الشيطان يفر من حس عمر([66])
أو لم يلق
الشيطان عمر منذ أسلم
إلا
خرَّ
لوجهه([67])،
أو ما سلك عمر فجاً إلا سلك الشيطان فجاً آخر([68])
ولعلهم أرادوا أن يقولوا: إن للنبي شيطاناً يعتريه كما
كان لأبي بكر..
وقد تقدم الحديث عن كل ذلك في بحوث سابقة.
ثم جاء المستشرقون الحاقدون، أعداء الإسلام، فحاولوا
الاستفادة من هذه الأباطيل والأساطير للطعن في نبينا الأعظم
>صلى
الله عليه وآله<([69])،
فأحبط الله سعيهم، ورد كيدهم
إلى
نحورهم.
فإن الحق كالصبح أبلج، وسيرة نبينا في النبل والصفاء
والطهر من كل عيب وشين كذكاء في كبد السماء تتوهج.
([1])
السيرة الحلبية: ج2 ص5
وص16، والسيرة النبوية لابن كثير: ج2 ص168.
([2])
السيرة النبوية لابن كثير ج2 ص17، والبداية والنهاية ج3 ص72
وتاريخ الخميس ج1 ص290 عن الصفوة والمنتقى.
([3])
سيرة ابن هشام ج1 ص345، والسيرة النبوية لابن كثيرج2 ص5،
والبداية والنهاية ج3 ص67، والسيرة الحلبية ج1 ص324، قال: وبه
جزم ابن المحدث في سيرته، وتاريخ الخميس ج1 ص288.
([4])
مستدرك الحاكم: ج2 ص622.
([5])
البداية والنهاية ج3 ص83، والبحار ج18 ص418، وإعلام الورى ص46
ـ 45 عن قصص الأنبياء.
([6])
البداية والنهاية ج3 ص70 عن أبي نعيم في الدلائل، والسيرة
النبوية لابن كثير ج2 ص11.
([7])
البداية والنهاية ج3 ص66 عن ابن إسحاق، والسيرة الحلبية ج1
ص323،
وتاريخ الخميس ج1 ص289 و275.
([8])
سيرة ابن هشام ج1 ص344 والبداية والنهاية ج3 ص66 عن البيهقي،
والسيرة الحلبية ج1 ص223.
([9])
الإصابة ج2 ص335، وراجع ج4 ص458 و459 والإستيعاب (بهامش
الإصابة) ج2 ص338 عن: مصعب الزبيري، وتهذيب الأسماء واللغات ج2
ص362، وأسد الغابة ج3 ص196 عن أبي عمر، وابن مندة، والسيرة
الحلبية ج1 ص323، وذخائر العقبى: ص253.
([10])
الإصابة ج1 ص301، والسيرة الحلبية ج1 ص323.
([11])
السيرة الحلبية ج1 ص323.
([12])
راجع: سيرة ابن هشام ج1 ص347، والبداية والنهاية ج3 ص67 و69
و70 عن ابن إسحاق وأحمد وعن أبي نعيم في الدلائل والسيرة
النبوية لابن كثير ج2 ص7 و9، وفتح الباري، ج7 ص143 ومجمع
الزوائد ج6 ص24 عن الطبراني وحلية الأولياء ج1 ص114.
([13])
راجع: السيرة النبوية لابن كثير ج2 ص14 والبداية والنهاية ج3
ص71.
([15])
البداية والنهاية ج3 ص79
عن ابن إسحاق، ومجمع الزوائد ج6 ص24، ومستدرك الحاكم ج4 ص58
والطبراني، والسيرة الحلبية ج1 ص323 و324.
([16])
السيرة الحلبية ج1 ص324، وتاريخ الخميس ج1 ص288 و289 عن
المنتقى والطبري ج2 ص69 وراجع البدء والتاريخ ج4 ص149، وإعلام
الورى ص43 واليعقوبي ج2 ص29 وزاد المعاد لابن القيم ج2 ص44.
([17])
راجع: السيرة النبوية لدحلان ج1 ص127 و128، وسيرة ابن هشام ج2
ص12 و13، وشرح النهج ج13 ص267، والمصنف ج5 ص386 و385 والبداية
والنهاية ج3 ص94 و95، وفي تاريخ الخميس ج1 ص319 و320 أن ذلك
كان في الثالثة عشرة من البعثة، وحياة الصحابة ج1 ص276 و277 عن
صحيح البخاري ص552.
([18])
راجع: شيخ المضيرة للشيخ محمود أبي رية، وأبو هريـرة للسيد شرف
الدين رحمهما الله تعالى، وراجع ترجمة كعب الأحبار في سير
أعلام النبلاء ج3 ص490 وغيره.
([19])
إعلام الورى ص55 والبحار ج19 ص7 عن القمي، وسيرة ابن هشام ج2
ص20، والبداية والنهاية ج3 ص137، والسيرة الحلبية ج1 ص360،
والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص142، وبهجة المحافل ج1 ص126.
([20])
شرح النهج للمعتزلي ج13 ص268 عن الإسكافي.
([21])
البدء والتاريخ ج5 ص76 و77، وتاريخ الخميس ج2 ص199، وتاريخ
الطبري ج2 ص615.
([22])
كشف الأستار عن مسند
البزار: ج3 ص163، ومجمع الزوائد: ج9 ص40.
([23])
وفاء الوفاء ج1 ص250 والسيرة الحلبية ج2 ص55.
([24])
السيرة الحلبية ج2 ص55، وطبقات ابن سعد ج3 ص179 و178 والأعلاق
النفيسة ص196 وتاريخ ابن كثير ج7 ص311، والغدير ج9 ص20 عنهما.
والأوائل للطبراني ص109 والروض الأنف ج3 ص248 والسيرة النبوية
لابن هشام ج2 ص143.
([25])
السيرة الحلبية ج2 ص55 ووفاء الوفاء ج1 ص250.
([26])
طبقات ابن سعد ط ليدن ج3 ص178 وذكره في البداية والنهاية ج7
ص311، وراجع: السيرة الحلبية ج2 ص55 فإنه صرح بأن هذا المسجد
كان خاصاً بالذي بناه.
([27])
البداية والنهاية ج3 ص92، وقد ذكرت هذه القضية في مختلف
المصادر التاريخية فلا حاجة إلى تعدادها.
([29])
ذكرنا ذلك في كتابنا ظلامة أبي طالب، الفصل الأول فراجع.
([30])
ذكرت الزكاة والصيام في مختلف المصادر؛ فراجع سيرة ابن هشام ج1
ص360، والسيرة النبوية لابن كثير ج2 ص21، والكامل لابن الأثير
ج2 ص80 (ولم يذكر الزكاة) وإعلام الورى ص44 ولم يذكر الصيام
والبداية والنهاية ج3 ص74 وتاريخ الخميس ج1 ص290، وحلية
الأولياء ج1 ص114، والسيرة الحلبية ج1 ص340. وستأتي بقية
المصادر حين الكلام عن أن تشريع الصلاة والزكاة كان في مكة،
وذلك قبيل الكلام عن غزوة بدر إن شاء الله تعالى.
([31])
راجع المصادر المتقدمة.
([32])
راجع: الاحتجاج ج1 ص411 و412، والسيرة النبرية لابن كثير ج2
ص27، والبداية والنهاية ج3 ص76.
([33])
هذا ما ذكره أحمد أمين في كتاب فجر الإسلام ص76 ولعله اقتبسه
من السيرة الحلبية ج1 ص339.
([34])
راجع كتابنا: دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام، الجزء الأول،
بحث: من هوالأمير الأول في غزوة مؤته.
([35])
تاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص136 السيرة النبوية لابن هشام ج1
ص365، والبداية والنهاية ج3 ص77، والسيرة الحلبية ج2 ص202 و(ط
دار المعرفة) ص465 والسيرة النبوية لابن كثير ج2 ص28 وسبل
الهدى والرشاد ج2 ص392.
([36])
البداية والنهاية ج3 ص75
عن ابن إسحاق، وسيرة ابن هشام ج1 ص362.
([37])
الآيتين 19 و20 من سورة النجم.
([38])
الغرانيق، جمع غرنوق بكسر الغين: طيور الماء. شبهت الأصنام بها
لارتفاعها في السماء فتكون الأصنام مثلها في رفعة القدر،
والغرنوق أيضاً: الشاب الأبيض الناعم.
([39])
الآيات 73 و74 و75 من سورة الإسراء.
([40])
الآيتان 52 و53 من سورة الحج.
([41])
راجع: الدر المنثور ج4 ص194 و366 ـ 368 والسيرة الحلبية ج1
ص325 ـ 326، وتفسير الطبري ج17 ص131 ـ 134، وفتح الباري ج8
ص333. وأشار إلى أصلها البخاري أيضاً في غير موضع من صحيحه،
كما في البداية والنهاية ج3 ص90، وقد صرح السيوطي في دره
المنثور بصحة أسانيد عدد منها، وراجع: لباب النقول، وتفسير
الطبري، وهي موجودة في مختلف التفاسير، عند تفسير الآيات، ولذا
فلا حاجة إلى تعداد مصادرها.
([42])
راجع: البحر المحيط لأبي حيان ج6 ص381.
([43])
تنزيه القرآن عن المطاعن ص243.
([44])
عن تفسير البحر المحيط ج6 ص381.
([45])
السيرة الحلبية ج1 ص11، والهدى إلى دين المصطفى ج1 ص130،
والرحلة المدرسية ص38. وفتح الباري ج8 ص333، وتفسير الرازي ج23
ص50.
([46])
الشفاء ج2 ص126 ط العثمانية والمواهب اللدنية ج1 ص53.
([47])
فتح الباري ج8 ص333.
([48])
راجع: مقدمة ابن الصلاح ص26.
([49])
فتح الباري ج8 ص333، والسيرة الحلبية ج1 ص326 وراجع سيرة
مغلطاي ص24 المواهب اللدنية ج1 ص53.
([50])
راجع: الاكتفاء للكلاعي ج1 ص352 و353.
([51])
الآية 42 من سورة الحجر.
([52])
الآية 99 من سورة النحل.
([53])
راجع: الإكتفاء للكلاعي ج1 ص352 و353.
([54])
الآية 23 من سورة النجم.
([55])
الآيتان 3 و4 من سورة النجم.
([56])
الآيات 44 و45 و46 من سورة الحاقة .
([57])
هذا إن لم نقل إن الآية ناظرة إلى صورة تعمد الكذب على الله،
لأنه عبر بالتقول، الذي هوتعمد القول.
([58])
ففي تنزيه الأنبياء ص107: أن حسان بن ثابت قال:
تمنى
كتـاب الله أول ليلـه وآخره لاقى حمـام المقادر
على
أن من الممكن أن يكون المقصود بالتمني هنا حب ذلك والشوق إليه.
([59])
تنزيه الأنبياء ص107 وص108.
([60])
الآية 73 من سورة الإسراء.
([61])
راجع: السيرة الحلبية ج1 ص326، والدر المنثور، وتفسير الخازن،
وسائر كتب التفسير.
([62])
الآية 60 من سورة الفرقان.
([63])
راجع هامش: الاكتفاء للكلاعي ج1 ص353 و354.
([64])
الآية 26 من سورة فصلت.
([65])
السيرة النبوية لدحلان ج1 ص128 وتنزيه الأنبياء ص107 وليراجع
هامش الاكتفاء للكلاعي ج1 ص354 عن السهيلي، وقد نقل الكلبي في
كتاب الأصنام: أن قريشاً كانت تقول هذه الكلمات في مدحها
لأصنامها حول الكعبة ـ كما نقل.
([66])
الرياض النضرة ج2 ص301.
([67])
عمدة القارئ ج16 ص196 وراجع تاريخ عمر ص62.
([68])
صحيح مسلم ج7 ص115 وفي تاريخ عمر ص35 ما يقرب من ذلك وكذلك ص62
والغدير ج8 ص94 ومسند أحمد ج1 ص171 و182 و187 وصحيح البخاري ج2
ص44 و188 وعمدة القارئ ج16 ص196.
([69])
راجع: تاريخ الشعوب الإسلامية ص34 لبروكلمان وكتاب الإسلام ص35
و36 لألفريد هيوم.
|