|
حـتـى الــشــعـــــب
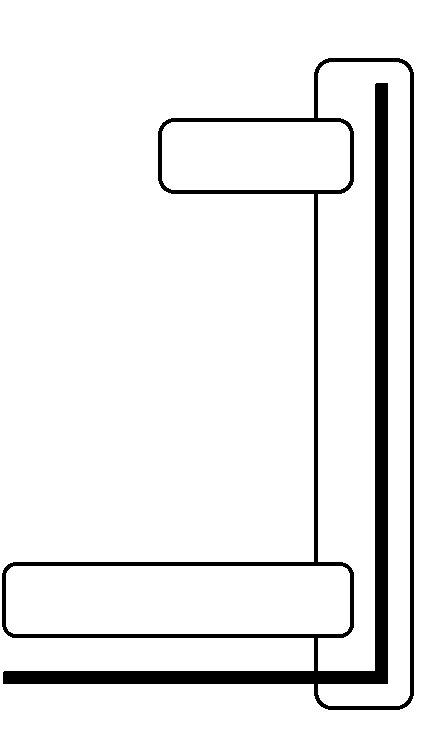
تناقضات في تاريخ
إسلام حمزة عليه السلام:
ويقولون:
إن إسلام حمزة
بن عبد المطلب >عليه
السلام<
كان في الثانية من البعثة.
ثم يقولون:
إنه أسلم بعد
دخوله >صلى
الله عليه وآله<
دار الأرقم. وهذا متناقض؛ لأنه إنما دخل دار الأرقم في أواخر السنة
الثالثة، كما يدَّعون.
وتناقض آخر:
إنهم
يذكرون أنه أسلم قبل عمر بثلاثة أيام، مع أنهم يذكرون أن عمر أسلم في
السنة السادسة بعد خروج النبي
>صلى
الله عليه وآله<
من دار الأرقم،
وهذا
متناقض؛ لأنه >صلى
الله عليه وآله<
إنما دخلها في أواخر السنة الثالثة من البعثة ولمدة شهر واحد فقط كما
يقال..
وسيأتي أن التحقيق هو:
أن إسلام عمر كان بعد إسلام حمزة بسنوات.
ونلاحظ:
أن ابن هشام
وغيره يذكرون إسلام حمزة
>رحمه
الله<
بعد الهجرة إلى الحبشة، أي في حوالي السنة السادسة للبعثة، ونحن نرجح
ذلك؛ لأنه حين أسلم ـ كما يقول المقدسي ـ عز به النبي
>صلى
الله عليه وآله<
وأهل الإسلام، فشق ذلك على المشركين، فعدلوا عن المنابذة إلى المعاتبة،
وأقبلوا يرغبونه في المال والأنعام، ويعرضون عليه الأزواج([1]).
وعروضهم هذه إنما كانت بعد الهجرة إلى الحبشة، كما يفهم
من سيرة ابن هشام.
كما أنه إنما أسلم بعد الإعلان بالدعوة، وبعد مفاوضات
قريش مع أبي طالب وعروضها عليه، وبعد أن عدلوا عن ذلك إلى العداوة
والأذى.
وعلى كل حال،
فقد كان إسلام حمزة تطوراً جديداً لم يكن قد دخل في حسابات قريش، حيث
قلب الموازين رأساً على عقب، وفتّ في عضد قريش، وزاد من مخاوفها، وكبح
من جماحها.
فقد مر أبو جهل بالرسول عند الصفا، فآذاه وشتمه، ونال
منه بعض ما يكره من العيب لدينه، والتضعيف لأمره، فلم يكلمه الرسول
>صلى
الله عليه وآله<.
وكان حمزة صاحب صيد وقنص، وكان إذا رجع بدأ بالبيت،
وطاف به، وسلم على من فيه، ورجع إلى بيته.
وفي هذه المرة كان حمزة راجعاً من صيده، فأخبرته إحدى
النساء بما كان من أبي جهل تجاه الرسول الأعظم
>صلى
الله عليه وآله<،
فاحتمل حمزة الغضب، ودخل المسجد، فرأى أبا جهل جالساً مع القوم، فأقبل
نحوه، حتى إذا قام على رأسه رفع القوس، فضربه بها ضربة شجه بها شجة
منكرة.
ثم قال:
أتشتمه وأنا على دينه، أقول ما يقول؟
فرد علَيّ
ذلك إن استطعت وكان ذلك بعد أن تضرع إليه أبو جهل، وأخذ بثوبه، فلم
يقبل منه.
فقام رجال من بني مخزوم لينصروا أبا جهل، فقالوا لحمزة:
ما نراك إلا قد صبأت؟
فقال حمزة:
وما يمنعني؟
وقد استبان لي منه أنه رسول الله، والذي يقول حق؟!
فوالله لا أنزع، فامنعوني إن كنتم صادقين.
فقال أبو جهل:
دعوا أبا عمارة، فإني والله لقد سببت ابن أخيه سباً
قبيحاً.
يقول المقدسي:
>فلما
أسلم حمزة عُزّ به الدين والنبي
>صلى
الله عليه وآله<([2])،
وسرّ رسول الله بإسلامه كثيراً.
وعلمت قريش:
أن رسول الله
>صلى
الله عليه وآله<
قد عز وامتنع، فكفوا عما كانوا ينالونه منه.
وقال حمزة للنبي
>صلى
الله عليه وآله<:
فأظهر يا
ابن
أخي دينك، فوالله ما أحب أن لي ما أظلته السماء، وأني على دين الأول([3]).
وكان حمزة أعز فتى في قريش، وأشدهم شكيمة([4]).
والظاهر، بل الصريح من كلام حمزة
>رحمه الله<،
ولا سيما قوله الأخير:
>وما
يمنعني، وقد استبان لي منه:
أنه رسول الله، والذي يقول حق<
أنه لم يكن في إسلامه منطلقاً من عاطفته التي أثيرت وحسب، وإنما سبقت
ذلك قناعة كاملة، كوّنها مما شاهده عن قرب من مواقف وسلوك، وسمعه من
أقوال النبي الأعظم
>صلى
الله عليه وآله<.
وقد يستفاد من قوله:
أتشتمه وأنا
على دينه؟!
أن إسلامه كان متقدماً على ذلك الوقت، ولكنه كان يتكتم به مراعاة
للظروف، وحفاظاً على الإسلام والمسلمين، الذين كانوا أضعف من أن
يتمكنوا من مواجهة قريش وجبروتها.
ولربما كان بعضهم بحاجة إلى المزيد من التربية النفسية
الخاصة، ليتمكن من مواجهة تلك الظروف القاسية مع المشركين.
ولا بد من التذكير هنا:
بأن أبا جهل، عظيم المشركين وجبارهم مع أنه كان بين
أهله وعشيرته، ومع أن عشيرته قد أعلنت عن استعدادها لنصرته، فإنه كان
أجبن وأذل من أن يقف في وجه أسد الله وأسد رسوله، وما ذلك إلا لأنه كان
من جهة:
يعلم فتوة حمزة وعزته، وشدة شكيمته وبطولته، ورأى مدى
تصميمه وإصراره، وعرف مقدار استعداده للتضحية والفداء في سبيل دينه،
وعقيدته.
ومن الجهة الأخرى:
فإن أبا جهل
إنما كان يحارب النبي
>صلى
الله عليه وآله<
ويناقضه، حباً بالحياة، ومن أجل الدنيا، فهو إذاً لا يريد الموت
إطلاقاً، بل هو يهرب منه، ويعده خسارة له، ما بعدها خسارة.
أما حمزة
>رحمه
الله<،
فكان يعتبر الموت في سبيل هذا الدين نصراً وفوزاً، تماماً بالمقدار
الذي يعتبره أبو جهل، ومن هم على شاكلته خسراناً وضياعاً فلماذا إذاً
يخشى الموت ويخافه؟
بل لماذا لا يكون الموت عنده أحلى من العسل، وألذ من
الشهد؟.
ومن جهة ثالثة:
فإن أبا جهل
لم يكن على استعداد لأن يحارب بني هاشم في تلك الفترة، التي كان له
فيها أنصار كثيرون فيهم، لأن حربه لهم لسوف تؤدي إلى أن يخسر هؤلاء
الذين يلتقي معهم فكرياً وعقيدياً، لأنهم بحكم المنطق القبلي الذي
يهيمن على مواقفهم وتصرفاتهم لن يتركوا ابن أخيهم، حتى ولو كان على غير
دينهم، وقد وعدوا أبا طالب باستثناء
أبي لهب أن يمنعوا محمداً ممن يريد به سوء كما تقدم.
بل إن تحرك أبي جهل في ظروف كهذه لربما يؤدي إلى ترسيخ
أمر محمد، وإلى دخول الكثيرين من بني هاشم في دينه، حمية وانتصاراً.
وهذا ما لا يريده أبو جهل، ولا يرغب فيه.
إذاً، فقد كانت جميع الظروف تدفعه إلى الاستسلام للذل
والهوان في مقابل أسد الله وأسد رسوله.
والخلاصة:
أن حب أبي جهل للحياة، وجبنه، ثم ما كان يراه من الصلاح
في عدم التصعيد في مناهضة محمد وبني هاشم،
قد جعله في موقف الذليل المهان،
وجعل الله كلمة الباطل هي السفلى، وكلمة الحق هي العليا.
والملاحظ هنا:
أنه بعد إسلام
حمزة بن عبد المطلب تتراجع قريش، وتليّن من موقفها، وتدخل في مفاوضات
معه >صلى
الله عليه وآله<،
وتعطيه بعض ما يريد، لأنها رأت أن المسلمين يزيد عددهم ويكثر، فكلمه
عتبة، فأبى >صلى
الله عليه وآله<
كل عروضهم([5]).
ويذكر المؤرخون بعد قضية الغرانيق، القضية التي نزلت
لأجلها سورة عبس وتولى، المكية، والتي نزلت بعد سورة النجم.
وملخص هذه القضية:
أن
النبي >صلى
الله عليه وآله<
كان يتكلم مع بعض زعماء قريش، ذوي الجاه والمال، فجاءه عبد الله بن أم
مكتوم ـ وكان أعمى ـ فجعل يستقرئ النبي
>صلى
الله عليه وآله<
آية من القرآن، قال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله.
فأعرض عنه رسول الله
>صلى
الله عليه وآله<
وعبس في وجهه، وتولى، وكره كلامه، وأقبل على أولئك الذين كان
>صلى
الله عليه وآله<
قد طمع في إسلامهم، فأنزل الله تعالى:
{عَبَسَ
وَتَوَلَّى، أَن جَاءهُ الأَعْمَى، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ
يَزَّكَّى، أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى، أَمَّا مَنِ
اسْتَغْنَى، فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى، وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكَّى،
وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى، وَهُوَ يَخْشَى، فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى}([6]).
وفي رواية:
أنه
>صلى
الله عليه وآله<
كره مجيء ابن أم مكتوم وقال في نفسه: يقول هذا القرشي: إنما أتباعه
العميان والسفلة، والعبيد، فعبس
>صلى
الله عليه وآله<
الخ..
>وكأن
ذلك الزعيم لم يكن يعلم بذلك!! وكأن قريشاً لم تكن قد صرحت بذلك
وأعلنته!!<.
وعن الحكم:
ما رؤي رسول
الله >صلى
الله عليه وآله<
بعد هذه الآية متصدياً لغني، ولا معرضاً عن فقير.
وعن ابن زيد:
لو أن رسول
الله >صلى
الله عليه وآله<
كتم شيئاً من الوحي، كتم هذا عن نفسه([7]).
فابن زيد يؤكد بكلامه هذا على مدى قبح هذا الأمر، وعلى
مدى صراحة الرسول
>صلى الله
عليه وآله<،
حتى إنه لم يكتم هذا الأمر، رغم شدة قبحه وشناعته!.
لقد أجمع المفسرون، وأهل الحديث، باستثناء شيعة أهل
البيت
>عليهم
السلام<
على أصل القضية المشار إليها.
ونحن نرى:
أنها قضية
مفتعلة، لا يمكن أن تصح،
وذلك.
أولاً:
لضعف أسانيدها، لأنها تنتهي: إما إلى عائشة، وأنس، وابن
عباس، من الصحابة، وهؤلاء لم يدرك أحد منهم هذه القضية أصلاً، لأنه إما
كان حينها طفلاً، أو لم يكن ولد([8])،
أو إلى أبي مالك([9])،
والحكم، وابن زيد، والضحاك، ومجاهد، وقتادة، وهؤلاء جميعاً من التابعين
فالرواية إليهم تكون مقطوعة، لا تقوم بها حجة.
ثانياً:
تناقض نصوصها([10])
حتى ما ورد منها عن راوٍ واحد، فعن عائشة،
الأمر الذي يشير إلى وجوب كذب وافتعال لكثير من نصوصها فلا يمكن
الاعتماد على الروايات إلا بعد تحديد ما هو صحيح منها.
في رواية:
إنه كان عنده رجل من عظماء المشركين، وفي أخرى عنها:
عتبة وشيبة.
وفي ثالثة عنها:
في مجلس فيه ناس من وجوه قريش، منهم أبو جهل، وعتبة بن
ربيعة.
وفي رواية عن ابن عباس:
إنه
>صلى
الله عليه وآله<
كان يناجي عتبة، وعمه العباس، وأبا جهل.
وفي التفسير المنسوب إلى ابن عباس:
إنهم العباس، وأمية بن خلف، وصفوان بن أمية.
وعن قتادة:
أمية بن خلف،
وفي أخرى عنه: أبي بن خلف.
وعن مجاهد:
صنديد من صناديد قريش، وفي أخرى عنه: عتبة بن ربيعة،
وأمية بن خلف.
هذا، عدا عن تناقض الروايات مع بعضها البعض في ذلك، وفي
نقل ما جرى، وفي نص كلام الرسول
>صلى
الله عليه وآله<،
ونص كلام ابن أم مكتوم.
ونحن نكتفي بهذا القدر، ومن أراد المزيد فعليه
بالمراجعة والمقارنة.
ثالثاً:
إن ظاهر الآيات المدعى نزولها في هذه المناسبة هو أنه
كان من عادة هذا الشخص وطبعه، وسجيته، وخلقه: أن يتصدى للغني، ويهتم به
ولو كان كافراً ويتلهى عن الفقير ولا يبالي به أن يتزكى، ولو كان
مسلماً.
وكلنا يعلم:
أن هذا لم يكن
من صفات وسجايا نبينا الأكرم
>صلى
الله عليه وآله<،
ولا من طبعه، وخلقه.
كما أن العبوس في وجه الفقير، والإعراض والتولي عنه، لم
يكن من صفاته
>صلى
الله عليه وآله<
حتى مع أعدائه، فكيف بالمؤمنين من أصحابه وأودائه([11])،
وهو الذي وصفه الله تعالى بأنه
{بِالْمُؤْمِنِينَ
رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ}([12]).
بل لقد كان من عادته
>صلى
الله عليه وآله<
مجالسة الفقراء، والاهتمام بهم، حتى ساء ذلك أهل الشرف والجاه، وشق
عليهم،
وطالبه الملأ من قريش بأن يبعد هؤلاء عنه ليتبعوه، وأشار عليه عمر
بطردهم، فنزل قوله تعالى:
{وَلاَ
تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ}([13]).
ويظهر:
أن الآية قد
نزلت قبل الهجرة إلى الحبشة لوجود ابن مسعود في الرواية،
أو حين بلوغهم أمر الهدنة، ورجوعهم إلى مكة.
ولكن يبقى إشكال أن ذكر عمر في هذا المقام في غير محله،
حيث
لم يكن قد أسلم حينئذٍ لأنه إنما أسلم قبل الهجرة إلى المدينة بيسير،
كما سنرى.
كما أن الله تعالى:
قد وصف نبيه في سورة القلم التي نزلت قبل
نزول
>عبس
وتولى<
بأنه على خلق عظيم، فإذا كان كذلك، فكيف يصدر عنه هذا الأمر المنافي
للأخلاق، والموجب للعتاب واللوم منه تعالى لنبيه
>صلى
الله عليه وآله<،
فهل كان الله ـ والعياذ بالله ـ جاهلاً بحقيقة أخلاق نبيه؟ أم أنه يعلم
بذلك، لكنه قال هذا لحكمة ولمصلحة اقتضت ذلك؟ نعوذ بالله من الغواية،
عن طريق الحق والهداية.
رابعاً:
إن الله تعالى
يقول في الآيات:
{وَمَا
عَلَيْكَ أَلا يَزَّكَّى}،
وهذا لا يناسب أن يخاطب به النبي
>صلى الله
عليه وآله<،
لأنه مبعوث لدعوة الناس وتزكيتهم.
وكيف لا يكون ذلك عليه، مع أنه هو مهمته الأولى
والأخيرة، ولا شيء غيره.
ألم يقل الله تعالى:
{هُوَ
الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ..}([14])
فكيف يغريه بترك الحرص على تزكية قومه([15]).
خامساً:
لقد نزلت آية
الإنذار:
{وَأَنذِرْ
عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}([16])
قبل سورة عبس
بسنتين فهل نسي >صلى
الله عليه وآله<:
أنه مأمور بخفض الجناح لمن اتبعه؟
وإذا كان نسي، فما الذي يؤمننا من أن لا يكون قد نسي
غير ذلك أيضاً، وإذا لم يكن قد نسي، فلماذا يتعمد أن يعصي هذا الأمر
الصريح؟!([17]).
سادساً:
إنه ليس في
الآية ما يدل على أنها خطاب للنبي
>صلى
الله عليه وآله<،
بل الله سبحانه يخبر عن رجل مَّا أنه:
{عَبَسَ
وَتَوَلَّى، أَن جَاءهُ الأَعْمَى}
ثم التفت الله تعالى بالخطاب إلى ذلك العابس نفسه، وخاطبه بقوله:
{وَمَا
يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى}
أي بحضوره مجلس النبي
>صلى
الله عليه وآله<
وسماعه لما يدور فيه الخ..
سابعاً:
لقد ذكر العلامة الطباطبائي: أن الملاك في التفضيل
وعدمه ليس هو الغنى والفقر، وإنما هو الأعمال الصالحة، والسجايا
الحسنة، والفضائل الرفيعة.
وهذا حكم عقلي وجاء به الدين الحنيف، فكيف جاز له
>صلى
الله عليه وآله<
أن يخالف ذلك، ويميز الكافر لما له من وجاهة على المؤمن؟([18]).
والقول:
بأنه إنما فعل ذلك لأنه يرجو إسلامه، وعلى أمل أن يتقوى به الدين، وهذا
أمر حسن، لأنه في طريق الدين، وفي سبيله،
لا يصح، لأنه يخالف صريح الآيات التي تنص على أن الذم للعابس
كان لأجل أنه يتصدى لذاك الغني لغناه، ويتلهى عن الفقير لفقره.
ولو صح هذا،
فقد كان
اللازم أن يفيض القرآن في مدحه وإطرائه على غيرته لدينه، وتحمسه
لرسالته؛ فلماذا هذا الذم والتقريع إذاً؟!
ونشير أخيراً:
إلى أن البعض
قد ذكر: أنه يمكن القول بأن الآية خطاب كلي مفادها: أن النبي
>صلى الله
عليه وآله<
كان إذا رأى فقيراً
تأذى
وأعرض عنه.
والجواب:
أولاً:
إن هذا يخالف القصة التي ذكروها من كونها قضية في واقعة
واحدة لم تتكرر..
ثانياً:
إذا كان المقصود هو الإعراض عن مطلق الفقير؛ فلماذا جاء التنصيص على
الأعمى؟!.
ثالثاً:
هل صحيح أنه قد كان من عادة النبي
>صلى الله
عليه وآله<
ذلك؟!!.
فيتضح مما تقدم:
أن المقصود بالآيات شخص آخر غير النبي
>صلى
الله عليه وآله<
ويؤيد ذلك:
ما روي عن الإمام جعفر الصادق
>عليه السلام<،
أنه قال:
كان رسول الله إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم قال: مرحباً، مرحباً،
والله لا يعاتبني الله فيك أبداً،
وكان يصنع به من اللطف، حتى يكف عن النبي
>صلى
الله عليه وآله<
مما كان يفعل به([19]).
فهذه الرواية تشير:
إلى أن الله تعالى لم يعاتب نبيه في شأن ابن أم مكتوم، بل فيها تعريض
بذلك الرجل الذي ارتكب في حق ابن أم مكتوم تلك المخالفة، إن لم نقل:
إنه يستفاد من الرواية نفي قاطع حتى لإمكان صدور مثل ذلك عنه
>صلى
الله عليه وآله<،
بحيث يستحق العتاب والتوبيخ؛ إذ لا معنى لهذا النفي لو كان الله تعالى
قد عاتبه فعلاً.
هذا ولكن الأيدي غير الأمينة قد حرفت هذه الكلمة؛ فادعت
أنه
>صلى
الله عليه وآله<
كان يقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي،
فلتراجع كتب التفسير، كالدر المنثور وغيره،
والصحيح هو ما تقدم.
ولعلك تقول:
إنه إذا كان
المقصود بالآيات شخصاً آخر؛ فما معنى قوله تعالى:
{فَأَنتَ
لَهُ تَصَدَّى}
وقوله: {فَأَنتَ
عَنْهُ تَلَهَّى}
فإن ظاهره: أن هذا التصدي والتلهي من قبل من يهمه هذا الدين؛ فيتصدى
لهذا، ويتلهى
عن ذاك؟!.
فالجواب:
أولاً:
إنه
ليس في الآيات ما يدل على أن التصدي كان لأجل الدعوة إلى الله أو
لغيرها.
فلعل التصدي كان لأهداف أخرى دنيوية، ككسب الصداقة، أو
الجاه، أو نحو ذلك.
ثانياً:
وقوله تعالى:
{لَعَلَّهُ
يَزَّكَّى}
ليس فيه أنه يزكى على يد المخاطب، بل هو أعم من ذلك، فيشمل التزكي على
يد غيره ممن هم في المجلس، كالنبي
>صلى
الله عليه وآله<
أو غيره.
ثم لنفرض:
أن التصدي كان
لأجل الدعوة، فإن ذلك ليس محصوراً به
>صلى
الله عليه وآله<
؛ فهم يقولون: إن غيره كان يتصدى لذلك أيضاً، وأسلم البعض على يديه، لو
صح ذلك!.
وبعدما تقدم نقول:
الظاهر هو أن
الصحيح
ما
جاء عن الإمام الصادق
>عليه
السلام<:
أنها نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي
>صلى
الله عليه وآله<
؛ فجاءه ابن أم مكتوم.
فلما جاءه تقذر منه، وعبس في وجهه، وجمع نفسه، وأعرض
بوجهه عنه، فحكى الله سبحانه ذلك عنه، وأنكره عليه([20]).
ويلاحظ:
أن الخطاب في
الآيات لم يوجه أولاً إلى ذلك الرجل؛ بل تكلم الله سبحانه عنه بصورة
الحكاية عن الغائب: إنه
{عَبَسَ
وَتَوَلَّى، أَن جَاءهُ الأَعْمَى}.
ثم التفت إليه بالخطاب، فقال له مباشرة:
{وَمَا
يُدْرِيكَ}.
ويمكن أن يكون الخطاب في الآيات أولاً للنبي
>صلى
الله عليه وآله<،
من باب: >إياك
أعني واسمعي يا جارة<.
والأول أقرب، وألطف ذوقاً.
ولعلك تقول:
إن
بعض الروايات تتهم عثمان بهذه القضية، وأنه هو الذي جرى له ذلك مع ابن
أم مكتوم([21]).
ولكننا نشك في هذا الأمر، لأن عثمان قد هاجر إلى الحبشة
مع من هاجر، فمن أين جاء عثمان إلى مكة، وجرى منه ما جرى؟!.
ونجيب بأن هناك نصوصاً
تاريخية صرحت بأن أكثر من ثلاثين رجلاً قد عادوا إلى مكة بعد شهرين من
هجرتهم كما تقدم، وكان عثمان منهم ثم عاد إلى الحبشة([22]).
وعلى كل حال،
فإن أمر اتهام عثمان([23])
أو غيره من بني أمية، لأهون بكثير من اتهام النبي المعصوم، الذي لا
يمكن أن يصدر منه أمر كهذا على الإطلاق.
وإن كان يهون على البعض اتهام النبي
>صلى
الله عليه وآله<
بها أو بغيرها، شريطة أن تبقى ساحة قدس غيره منزهة وبريئة!!.
تاريخ
هذه القضية:
ونسجل أخيراً:
تحفظاً على
ذكر المؤرخين لرواية ابن أم مكتوم ونزول سورة عبس، بعد قضية الغرانيق؛
فإن الظاهر هو أن هذه القضية قد حصلت قبل الهجرة إلى الحبشة لأن عثمان
كان قد هاجر إلى الحبشة قبل قضية الغرانيق بشهرين كما يقولون،
إلا أن يكون عثمان قد عاد إلى مكة مع من عاد بعد أن سمعوا بقضية
الغرانيق كما يدعون.
ومما تجدر الإشارة إليه هنا:
أن بعض
المسيحيين الحاقدين قد حاول أن يتخذ من قضية عبس وتولى وسيلة للطعن في
قدسية نبينا الأعظم
>صلى
الله عليه وآله<([24])،
ولكن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
فها نحن قد أثبتنا:
أنها أكاذيب وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان.
وبالمناسبة فقد رووا:
أن الأقرع بن
حابس، وعيينة بن حصن، جاءا إلى النبي
>صلى
الله عليه وآله<،
فوجداه قاعداً مع عمار، وصهيب، وبلال وخباب، وغيرهم من ضعفاء المؤمنين،
فحقروهم، فَخَلَوا بالنبي
>صلى
الله عليه وآله<،
فقالا: إن وفود العرب تأتيك؛ فنستحي أن يرانا العرب قعوداً
مع هذه الأعبد فإذا جئناك فأقمهم عنا، قال: نعم.
قالا:
فاكتب لنا
عليك كتاباً؛ فدعا بالصحيفة، ودعا علياً ليكتب، فنزل قوله تعالى:
{وَلاَ
تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ..}([25])
فرمى
>صلى
الله عليه وآله<
بالصحيفة، ودعاهم وجلس معهم، وصار دأبه هذا: أن يجلس معهم، فإذا أراد
أن يقوم قام وتركهم فأنزل الله تعالى:
{وَاصْبِرْ
نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ..}([26]).
فكان يجلس معهم إلى أن يقوموا عنه وفي بعض الروايات:
إنهم يقصدون أبا ذر وسلمان([27]).
ويردّ
هذه الأباطيل جميع ما تقدم حين الكلام عن قصة ابن أم مكتوم، ولذلك فلا
حاجة إلى الإعادة،
وأيضاً فقد استفاض: أن سورة الأنعام قد نزلت دفعة واحدة في مكة([28])،
فما معنى أن تكون هذه الآيات قد نزلت بهذه المناسبة في المدينة؟!.
والقول بأن نزولها كذلك لا ينافي كون هذه الآيات نزلت
بهذه المناسبة، مرفوض لأنها قد نزلت دفعة واحدة قبل الهجرة، بعد إسلام
الأنصار، لأنها نزلت وأسماء بنت يزيد الأنصارية آخذة بزمام ناقة النبي
>صلى
الله عليه وآله<([29])
والآية نزلت في المدينة على الفرض.
على أن قصة عبس وتولى وحدها كافية لأن يرتدع النبي
>صلى
الله عليه وآله<
عن أمر كهذا، ولا سيما إذا كانت تؤنب غيره
>صلى
الله عليه وآله<،
ممن هو ليس بمعصوم على فعل كهذا.
ثم إن سلمان إنما أسلم في المدينة، كما أن أبا ذر قد
فارق النبي
>صلى
الله عليه وآله<
فور إسلامه، وأقام بعسفان على طريق قوافل مكة، كما قدمنا.
والظاهر هو أنهم أصروا على النبي
>صلى
الله عليه وآله<
أن يبعد الفقراء عنه، حتى توسطوا لدى أبي طالب في ذلك، وأشار عليه عمر
بقبول ذلك كما جاء في بعض الروايات، فجاءت هذه الآيات في ضمن سورة
الأنعام بمثابة رد عليهم، وتفنيد لرأيهم.
وليس في الآيات ما يدل على قبوله
>صلى
الله عليه وآله<
بذلك، كما تدعيه الروايات المزعومة آنفاً.
ولم نتوسع في بيان وجوه الاختلاف بين الروايات، ونقاط
الضعف فيها، والرد على هذه المزاعم، اعتماداً على ما ذكرناه في قضية
ابن أم مكتوم المتقدمة.
بل إن ظاهر الآية الأولى:
أن طرد
الذين يدعون ربهم.. قد كان عقاباً لهم على أمر صدر منهم، وذلك بقرينة
قوله تعالى فيها:
{مَا
عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ}([30]).
فكأن الله سبحانه قد رفع التكليف عنه
>صلى الله
عليه وآله<
بمؤاخذتهم، رفقاً منه تعالى بهم، وعطفاً عليهم.
ويقولون:
إن عمر بن الخطاب قد أسلم في السنة السادسة من البعثة،
بعد إسلام حمزة بثلاثة أيام؛ حيث خرج متوشحاً سيفه، يريد رسول الله
ورهطاً من أصحابه، وهم قريب من أربعين رجلاً في دار الأرقم عند الصفا،
فيهم أبو بكر، وحمزة، وعلي، وغيرهم ممن لم يخرج إلى الحبشة، فالتقى عمر
بنعيم بن عبد الله، فسأله عن أمره، فأخبره: أنه يريد أن يقتل محمداً.
فذكر له نعيم:
أنه إن قتله لا ينجو من بني عبد مناف، وأن صهره وأخته قد أسلما، فرجع
عمر إليهما، وعندهما خباب بن الأرت يعلمهما سورة طه، فلما سمعوا حسه،
اختبأ خباب في مخدع، وخبأت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة تحت فخذها.
فدخل عمر، وبعد كلام بطش عمر بخَتْنِهِ،
وشج أخته، فأخبرته حينئذٍ أنهما قد أسلما؛ فليصنع ما بدا له. فندم عمر،
وارعوى لما رأى الدم بأخته، وطلب الصحيفة فلم تعطه إياها حتى حلف
بآلهته ليردنها إليها، فقالت له: إنك نجس على شركك، ولا تغتسل من الجنـابـة،
وهذا لا يمسه إلا المطهرون.
فقام عمر، فاغتسل (توضأ)، ثم قرأ من الصحيفة صدراً وكان
كاتباً، فاستحسنه، وظهر له خباب، وأخبره: أن النبي
>صلى
الله عليه وآله<
قد دعا له بأن يعز الإسلام به أو بأبي جهل،
فطلب منه عمر: أن يدله على الرسول ليسلم؛ ففعل، فذهب إليهم، وضرب
الباب، فنظر رجل منهم من خلال الباب؛ فرآه متوشحاً السيف، فرجع إلى
الرسول >صلى
الله عليه وآله<
فزعاً،
فأخبره.
فقال حمزة:
فأذن له، فإن كان جاء يريد خيراً بذلناه له، وإن كان
يريد شراً، قتلناه بسيفه.
فأذن له، ونهض إليه
>صلى
الله عليه وآله<
حتى لقيه في الحجرة، فأخذ بمجمع ردائه، ثم جبذه جبذة شديدة، وتهدده،
فأخبره عمر: أنه جاء ليسلم، فكبر
>صلى
الله عليه وآله<،
وكبر المسلمون تكبيرة سمعها من في المسجد.
ثم طلب عمر من الرسول:
أن يخرج ويعلن أمره، قال عمر: فأخرجناه في صفين: حمزة في أحدهما، وأنا
في الآخر، له كديد (أي غبار) ككديد الطحين، حتى دخلنا المسجد.
قال:
فنظرت إلي
قريش فأصابتهم كآبة لم تصبهم مثلها،
فسماه رسول الله
>صلى الله
عليه وآله<:
بـ
>الفاروق<
يومئذٍ.
وفي رواية:
أن قريشاً اجتمعت وتشاورت فيمن يقتل محمداً، فقال عمر:
أنا لها.
فقالوا:
أنت لها يا عمر، فخرج متقلداً السيف، فالتقى بسعد بن
أبي وقاص، وجرت بينهما مشادة، حتى سل كل منهما سيفه؛ فأخبره سعد بخبر
أخته إلخ..
وفي ثالثة:
أنهم خرجوا
وعمر أمامهم، ينادي: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فلما سألته قريش
عما وراءه تهددهم بأنه إن تحرك منهم أحد ليمكنن سيفه منه، ثم تقدم أمام
رسول الله، يطوف الرسول، ويحميه عمر، ثم صلى
النبي
>صلى
الله عليه وآله<
الظهر معلناً.
وفي رابعة:
أنه لما أسلم
ـ وكان المسلمون يُضربون ـ جاء إلى خاله أبي جهل ـ كما عند ابن هشام.
وقال ابن الجوزي:
هو غلط بل خاله العاص بن هاشم ـ فأعلمه بإسلامه، فأجاف
الباب، فذهب إلى آخر من كبراء قريش فكذلك.
فقال في نفسه:
ما هذا بشيء،
الناس يُضربون،
وأنا لا يضربني أحد؛ فاستدل على أنقل رجل للحديث، فدلوه، فأعلمه
بإسلامه؛ فنادى في قريش بذلك، فقاموا إليه يضربونه؛ فأجاره خاله،
فانكشف الناس عنه،
ولكنه عاد فرد عليه جواره؛ لأن الناس يُضربون ولا يُضرب،
قال: فلم يزل يُضرب، حتى أظهر الله الإسلام.
وفي خامسة:
أنه ذهب
ليطوف، فقال له أبو جهل: زعم فلان أنك صبأت؟ فتشهد الشهادتين، فوثب
عليه المشركون،
فوثب عمر على عُتْبَة
بن ربيعة، وبرك عليه، وجعل يضربه، وجعل إصبعيه في عينيه، فجعل عتبة
يصيح، فتنحى الناس عنه، فقام عمر، فجعل لا يدنو منه إلا أحد شريف، وجعل
حمزة يكشف الناس عنه.
وفي سادسة:
أنه كان صاحب
خمر في الجاهلية؛ فقصد ليلة المجلس المألوف له، فلم يجد فيه أحداً،
فطلب فلاناً الخمار، فكذلك، فذهب ليطوف فوجد محمداً يصلي، فأحب
الاستماع إليه، فدخل تحت ثياب الكعبة وسمع، فدخل الإسلام في قلبه فلما
انصرف الرسول >صلى الله
عليه وآله<
وذهب إلى داره التي يسكنها المعروفة بالرقطاء لحقه في الطريق، وأسلم،
ثم انصرف إلى بيته.
وفي العمدة:
قيل أسلم عمر
بعد ثلاثة وثلاثين رجلاً وست نسوة، وقال ابن المسيب بعد أربعين وعشر
نسوة، وقال عبد الله بن ثعلبة:
بعد خمس وأربعين وإحدى عشرة امرأة.
وقيل:
أسلم تمام
الأربعين؛ فنزل قوله تعالى:
{يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ}([31]).
ويقولون:
إنه
>صلى
الله عليه وآله<
كان قد دعا قبل إسلام عمر، فقال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب.
وفي نص آخر:
اللهم أيد (أو أعز) الإسلام بأبي الحكم بن هشام، أو بعمر بن الخطاب،
وكان
دعاؤه
>صلى
الله عليه وآله<
يوم الأربعاء، وإسلام عمر يوم الخميس.
وعن ابن عمر:
إنه
>صلى
الله عليه وآله<
قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل، أو بعمر بن
الخطاب، قال: وكان أحبهما إليه عمر.
وقالوا:
إن إسلام عمر
كان فتحاً، وإن
هجرته نصراً، وإن أمارته كانت رحمة،
وإنه لما أسلم قاتل حتى صلى المسلمون عند الكعبة([32])
إلى غيرذلك مما لا مجال له هنا.
وقد استغرب الترمذي هذه الأحاديث رغم تصحيحه لبعضها.
ونحن نشك في صحة كل ما تقدم، بل ونطمئن إلى بطلانه
جميعاً من الأساس، ولبيان ذلك نشير إلى النقاط التالية:
1 ـ
متى كان إسلام عمر؟!
تذكر تلك الروايات:
أن عمر قد
أسلم بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب
>عليه
السلام<
بثلاثة أيام. وكان إسلامه سبباً لخروجه
>صلى الله
عليه وآله<
من دار الأرقم، بعد أن تكامل المسلمون أربعين رجلاً، أو ما هو قريب من
ذلك.
ونحن نشير هنا إلى:
أ ـ
أن الخروج من
دار الأرقم ـ كما يقولون ـ إنما كان في الثالثة من البعثة، حينما أمر
النبي >صلى
الله عليه وآله<
بالإعلان بالدعوة،
وهم يصرحون بأن إسلام عمر كان في السادسة من البعثة.
ب ـ
إنهم
يقولون إن عمر قد أسلم بعد الهجرة إلى الحبشة، حتى لقد رق للمهاجرين،
لما رآهم يستعدون للرحيل، حتى رجوا إسلامه منذئذٍ،
والهجرة إلى الحبشة قد كانت في السنة الخامسة من البعثة، والخروج من
دار الأرقم قد كان قبل ذلك أي في السنة الثالثة.
ج ـ
أنه قد اشترك في تعذيب المسلمين، وإنما كان ذلك بعد
الخروج من دار الأرقم، والإعلان بالدعوة.
إننا نستطيع أن نقول باطمئنان:
إنه لم يسلم في السنة السادسة قطعاً بل أسلم بعد ذلك
بسنوات، ومستندنا في ذلك:
أولاً:
إنهم
يقولون: إنه قد أسلم بعد فرض صلاة الظهر، فصلى رسول الله
>صلى
الله عليه وآله<
الظهر معلناً تحت حماية عمر كما تقدم،
وصلاة الظهر قد فرضت ـ حسب قولهم ـ حين الإسراء والمعراج الذي كان ـ
عندهم ـ في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من البعثة،
فكلامهم متناقض.
وإن كنا نحن قد حققنا:
أن الإسراء والمعراج كان في حوالي السنة الثانية من
البعثة.
وقد أجاب البعض عن ذلك، بأن المقصود هو صلاة الغداة أي
الصبح([33]).
ولكنه توجيه لا يصح؛ فإن كلمة الظهر لا تنطبق على
الغداة ولا تطلق عليها وهو جواب عجيب وغريب كما ترى.
وإن كان مرادهم أن النبي
>صلى
الله عليه وآله<
كان يؤخر صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس فهو غير معقول؛ إذ كيف يؤخر
النبي >صلى
الله عليه وآله<
صلاته عن وقتها بلا عذر ظاهر؟.
ثانياً:
إن عبد الله بن عمر يصرح: أنه حين أسلم أبوه كان له هو
من العمر ست سنين([34]).
ويرى البعض:
أن عمره كان خمس سنين([35]).
ويدل على ذلك:
رواية أن ابن عمر كان حين إسلام أبيه على سطح البيت،
ورأى أن الناس قد هاجوا ضد أبيه، وحصروه في البيت؛ فجاء العاص بن وائل
ففرقهم عنه، وقد استفسر ابن عمر أباه حينئذٍ عن بعض الخصوصيات كما
سيأتي عن قريب.
كما أن ابن عمر يروي:
أنه حين أسلم أبوه غدا يتبع أثره، وينظر ما يفعل، يقول:
وأنا غلام أعقل ما رأيت([36])،
مما يدل على أن ابن عمر كان حين إسلام أبيه مميزاً مدركاً.
وذلك يدل على أن عمر أسلم حوالي السنة التاسعة من
البعثة ـ كما ذهب إليه البعض([37])
ـ لأن ابن عمر ولد في الثالثة من البعثة، وتم عمره على الخمس عشرة سنة
في عام الخندق سنة خمس من الهجرة، حيث أجازه
>صلى الله
عليه وآله<
فيها كما هو مشهور([38]).
بل ورد عن ابن شهاب:
أن حفصة وابن
عمر قد أسلما قبل عمر،
ولما أسلم أبوهما كان عبد الله ابن نحو من سبع سنين([39])
وذلك يعني
أن
إسلام عمر قد كان في العاشرة من البعثة.
بل نقول:
إن عمر بن الخطاب لم يسلم إلا قبل الهجرة بقليل، ويدل
على ذلك:
أولاً:
إنه بلغه،
أن أخته لا تأكل الميتة([40]).
وواضح:
أن تحريم الميتة إنما كان في سورة الأنعام، التي نزلت
في مكة جملة واحدة.
وكانت ـ كما تقول بعض الروايات ـ أسماء بنت يزيد
الأوسية آخذة بزمام ناقته
>صلى الله
عليه وآله<([41])
وإسلام الأوس وأهل المدينة إنما كان بعد الهجرة إلى
الطائف، ومجيء نسائهم إلى مكة قد كان بعد العقبة الأولى.
وما تقدم في فصل:
بحوث تسبق
السيرة،
من أن زيد بن عمرو بن نفيل كان لا يأكل الميتة.. لو صح؛ فإنما هو لأجل
أنه كان يدين بالنصرانية إلا أن يقال: إن تحريم الميتة قد كان على لسان
النبي >صلى
الله عليه وآله<
قبل نزول سورة الأنعام لكن ذلك يحتاج إلى دليل وشاهد
وهو غير موجود.
ثالثاً:
لقد استقرب البعض: أن يكون قد أسلم بعد أربعين، أو خمس
وأربعين ممن أسلم بعد الهجرة إلى الحبشة([42]).
ويؤيد ذلك:
أن الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا أكثر من ثمانين
رجلاً، والهجرة إليها إنما كانت في الخامسة، وإسلام عمر كان في السادسة
من البعثة حسب زعمهم ـ فلا بد أن يكون الأربعون الذين أتمهم عمر
بإسلامه غير هؤلاء الذين هاجروا، وإن كان ابن الجوزي يعد الذين أسلموا
قبل عمر، فيذكر أسماء من هاجر إلى الحبشة على الأكثر([43])
الأمر الذي يشير إلى أنه يرى:
أن الأربعين الذين أتمهم عمر هم هؤلاء، وليسوا فريقاً
آخر قد أسلم بعد هجرتهم.
ويؤيد ذلك أيضاً:
الروايات التي
تصرح بأنه أسلم في السادسة من البعثة، وأنه رق للمهاجرين إلى الحبشة،
حتى لقد رجوا إسلامه،
فإذا كان ذلك،
فلسوف يأتي في حديث المؤاخاة التي جرت في المدينة بعد الهجرة بين
المهاجرين والأنصار: أن المهاجرين كانوا حين المؤاخاة خمسة وأربعين
رجلاً أو أقل أو أكثر بقليل([44]).
أي أن الذين أسلموا بعد الهجرة إلى الحبشة كانوا خصوص
هؤلاء، فإذا كان عمر قد أسلم وكان تمام الأربعين فيهم فإن معنى ذلك هو
أنه قد أسلم قبل الهجرة بقليل،
ثم هاجر.
ولعله لأجل ذلك لم يتعرض للتعذيب في مكة، كما سنشير
إليه حين الكلام عن الذين عذبوا فيها.
رابعاً:
لقد جاء في
الروايات في إسلام عمر: أنه
>دنا
من رسول الله، وهو يصلي ويجهر بالقراءة، فسمع رسول الله
>صلى
الله عليه وآله<
يقرأ:
{وَمَا
كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ}
حتى
بلغ {الظَّالِمُونَ}<([45]).
وواضح:
أن هاتين الآيتين قد وردتا في سورة العنكبوت، وهي إما آخر ما نزل في
مكة، أو هي السورة قبل الأخيرة([46]).
فإسلام عمر قد كان قبل الهجرة بقليل، لأنه يكون أسلم
قبل نزول هاتين السورتين.
خامساً:
لقد روى البخاري في صحيحه، بسنده عن نافع قال: إن الناس
يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر..
ثم حاول نافع أن يوجه هذا بأن ابن عمر بايع تحت الشجرة
قبل أبيه، ثم قال: فهي التي يتحدث الناس: أن ابن عمر أسلم قبل عمر([47]).
ولكننا نقول لنافع:
ألم يكن الناس يعرفون اللغة العربية؟
فلم لم يقولوا:
إنه بايع قبل أبيه، وقالوا: أسلم قبل أبيه؟!.
ثم ألم يكن أحد منهم يعرف أن هذا الكلام لا يدل على ذاك
ولا يشير إليه، فكيف يصح أن يكون هو المقصود منه؟!.
ونحن نعتقد:
أن ما يقوله
الناس في ذلك الزمان هو الصحيح الظاهر، فإن
ابن عمر قد أسلم قبل الهجرة بيسير، ثم أسلم أبوه وهاجر([48]).
سادساً:
إن عمر قد رفض
في عام الحديبية: حمل رسالة النبي
>صلى
الله عليه وآله<
بحجة أن بني عدي لا ينصرونه؛ فمعنى ذلك هو أنه قد أسلم وهاجر ولم يعلم
أحد بإسلامه، وإلا لكان قد عذب،
ولم ينصره بنو عدي([49])،
لا سيما مع ما سيأتي من حالة الذل التي كان يعاني منها هذا الرجل قبل
إسلامه.
سابعاً:
إن عمر كما
يدَّعون قد أسلم حينما سمع النبي
>صلى
الله عليه وآله<
يقرأ في صلاته ويجهر في القراءة، وكان عمر مختبئاً تحت أستار الكعبة..
مع أنهم يقولون:
إن النبي
>صلى
الله عليه وآله<
والمسلمين لم يتمكنوا من الصلاة في الكعبة إلا بعد إسلام عمر! فأي ذلك
هو الصحيح؟.
2 ـ من
سمى عمر بالفاروق؟!
وقد ذكرت تلك الروايات:
أن النبي
>صلى
الله عليه وآله<
قد سمى عمر بالفاروق حين أسلم،
ولكننا نشك في ذلك جداً، إذ
إن
الزهري يقول:
>بلغنا:
أن
أهل الكتاب أول من قال لعمر:
>الفاروق<.
وكان المسلمون يأثرون ذلك من قولهم.
ولم يبلغنا:
أن رسول الله
>صلى
الله عليه وآله<
ذكر من ذلك شيئاً<([50]).
وقد كانت كلمة الفاروق تطلق عليه في أيام خلافته([51]).
3 ـ
هل كان عمر
قارئاً؟!
وتذكر الروايات:
أن عمر بن الخطاب كان قارئاً، وأنه قد قرأ الصحيفة
بنفسه.
ونحن نشك في ذلك أيضاً:
لاعتقـادنـا
أنه لم يكن يعرف القراءة والكتابة، ولا سيما في بادئ أمره، إلا أن يكون
قد تعلمها بعد ذلك في أواخر أيام حياته؛ وذلك لأمرين:
أحدهما:
أن البعض يصرح بأن خباب بن الأرت هو الذي قرأ له
الصحيفة([52])
فلو كان قارئاً؛ فلماذا لا يقرؤها بنفسه، ليتأكد من صحة الأمر؟!
الثاني:
لقد روى
الحافظ عبد الرزاق، بسند صحيح حسبما
يقولون هذه الرواية نفسها، ولكنه قال فيها:
>فالتمس
الكتف في البيت حتى وجدها، فقال حين وجدها:
أما إني قد حُدّثْتُ:
أنك لا تأكلين
طعامي الذي آكل منه، ثم ضربها بالكتف فشجها شجتين، ثم خرج بالكتف حتى
دعا قارئاً؛ فقرأ عليه، وكان عمر لا يكتب، فلما قُرِئَتْ عليه تحرك
قلبه حين سمع القرآن الخ..<([53]).
ويؤيد ذلك ما عن عياض بن أبي موسى:
أن عمر بن
الخطاب قال لأبي موسى:
ادع
لي كاتبك ليقرأ لنا صحفاً جاءت من الشام.
فقال أبو موسى:
إنه لا يدخل المسجد.
قال عمر:
أبه جنابة؟
قال:
لا، ولكنه نصـراني؛
فرفع عمر يده فضرب فخذه حتى كاد يكسرها
الخ..([54]).
فلو كان عمر يعرف القراءة لم يحتج لكاتب أبي موسى ليقرأ له الصحف التي
جاءته،
ولربما يعتذر عن ذلك بأن الخليفة ربما لم يكن يباشر القراءة لمركزه مع
معرفته لها،
أو أن الرسائل كانت بغير العربية.
ولكن الظاهر هو:
أن هذه الأعراف والتقيدات قد حدثت في وقت متأخر، ولم يكن عمر يتقيد بها
كما أن بلاد الشام كانت ولا تزال عربية اللغة، فمن البعيد أن يكتبوا له
بغير العربية.
ويمكن أن يؤيد ذلك أيضاً:
بأن عمر لم يكن ذا ذهنية علمية، وذلك بدليل:
أنه بقي اثنتي عشرة سنة حتى تعلم سورة البقرة، فلما
حفظها نحر جزوراً([55]).
بل لقد ورد أنه لما طلب من حفصة أن تسأل له النبي
>صلى
الله عليه وآله<
عن الكلالة، فسألته عنها؛ فأملها
عليها في كتب، ثم قال رسول الله
>صلى
الله عليه وآله<:
>عمر
أمرك بهذا؟ ما أظنه أن يفهمها<([56])،
بل لقد واجهه
النبي >صلى
الله عليه وآله<
نفسه بذلك كما رواه كثيرون([57]).
إلا أن من الممكن أن يكون عمر قد عاد فتعلم القراءة
والكتابة بمشاق ومتاعب جمة، ويمكن أن يستدل على ذلك بأنه ـ كما روى
البخاري ـ كان يقول:
إنه لولا أن يقال:
إن عمر قد زاد في كتاب الله لكتب آية الرجم بيده؟!([58]).
ومهما يكن من أمر،
فإننا لسنا أول من شك في معرفة الخليفة الثاني للقراءة
والكتابة، فقد كان هذا الأمر موضع نقاش وشك منذ القرن الأول للهجرة،
فهذا الزهري يقول:
كنا عند عمر بن عبد العزيز وهو والي المدينة ثم صارت
إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فقال: هل من معه به خبر فأساله: هل
كان عمر يكتب؟.
فقال عروة:
نعم كان يكتب.
فقال:
بآية ماذا؟.
قال:
بقوله: لولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لخططت آية الرجم بيدي.
فقال عبيد الله:
هل يسمي عروة من حدثه؟.
قلت:
لا.
قال عبيد الله:
فإنما صار عروة يمص مص البعوضة لتملأ بطنها، ولا يرى
أثرها، يسرق أحاديثنا ويكتمنا، أي أني أنا حدثته([59]).
ملاحظة:
وإذا ثبت عدم معرفته بالقراءة، أو شك في كونه كان
حينئذٍ يقرأ ويكتب، فمن الطبيعي أن يتطرق الشك إلى قولهم إنه كان من كتَّاب
الوحي([60])،
فلعل ذلك كان من الأوسمة التي نحله إياها بعض من عز عليهم أن يحرم عمر
من هذا الشرف بنظرهم.
وملاحظة أخرى:
وهي أننا رأينا عمر بن الخطاب يضرب فخذ أبي موسى حتى
كاد يكسرها، لاتخاذه كاتباً نصرانياً، مع أنهم يقولون: إنه هو نفسه كان
له مملوك نصراني لم يسلم، وكان يعرض عليه الإسلام فيأبى، حتى حضرته
الوفاة فأعتقه([61])
فما هذا التناقض في مواقف الخليفة الثاني؟! وما هو المبرر لها إلا أن
يكون اعتراضه على أبي موسى منصباً على استعانته بغير المسلم في
شؤون المسلمين العامة، وهذا غير خدمة غير المسلم
للمسلم.
4 ـ
هل عز الإسلام
بعمر حقاً؟!
وتذكر الروايات:
أن الإسلام قد
عز بعمر وأنه >صلى
الله عليه وآله<
قد دعا الله أن يعز الإسلام به،
بل لقد ذهبت بعض الروايات إلى اعتبار عمر من الجبارين في الجاهلية، حيث
إنه حين أشار على أبي بكر أن يتألف الناس ويرفق بهم، قال له أبو بكر:
>رجوت
نصرك، وجئتني بهذا لأنك جبار في الجاهلية، خوار في الإسلام
الخ..<([62]).
ونحن نشك في صحة ذلك بل نجزم بعدم صحته، وذلك للأمور
التالية:
أ ـ
إن الإسلام إذا لم يعز بأبي طالب شيخ الأبطح، وبحمزة أسد الله وأسد
رسوله، الذي فعل برأس الشرك أبي جهل ما فعل، وإذا لم يعز بسائر بني
هاشم أصحاب العز والشرف والنجدة، فلا يمكن أن يعز بعمر الذي كان عسيفاً
>أي
مملوكاً مستهاناً به<([63])
مع الوليد بن المغيرة إلى الشام([64]).
لا سيما وأنه لم يكن في قبيلته سيد أصلاً([65])،
ولم تؤثر عنه في طول حياته مع النبي
>صلى الله
عليه وآله<
أية مواقف شجاعة، وحاسمة، بل لم نجد له أية مبارزة، أو عمل جريء في أي
من غزواته، رغم كثرتها وتعددها.
بل لقد رأيناه يفر في غير موضع، كأحد، وحنين وخيبر
حسبما صرح به الجم الغفير من أهل السير، ورواة الأثر،
كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ومن الطريف هنا:
ما رواه الزمخشري، من أن أنس بن مدركة كان قد أغار على سرح قريش في
الجاهلية؛ فذهب به، فقال له عمر في خلافته: لقد اتبعناك تلك الليلة؛
فلو أدركناك؟.
فقال:
لو أدركتني لم تكن للناس خليفة([66]).
والخلاصة:
أنه لا يمكن أن يعز الإسلام بعمر، الذي لم يكن له عز في
نفسه، ولا بعشيرته، ولا شجاعة يخاف منها.
ب ـ
إننا سواء
قلنا: إن عمر قد أسلم قبل الحصر في الشعب أو بعده، فإن الأمر يبقى على
حاله، لأننا لم نجد أي تفاوت في حالة المسلمين قبل وبعد إسلام عمر، ولا
لمسنا أي تحول نحو الأفضل بعد إسلامه، بل رأينا: عكس ذلك هو الصحيح،
فمن حصر المشركين للنبي
>صلى
الله عليه وآله<
والهاشميين في الشعب، حتى كادوا يهلكون جوعاً، وحتى كانوا يأكلون
ورق السمر، وأطفالهم يتضاغون جوعاً،
إلى تآمر على حياة النبي
>صلى
الله عليه وآله<.
ثم بعد وفاة أبي طالب
>رحمه
الله<
لم يستطع >صلى
الله عليه وآله<
دخول مكة بعد عودته من الطائف إلا بعد مصاعب جمة، لم نجد عمر ممن ساعد
على حلها.
هذا كله،
عدا عن الأذايا الكثيرة التي كان أبو لهب يوجهها للنبي
>صلى
الله عليه وآله<
باستمرار.
ج ـ
وفي صحيح
البخاري وغيره حول إسلام عمر: عن عبد الله بن عمر قال: بينما عمر في
الدار خائفاً، إذ جاءه العاص بن وائل السهمي،
إلى أن قال: فقال: ما بالك؟
قال:
زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت.
قال:
لا سبيل إليك،
بعد أن قالها أمنت.
ثم ذكر إرجاع العاص الناس عنه.
وأضاف الذهبي قول عمر:
فعجبت من عزه([67]).
فمن يتهدده الناس بالقتل، ويخاف، ويختبئ في داره، فإنه
لا يكون عزيزاً ولا يعز الإسلام به،
غير أنه هو نفسه قد ارتفع بالإسلام، وصار له شخصية وشأن، كما سنرى.
هذا عدا عن الروايات القائلة:
إن أبا جهل هو الذي أجار عمر([68]).
وعلى هذا فقد كان الأجدر:
أن
يدعو النبي >صلى
الله عليه وآله<
بأن يعز الإسلام بمن يجير عمر، والذي يعجب الناس من عزته، لا بعمر
الخائف، والمختبئ في بيته.
د ـ
والغريب هنا:
أن أحد الرجلين اللذين دعا لهما النبي
>صلى
الله عليه وآله<
وهو أبو جهل يضربه حمزة رضوان الله عليه بقوسه أمام الملأ من قومه،
فيشجه شجة منكرة، ولا يجرؤ على الكلام، ثم يقتل في بدر في أول وقعة بين
المسلمين والمشركين.
والرجل الآخر وهو عمر بن الخطاب يكون على خلاف توقعات
النبي
>صلى
الله عليه وآله<
ولا يستجيب الله دعاءه فيه، حيث لم يعز الإسلام به، كما رأينا.
مع أن النبي
>صلى
الله عليه وآله<
يقول: >ما
سألت ـ ربي ـ الله ـ شيئاً إلا أعطانيه<([69])
بل لقد كانت النتيجة عكسية، حيث يذكر عبد الرزاق:
>أنه
لما جهر عمر بإسلامه اشتد ذلك على المشركين فعذبوا من المسلمين نفراً<([70]).
ه ـ
لا بأس
بالمقارنة بين نعيم بن عبد الله النحام العدوي،
وبين عمر بن الخطاب العدوي؛ فقد أسلم نعيم قبل عمر، وكان يكتم إسلامه،
ومنعه قومه لشرفه فيهم من الهجرة، لأنه كان ينفق على أرامل بني عدي
وأيتامهم.
فقالوا:
>أقم
عندنا على أي دين شئت، فوالله لا يتعرض إليك أحد إلا ذهبت أنفسنا
جميعاً دونك<([71]).
ويقول عروة عن بيت نعيم هذا:
>ما أقدم
على هذا البيت أحد من بني عدي<([72])
أي لشرفه.
أما عمر، فإن رسول الله أراد في الحديبية أن يرسله إلى
مكة؛ ليبلغ عنه رسالة إلى أشراف قريش، تتعلق بالأمر الذي جاء له؛ فرفض
ذلك وقال:
>إني
أخاف قريشاً على نفسي، وليس بمكة من بني عدي أحد يمنعني<
ثم أشار على النبي
>صلى
الله عليه وآله<
بأن يرسل عثمان بن عفان([73]).
و ـ
لقد خطب ابن
عمر بنت نعيم النحام، فرده نعيم، وقال:
>لا
أدع لحمي ترباً<
وزوجها من النعمان بن عدي بن نضلة([74])
فنعيم يربأ بابنته عن أن تتزوج بابن عمر، ويرى ذلك تضييعاً لها!!.
ز ـ
وفي زيارة عمر للشام أيام خلافته خلع عمر خفيه، ووضعهما على عاتقه،
وأخذ بزمام ناقته، وخاض المخاضة فاعترض عليه أبو عبيدة، فأجابه عمر
بقوله: >إنا
كنا أذل قوم؛ فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا
الله به أذلنا الله<([75]).
وفي نص آخر عنه:
>إنا
قوم أعزنا الله بالإسلام، فلن نبتغي العز بغيره<([76]).
واحتمال
أن يكون مقصوده هو ذل العرب وعزهم لا خصوص بني عدي بعيد؛ لأنه قد عنف
أبا عبيدة على مقولته تلك بأن غير أبي عبيدة لو كان قال ذلك لكان له
وجه، أما أن يقوله أبو عبيدة العارف بالحال والسوابق فإنه غير مقبول
منه.
هذا بالإضافة إلى ما سيأتي مما يدل على ذل بني عدي،
فانتظر.
ح ـ
وقال أبو
سفيان للعباس في فتح مكة، حينما كان يستعرض الألوية؛ فرأى عمر، وله
زجل: >يا
أبا الفضل، من هذا المتكلم؟
قال:
عمر بن الخطاب.
قال: لقد ـ أمر ـ أَمْر بني عدي بعد ـ والله ـ قلة
وذلة.
فقال العباس:
يا أبا سفيان،
إن الله يرفع من يشاء بما يشاء، وإن عمر ممن رفعه الإسلام<([77]).
ط ـ
تقدم قول عوف بن عطية:
وأمـــا الألأمــان بـنـــو عــدي وتـيــم
حـيــن تـزدحـم الأمـور
فـــلا تـشـهـد لـهم فتيان حـرب ولـكــن أدن من حـلـب
وعيـــر
وفي رسالة من معاوية لزياد بن أبيه يذكر فيها أمر
الخلافة يقول:
>ولكن
الله عز وجل أخرجها من بني هاشم وصيرها إلى بني تيم بن مرة،
ثم خرجت إلى بني عدي بن كعب وليس في قريش حيان أذل منهما ولا أنذل إلخ..<([78]).
ي ـ
وقال خالد بن
الوليد لعمر: >إنك
ألأمها حسباً،
وأقلها عدداً،
وأخملها ذكراً.. إلى أن قال له: لئيم العنصر ما لك في قريش فخر،
قال:
فأسكته
خالد<([79]).
5 ـ
غسل عمر لمس الصحيفة:
وإشكال آخر يبقى بلا جواب، وهو أنه
كيف طلبت أخته منه:
أن يغتسل لمس الصحيفة، مع أن غسل المشرك لا يجدي في جواز مس القرآن؛
فإن المانع هو شركه، لا حدثه؟!
ولذلك قالت له: >إنك
نجس على شركك، وإنه
{لا
يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ}<([80])،
ودعوى أن المراد هو غسل الجنابة مدفوعة أيضاً، فإنهم
يقولون: إن أهل الجاهلية كانوا يغتسلون من الجنابة([81])
فكيف تقول له أخته: إنك لا تغتسل من الجنابة؟
إلا أن يكون هو نفسه لم يكن يلتزم بما كان يلتزم به
قومه في الجاهلية.
ومما يدل على أنهم كانوا يغتسلون من الجنابة، أن أبا
سفيان قد نذر أو حلف بعد رجوعه من بدر مهزوماً: أن لا يمس رأسه ماء من
جنابة، حتى يغزو محمداً،
وكانت غزوة السويق لأجل أن يكفر عن يمينه،
([82])
كما سنرى.
ويدل على ذلك:
ما يذكرونه عن صيفي بن الأسلت من أنه كان قد ترهب في
الجاهلية ولبس المسوح واغتسل من الجنابة([83]).
6 ـ
نزول
آية
في إسلام عمر:
ويذكرون أن آية:
{يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
المُؤْمِنِينَ}([84])
قد نزلت في هذه المناسبة حيث أسلم عمر رابع أربعين([85]).
ولكن يعارض ذلك ما روي عن الكلبي، من أن الآية قد نزلت
في المدينة في غزوة بدر([86]).
وعن الواقدي:
أنها نزلت في بني قريظة والنضير([87]).
وأيضاً فإن الآية في سورة الأنفال، وهي مدنية لا مكية.
وفي رواية الزهري:
أن هذه الآية نزلت في الأنصار([88]).
يضاف إلى ذلك:
أن الآية
مسبوقة بآيات القتال، ولم يشرع القتال إلا في المدينة، وهي تنسجم مع
تلك الآيات تمام الانسجام، فراجعها وتأمل فيها،
وهي أيضاً تناسب المدينة، حيث قويت شوكة الإسلام، وعز المؤمنون.
وغير أننا نرى هذه الرواية قد تكون من دلائل تأخر إسلام
عمر إلى قبل الهجرة إلى المدينة بقليل، فإن الروايات الأخرى المروية في
هذه المناسبة تشير إلى أنه قد أسلم تمام الأربعين.
ومن المعلوم:
أن الذين هاجروا في السنة الخامسة إلى الحبشة كانوا
أكثر من ثمانين رجلاً، وهو إنما أسلم بعد الهجرة إلى الحبشة بمدة
طويلة، فلا يصح تفسير هذه الرواية إلا على معنى أنه قد أسلم في
الأربعين الرابعة، وكان ـ بقرينة الروايات الأخرى ـ آخر واحد منها.. أي
كان برقم مئة وستين.
وهذا معناه:
أن إسلامه قد كان قبيل الهجرة، كما سنرى.
وأخيراً، فإننا نذكر:
1 ـ
إن الذي يطالع روايات إسلام عمر، يرى: أنها متناقضة
تناقضاً كبيراً فيما بينها.
2 ـ
إن بعض الروايات تذكر: أن عمر قد التقى بسعد الذي كان قد أسلم، أو
بنعيم النحام، وجرى بينهما كلام؛ فأخبره بإسلام أخته، وزوجها، وأغراه
بهما.
ويرد سؤال:
إنه إذا كان سعد مسلماً، وكان نعيم قد أسلم قبل عمر
سراً، فلماذا يغري عمر بأخته المسلمة وصهره؟!
وإذا كان إنما فعل ذلك ليصرفه عن قصد النبي
>صلى
الله عليه وآله<
بالسوء؛
فلا ندري كيف يخاف من عمر على النبي وعند النبي
>صلى
الله عليه وآله<
أمثال حمزة وعلي إلى تمام الأربعين رجلاً؛ ولماذا لا يخاف على هذين
المسلمين، وليس لهما ناصر، ولا عندهما أحد؟!.
3 ـ
إن قول حمزة عن عمر:
>وإن
كان يريد شراً قتلناه بسيفه<
يشير إلى أنه >رحمه
الله<
لم يكن يقيم وزناً لعمر، حتى حينما يكون عمر متوشحاً بالسيف، حتى يرى:
أن أمره سهل، وأن بالإمكان قتله بنفس سيفه الذي يحمله، وهذا غاية في
الاستهانة بقدرات عمر، ما بعدها غاية.
4 ـ
لا ندري لماذا تهدد النبي عمر؟
وجبذه جبذة شديدة!!.
وكيف وصل عمر إلى النبي بهذه السهولة؟
ولماذا لقيه في الحجرة؟
ولماذا خرج المسلمون في صفين؟
وما هي فلسفة ذلك عسكرياً،
وهل لم يكن عمر يعرف من هو أنقل رجل
للحديث
في قريش؟
ولماذا لم يكن يدنو إليه إلا شريف؟!
وإذا كان قد خرج مع المسلمين في صفين وتهدد المشركين،
وخاف رسول الله
>صلى
الله عليه وآله<
حينئذٍ فلماذا احتاج إلى أنقل رجل للحديث في قريش؟!
ولماذا ذهب إلى المسلمين متوشحاً سيفه؟!
إلى كثير من الأسئلة التي تعلم بالمراجعة والمقارنة.
وبعد ما تقدم، فإن المراجع لروايات إسلام عمر لا يصعب
عليه: أن يكتشف بسرعة:
أن ثمة محاولات للتغطية على قضية إسلام حمزة، الذي عز
به الإسلام حقاً، وسر به رسول الله
>صلى
الله عليه وآله<
سروراً كثيراً.
ولهذا تجد:
أنهم يقرنون عمر بحمزة كثيراً في تلك الروايات،
ويحاولون إعطاءهما المواقف مناصفة، مع تخصيص عمر بحصة الأسد فيها.
كما أن فضيلة رد الجوار التي هي لعثمان بن مظعون
يحاولون إعطاءها إلى عمر.
بل نجد في بعض الروايات:
أن أهل الكتاب في الشام قد بشروا عمر بما سوف يؤول إليه
أمره في مستقبل هذا الدين الجديد([89])،
كما بشروا أبا بكر في بصرى([90])
وكما بشروا
النبي >صلى الله
عليه وآله<
نفسه([91])
حسب رواياتهم.
ثم إنهم قد وجدوا في عمر العلامات التي تدعم مدعاهم([92])،
كما وجدوها في أبي بكر من قبل..
ثم كان إسلام عمر، وكانت كل الجهود موقوفة على صنع
الفضائل والكرامات له!!
فتبارك الله أحسن الخالقين!!
ولقد قال ابن عرفة المعروف بنفطويه: إن أكثر فضائل
الصحابة قد افتعلت في عهد بني أمية، إرغاماً لأنوف بني هاشم!([93]).
كما أن معاوية قد أمر الناس بوضع الحديث في الخلفاء
الثلاثة كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
وحسبنا ما ذكرناه هنا؛ فإن فيه مقنعاً وكفاية لكل من
أراد الرشد والهداية.
([1])
البدء والتاريخ ج4 ص148 و149، وهوالظاهر من سيرة ابن هشام، حيث
ذكر هذه العروض بعد ذكره لإسلام حمزة
>عليه
السلام<.
([2])
البدء والتاريخ ج5 ص98.
([3])
راجع: تاريخ الأمم والملوك ج2 ص72 و73 والسيرة النبوية لابن
هشام ج1 ص312.
([4])
راجع: تاريخ الأمم والملوك ج2 ص72.
([5])
راجع: كنز العمال: ج14 ص48 عن البيهقي في الدلائل، وابن عساكر.
([6])
الآيات من أول سورة عبس.
([7])
راجع في هذه الروايات: مجمع البيان ج10 ص437 والميزان عن
المجمع وتفسير ابن كثير ج4 ص470 عن الترمذي، وأبي يعلى، وحياة
الصحابة ج2 ص520 عنه، وتفسير الطبري ج30 ص33 و34، والدر
المنثور ج6 ص314 و315. وأي تفسير قرآن آخر لغير الشيعة؛ فإنك
تجد فيه الروايات المختلفة التي تصب في هذا الاتجاه، فراجع
الأخير على سبيل المثال.
([8])
راجع: الهدى إلى دين المصطفى ج1 ص158.
([9])
الظاهر أن المراد به: أبا
مالك الأشجعي، المشهور بالرواية، وتفسير القرآن، وهو تابعي.
([10])
راجع: الهدى إلى دين المصطفى ج1 ص158 و159.
([11])
راجع: الهدى إلى دين المصطفى ج1 ص158، والميزان ج20 ص203،
وتنزيه الأنبياء ص119 ومجمع البيان ج1 ص437.
([12])
الآية 128 من سورة التوبة.
([13])
الآية 52 من سورة الأنعام.
([14])
الآية2 من سورة الجمعة.
([15])
تنزيه الأنبياء ص119.
([16])
الآيتان214 و215 من سورة الشعراء.
([18])
راجع: الميزان ج20 ص304.
([19])
تفسير البرهان ج4 ص428، وتفسير نور الثقلين ج5 ص509، ومجمع
البيان ج10 ص437.
([20])
مجمع البيان ج10 ص437 وتفسير البرهان ج4 ص428، وتفسير نور
الثقلين ج5 ص509.
([21])
تفسير القمي ج2 ص405 وتفسير البرهان ج4 ص427، وتفسير نور
الثقلين ج5 ص508.
([22])
سيرة ابن هشام ج2 ص3.
([23])
ونحن نجد في عثمان بعض الصفات التي تنسجم مع مدلول الآية، كما
تشهد له قضيته مع عمار حين بناء المسجد في المدينة، حين ردد
عمار ما ارتجز به علي عليه السلام تعريضاً بعثمان:
لا يستوي من يعمر المساجـدا
يــدأب قــائمـاً وقـاعــدا
ومن يرى عن التراب
حائداً
وستأتي هذه القضية إن شاء الله تعالى.
([24])
راجع: الهدى إلى دين المصطفى ج1 ص158.
([25])
الآية 52 من سورة الأنعام.
([26])
الآية 28 من سورة الكهف.
([27])
حلية الأولياء ج1 ص146 ـ345، وراجع مجمع البيان ج4 305306.
والبداية والنهاية ج6 ص56 وعن كنز العمال ج1 ص245 وج7 ص46 عن
ابن أبي شيبة وابن عساكر. والدر المنثور في تفسير الآيات
المشار إليها. عن العديد من المصادر.
([28])
راجع الميزان ج7 ص110.
([29])
الدر المنثور ج3 ص22.
([30])
الآية 52 من سورة الإنعام.
([31])
راجع في مجموع ما تقدم: الأوائل للعسكري ج1 ص221 و222، والثقات
لابن حبان ص72 ـ 75 والبدء والتاريخ ج5 ص88 ـ 90 ومجمع الزوائد
ج9 ص61 عن البزار والطبراني، وتاريخ الطبري حوادث سنة 23،
وطبقات ابن سعد ج3 ص191، وعمدة القاري للعيني ج8 ص68، وسيرة
ابن هشام ج1 ص366 ـ 374، وتاريخ الخميس ج1 ص295 ـ 297 وتاريخ
عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص23 ـ 30، والبداية والنهاية ج3 ص31
و72 ـ 80، والسيرة الحلبية ج1 ص329 ـ 335، والسيرة النبوية
لدحلان ج1 ص132 ـ 137 ومصنف الحافظ عبد الرزاق ج5 ص327 و328،
وشرح النهج للمعتزلي ج12 ص182 و183، وأسباب النزول للواحدي
وحياة الصحابة ج1 ص274 ـ 276، والإتقان ج1 ص15، والدر المنثور
ج3 ص200 وكشف الأستار عن مسند البزار ج3 ص169 ـ 172 ولباب
النقول ط دار إحياء العلوم ص113، إلى غير ذلك من كتب الحديث
والتاريخ ودلائل النبوة للبيهقي ج2 ص4 ـ 9 ط دار النصر
للطباعة.
([32])
راجع هذه الأحاديث وغيرها في: البدء والتاريخ ج5 ص88، وسيرة
مغلطاي ص23، ومنتخب كنز العمال هامش مسند أحمد ج4 ص470 عن
الطبراني، وأحمد، وابن ماجة، والحاكم والبيهقي، والترمذي،
والنسائي، عن عمر، وخباب، وابن مسعود، والأوائل ج1 ص221،
وطبقات ابن سعد ج3 قسم 1 ص191 ـ 193، وجامع الترمذي ط الهند ج4
ص314 و315، ودلائل النبوة للبيهقي ج2 ص7 وتحفة الأحوذي ج4 ص314
والبداية والنهاية ج3 ص79، والبخاري ط الميمنية، ومصنف عبد
الرزاق ج5 ص325، والاستيعاب هامش الإصابة ج1 ص271، والسيرة
الحلبية ج1 ص330، وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص102 وتاريخ
الخميس، وسيرة ابن هشام، وسيرة دحلان، ومسند أحمد، وسيرة
المصطفى، والطبراني في الكبير والأوسط، والمشكاة وغير ذلك من
كتب الحديث والتاريخ.
([33])
السيرة الحلبية ج1 ص335.
([34])
تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص19، وطبقات ابن سعد ج3 قسم 1
ص193، وشرح النهج للمعتزلي ج12 ص182.
([35])
فتح الباري ج7 ص135.
([36])
البداية والنهاية ج3 ص81 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص105 وسيرة
ابن هشام ج1 ص373 ـ 374.
([37])
السيرة النبوية لابن كثير ج2 ص39، والبداية والنهاية ج3 ص82،
ومروج الذهب ط دار الأندلس بيروت ج2 ص321.
([38])
سير أعلام النبلاء ج3 ص209، تهذيب الكمال ج15 ص340 الإصابة ج2
ص347 والاستيعاب بهامش الإصابة ج2 ص342 وبقية المصادر لذلك
تراجع في كتابنا: سلمان الفارسي في مواجهة التحدي ص24.
([39])
سير أعلام النبلاء ج3 ص209.
([40])
مصنف الحافظ عبد الرزاق ج5 ص326.
([41])
الدر المنثور ج3 ص2 عن الطبراني، وابن مردويه.
([42])
الثقات ج1 ص73، والبداية والنهاية ج3 ص80 والبدء والتاريخ ج5
ص88.
([43])
تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص28 و29.
([44])
وإن كان ابن هشام قد عد نحو سبعين ممن هاجر إلى المدينة، ولكن
ذلك لا يمكن الاعتماد عليه بعد النص على عدد من آخى رسول الله
>صلى
الله عليه وآله<
بينهم من قبل غير واحد، كما سيأتي، ولا يعقل أن يترك أحداً من
أصحابه لا يؤاخي بينه وبين آخر من إخوانه.
([45])
المصنف للحافظ عبد الرزاق
ج5 ص326. وراجع مصادر روايات إسلام عمر المتقدمة.
([46])
الإتقان ج1 ص10 و11.
([47])
صحيح البخاري ط مشكول ج5 ص163.
([48])
وقد تقدم عن الزهري أن عمر قد أسلم بعد حفصة وعبد الله بن عمر.
([49])
ستأتي مصادر ذلك بعد حوالي خمس صفحات.
([50])
تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص30، وطبقات ابن سعد ج3 قسم 1
ص193، والبداية والنهاية ج7 ص133، وتاريخ الطبري ج3 ص267 حوادث
سنة 23، وذيل المذيل ج8 من تاريخ الطبري.
([51])
راجع: طبقات الشعراء لابن سلام ص44.
([52])
تاريخ ابن خلدون ج2 قسم 2 ص9.
([53])
مصنف الحافظ عبد الرزاق ج5 ص326.
([54])
عيون الأخبار لابن قتيبة ج1 ص43 والدر المنثور ج2 ص291 عن ابن
أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان وحياة الصحابة ج2 ص785 عن
تفسير ابن كثير ج2 ص68.
([55])
تاريخ عمر بن الخطاب ص165، والدر المنثور ج1 ص21، عن الخطيب في
رواة مالك، والبيهقي في شعب الإيمان، وشرح النهج للمعتزلي ج12
ص66، والغدير ج6 ص196 عنهم وتفسير القرطبي ج1 ص152 والتراتيب
الإدارية ج2 ص280 عن تنوير الحوالك.
([56])
المصنف للحافظ عبد الرزاق ج10 ص305.
([57])
راجع الغدير ج6 ص116 عن غير واحد وراجع 128.
([58])
راجع كتابنا: حقائق هامة حول القرآن ص346، فقد نقلنا ذلك عن
عشرات المصادر.
([59])
مختصر تاريخ دمشق ج17 ص10.
([60])
بحوث في تاريخ القرآن
وعلومه ص113 عن تاريخ القرآن للزنجاني. وفي تاريخ اليعقوبي ج2
ص80 ط صادر والاستيعاب بهامش الإصابة ج1 ص51، ذكرا عمر في جملة
من كان يكتب للنبي
>صلى
الله عليه وآله<،
لكن لم يبينا إذا كان يكتب الوحي، أو غيره.
([61])
حلية الأولياء ج9 ص34، عن كنز العمال ج5 ص50 عن ابن سعد، وسعيد
بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي شيبة، وابن أبي حاتم،
والطبقات الكبرى ج6 ص109 والتراتيب الإدارية ج1 ص102 ونظام
الحكم في الشريعة والتاريخ والحياة الدستورية ص58 عن تاريخ عمر
لابن الجوزي ص87 و148.
([62])
كنز العمال ج6 ص295.
([63])
راجع: أقرب الموارد، مادة: >عسف<.
([64])
المنمق، لابن حبيب ط الهند ص146، وشرح النهج للمعتزلي ج12
ص183.
([66])
ربيع الأبرار ج1 ص707.
([67])
راجع: صحيح البخاري ج5 ص60 و61 ط مشكول، ففيه روايتان بهذا
المعنى، وتـاريخ الإسـلام لـلـذهـبي ج2 ص104، ونسب قـريـش
لمصعب الزبيري = = ص409، وتاريخ عمر لابن الجوزي ص26، والسيرة
الحلبية ج1 ص332، والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص135، وسيرة ابن
هشام ج1 ص374، والبداية والنهاية ج3 ص82 وراجع: دلائل النبوة
للبيهقي ط دار النصر ج2 ص9.
([68])
تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص24 ـ 25 وراجع كشف الأستار
ج3 ص171 ومجمع الزوائد ج9 ص64 وذكر: أن خاله هو الذي أجاره
وقال ابن إسحاق المراد بخاله: أبوجهل، ولم يرتض ذلك ابن
الجوزي، فراجع.
([69])
راجع: ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ ابن عساكر بتحقيق
المحمودي ج2 ص275 و276 وهامشها و278 وفرائد السمطين باب 43
حديث 172 وكنز العمال ج15 ص150 ط 2 عن ابن جرير، وصححه، وابن
أبي عاصم، والطبراني في الأوسط، وابن شاهين في السنة، وعن
الرياض النضرة ج2 ص213.
([70])
راجع المصنف لعبد الرزاق ج5 ص328.
([71])
أسد الغابة ج2 ص33 وراجع: نسب قريش لمصعب ص380.
([72])
نسب قريش لمصعب ص381.
([73])
راجع: البداية والنهاية ج4 ص167 عن ابن إسحاق، وحياة الصحابة
ج2 ص397 و398 عن كنز العمال ج1 ص84 و56 وج5 ص288 عن ابن أبي
شيبة، والروياني، وابن عساكر، وأبي يعلى، وطبقات ابن سعد ج1
ص461 وسنن البيهقي ج9 ص221.
([74])
نسب قريش لمصعب ص380.
([75])
مستدرك الحاكم ج1 ص61.
وتلخيصه للذهبي بهامشه، وصححه على شرط الشيخين.
([76])
مستدرك الحاكم ج1 ص62.
([77])
مغازي الواقدي ج2 ص821، وعن كنز العمال ج5 ص295، عن ابن عساكر،
عن الواقدي.
([78])
كتاب سليم بن قيس ص140.
([80])
الثقات ج1 ص74، وراجع مصادر الرواية المتقدمة، ومجمع الزوائد
ج9 ص63.
([81])
السيرة الحلبية ج1 ص329 عن الدميري، والسهيلي وذكر الدميري:
أنه بقية من دين إبراهيم وإسماعيل قال: وفي كلام بعضهم: كانوا
في الجاهلية يغتسلون من الجنابة، ويغسلون موتاهم، ويكفنونهم،
ويصلون عليهم إلخ.
([82])
البداية والنهاية ج3 ص344 والسيرة النبوية لابن كثير ج2 ص540
وتاريخ الخميس ج1 ص410 والسيرة الحلبية ج2 ص211 والكامل في
التاريخ ج2 ص139 والسيرة النبوية لدحلان (مطبوع بهامش الحلبية)
ج2 ص5 والبحار ج20 ص2 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص175.
([83])
السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص47 وتاريخ الإسلام للذهبي ص109
والسيرة الحلبية ج2 ص14.
([84])
الآية 64 من سورة الأنفال.
([85])
راجع: الدر المنثور ج3 ص200 عن الطبراني، وأبي الشيخ، وابن
مردويه وراجع أيضاً ما أخرجه عن البزار وابن المنذر، وابن أبي
حاتم، وغيرهم.
([86])
مجمع البيان ج4 ص557.
([87])
التبيان للطوسي ج5 ص152.
([88])
الدر المنثور ج3 ص200 عن ابن إسحاق، وابن أبي حاتم.
([89])
راجع الرياض النضرة ج2 ص319.
([90])
راجع: السيرة الحلبية ج1 ص274 و275 و186 والرياض النضرة ج1
ص221.
([91])
قد أشرنا إلى ما يذكرونه عن دور ورقة بن نوفل في ذلك، وأثبتنا
عدم صحة ذلك، فراجع روايات بدء الوحي في الجزء الأول من هذا
الكتاب.
([92])
تاريخ عمر بن الخطاب ص22.
([93])
راجع النصائح الكافية ص74 وحياة الإمام الحسن للقرشي ج2 ص148
والكنى والألقاب ج3 ص262 وفجر الإسلام ص213.
|