|
حــدث ونـــقــــــد
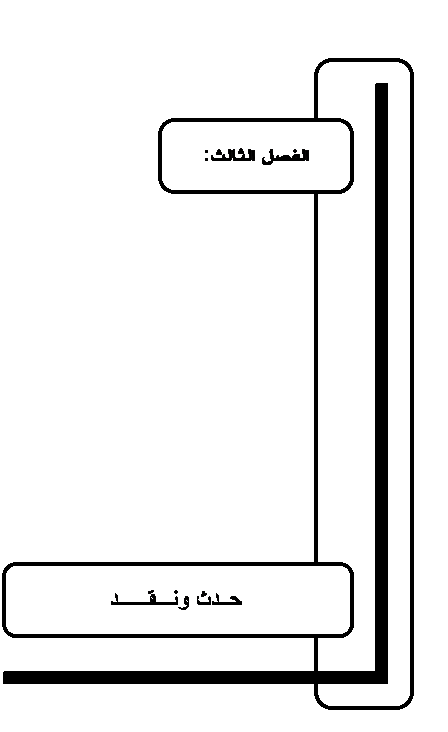
بـدايـة:
وبعد ما تقدم؛ فإن لنا على كثير من الفقرات التي
أوردتها روايات هذه السرية العديد من الملاحظات والإيرادات التي تبقى
بلا جواب.
ونحن نورد ذلك فيما يلي:
قد تقدم:
أن ثمة نصاً يقول: إن بني لحيان ـ بعد قتل صاحبهم سفيان
بن خالد ـ أرادوا الانتقام له ممن قتله،
فكلموا قبيلتي عضل والقارة، وطلبوا منهما أن يذهبوا إلى النبي «صلى
الله عليه وآله»، ويخدعوه؛ ليرسل معهم بعض أصحابه، ليقتلوا من قتل
صاحبهم، ويبيعوا الباقين من قريش، فكان ما كان، وفعلوا فعلتهم حسبما
تقدم([1]).
ونقول: إن ذلك لا يصح، وذلك لما يلي:
ألف:
قد تقدم: أنه «صلى الله عليه وآله» أرسلهم عيوناً
إلى مكة، فاكتشفت هذيل أمرهم.
وثمة روايات أخرى تفيد:
أن هذيلاً
لم تكن تعلم بأمرهم قبل ذلك، فراجع الفقرة (ج) من حديثنا الآنف حول
تناقضات الرواية.
ب:
هناك نص آخر
يقول: إن سفيان بن خالد نفسه هو الذي قتل أصحاب الرجيع حينما علم بهم([2]).
ج:
قد تقدم: أن
تاريخ غزوة الرجيع، إما هو سنة ثلاث بعد غزوة أحد، أو في صفر سنة أربع([3]).
والأصح، هو الأول وذلك لأن بعض
النصوص تصرح:
بأن أهل مكة قد اشتروا خبيباً، وابن الدثنة في ذي القعدة فحبسوهما حتى
خرجت الأشهر
الحرم، ثم أخرجوهما، فقتلوهما([4]).
ومن الواضح:
أن قتل سفيان بن خالد قد كان بعد ذلك، وذلك: لما يلي:
1 ـ
إن بعض الروايات تقول: إن سفيان قتل لخمس خلون من المحرم على رأس خمسة
وثلاثين شهراً
من الهجرة([5]).
2 ـ
بل لقد أورد البعض قصة سفيان بن خالد في السنة الخامسة، بعد غزوة بني
قريظة([6])
ولا شك في أن قصة الرجيع قد كانت قبل ذلك.
3 ـ
إن الحافظ البيهقي قد ذكر في الدلائل:
قتل سفيان بعد مقتل أبي رافع([7])
فإذا انضم ذلك إلى ما يظهر من ابن إسحاق من أن مقتل أبي رافع كان بعد
الخندق وقريظة([8]):
فإن النتيجة تكون:
أن قتل سفيان قد كان بعد هاتين الغزوتين أيضاً، أما قصة
الرجيع، فلا شك في سبقها على ذلك.
4 ـ
قال البلاذري:
«وسرية
عبد الله بن أنيس، من ولد البرك بن وبرة، عداده في جهينة، في المحرم
سنة ست، إلى سفيان بن خالد بن نبيح»([9]).
تقول الرواية المتقدمة:
إنهم أرادوا قطع رأس عاصم بن ثابت، ليبيعوه من سلافة
بنت سعد، فحمته الدبر منهم (أي من بني لحيان الهذليين)، ثم احتمله
السيل في المساء.
ونقول:
1 ـ
إننا نجد عند أبي الفرج: أن حياً
من قيس،
(وعند
غيره: أن حياً
من قريش)، قد أرسلوا إلى عاصم ليؤتوا من لحمه بشيء، وقد كان لعاصم فيهم
آثار بأحد، فبعث الله عليه دبراً
فحمت لحمه([10]).
ومعنى ذلك هو:
أن السيل لم يكن قد احتمل عاصماً،
حسبما ذكرته الرواية المتقدمة.
واعتذار العسقلاني وغيره عن ذلك:
بأن من الممكن أن لا تكون قريش قد علمت بحماية الزنابير له من هذيل، أو
شعرت بذلك، لكن رجت أن تكون الزنابير قد تركته([11])،
هذا الاعتذار لا يجدي في دفع ما
ذكرناه، لأن الرواية المتقدمة تذكر:
أن السيل قد احتمل عاصماً
في مساء ذلك اليوم الذي أرادت هذيل قطع رأسه فيه فحمته الدبر.
وزاد في بعض الروايات:
أن ذلك السيل قد احتمل معه خمسين من المشركين إلى النار أيضاً كما
تقدم([12]).
2 ـ
لا ندري لماذا جاء ذلك السيل الذي احتمل عاصماً
ليلاً،
ولم يأت نهاراً؟!
فهل خشي على نفسه من هذيل أن يعرفوه، ويعاقبوه بعد ذلك؟
ولماذا اكتفى بحمل خمسين من المشركين، ولم يحمل بقيتهم،
ويخلص الناس من شرهم؟!
ولماذا لم يعتبروا بما جرى، وأصروا على أسر خبيب
وأصحابه، ثم قدموا بهم إلى مكة، حتى جرى عليهم ما جرى؟!
ألم يكن الأنسب أن يطلقوا سراح أسراهم، ويعتذروا
إليهم؟!
ألم يكن الأجدر بهم أن يرجعوا إلى أنفسهم، ويعرفوا: أن
دعوة عاصم وأصحابه صحيحة ومحقة، فيقبلوا بها ويعتنقوها، ويعتذروا لنبي
الإسلام عما صدر منهم؟! ولا أقل من أن يفعل بعضهم ذلك، أو يختلفوا فيما
بينهم لأجله!!
وقريش أيضاً:
لماذا لم تعتبر بما رأته من الكرامة لعاصم، فترجع إلى نفسها، وتصدق
بالحق، أو يصدق بعض رجالها به؟!
3 ـ
إن بعض الروايات تصرح:
بأن المسلمين قد دفنوا عاصماً
بعد أن حمته الدبر([13])،
ومعنى ذلك هو:
أن السيل لم يحتمله، إلا أن يكون قد احتمله ثم أرجعه إليهم!!
كما أننا لم نعرف من أين جاء المسلمون إلى عاصم
ليدفنوه، فهل هم خبيب وأصحابه الأسرى الذين لم يكن يمكنهم القيام بأي
عمل من دون
إذن
آسريهم؟
أم أنهم مسلمون آخرون كانوا حاضرين،
ولكنهم لم يشاركوا في المعركة ولم يدافعوا عن إخوانهم؟!
لقد ذكروا:
أن العظيم الذي قتله عاصم يوم بدر، هو عقبة بن أبي معيط، قتله صبراً
بأمر النبي «صلى الله عليه وآله»، بعد منصرفهم من بدر([14]).
ولكن ذلك لا يصح؛ إذ قد تقدم:
أن علياً «عليه السلام»: هو الذي قتل عقبة هذا بأمر من رسول الله «صلى
الله عليه وآله»([15]).
وقال معاوية للوليد بن عقبة في صفين
يحرضه على علي «عليه السلام»:
«..
وأما أنت يا وليد فإنه قتل أباك بيده صبراً
يوم بدر»([16]).
ونقول أيضاً:
1 ـ
إننا لم نفهم السر في سكوت عبد الله بن طارق حتى بلغوا به مر الظهران،
ولماذا قال لهم في هذا المكان بالذات: هذا أول الغدر، فكلمة (هذا) يراد
بها الإشارة إلى أي شيء؟!
أليس كانوا قد وعدوه بأن يأخذوه إلى مكة ليصيبوا به
وبرفيقيه مالاً
من أهلها؟ فهل غيروا خطتهم الآن، وغدروا بهم وأخلفوا بوعدهم؟!
2 ـ
ما معنى قوله: إن بهؤلاء لأسوة، يعني القتلى؟ فهل كان القتلى حاضرين في
مر الظهران إلى جانبه حتى صح أن يشير إليهم بكلمة (هؤلاء)؟ ألم يترك
القتلى في منطقة الرجيع البعيدة عن مر الظهران مسافات طويلة؟!
3 ـ
قد تقدم: أن من غير المعقول: أن يبقي آسروه سيفه معه، وتقدم غير ذلك
أيضاً، فلا نعيد.
4 ـ
ويفهم من عبارة ابن الوردي: أنه قد هرب من آسريه، فلما حاولوا استعادته
قاتلهم، لا أنه تمرد عليهم ثم قاتلهم، يقول ابن الوردي:
«فهرب
طارق (كذا) في الطريق، وقاتل إلى أن قتلوه بالحجارة»([17]).
وحول ما ذكرته
بعض الروايات المتقدمة، من أن عقبة بن الحارث اشترى خبيباً من بني
النجار([18]).
فإن لنا أن نسأل:
لماذا من بني النجار، وليس من الهذليين؟!
ولماذا اشتراه بنو النجار؟ ثم لماذا عادوا فباعوه بعد
ذلك؟!
فهل كانوا يريدون المتاجرة به والحصول على المال؟!
وتذكر الرواية المتقدمة:
أن عبد الله بن طارق استأسر مع رفيقيه، وسار معهم، حتى إذا بلغوا مر
الظهران ـ واد قرب مكة ـ انتزع يده من الحبل الذي ربط به، ثم أخذ سيفه
وقاتلهم، فرموه بالحجارة حتى قتلوه؛ فقبره بالظهران.
وذكر ابن سعد:
أن معتب بن عبيد هو الآخر قد قتل يوم الرجيع بمر
الظهران شهيداً([19]).
ونقول:
ألف:
قد تقدمت الرواية الأخرى القائلة: إنه بعد قتل عاصم ورفيقيه رفض عبد
الله أن يسير مع آسريه، فقتلوه إلى جانب رفاقه.
ب:
إننا لم نفهم سر بقاء سيفه معه، إلى أن بلغ معهم مر
الظهران، وكيف لم ينتزعوه منه، وهو أسيرهم، ومربوط بحبالهم؟!
ج:
لماذا رموه بالحجارة حتى قتلوه، ألم يكن معهم سيوف يقاتلونه بها؟!
ولماذا لم يرموه بسهامهم، وقد كانوا مئة رام، أو مئتين؟!
أو لماذا لم يشجروه برماحهم؟!
د:
معنى قول ابن سعد: أن معتباً
هو الآخر قد استشهد بمر الظهران هو أن الأسرى كانوا أربعة لا ثلاثة.
وعبارة الواقدي هنا هي التالية:
«حتى
إذا كانوا بمر الظهران، وهم موثقون بأوتار قسيهم، قال عبد الله بن
طارق: هذا أول الغدر،
والله لا أصاحبكم، إن لي في هؤلاء لأسوة، يعني القتلى، فعالجوه؛ فأبى
ونزع يده من رباطه ثم أخذ سيفه
الخ..»([20]).
وقريب منه عبارة ابن سعد أيضاً،
فالقتلى لم يكونوا بمر الظهران ليصح قوله: إن لي بهؤلاء لأسوة.
وقد صرحت الرواية المتقدمة:
بأن الذي اشترى خبيباً هو:
حجير بن أبي إهاب لعقبة بن الحارث،
ليقتله بأبيه الحارث بن عامر بن نوفل.
وصرح البعض:
بأن خبيباً هو
الذي قتل الحارث في غزوة أحد([21])
أو في بدر([22]).
ونقول:
1 ـ
قد تقدم: أن بعض الروايات تقول: إن ثلاثة قد اشتركوا في شراء خبيب. وهم:
أبو سروعة، وعقبة، وأخوهما لأمهما حجير بن أبي إهاب([23])
وتقدمت روايات أخرى في من اشتراه.
2 ـ
إن رواية أخرى تقول: إن المقتول ببدر هو عامر بن نوفل([24])
وليس هو الحارث بن عامر.
3 ـ
إن الدمياطي قد أشكل على هذا المورد بأمرين:
أحدهما:
أن خبيباً لم يذكره أحد من أهل المغازي في من شهد بدراً([25]).
الثاني:
أن
الذي قتل الحارث هو خبيب بن أساف الخزرجي، وهو غير خبيب بن عدي الأوسي([26]).
4 ـ
ونقول: بل قيل: إن قاتل الحارث هذا هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
«عليه السلام»([27]).
وقد أجابوا عن قول الدمياطي الآنف
الذكر:
بأن في هذا تضعيفاً
للحديث الصحيح، ولو لم يقتل خبيب بن عدي الحارث بن عامر، لم يكن
لاعتناء آل الحارث بشرائه وقتله به معنى، إلا أن يقال: لكونه من قبيلة
قاتله، وهم الأنصار، كذا قال ابن حجر([28]).
ونقول:
إن هذه الأجوبة لا مجال لقبولها، وذلك:
ألف:
إن الحديث الصحيح ليس وحياً
منزلاً،
فكم من حديث ورد بسند صحيح في الصحاح الستة، ومنها البخاري، ثم ثبت
كذبه، وإذا جاء الحديث الصحيح مخالفاً
لكل الأدلة القطعية، فلا بد من رده وتضعيفه.
وخذ مثلاً على ذلك:
حديث بدء نزول الوحي، وحديث الإفك، وحديث زواج علي «عليه السلام» ببنت
أبي جهل، إلى عشرات، بل مئات من الأحاديث التي ثبت كذبها وضعفها، أو
التصرف العمدي فيها.
ب:
وأما بالنسبة لاعتناء آل الحارث بشراء خبيب وقتله
بصاحبهم، فلا يدل على أنه قد قتل أباهم بنفسه، إذ يكفي أن يكون من
الفريق القاتل ومن مؤيديه ومناصريه.
ومن عادة العرب:
أن يقتلوا أياً
من أفراد القبيلة إذا كان أحد أفرادها قد قتل بعضهم.
ومن الواضح:
أن خبيب بن عدي كان قحطانياً
كخبيب بن
أساف،
وكان من مؤيدي ومناصري النبي «صلى الله عليه وآله»، وعلى دينه،
فإذا كان الحارث في حالة غليان ضد النبي
«صلى
الله
عليه وآله»
وكل من يلوذ به، فإن اهتمامهم بأمر خبيب لا يكون غريباً
ولا عجيباً.
وقد أشار ابن حجر إلى هذا المعنى، فاعتبر كون خبيب من
الأنصار كافياً
لاهتمام آل الحارث بقتله، وإن كان القاتل للحارث هو ابن أساف لا ابن
عدي.
هذا كله،
مع غض النظر عن سائر ما يرد على الرواية مما تقدم وسيأتي فإنه لا يبقي
مجالاً
للشك في عدم صحة هذا الحديث، وإن كان مذكوراً
في الكتب التي اعتبروها صحاحاً.
وبعد كل ما تقدم نقول:
إن عد
«الإستيعاب»
خبيب بن عدي في من شهد بدراً([29])
لعله مستند إلى رواية قتله الحارث بن عامر، فلا يصلح دليلاً
على صحتها.
وفي الرواية المتقدمة:
كما في بعض المصادر: أن المنافقين قالوا في هذه
المناسبة: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا، لا هم قعدوا في أهليهم
ولا هم أدوا رسالة صاحبهم؛ فأنزل الله:
﴿وَمِنَ
النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ،
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ
الحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ، وَإِذَا قِيلَ
لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ
جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾([30]).
﴿وَمِنَ
النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ الله وَاللهُ
رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾([31]).
قال ابن إسحاق:
في أصحاب الرجيع نزلت:
﴿وَمِنَ
النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ..﴾
الخ..([32]).
ونقول:
إن ذلك لا يصح، وذلك لما يلي:
1 ـ
أما بالنسبة لآية:
﴿وَمِنَ
النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ..﴾،
فقد قال السهيلي رداً
على ابن إسحاق:
«أكثر
أهل التفسير على خلاف قوله، وأنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، رواه
أبو مالك عن ابن عباس، وقاله مجاهد.
وقال ابن الكلبي:
كنت بمكة، فَسُئلت
عن هذه الآية، فقلت: نزلت في الأخنس
بن شريق، فسمعني رجل من ولده، فقال: يا هذا، إنما أنزل القرآن على أهل
مكة؛ فلا تسم أحداً ما دمت فيها»([33]).
2 ـ
كما أننا لم نفهم معنى لقول المنافقين:
«ولا
هم أدوا رسالة صاحبهم»، فهل كانوا يحملون رسالة منه «صلى الله عليه
وآله» لبني هذيل؟!
كما أن قول المنافقين:
«لا
هم قعدوا في أهليهم» يفيد: أن مسيرهم ذاك كان برأي منهم، والفقرة
السابقة تدل على:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد حملهم رسالة، فما هذا التناقض؟
3 ـ
وأما بالنسبة لآية الشراء فإنهم تارة يقولون: إنها نزلت
في قضية الرجيع، حسبما تقدم، وأخرى يقولون: إنها نزلت في حق الزبير
والمقداد، في محاولتهما إنزال جثة خبيب عن الخشبة التي كان مصلوباً
عليها([34]).
وسيأتي في الفصل التالي:
أن ذلك كله لا يصح.
وثالثة:
إنها نزلت في صهيب لما أخذه المشركون ليعذبوه، فأعطاهم ماله([35]).
وقد ذكرنا في فصل:
هجرة الرسول الأعظم أن ذلك أيضاً لا يصح.
ولكن الصحيح هو:
أنها نزلت في علي أمير المؤمنين «عليه السلام» حين مبيته على فراش
النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» حينما هاجر، ووقاه «عليه السلام»
بنفسه([36])،
كما قدمناه في فصل هجرة الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله».
وقد تقدم:
أن خبيباً قد دعا عليهم بقوله:
«اللهم
أحصهم عدداً
واقتلهم بدداً،
ولا تبق منهم أحداً»
فلبد رجل بالأرض خوفاً
من دعائه.
وقالوا:
حضر قتلهما أكثر أهل مكة([37]).
وعند ابن سعد:
«خرج
معه الصبيان والنساء والعبيد، وجماعة أهل مكة فلم يتخلف أحد»([38]).
ثم قالوا:
«فلم
يحل الحول ومنهم أحد حي،
غير ذلك الرجل الذي لبد في الأرض.
قيل:
إن ذلك الرجل هو معاوية»([39]).
وأضاف البعض:
«ولقد
مكثت قريش شهراً،
أو أكثر، وما لها حديث في أنديتها غير دعوة خبيب»([40]).
وأضاف بعض آخر قوله:
«وقد
قتلوا في الخندق متفرقين»([41]).
ونقول:
1 ـ
إن الدعاء المنسوب إلى خبيب بعينه رواه غير واحد على أنه من كلام
الإمام الحسين «عليه السلام» في كربلاء([42]).
وقد تعودنا في موارد كثيرة:
أن نجدهم يسرقون كلام علي وغيره من الأئمة الأطهار «عليهم
السلام»، وينسبونه إلى آخرين ممن لهم هوى في مناصرته، وإظهار أمره،
وتضخيم مواقفه.
2 ـ
كيف لم يحل الحول وأحد ممن حضر حيّ،
مع أن أبا سفيان قد كان في جملة من حضر، وقد بقي بعد ذلك عشرات السنين،
هذا بالإضافة إلى كثيرين ذكرت أسماؤهم؟
بل تقدم:
أن أكثر أهل مكة كانوا حاضرين، فلو كان أكثرها قد هلك، قبل أن يحول
الحول، فلماذا يحتاج النبي «صلى الله عليه وآله» إلى خوض حرب الخندق،
وما بعدها من حروب إلى فتح مكة؟
ألم يكن بإمكان الرسول «صلى الله عليه وآله» أن يهجم
حينئذٍ على مكة، ويستولي عليها، ولماذا ينتظر إلى سنة ثمان من الهجرة
أي حوالي أربع سنين من هلاك أكثر أهل مكة؟!
ولا ندري بعد هذا ما المقصود
بقولهم:
إنهم قتلوا في الخندق متفرقين، ونحن نعلم أنه لم يقتل في الخندق من
المشركين سوى عدة قليلة معروفين بأسمائهم وأعيانهم، كما سيأتي.
والغريب في الأمر:
أننا نجد الزرقاني والسهيلي يتبرعان بحل هذا المشكل على
النحو التالي:
إن دعوة خبيب أصابت منهم من سبق في
علمه تعالى:
أن يموت كافراً،
وأما من سبق في علمه تعالى أنه يسلم: فلم يعنه خبيب، ولا قصده في دعائه
فلم تصبه.
وعلامة استجابة دعوته:
أن من هلك بعد الدعوة، فإنما هلك بدداً،
لأنهم قتلوا غير معسكرين، ولا مجتمعين، كاجتماعهم في بدر وأحد، لأن
الدعوة بعدهما، فنفذ الدعوة على صورتها([43]).
إنتهى.
ونقول:
ألف:
إن صريح الكلام المتقدم هو أن جميع الذين حضروا قتل
خبيب قد هلكوا، ولم يبق منهم أحد قبل أن يحول الحول.
ب:
من الذي أخبره أن خبيباً كان قد فكر هذا التفكير الذي
ذكره، فلعله لم يدر بخلده، ولم يخطر له على بال أصلاً،
فكيف حكم بأن خبيباً لم يعنه؟
ج:
هل إن الذين ماتوا من مشركي مكة ما بين قتل خبيب وفتح
مكة ماتوا جميعاً
قتلاً،
ألم يمت من مكة طيلة الأربع سنين أحد حتف أنفه؟!
وذكرت الرواية المتقدمة:
أن خبيباً قد
صلى ركعتين قبل قتله، ثم قتل، فهو أول من سن الصلاة حين القتل([44]).
وقوله هذا يدل
على أنها سنة جارية([45]).
1 ـ
لا ندري كيف سمح له المشركون بالصلاة، وهم الأشرار والموتورون، الذين
ما كانوا يتحملون ما هو أقل من الصلاة، وكان يسرهم حتى آخر لحظة: أن
يجعلوه يرجع عن دينه ويتخلى عنه؟
2 ـ
لا ندري لماذا يقال: إن خبيباً هو أول من سن الركعتين،
مع أن المصادر قد ذكرت:
«أن
زيد بن الدثنة أيضاً قد صلى هاتين الركعتين»([46])
وكيف نفسر قول ابن سعد:
«وكانا
قد صليا ركعتين ركعتين قبل أن يقتلا، فخبيب أول من سن ركعتين عند القتل»([47])؟
وذكر الواقدي:
أنهما التقيا في التنعيم؛ فأوصى كل منهما الآخر بالصبر، ثم افترقا([48]).
ويظهر من الرواية المتقدمة:
أن قتل زيد بن الدثنة كان أسبق من قتل خبيب([49]).
إذاً، فما معنى أن يقال:
إن خبيباً هو أول من سن الصلاة حين القتل؟
3 ـ
ثم إنهم يقولون: إن زيد بن حارثة هو الآخر حين أراد أحد الأشرار قتله
قد صلى ركعتين، ثم دعا الله سبحانه؛ فخلصه الله منه([50]).
قال مغلطاي:
«وصلى
خبيب قبل قتله ركعتين فكان أول من سنهما، وقيل: أسامة بن زيد حين أراد
المكري الغدر به كذا ذكره بعضهم وكان الصواب زيد»([51]).
قال في النور:
والمعروف أن زيد بن حارثة صلاهما قبل خبيب بزمن طويل.
وفي الينبوع:
إن قصة زيد بن حارثة
«رضي
الله تعالى عنهما»
كانت قبل الهجرة([52]).
4 ـ
هل يصح أن يقال: إن خبيباً قد سن صلاة كذا؟ وهل يحق لغير الرسول أن
يشرع من عند نفسه؟ وهل يحق للآخرين أن يقتدوا به؟!
وقد حاول البعض أن يجيب على هذا
السؤال فقال:
«وإنما
صار فعل خبيب سنة، والسنة إنما هي أقوال رسول الله «صلى الله عليه
وآله» وأفعاله وتقريره؛ لأنه فعله في حياته «صلى الله عليه وآله»،
فاستحسن ذلك من فعله، واستحسنها المسلمون، والصلاة خير ما ختم به عمل
العبد»([53]).
ونقول لهؤلاء:
ألف:
إن كلامهم يبقى مجرد دعوى بلا دليل ولا شاهد؛ إذ لا بد من إثبات أن ذلك
قد بلغ رسول الله «صلى الله عليه وآله» أولاً، ثم إثبات: أن الرسول
«صلى الله عليه وآله» قد استحسن ذلك من فعله ثانياً،
وليس لدينا ما يثبت ذلك ولو حتى رواية واحدة.
ب:
إنه لم يثبت أن المسلمين قد استحسنوا ذلك، ولو قبلنا ذلك؛ فإن استحسان
المسلمين لا يصير تشريعاً.
ج:
إن كون الصلاة خير ما ختم به عمل العبد صحيح في نفسه، ولكن جعل ذلك في
وقت معين وحالة معينة بحيث يصبح من التشريعات والسنن، يكون خلاف الشرع،
ولا يجوز ارتكابه، لأنه تشريع وتقوُّل على الله سبحانه.
والصحيح هو:
أن يقال هنا: إن خبيباً أو زيداً
لم يفعلا ذلك بقصد التشريع، ولا إحداث سُنَّة،
وإنما أحبا أن يختم عملهما بالصلاة التي هي عمود الدين، ففعلا ذلك وقد
اقتدى الآخرون بفعلهما، لا بقصد فعل ما هو مشرع ومسنون أيضاً.
وبينما نجد الروايات المتقدمة تقول:
إن خبيباً أسر يوم الرجيع، نجد ابن دريد يقول:
«ومنهم
خبيب بن عدي أسر يوم الأحزاب، وقتلته قريش بمكة وصلبوه»([54]).
وأخيراً فإننا لم نستطع أن نفهم
معنى قول خبيب:
اللهم بلغنا رسالة رسولك، فبلغه الغداة ما أتى إلينا.
فهل طلب النبي «صلى الله عليه وآله» منهم أن يوصلوا
رسالته إلى أحد؟ ولمن كان «صلى الله عليه وآله» قد أرسل تلك الرسالة؟
وما يذكر من أحداث في هذه الرواية يدل على أن أصحاب
الرجيع قد قتلوا في الطريق، وقبل أن يصلوا إلى أي قبيلة أو بلد يمكنهم
إبلاغ رسالة رسولهم فيه.
ثم إننا لم نفهم وجه الربط بين هذه الكلمة من هؤلاء،
ودعواهم تبليغ رسالة الرسول، وبين إنكار المنافقين لذلك، حين قالوا: لا
هم قعدوا في أهليهم، ولا هم أدوا رسالة صاحبهم.
كما أن قول المنافقين الآنف الذكر يدل على أنهم كانوا
متبرعين بالذهاب.
وحسبنا ما ذكرناه هنا،
فإن ذلك كله يكشف عن مدى التلاعب والتزوير للحقائق، ويجعلنا نفقد الثقة
فيما يدَّعى
أنه تاريخ وحديث لدى البعض بصورة عامة.
وأخيراً.. فقد قال ابن دريد:
«وكان
معاوية يقول: إني لأذكر دعوة خبيب، فأتطأطأ مخافة أن تصيبني، والله ما
كنت بلغت، ولكن جاء رجل من قريش ـ سماه ـ فجمع يدي في يده، وفيها حربة،
ثم طعنه بها
الخ..»([55]).
ولكن من الواضح،
أن معاوية قد ولد قبل البعثة بخمس سنين، وقيل: بسبع،
وقيل:
بثلاث عشرة([56]).
ومعنى هذا هو:
أن عمره كان حين قتل خبيب لو كان قتل في السنة الرابعة من الهجرة، لا
بعد ذلك، كان اثنين وعشرين، أو أربع وعشرين، أو ثلاثين سنة، فكيف يقول:
إنه حين قتل خبيب لم يكن قد بلغ؟!
بقي أن نشير إلى الأمور الثلاثة التالية:
وقد لاحظنا:
أن ابن هشام يقول بالنسبة للأشعار المنسوبة لخبيب بن
عدي، وحسان بن ثابت: إن أهل العلم بالشعر، أو بعضهم، ينكر أن تكون هذه
الأشعار أو تلك لخبيب أو لحسان.
بل إن ابن هشام يصرح:
بأنه قد ترك ذكر أشعار أخرى تنسب لحسان، بسبب إنكار العلماء بالشعر، أو
بعضهم نسبتها لحسان.
الأمر الذي يعطي:
أنه قد كان ثمة شكوك منذ الصدر الأول تراود أذهان
العلماء في هذا المجال، وأنهم كانوا يشعرون بوجود تعمد وإصرار على نظم
أشعار ونسبتها إلى خبيب تارة وإلى حسان أخرى.
وإن ذلك لمريب حقاً،
وأي مريب.
ومن يراجع النصوص الروائية
والتاريخية يتضح له:
أن خبيب بن عدي هو محط الاهتمام، والحائز على أوسمة التبجيل والإكرام،
وهو الذي ترثيه الشعراء، وتظهر له الكرامات وتبرز له الفضائل.
بل ذكروا:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال يوم قتل خبيب: خبيب
قتلته قريش، ولا ندري أذكر زيداً
أم لا([57]).
فهل سبب ذلك:
أنه كان أفضل من زيد بن الدثنة وأعلم وأعبد؟!
أم أن سبب ذلك هو:
أن العلماء يشكون في أمر زيد بن الدثنة، ويرون أنه لم يقتل مع خبيب؟!
أم أنه قد كان ثمة من يهتم بأمر خبيب، والتركيز عليه
لقرابة له معه، أو لهوى سياسي له يخوله الاستفادة من استشهاد خبيب
لتثبيت أمر فريق، وتقوية مركزه في مقابل الفرقاء الآخرين.
أم أنه قد كان ثمة أهداف ومرام أخرى؟!
إن التاريخ لم يفصح لنا عن شيء من ذلك، ولسوف تبقى تلك
الأسئلة وسواها تراود أذهاننا، حتى
نجد
الإجابة الصريحة، والمقنعة والمفيدة.
ونلاحظ:
أن شخصية عاصم بن ثابت بن الأقلح
تظهر كذلك على أنها متميزة على من عداها من أولئك الذين استشهدوا في
قضية الرجيع، فهو أمير السرية عند البعض، وهو الوحيد الذي قتل رجلاً،
وجرح رجلين، بل لقد كان عنده سبعة أسهم، فقتل بكل سهم رجلاً
من عظمائهم، وهو الذي يرفض قبول طلب الأعداء، فيقتدي به الآخرون وهو
الذي حمت رأسه الدبر، ويحتمله السيل، وهو الذي يقرضه الخليفة الثاني
عمر بن الخطاب
الخ..
وعاصم وإن كان شهيداً
مغفوراً
له، وله الدرجات العلى عند الله، لكن الباحث قد تراوده بعض الشكوك في
الموارد التي يرى أنها خارجة عن المألوف والمعروف،
وقد يكون سر التكرم بالأوسمة على عاصم، هو أنه كان خال عاصم بن عمر بن
الخطاب لأن أم عاصم بن عمر هي جميلة بنت ثابت، فيكون عاصم أخاها([58]).
ووهم البعض فادعى:
أنه جد عاصم بن عمر([59])
والصحيح هو ما ذكرناه
.
([1])
السيرة النبوية لدحلان ج1 ص255 وراجع: تاريخ الخميس ج1 ص451
والسيرة الحلبية ج3 ص165، 166 وزاد المعاد ج2 ص109 والبداية
والنهاية ج4 ص62 و63 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص123 و125
وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ج1 ص187 و189 وبهجة المحافل
ج1 ص218 وفتح الباري ج7 ص291 وحلية الأولياء ج1 ص112 وصفة
الصفوة ج1 ص619= = وصحيح البخاري ج2 ص114 وج 3 ص18 وأسد الغابة
ج2 ص103 ومسند أحمد ج2 ص284 و310.
([2])
السيرة الحلبية ج3 ص166.
([3])
راجع: ما ذكرناه حول تناقضات الرواية الفقرة رقم: ألف.
([4])
راجع: مغازي الواقدي ج1 ص357 والسيرة الحلبية ج3 ص166 والسيرة
النبوية لدحلان ج1 ص256 وطبقات ابن سعد ج2 ص56 والسيرة النبوية
لابن كثير ج3 ص131 والبداية والنهاية ج4 ص67 وتاريخ الخميس ج1
ص456.
([5])
راجع: السيرة النبوية لدحلان ج1 ص254 والمواهب اللدنية ج1 ص100
وسيرة مغلطاي ص51 وطبقات ابن سعد ج2 ص50 وتاريخ الخميس ج1 ص450
والتنبيه والإشراف ص212.
([6])
تاريخ الخميس ج1 ص451 عن الوفاء والمحبر ص119 وذكره بلفظ قيل
في التنبيه والإشراف ص212.
([7])
السيرة النبوية لابن كثير ج3 ص267 والبداية والنهاية ج4 ص140.
([8])
السيرة النبوية لابن كثير ج3 ص261 والبداية والنهاية ج4 ص137.
([9])
أنساب الأشراف ج1 ص376 (قسم حياة النبي «صلى الله عليه وآله»).
([10])
تاريخ الأمم والملوك (ط دار المعارف) ج2 ص540 والأغاني ج4 ص228
وراجع: المواهب اللدنية ج1 ص102 والسيرة النبوية لابن كثير ج3
ص124 و 125 والبداية والنهاية ج4 ص63 وتاريخ الإسلام للذهبي
(المغازي) ج1 ص188 وبهجة المحافل ج1 ص220 والسيرة الحلبية ج3
ص170 وتاريخ الخميس ج1 ص455 وأسد الغابة ج2 ص104 وصحيح البخاري
ج2 ص115 وج 3 ص19 ومسند أحمد ج2 ص395 و 311.
([11])
فتح الباري ج7 ص295 والسيرة الحلبية ج3 ص170.
([12])
تاريخ الخميس ج1 ص455 وشرح بهجة المحافل ج1 ص220 عن البغوي.
([13])
تاريخ الخميس ج1 ص455.
([14])
المواهب اللدنية ج1 ص102 و87 والسيرة النبوية لابن هشام ومغازي
الواقدي ج1 ص148 و 282 و 138 والبحار ج19 ص347 وعمدة القاري
ج17 ص99 و 169 وفتح الباري ج7 ص240.
([15])
راجع: السيرة النبوية لابن هشام ج2 ص298 بلفظ قيل، والبحار ج19
ص260 وتفسير القمي ج1 ص269، ومن دون ترديد وكذا في الدر
المنثور ج5 ص69 عن عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر وغيرهما.
([16])
الفتوح لابن أعثم ج3 ص191 وراجع: صفين للمنقري ص417 وفيه:
(الجمل) وهو غلط.
([17])
تاريخ ابن الوردي ج1 ص158.
([18])
الإستيعاب بهامش الإصابة ج1 ص431.
([19])
مغازي الواقدي ج1 ص357 وطبقات ابن سعد ج3 ص455.
([20])
طبقات ابن سعد (ط دار صادر) ج3 ص455.
([21])
تاريخ الأمم والملوك (ط دار المعارف) ج2 ص540 والأغاني ج4 ص228
والكامل في التاريخ ج2 ص167.
([22])
البداية والنهاية ج4 ص62 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص124
والروض الأنف ج3 ص234 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ج1 ص188
وبهجة المحافل ج1 ص218 والسيرة الحلبية ج3 ص166 وتاريخ الخميس
ج1 ص456 وفتح الباري ج7 ص293 والإصابة ج1 ص418 والإستيعاب
بهامشه ج1 ص429 و 431 وأسد الغابة ج2 ص104 وصحيح البخاري ج2
ص115 وج 3 ص18 ومسند أحمد ج2 ص294 و 310 وصفة الصفوة ج1 ص620
وحلية الأولياء ج1 ص112 وجمهرة أنساب العرب ص116 وراجع: عمدة
القاري ج17 ص100 و 168.
([23])
السيرة النبوية لدحلان ج1 ص256.
([25])
شرح بهجة المحافل ج1 ص218 والسيرة الحلبية ج3 ص166 و 167 وفتح
الباري ج7 ص293 وعمدة القاري ج17 ص168 و100.
([26])
شرح بهجة المحافل ج1 ص218 والسيرة الحلبية ج3 ص166 وفتح الباري
ج7 ص293 وراجع: شرح النهج للمعتزلي ج14 ص134 وفيه: أنه قتله
وهو لا يعرفه وراجع: نسب قريش لمصعب ص204 وأنساب الأشراف (قسم
حياة النبي «صلى الله عليه وآله») ج1 ص154 وعمدة القاري ج17
ص100 و168.
([27])
السيرة الحلبية ج3 ص166.
([28])
راجع: السيرة الحلبية ج3 ص167 وفتح الباري ج7 ص293.
([29])
عمدة القاري ج17 ص100.
([30])
الآيات 204 ـ 206 من سورة البقرة.
([31])
الآية 207 من سورة البقرة.
([32])
راجع: السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص183 و 184 والسيرة النبوية
لابن كثير ج3 ص132 والبداية والنهاية ج4 ص67 وراجع البدء
والتاريخ ج4 ص211 والجامع لأحكام القرآن ج3 ص21 بلفظ: قيل.
([33])
الروض الأنف ج3 ص237 ونزول الآيات في الأخنس بن شريق مذكور في
كثير من المصادر الروائية والتفسيرية، فراجع.
([34])
راجع: السيرة الحلبية ج3 ص168 وبهجة المحافل ج1 ص220 و 221
وتاريخ الخميس ج1 ص458 وكلام الفضل بن روزبهان في دلائل الصدق
ج2 ص81.
([35])
الروض الأنف ج3 ص237 والسيرة الحلبية ج3 ص168 وج 2 ص23 و 24
وتاريخ الخميس ج1 ص458 والإصابة ج2 والدر المنثور ج1 ص204 عن
عدد من المصادر.
([36])
قد ذكرنا في الجزء الثالث من هذا الكتاب طائفة كبيرة من
المصادر لهذه القضية فلتراجع هناك في فصل هجرة الرسول الأعظم.
([37])
تاريخ الخميس ج1 ص456 والإشتقاق ص442 باستثناء العبارة
الأخيرة.
([38])
طبقات ابن سعد ج8 ص302.
([39])
السيرة النبوية لدحلان ج1 ص256 وراجع: فتح الباري ج7 ص295
وعمدة القاري ج17 ص169 وراجع: تاريخ الخميس ج1 ص456 والمواهب
اللدنية ج1 ص101 ولكنه لم يستثن ممن هلك أحداً.
([40])
مغازي الواقدي ج1 ص360.
([41])
السيرة الحلبية ج3 ص167.
([42])
مقتل الحسين للخوارزمي ج2 ص34 ومقتل الحسين للمقرم ص339 و 340
عنه وعن نفس المهموم ص189 وعن مقتل العوالم ص98.
([43])
السيرة النبوية لدحلان ج1 ص256 عن الزرقاني وشرح بهجة المحافل
ج1 ص219 عن السهيلي.
([44])
تقدمت المصادر لذلك.
([45])
الروض الأنف ج3 ص235.
([46])
راجع: طبقات ابن سعد ج2 ص56 ومغازي الواقدي ج1 ص362.
([47])
طبقات ابن سعد ج2 ص56.
([48])
مغازي الواقدي ج1 ص362.
تنبيه: ذكر في الكامل في التاريخ ج2 ص168: أنهم لما خرجوا
بخبيب من الحرم ليقتلوه، قال: ردوني أصلي ركعتين؛ فتركوه
فصلاهما إلخ..
والصحيح: ذروني (كما في تاريخ الأمم والملوك (ط دار المعارف)
ج2 ص456) وهو المناسب لقوله: فتركوه الخ..
([49])
راجع أيضاً: السيرة النبوية لدحلان ج1 ص256.
ولكن
سياق كلام الدياربكري يفيد: أن قتل خبيب كان أسبق: (راجع:
تاريخ الخميس ج1 ص458) ويبدو أنه قد استفاد ذلك من كون خبيب
أول من سن الصلاة عند القتل.
([50])
راجع: السيرة الحلبية ج3 ص169 وزاد المعاد ج2 ص109 والسيرة
النبوية لابن كثير ج3 ص130 والبداية والنهاية ج4 ص65 وتاريخ
الخميس ج1 ص457 والمواهب اللدنية ج1 ص102 والروض الأنف ج3
ص235.
([52])
السيرة الحلبية ج3 ص169.
([53])
المواهب اللدنية ج1 ص102 والروض الأنف ج3 ص235.
([56])
راجع: الإصابة ج3 ص433.
([57])
عمدة القاري ج17 ص101.
([58])
إرشاد الساري ج6 ص312 وراجع: فتح الباري ج7 ص240 و 292 وعمدة
القاري ج17 ص168.
([59])
صحيح البخاري ج2 ص114 وج 3 ص18 ومسند أحمد ج2 ص294 و 310 وحلية
الأولياء ج1 ص112 والبداية والنهاية ج4 ص62 والسيرة النبوية
لابن كثير ج3 ص123 وفتح الباري ج7 ص240 وأسد الغابة ج2 ص103
وأنساب الأشراف (قسم حياة النبي «صلى الله عليه وآله») ج1 ص428
والمواهب اللدنية ج1 ص87 وعمدة القاري ج17 ص168.
|