|
النصوص وتناقضاتها
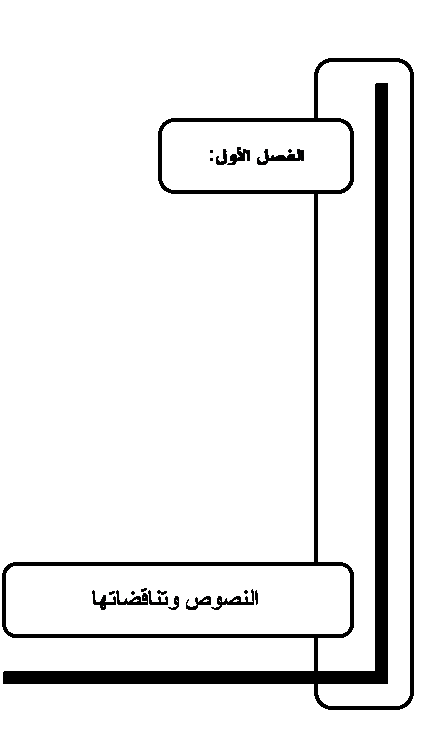
نص الرواية:
ويقولون:
إن سرية بئر
معونة([1])
كانت في السنة الرابعة في المحرم، كما قال البعض([2]).
وقد اختلفت الروايات في بيان حقيقة ما جرى، ونحن نذكر
أولاً
نص الطبري الذي قال:
قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر، ملاعب الأسنة ـ
وكان سيد بني عامر بن صعصعة ـ على رسول الله «صلى الله عليه وآله»
المدينة، وأهدى له هدية، فأبى رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن
يقبلها، وقال: يا أبا براء، لا أقبل هدية مشرك، فأسلم إن أردت أن أقبل
هديتك. ثم عرض عليه الإسلام، وأخبره بما له فيه، وما وعد الله المؤمنين
من الثواب، وقرأ عليه القرآن فلم يسلم ولم يبعد، وقال: يا محمد إن أمرك
هذا الذي تدعو إليه حسن جميل، فلو بعثت رجالاً
من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
إني أخشى عليهم أهل نجد! فقال أبو براء: أنا لهم جار، فابعثهم فليدعوا
الناس إلى أمرك.
فبعث رسول
الله «صلى الله عليه وآله» المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة المعنق([3])
ليموت في أربعين رجلاً
من أصحابه من خيار المسلمين؛ منهم الحارث بن الصمة، وحرام بن ملحان أخو
بني عدي النجار، وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي، ونافع بن بديل بن
ورقاء الخزاعي، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر؛ في رجال مسمين من خيار
المسلمين([4]).
فحدثنا ابن حميد، قال:
حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن حميد الطويل،
عن أنس بن مالك، قال: بعث رسول الله «صلى الله عليه وآله» المنذر بن
عمرو في سبعين راكباً،
فساروا حتى نزلوا بئر معونة ـ وهي أرض بين أرض بني عامر وحرة بني سليم،
كلا البلدين منها قريب، وهي إلى حرة بني سليم أقرب ـ فلما نزلوها بعثوا
حرام بن ملحان بكتاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى عامر بن
الطفيل، فلما أتاه لم ينظر في كتابه، حتى عدا على الرجل فقتله، ثم
استصرخ عليهم بني عامر، فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه، وقالوا: لن
نخفر أبا براء، قد عقد لهم عقداً
وجواراً.
فاستصرخ عليهم قبائل من بني سُليم:
عُصيّة، ورعلاً،
وذكوان، فأجابوه إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم، فأحاطوا بهم في
رحالهم، فلما رأوهم أخذوا السيوف، ثم قاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم، إلا
كعب بن زيد أخا بني دينار بن النجار، فإنهم تركوه وبه رمق، فارتث([5])
من بين القتلى، فعاش حتى قتل يوم الخندق.
وكان في سرح
القوم عمرو بن أمية الضمري، ورجل([6])
من الأنصار أحد بني عمرو بن عوف، فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير
تحوم على العسكر، فقالا: والله إن لهذه الطير لشأناً،
فأقبلا لينظرا إليه، فإذا القوم في دمائهم، وإذا الخيل التي أصابتهم
واقفة.
فقال الأنصاري لعمرو بن أمية:
ماذا ترى؟
قال:
أرى أن تلحق برسول الله «صلى الله عليه وآله» فتخبره
الخبر، فقال الأنصاري: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر
بن عمرو، وما كنت لتخبرني عنه الرجال. ثم قاتل القوم حتى قتل.
وأخذوا عمرو بن أمية أسيراً،
فلما أخبرهم أنه من مضر، أطلقه عامر بن الطفيل، وجز ناصيته، وأعتقه عن
رقبة زعم أنها كانت على أمه.
فخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة،
أقبل رجلان من بني عامر حتى نزلا معه في ظل هو فيه؛ وكان مع العامريين
عقد من رسول الله «صلى الله عليه وآله» وجوار لم يعلم به عمرو بن أمية،
وقد سألهما حين نزلا: ممن أنتما؟
فقالا:
من بني عامر،
فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما، وهو يرى أنه قد أصاب بهما
ثؤرة([7])
من بني عامر، بما أصابوا من أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله».
فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله «صلى الله عليه
وآله» أخبره الخبر، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: لقد قتلت
قتيلين لأدينهما.
ثم قال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
هذا عمل أبي براء؛ قد كنت لهذا كارهاً
متخوفاً.
فبلغ ذلك أبا
براء فشق عليه إخفار عامر إياه، وما أصاب رسول الله «صلى الله عليه
وآله» بسببه وجواره وكان فيمن أصيب عامر بن فهيرة([8]).
حدثنا ابن حميد، قال:
حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن
أبيه، أن عامر بن الطفيل كان يقول: إن الرجل منهم لما قتل رأيته رفع
بين السماء والأرض حتى رأيت السماء من دونه.
قالوا: هو عامر بن فهيرة([9]).
حدثنا ابن حميد، قال:
حدثنا سلمة،
قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن أحد بني جعفر، رجل من بني جبار بن سلمى
بن مالك بن جعفر، قال: كان جبار فيمن حضرها([10])
يومئذ مع عامر، ثم أسلم بعد ذلك.
قال:
فكان يقول مما دعاني إلى الإسلام أني طعنت رجلاً
منهم يومئذ بالرمح بين كتفيه، فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره،
فسمعته يقول حين طعنته: فزت والله!
قال:
فقلت في نفسي: ما فاز! أليس قد قتلت الرجل؟!
حتى سألت بعد ذلك عن قوله.
فقالوا:
الشهادة.
قال:
فقلت: فاز لعمرو الله!
فقال حسان بن
ثابت([11])
يحرض بني أبي البراء على عامر بن الطفيل:
بـنـي أم البنين ألـم يـرعــكـــم
وأنـتـم مـن ذوائـب أهـل نـجـد
تـهـكـم عـامـر بـأبـي بــــــراء ليـخـفـره، ومــا خـطـأ
كـعـمـد
ألا أبـلـغ ربـيـعـة ذا المســــاعي فمـا أحـدثت في الحدثـان
بعدي([12])
أبـوك أبـو الحـروب أبـو بــــراء وخـالك مـاجد حـكـم بـن سعد
وقال كعب بن مالك في ذلك أيضاً:
لـقـد طـارت شعـاعـاً كل وجـه فــارة مـــا أجــار أبــو
بــــراء
فـمـثـل مسـهـب وبـنـي أبـيــه بـجـنـب الـرَّده من كنفي
سـواء([13])
بـنـي أم الـبـنـيـن أمـا سمعتــم دعـاء المسـتـغـيـث مـع
المســاء!
وتـنـويـه الصريـخ بـلى ولـكـن عـرفـتـم أنـه صـدق
الـلـقــــاء
فـمـا صفرت عياب بني كـلاب ولا القـرطــاء مـن ذم الــوفـــاء
أعـامـر عـامـر السـوءات قدماً فـلا بـالفعـل فـزت ولا
الـسنـاء
أأخـفـرت النبي وكـنـت قـدمـاً إلى السوءات تـجـري
بـالـعـراء ؟
فـلـست كجـار جـار أبـي داودٍ ولا الأســدي جــار أبـي
العـلاء
ولـكـن عـاركـم داء قـديــــم وداء الـغـدر فـاعـلــم
شــر داء
فلما بلغ ربيعة بن عامر أبي البراء قول حسان وقول كعب،
حمل على عامر بن الطفيل فطعنه، فشطب الرمح عن مقتله، فخر عن فرسه.
فقال:
هذا عمل أبي براء! إن مت فدمي لعمي ولا يتبعن به،
وإن أعش فسأرى رأيي فيما أتى إليَّ([14]).
حدثني محمد بن مرزوق، حدثنا عمرو بن يونس، عن عكرمة،
قال: حدثنا إسحاق بن أبي طلحة، قال: حدثني أنس بن مالك في أصحاب النبي
الذين أرسلهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى أهل بئر معونة.
قال:
لا أدري، أربعين أو سبعين وعلى ذلك الماء عامر بن
الطفيل الجعفري، فخرج أولئك النفر من أصحاب النبي «صلى الله عليه وآله»
الذين بعثوا؛ حتى أتوا غاراً
مشرفاً
على الماء قعدوا فيه.
ثم قال بعضهم لبعض:
أيكم يبلغ رسالة رسول الله «صلى الله عليه وآله» أهل
هذا الماء؟
فقال ـ أراه ابن ملحان الأنصاري ـ :
أنا أبلغ رسالة رسول الله «صلى الله عليه وآله».
فخرج حتى أتى حواء منهم، فاحتبى
أمام البيوت، ثم قال:
يا أهل بئر معونة، إني رسول رسول الله إليكم، إني أشهد
أن لا إله إلا الله وأن محمداً
عبده ورسوله فآمنوا بالله ورسوله.
فَخُرِج إليه من كسر البيت برمح، فَضُرِب به في جنبه
حتى خرج من الشق الآخر، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فاتبعوا أثره
حتى أتوا أصحابه في الغار، فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل.
قال إسحاق:
حدثني أنس بن مالك أن الله عز وجل أنزل فيهم قرآناً:
«بلِّغوا
عنا قومنا
أنَّا
قد لقينا ربنا، فرضي عنا، ورضينا عنه».
ثم نسخت، فرفعت بعدما قرأناه زماناً،
وأنزل الله عز وجل:
﴿وَلاَ
تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ الله أَمْوَاتاً بَلْ
أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ..﴾([15]).
حدثني العباس بن الوليد، قال:
حدثني أبي قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني إسحاق بن
عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله
«صلى الله عليه وآله» إلى عامر بن الطفيل الكلابي سبعين رجلاً
من الأنصار قال: فقال أميرهم: مكانكم حتى آتيكم بخبر القوم!
فلما جاءهم قال:
أتؤمنونني حتى أخبركم برسالة رسول الله «صلى الله عليه
وآله»؟
قالوا:
نعم، فبينا هو عندهم، إذ وخزه رجل منهم بالسنان: قال:
فقال الرجل:
فزت ورب الكعبة! فقتل.
فقال:
عامر: لا أحسبه إلا أن له أصحاباً،
فاقتصوا أثره حتى أتوهم فقتلوهم، فلم يفلت منهم إلا رجل واحد.
قال أنس:
فكنا نقرأ فيما نسخ:
«بلغوا
عنا إخواننا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه»([16]).
وتقول الروايات:
إنه «صلى الله عليه وآله» قنت شهراً
في صلاة الغداة يدعو على رعل وذكوان وعصية.
وثمة نص آخر، عن سهل بن سعد، ملخصه:
أن عامر بن الطفيل قدم على النبي «صلى الله عليه وآله»
المدينة، فراجع النبي «صلى الله عليه وآله» وارتفع صوته، وثابت بن قيس
قائم بسيفه على النبي «صلى الله عليه وآله»، فأمره بغض صوته، وجرى
بينهما كلام.
فعطس ابن أخ لعامر، فحمد الله، فسمّته النبي «صلى الله
عليه وآله»، ثم عطس عامر، فلم يسمّته، فقال عامر: سمّت هذا الصبي، ولم
تسمّتني؟!
فقال «صلى الله عليه وآله»:
إن هذا حمد الله.
قال:
ومحلوفه، لأملأنها عليك خيلاً
ورجالاً.
فقال «صلى الله عليه وآله»:
يكفينيك الله وابنا قيلة.
ثم خرج عامر، فجمع للنبي «صلى الله عليه وآله»، فاجتمع
من بني سليم ثلاثة أبطن هم الذين كان «صلى الله عليه وآله» يدعو عليهم
في صلاة الصبح: اللهم العن لحياناً،
ورعلاً،
وذكوان وعصية، دعا سبع عشرة ليلة.
فلما أن سمع «صلى الله عليه وآله»:
أن عامراً
جمع له، بعث النبي «صلى الله عليه وآله» عشرة، فيهم عمرو بن أمية
الضمري وسائرهم من الأنصار، وأميرهم المنذر بن عمرو.
فمضوا، حتى نزلوا بئر معونة، فأقبل حتى هجم عليهم،
فقتلهم كلهم؛ فلم يفلت منهم إلا عمرو بن أمية، كان في الركاب.
فأخبر الله نبيه بقتلهم، فقال «صلى
الله عليه وآله»:
اللهم اكفني عامراً،
فأقبل حتى نزل بفنائه. فرماه الله بالذبحة في حلقه في بيت امرأة سلولية
فأقبل ينزو ويقول: يا آل عامر، غدة كغدة الجمل في بيت سلولية، يرغب أن
تموت في بيتها، فلم يزل كذلك حتى مات في بيتها.
وكان أربد بن قيس أصابته صاعقة، فاحترق فمات،
فرجع من كان معهم([17]).
وحسب نص ابن طاووس:
أقبل عامر بن الطفيل، وزيد بن قيس، وهما عامريان، أبناء عم، يريدان
رسول الله، وهو في المسجد جالس في نفر من أصحابه.
قال:
فدخلا المسجد، فاستبشر الناس لجمال عامر بن الطفيل،
وكان من أجمل الناس، أعور.
فجعل يسأل:
أين محمد؟ فيخبرونه، فيقصد نحو رجل من أصحاب رسول الله،
فقال: هذا عامر بن الطفيل يا رسول الله.
فأقبل، حتى قام عليه؛ فقال:
أين محمد؟
فقالوا:
هو ذا.
قال:
أنت محمد؟
قال:
نعم.
قال:
ما لي إن أسلمت؟
قال:
لك ما للمسلمين، وعليك ما على المسلمين.
قال:
تجعل لي الأمر بعدك؟
قال:
ليس ذلك لك، ولا لقومك، ولكن ذاك إلى الله، يجعله حيث
يشاء.
قال:
فتجعلني على الوبر ـ يعني الإبل ـ وأنت على المدر؟
قال:
لا.
قال:
فماذا تجعل لي؟
قال:
أجعل لك أعنة الخيل، تغزو عليها، إذ ليس ذلك لي اليوم،
قم معي، فأكلمك.
فقام معه رسول الله «صلى الله عليه وآله» وأوصى (أي
عامر) لزيد بن قيس: أن اضربه.
قال:
فدار زيد بن قيس خلف النبي «صلى الله عليه وآله»؛ فذهب
ليخترط السيف فاخترط منه شبراً،
أو ذراعاً،
فحبسه الله تعالى، فلم يقدر على سله.
فجعل يومئ عامر إليه، فلا يستطيع سله.
فقال رسول الله:
اللهم هذا عامر بن الطفيل أعر (كذا) الدين عن عامر ـ ثلاثاً
ـ ثم التفت فرأى زيداً
وما يصنع بسيفه، فقال: اللهم اكفنيهما.
ثم رجع، وبدر([18])
بهما الناس، فوليا هاربين.
قال:
وأرسل الله
على زيد بن قيس صاعقة فأحرقته([19]).
ورأى عامر بن
الطفيل بيت سلولية، فنزل عليها، فطعن في خنصره فجعل يقول: يا عامر غدة
كغدة البعير وتموت في بيت سلولية، وكان يعتبر([20])
بعضهم بعضاً
بنزوله على سلول ذكراً
كان أو أنثى.
قال:
فدعا عامر بفرسه فركبه، ثم أجراه حتى مات على ظهره
خارجاً
من منزلها. فذلك قول الله عز وجل:
﴿فَيُصِيبُ
بِهَا مَن يَشَاء وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي الله
[في آيات الله]
وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾،
يقول: العقاب.
فقتل عامر بن
الطفيل بالطعنة، وقتل زيد بالصاعقة([21]).
وفي نص آخر:
أن عامراً
كان رئيس المشركين قدم على النبي، فقال: إختر مني ثلاث خصال، يكون لك
السهل ويكون لي أهل الوبر، أو أكون خليفة من بعدك، أو أغزوك بغطفان ألف
أسفر وألف سفراً([22])
قال: فطعن في بيت امرأة من بني فلان
الخ..
وفي الإصابة:
«أن
ربيعة جاء إلى النبي «صلى الله عليه وآله» فقال: يا رسول الله أيغسل عن
أبي هذه الغدرة: أن أضرب عامر بن الطفيل ضربة أو طعنة؟
قال:
نعم، فرجع ربيعة فضرب عامراً
ضربة أشواه منها فوثب عليه قومه فقالوا لعامر بن الطفيل:
اقتص.
فقال:
قد عفوت وعقب ذلك مات أبو براء أسفاً
الخ..»([23]).
وذكروا أيضاً:
أن سبب مجيء ربيعة إلى النبي «صلى الله عليه وآله»
وسؤاله له حسبما تقدم عن الإصابة: أن حسان بن ثابت قال شعراً
يحرضه على عامر بن الطفيل:
ألا مـن مبـلـغ عـنـي ربـيـعـــاً
بمـا قـد أحـدث الحدثـان بـعدي
وخـالـد مـاجـد
الـخ..([24])
فقال ربيعة:
هل يرضى حسان طعنة أطعنها عامراً
قيل: نعم،
فشد عليه فطعنه فعاش منها([25]).
وثمة نصوص أخرى يتضح مخالفتها لما قدمناه مما سيأتي حين
الكلام عن تناقض النصوص.
إن أدنى ملاحظة للنصوص توضح لنا مدى الاختلاف والتناقض
فيما بينها، بشكل يتعذر معه الجمع فيما بينها، وحيث إن استقصاء هذه
الاختلافات والتناقضات أمر يطول، فإننا نلمح إلى بعض الموارد، ونترك
سائرها إلى معاناة القارئ أو الباحث الذي يهمه ذلك، لسبب أو لآخر:
فنقول:
هناك من يقول:
إنها كانت في
السنة الرابعة من المحرم([26]).
وآخرون يقولون:
إنها كانت على رأس ستة وثلاثين شهراً
أي على رأس أربعة أشهر من أحد، في شهر صفر([27]).
أو لعشرين
بقين منه([28]).
وثالث، وهو مكحول، زعم:
أنها كانت بعد
غزوة الخندق([29]).
أما العامري فقد رأى:
أن من الممكن أن تكون في السنة الثالثة حيث قال:
«وفيها،
أو في الرابعة، سرية بئر معونة»([30]).
1 ـ
وحول سبب إرسال السرية نجد الرواية المذكورة في صدر
البحث تقول: إن أبا براء قدم على النبي «صلى الله عليه وآله»، فدعاه
«صلى الله عليه وآله» إلى الإسلام، فلم يسلم،
ولم يبعد، ولكنه طلب من النبي «صلى الله عليه وآله»، أن يرسل دعاته إلى
نجد، وتعهد بأن يكون جاراً
لهم، إن تعرض لهم أحد.
2 ـ
ولكننا نجد في مقابل ذلك من يقول: إن أبا براء بعث إلى
النبي «صلى الله عليه وآله» يقول له:
ابعث
إلي رهطاً
ممن معك، يبلغوني عنك، وهم في جواري، فأرسل إليه «صلى الله عليه وآله»
المنذر بن عمرو
الخ..»([31]).
ومعنى ذلك هو:
أن أبا براء لم يطلب ذلك من النبي «صلى الله عليه وآله» حين قدم عليه.
3 ـ
وجاء في نص ثالث: أن أناساً
جاؤوا إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، فقالوا:
ابعث
معنا رجالاً
يعلموننا القرآن والسنة، فبعث إليهم سبعين رجلاً
من الأنصار.
إلى أن تقول الرواية:
فبعثهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» إليهم، فتعرضوا
لهم،
فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان([32]).
4 ـ
وحسب ما جاء في صحيح البخاري، وغيره، أن رعلاً،
وذكوان وعصية، وبني لحيان، أتوا رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
فزعموا: أنهم أسلموا فاستمدوه على قومهم (عدوهم خ ل)، فأمدهم سبعين
رجلاً
الخ..([33]).
5 ـ
ولكننا نجد رواية أخرى تقول: إنه «صلى الله عليه وآله»
بعث المنذر بن عمرو في هؤلاء الرهط ـ عيناً
له في أهل نجد ـ فسمع بهم عامر بن الطفيل، فاستنفر بني عامر
الخ..([34]).
6 ـ
وآخر ما نذكره
هنا هو: النص الذي يقول: إنه «صلى الله عليه وآله» سمع أن عامر بن
الطفيل قد جمع له، فبعث «صلى الله عليه وآله» عشرة، فيهم عمرو بن أمية،
وسائرهم من الأنصار؛ فأقبل عامر بن الطفيل، حتى هجم عليهم فقتلهم([35]).
ملاحظة:
وقد سجل الدمياطي تحفظاً
على النص الذي رواه البخاري وغيره، وهو المتقدم آنفاً:
وهو أن قوله أتاه رعل وذكوان وعصية، ولحيان، وهم؛ لأن بني لحيان ليسوا
في أصحاب بئر معونة، وإنما هم أصحاب الرجيع، وهو كما قال
الخ..([36]).
وتذكر المصادر المتقدمة:
أن
أمير السرية هو المنذر بن عمرو.
ولكن نصاً آخر يقول:
إن أميرها هو
مرثد بن أبي مرثد([37]).
بل نجد في الطبري رواية تفيد:
أن حرام بن ملحان كان أمير السرية.
وتقول الرواية:
فقال أميرهم: مكانكم، حتى آتيكم بخبر القوم.
ثم تذكر الرواية:
ذهابه إليهم، وغدرهم به، وقتلهم إياه على النحو الذي سبق([38]).
مع أن الروايات متفقة:
على أن الذي جاءهم وغدروا به هو حرام بن ملحان.
وقد تقدم:
أن الروايات مختلفة في عدد أفراد السرية هل هم سبعون أو
أربعون؟
بل إن أنس بن مالك كان متردداً
أيضاً، فهو يقول:
«لا
أدري، في أربعين أو سبعين»([39]).
وبعض الروايات تقول:
زهاء سبعين([40]).
ورواية ثالثة تذكر:
أنهم كانوا ثلاثين رجلاً،
أربعة من المهاجرين والباقون من الأنصار([41]).
ورابعة تقول:
كانوا عشرة
فقط، منهم عمرو بن أمية ـ فقط ـ من المهاجرين([42]).
وخامسة:
تحدد عددهم ب
«اثنين
وعشرين راكباً».
واحتمل الذهبي:
أن يكون قد عد
الركاب دون الرجالة([43]).
ونقول:
وهو خلاف ظاهر الحصر.
كما أن رواية العشرة، ورواية الإثنين والعشرين ورواية
الأربعين، تبقى على حالها، فإن احتمال الذهبي لا يجدي في رفع تناقضها.
أضف إلى ذلك:
أن رواية السبعين أيضاً تصرح بكونهم ركباناً([44]).
ورواية سادسة تذكر:
أنهم كانوا تسعة وعشرين رجلاً([45]).
وسابعة تقول:
إن عدتهم أربعة عشر رجلاً([46]).
وثامنة تقول:
إنهم كانوا أربعة وخمسين رجلاً.
وتاسعة تقول:
كانوا سبعة وعشرين رجلاً.
ولعلها لا تخلتف عن رواية التسعة والعشرين، لتقارب رسم
الخط فيهما.
ورواية عاشرة تقول:
كانوا أربعة وعشرين رجلاً([47]).
هـ
: لم يكن في السرية إلا أنصاري:
وفي حين نجد
الروايات تصرح بوجود أربعة من المهاجرين في السرية مثل عامر بن فهيرة،
والحكم بن كيسان المخزومي، ونافع بن بديل بن ورقاء السهمي، بل وحتى سعد
بن أبي وقاص([48])،
فإننا نجد البعض يصرح:
بأنه لم يكن في هذه السرية إلا أنصاري.
قال الواقدي:
وهذا الثبت
عندنا([49]).
مع أن الواقدي نفسه قد صرح بأسماء المهاجرين الآنفة الذكر([50]).
واستثنى البعض
خصوص عمرو بن أمية دون سواه([51]).
ولعل منشأ تخصيص الأنصار بذلك هو
رواية أنس التي تقول:
ذكر أنس سبعين
من الأنصار، كانوا إذا جنّهم الليل أووا إلى معلم بالمدينة ثم تذكر
الرواية إرسالهم إلى بئر معونة([52]).
وقد تقدم:
أن عامر بن الطفيل لم ينظر في كتاب رسول الله «صلى الله
عليه وآله» حتى عدا على حرام بن ملحان؛ فقتله، وهذا هو صريح رواية
اليعقوبي أيضاً، وابن إسحاق، كما عند دحلان.
ولكن رواية أخرى تقول:
إن رجلاً
خرج من كسر البيت، أو من خلفه، فقتله([53]).
وعند الواقدي:
أن الذي قتله
هو جبار بن سلمى الكلابي([54]).
وقيل:
إنه لم يمت من
طعنة عامر بن الطفيل، وإنما أثخن، وظنوا أنه مات فكان عند امرأة تداوي
جراحه كما سيأتي([55]).
ملاحظة:
لعل القول بأن قاتله هو جبار بن سلمى قد نشأ عن الخلط
بينه وبين عامر بن فهيرة، كما سنرى إن شاء الله تعالى.
وقد تقدم:
أن المشركين بعد قتلهم لحرام قد توجهوا إلى المسلمين،
حتى غشوهم، فأحاطوا بهم وهم في رحالهم، فلما رأوهم أخذوا السيوف،
فقاتلوهم.
ولكن نصاً آخر يقول:
إن المسلمين
استبطأوا صاحبهم، فأقبلوا في أثره فلقيهم عامر، فأحاطت بهم بنو عامر،
وكاثروهم حتى قتلوهم([56]).
ونجد في الروايات:
أن عامر بن
الطفيل هو الذي قتل عامر بن فهيرة([57]).
ولكننا نجد نصاً آخر يقول:
إن الذي قتله
هو رجل من بني كلاب([58]).
ويصرح الواقدي:
أن ابن الطفيل
قد نسب قتله إلى ذلك الرجل أيضاً([59]).
وقد سمته بعض
الروايات بجبار بن سلمى([60]).
ملاحظة:
لقد حاول
البعض الجمع بين الروايات بأن نسبة القتل إلى عامر بن الطفيل قد جاء
على سبيل التجوز، لكونه كان رأس القوم([61]).
ونقول:
لو صح ذلك لكان ينبغي نسبة قتل غير ابن فهيرة إلى عامر
أيضاً فلماذا اقتصر الرواة على نسبة قتل ابن فهيرة إلى ابن الطفيل؟!
قد ذكرت الروايات المتقدمة:
أن عمرو بن أمية كان في سرح القوم مع رجل آخر.
وتقول بعض الروايات:
إن ذلك الآخر كان أنصارياً
أحد بني عمرو بن عوف.
ولكننا نجد:
أن بعض الروايات قد سمت هذا الآخر
بـ «الحارث
بن الصمة»([62]).
وسماه بعض آخر
بـ «المنذر
بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح»([63]).
قد تقدمت الرواية التي تقول:
إن الناجي
من القتل هو ـ فقط ـ عمرو بن أمية الضمري([64]).
وأضافت رواية أخرى إلى عمرو بن أمية رجلاً
آخر هو كعب بن زيد، الذي استشهد يوم الخندق([65])،
وقالوا: بأنه ارتث بين القتلى.
وعند الزمخشري وغيره:
أن ثلاثة قد
نجوا من القتل([66]).
ونص رابع يقول:
إن رجلاً
أعرج ـ فقط ـ قد نجا من القتل([67])
وصرح البعض بأنه كعب بن زيد([68]).
أما اليعقوبي فيقول:
إن الناجي هو
أسعد بن زيد، حيث أعتقه عامر بن الطفيل عن رقبة كانت على أمه ولم يذكر
عمرو بن أمية ولا غيره([69]).
ونص سادس يقول:
إن سعد بن أبي
وقاص قد نجا أيضاً([70]).
وسابع يقول:
إن أصحاب بئر معونة قتلوا جميعاً([71]).
وفي نص آخر:
ما بقي منهم
مخبر([72]).
ويذكر نص ثامن:
أن المنذر بن
عمرو أمير السرية، أمر أربعة فذهبوا إلى بعض مياههم، فلما رجعوا إذا هم
بنسور تحوم، فآثر اثنان منهم الموت، فقاتلا حتى قتلا، ورجع اثنان منهم
إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»([73]).
لكن نصاً آخر يذكر:
أن عمرو بن أمية ورجلاً
آخر كانا في سرح القوم، فعادا فوجدا نسوراً
تحوم، فقاتل أحدهما،
فيقال:
إنه قتل أربعة من المشركين.
وعند الواقدي:
أن هذا الرجل
هو الحارث بن الصمة، وأنه قتل رجلين فقط([74])
ثم قتل،
وأسر عمرو بن
أمية، ثم أطلق، ورجع وحده([75]).
وفي بعض المصادر:
انطلق حرام ورجلان معه، أحدهما أعرج، فقال: كونا قريباً
مني حتى آتيهم.
إلى أن قال:
وقتل كلهم إلا
الأعرج كان في رأس الجبل([76]).
وفي بعض المصادر:
أن اللذين
كانا مع حرام كانا من بني أمية([77]).
وقد تقدم تسمية الأعرج بأنه كعب بن زيد من بني دينار بن
النجار
أما
الرجل الآخر، فسموه بالمنذر بن محمد بن عقبة بن الجلاح الخزرجي([78]).
وتقول رواية أخرى:
قتل المنذر بن عمرو وأصحابه إلا ثلاثة نفر كانوا في طلب
ضالة لهم،
أحدهم
عمرو بن أمية فلم يرعهم إلا والطير تحوم، فحمل أحد الثلاثة يشتد، فلقي
رجلاً
فقتله ذلك الرجل، ورجع صاحباه وقتلا رجلاً
من بني سليم في طريقهما، وقدما على النبي «صلى الله عليه وآله»([79]).
ملاحظة:
جاء في البخاري: فانطلق حرام أخو
أم
سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان وقال: كونا قريباً
مني.
إلى أن قال:
فقتلوا كلهم
غير الأعرج([80]).
فالظاهر:
أن الواو في قوله:
(وهو) قدمت سهواً
والصحيح:
(هو ورجل) لأن
حراماً
قد قتل أيضاً([81])،
ولأن قوله قريباً
الخ..
يدل على أن الذين كانوا مع حرام رجلين.
ونجد بعض الروايات تصرح:
بأن رجلين كانا في سرح القوم، فرجعا؛ فرأيا الطير تحوم([82]).
ولكن رواية أخرى تقول:
إن ثلاثة نفر
كانوا في طلب ضالة لهم؛ فرجعوا فرأوا الطير تحوم([83]).
ورواية ثالثة تذكر:
أن أمير
السرية أرسل أربعة إلى بعض مياههم؛ فرجعوا فإذا هم بنسور تحوم([84]).
وتقول الروايات المتقدمة:
إن عمرو بن أمية ـ وحده ـ قد قتل العامريين اللذين كان
معهما عهد من رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وهو راجع إلى النبي «صلى
الله عليه وآله».
ولكننا نجد نصاً آخر يقول:
إن رجلين قد نجيا من بئر معونة فقتلا الرجلين، وأخذا ما
معهما، فأتيا رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأخبراه
الخ..([85]).
وفي نص ثالث:
«فقتل
المنذر بن عمرو وأصحابه إلا عمرو بن أمية الضمري فإنهم أسروه، فاستحيوه
حتى قدموا به مكة، فهو دفن خبيب بن عدي»([86]).
فكيف يكون قد قتل العامريين وهو عائد من بئر معونة؟
وفي رواية أخرى:
أنهما كانا من
بني سليم لكنهما اعتزيا إلى بني عامر لأنهم كانوا أعز من بني سليم([87]).
قد تقدم:
أن النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» قد دعا على رعل وذكوان، وعصية
شهراً
في قنوته ثم تركه لما جاؤوا مسلمين تائبين كما ذكره ابن القيم([88]).
وفي نص آخر:
أنه دعا عليهم
سبع عشرة ليلة([89]).
وفي ثالث:
خمس عشرة ليلة أو يوماً([90]).
وفي رابع:
سبعين يوماً([91]).
وفي خامس:
أربعين يوماً([92]).
وحول مصير ملاعب الأسنة؛ فإن
الروايات المتقدمة تذكر:
أنه قد بقي حياً،
وأنه حين بلغه قول النبي «صلى الله عليه وآله»: هذا عمل أبي براء، شق
عليه ذلك، ولكنه كما يقول الواقدي:
كان لا حركة له من الكبر([93]).
ولكن نصاً آخر يقول:
إن أبا براء
قد مات أسفاً على ما صنع به ابن أخيه عامر بن الطفيل([94]).
ونص ثالث يقول:
إن أبا براء
أسلم عند ذلك، وقاتل حتى قتل([95]).
وفي رواية أخرى:
أن أبا براء طلب من النبي إرسال رجال إليه لتعليم
القرآن، فبعث إليه المنذر بن عمرو في أربعة عشر رجلاً،
فلما ساروا إليهم بلغهم موت أبي براء، فأرسل المنذر بن عمرو إلى النبي
«صلى الله عليه وآله» يستمده فأمده بأربعين رجلاً
أميرهم عمرو بن أمية، على أن يكون المنذر بن عمرو أميرهم حين يجتمعون
فلما وصلوا إلى بئر معونة كتبوا إلى ربيعة بن أبي البراء: نحن في ذمتك
وذمة أبيك فنقدم عليك أم لا؟!
قال:
أنتم في ذمتي فأقدموا
الخ..([96]).
وفي نص آخر دلالة على:
أن ملاعب الأسنة قد قتل نفسه بعد موت عامر بن الطفيل، لأن قومه بعد موت
عامر حين انصرافه من عند النبي «صلى الله عليه وآله» أرادوا النجعة دون
مشورته لأنهم يزعمون:
أنه قد حدث له عارض في عقله، بسبب إرساله إلى رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، فدعا لبيداً
وقينتين، فشرب وغنتاه، فقال للبيد: أرأيت إن حدث بعمك حدث ما أنت قائل؟
فإن قومك يزعمون أن عقلي قد ذهب والموت خير من عزوب العقل،
فقال لبيد:
قـومــاً تـجـوبـان مـع الأنــواح
فـي مـأتـم مـهــجــر الــــرواح
في السلب السود وفـي الأمسـاح وابّـنـا مـــلاعـــب
الــرمــــاح
يا عـامـراً يـا عـامـر الـصـبــاح وعــامــر الـكـتـيـبـة الــــرداح
حتى أتمها، وغيرها من المراثي، فلما أثقله الشرب اتكأ
على سيفه حتى مات، وقال:
لا خير في العيش، وقد عصتني عامر ........
وتزعم عامر:
أنه مات مسلماً
ولم يقتل نفسه([97]).
وقال الذهبي:
الصحيح أنه لم
يسلم([98]).
ونجد رواية تقول:
إن ربيعة بن
أبي براء، بعد موت أبيه طعن عامر بن الطفيل فقتله([99]).
وأخرى تقول:
إن عامراً
عاش بعد ذلك حتى ابتلي بغدة كغدة البعير، ومات كافراً،
وهو منصرف من عند رسول الله «صلى الله عليه وآله»([100]).
وقيل:
إنه قدم على
النبي «صلى الله عليه وآله» وهو ابن بضع وثمانين سنة، ولم يسلم، وعاد
من عنده؛ فخرج له خراج في أصل أذنه، أخذه منه مثل النار، فاشتد عليه،
ومات منه([101]).
وتناقض آخر، وهو:
أن عامر بن الطفيل، هل مات على ظهر فرسه، بعد تركه بيت السلولية، كما
جاء في الروايات المتقدمة؟
أم أنه مات في بيت السلولية بالذات، كما رواه الطبراني؟!([102]).
هذا كله..
عدا عن الاختلاف في أنه مات قبل موت أبي براء، أو بعده.
وحسبنا هذا الذي ذكرناه من التناقضات والاختلافات بين
الروايات، ولو أردنا استقصاء ذلك لاحتجنا إلى جهد أعظم، ووقت أطول،
ولملأنا العديد من الصفحات، والمهم هو الإلماح والإشارة؛ ليتضح: أن ثمة
تعمُّداً
للكذب، والوضع، والتحريف،
وأنه لا يمكن الركون إلى النصوص، ولا اعتماد بعض دون بعض، إلا بعد
تزييف الزائف، وتحقيق ما هو حقيقة.
والله هو الموفق، والمسدد.
([1])
ستأتي المصادر لذلك وبئر معونة: موضع ببلاد هذيل بين مكة
وعسفان. وفي معجم ما استعجم: ماء لبني عامر بن صعصعة وفي
الاكتفاء ج2 ص142 والسيرة الحلبية ج3 ص172: هي بين أرض بني
عامر، وحرة بني سليم.
([2])
تاريخ الأمم والملوك ج2 ص545 وسيرة مغلطاي ص52 وتاريخ ابن
الوردي ج1 ص158 وتاريخ الخميس ج1 ص451 و 452 وغير ذلك.
([3])
المعنق: المسرع؛ وإنما سمي بذلك لأنه أسرع إلى الشهادة.
([4])
سيرة ابن هشام ج3 ص174.
([5])
ارتث: أي وقع وبه جراح.
([6])
قال ابن هشام: «هو المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح».
([8])
السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص195و 196.
([9])
السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص175.
([10])
أي فيمن حضر يوم بئر معونة.
([11])
ديوانه ص50 مع اختلاف في ترتيب الأبيات.
([12])
المساعي: السعي في طلب المجد والمكارم.
([14])
سيرة ابن هشام ج2 ص174 و 175.
([15])
الآيتان 169 و 170 من سورة آل عمران، والخبر في التفسير ج7
ص393 والدر المنثور ج2 ص95 عن ابن المنذر وابن جرير.
([16])
تاريخ الأمم والملوك ج2 ص545 ـ 550 والكامل لابن الأثير ج2
ص171 ـ 173 ولباب التأويل ج1 ص301 و 302 ومجمع البيان ج2 ص535
و 536 وتفسير القرآن العظيم ج1 ص426.
([17])
مجمع الزوائد ج6 ص125 و 126 عن الطبراني.
([19])
لعل الصحيح: فأحرقته.
([21])
سعد السعود ص218 و 219 عن تفسير الكلبي، تفسير سورة الرعد في
قوله تعالى: ويرسل الصواعق، الآية.
([22])
لعل الصحيح «ألف أشقر وألف شقراء» كما في غيره من المصادر.
([23])
السيرة الحلبية ج3 ص173 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص259.
([24])
السيرة النبوية لدحلان ج1 ص259.
([25])
تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص208.
([26])
تاريخ الخميس ج1 ص451 عن الوفاء.
([27])
تاريخ الأمم والملوك ج2 ص545 وسيرة مغلطاي ص52 وتاريخ ابن
الوردي ج1 ص158 وتاريخ الخميس ج1 ص451 و 452 وتاريخ الإسلام
للذهبي (المغازي) ص192 وعمدة القاري ج14 ص320 وج 18 ص126 و 174
وج7 ص18 ولباب التأويل للخازن ج1 ص302 ومجمع البيان ج2 ص536
وأنساب الأشراف ج1 ص194 و 375 وزاد المعاد ج2 ص109 والمواهب
اللدنية ج1 ص103 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص193 والسيرة
النبوية لدحلان ج1 ص258 وبهجة المحافل ج1 ص223 والإكتفاء
للكلاعي ج2 ص142 والمحبر ص118 وطبقات ابن سعد (ط ليدن) ج2 قسم
1 ص36 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 قسم 2 ص27 والبداية
والنهاية ج4 ص71 و 72 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص139 و 141
والتنبيه والإشراف ص212.
([28])
المحبر ص118 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 قسم 2 ص28.
([29])
عمدة القاري ج7 ص18 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص139
والبداية والنهاية ج4 ص71.
([30])
بهجة المحافل ج1 ص221.
([31])
تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص208 والمحبر ص472 وراجع:
تاريخ اليعقوبي (ط دار صادر) ج2 ص72، وراجع أيضاً: عمدة القاري
ج17 ص174 عن أبي معشر في المغازي.
([32])
صحيح مسلم ج6 ص45 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص194 وراجع:
طبقات ابن سعد ج2 قسم 1 ص38 وبهجة المحافل ج1 ص223 ولباب
التأويل ج1ص303.
([33])
صحيح البخاري ج3 ص19 وج 1 ص116 وتاريخ الخميس ج1 ص451 عن
الوفاء وطبقات ابن سعد ج2 قسم 1 ص38 والسنن الكبرى للبيهقي ج2
ص199 وفتح الباري ج7 ص296 وعمدة القاري ج17 ص169 ومسند أحمد ج3
ص255 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص139 والبداية والنهاية ج4
ص71 ولباب التأويل ج1 ص302.
([34])
تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص192 ومجمع الزوائد ج6 ص127 عن
الطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح.
([35])
مجمع الزوائد ج6 ص125.
([36])
راجع: فتح الباري ج6 ص126 وعمدة القاري ج13 ص309 و 310 وج 17
ص170.
([37])
راجع: البداية والنهاية ج4 ص74 والسيرة النبوية لابن كثير ج3
ص44 وعمدة القاري ج14 ص310 وج 7 ص18 وج 17 ص126.
([38])
تاريخ الأمم والملوك ج2 ص550 وراجع: الدر المنثور ج2 ص95 عن
ابن جرير، وابن المنذر.
([39])
الدر المنثور ج2 ص95.
([40])
السنن الكبرى ج2 ص207.
([41])
المحبر ص118 وسيرة مغلطاي ص52 وتاريخ الخميس ج1 ص452 والمواهب
اللدنية ج1 ص103، والسيرة الحلبية ج3 ص171 وراجع: فتح الباري
ج7 ص97 وعمدة القاري للعيني ج7 ص19 عن الطبراني.
([42])
مجمع الزوائد ج6 ص125 عن الطبراني.
([43])
تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص208 و207.
([44])
لباب التأويل للخازن ج1 ص302 وراجع غيره.
([45])
تاريخ اليعقوبي (ط دار صادر) ج2 ص72.
([46])
عمدة القاري ج17 ص174.
([47])
الجامع لأحكام القرآن ج16 ص301 عن الماوردي.
([48])
ورد التصريح باستثناء أربعة من المهاجرين في الرواية التي
تذكر: أنهم كانوا ثلاثين رجلاً، فراجع مصادرها فيما سبق.
([49])
مغازي الواقدي ج1 ص352
و348 و 350 وراجع المصادر التالية: صحيح البخاري ج3 ص19 وفتح
الباري ج7 ص296 وطبقات ابن سعد (ط ليدن) ج2 قسم 1 ص36 و 37
والثقات ج1 ص238 وراجع: لباب التأويل ج1 ص302.
([50])
راجع: مغازي الواقدي ج1 ص352.
([51])
مجمع الزوائد ج6 ص125 عن الطبراني وراجع: عمدة القاري ج17 ص174
عن العسكري.
([52])
تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص195 و 196 وكنز العمال ج10
ص371 و 372 عن الطبراني وأبي عوانة.
([53])
تاريخ الأمم والملوك ج2 ص550 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي)
ص194 وصحيح مسلم ج6 ص45 وتاريخ الخميس ج1 ص452 والسيرة الحلبية
ج3 ص172.
([54])
البداية والنهاية ج4 ص71 وحياة الصحابة ج1 ص545.
([55])
السيرة النبوية لدحلان ج1
ص258 و 259 والإصابة ج1 ص319 والإستيعاب بهامشه ج1 ص353.
([56])
مغازي الواقدي ج1 ص348 وطبقات ابن سعد ج2 قسم 1 ص37 وتاريخ
الخميس ج1 ص452.
([57])
الإستيعاب بهامش الإصابة ج3 ص8 والروض الأنف ج3 ص239 والسيرة
الحلبية ج3 ص173 وفتح الباري ج7 ص300 والسيرة النبوية لدحلان
ج1 ص259.
([58])
تاريخ الخميس ج1 ص453.
([59])
مغازي الواقدي ج1 ص349.
([60])
راجع: فتح الباري ج7 ص300 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص259
والثقات ج1 ص238 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص196 وتاريخ
الخميس ج1 ص253 والاكتفاء للكلاعي ج2 ص144 و 145 والسيرة
الحلبية ج3 ص173 وشرح بهجة المحافل ج1 ص224 والسيرة النبوية
لابن كثير ج3 ص1414 وأنساب الأشراف ج1 ص194 و 375 والبداية
والنهاية ج4 ص72 والمحبر ص183 وطبقات ابن سعد ج2 قسم 1 ص37
والمغازي للواقدي ج1 ص349 وأنساب الأشراف ج1 ص375.
([61])
راجع: فتح الباري ج7 ص300 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص259.
([62])
المغازي للواقدي ج1 ص347 وتاريخ الخميس ج1 ص452.
([63])
تاريخ الخميس ج1 ص453 وزاد المعاد ج2 ص110 والإكتفاء للكلاعي
ج2 ص143.
وراجع: العبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 قسم 2 ص28 والسيرة
النبوية لابن هشام ج3 ص195 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص259
وشرح بهجة المحافل ج1 ص222.
([64])
راجع: تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص192 عن موسى بن عقبة
وأنساب الأشراف ج1 ص375 وعمدة القاري ج17 ص174 و 175 وزاد
المعاد ج2 ص110 والمحبر ص118 و 472 وفتح الباري ج7 ص299 والبدء
والتاريخ ج4 ص211 وطبقات ابن سعد ج2 قسم 1 ص37 و 38 ومجمع
الزوائد ج6 ص125 و126 عن الطبراني بأسانيد رجالها رجال الصحيح.
([65])
راجع: تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص193 و 194 وسيرة مغلطاي
ص52 وتاريخ ابن الوردي ج1 ص159 وحياة الصحابة ج1 ص543 و 544
والبداية والنهاية ج4 ص73 وتاريخ الخميس ج1 ص452 وزاد المعاد
ج2 ص110 والمواهب اللدنية ج1 ص103 والإكتفاء للكلاعي ج2 ص143
والسيرة الحلبية ج2 ص172 والثقات ج1 ص238 ومجمع الزوائد ج6
ص128 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص194.
وراجع: السيرة النبوية لدحلان ج1 ص259 وبهجة المحافل ج1 ص222
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص142.
وراجع
أيضاً: عمدة القاري ج7 ص19 وذكره ص18 وحده، ولباب التأويل ج1
ص302 ومجمع البيان ج2 ص536.
([66])
الكشاف ج4 ص350 والجامع لأحكام القرآن ج16 ص301 عن الماوردي.
([67])
تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص194 و 195 وصحيح البخاري ج3
ص19 وحيـاة الصحابة ج1 ص545 وبهجة المحافـل ج1 ص222 والبـداية
والنهاية ج4 ص72 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص140 وعمدة
القاري ج17 ص172 وراجع: مسند أحمد ج3 ص289 لكنه ذكر في ص210
تشكيكاً في كونه أضاف نجاة رجل آخر كان مع الأعرج على الجبل.
([68])
راجع: شرح بهجة المحافل للأشخر اليمني ج1 ص222 وفتح الباري ج7
ص298 وعمدة القاري ج17 ص171.
([69])
تاريخ اليعقوبي ج2 ص72.
([70])
مغازي الواقدي ج1 ص352.
([71])
أنساب الأشراف ج1 ص375.
([72])
تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص196 وكنز العمال ج10 ص371 و
372 عن الطبراني، وأبي عوانة.
([73])
تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص208.
([74])
راجع: مغازي الواقدي ج1 ص348.
([75])
الثقات ج1 ص239 وتاريخ الخميس ج1 ص453.
([76])
تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص195 وفتح الباري ج7 ص298 و
299 وصحيح البخاري ج3 ص19 وعمدة القاري ج17 ص172 ومجمع الزوائد
ج6 ص126.
([77])
مجمع الزوائد ج6 ص126 ومسند أحمد ج3 ص210.
([78])
فتح الباري ج7 ص298 وراجع: عمدة القاري ج17 ص172.
([79])
تاريخ الخميس ج1 ص453 و 454.
([80])
صحيح البخاري ج3 ص19 وعمدة القاري ج17 ص172.
([81])
راجع: فتح الباري ج7 ص298 وعمدة القاري ج17 ص171.
([82])
قد تقدمت مصادر ذلك حين ذكر التناقض في من كان في سرح القوم.
([83])
تاريخ الخميس ج1 ص454.
([84])
تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص208.
([85])
تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص208.
([86])
مجمع الزوائد ج6 ص127 عن الطبراني.
([87])
الكشاف ج4 ص350 والجامع لأحكام القرآن ج16 ص301 عن الماوردي.
([88])
راجع فيما تقدم: الثقات ج1 ص237 وصحيح مسلم ج2 ص136 و 137 وسنن
الدارمي ج1 ص375 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص194 و 195
وشرح الموطأ للزرقاني ج2 ص51 وزاد المعاد ج2 ص110 وج 1 ص71 و73
وكنز العمال ج8 ص53 عن المتفق والمفترق وعبد الرزاق والإعتبار
ص85 و 86 و 87 و 91 و 93 والمواهب اللدنية ج1 ص103 وتاريخ
الخميس ج1 ص451 والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج5 ص308 و 320
و 322 و 323 وفي هامشه عن شرح معاني الآثار ج1 ص244 و 243
وراجع: مسند أبي عوانة ج2 ص306 و 307 و 311 و 312 والإكتفاء
للكلاعي ج2 ص145 والسيرة الحلبية ج3 ص173 ومجمع الزوائد ج2
ص137 عن أبي يعلى، والبزار، والطبراني في الكبير، وطبقات ابن
سعد ج2 قسم 1 ص37 وصحيح البخاري ج3 ص19 و 20 وج4 ص74 وج1 ص117
و 148 وج2 ص117 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص260 وفتح الباري ج7
ص301 وبهجة المحافل ج1 ص224 والبداية والنهاية ج4 ص71 و 72
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص139 و 140 ومسند أحمد ج1 ص301
وج 3 ص255 و 167 و 162 و 204 و 216 و 259 و 278 و 282 و 215 و
289 والمنتقى ج1 ص502 والمغني ج1 ص787 و 788 ومنحة المعبود ج1
ص101 وسنن ابن ماجة ج1 ص394 وسنن أبي داود ج1 ص68 ونصب الراية
ج2 ص127 والسنن الكبرى ج2 ص213 و 200 و 199 و 207 و 244 ونيل
الأوطار ج2 ص395 و 396 عن الدارقطني، وأحمد والبيهقي والحاكم
وصححه، وعبد الرزاق، وأبي نعيم وجامع المسانيد ج1 ص346 وراجع
ص324 و 342 ومصابيح السنة ج1 ص446 و 447 وسنن النسائي ج2 ص200
و 203 و 204 وعمدة القاري ج17 ص169 وج 5 ص73 وج 7 ص17 و 19 و
22 و 23 والإعتصام بحبل الله المتين ج2 ص19 وبداية المجتهد ج1
ص134.
([89])
مجمع الزوائد ج6 ص125.
([90])
مغازي الواقدي ج1 ص347 و 350 والسنن الكبرى ج2 ص199.
([91])
تاريخ الإسلام للذهبي
(المغازي) ص194 و 195 وتاريخ الخميس ج1 ص451.
([92])
راجع: أسد الغابة ج3 ص91 والإستيعاب هامش الإصابة ج3 ص8 والبدء
والتاريخ ج4 ص212 وراجع: مغازي الواقدي ج1 ص350 وجامع المسانيد
ج1 ص330 والسنن الكبرى ج2 ص199 وعمدة القاري ج23 ص18 وبهجة
المحافل ج1 ص224 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص260 ومسند أحمد ج3
ص210 وبداية المجتهد ج1 ص134 ولباب التأويل ج1 ص302.
([93])
مغازي الواقدي ج1 ص351 وراجع: تاريخ الأمم والملوك ج2 ص547
وغير ذلك.
([94])
راجع: تاريخ الخميس ج1 ص452 وفتح الباري ج7 ص301 والمواهب
اللدنية ج1 ص103 والسيرة الحلبية ج3 ص173 والسيرة النبوية
لدحلان ج1 ص259.
([95])
تاريخ الخميس ج1 ص452.
([96])
عمدة القاري ج17 ص174.
([97])
المحبر ص472 و 473.
([98])
السيرة النبوية لدحلان ج1 ص258.
([99])
تاريخ الخميس ج1 ص453 عن معالم التنزيل، وشرح بهجة المحافل ج1
ص224 عن تفسير البغوي.
([100])
تاريخ الخميس ج1 ص453 والسيرة الحلبية ج3 ص173 والمحبر ص472
والمغازي للواقدي ج1 ص351 ومجمع الزوائد للهيثمي ج6 ص125 و 126
عن الطبراني وفتح الباري ج7 ص301 وبهجة المحافل ج1 ص224 وتاريخ
الإسلام للذهبي (المغازي) ص208 و 194 و 195 والبداية والنهاية
ج4 ص71 و 72 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص140 وصحيح البخاري
ج3 ص19.
([101])
لباب التأويل للخازن ج1 ص302.
([102])
مجمع الزوائد ج6 ص126 عن الطبراني.
|