|
الـقـــرار والـحـصــــار 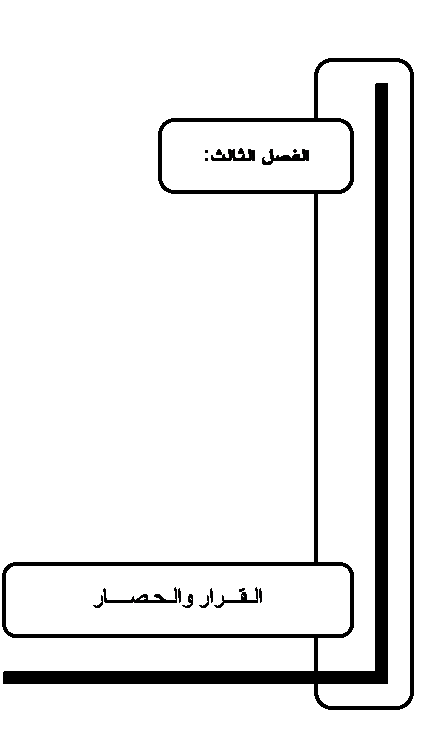
القرار الحكيم:
لقد كان من المتوقع ـ بعد نقض بني النضير للعهد، وخيانتهم الظاهرة ـ
:
أن يكون قرار النبي «صلى الله عليه وآله» هو حربهم وقتالهم، وإبادة
خضرائهم؛ فإن ذلك هو الجزاء العادل لكل خائن وغادر، ولا سيما إذا كان
يخطط ويتآمر، ثم يعمل على تنفيذ خططه بضرب الإسلام في الصميم، على
مستوى ضرب مقام النبوة والقيادة في أعلى مستوياتها، وأخلص تجلياتها.
ولكن الملاحظ هو:
أن الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» قد آثر أن يعامل بني النضير ـ
كما عامل بني قينقاع قبلهم ـ بمزيد من الرفق والتسامح، ولعل ذلك يرجع
إلى الأمور التالية:
1 ـ
إن هؤلاء القوم قد عاشوا دهراً في هذه المنطقة، وأصبحت لديهم الكثير من
العلاقات الإقتصادية
والتجارية، وغيرها، إلى جانب علاقات الصداقة والمحبة مع سائر أهل
البلاد الذين قَبِلَ
كثير منهم الإسلام ديناً
وهداهم الله للإيمان..
وإذاً..
فقد يعز على الكثيرين ممن لهم معهم علاقات كهذه أن يروهم وقد حاقت بهم
المصائب والبلايا، واختطفت الكثيرين منهم أيدي المنايا، فيعتبرون أنهم
قد عوملوا بقسوة بالغة، وبلا شفقة ولا رحمة، وقد كان يمكن أن يكون
الموقف أكثر مرونة وانعطافاً
وملاءمة من ذلك.
2 ـ
إن الكثيرين من الناس كانوا مبهورين بأهل الكتاب واليهود بالذات،
وينظرون إليهم على أنهم مصدر العلوم والمعارف، وعندهم الكثير من
الخفايا والأسرار.. وعلى هذا فقد يفسر ضربهم بقسوة على أنه ناشئ عن
حالة من التخوف منهم، أو الحسد والبغي عليهم.
وإذا كان كذلك فلا حرج من أن يتخيلهم المتخيلون شهداء وأبطالاً،
لا بد من التأسف عليهم، بل والحنين إليهم..
3 ـ
ومن جهة أخرى، فإن رؤية ذلهم وصغارهم، ثم مراقبة ما يصدر منهم خلال ذلك
من مواقف ماكرة وغادرة، ومن مخالفات صريحة للأعراف، ولأحكام العقل
والفطرة، والضمير، لسوف يساهم في كشف زيفهم وخداعهم وغشهم للإسلام
وللمسلمين.
كما أن رؤية الكرامات الإلهية الظاهرة، والتأييدات الربانية الخفية منه
تعالى لنبيه وللمسلمين، ونصره تعالى عليهم لسوف يرسخ حقانية موقف
الإسلام، ونبي الإسلام منهم.
هذا..
مع تـوفـر
المزيـد
من الفرص للإنسـان
المسلم الواعي للتأمـل
والتدبر في ذلك كله، بعيداً
عن الانفعالات والتشنجات، وفي منأى عن أعمال التضليل والتزوير، التي
ربما يمارسها الكثيرون من المنافقين، وباقي اليهود الذين يتعاطفون
معهم.
ومن هنا..
فقد جاء قرار إجلائهم عن المدينة ليكون القرار الحكيم والصائب، وليكون
هو الأوفق والأنسب والأقرب لتحقيق الأهداف الإلهية السامية والكبرى.
وقد أبلغهم النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» بقراره هذا، عن طريق
رسول أرسله إليهم، ليرى ماذا يكون جوابهم ويعلم الناس حقيقة موقفهم..
4 ـ
كما أن في ذلك التفافاً أيضاً على المنافقين، وعلى كل المتربصين
بالمسلمين والإسلام سوءاً، من أن يجعلوا ذلك ذريعة للتحريض والتشهير
بالإسلام وبنبيه الأكرم «صلى الله عليه وآله»..
إن النص التاريخي يقول:
إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» حين أراد أن ينذر بني النضير، قال:
ادعوا
لي محمد بن مسلمة، فحين أتى أرسله إليهم ينذرهم بوجوب مغادرتهم مساكنهم([1]).
ولا بد لنا من وقفة هنا، لنعلم السر في اختياره «صلى الله عليه وآله»
هذا الرجل بالذات ـ محمد بن مسلمة ـ ليكون رسوله إلى يهود بني النضير،
فنقول: إن الأوس كانوا حلفاء لبني النضير([2])،
ولربما كان يدور بخلدهم أن يكون للأوس دور إيجابي لصالحهم، ولا أقل من
أن يكون لهم موقف فيه شيء من العطف، وعدم القسوة تجاههم..
إذا عرفنا ذلك:
فإن اختيار رجل من الأوس ليحمل رسالة النبي «صلى الله عليه وآله» إليهم
يأمرهم فيها بالجلاء، لسوف يزيد من يأسهم، ويضاعف من تخوفاتهم وهو يمثل
ضربة روحية موفقة ساهمت في المزيد من إضعاف معنوياتهم، وجعلتهم يراجعون
حساباتهم بجدية، ثم يرضخون للأمر الواقع.
ويكفي أن نذكر شاهداً
على ذلك:
أنهم حين جاءهم محمد بن مسلمة الأوسي بالخبر، قالوا:
«يا
محمد، ما كنا نظن: أن يجيئنا بهذا رجل من الأوس،
فقال محمد بن مسلمة: تغيرت القلوب، ومحا الإسلام العهود.
فقالوا:
نتحمل.
فأرسل إليهم عبد الله بن
أُبي:
لا تخرجوا الخ..»([3]).
بل في بعض النصوص:
أن محمد بن مسلمة هو الذي تولى إخراجهم من ديارهم([4]).
وقال الواقدي:
«كان
محمد بن مسلمة الذي ولي قبض الأموال والحلقة، وكشفهم عنها»([5]).
وواضح:
أن ذلك أيضاً يضاعف ذلهم وخزيهم، ويزيد من آلامهم، وقد كان يفترض فيهم:
أن يأخذوا من ذلك عظة وعبرة، وأن يراجعوا حساباتهم بشأن هذا الرسول
ودعوته؛ فقد تبين لهم أن الإسلام قد هيمن على القلوب وغيّرها، ومحا
الإسلام العهود.
ومعنى ذلك هو:
أن ثمة رعاية إلهية له «صلى الله عليه وآله»، ولدينه، ورسالته الظافرة،
وقد تجاوزت هذه الرعاية كل التوقعات، وقلبت جميع الموازين لديهم، ولدى
غيرهم من المشركين، الذين كانوا يعيشون في المنطقة، وكانوا يتعاملون مع
النبي «صلى الله عليه وآله» ومع الدين الذي جاء به من موقع التحدي،
والمكابرة، والجحود..
فما كان أحراهم بعد أن عاينوا ما عاينوا من آيات بينات، ومن كرامات
ومعجزات، أن يسلموا ويشهدوا لنبي الإسلام بالرسالة والنبوة، ولكنهم لم
يفعلوا.. بل جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً.
وقال رسول الله «صلى
الله عليه وآله» لعلي «عليه السلام»:
تقدم إلى بني النضير، فأخذ أمير المؤمنين الراية، وتقدم، وجاء رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، وأحاط بحصنهم([6]).
وحسب نص آخر:
وحمل لواء رسول الله «صلى الله عليه وآله» علي بن أبي طالب([7]).
ولكن الواقدي قال:
«وقد
استعمل علياً «عليه السلام» على العسكر، وقيل: أبا بكر»([8]).
ونقول: لا بد من الإشارة هنا إلى أمرين:
الأول:
بالنسبة لاستعمال أبي بكر على العسكر، فإنه قول منسوب إلى مجهول، لم
يجرؤ الواقدي على ذكر اسمه، ولا مستنده، ونحن نشك في كونه مختلقاً
وموضوعاً
على أبي بكر؛ وذلك لما قدمناه من أن علياً كان صاحب لواء رسول الله
«صلى الله عليه وآله» في بدر وفي كل مشهد([9]).
وقد صرحوا:
بأنه «صلى الله عليه وآله» لم يؤمِّر
على علي أحداً «عليه
السلام»([10])،
وقد كان «عليه السلام» في غزاة بني النضير، فكيف يكون قد أمَّر
أبا بكر عليه؟!
وعدا عن ذلك كله..
فإن أبا بكر لم يكن معروفاً
بالشجاعة والإقدام، إن لم نقل: إن الأمر كان على عكس ذلك تماماً،
حسبما أوضحناه في الجزء الثالث من هذا الكتاب، حين الكلام حول حرب بدر،
وما يذكر من شجاعة أبي بكر فيها، لبقائه مع رسول الله «صلى الله عليه
وآله» في العريش.
ومن الواضح:
أن إمارة الجيوش وراياتها إنما تكون بيد الشجعان وأصحاب النجدة، قال
علي «عليه السلام»: وهو يحث أصحابه على القتال:
«ورايتكم
فلا تميلوها، ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم، والمانعين الذمار منكم؛
فإن الصابرين على نزول الحقائق، هم الذين يحفون براياتهم ويكتنفونها؛
حفاً
فيها، ووراءها، وأمامها، لا يتأخرون عنها فيسلموها، ولا يتقدمون عليها،
فيفردوها»([11]).
ولعل الهدف من تلك الأكذوبة التي نسبها الواقدي إلى القيل:
هو التشكيك فيما هو حق وصدق فيما يرتبط بعلي «عليه السلام»، والتخفيف
من حدة النقد الموجه إلى أبي بكر، بسبب ما عرف عنه من إحجام عن خوض
الغمرات، والفرار في مواطن الخطر، والتحدي الحقيقي، كما جرى له في أُحد
وخيبر وغيرهما، مما هو مسطور في كتب الحديث والتاريخ.
الثاني:
إن
من
الواضح: أن حمله «عليه السلام» لراية رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
وقيادته للعسكر لمما يزيد في رعب اليهود، ويهزمهم نفسياً.
كيف لا..
وقد كانت أخبار مواقفه وبطولاته في بدر ـ وكذا في أحد، لو صح كون غزوة
بني النضير بعدها، وقد استبعدناه ـ قد أرهبت وأرعبت القاصي والداني، من
أعداء الله وأعداء رسوله ودينه.
فهو قد قتل نصف قتلى المشركين، وشارك في قتل النصف الثاني في حرب بدر،
وفي أُحد
ـ لو كانت القضية بعدها ـ كان الفتح وحفظ الإسلام على يديه، وقد آثرت
قريش الفرار على البقاء والقرار، حينما علمت أنه «عليه السلام» يلاحقها
في غزوة حمراء الأسد، رغم ما كانت تشعر به من زهو وخيلاء بالنسبة
للنتائج التي تمخضت عنها حرب أُحد.
لما توجه رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى بني النضير عمد إلى
حصارهم، فضرب قبته في أقصى بني خطمة من البطحاء.
فلما أقبل الليل رماه رجل من بني النضير بسهم، فأصاب القبة، فأمر النبي
«صلى الله عليه وآله» أن تحول قبته إلى السفح، وأحاط بها المهاجرون
والأنصار. (وعند الواقدي: أنها حولت إلى مسجد الفضيخ).
فلما اختلط الظلام فقدوا
أمير المؤمنين «عليه السلام»؛ فقال الناس:
يا رسول الله، لا نرى علياً.
فقال «صلى الله عليه
وآله»:
أراه([12])
في بعض ما يصلح شأنكم.
فلم يلبث أن جاء برأس اليهودي الذي رمى النبي «صلى الله عليه وآله» ـ
وكان يقال له: عزورا ـ فطرحه بين يدي النبي «صلى الله عليه وآله».
فقال له النبي «صلى الله
عليه وآله»:
كيف صنعت؟
فقال:
إني رأيت هذا الخبيث جريَّاً
شجاعاً؛
فكمنت له، وقلت: ما أجرأه أن يخرج إذا اختلط الليل، يطلب منا غرة.
فأقبل مصلتاً
بسيفه، في تسعة نفر من اليهود؛ فشددت عليه، وقتلته، فأفلت أصحابه، ولم
يبرحوا قريباً؛
فابعث معي نفراً
فإني أرجو أن أظفر بهم.
فبعث رسول الله «صلى الله عليه وآله» معه عشرة، فيهم أبو دجانة سماك بن
خرشة، وسهل بن حنيف؛ فأدركوهم قبل أن يلجوا الحصن؛ فقتلوهم، وجاؤوا
برؤوسهم إلى النبي «صلى الله عليه وآله» فأمر أن تطرح في بعض آبار بني
خطمة.
وكان ذلك سبب فتح حصون بني النضير.
وفي ذلك يقول حسان بن ثابت:
لله أي كــريــهــة
أبــلــيـتـهـا بـبـني قـريـظـة والـنـفوس تطلع
أردى رئـيـسـهم وآب بـتـسـعة طـوراً يشـلـهـم([13])
وطـوراً يـدفـع
وحسب نص الواقدي ودحلان:
أن القبة كانت من غرب (ضرب من الشجر) عليها مسوح، أرسل بها إليه سعد بن
عبادة فأمر بلالاً،
فضربها في موضع المسجد الصغير الذي بفضاء بني خطمة وصلى بالناس في ذلك
الفضاء، فلما رماها،
«عزوك»
ـ كما في الواقدي ـ بالسهم حولت إلى مسجد الفضيخ.
إلى أن تقول الرواية:
فيئسوا من نصرهم، فقالوا: نحن نخرج من بلادك الخ..([14]).
ونحن نسجل هنا الأمور التالية:
إن تحويل النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» قبته إلى السفح، حتى لا
تنالها يد العدو، يعطينا: أنه «صلى الله عليه وآله» كان يتحرك من موقع
الحكمة والتدبير، وفقاً
لأحكام العقل وجرياً
على مقتضيات الفطرة.
وأما المعجزة، والتصرف الإلهي الغيبي، فإنما كان في حالات خاصة، حيث
تمس الحاجة لذلك، وتفرضه ضرورة حفظ الإسلام، ورمزه الأول، كما كان
الحال بالنسبة لإخبار جبرئيل «عليه السلام» للنبي
«صلى
الله عليه وآله»
بتآمر بني النضير على حياته «صلى الله عليه وآله»، حينما ذهب إليهم
يستمدهم في ديّة
العامريين، حسبما تقدم..
وكما كان الحال بالنسبة إلى الإمداد بالملائكة في حرب بدر، إلى غير ذلك
من موارد فرضت التدخل الإلهي، وحدوث المعجزة والكرامة، من أجل حفظ
الإسلام في منطلقاته الأساسية، وفي رموزه الأولى والكبيرة.
ولعل تحول النبي «صلى الله عليه وآله» إلى السفح بعد وصول النبل إلى
تلك الخيمة كان يهدف إلى تعليم المسلمين هذا الدرس بالذات بالإضافة إلى
دروس أخرى تأتي.
إن
تحرك أمير المؤمنين
«عليه
الصلاة والسلام»
لمواجهة الخطر اليهودي إنما جاء من منطلق الإحساس بالمسؤولية، ونتيجة
للشعور بالواجب، والثقة بالله سبحانه.. حتى ولو لم يصدر الأمر به من
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، تفادياً
لبعض السلبيات.
وهذا الإحساس والشعور لم نجده عند سائر الصحابة، الذين كانوا حاضرين مع
النبي «صلى الله عليه وآله»، وشهدوا ما شهده علي
«عليه السلام»، وعاينوا ما عاينه.
إن سرية تحرك أمير المؤمنين
«عليه
الصلاة والسلام»،
وعدم إفصاح النبي «صلى الله عليه وآله» عن طبيعة المهمة التي كان أمير
المؤمنين بصدد تحقيقها، حتى إنه «صلى الله على وآله» لم يشر إلى أن
طابعها كان عسكرياً
أو استطلاعياً،
أو تموينياً،
أو غير ذلك..
إن هذه السرية مطلوبة في كل عمل عسكري ـ إلا ما كان ذا طبيعة خاصة ـ
ليمكن تحقيق الأهداف المتوخاة من ذلك العمل على النحو الأفضل والأكمل.
وقد كان من الطبيعي أن يتسرب الخبر في ظروف كهذه إلى بني النضير ـ لو
أفصح به النبي «صلى الله عليه وآله» ـ عن طريق المنافقين، ولعل ذلك
يؤدي إلى تفويت الكثير من الفرص، وإلى أن تفقد العملية عناصر هامة من
شأنها أن تساعد على إحراز نصر كبير فيها،
كأن يتمكن بنو النضير من نجدة سريتهم العاملة، ولا أقل من تمكن
المنافقين من مساعدة عناصر السرية اليهودية على الفرار والنجاة، أو
الاختفاء في الأمكنة المناسبة لذلك..
إن قول أمير المؤمنين
«عليه السلام»:
«إني
رأيت هذا الخبيث جريَّاً
شجاعاً؛
فكمنت له، وقلت: ما أجرأه أن يخرج إذا اختلط الليل، فيطلب منا غرة»
يعطينا: أنه لا بد من دراسة حالات العدو، وخصائصه النفسية، فإن لذلك
أثراً
كبيراً
في العمل العسكري، وله دور هام في تعيين مستقبل الحرب، وأسلوب حركتها
ونتائجها.
إن كلمة أمير المؤمنين
«عليه السلام»، الآنفة الذكر، لتعطينا:
أنه لا بد من أن تكون لدى الكوادر القيادية القدرة على التنبؤ بما يمكن
أن يخطط له العدو، وطرح الافتراضات والخيارات كافة التي يمكن أن يلجأ
إليها، لمواجهتها من موقع الوعي والدراسة والتخطيط، حتى لا تتحول إلى
مفاجأة يتعامل معها من موقع العفوية والارتجال، وردة الفعل، والانفعال.
وبعد..
فلم تكن مبادرة أمير المؤمنين لإفشال المخططات المحتملة للعدو إلا
إيذاناً بضرورة القيام بعمليات وقائية، وضرب العدو في مواقعه، وبصورة
مفاجئة، وقوية، فإن ذلك من شأنه أن يلحق به هزيمة نفسية، فضلاً عن
الهزيمة العسكرية الساحقة.
إن شعر حسان الآنف الذكر
يدل على:
أن علياً «عليه الصلاة والسلام» هو الذي آب بالتسعة، وأنه قد قتل
بعضهم، وآب بالبعض الآخر أحياء.
ولعل دور العشرة الذين أرسلهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» معه قد
اقتصر على أمور ثانوية وهامشية في عملية أسر التسعة، أو قتلهم، وإن
الدور المصيري والأهم إنما كان لأمير المؤمنين «عليه السلام».
ولأجل ذلك لا يصغى إلى ما ذكره الحلبي، حينما ذكر إرسال العشرة مع علي
«عليه السلام» لقتل التسعة فقتلوهم، وطرحوهم في بعض الآبار،
حيث قال الحلبي:
«..وفي
هذا رد على بعض الرافضة حيث ادَّعى:
أن علياً
هو القاتل لأولئك العشرة»([15]).
وكان من الطبيعي:
أن يكون لهذه الضربة تأثير كبير على معنويات بني النضير، وأن يضج الرعب
في قلوبهم. فإن تصدي رجل واحد من المسلمين لعشرة منهم، ثم قتل العشرة
جميعاً، يؤذن بأن المسلمين قادرون على إبادتهم، واستئصال شأفتهم بسهولة
ويسر.
وإذا كان يمكن اعتبار حرق الأشجار وقطعها تهديداً،
وممارسة لمستوى من الضغط، قد يتم التراجع عنه، حين يؤول الأمر إلى سفك
الدماء، وإزهاق الأرواح، فإن هذا التراجع قد أصبح غير محتمل على
الإطلاق، بعد أن باشر المسلمون عملاً
عسكرياً
بهذا المستوى، وبهذه الشدة والصلابة والتصميم.
ولقد باشر هذا الأمر رجل هو أقرب الناس إلى رسول الله، وأعرفهم بنواياه
وآرائه، وأشدهم اتباعاً
له. رجل عرفوا بعض مواقفه المرعبة في بدر وربما في أحد.. وهو علي بن
أبي طالب «عليه الصلاة والسلام».
إذاً..
وبعد أن تخلى عنهم حلفاؤهم، ولم يفِ
لهم المنافقون بما وعدوهم به، فإنهم لم يبقَ
لهم إلا هذه الأحجار التي يختبئوون
خلفها كالفئران. ولكن إلى أي حد يمكن لهذه الحجارة أن تدفع عنهم، وكيف
وأنى لهم برد هجوم الجيش الإسلامي عنها حين يصمم على تدميرها؟!
فقد جاءهم ما لم يكن بالحسبان،
﴿فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ
يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾([16])
و«كان
ذلك سبب فتح حصون بني النضير»
كما تقدم في النص السابق.
ومن جهة أخرى:
فإن الضربة الموفقة لا بد أن تقوي من معنويات الجيش الإسلامي. وقد
حصنته من أن يصاب بالضعف والوهن لدى المواجهة الأولى مع عدو لا يرى
سبيلاً
إليه، ما دام بالحصون المنيعة، بالإضافة إلى قدرات قتالية عالية لديه
بنظر الكثيرين.
ومما ذكرناه:
يتضح معنى العبارة المنقولة عن النبي «صلى الله عليه وآله» هنا، حينما
سئل عن علي «عليه السلام» حيث يقول:
«أراه
في بعض ما يصلح شأنكم».
فإن هذه العملية كان لها أثر كبير في إصلاح شأن المسلمين ـ كل المسلمين
ـ وإفساد أمر أعدائهم، ودحرهم وكسر شوكتهم، حيث أتاهم الله من
حيث
لم يحتسبوا.
ونلاحظ أيضاً:
أن الهدف العسكري الذي وضعه علي «عليه السلام»، هو قتل قائد المجموعة
بالذات.
وهذا العمل يعتبر نموذجياً،
وناجحاً
عسكرياً
مائة في المائة، فإن حدوث فراغ على مستوى القيادة يزعزع كل الثوابت،
ويفقد المجموعة بأسرها كل فاعليتها وحيويتها، وتتحول إلى ركام خاو
ورماد خامد.
ويلاحظ:
أن شعر حسان قد ذكر: أن هذه القضية وقعت في بني قريظة، لكن الرواية تنص
على حدوث ذلك في بني النضير. وهذا تناقض ظاهر، ولعل ملاءمة كلمة:
«بني
قريظة»
لوزن الشعر، أكثر من كلمة
«بني
النضير»
يؤيد: أن يكون الشعر صحيحاً
وغير محرّف..
ولكن هذا المقدار لا يكفي للحكم على الرواية بالتلاعب والتصرف فيها.
وذلك لأن الرواية قد
صرحت:
بأنه «صلى الله عليه وآله» في حصار بني النضير قد ضرب قبته في أقصى بني
خطمة من البطحاء.
وهذا يعني:
أن بني خطمة كانوا يسكنون في مجاورة بني النضير.
وإذاً، فمن المفيد:
أن نحدد موقع بني خطمة، وبني النضير، وبني قريظة؛ ليتضح من ثم أن حصول
التلاعب في الشعر هو الأقرب والأنسب فنقول:
أما بالنسبة لبني قريظة،
فإنهم يقولون:
إنهم نزلوا بالعالية على وادي مهزور([17])
وذلك حيث يقع مسجد بني قريظة، الذي هو شرقي مسجد الشمس (أعني مسجد
الفضيخ) الذي يقع هو الآخر شرقي مسجد قباء([18])
في الحرة الشرقية، المعروفة بحرة واقم، وتسمى حرة بني قريظة أيضاً،
لأنهم كانوا بطرفها القبلي([19]).
أما بنو النضير، فقد نزلوا بالعالية أيضاً على وادي مذينب، وهو شعبة من
سيل بطحان([20]).
وقد نقل ابن عساكر
والحموي عن الواقدي:
أن منازلهم كانت بناحية الغرس وما والاها مقبرة بني حنظلة([21])
أو خطمة([22]).
قال السمهودي:
«الظاهر:
أنهم كانوا بالنواعم، وتمتد منازلهم وأموالهم إلى ناحية الغرس، وإلى
ناحية الصافية، وما معها من صدقات النبي «صلى الله عليه وآله». وبعض
منازلهم كانت بجفاف، لأن فاضجة (أطم لبني النضير، معجم البلدان ج4
ص231) به، ورأيت بالحرة في شرقي النواعم آثار حصون وقرية بقرب مذينب،
يظهر أنها من جملة منازلهم»([23]).
وأما منازل بني خطمة،
فإن المطري يقول:
إنها قرب مسجد الشمس بالعوالي([24]).
لكن السمهودي قد رد على
ذلك بقوله:
«والأظهر
عندنا: أنهم بقرب الماجشونية، لقول ابن شبة في سيل بطحان: إنه يصب في
جفاف، ويمر فيه، حتى يفضي إلى فضاء بني خطمة، والأغرس، وقوله في مذينب:
إنه يلتقي هو وسيل بني قريظة بالمشارف، فضاء بني خطمة.
وسيأتي:
أن ذلك عند تنور النورة، الذي في شامي الماجشونية،
وقد رأيت آثار القرية والآطام هناك»([25]).
إذا عرفت هذا فإننا نقول:
إن الرواية هي الصحيحة، وإن
شعر حسان هو الذي تعرض للتلاعب العفوي أو المتعمد؛ وذلك لأن الرواية قد
صرحت ـ كما صرح غيرها ـ:
بأن فضاء بني خطمة ملاصق للمواقع المحاصرة، لأن السهام كانت قد نالت
القبة التي ضربها النبي «صلى الله عليه وآله» في أقصى بني خطمة.
وقد كان بنو خطمة قرب بني النضير لا قرب بني قريظة.. وكان الفاصل بين
قريظة والنضير شاسعاً جداً. فقد كان بنو قريظة جنوبي المدينة شرقي مسجد
قباء، ومسجد الشمس، في الطرف القبلي للحرة الشرقية.
أما بنو النضير، فقد كانوا شرقي المدينة المتمايل إلى جهة الشام
شمالاً..
ونحن في مقام التدليل على هذين الأمرين: أعني بُعد قريظة عن النضير،
وقرب بني خطمة من هؤلاء لا أولئك نقسم الكلام إلى قسمين؛ فنقول:
أما بالنسبة لكون بني النضير شرقي المدينة؛ فيدل على ذلك:
أولاً:
قال ابن كثير:
«كانت
منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها، شرقيها»([26]).
ثانياً:
إن الصافية، وبرقة، والدلال والميثب متجاورات بأعلى الصورين، من خلف
قصر مروان بن الحكم([27]).
وهذه المواضع المشار إليها هي من أموال مخيريق، التي أوصى بها إلى
النبي «صلى الله عليه وآله». وكان هذا الرجل من بني النضير، وكانت
حوائطه سبعة، وهي الأربعة المتقدمة بالإضافة إلى: حسنى، والأعواف،
ومشربة أم إبراهيم.
وقيل:
بل هو من يهود بني قينقاع، كان نازلاً
ببني النضير، وكانت أمواله فيهم، وهي عامة صدقات رسول الله «صلى الله
عليه وآله»([28]).
وعليه..
فإذا كانت تلك المواضع الأربعة متجاورات بأعلى الصورين، وكانت من أموال
بني النضير، فنقول:
إنهم يقولون:
إن الصورين يقعان في أدنى الغابة، والغابة في عوالي المدينة من جهة
الشام([29]).
وحسب نص آخر:
أنها كانت على بريد من المدينة على طريق الشام([30]).
(والصوران أيضاً موقع في البقيع([31])،
والبقيع يقع داخل المدينة)،
وليس هذا الموضع قرب قصر مروان، فلا يتوهم ذلك.
ثالثاً:
قد صرحوا:
بأن مشربة أم إبراهيم، وهي من أموال بني النضير، من مخيريق، قد كانت في
«القف»،
كما أن سائر أموال مخيريق قد كانت بقرب القف أيضاً([32]).
ومعلوم:
أن القف يقع في شرقي المدينة، لأن زهرة مما يليه، كما سنرى([33]).
رابعاً:
قد صرحوا:
بأن بني النضير كانوا يسكنون في قرية يقال لها: زهرة([34]).
وزهرة تقع في شرقي المدينة، وبها تقع الصافية([35])،
التي كانت من أموال مخيريق، وصارت إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله».
كما أنهم قد ذكروا:
أن زهرة هي الأرض السهلة بين الحرة والسافلة مما يلي القف([36]).
ولعل التعبير الأدق، أن
يقال:
إن زهرة مما يلي طرف العالية، وما نزل عنها، فهو السافلة وأدنى العالية
ميل من المسجد([37]).
خامساً:
إن سهم عثمان الذي أعطاه إياه رسول الله
«صلى
الله عليه عليه وآله»
من بني النضير أيضاً([38]).
وغافر والبرزتان أيضاً، وهما من طعم أزواج النبي «صلى الله عليه وآله»
من بني النضير([39])،
وفي بئر أريس أيضاً([40]).
ولعل كيدمة هي نفس الجزع الذي بقرب مشربة أم إبراهيم، والمعروف
بالحسينيات، (وهو قرية في زهرة) ويعرف بلفظ (كيادم) بصيغة الجمع([41]).
ثم إن السمهودي بعد أن
ذكر:
أن المعروف اليوم هو بئر أريس غربي مسجد قباء، وأنها ليهودي من بني
محمم،
قد رد ذلك:
بأن ما تقدم من كون سهم عثمان وعبد الرحمن بن عوف من بني النضير
موجوداً فيها يدل على خلاف ذلك؛ لأن بني النضير وبني محمم لم يكونوا
بقباء، لا سيما وأن ابن زبالة يذكر: أن مهزوراً
يشق في أموال عثمان، يأتي على أريس، وأسفل منه، حتى يتبطن الصورين،
فصرفه عثمان مخافة على المسجد الذي في بئر أريس.
ومن الواضح:
أن الموضع المعروف بقباء لا يمكن وصول شيء من مهزور إليه([42]).
سادساً:
روي عن جعفر: أن سلمان كان لناس من بني النضير؛ فكاتبوه على أن يغرس
لهم نخلاً، ثم أفاءها الله على نبيه، فهي الميثب صدقة النبي «صلى الله
عليه وآله» بالمدينة([43]).
وفي رواية أخرى:
أن امرأة من بني النضير قد كاتبت سلمان على أن يحيي لها موضعاً
اسمه
«الدلال»،
فأعلم النبي «صلى الله عليه وآله» بذلك، فجاء، فجلس على
«فقير»،
ثم جعل يحمل إليه الودي؛ فيضعها «صلى الله عليه وآله» بيده، فقال:
«والذي
تظاهر عندنا: أنها (أي الدلال) من أموال بني النضير، ومما يدل على ذلك:
أن مهزوراً
يسقيها، ولم يزل يسمع أنه لا يسقي إلا أموال بني النضير»([44]).
قال السمهودي:
«الذي
يتحصل من مجموع ما تقدم: أن نخل سلمان الذي غرسه هو
«الدلال»
وقيل: برقة، والميثب
«وقيل:
الميثب»([45]).
وقد ذكر السمهودي هنا:
أن
«الفقير»
الذي جلس عليه النبي اسم الحديقة بالعالية، قرب بني قريظة،
ثم أورد على ذلك:
بأن
«الفقير»
ليس من صدقات النبي «صلى الله عليه وآله»، وإنما هو من صدقات علي «عليه
السلام»([46]).
ونقول:
إننا نلاحظ هنا: أن التعبير الوارد هو:
«جلس
على فقير»،
فإذا كان هذا اللفظ اسماً
لحديقة، لم يصح قوله: جلس عليه، بل يقال: ذهب إليه، وجلس فيه، أو في
بعض جوانبه ونواحيه.
والصحيح هو:
أن
«الفقير»
هو الحفرة التي توضع فيها النخلة حين غرسها،
فالنبي «صلى الله عليه وآله» قد جلس فوقها بانتظار أن يأتيه سلمان
بالودي ليضعه فيها؛ فصح أن يقال حينئذٍ: جلس على فقير..
ولكن يبقى إيراد آخر،
وهو:
أن رواية رواها أحمد والطبراني وغيرهما تفيد: أن الذي اشترى سلمان هو
رجل من بني قريظة([47]).
ويدل على ذلك أيضاً:
نفس كتاب المفاداة الذي صرح باسم ذلك الرجل، وأنه قرظي([48]).
ونقول:
إنه يمكن أن يكون ذلك القرظي زوجاً
لمالكة سلمان، التي كانت نضيرية،
وكانت أموالها في منطقة قبيلتها،
وقد تولى زوجها كتب الكتاب عنها، وذلك ليس بالأمر الغريب، ولا البعيد
عن المألوف.
ألف:
وأما بالنسبة للقسم الثاني، أعني قرب بني خطمة من منازل بني النضير،
وبعدهم عن منازل بني قريظة، فيدل على ذلك بالإضافة إلى صراحة نفس
الرواية التي هي موضع البحث في ذلك:
أولاً:
قول المسعودي:
«كانت
منازل بني النضير، بناحية الغرس، وما والاها ومقبرة بني خطمة»([49]).
ثانياً:
تصريحهم بأن بئر غرس، حيث منازل بني النضير، إنما تقع في جهة بني خطمة([50])،
فبنو خطمة إذاً هم في منطقة زهرة منازل بني النضير..
ثالثاً:
إن فضاء بني خطمة يقع شامي الماجشونية ـ كما ذكره السمهودي([51])
ـ والماجشونية تقع قرب تربة صعيب وبلحارث، كما أن منازل بني النضير تقع
بناحية الغرس، وهي قرب تربة صعيب أيضاً([52]).
وذلك يعني:
أن بني خطمة كانوا قرب بني النضير، لا قرب بني قريظة.
رابعاً:
إن ما يدل على بعد بني خطمة عن بني قريظة: أن البويرة التي وقع الحريق
فيها قد كانت قرب تربة صعيب ودار بلحارث بن الخزرج،
وليست
هي البويرة المعروفة في قبلة مسجد قباء.
ويدل على ذلك ما رواه
ابن زبالة:
من أنه «صلى الله عليه وآله» قد وقف على السيرة التي على الطريق، حذو
البويرة؛ فقال: إن خير نساء ورجال في هذه الدور،
وأشار إلى دار بني سالم، ودار بلحبلى، ودار بلحارث بن الخزرج.
وهـذا
الوصف لا يطابق المـوضع
الذي في قبلة مسجد قباء؛ لبعده جداً([53]).
وقد أكد السمهودي:
في غير موضع من كتابه على هذا الأمر، ورد القول بأن البويرة هي في قبلة
مسجد قباء، فراجع([54]).
بل لقد ذكر البعض:
أن البويرة موضع بين المدينة وتيماء([55])
ولكن العسقلاني قد زاد على ذلك قوله:
«وهي
من جهة قبلة مسجد قباء إلى الغرب»([56]).
ومعلوم:
أن تيماء موضع بين المدينة والشام،
ومنازل بني قريظة إنما هي قبلي المدينة شرقي مسجد قباء أي في الجهة
المقابلة لجهة الشام، فكيف يتلاءم قول العسقلاني هذا مع قوله بأنها إلى
جهة تيماء؟!
ومما يؤكد قول السمهودي
المتقدم:
أنهم يقولون في قصة إجلاء بني النضير:
«فخرجوا
على بلحارث بن الخزرج، ثم على الجبلية، ثم على الجسر، حتى مروا
بالمصلى، ثم شقوا سوق المدينة، والنساء في الهوادج»([57]).
وحين هم اليهود بالغدر برسول الله «صلى الله عليه وآله» ورجع إلى
المدينة، وتبعه أصحابه لقوا رجلاً خارجاً
من المدينة، فسألوه: هل لقيت رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟
قال:
لقيته بالجسر داخلاً([58]).
خامساً:
ومما يدل على ذلك أيضاً: أن وادي مهزور يأتي من شرقي الحرة، ومن هكر،
وحرة صفة، حتى يأتي على حلاة بني قريظة.
ثم يسلك منه شعيب؛ فيأخذ على بني أمية بن زيد بين البيوت في واد يقال
له مذينب، ثم يلتقي وسيل بني قريظة بفضاء بني خطمة، ثم يجتمع الواديان:
مهزور، ومذينب، فيفترقان بالأموال([59])،
ويدخلان في صدقات رسول الله كلها إلا مشربة أم إبراهيم، ثم يفضي إلى
الصورين على قصر مروان بن الحكم([60]).
ونص آخر يقول:
إن دار بني أمية بن زيد شرقي دار الحارث بن الخزرج، أي أنهم كانوا قرب
النواعم، ويمر سيل مذينب بين بيوتهم ثم يسقي الأموال.
ويشهد لذلك:
أن ابن إسحاق ذكر في مقتل كعب بن الأشرف ـ وكان من بني النضير ـ أن
محمد بن مسلمة ومن معه بعد أن قتلوه سلكوا حسب قول ابن مسلمة على بني
أمية بن زيد، ثم على بني قريظة ثم على بعاث إلى آخره([61]).
فقد اتضح من هذا النص:
أن فضاء بني خطمة متصل بالأموال والصدقات (التي هي في زهرة، ومن أموال
بني النضير) وأن قريظة منفصلة عن فضاء بني خطمة ببني أمية بن زيد.
وأخيراً:
فإن المتحصل مما تقدم هو: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد نصب قبته
في أقصى بني خطمة، وكانت نبال المحاصرين تناله، فانتقل إلى السفح،
وهناك صلى بأصحابه.
وأن بني النضير كانوا أقرب إلى بني خطمة من بني قريظة..
وكان بنو قريظة قبلي المدينة شرقي مسجد قباء. أما بنو النضير فكانوا
شرقي المدينة إلى جهة الشام وشتان ما بينهما.. وكل ذلك يؤيد أن يكون
الشعر هو المحرف، والرواية هي الصحيحة..
ويبقى أن نشير هنا:
إلى أن ما ذكره الواقدي، ودحلان، من أن المسلمين قد جعلوا القبة أولاً
عند مسجد بني خطمة، فلما رماها (عزوك) ـ كما في الواقدي وغيره ـ
اليهودي بالسهم، حولت إلى مسجد الفضيخ:
إن هذا لا يصح، وذلك:
أولاً:
لأن مسجد الفضيخ يقع شرقي مسجد قباء، على شفير الوادي، على نشز من
الأرض([62]).
وقد عرفنا:
أن منازل بني النضير بعيدة عن هذا الموضع جداً، كما أن فضاء بني خطمة
كان بعيداً أيضاً.
إلا أن يقال:
إن كون مسجد الفضيخ في قباء موضع شك، ولا يصح، وإنما هو في بني خطمة،
وسيأتي ما يدل على هذا حين الكلام عن تحريم الخمر.
ثانياً:
إن النصوص تصرح:
بأنه «صلى الله عليه وآله» قد ضرب قبته في أقصى بني خطمة، على مرمى سهم
من بني النضير..
ويبعد أن يختط بنو خطمة مسجدهم في أقصى ديارهم، إلى جانب بني النضير.
وتذكر الروايات:
أن النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» قد أمر المسلمين بقطع نخل بني
النضير، والتحريق فيه، وكان ذلك في موضع يقال له:
البويرة؛ فناداه اليهود: أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد، وتعيب من
صنعه، فما بال قطع النخل وتحريقها، فأنزل الله:
﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ
تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ
وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾([63]).
زاد البعض:
أن أهل التأويل قالوا:
«وقع
في نفوس المسلمين من هذا الكلام شيء، حتى أنزل الله:
﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ..﴾([64]).
قال ابن شهرآشوب:
«أمر
بقطع نخلات..
إلى أن قال:
ثم أمسك عن قطعها بمقالهم، واصطلحوا أن يخرجوا»([65]).
وقيل:
أحرقوا نخلة، وقطعوا نخلة، وقيل: كان جميع ما قطعوا وأحرقوا ست نخلات»([66]).
ونحن نشك في أن يكونوا قد قطعوا هذا العدد القليل من النخل، أو أحرقوه،
فإن قطع نخلة واحدة، وحتى ست نخلات، لا يوجب خضوع بني النضير، وقبولهم
بالجلاء، وخزي الفاسقين بصورة عامة، كما نصت عليه الآية الكريمة.
كما أنه لا يوجب نزول آية قرآنية تتحدث عن هذا الأمر، وتخلده كأسلوب
ناجح في إرعاب العدو وإرهابه..
فإنه لا بد أن يكون القطع قد بلغ حداً
جعلهم يجنحون إلى الاستسلام، والقبول بما يريده الرسول، ثم نزلت آية
كريمة تتحدث عن هذا الموضوع، وتفصل الأمر فيه، وتحسم فيه النزاع.
وجزعوا على قطع العجوة، فجعل سلام بن مشكم يقول: يا حيي العذق خير من
العجوة، يغرس فلا يطعم ثلاثين سنة، يقطع.
فأرسل حيي إلى رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
يا محمد، إنك كنت تنهى عن الفساد، لم تقطع النخل؟ نحن نخرج من بلادك.
فقال رسول الله «صلى
الله عليه وآله»:
لا أقبله اليوم الخ..([67])،
«وكانت
النخلة ثمن وصيف، وأحب إليهم من وصيف»([68]).
وجاء في نص آخر:
أن الذي حرق نخلهم وقطعها عبد الله بن سلام، وعبد الرحمن بن كعب، أبو
ليلى الحراني، من أهل بدر،
فقطع أبو ليلى العجوة، وقطع ابن سلام اللون، فقال رسول الله «صلى الله
عليه وآله»: لم قطعتم العجوة؟!
قال أبو ليلى:
يا رسول الله، كانت العجوة أحرق لهم وأغيظ، فنزل:
﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ
تَرَكْتُمُوهَا..﴾([69])
الآية..
فاللينة:
ألوان النخل.
والقائمة على أصولها:
العجوة.
فنادوا:
يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد الخ..([70]).
وصرحت بعض النصوص:
بأن النبي «صلى الله عليه وآله» قد استعمل ابن سلام، وأبا ليلى المازني
على قطع النخل([71])،
أو أمرهما([72])،
أو أشار إليهما
بذلك([73]).
وأضاف الدياربكري قوله:
«أما
أبو ليلى فكان يقطع أجود أنواع التمر، وهي العجوة، ويقول: قطع العجوة
أشد عليهم.
وأما عبد الله بن سلام، فكان يقطع أردأ أنواع التمر، وهو تمر يقال له:
اللون، ويقول: إني أعلم: أن الله سيجعلها للمسلمين الخ..»([74]).
فلما قطعت العجوة شق النساء الجيوب، وضربن الخدود، ودعون بالويل؛ فقال
رسول الله «صلى الله عليه وآله»: ما لهن؟!
فقيل:
يجزعن على قطع العجوة.
فقال رسول الله «صلى
الله عليه وآله»:
إن مثل العجوة جزع عليه.
إلى أن قال:
فلما صحن صاح بهن أبو رافع: إن قطعت العجوة ههنا، فإن لنا بخيبر عجوة.
قالت عجوز منهن:
خيبر يصنع بها مثل هذا.
فقال أبو رافع:
فض الله فاك، إن حلفائي
بخيبر عشرة آلاف مقاتل؛ فبلغ رسول الله «صلى الله عليه وآله» فتبسم.
ونحن نسجل هنا الأمور التالية:
1 ـ
لماذا ابن سلام؟!
إننا نجد:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد استعمل ابن سلام ـ وهو كان من اليهود، من
علمائهم ـ مع ذلك الرجل البدري على قطع نخل يهود بني النضير.. ومن
الطبيعي أن يكون لذلك أثر ظاهر في بث اليأس في نفوسهم، وفي إذلالهم
وخزيهم، ويساهم في كسر شوكتهم، ويثير فيهم المزيد من الحنق، والغيظ
والألم، وهم ذوو الغطرسة، والعنجهية والخيلاء، كما سيأتي توضيحه في
موضعه إن شاء الله تعالى.
ونلاحظ هنا:
كيف أن ابن سلام قد اختار أردأ أنواع التمر، على الرغم من أنه «صلى
الله عليه وآله» قد أمر بقطع النخل بصورة مطلقة، ولم يقيد بشيء، ورغم
أنه قد كان من الواضح: أن الهدف من هذا الإجراء هو الضغط على هؤلاء
القوم، وإغاظتهم، وإذلالهم،
وذلك إنما يتحقق بقطع ما له أثر ظاهر في ذلك، كما فهمه وعمل به ذلك
الرجل البدري، الذي جعله الرسول إلى جانب ابن سلام.
ولا نريد أن نسترسل في شكوكنا حول ابن سلام هذا ونواياه؛ فنتهمه
بالتعاطف مع اليهود الذين كان في وقت ما أحد علمائهم وكبرائهم، حسبما
يذكره التاريخ عنه.
ولعل هذه الشكوك تجد لها أكثر من مؤيد وشاهد فيما ينقل عن هذا الرجل من
مواقف، وأقوال، واتجاهات، وأحوال، ولا سيما بعد وفاة الرسول الأكرم
«صلى الله عليه وآله».
ولسنا هنا في صدد عرض ذلك واستقصائه، فلنكف عنان القلم ـ إذاً ـ إلى ما
هو أهم، ونفعه أعم وأتم.
ومن العجيب هنا قول
البعض:
«لما
أمر النبي «صلى الله عليه وآله» بقطع النخيل، وإحراقها ترددوا في ذلك،
فمنهم الفاعل، ومنهم الناهي، ورأوه من الفساد وعيّرهم اليهود بذلك،
فنزل القرآن العظيم بتصديق من نهى، وتحليل من فعل، فقال تعالى:
﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ
تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ الله
وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾([75]).
مع أن الآية ظاهرة الدلالة في تأييد أولئك الذين امتثلوا أمر النبي
«صلى الله عليه وآله»، وأن أمره إنما كان بإذن الله، وليس من عند نفسه.
فالآية في الحقيقة قد جاءت لتقريع وتأنيب المخالفين لأمر الرسول الأعظم
«صلى الله عليه وآله». لكن هذا الرجل قد عكس الآية في مفادها ومدلولها،
ولم يلتفت إلى المراد منها.
وبعد..
فإننا نجد النصوص التاريخية تكاد تكون مجمعة على أنه «صلى الله على
وآله» قد حرق النخيل. ولكن الآية الكريمة التي نزلت في هذه المناسبة لم
تشر إلى ذلك أصلاً،
وإنما سجلت القطع فقط. فلربما يكون الأمر منه «صلى الله عليه وآله» قد
صدر بالقطع دون الحرق، فكان الحرق من بعض المسلمين، اجتهاداً
منهم، ولعله لم يكن ثمة حرق أصلاً،
والله أعلم.
لقد أفتى عدد من الفقهاء بحرمة قطع الأشجار في الحرب، إلا في حال
الضرورة([76]).
وحكم كثير من الفقهاء بالكراهة([77]).
وقيد البعض بصورة ما لو رجي صيرورته للمسلمين، وكان مما يقتات به([78]).
وقد عرفنا في ما تقدم:
أن التاريخ يؤكد على أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» هو الذي أمر
بحرق نخل بني النضير، أو قطعه. وقد تحدث القرآن عن القطع هذا بأسلوب
الرضا والقبول، حسبما تقدم.
وروي أيضاً:
أنهم قد قطعوا الشجر والنخل بالطائف، بالإضافة إلى قطع النخل بخيبر،
وروي أيضاً قطع شجر بني المصطلق وإحراقه([79]).
وعن أسامة بن زيد قال:
بعثني رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى قرية يقال لها:
«أُبنى».
فقال:
«ائت
أُبنى
صباحاً
ثم حرق».
أي بيوتهم وزروعهم، ولم يُرد تحريق أهلها([80]).
وفي مجال آخر:
فإنه «صلى الله عليه وآله» قد أمر بحرق مسجد الضرار وهدمه([81]).
وأمر «صلى الله عليه وآله» بتحريق متاع الغال([82]).
وروي أنه «صلى الله عليه وآله» هم بحرق بيوت تاركي صلاة الجماعة([83]).
وقد بلغه «صلى الله عليه
وآله»:
أن ناساً
من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي يثبطون الناس عن رسول الله
«صلى الله عليه وآله» في غزوة تبوك فبعث إليهم نفراً،
وأمرهم أن يحرقوا عليهم بيت سويلم([84]).
وبعد ما تقدم..
فإن السؤال الذي يتطلب منا الإجابة هنا هو:
أنه
إذا كان رسول الله قد أمر بذلك كله، أو همّ به؛ فكيف نوفق بين أمره هذا
وبين فتوى الفقهاء بالحرمة، أو بالكراهة، حسبما تقدم؟!!.
بل لقد ورد:
أنه «صلى الله عليه وآله» كان حين يرسل سرية، يوصيهم بأن لا يقطعوا
شجراً
إلا أن يضطروا إليها([85]).
وعن ثوبان:
أنه سمع رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول:
«من
قتل صغيراً،
أو كبيراً،
أو أحرق نخلاً، أو قطع شجرة مثمرة، أو ذبح شاة لإهابها، لم يرجع كفافاً»([86]).
أضف إلى ذلك كله:
أن اليهود أنفسهم قد اعترضوا على النبي «صلى الله عليه وآله» بأنه ينهى
عن الفساد، فلم يقطع النخل؟! وقد تقدم ذلك..
فقد يقال:
في مقام الإجابة على ذلك استناداً
إلى رواية ثوبان المتقدمة: أن المنهي عنه هو قطع الشجر المثمر، وعلى حد
تعبير السهيلي: أنه «صلى الله عليه وآله» إنما أحرق ما ليس بقوت للناس.
قال السهيلي:
«لينة:
ألوان التمر، ما عدا العجوة، والبرني؛ ففي هذه الآية: أن النبي «صلى
الله عليه وآله» لم يحرق من نخلهم إلا ما ليس بقوت للناس،
وكانوا يقتاتون العجوة.. (ثم ذكر أهمية العجوة والبرني، ثم قال): في
قوله تعالى:
﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ..﴾([87])
(ولم يقل: من نخلة، على العموم) تنبيه على كراهة قطع ما يقتات، ويغذو
من شجر العدو. إذا رجى أن يصير إلى المسلمين.
وقد كان الصديق (رض) يوصي الجيوش ألا يقطعوا شجراً
مثمراً.
وأخذ بذلك الأوزاعي؛ فإما تأولوا حديث بني النضير، وإما رأوه خالصاً
للنبي «عليه السلام»([88]).
ولكننا لا نوافق السهيلي على ما قاله، وذلك لما يلي:
ألف:
بالنسبة لما ذكره في معنى اللينة، نجد كثيراً من أهل اللغة لا يوافقونه
على ما ذكره في معناها، فقد:
قال الراغب وغيره:
«﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ..﴾:
أي من نخلة ناعمة، ومخرجه مخرج فعلة، نحو حنطة، ولا يختص بنوع منه دون
نوع.
وكذا نقل عن ابن زيد، وعمرو بن ميمون، ومجاهد»([89]).
وقال:
«سعيد
بن جبير، ومالك، والخليل، ويزيد بن رومان، ورجحه النووي، وكذا قال
الفراء والزهري، وعكرمة، وقتادة، وابن عباس، ونسب إلى أهل المدينة:
اللينة كل شيء من النخل سوى العجوة؛ فهو من اللين، واحدته لينة»([90]).
وقال الزبيدي:
كذا عن ابن عباس ومقاتل، وعن الحسن، ومجاهد وعطية:
«اللينة
ـ بالكسر ـ:
النخل»([91]).
وقيل:
هي كل الأشجار([92]).
وقال سفيان:
هي كرام النخل وكذا عن مجاهد، وابن زيد([93]).
وقال آخر، ونسب ذلك إلى مجاهد، وعطية:
﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ﴾([94]):
أي من نخل، والنخل كله، ما عدا البرني([95]).
وعن مقاتل، هي:
«ضرب
من النخل يقال لتمرها: اللون، وهي شديدة الصفرة، يرى نواها من خارج،
تغيب فيها الأضراس، وكانت من أجود تمرهم، وأحبها إليهم، وكانت النخلة
الواحدة ثمن وصيف، وأحب إليهم من وصيف؛ فلما رأوهم يقطعونها شق عليهم»([96]).
وقيل:
هي الدقل([97])،
إلى غير ذلك من أقوال.
ب:
قولهم: إنه قطع اللين وترك العجوة، لا تؤيده النصوص التاريخية.
فقد قال دحلان:
«..فقطع
لهم نخل يسمى:
«العجوة»،
وآخر يسمى:
«اللين»،
وكان ذلك أحرق لقلوبهم؛ لأن ذلك خير أموالهم؛ فلما قطعت العجوة شق
النساء الجيوب، وضربن الخدود، ودعون بالويل».
وكذا قال غيره([98]).
زاد الحلبي قوله:
وكانت العجوة خير أموال بني النضير لأنهم كانوا يقتاتونه([99]).
وعن الماوردي:
وكانت العجوة أصل الإناث كلها، فلذلك شق على اليهود قطعها([100]).
وعن الإمام الصادق «عليه
السلام» في تفسير اللين:
أنها
العجوة خاصة([101]).
وتقدم:
أن أبا ليلى قطع العجوة، وأن ابن سلام قطع اللون،
وتقدم أنهم جزعوا على قطع العجوة، فراجع ما جاء تحت عنوان
«تفاصيل
أخرى في حرق وقطع النخيل».
ج:
ولو قبلنا تفسير السهيلي لكلمة
«لينة»
فإن ما ذكره لا يحل الإشكال؛ ما دام أنه كان ينهى سراياه عن قطع مطلق
الشجر، فكان يقول لهم:
«ولا
تقطعوا شجراً»،
ولا يختص ذلك بالشجر الذي يقتات منه، ولا بالشجر المثمر..
د:
ولو قبلنا أيضاً أن المراد هو خصوص ما يقتات منه، فإن ما عدا العجوة
والبرني كان أيضاً مما يقتات به، ويؤكل.. غاية الأمر أن جودة ثمره لم
تكن في مستواهما وإنما هو رديء بالنسبة إليهما.
هـ:
ولو
قبلنا كل ما ذكره السهيلي فإننا نقول: إن قوله بكراهة قطع الشجر في
صورة ما لو رجي أن يصير للمسلمين، في غير محله؛ فإن النهي عن قطع الشجر
مطلق، ولم يقيد بصورة الرجاء المذكور.
نعم،
هو قد جاء على لسان الحبر اليهودي عبد الله بن سلام، ولم يعلم من النبي
«صلى الله عليه وآله» أنه قبله ورضيه.
و:
وأما قوله، إن الأوزاعي وأبا بكر: قد تأوّلا حديث بني النضير، أو أنهما
رأيا أنه مختص برسول الله «صلى الله عليه وآله» حيث منعا من قطع الشجر
المثمر مطلقاً.
فليس في محله أيضاً؛ فإنهما قد فهما ذلك من كلامه «صلى الله عليه وآله»
في نهيه عن قطع الشجر، فحكما بمقتضاه، ولم يخصصا حكمهما هذا بشخص ولا
بشيء، وإنما هما قد وجدا: أنه «صلى الله عليه وآله» قد اضطر إلى قطع
شجر بني النضير، فأجازا ذلك للضرورة؛ فإن قطع الشجر لأجل الضرورة مما
رخص به النبي «صلى الله عليه وآله» في نفس وصاياه لسراياه، حسبما
ألمحنا إليه([102]).
وإذاً..
فهما لم يريا أن ذلك من الأحكام المختصة به «صلى الله عليه وآله».
لقد نزل القرآن ليرد على الذين عابوا قطع الأشجار، وليؤكد على أن ذلك
كان بإذن من الله سبحانه، تماماً
كما كان ترك ما ترك منها بإذن الله تعالى..
إذاً، فلا بد لنا من التعرف على السر الكامن وراء تجويز هذا العمل،
وصيرورته مقبولاً،
بعد أن كان مرفوضاً،
ومأذوناً
به بعد أن كان ممنوعاً عنه.
فنقول:
إن الذي يبدو لنا هو:
أن بني النضير أهل الزهو والخيلاء، والعزة([103])
كانوا يحسون في أنفسهم شيئاً من القوة، والمنعة في قبال المسلمين،
ويجدون: أن بإمكانهم مواجهة التحدي، فيما لو أتيح لهم إطالة أمد
المواجهة، حيث يمكنهم أن يجدوا الفرصة لإقناع حلفائهم بمعونتهم، ولا
سيما إذا تحرك أهل خيبر الذين كان لديهم العدة والعدد الكثير، حسبما
تقدم في كلمات سلام بن مشكم. كما أن ابن أُبي
ومن معه قد يراجعون حساباتهم، ويفون لهم بما وعدوهم به من النصرة
والعون.
ولا أقل من أن يتمكن ابن أُبي
وأتباعه من إحداث بلبلة داخلية، من شأنها إرباك المسلمين وزعزعة ثباتهم
من الداخل.
وقد يمكن لقريش، ولمن يحالفها من قبائل العرب، أن يتحركوا أيضاً لحسم
الموقف لصالح بني النضير، وصالحهم بصورة عامة.
ولا أقل من أن يتمكن يهود بني النضير من الاحتفاظ بمواقعهم، وبأرضهم
وديارهم، حين يجد المسلمون: أن مواصلة التحدي لهم لن تجدي نفعاً،
ما داموا قادرين على الاحتماء بحصونهم، والدفاع عنها مدة طويلة،
فيتراجعون عن حربهم، ويتركونهم وشأنهم، من أجل التفرغ إلى ما هو أهم،
وأولى.
وإذا كانت قضية بني النضير قد حصلت بعد وقعة أحد ـ وإن كنا لم نرتض ذلك
ـ فلا بد أن يكون اليهود قد فكروا: أن محمداً
«صلى الله عليه وآله» وأصحابه قد أصبحوا الآن في موقف الضعف والتراجع.
ولعل في تسويف الوقت معهم، في الوقت الذي يحس فيه المسلمون بالفشل
وبالكارثة، نتيجة لما نزل بهم في أحد، لسوف يجعلهم يفكرون في انتهاج
سبيل السلامة، والانسحاب من موقع التحدي إلى موقع المساومة، ومن سبيل
الحرب إلى سبيل السلم، وتوفير الأمن، ومراعاة جانب هؤلاء وأولئك، وعدم
إثارة العداوات الكبيرة داخل بلادهم، وفي قلب مواضعهم ومواقعهم.
وأما إذا كانت قضية بني النضير قد حصلت قبل ذلك، وبعد ستة أشهر من حرب
بدر، حسبما قويناه، استناداً
إلى العديد من الدلائل والشواهد:
فلعل يهود بني النضير قد
فكروا:
أن المسلمين لسوف لا يفرطون بهذا النصر الكبير الذي حققوه، ولعلهم على
استعداد لمداراة هؤلاء وأولئك في سبيل الحفاظ على صلابة الموقف وثباته،
ولسوف لا يقدمون على أي عمل من شأنه إحداث خلخلة في بنية مجتمعهم. ولعل
اليهود يعتقدون: أن حرب بدر كانت أمراً
اتفاقياً
صنعته الصدفة، والحظ السيء للمشركين، وليس نتيجة قدرات حقيقية كانت لدى
المسلمين. وإذاً فليس ثمة ما يخيف، وليس هنالك ما يثير قلقاً.
أما هم ـ أعني بني النضير ـ فيجدون في أنفسهم القوة والمنعة، ولهم
حلفاء كثيرون، وكثيرون جداً.
وبعد كل ما تقدم،
فقد جاء موقف الإسلام، المتمثل في موقف رسوله الأعظم «صلى الله عليه
وآله»، في دقته، وفي ثاقب بصيرته ـ قد جاء ـ على خلاف ما يتوقعون،
وبغير ما يريدون ويشتهون.
فقد رأى المسلمون، من خلال الموقف النبوي الحازم والقوي: أن النصر في
بدر، وكذلك الضربة القاسية التي نزلت في أحد، لا بد أن تعمق فيهم
إيمانهم، وارتباطهم بالله سبحانه، وتقوي من صمودهم، وتشد من عزائمهم.
وقد جعلهم هذا النصر، وتلك المأساة يشعرون بمسؤولية أكبر تجاه الرسالة،
حيث أصبحوا في موقع التحدي السافر لكل مظاهر الظلم والجبروت والطغيان
ومصادره.
وعليهم من الآن فصاعداً
أن يطردوا من آفاقهم كل مظاهر الضعف، وأن ينقوا أجواءهم من جميع عوامل
التشرذم والتشتت، وأن يبعدوا عن واقعهم وعن علاقاتهم، جميع مصادر
الخلل، وعدم الانسجام.
فالتحدي كبير، والمسؤوليات جليلة وخطيرة، فلا بد من الاستعداد ولا بد
من التصدي، بصورة أعمق، وأوثق وأوفق، ما دام أنهم قد وصلوا إلى نقطة
اللارجوع، وأصبح الثمن غالياً،
وهو دماء زكية، وأرواح طاهرة، ونقية، فالحفاظ على القضية، وعلى
منجزاتها، التي دفعوا ثمنها جزء من وجودهم ومن ذواتهم وأرواحهم أمر
حتمي، إذ
إن
التخلي عنها يساوق التخلي عن الحياة وعن الوجود، وعن كل شيء.
وقد اتضح لديهم:
أن أي تراجع أمام التحديات الكبيرة الراهنة، لسوف تلحقه تراجعات أعظم،
ويستتبع انحساراً
أكبر عن كثير من المواضع والمواقع الحساسة، لصالح كل الأعداء
والطامعين، في منطقة العمل والكفاح الإسلامي المقدس.
كما أن هذا التراجع والانحسار لسوف يزيد من اشتهاء الآخرين للحصول على
المزيد من المكاسب، ويضاعف من تصلبهم وشدتهم في مواجهة المد الإسلامي
العارم. ولسوف تنتعش الآمال، وتحيا الأماني، بإضعاف هذا المد تدريجاً،
ثم القضاء عليه قضاء مبرماً
ونهائياً
في الوقت المناسب. وأما بالنسبة إلى أولئك الذين يميلون إلى الدخول في
هذا الدين الجديـد،
فإنهم حين يرون ضعفه، وتراجعه، وقوة خصومـه
وشوكتهم، لسـوف
يجـدون
في أنفسهم المـبررات
الكـافية
للتأني والتريث بانتظـار
المستجدات، وما ستؤول إليه الأمور.
ولربما يتشجع الكثيرون أيضاً على نقض تحالفاتهم، التي كانوا قد عقدوهـا
مع المسلمين ما دام أن ذلـك
لن يستتبع خطـراً،
ولا يصطـدم
بصعوبات ذات بال.
كما أن الآخرين الذين يعيشون حالة الترقب سوف لا يجدون في أنفسهم حاجة
لعقد تحالفات ومعاهدات مع المسلمين في هذه الظروف المستجدة.
وأخيراً.. فإننا نضيف
إلى كل ما تقدم:
أن من الطبيعي أن يكون خوض معركة كبيرة مع اليهود ـ وربما مع كثير من
حلفائهم، الذين قد يتشجعون لمسـاعـدة
اليهـود
بعـد
طـول
المـدة،
وبعـد
إحساسهم بقوتهم وصلابتهم في وجه الحصار، وبضعف في موقف المسلمين ـ سوف
يوجب أن تلحق بالمسلمين خسائر كبيرة، مادية وبشرية، لو أمكن توفيرها
لما هو أهم لكان أجدر وأولى.
فإذا استطاع النبي «صلى الله عليه وآله» والمسلمون كسر عنجهية بني
النضير وغزوهم قبل أن يستفحل الأمر، وإفهامهم ـ ومن هو على مثل رأيهم
ـ مدى التصميم على المواجهة والتحدي، حتى يفقدوا الأمل بجدوى المقاومة،
وليفهموا ـ بصورة عملية ـ أنهم إذا كانوا يطمعون بالبقاء في أرضهم، فإن
عليهم أن يقبلوا بها أرضاً
محروقة، جرداء، ليس فيها أي أثر للحياة، ولا تستطيع أن توفر لهم حتى
لقمة العيش التي لا بد منها ـ هذا فيما لو قدر لهم أن يحتفظوا بالحياة،
ويخرجوا أو بعضهم سالمين من هذه الحرب التي جروها على أنفسهم ـ.
نعم..
إنه «صلى الله عليه وآله» إذا استطاع ذلك، فإنه يكون قد وفر على نفسه،
وعلى الإسلام والمسلمين الكثير من المتاعب، والمصاعب، والمصائب، التي
ألمحنا إليها.
وهذا هو ما اختاره رسول الله «صلى الله عليه وآله» فعلاً،
وبادر إليه عملاً.
فكان قطع النخيل وحرقه يمثل قطع آخر آمالهم، وتدمير كل أمانيهم، وغاية
ذلهم وخزيهم.
ورأوا حينئذٍ:
أن لا فائدة من الاستمرار في اللجاج والتحدي إلا تكبد المزيد من
الخسائر، ومواجهة الكثير من النكسات.
وهذا بالذات،
هو ما يفسر لنا قوله تعالى في تعليل إذن الله سبحانه بقطع النخل:
﴿..وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾.
فقد كان قطع النخل ضرورياً
ولازماً،
من أجل قطع آمال بني النضير، وكل آمال غيرهم أيضاً، وخزيهم وخزي سائر
حلفائهم، وعلى رأسهم ابن أُبي،
ومن معهم من المنافقين، ثم كل من يرقب الساحة، ويطمع في أن يستفيد من
تحولاتها في تحقيق مآربه ضد الإسلام، والمسلمين.
ومن هنا نعرف السر في
قوله تعالى:
﴿..وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾
بدل:
«الكافرين»،
من أجل أن يشمل الخزي كل من يسوءه ما جرى لبني النضير، حتى أولئك الذين
يتظاهرون بالإسلام، أو بالمودة الكاذبة للمسلمين.
وهذه ما يفسر لنا:
الاهتمام الكبير الذي أولاه سبحانه لموضوع قطع النخل، حتى لقد خلده في
آية قرآنية كريمة،
فإن القضية كانت أكبر من بني النضير، وأخطر، حسبما أوضحناه.
بقي علينا أن نشير هنا
إلى أن البعض يذكر:
أن المهاجرين هم الذين اختلفوا فيما بينهم حول قطع النخل.
فعن مجاهد، قال:
نهى بعض المهاجرين بعضاً
عن قطع النخل، قالوا: إنما هي مغانم للمسلمين([104]).
ونلاحظ:
أن هذا بالذات كان رأي عبد الله بن سلام، الذي كان يهودياً
فأسلم، رغم أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان قد أمره بقطع النخل،
فعلل اختياره للرديء بذلك كما ذكرنا.
ولنا أن نتساءل هنا:
لماذا المهاجرون هم الذين ينهون عن ذلك؟!
ولماذا لم يكن فيهم أحد من الأنصار؟
سوى ابن سلام!!
وربما رجل آخر أيضاً!!
فهل أدرك المهاجرون أمراً
عجز الأنصار عن إدراكه؟! أم أنهم قد اتخذوا هذا الموقف انطلاقاً
من مصالح رأوا أنها لربما تفوتهم، لو استمر الأمر على النحو الذي خطط
له رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!
أم أنه قد كانت ثمة خلفيات أخرى، لم يستطع التاريخ أن يفصح لنا عنها،
لسبب، أو لآخر؟!
وإذا كانت النصوص كلها
تقريباً تؤكد على:
أن الرسول الأعظم نفسه هو الذي أمر بقطع نخلهم([105])..
فإن معنى ذلك هو:
أن اعتراض هذا الفريق من المهاجرين قد كان متوجهاً
إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالذات. وأن
الفريق الآخر منهم إنما كان ينفذ أمره «صلى الله عليه وآله».
ولا نملك هنا إلا
التذكير بأنه قد سبق لبعض المهاجرين:
أن اعترضوا على رسول الله، حينما أراد قتل أسرى بدر، وأصروا عليه في
ترك ذلك، حتى نزل القرآن مُصوّباً رأيه «صلى الله عليه وآله».
ولكنهم لم يقنعهم ذلك، رغم أنه «صلى الله عليه وآله» قد أخبرهم: أنه
سيقتل بعدتهم فيما بعد، لو تم إطلاق سراحهم.. وهكذا كان.
وقد سجلنا بعض الشكوك والتساؤلات حول موقف بعض المهاجرين في حرب أحد([106])
فلا نعيد.
ومهما يكن من أمر،
فإننا لا نستطيع أن نفهم موقف هذا الفريق من المهاجرين هنا، وكذلك موقف
بعضهم في بدر، وأُحد،
بصورة ساذجة ولا أن نفسره بطريقة سطحية، ما دام أن الدلائل تشير إلى
خلفيات، ودوافع غير معلنة، ولا ظاهرة، يؤثر الوقوف عليها في استجلاء
كثير من الحقائق، والوقوف على بواطن وكوامن كثيرة، ولربما على مبهمات
خطيرة، تؤثر على فهمنا العام لكثير من المواقف في حياة العديد من
الشخصيات التي كان لها دور مرموق في كثير من الأحداث الخطيرة في
التأريخ الإسلامي.
وخلاصة الأمر:
أن البحث الموضوعي يقضي بتقصي النصوص والمواقف واستنطاقها، لمعرفة مدى
تعاطف بعض المهاجرين مع قومهم المكيين، ومع يهود المدينة، ليمكن لنا
تقييم مواقفهم، وفهم معاني كلماتهم، وإشاراتها ومراميها، بصورة أدق
وأعمق، وليكون تصورنا أقرب إلى الواقع، وأكثر شمولية، وأتم وأوفى.
وفي إشارة خاطفة نذكّر:
بأننا قد تحدثنا عن أن المهاجرين كانوا يشكلون تكتلاً
مستقلاً،
له تطلعاته وطموحاته، وله فكره المتميز في آفاقه وفي خصائصه، ولا سيما
في ما يرتبط بالسياسة والحكم والتخطيط له.
أما الأنصار، فلم يكونوا كذلك، بل كانوا فريقاً
آخر، يحرم من اهتمامات الحكام، ويستثنى من مختلف الامتيازات، إلا حيث
يحرج الحاكم، ولا يجد من ذلك بداً
ولا مناصاً.
وقد روي عن الخليفة الثاني، عمر بن الخطاب قوله:
«أوصي
الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين: أن يعرف لهم حقهم، ويحفظ لهم حرمتهم.
وأوصيه
بالأنصار، الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم: أن يقبل من محسنهم،
ويتجاوز عن مسيئهم»([107]).
فيلاحظ:
الفرق النوعي فيما يطلبه ثاني الخلفاء ممن يلي الأمر بعده بالنسبة
لهؤلاء، وبالنسبة لأولئك.
وعلى هذا الأساس، ومن منطلق هذه الفوارق،
جاء قول ابن أبي ليلى: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون، والذين
تبوؤوا الدار والإيمان، والذين جاؤوا من بعدهم: فاجهد: ألا تخرج من هذه
المنازل.
وقال بعضهم:
كن شمساً،
فإن لم تستطع، فكن قمراً
فإن لم تستطع فكن كوكباً
مضيئاً؛
فإن لم تستطع فكن كوكباً
صغيراً،
ومن جهة النور لا تنقطع.
ومعنى هذا:
كن مهاجرياً،
فإن قلت: لا أجد، فكن أنصارياً،
فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم الخ..([108]).
ولا ندري من أين جاءت هذه الطبقية، وكيف قبل الناس هذا التمييز الذي لا
يقوم على تقوى الله، وإنما على عناوين وخصوصيات فرضتها طبيعة التحرك في
مجال نشر الدعوة وتركيزها؟ ويوضح ذلك أن عمر بن الخطاب حين خطب
بالجابية قال:
«ومن
أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن
الله تعالى جعل له خازناً
وقاسماً.
ألا وإني بادئ
بأزواج النبي
«صلى
الله عليه وآله»
فمعطيهن، ثم المهاجرين الأولين، أنا وأصحابي، أخرجنا من مكة من ديارنا
وأموالنا»([109]).
ومهما يكن من أمر،
فإنك تجد في كتابنا هذا إشارات ونصوصاً كثيرة في مواضع مختلفة توضح ما
عانى منه الأنصار، واختص به المهاجرون. واستيفاء البحث في هذا يحتاج
إلى توفر تام، وتأليف مستقل.
لقد استدل البعض بقوله تعالى:
﴿مَا قَطَعْتُم مِنْ لِينَةٍ أَوْ
تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ
وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾([110])
على جواز الاجتهاد، وعلى تصويب المجتهدين([111]).
كما واستدلوا على جواز الاجتهاد بحضرة الرسول، وعلى أن كل مجتهد مصيب،
بالرواية التي تقول:
إن رجلين، أحدهما كان يقطع العجوة، والآخر اللون، فسألهما «صلى الله
عليه وآله» فقال هذا: تركتها لرسول الله.
وقال هذا:
قطعتها غيظاً
للكفار([112]).
ونقول:
إن الاستدلال بما ذكر لا يصح، وذلك لما يلي:
1 ـ
بالنسبة للاستدلال بالرواية على التصويب فقد قال ابن العربي:
«وهذا
باطل، لأن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان معهم، ولا اجتهاد مع
حضور رسول الله «صلى الله عليه وآله»([113]).
2 ـ
إن الرواية المذكورة لم تصرح بأن النبي «صلى الله عليه وآله» أمضى
اجتهادهما أم لا. حيث إنها ذكرت اعتذارهما للنبي «صلى الله عليه وآله»
بهذا الشأن، فهل أيد هذا الفريق؟ أو ذاك؟ أو لم يؤيد أياً
منهما؟ كل ذلك لا دليل عليه، ولا شيء يشير إليه.
3 ـ
إنه ـ لو فرض أن هذا اجتهاد ـ فإنما هو اجتهاد بالتطبيق، فواحد يرى: أن
هذا جائز، لأن فيه نكاية في العدو، والنكاية في العدو، وإغاظته مطلوبة
منه وواجب عليه.
وذاك يرى:
أن تقوية المسلمين مطلوبة، وأن في الاحتفاظ بالنخل تقوية لهم، وعملاً
بالحكم الشرعي.
فليس ثمة اجتهاد في حكم شرعي كلي من الأحكام الخمسة، وإنما هم مختلفون
في تشخيص موضوع الحكم الشرعي أي فيما هو المصلحة لهم، وما فيه نكاية في
العدو.
4 ـ
من الذي قال: إن هؤلاء الذين اختلفوا في قطع النخل وعدمه، كانوا قد
بلغوا رتبة الاجتهاد؟ فلعل أحداً منهم لم يكن قد بلغ هذه المرتبة
الشريفة، ولعل أحد الفريقين قد بلغها دون الآخر، ولعل،
ولعل.
5 ـ
إنه إذا كان الرسول «صلى الله عليه وآله» هو الذي أمر بقطع النخل، كما
صرحت به النصوص المتقدمة عن مصادر كثيرة جداً، فإن الاستدلال على جواز
الاجتهاد والتصويب فيه بالآية الكريمة يصبح في غير محله، وذلك لأن عدم
القطع يصير اجتهاداً
في مقابل النص، بل هو عصيان لأمر الرسول، وشك في صواب ما يصدر منه «صلى
الله عليه وآله».
ولعله «صلى الله عليه وآله» قد أمرهم بقطع نوع من النخيل، فلم يعجبهم
ذلك، فعصوا الأمر.
6 ـ
إن التصويب باطل، ولا يصح، لا عقلاً،
ولا شرعاً،
وقد تكلم الأصوليون على هذا الأمر بالتفصيل، فمن أراد الوقوف على ذلك
فليراجع المطولات([114]).
قال السمهودي ـ كما قال
غيره ـ:
«ولما
حرق رسول الله «صلى الله عليه وآله» نخلهم،
قال حسان رضي الله عنه يعير قريشاً
من أبيات:
وهـان عـلـى
سـراة بـنـي لــؤي حـريـق بـالـبـويـرة مـسـتـطــير
فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ولم يكن أسلم حينئذٍ:
أدام الله
ذلــك مـــن صــنـيــع وحــرق فـي نـواحـيـهـا السعـير
سـتـعـلـم أيـنـا مـنهـا بـــنــزه وتـعـلـم أي أرضـيـنــا تــضـير
أي ستعلم أينا منها ببعد، وأي الأرضين أرضنا أو أرضكم يحصل لها الضير،
أي الضرر، لأن بني النضير إذا خربت أضرت بما جاورها، وهو أرض الأنصار،
لا أرض قريش.
ونقل ابن سيد الناس، عن
أبي عمرو الشيباني:
أن الذي قال البيت المتقدم، المنسوب لحسان هو:
أبو سفيان بن الحارث، وأنه لما قال: وعز على سراة بني لؤي، بدل: هان
قال: ويروى (بالبويلة) بدل (بالبويرة) وأن المجيب له بالبيتين
المتقدمين هو حسان.
وما قدمناه هو رواية البخاري.
قال ابن سيد الناس:
وما ذكره الشيباني أشبه.
قلت:
كأنه استبعد أن يدعو أبو سفيان في حالة كفره على أرض بني النضير، وقد
قدمنا وجهه([115]).
انتهى كلام السمهودي.
ولكننا بدورنا نؤيد ما ذكره ابن سيد الناس، وذلك لأن تفسير السمهودي
للبيت الثاني غير مفهوم، فإن حريق النخل لا يلزم منه لحوق الضرر بأراضي
الأنصار.
كما أن تفسيره، الذي ذكره لا يدفع كلام ابن سيد الناس، وذلك لأن البيت
الأول من بيتي الجواب، فيه الدعاء والطلب من الله أن يديم هذا الصنيع.
وظاهره:
أن ذلك الدعاء يصدر من رجل محب وموال وموافق على هذا الحريق.
كما أن من البعيد أن يكون قد وصل خبر حرق النخل إلى مكة، ثم وصل شعر
حسان إليهم، وأجابوا عليه بالطلب من الله إدامة هذا الأمر من أجل أن
تحترق أراضي الأنصار،
فإن أمر بني النضير قد فرغ منه خلال أيام.
ومن جهة أخرى:
فإن البيت الأول يناسبه كلمة وعز؛ لأن سراة بني لؤي ـ وهم مشركو مكة ـ
يعز عليهم حدوث هذا الحريق في بني النضير، ولا يهون عليهم.. إلا إذا
كان يقصد بسراة بني لؤي النبي «صلى الله عليه وآله» ومن معه.
أو كان يقصد:
أن هذا الحريق لا تهتم له قريش ولا يضرها بشيء، فأجابه حسان بأن ذلك
سوف يضيرهم قطعاً، ولن تتضرر أرض الأنصار منه.
ومهما يكن من أمر،
فإنه لم يتضح لنا وجه تقويته لأن يكون البيت الأول لحسان.. والبيتان
الآخران لأبي سفيان بن الحارث..
ولعل كلام ابن سيد الناس أولى بالقبول، وأقرب إلى اعتبارات العقول.
وأخيراً.. فقد قال العيني:
في ترجيح قول ابن سيد الناس:
«يصلح
للترجيح قول أبي عمرو الشيباني، لأنه أدرى بذلك من غيره على ما لا يخفى
على أحد»([116]).
([1])
الثقات ج1 ص241 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص552، والمغازي
للواقدي ج1 ص367 ودلائل النبوة لأبي نعيم ص427. وإرسال محمد بن
مسلمة إليهم موجود في مختلف المصادر، فراجع على سبيل المثال:
السيرة الحلبية ج2 ص264 وتفسير القمي ج2 ص359 وإعلام الورى ص89
وتاريخ الخميس ج1 ص460 ومجمع البيان ج9 ص258 والسيرة النبوية
لابن كثير ج3 ص147 والبحار ج20 ص160 و 164 و 169 عن بعض من
تقدم، وعن الكازروني وغيره. وراجع سائر المصادر التي سلفت
وستأتي.
([2])
دلائل النبوة لأبي نعيم ص425 وراجع: مغازي الواقدي ج1 ص364.
([3])
الثقات ج1 ص241 والمغازي للواقدي ج1 ص367.
([4])
تاريخ الخميس ج1 ص460 والبحار ج20 ص165 عن الكازروني وغيره،
والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص262 والمغازي للواقدي ج1 ص374.
([5])
المغازي للواقدي ج1 ص377.
([6])
تفسير القمي ج2 ص359 وعنه في البحار ج20 ص169 والصافي ج5 ص154.
([7])
الثقات ج1 ص242 والطبقات الكبرى ج2 ص58 والوفاء ص689 وتاريخ
الخميس ج1 ص461 والبحار ج20 ص165 عن الكازروني وغيره، وراجع:
الكامل في التاريخ ج2 ص74 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص555 وزاد
المعاد ج1 ص71 وحبيب السير ج1 ص355 والسيرة الحلبية ج2 ص264 و
265 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص261.
([8])
المغازي للواقدي ج1 ص371 والسيرة الحلبية ج2 ص265.
([9])
راجع: ترجمة الإمام علي أمير المؤمنين، من تاريخ ابن عساكر
(بتحقيق المحمودي) ج1 ص154. وذخائر العقبى ص75 عن أحمد في
المناقب، والطبقات الكبرى ج3 قسم 1 ص14 وكفاية الطالب ص336 وفي
هامشه عن كنز العمال ج6 ص398 عن الطبراني، وراجع: هامش ص180 من
احتجاج الطبرسي عن الرياض النضرة ج2 ص267 و202 عن نظام الملك
في أماليه. وراجع أيضا: مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي
ص200 والمناقب للخوارزمي ص258 و 259 وعمدة القاري ج16 ص216
ومستدرك الحاكم ج3 ص500 وتلخيصه = = بهامش نفس الصفحة للذهبي
وصححاه على شرط الشيخين والمصنف لعبد الرزاق ج5 ص288 وحياة
الصحابة ج2 ص514 و 515 وتاريخ الخميس ج1 ص434 وفتح الباري ج6
ص89 عن أحمد وأسد الغابة ج4 ص20 وأنساب الأشراف (بتحقيق
المحمودي) ج2 ص106 وشرح النهج للمعتزلي الشافعي ج6 ص289،
والغدير للعلامة الأميني ج10 ص168 عنه.
([10])
المناقب لابن شهرآشوب ج4 ص223 والبحار ج47 ص127 عنه.
([11])
نهج البلاغة ج2 ص5 وتاريخ الأمم والملوك ج5 ص17 والفتوح لابن
أعثم ج3 ص73 وصفين ص235 والكافي ج5 ص39.
([12])
في مغازي الواقدي والسيرة الحلبية: دعوه فإنه في بعض شأنكم.
([13])
يشلهم بالسيف: يضربهم ويطردهم.
([14])
راجع ما تقدم في المصادر التالية: الإرشاد للمفيد ص49 ـ50
والبحار ج20 ص172 و 173 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص196 و 197
والمغازي للواقدي ج1 ص371 و 372 وكشف الغمة للأربلي ج1 ص201
و255 والسيرة الحلبية ج2 ص265 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص262.
([15])
السيرة الحلبية ج2 ص265.
([16])
الآية 2 من سورة الحشر.
([17])
وفاء الوفاء ج1 ص161 وج3 ص1076 وراجع: معجم البلدان ج1 ص346
وج5 ص234.
([18])
راجع: وفاء الوفاء ج3 ص823 و 821 وراجع: مرآة الحرمين ج1 ص419.
([19])
راجع: وفاء الوفاء ج4 ص1188.
([20])
راجع: وفاء الوفاء ج1 ص161 وج3 ص1076 وراجع: معجم البلدان ج1
ص446 وج5 ص290 و 234.
([21])
وفاء الوفاء ج3 ص1075 و 1076 وج1 ص161 ومعجم البلدان ج4 ص193.
([22])
التنبيه والأشراف ص213.
([23])
وفاء الوفاء ج1 ص163.
([24])
وفاء الوفاء ج1 ص198 وج3 ص873 .
([25])
وفاء الوفاء ج3 ص873 وراجع ص1075 و 1077.
([26])
تفسير القرآن العظيم ج4 ص331.
([27])
راجع: تاريخ المدينة ج1 ص173 ووفاء الوفاء ج3 ص993.
([28])
راجع: فتح الباري ج6 ص148 ومعجم البلدان ج5 ص290 و 291 وتاريخ
المدينة ج1 ص175 ووفاء الوفاء ج3 ص989 و 990 عنه وعن ابن
زبالة.
([29])
راجع: وفاء الوفاء ج4 ص1275.
([30])
معجم البلدان ج4 ص182.
([31])
معجم البلدان ج3 ص432.
([32])
راجع: وفاء الوفاء ج4 ص1229 و 1230 وفي ج3 ص826 عن الإستيعاب.
([33])
راجع: وفاء الوفاء ج3 ص978.
([34])
راجع: تاريخ الخميس ج1 ص460 والبحار ج20 ص164 عن الكازروني
وغيره، وفي هامشه عن: المنتقى في مولود المصطفى ص125. وراجع
أيضاً: بهجة المحافل ج1 ص214 ولباب التأويل ج4 ص244.
([35])
راجع: وفاء الوفاء ج3 ص993.
([36])
وفاء الوفاء ج4 ص1229.
([37])
وفاء والوفاء ج4 ص1230.
([38])
راجع: وفاء والوفاء ج3 ص944 وستأتي بعض المصادر لكيدمة وكونها
سهم ابن عوف من بني النضير في فصل: كي لا يكون دولة بين
الأغنياء.
([39])
وفاء الوفاء ج3 ص992 عن ابن زبالة وراجع ص993.
([40])
راجع: وفاء الوفاء ج3 ص992 وج4 ص1139.
([41])
راجع: وفاء الوفاء ج3 ص945 و 946.
([43])
وفاء الوفاء ج3 ص991.
([44])
تاريخ المدينة ج1 ص174.
([45])
وفاء الوفاء ج3 ص991.
([46])
راجع: وفاء الوفاء ج3 ص992 وج4 ص1282 وتاريخ المدينة ج1 ص222.
([47])
الثقات ج1 ص254 ووفاء الوفاء ج3 ص991.
([48])
راجع كتابنا: سلمان الفارسي في مواجهة التحدي، الفصل الثاني.
([49])
التنبيه والأشراف ص213.
([50])
راجع: وفاء الوفاء ج3 ص978.
([51])
راجع: وفاء الوفاء ج3 ص873 وراجع ص1075 و 1077.
([52])
راجع: وفاء الوفاء ج1 ص197 و 198 وج4 ص1157 و 1298.
([53])
وفاء الوفاء ج3 ص1157.
([55])
شرح بهجة المحافل ج1 ص214 وفتح الباري ج7 ص256.
([56])
فتح الباري ج7 ص256.
([57])
المغازي للواقدي ج1 ص374.
([58])
المغازي للواقدي ج1 ص366.
([59])
هي أموال مخيريق التي أوصى بها إلى رسول الله «صلى الله عليه
وآله» ويعبرون عنها بالصدقات لما سيأتي في فصل: كي لا يكون
دولة بين الأغنياء.
([60])
راجع وفاء الوفاء ج3 ص1077.
([61])
راجع: وفاء الوفاء ج3 ص874 وج4 ص1150.
([62])
وفاء الوفاء ج3 ص821 ومرآة الحرمين ج1 ص418.
([63])
الآية 5 من سورة الحشر.
وأمر الرسول «صلى الله عليه وآله» بحرق وقطع النخيل موجود في
المصادر التالية: جامع البيان ج28 ص23 وأسباب النزول للواحدي
ص237 و238 ومسند الحميدي ج2 ص301 ومسند أبي عوانة ج4 ص97
والطبقات الكبرى ج2 ص58 وفتوح البلدان قسم 1 ص19 و 20 والجامع
الصحيح ج4 ص122 وج5 ص408 ومسند أحمد ج2 ص8 و 52 و 80 و 86 و
123 و 140 ومسند الطيالسي ص251 والمبسوط للسرخسي ج10 ص31 و 32
وسنن الـدارمي = = ج2 ص22 والمحلى ج7 ص294 ووفاء الوفاء ج1
ص290 ودلائل النبوة لأبي نعيم ص429 وسيرة مغلطاي ص53 ومعجم
البلدان ج1 ص512 وصحيح البخاري ج3 ص11 و 128 والسيرة النبوية
لابن كثير ج3 ص50 و 147 و 149 و 150 والبداية والنهاية ج4 ص79
و 77 والثقات ج1 ص242 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص197، والأحكام
السلطانية ص64 وفتح الباري ج7 ص254 و 256 والروض الأنف ج3 ص250
وسنن ابن ماجة ج2 ص948 وجوامع الجامع ص486 والعبر وديوان
المبتدأ والخبر ج2 قسم 2 ص28 والمغازي للواقدي ج1 ص381 و 372
وحبيب السير ج1 ص355 وأحكام القرآن للجصاص ج3 ص429 وأحكام
القرآن لابن العربي ج4 ص1768 وسنن أبي داود ج3 ص38 والجامع
لأحكام القرآن ج18 ص8 و 6 و7 عن مسلم ولباب التأويل ج4 ص246
والتفسير الكبير ج29 ص283 وزاد المعاد ج2 ص71 والكشاف ج4 ص501
وتفسير الصافي ج5 ص154 وتفسير البرهان ج4 ص313 والسيرة الحلبية
ج2 ص265 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص331 و 333 و 334 والإكتفاء
ج1 ص147 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص122 وصحيح مسلم ج5
ص145 وتاريخ الخميس ج1 ص461 وفتح القدير ج5 ص199 ووفاء الوفاء
ج1 ص298 وبهجة المحافل ج1 ص214 و 215 والسيرة النبوية لدحلان
ج1 ص261 ومنهاج السنة ج4 ص173 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص552
والأموال ص15 ومجمع البيان ج9 ص257 وغرائب القرآن مطبوع بهامش
جامع البيان ج28 ص36 والبحار ج2 ص159 و 165 و 169 وتفسير القمي
ج2 ص359 والكامل في التاريخ ج2 ص173 والدر المنثور ج6 ص188 عن
بعض من تقدم، وعن سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر،
وابن مردويه والنسائي وابن أبي حاتم، وابن إسحاق، والتراتيب
الإدارية ج1 ص310 ومسند أبي يعلى ج10 ص207.
([64])
راجع: الروض الأنف ج3 ص250 وفتح القدير ج5 ص196 وتاريخ الخميس
ج1 ص461 وتعليقات محمد فؤاد عبد الباقي على سنن ابن ماجة ج2
ص949.
([65])
مناقب آل أبي طالب ج1 ص197.
([66])
تاريخ الخميس ج1 ص461 والبحار ج20 ص165 عن الكازروني وغيره،
وفتح القدير ج5 ص196 والجامع لأحكام القرآن ج18 ص6 والسيرة
الحلبية ج2 ص266 والقول الأول ذكره في الأحكام السلطانية ص64.
([67])
المغازي للواقدي ج1 ص373.
([68])
البحار ج20 ص165 عن الكازروني وغيره، ولباب التأويل ج4 ص246
وراجع: تاريخ الخميس ج1 ص461 وإرشاد الساري ج7 ص375.
([69])
الآية 5 من سورة الحشر.
([70])
الثقات ج1 ص242 وراجع التفسير الكبير ج29 ص283 وحبيب السير ج1
ص355 والمغازي للواقدي ج1 ص381 والسيرة الحلبية ج2 ص265.
([71])
المغازي للواقدي ج1 ص381 والسيرة الحلبية ج1 ص265 والإصابة ج2
ص420.
([72])
تاريخ الخميس ج1 ص461 عن روضة الأحباب وراجع: المغازي للواقدي
ج1 ص372.
([73])
حبيب السير ج1 ص355.
([74])
تاريخ الخميس ج1 ص461 وراجع: المغازي للواقدي ج1 ص372 وليراجع:
الكشاف ج4 ص501 و 502 والتفسير الكبير ج29 ص283 لكنهما لم
يسميا الرجلين.
([75])
بهجة المحافل ج1 ص215.
([76])
راجع: المهذب لابن البراج (مطبوع ضمن الينابيع الفقهية) كتاب
الجهاد ص88 مقيداً للأشجار بـ «المثمرة» وفي منتهى المطلب ج2
ص909 عن أحمد، وقد حكي القول بعدم الجواز عن الليث بن سعد،
وأبي ثور، والأوزاعي فراجع: فتح الباري ج5 ص7 والجامع الصحيح
ج4 ص122 وفقه السيرة ص280 وعن شرح النووي على صحيح مسلم ج12
ص50.
([77])
تذكرة الفقهاء ج1 ص412 و413 وراجع: السرائر ص157 وتحرير
الأحكام ج1 ص135 وشرائع الإسلام ج1 ص312 والقواعد (المطبوع مع
الإيضاح) ج1 ص357 والجامع لأحكام الشرائع ص236 ومنتهى المطلب
ج2 ص909 = = والوسيلة
(المطبوع ضمن الجوامع الفقهية) ص696 والخراج لأبي يوسف ص210
والمبسوط للسرخسي ج10 ص31 عن الأوزاعي والمبسوط للشيخ الطوسي
رحمه الله ج2 ص11 وعون المعبود ج7 ص275 ومجمع الأنهر ج1 ص590.
([78])
الروض الأنف ج3 ص350.
([79])
راجع: تذكرة الفقهاء ج1 ص412 وراجع أيضاً: السرائر ص157
والجواهر ج21 ص67 ومنتهى المطلب ج2 ص909 والمبسوط للشيخ الطوسي
ج2 ص11 والمبسوط للسرخسي ج10 ص32.
([80])
سنن ابن ماجة ج2 ص948 وهامشه لمحمد فؤاد عبد الباقي، والمبسوط
للسرخسي ج10 ص31 وسنن أبي داود ج3 ص38 وأحكام القرآن للجصاص ج3
ص429 ومسند أحمد ج5 ص205 و 209.
([81])
راجع: زاد المعاد ج3 ص17 والتنبيه والإشراف ص237 والتراتيب
الإدارية ج1 ص309.
([82])
زاد المعاد ج2 ص66 وسنن الدارمي ج2 ص231 والجامع الصحيح ج4 ص61
وسنن أبي داود ج3 ص69 ومسند أحمد ج1 ص22.
([83])
زاد المعاد ج3 ص17 والسنن الكبرى ج3 ص55 و56 وسنن أبي داود ج1
ص150 وسنن الدارمي ج1 ص292 ومسند أحمد ج1 ص292 و 402 و 422 و
449 و 450 وج2 ص224 و 292 و 214 و 319 و 367 و 376 و 377 و 416
و 424 و 472 و 479 و 531 و 539 وج5 ص206 وصحيح مسلم ج2 ص123 و
124 وفيض الباري ج2 ص191 وصحيح البخاري ج1 ص78 و 79 وج2 ص40
وج4 ص159 والتراتيب الإدارية ج1 ص89 و 90 والمعجم الصغير ج2
ص57 وج1 ص172. والجامع الصحيح ج1 ص422 وسنن النسائي ج2 ص107
وسنن ابن ماجة ج1 ص296 والموطأ (مطبوع مع تنوير الحوالك) ج1
ص150.
([84])
راجع: السيرة النبوية لابن هشام ج4 ص160 والتراتيب الإدارية ج1
ص309.
([85])
الكافي ج5 ص30 والبحار ج19 ص177 و 199 وتذكرة الفقهاء ج1 ص412
و413 ومنتهى المطلب ج2 ص908 و 909 وجواهر الكلام ج21 ص66
والوسائل ج11 ص43 و 44 والمحاسن للبرقي ص355 وفي هامشه عن
الوسائل، وعن التهذيب ج2 ص46.
([86])
مسند أحمد ج5 ص276.
([87])
الآية 5 من سورة الحشر.
([88])
الروض الأنف ج3 ص250 وراجع: فتح الباري ج7 ص256 و 257 وأشار
إلى أن العجوة كانت قوت بني النضير في السيرة الحلبية ج2 ص266.
([89])
المفردات للراغب ص257 وراجع: التبيان ج9 ص559.
([90])
راجع: لسان العرب ج13 ص393 و395، وفتح الباري ج7 ص257 وعمدة
القاري ج17 ص128 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص202 وشرح
المحافل ج1 ص215 والتبيان ج9 ص559 ولباب التأويل ج4 ص246 وجامع
البيان ج28 ص22 وفتح القدير ج5 ص197، ومجمع البيان ج9 ص259
والبحار ج20 ص161 وتاريخ الخميس ج1 ص461 وتفسير القرآن العظيم
ج4 ص333 والجامع لأحكام القرآن ج18 ص8 وأحكام القرآن لابن
العربي ج4 ص1768 ويلاحظ: أن المذكورين في المتن قد ذكرت
أسماؤهم في بعض المصادر دون بعض.
([91])
راجع: تاج العروس ج9 ص338 وفتح الباري ج7 ص257 وأحكام القرآن
لابن العربي ج4 ص1768 وعمدة القاري ج17 ص126 وإرشاد الساري ج7
ص375 وجامع البيان ج28 ص22 و 23 وفتح القدير ج5 ص199 و 197
وأحكام القرآن للجصاص ج3 ص429 والجامع لأحكام القرآن ج18 ص9
والجامع الصحيح للترمذي ج5 ص408 وتاريخ الخميس ج1 ص461 ولباب
التأويل ج4 ص246 وجوامع الجامع ص486 وتفسير القرآن العظيم ج4
ص333 والأحكام السلطانية ص65.
([92])
شرح بهجة المحافل ج1 ص215 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص261
وعمدة القاري ج17 ص128 والأحكام السلطانية ص65.
([93])
عمدة القاري ج17 ص128 وتاريخ الخميس ج1 ص461 وأحكام القرآن
للجصاص ج3 ص429 ومجمع البيان ج9 ص259 والبحار ج20 ص161 عنه
وشرح بهجة المحافل ج1 ص215 ولباب التأويل ج4 ص246 والجامع
لأحكام القرآن ج18 ص9 والأحكام السلطانية ص65 والتبيان ج9 ص559
ومدارك التنزيل بهامش لباب التأويل ج4 ص246 وجامع البيان ج28
ص23 وغرائب القرآن مطبوع بهامشه ج28 ص37 وأحكام القرآن لابن
العربي ج4 ص1768 والتفسير الكبير ج29 ص283 والكشاف ج4 ص500.
([94])
الآية 5 من سورة الحشر.
([95])
الدر النظيم في لغات القرآن الكريم ص207 وراجع تاريخ الخميس ج1
ص461 عن مجاهد وعطية.
([96])
تاريخ الخميس ج1 ص461 وإرشاد الساري ج7 ص375 وراجع: الأحكام
السلطانية ص64.
([97])
الجامع لأحكام القرآن ج18 ص1769 والدقل: نوع من التمر، قيل: هو
أردأ أنواعه. راجع: لسان العرب ج11 ص246.
([98])
السيرة النبوية لدحلان ج1 ص261. والسيرة الحلبية ج2 ص266.
([99])
السيرة الحلبية ج2 ص266.
([100])
الجامع لأحكام القرآن ج18 ص9.
([101])
فتح القدير ج5 ص197 والجامع لأحكام القرآن ج18 ص9 وأحكام
القرآن لابن العربي ج4 ص1768 وتفسير البرهان ج4 ص313.
([102])
قد تقدم ما يفيد في ذلك وراجع أيضاً: ج3 من هذا الكتاب.
([103])
سيتضح ذلك حين الكلام عن كونهم في قومهم بمنزلة بني المغيرة في
قريش، فانتظر.
([104])
جامع البيان ج28 ص23 و22 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص333 وفتح
القدير ج5 ص196 وأحكام القرآن للجصاص ج3 ص429 والدر المنثور ج6
ص188 عن عبد الرزاق، وعبد بن حميد وابن المنذر، والبيهقي في
الدلائل.
([105])
قد تقدمت المصادر لذلك.
([106])
راجع هذا الكتاب ج 8 عنوان: من مشاهد الحرب.
([107])
فتح القدير ج5 ص202 وصحيح البخاري ج3 ص128 وتفسير القرآن
العظيم ج4 ص337 وأحكام القرآن لابن العربي ج4 ص1775 والدر
المنثور ج6 ص195 عن البخاري، وابن أبي شيبة، وابن مردويه.
([108])
الجامع لأحكام القرآن ج18 ص31.
([109])
الجامع لأحكام القرآن ج18 ص20 وحول مصادر تمييز عمر بين الناس
في العطاء، وتفضيل بعضهم على بعض راجع كتابنا:
«سلمان الفارسي في مواجهة
التحدي».
([110])
الآية 5 من سورة الحشر.
([111])
فتح القدير ج5 ص197 وراجع: الجامع لأحكام القرآن ج18 ص8 عن
الماوردي، وعن الكيا الطبري وراجع: غرائب القرآن (مطبوع بهامش
جامع البيان) ج28 ص37 وأحكام القرآن لابن العربي ج4 ص1769.
([112])
التفسير الكبير ج29 ص283 والكشاف ج4 ص501 و502 وقد تقدم اسم
هذين الرجلين، ومصادر موقفهما هذا فليراجعه من أراد.
([113])
أحكام القرآن لابن العربي ج4 ص1769 والجامع لأحكام القرآن ج18
ص8.
([114])
فوائد الأصول، للشيخ الأنصاري ص25.
([115])
وفاء الوفاء ج1 ص298 و 299 وراجع: شرح بهجة المحافل ج1 ص215،
عن ابن سيد الناس، والجواب عن ابن حجر وعمدة القاري ج17 ص129
وراجع: فتح الباري ج7 ص257 و 258 ومعجم البلدان ج1 ص512 و 513.
([116])
عمدة القاري ج17 ص129.
|