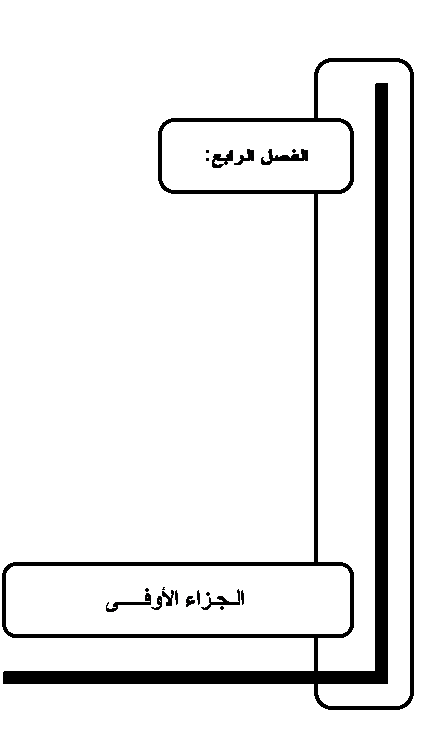
تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى:
قال تعالى:
﴿لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعأً إِلا فِي
قُرىً مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاء جُدُرٍ بَأسُهُمْ بَيْنَهُمْ
شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعأً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ﴾([1]).
قد أعطت هذه الآية الشريفة تصوراً
متكاملاً
عن حالة أولئك الذين لا يملكون صفة الإيمان، حيث أرجعت هذه الحالة
إلى عللها وأسبابها، وربطتها بمناشئها الحقيقية، بصورة واضحة
ودقيقة.
ولا نريد أن نستعرض هنا كل ما تعرضت له الآية تصريحاً،
أو تلويحاً،
فإن ذلك يحتاج إلى توفر تام، وتأمل ودقة وجهد، لا نجد لدينا القدرة
على توفيره فعلاً،
وإنما نريد أن نسجل هنا حقيقة واحدة، نحسب أن الإلفات إليها يناسب
ما نحن بصدده، وهي:
أن النظرة المادية للحياة، وعدم الإيمان بالآخرة، أو عدم تعمق
الإيمان بها يجعل الإنسان يقيس الأمور بمقياس الربح والخسارة في
الدنيا. وهذا ـ بنظره ـ هو الذي يعطيها القيمة، أو يفقدها إياها،
ولتصبح الحياة الدنيا ـ من ثم ـ هي الغاية، وهي النهاية، وهي كل
شيء بالنسبة إلى هذا النوع من الناس، فإذا فقدها، فلا شيء له بعد
ذلك على الإطلاق. ويصبح شخصه كفرد هو المعيار والميزان للصلاح
والفساد، وللحسن والقبيح، وللواجب والحرام. فهو لا يمارس شيئاً ولا
يرتبط بشيء إلا بمقدار ما يجر إليه نفعاً،
أو يدفع عنه شراً وضراً.
وتفقد الحياة الاجتماعية معناها ومغزاها،
إلا في الحدود التي تخدم وجود الفرد، ومصالحه،. فهو مع الناس،
وإنما لأجل نفسه، وهو وحده لا شريك له، وكل ما في الوجود يجب أن
يكون من أجله وفي خدمته. ويجب أن يضحى بكل غال ونفيس في سبيله، فهو
القيمة لكل شيء، وليس لأي شيء
آخر أية قيمة تذكر.
وعلى هذا، فإن جميع القيم تسقط، ويبقى هو. فلا معنى للتضحية إلا
إذا كانت من الآخرين من أجله، ولا معنى للإيثار إلا إيثار الآخرين
له على أنفسهم. ولا معنى للشهادة في سبيل الله إلا إذا نالت
الآخرين دونه، ولا معنى للحق وللباطل، وللغدر والوفاء، وللصدق
والكذب و..
و..
الخ.. إلا من خلال ما يجلب له نفعاً،
أو يدفع عنه ضراً
وشراً.
وإذا كان مع الجماعة فإنه لا يشاركهم في شيء، ولا يهمه من أمرهم
شيء، بل هو يريد منهم أن يدفعوا عنه، ويموتوا من أجله وفي سبيله.
وهذا بالذات ما يفسر لنا قوله تعالى:
﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ
شَتَّى﴾([2]).
نعم..
إن قلوبهم (شتى) بكل ما لهذه الكلمة من معنى لأنهم لا يفكرون في
شيء واحد، وإنما هم يفكرون بأشياء متباينة، ومتعددة، بعددهم
جميعاً. فنفس كل فرد منهم تخضع لفكرين متناقضين فصاحبها يفكر في
حفظها، وبقائها، وكل من معه يفكرون في إتلاف هذه النفس من أجل حفظ
وجودهم هم دونه.
وهكذا الحال بالنسبة لنفس كل فرد منهم، وإذا فكر أحد منهم بحفظ
نفوس الآخرين، فإنما ذلك حين يرى فيه ضمانة لبقائه، وحفظ نفسه هو
أولاً.
وذلك يوضح لنا
أيضاً:
السر في أن هؤلاء لا يقاتلون المؤمنين إلا من وراء جدر، أو في قرى
محصنة، حسبما أوضحته الآية الشريفة.
وما ذلك إلا لأن هؤلاء لا يعقلون معنى الحياة وأسرارها، ولا حكمة
الخلق وأهداف الوجود. فإن ذلك إنما جاء وفق المعايير والأحكام
العقلية والفطرية، فهو لا يشذ عنها، ولا يختلف ولا يتخلف عن
أحكامها ومقتضياتها.
ولو أنهم فكروا وأطلقوا عقولهم من عقال الهوى، لأدركوا ذلك كله،
ولتغيرت نظرتهم للكون وللحياة، ولعرفوا بعضاً
من أسرار الخلق والوجود، ولتبدلت المعايير والقيم التي كانت تستند
إلى أوهام وخيالات، وتؤكدها وتفرضها الفطرة الخالصة عن الشوائب،
والبعيدة عن تجاذب الأهواء.
إذاً..
فعدم التزامهم بهدى العقل، ورفضهم الانصياع لأحكامه، هو أصل
البلاء، وسبب العناء، وهو ما أكدته الآية الكريمة، التي أرجعت
حالتهم التي هي غاية خزيهم وذلهم إلى ذلك، فهي تقول:
﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ
يَعْقِلُونَ﴾([3]).
ونلاحظ هنا:
أن المعاهدات التي كان النبي
«صلى
الله عيله وآله»
يبرمها مع اليهود، لم يظهر اليهود فيها وحدة متكاملة، بل كانوا
شيعاً
وأحزاباً.
فقد عاهد «صلى الله عليه وآله» كل قبيلة منهم على حدة: النضير،
وقينقاع،
وقريظة، وكذلك الحال بالنسبة لخيبر وفدك وغير ذلك، ومعنى ذلك هو
أنهم كانوا فيما بينهم شيعاً
وأحزاباً.
ويلاحظ أيضاً:
أن أياً
من قبائلهم لم تنهض للدفاع عن القبيلة الأخرى. كما أن أحلافهم من
غطفان، ومن المنافقين، لم يهبوا لنصر أي من القبائل والجماعات التي
حالفوها ووعدوها النصر، وهو ما نص عليه الله تعالى حين قال عنهم:
﴿أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا
يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا
نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَدأً وَإِن قُوتِلْتُمْ
لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لَئِنْ
أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لا
يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الأَدْبَارَ
ثُمَّ لا يُنصَرُونَ﴾([4])..
﴿لأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم
مِنَ اللهَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ﴾([5]).
وقد علم معنى الآيات مما قدمناه.
وعن علي «عليه
السلام» أنه قال:
المؤمنون بعضهم لبعض نصحاء، وإن افترقت منازلهم، والفجرة بعضهم
لبعض غششة خونة، وإن اجتمعت أبدانهم([6]).
وكان مما قاله سلام بن مشكم لحيي بن أخطب حول وعد ابن أبي لهم
بالنصر:
«ليس
قول ابن أبي بشيء، إنما يريد ابن أبي: أن يورطك في الهلكة، حتى
نحارب محمداً،
ثم يجلس في بيته ويتركك. قد أراد من كعب بن أسد النصر، فأبى كعب،
وقال: لا ينقضن العهد رجل من بني قريظة وأنا حي،
وإلا فإن ابن أبي قد وعد حلفاءه من بني قينقاع مثل ما وعدك حتى
حاربوا ونقضوا العهد، وحصروا أنفسهم في صياصيهم، وانتظروا نصرة ابن
أبي، فجلس في بيته، وسار محمد إليهم، فحصرهم حتى نزلوا على حكمه.
فابن أبي لا ينصر حلفاءه، ومن كان يمنعه من الناس كلهم، ونحن لم
نزل نضربه بسيوفنا مع الأوس في حربهم كلها، إلى أن تقطعت حربهم،
فقدم محمد فحجز بينهم. وابن أبي لا يهودي على دين يهود، ولا على
دين محمد، ولا على دين قومه، فكيف تقبل منه قولاً
قاله؟
قال حيي:
تأبى نفسي إلا عداوة محمد وإلا قتاله..
قال سلام:
«فهو
والله جلاؤنا من أرضنا الخ..»([7]).
ويلاحظ من كلام
سلام:
أنه كان يشك في نوايا عبد الله بن أبي تجاههم.
ومما يؤكد هذه التهمة قول الواقدي بعد ذكره إرسال ابن أبي إلى
قريظة يطلب منهم نصر إخوانهم من بني النضير، ورفضهم لذلك:
«فيئس
ابن أبي من قريظة، وأراد أن يلحم الأمر فيما بين بني النضير، ورسول
الله، فلم يزل يرسل إلى حيي، حتى قال حيي: أنا أرسل إلى محمد
أعلمه: أنا لا نخرج من دارنا ومن أموالنا الخ..»([8]).
فصدق الله العظيم،
وصدق رسوله الكريم «صلى الله عليه وآله»،
وصدق أمير المؤمنين علي «عليه الصلاة والسلام» وصدق الأئمة من ولده
صلوات الله عليهم أجمعين.
هناك أقوال كثيرة في بيان المراد من قوله تعالى عن بني النضير:
﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ
وَأَيْدِي المُؤْمِنِينَ﴾([9]).
ونحن نشير هنا إلى بعضها، فنقول:
قال البعض:
«يخربونها
من داخل (أي ليهربوا) ويخربها المؤمنون من خارج (أي ليصلوا إليهم).
وقيل:
معنى بأيديهم: بما كسبت أيديهم من نقض العهد، وأيدي المؤمنين، أي
بجهادهم»([10]).
ولعل هذا القول هو
الذي أشار إليه الزجاج، حين قال:
معنى تخريبها بأيدي المؤمنين: أنهم عرضوها لذلك([11]).
وكان المسلمون يخربون ما يليهم ويحرقون حتى وقع الصلح([12]).
وقال البعض:
«كانوا
ينظرون إلى منازلهم فيهدمونها، وينزعون منها الخشب، ما يستحسنونها،
فيحملونها على إبلهم، ويخرب المؤمنون بواقيها..
إلى أن قال:
قال ابن زيد: كانوا يقلعون العمد، وينقضون السقف، وينقبون الجدر،
وينزعون الخشب حتى الأوتاد، ويخربونها، حتى لا يسكنها المؤمنون،
حسداً
وبغضاً»([13]).
وقيل:
إن سبب خرابهم لبيوتهم حاجتهم إلى الخشب والحجارة، ليسدوا بها
أفواه الأزقة، وأن لا يتحسروا بعد جلائهم على بقائها للمسلمين، وأن
ينقلوا معهم ما كان في أبنيتهم من جيد الخشب، والساج المليح. أما
المؤمنون فداعيهم إزالة متحصنهم وممتنعهم، وأن يتسع لهم مجال الحرب([14]).
وقال القمي:
«وكان
رسول الله «صلى الله عليه وآله» إذا ظهر بمقدم بيوتهم، حصنوا ما
يليهم، وخربوا ما يليه، وكان الرجل ممن كان له بيت حسن خربه..»([15]).
وثمة أقوال أخرى في المقام، وبعضها يرجع إلى ما تقدم.
منها:
قول عكرمة: إن منازلهم كانت مزخرفة، فحسدوا المسلمين أن يسكنوها،
فخربوها من داخل، وخربها المسلمون من خارج([16]).
وقول آخر:
إنه كلما هدم المسلمون شيئاً من حصونهم، جعلوا ينقضون بيوتهم،
ويخربونها ليبنوا ما هدم المسلمون([17]).
وقول ثالث:
إنهم كانوا كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها، لتتسع لهم
المقاتل، وجعل اليهود ينقبون دورهم من أدبارها فيخرجون إلى التي
بعدها، فيتحصنون فيها، ويكسرون ما يليهم، ويرمون بالتي خرجوا منها
أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فلما كادت اليهود أن تبلغ
آخر دورها، وهم ينتظرون المنافقين، حتى يئسوا منهم طلبوا الصلح([18]).
وثمة قول رابع:
إنهم دربوا الأزقة وحصونها، فنقضوا بيوتهم، وجعلوها كالحصون على
أبواب الأزقة، وكان المسلمون يخربون سائر الجوانب([19]).
إلى غير ذلك من أقوال لا مجال لتتبعها واستقصائها.
تنص الروايات:
على أن الرجل من بني النضير كان يهدم بيته عن نجاف بابه، فيضعه على
ظهر بعيره، فينطلق به([20]).
وقد فسر البعض هذه
الظاهرة، فكتب يقول:
«هدم
نجاف([21])
البيوت يتعلق بعقيدة تلمودية معروفة، هي: أن كل يهودي يعلق على
نجاف داره صحيفة تشتمل على وصية موسى لبني إسرائيل: أن يحتفظوا
بالإيمان بإله واحد، ولا يبدلوه ولو عذبوا وقتلوا.
فاليهود حين ينزحون عن منازلهم يأخذونها معهم،
وهي عادة متبعة عند اليهود إلى يومنا هذا.
ويظهر:
أن يهود بلاد العرب كانوا يضعون تلك الصحيفة داخل النجاف، خوفاً
من إتلاف الهواء، أو مس الأيدي فلما رحلوا عن ديارهم هدموا نجاف
البيوت، وأخذوها..»([22]).
ونحن نشك كثيراً في عدد من الروايات التي تقدمت في الفصل الأول من
هذا الباب،
وفي غيره من الفصول، والتي تحاول أن تعطي لغزوة بني النضير طابعاً
حربياً
عنيفاً،
حتى ليذكر البعض منها: أن المسلمين كانوا يخربون بيوت بني النضير
من الخارج ليتسع لهم ميدان القتال، وكان بنو النضير يخربون بيوتهم
من الداخل لأجل التحصين بها، وأنهم قد بلغوا أقصى دورهم، وهم على
هذه الصفة،
إلى غير ذلك من نصوص وروايات تصب في هذا الاتجاه.
فإننا وإن كنا نقول:
إنه قد كان ثمة حصار، وقطع للأشجار، ورشق بالنبل من قبل بني
النضير، وخراب للبيوت بأيدي بني النضير، وبأيدي المؤمنين، ثم قتل
أمير المؤمنين «عليه السلام» عشرة منهم، فدب الرعب في قلوبهم،
واقتنعوا: أن لا طاقة لهم بالحرب، فآثروا الاستسلام والقبول
بالجلاء.
وأفاء الله على رسوله أراضيهم، وسوغه أموالهم.
ولكن الإصرار على إظهار جانب العنف والقتال والحرب القوية والضارية
من البعض، إنما هو لأجل الإيحاء بأن أرض بني النضير قد فتحت عنوة،
وأن المسلمين قد أخذوها عن استحقاق، ولم يكن النبي «صلى الله عليه
وآله» متفضلاً
عليهم في إعطائهم إياها!!
ومعنى ذلك هو:
أن المطالبة بها من قبل الورثة الحقيقيين للرسول الأكرم «صلى الله
عليه وآله» بعد وفاته تصبح بلا معنى، وبلا مبرر ظاهر..
رغم أن القرآن قد صرح:
بأن أرضهم كانت فيئاً،
وأنها خاصة برسول الله «صلى الله عليه وآله». ولكن تبرير موقف
السلطة، والتعتيم على مظالمها أهم وأولى من الحفاظ على القرآن،
وأحكامه،
بنظر هؤلاء المتحذلقين، الذين يستخدمون كل وسائل التزوير والتحوير
والإبهام في خدمة أهوائهم ومصالحهم واتجاهاتهم.
ضـيـعـوا حقهـا المبين بـتـزويــر وهـل عنـدهم سـوى
الـتـزوير؟!
قد ذكرت سورة الحشر ـ التي يرى المؤرخون والمفسرون: أنها تتحدث عن
حادثة بني النضير، الذين أخرجهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» ـ
أن هذا هو أول الحشر لهم..
وقد اختلفوا في المراد من ذلك.
فروى موسى بن عقبة:
أنهم قالوا: إلى أين نخرج يا محمد؟
قال:
إلى الحشر.
يعني:
أرض المحشر، وهي الشام..
هذا في الدنيا، والحشر الثاني يوم القيامة إلى الشام أيضاً([23]).
وقيل:
إن أول الحشر هو إخراجهم من حصونهم إلى خيبر، وآخر الحشر إخراجهم
من خيبر إلى الشام([24]).
وقيل:
إنما قال لأول الحشر؛
لأن الله فتح على نبيه «صلى الله عليه وآله» في أول ما قاتلهم([25]).
وقيل:
المراد بالحشر؛ الجلاء،
وقد كان بنو النضير من سبط من بني إسرائيل لم يصبهم جلاء.
زاد الطبرسي، وغيره:
أن الحشر الثاني هو إخراج إخوانهم من جزيرة العرب (أي على يد عمر
بن الخطاب) لئلا يجتمع في جزيرة العرب دينان([26]).
وقيل:
إن الحشر الثـاني،
هو حشر النـار
التي تخـرج
من قعـر
عـدن؛
فتحشر الناس إلى الموقف، تبيت معهم حيث باتوا؛ وتقيل معهم حيث
قالوا، وتأكل من تخلف([27]).
وقال العيني:
«إن
بني النضير أول من أخرج من ديارهم»([28]).
ونقول:
بل أجلي بنو قينقاع قبلهم.
وقال الكلبي:
كانوا أول من أجلي من أهل الذمة من جزيرة العرب ثم أجلي آخرهم في
زمن عمر بن الخطاب؛ فكان جلاؤهم أول حشر من المدينة، وآخر حشر
إجلاء عمر لهم([29]).
قال السهيلي، بعد ذكره ما تقدم:
«..
والآية
متضمنة لهذه الأقوال كلها، ولزائد عليها؛ فإن قوله:
﴿لأَوَّلِ الحَشْرِ﴾
يؤذن: أن ثمة
حشراً
آخر؛ فكان هذا الحشر والجلاء إلى خيبر، ثم أجلاهم عمر من خيبر إلى
تيماء، وأريحا، وذلك حين بلغه التثبت عن النبي «صلى الله عليه
وآله» أنه قال: لا يبقين دينان بأرض العرب»([30]).
كما أن عبد الرزاق
الصنعاني، بعد أن ذكر:
أن النبي: «صلى الله عليه وآله» قد دفع خيبر إلى اليهود، على أن
يعملوا بها، ولهم شطرها قال:
«فمضى
على ذلك رسول الله «صلى الله عليه وآله» وأبو بكر، وصدر من خلافة
عمر، ثم أخبر عمر: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال في وجعه الذي
مات فيه: لا يجتمع بأرض الحجاز ـ أو بأرض العرب ـ دينان؛ ففحص عن
ذلك حتى وجد عليه الثبت، فقال:
من كان عنده عهد من رسول الله «صلى الله عليه وآله» فليأت به، وإلا
فإني مجليكم.
قال:
فأجلاهم».
وكذا ذكر غير عبد الرزاق أيضاً([31]).
وقد نص المؤرخون:
على أن عمر أجلى من يهود من لم يكن معه عهد من رسول الله([32]).
ونقول:
إن حديث إجلاء عمر لليهود، حين بلغه الثبت عن رسول الله «صلى الله
عليه وآله»: لا يجتمع بأرض العرب دينان، يحتاج إلى شيء من البسط
والتوضيح..
وقد كنا نود إرجاء الحديث عن هذا الأمر إلى وقعة خيبر، ولكن ما
ذكره السهيلي وغيره هنا قد جعلنا نتعجل الإشارة إلى بعض من ذلك.
ولكننا قبل أن ندخل في مناقشة هذا الأمر نشير إلى أمرين:
الأول:
إن تصريح الرواية المتقدمة بأن الخليفة قد نفذ ما كان قد سمعه من
النبي «صلى الله عليه وآله» في وجعه الذي مات فيه، يحتاج إلى مزيد
من التأمل، بعد أن كان هو نفسه قد قال عن النبي «صلى الله عليه
وآله» في نفس ذلك المرض: إنه يهجر، أو غلبه الوجع أو نحو ذلك..([33]).
وصرحت المصادر:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب،
وأنه لا يجتمع فيها دينان، بعد قول عمر الآنف الذكر، وتنازعهم عنده([34]).
فمن غلبه الوجع:
ومن كان يهجر ـ والعياذ بالله ـ لا يوثق بما يقوله، ولا ينبغي
الالتزام به، حتى ولو ورد بالطرق الصحيحة والصريحة. نعوذ بالله من
الزلل والخطل في القول والعمل.. وعصمنا الله من نسبة ذلك لرسوله
الأكرم «صلى الله عليه وآله».
الثاني:
إنا لا نريد أن نسجل إدانة صريحة للخليفة الثاني،
حول ما تذكره الرواية من جهله بآخر أمر صدر من النبي الأكرم «صلى
الله عليه وآله»، حول وجود الأديان في جزيرة العرب.. بأن نقول: إن
ذلك لا يتناسب مع مقام خلافة رسول الله «صلى عليه وآله».
لا.. لا نريد ذلك، لأننا نشك في أن يكون الخليفة قد استند في موقفه
من اليهود إلى قول رسول الله «صلى الله عليه وآله»..
ونحن نوضح ذلك فيما يلي:
إن من المسلَّم به:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» حين افتتح خيبر قد أبقى اليهود في
شطر منها، يعملون فيه، ولهم شطر ثماره، ولكن عمر قد أخرجهم منها
إلى تيماء وأريحا([35]).
ولكن ما ذكروه في سبب ذلك، من أنه قد فعل امتثالاً
لأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» وتديناً
منه، والتزاماً
بالحكم الشرعي، لا يمكن المساعدة عليه، ولا الالتزام به، حيث إننا
نشك في ذلك، وذلك لما يلي:
ألف:
لماذا لم يفعل ذلك أبو بكر، فهل لم يبلغه ذلك؟!
والذين أبلغوا عمر بن الخطاب لماذا لم يبلغوا سلفه أبا بكر؟!
ب:
قولهم: إن عمر لم يكن يعلم بلزوم إجلاء اليهود، حتى بلغه الثبت عن
رسول الله ينافيه ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال:
أخبرني عمر بن
الخطاب:
أنه سمع رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: لأخرجن اليهود
والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع إلا مسلماً([36]).
فلماذا توقف عن إخراجهم، حتى بلغه الثبت عن رسول الله؟ ألم يكن هو
قد سمع ذلك من النبي «صلى الله عليه وآله» مباشرة، فلماذا لم ينفذ
ما سمعه؟!
ولماذا أيضاً لم يخبر عمر نفسه رفيقه وصديقه الحميم أبا بكر بهذا
القول منه «صلى الله عليه وآله»؟!
إلا أن يقال:
إن هذا لا يدل على أنه «صلى الله عليه وآله» قد أمر الخليفة بعده
بذلك.
ج:
إن ثمة حديثاً يفيد: أن سبب إخراج عمر ليهود خيبر هو أنهم اعتدوا
على ولده، فقد روى البخاري وغيره:
عن ابن عمر، قال:
لما فدع([37])
أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيباً،
فقال: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان عامل يهود خيبر على
أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم
الله،
وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك، فعدي عليه من الليل، ففدعت
يداه، ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد
رأيت إجلاءهم.
فلما أجمع عمر على
ذلك أتاه أحد بني الحقيق، فقال:
يا أمير المؤمنين، أتخرجنا، وقد أقرنا محمد، وعاملنا على الأموال،
وشرط ذلك لنا؟!
فقال عمر:
أظننت أني نسيت قول رسول الله: كيف بك إذا أخرجت من خيبر، تعدو بك
قلوصك ليلة بعد ليلة؟!
فقال:
كانت هذه هزيلة (أي فرحة) من أبي القاسم.
فقال:
كذبت يا عدو الله.
فأجلاهم عمر الخ..([38]).
ونشير في هذه الرواية إلى أمرين:
الأول:
إنها تصرح بأن إجلاء اليهود كان رأياً
من عمر، وليس امتثالاً
لأمر رسول الله «صلى الله عليه آله»،
وأن الدافع له هو ما فعلوه بولده.
ومن الواضح:
أن ذلك ليس مبرراً
كافياً
لذلك، فقد سبق لليهود أن قتلوا عبد الله بن سهل بخيبر، فاتهمهم
رسول الله «صلى الله عليه وآله» والمسلمون بقتله، فأنكروا ذلك،
فوداه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولم يخرجهم بسبب ذلك([39]).
الثاني:
إن ما نقله عمر لأحد بني الحقيق، لم يكن هو المستند لإخراجهم، بل
صرح عمر بأن ذلك كان لرأي رآه بسبب ما فعلوه بولده.. كما أن إخبار
النبي هذا ليس فيه ما يدل على أنهم يخرجون بحق أو بغير حق، ولا
يفيد تأييد هذا الإخراج ولا تفنيده، ولعل لأجل ذلك لم يستطع أن
يستند إليه الخليفة في تبرير ما يقدم عليه.
د:
وفي بعض المصادر: أضاف إلى ما صنعوه بابن عمر، أنهم غشوا المسلمين([40]).
ولا ندري إن كان
يقصد:
أن غشهم هذا كان بفعل مستقل منهم، أم أن ما فعلوه بابن عمر هو
الدليل لهذا الغش؟!
قال دحلان:
«استمروا
على ذلك إلى خلافة عمر (رض)،
ووقعت منهم خيانة وغدر لبعض المسلمين، فأجلاهم إلى الشام، بعد أن
استشار الصحابة (رض) في ذلك»([41]).
وعبارة دحلان هذه،
ظاهرة في أن المقصود بخيانتهم وغدرهم:
هو نفس ما صدر منهم في حق بعض المسلمين، وهو ابن عمر بالذات،
ولا ندري لماذا لم يصرح باسمه ونسبه هنا؟!.
هـ:
ومما يدل على أن إجلاءهم كان رأياً
من الخليفة الثاني، ما رواه أبو داود وغيره، عن ابن عمر، عن عمر،
أنه قال:
أيها الناس، إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان عامل يهود خيبر
على أنّا نخرجهم إذا شئنا، فمن كان له مال فليلحق به، فإني مخرج
يهود. فأخرجهم([42]).
ومعنى ذلك:
هو أنه لم يكن يرى إخراجهم واجباً
شرعياً.
كما أنه قد احتج لما يفعله بشرط النبي «صلى الله عليه وآله»
إبقاءهم بالمشيئة ـ إذا شئنا ـ ولا يحتج لذلك بما ثبت له عنه «صلى
الله عليه وآله»، من عدم بقاء دينين في أرض العرب.
مع أنه لو كان هذا هو السبب والداعي، لكان الاحتجاج به أولى وأنسب.
ومما يؤيد ذلك
ويعضده:
أن اليهود حين اعترضوا عليه بقولهم: لم يصالحنا النبي «صلى الله
عليه وآله» على كذا وكذا؟!
قال:
بلى،
على أن نقركم ما بدا لله ولرسوله، فهذا حين بدا لي إخراجكم.
فأخرجهم([43]).
و:
إنه قد أخرج نصارى نجران، وأنزلهم ناحية الكوفة([44]).
ز:
قد ذكرت بعض الروايات:
أن السبب في إجلائهم هو استغناء المسلمين عنهم، وليس هو وصية النبي
«صلى الله عليه وآله» بإخراجهم.
يقول ابن سعد وغيره:
إنه لما صارت خيبر في أيدي المسلمين، لم يكن لهم من العمال ما
يكفون عمل الأرض، فدفعها النبي «صلى الله عليه وآله» إلى اليهود،
يعملونها على نصف ما يخرج منها.
فلم يزالوا على ذلك،
حتى كان عمر بن الخطاب، وكثر في أيدي المسلمين العمال، وقووا على
عمل الأرض، فأجلى عمر اليهود إلى الشام، وقسم الأموال بين المسلمين
إلى اليوم([45]).
وقريب من ذلك ذكره ابن سلام أيضاً، فراجع([46]).
وبعد أن ذكر العسقلاني هذه الرواية، وذكر رواية عدم اجتماع دينين
في جزيرة العرب، ثم رواية البخاري عن فدع اليهود لعبد الله بن عمر،
قال:
«..ويحتمل
أن يكون كل هذه الأشياء جزء علة في إخراجهم»([47]).
ولكنه احتمال غير
وارد، فإن ظاهر الروايات:
أن السبب في إخراجهم هو خصوص ما تذكره دون غيره، ولا سيما حين يكون
الحديث والتعليل في مقام الاحتجاج والاستدلال ودفع الشبهة، من نفس
ذلك الرجل الذي تصدى لذلك.
ح:
قولهم: إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أمر بإجلاء اليهود
والنصارى من بلاد العرب، وأنه قال: لا يجتمع ببلاد العرب دينان، أو
نحو ذلك،
ينافيه:
1 ـ
قولهم: ـ حسبما روي عن سالم بن أبي الجعد ـ:
«كان
أهل نجران بلغوا أربعين ألفاً،
وكان عمر يخافهم أن يميلوا على المسلمين، فتحاسدوا بينهم، فأتوا
عمر، فقالوا: إنا قد تحاسدنا بيننا، فأجلنا.
وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد كتب لهم كتاباً:
أن لا يجلوا،
فاغتنمها عمر، فأجلاهم الخ..»([48]).
2 ـ
وفي نص آخر: إنما أخرج عمر أهل نجران، لأنهم أصابوا الربا في زمانه([49]).
3 ـ
وعن علي «عليه السلام»: أنه نسب إجلاء أهل نجران إلى عمر أيضاً
فراجع([50]).
إلا أن يقال:
إن نسبة ذلك إليه لا يدل على عدم الأمر به من النبي «صلى الله عليه
وآله».
ط:
عن ابن عمر: أن عمر أجلى اليهود من المدينة، فقالوا: أقرنا النبي
«صلى الله عليه وآله» وأنت تخرجنا؟!
قال:
أقركم النبي «صلى الله عليه وآله»، وأنا أرى أن
أخرجكم،
فأخرجهم من المدينة([51]).
فلو أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان قد أمر بإخراجهم لم ينسب
عمر إخراجهم إلى رأيه الشخصي.
ي:
إنه يرد هنا سؤال، وهو: لماذا يخرجهم من بلاد العرب، ولا يخرجهم من
بلاد المسلمين كلها؟ فهل لبلاد العرب خصوصية هنا؟! وما هي هذه
الخصوصية سوى التعصب القومي، والتمييز العنصري، والشعور بالتفوق
على الآخرين، بلا مبرر ظاهر؟.
ك:
عن يحيى بن سهل بن أبي حثمة، قال: أقبل مظهر بن رافع الحارثي إلى
أبي بأعلاج من الشام، عشرة، ليعملوا في أرضه، فلما نزل خيبر أقام
بها ثلاثاً،
فدخلت يهود للأعلاج، وحرضوهم على قتل مظهر، ودسوا لهم سكينين أو
ثلاثاً!
فلما خرجوا من خيبر، وكانوا بثبار، وثبوا عليه، فبعجوا بطنه،
فقتلوه،
ثم انصرفوا إلى خيبر، فزودتهم يهود وقوّتهم
حتى لحقوا بالشام.
وجاء عمر بن الخطاب
الخبر بذلك، فقال:
إني خارج إلى خيبر، فقاسم ما كان بها من الأموال، وحاد حدودها،
ومورف أرفها([52])،
ومجل يهود عنها، فإن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال لهم:
أقركم ما أقركم الله،
وقد أذن الله في إجلائهم،
ففعل ذلك بهم([53]).
وفي الواقدي:
أن عمر خطب الناس، فقال: أيها الناس إن اليهود فعلوا بعبد الله ما
فعلوا، وفعلوا بمظهر بن رافع، مع عدوتهم على عبد الله بن سهل في
عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، لا أشك أنهم أصحابه، ليس لنا
عدو هناك غيرهم؛ فمن كان له هناك مال؛ فليخرج؛ فأنا خارج فقاسم.
إلى أن قال:
إلا أن يأتي رجل منهم بعهد، أو بينة من النبي «صلى الله عليه وآله»
أنه أقره، فأقره.
ثم ذكر تأييد طلحة
لكلام عمر، ثم قول عمر له:
من معك على مثل رأيك؟!
قال:
المهاجرون جميعاً، والأنصار. فسُرَّ
بذلك عمر([54]).
ل:
قال الحلبي الشافعي بعد ذكره رواية مصالحة النبي «صلى الله عليه
وآله» لهم، وأنه «صلى الله عليه وآله» قال لهم: على أنَّا
إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم:
«أي
وهذا يخالف ما عليه أئمتنا من أنه لا يجوز في عقد الجزية أن يقول
الإمام، أو نائبه: أقركم ما شئنا، بخلاف ما شئتم، لأنه تصريح
بمقتضى العقد؛ لأن لهم نبذ العقد ما شاؤوا.
وذكر أئمتنا:
أنه يجوز منه «صلى الله عليه وآله» ـ لا منا ـ أن يقول: أقررتكم ما
شاء الله؛ لأنه يعلم مشيئة الله دوننا»([55]).
ونقول: إن ذلك محل نظر؛ إذ:
1 ـ
من الذي قال: إنه «صلى الله عليه وآله» يعلم ـ في هذا المورد
بخصوصه ـ مشيئة الله سبحانه؟!.
2 ـ
لماذا لا يصح للنبي، ولغيره أيضاً، أن يقول ذلك؟! أليس حكمهم
الجلاء، وقد عادت الأرض إلى الرسول «صلى الله عليه وآله»، لتكون
خالصة له؟ فهو يزارعهم في ملكه، وله أن يمنعهم من العمل والسكنى
فيها متى شاء. لا أن الأرض لهم، وهو «صلى الله عليه وآله» ينتظر
نقضهم للعهد، حتى تكون المشيئة إليهم في النقض وعدمه، كما يريد
هؤلاء أن يفهموا.
م:
إن عمر إنما أجلاهم إلى أريحا وتيماء من جزيرة العرب([56]).
وقد حاول الحلبي الشافعي دعوى: أن المقصود بجزيرة العرب خصوص
الحجاز، وأريحا وتيماء ليستا من الحجاز، ولعله استند في ذلك إلى
بعض النصوص التي عبرت بكلمة
«الحجاز»
بدل
«جزيرة العرب»
كما يفهم من كلامه ضمناً([57]).
ونقول:
أولاً:
إن الروايات متناقضة، فبعضها قال: اليهود والنصارى.
وبعضها قال:
المشركين.
وفي بعضها:
لا يبقى دينان في جزيرة العرب.
وفي بعضها:
اليهود.
ومن جهة أخرى:
فإن بعضها ذكر الحجاز، وبعضها ذكر جزيرة العرب.
وفي بعضها أنه قال:
أخرجوا اليهود من الحجاز، وأخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب([58]).
وهذا الاختلاف يوجب ضعف الرواية إلى حد كبير.
ثانياً:
قال السمهودي:
«لم
ينقل أن أحداً من الخلفاء أجلاهم من اليمن، مع أنها من الجزيرة»([59])،
ثم قال: فدل على أن المراد الحجاز فقط.
ونقول:
بل دل ذلك على ضعف الرواية من الأساس لا سيما وأن عدداً
من الروايات يصرح بأن النبي قال: لا يبقين دينان بأرض العرب،
وأرض العرب لا تختص بالحجاز كما هو معلوم.
ثالثاً:
إن تيماء من الحجاز أيضاً، قال ابن حوقل: بينها وبين أول الشام
ثلاثة أيام([60]).
وهي تقع على ثمان مراحل من المدينة بينها وبين الشام، وهي تعد من
توابع المدينة([61]).
ومدين التي هي من أعراض المدينة تقع في محاذاة تبوك([62]).
وتبوك أبعد من تيماء كما هو ظاهر.
وآخر عمل المدينة
«سرغ»،
بوادي تبوك، على ثلاث عشرة مرحلة من المدينة([63]).
وقالوا عن سرغ:
إنها أول الحجاز، وآخر الشام([64]).
بل لقد قال الحرقي:
تبوك وفلسطين من الحجاز([65]).
ولكن قال السمهودي:
إن عمر
«لم
يخرج أهل تيماء ووادي القرى، لأنهما داخلتان في أرض الشام.
ويرون:
أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز، وأن ما وراء ذلك من الشام»([66]).
ولكن السمهودي نفسه ينقل عن صاحب المسالك والممالك وعن ابن قرقول:
أنهما قد عدا وادي القرى من المدينة([67]).
كما أن ابن الفقيه قد عد دومة الجندل من أعمال المدينة، ووادي
القرى تقع فيها([68]).
وقال ياقوت وغيره:
إن وادي القرى من أعمال المدينة، أيضاً([69]).
وعدها ابن حوقل وغيره من الحجاز([70]).
وبعد هذا:
فإن كلام السمهودي يصبح متناقضاً
وغير واضح، وإن كان يمكن الاعتذار عنه بأنه ينسب بعض ما يقوله
لغيره، وذلك لا يدل على رضاه وقبوله به.
ولكن هذا الاعتذار إنما يصح في بعض الموارد دون بعض، مع ملاحظة:
أننا لم نجده يعترض على ما ينقله عن الآخرين، بل ظاهره أنه مصدق
ومعترف به.
وقد حاول الحلبي
هنا:
أن يجعل من أسباب كثيرة سبباً
واحداً، فوقع في التناقض والاختلاف، فإنه بعد أن ذكر: عزم عمر على
إجلاء اليهود، بسبب ما فعلوه بولده وبعبد الله بن سهل، وبمظهر بن
رافع، قال:
«فلما
أجمع الصحابة على ذلك، أي على ما أراده سيدنا عمر، جاءه أحد بني
الحقيق فقال له: يا أمير المؤمنين الخ..»
فذكر القصة المتقدمة وأن عمر لم ينس قول النبي لابن أبي الحقيق حول
خروجه.
ثم قال:
«ثم
بلغه (رض): أنه «صلى الله عليه وآله» قال: لا يبقى دينان في جزيرة
العرب ونصوصاً
أخرى تقدمت».
ثم ذكر أن المراد بالجزيرة خصوص الحجاز.
إلى أن قال:
«ففحص
عمر عن ذلك حتى تيقنه وثلج صدره فأجلى يهود خيبر، أي وأعطاهم قيمة
ما كان لهم من ثمر وغيره وأجلى يهود فدك، ونصارى نجران، فلا يجوز
إقامتهم أكثر من ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج، ولم يخرج
يهود وادي القرى وتيماء، لأنهما من أرض الشام لا من الحجاز»([71]).
فهو يقول:
إن عمر هو الذي عزم على إجلاء اليهود ثم يقول: إن الصحابة قد
أجمعوا. ثم يذكر أنه عرف بأوامر النبي «صلى الله عليه وآله» حول
اليهود بعد هذا العزم وبعد ذلك الإجماع، فلما تيقنه وثلج صدره
أجلاهم.
كما أنه يذكر العبارات المتناقضة حول جزيرة العرب والحجاز، ويدَّعي
أن المقصود بالجزيرة هو خصوص الحجاز، ولكنه يدَّعي
أن تيماء ووادي القرى ليستا من الحجاز، مع أن النصوص الجغرافية على
خلاف ذلك، حسبما أوضحناه.
ثم يذكر:
أنه أعطاهم ثمن أموالهم.. ولا ندري السبب في ذلك إن كان إخراجهم
بسبب نقضهم للعهد، فإن ناقض العهد لا يعطى ذلك..
وأخيراً..
فإنه
ادَّعى
عدم جواز اقامتهم أكثر من ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج، فهل
هذا الحكم مأخوذ من النبي «صلى الله عليه وآله»، أم أنه حكم سلطاني
متأخر عن زمنه «صلى الله عليه وآله»؟
ولا ندري كيف أُجيز لهم ذلك بعد منعه «صلى الله عليه وآله» لهم من
البقاء في أرض العرب.
كما أننا لا نعرف:
من أين جاء استثناء يومي الخروج والدخول؟
إلى غير ذلك من الأسئلة،
التي يمكن استخلاصها من مجموع ما ذكرناه.
ولعلنا لا نبعد
كثيراً إذا قلنا:
إن حديث
«لا
يجتمع في جزيرة العرب دينان»
هو من قول عمر، وقد نسب إلى النبي «صلى الله عليه وآله»
من أجل تصحيح ما أقدم عليه عمر من نقض عهد اليهود لأجل ابنه، أو
لغير ذلك من أسباب، لم ير فيها النبي «صلى الله عليه وآله»
ما يوجب ذلك حسبما ألمحنا إليه؛
فقد قال أبو عبيد الله القاسم بن سلام:
«حدثنا
يحيي بن زكريا بن أبي زائدة، ومحمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر،
عن نافع عن ابن عمر، قال: أجلى عمر المشركين من جزيرة العرب، وقال:
«لا
يجتمع في جزيرة العرب دينان»
وضرب لمن
قدم منهم أجلاً،
قدر ما يبيعون سلعهم»([72])
انتهى.
فترى في هذا الحديث:
أنه قد نسب القول بعدم اجتماع دينين في جزيرة العرب إلى عمر نفسه
من دون إشارة إلى رسول الله، ولعله الأوفق والأولى، وقد تقدم ما
يشير إلى أن ذلك كان رأياً من عمر، فلا نعيد.
قد تقدم:
أن آية لا إكراه في الدين قد نزلت في مناسبة غزوة بني النضير، حيث
كان معهم أولاد للأنصار أراد آباؤهم أن يمنعوهم من الخروج معهم
فنزلت هذه الآية.
ونقول:
إن ذلك موضع مناقشة وغير مسلَّم؛
وإن أصر عليه القرطبي([73]).
فأولاً:
قد روي في سبب نزول الآية:
1 ـ
إن سبب نزولها هو وجود أبناء للأنصار في بني النضير، عن
طريق الاسترضاع فثبتوا على دينهم، فلما جاء الإسلام أرادهم أهلوهم
على الإسلام فنزلت([74]).
2 ـ
عن السدي: أنها نزلت في أبي حصين الأنصاري، الذي تنصر ابناه، ومضيا
إلى الشام، فطلب من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يبعث من يردهما،
فنزلت([75]).
ثانياً:
إن منع الأنصار أولادهم من الخروج مع اليهود لا يعني إجبارهم على
الدخول في الإسلام، ولم يرد الآباء ذلك من أولادهم، وإنما أرادوا
منعهم من الخروج فقط..
وتقول بعض المصادر:
إن بني النضير
«تحملوا
إلى الشام»
كما هو مذكور في بعض الروايات.. أي إلى أذرعات منها([76]).
وتذكر مصادر أخرى:
أنهم أجلوا إلى خيبر([77]).
وتذكر مصادر أخرى:
أنهم أجلوا إلى فدك([78]).
فقد يتخيل وجود تناقض فيما بين هذه النصوص..
فإذا ضممنا ذلك إلى نصوص أخرى، فإن هذا التناقض يتأكد، حيث نجد
بعضها يقول:
«تحملوا
إلى خيبر، وإلى الشام، وممن سار منهم إلى خيبر، أكابرهم، كحيي بن
أخطب، وسلام بن
أبي
الحقيق، وكنانة بن الربيع، فدانت لهم خيبر»([79]).
وقال آخر:
«ومضى
من بني النضير إلى خيبر ناس، وإلى الشام ناس»([80]).
وآخر يقول:
«خرجوا
إلى أذرعات، وأريحا، وخيبر، وحيرة»([81]).
وبعض آخر يذكر ذلك، من دون ذكر الحيرة([82]).
ونص آخر يذكر:
أنهم لحقوا بأذرعات بالشام وأريحا، إلا أهل بيتين منهم: آل أبي
الحقيق، وآل حيي بن أخطب، فإنهم لحقوا بخيبر، ولحقت طائفة منهم
بالحيرة([83]).
وجاء في بعض النصوص
قوله:
«وطاروا
كل مطير، وذهبوا كل مذهب، ولحق بنو أبي الحقيق بخيبر، ومعهم آنية
كثيرة من فضة، فرآها النبي «صلى الله عليه وآله» والمسلمون، وعمد
حيي بن أخطب حتى قدم مكة على قريش، فاستغواهم على رسول الله «صلى
الله عليه وآله»([84]).
وآخر نص نذكره هو ما
قاله البعض:
«وقع
قوم منهم إلى فدك، ووادي القرى، وخرج قوم منهم إلى الشام»([85]).
ونلاحظ:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد أجلاهم، وسمح لهم بأن يأخذوا ما أقلته
الإبل، إلا الحلقة.
وتذكر بعض النصوص إحصائية لما حصل عليه المسلمون من سلاح، فتقول:
«فوجد
من الحلقة خمسين درعاً
وخمسين بيضة، وثلاثمائة سيف، وأربعين سيفاً»([86]).
ومن الواضح:
أن في ذلك قوة للمسلمين الذين يواجهون العدو المتربص بهم ليل نهار
وفي كل اتجاه.
ثم هو إضعاف لعدوهم، مادياً
ومعنوياً،
وله تأثيرات سلبية على معنويات كل أولئك الذين يتعاطفون معهم،
ويميلون إليهم.
ومن وجهة نظر مبدئية، وعقيدية، فإن السلاح لا يكون إلا للمؤمنين،
وهم وحدهم الذين يملكون الحق في السلاح، لأنهم إنما ينصرون به
الحق، ويدمرون به الباطل.
أما الآخرون فعلى العكس من ذلك، ولا أقل من أن السلاح ـ إذا كان
بأيدي غير المؤمنين ـ فإنه تصبح له حالة ردع تلقائية، وتخوف في
قلوب المؤمنين الذين لا بد لهم أن يعملوا على نشر الدين، وإعزازه،
واستئصال الباطل وإذلاله.
وإن ما جرى لبني النضير، وهم أعز يهود منطقة الحجاز، قد جعل
المنافقين، الذين كانوا يلتقون معهم في العداء للإسلام، والخلاف له
وعليه، وقد ثقل عليهم إقامة شعائره، والالتزام بأحكامه، وأن يربوا
أنفسهم تربية صالحة، وفقاً
لأهدافه ومراميه ـ قد جعلهم ـ يحسون بالضعف، ويشعرون بأنهم قد
خسروا واحداً من أهم حلفائهم ومن هم على رأيهم، ولهم نفس أهدافهم
وطموحاتهم بالنسبة إلى مستقبل الإسلام والمسلمين..
فخابت آمالهم، وتبخرت أحلامهم، التي كانوا قد نسجوها، وخدعوا
أنفسهم بها..
إذ إن من الواضح:
أن مجاراة المنافقين للمسلمين، إنما كانت ـ في الأكثر ـ تهدف إلى
الحصول على بعض الامتيازات والمنافع، ثم يديرون ظهورهم إليهم
ويواصلون مسيرتهم بالطريقة التي تروق لهم، وبالأسلوب الذي يعجبهم
ويحلو لهم. فليس الإسلام والمسلمون سوى وسائل توصلهم إلى تلك
المآرب، وتحقق لهم هاتيكم الأهداف..
وأما أولئك الذين أظهروا الإسلام، لأن ظروفهم وعلاقاتهم قد فرضت
عليهم ذلك، وكانوا بانتظار زوال ذلك الكابوس، فإنهم أيضاً قد تلقوا
ضربة هائلة ومخيفة، وهم يرون الإسلام تقوى شوكته، ويتعمق ويتجذر،
ويستقطب ويجتاح كل خصومهم، ويدمرهم، أو يقضي على مصادر القوة فيهم.
فكان من الطبيعي أن نجد المنافقين من أولئك وهؤلاء يشتد حزنهم،
ويتضاعف كمدهم، ويكبر خوفهم، ولم يخف حالهم على أحد، وسجلهم
التاريخ على صفحاته، ليخلد خزيهم، وذلهم، فذكر المؤرخون: أنه حين
أجلي بنو النضير:
«حزن
المنافقون عليهم حزناً
شديداً»([87]).
ونجد فيما حفظه لنا التاريخ من تأوهات، وصرخات مكتومة وظاهرة لبعض
هؤلاء الذين كانوا يتعاطفون مع اليهود، رغم ما يرونه من غدرهم
ومجانبتهم للحق ـ نجد ـ بعض ما يثير فينا عجباً
لا حد له..
فإن بعض الناس الذين كنا وما زلنا نرى ونسمع لهم الكثير من المدح
والثناء، والتعظيم والتبجيل، قد عبروا عن عميق احترامهم، وعن
تعاطفهم مع أولئك الغدرة الفجرة، أعداء الله، وأعداء رسوله، فاقرأ
النص التالي، واعجب ما بدا لك:
حينما أجلى النبي «صلى الله عليه وآله» بني النضير..
«قال
حسان بن ثابت، وهو يراهم وسراة الرجال على الرحال: أما والله،
أن
لقد كان عندكم لَنائلٌ للمجتدي، وقرى حاضرٌ للضيف، وسقياً
للمدام، وحلم على من سفه عليكم، ونجدة إذا استنجدتم.
فقال الضحاك بن
خليفة:
وا صباحاه، نفسي فداؤكم؛ ماذا تحملتم به من السؤدد والبهاء،
والنجدة والسخاء؟
قال:
يقول نعيم بن مسعود الأشجعي: فدى لهذه الوجوه التي كأنها المصابيح،
ظاعنين من يثرب. من للمجتدي الملهوف؟ ومن للطارق السغبان؟ ومن يسقي
العقار؟ ومن يطعم الشحم فوق اللحم؟ ما لنا بيثرب بعدكم مقام.
يقول أبو عبس بن
جبر، وهو يسمع كلامه:
نعم، فالحقهم حتى تدخل معهم النار.
قال نعيم:
ما هذا جزاؤهم منكم، لقد استنصرتموهم فنصروكم على الخزرج، ولقد
استنصرتم سائر العرب؛ فأبوا ذلك عليكم.
قال أبو عبس:
قطع الإسلام العهود.
قال:
ومرّوا وهم يضربون الدفوف والمزامير الخ..([88]).
ونلاحظ هنا:
ألف:
إن حسان بن ثابت يمدح بني النضير بأنهم كانوا يسقون المدام!! وكذلك
نعيم بن مسعود الأشجعي..
ومعنى ذلك:
هو أن إسلام هؤلاء لم يكن معمقاً،
ولا راسخاً
في نفوسهم.
وأنهم لا يزالون يهتمون بالمدام (أو العقار) ويتعشقونها، رغم نهي
النبي عنها، ونزول القرآن بتحريمها..
ب:
إننا نلاحظ: أن حسان بن ثابت كان مقرباً
من الهيئة التي حكمت الناس بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
كما أنه كان منحرفاً
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «عليه السلام»، ولم يبايعه، بل
يقال: إنه سب علياً «عليه السلام» وهجاه([89]).
ج:
إن الأمور التي تمدح بها هؤلاء الأشخاص اليهود، لا تنطلق ـ في
أكثرها ـ من قيم إنسانية سامية، وإنما هي الحالات والأوضاع التي
يتطلبها واقع حياتهم، وخصوصيات معيشية في مجتمع لا يملك نظرة
بعيدة، ولا تقييماً
سليماً
للكون والوجود، وللحياة وللإنسان.. فلتراجع الفقرات بدقة ليتضح
ذلك..
د:
إن هذا التعاطف الذي نراه لا ينطلق من الإحساس الإنساني، ولا من
مثل أعلى، وإنما هو ينطلق من حالة هلع وأسف على فوات منافع دنيوية
ومادية للمتأسفين بالدرجة الأولى..
هـ:
إن تأسف حسان بن ثابت وغيره على بني النضير، رغم أنهم قد رأوا بأم
أعينهم ظلمهم وبغيهم، وغدرهم، ومجانبتهم للحق، لأمر يثير العجب حقاً.
ولا ندري إن كان ذلك يكفي لعد هؤلاء في جملة الذين عنتهم الآية
القرآنية التي تقول:
﴿أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا
يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا
نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِن قُوتِلْتُمْ
لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾([90]).
فهي لا تشمل الذين يفدون اليهود بأنفسهم، ويتأسفون عليهم لما
نالهم، ويرون: أنهم لم يعاملوا بما يليق بهم، بل كانوا مظلومين
فيما أصابهم.
أم أن الآية لا يجوز أن تتجاوز عبد الله بن أبي وأصحابه المجهولين!
على اعتبار أن حساناً
وسواه من حواريي الحكام بعد النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله»، لا
يفسقون بما يفسق به الآخرون ـ كما جاء في السيرة الحلبية([91])
ـ ولا تشملهم الآيات التي تشمل غيرهم ممن هم على شاكلتهم وطريقتهم،
ما دام أن نفس رضا الحكام عنهم يعطيهم مناعة وصلابة تجعلهم في مأمن
من كل العوادي، وترفعهم عن مستوى هذا البشر العادي..
إن المراجع لتأريخ التزوير والتحوير لسوف يدرك الحقيقة، ويعرف
الغثاء ويميزه عن ذلك الذي يمكث في الأرض مما ينفع الناس.
وقد جاء في رواية عن ابن عمر:
«..إن
يهود بني النضير وقريظة، قتل رجالهم، وقُسم نساؤهم، وأموالهم،
وأولادهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحق برسول الله «صلى الله
عليه وآله» فآمنهم، وأسلموا. وأجلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»
يهود المدينة من بني قينقاع، وهم قوم عبد الله بن سلام الخ..»([92]).
وواضح:
أن ذلك لا يصح بالنسبة إلى بني النضير؛ لأنه «صلى الله عليه وآله»
لم يقتل رجالهم، ولا سبى نساءهم وأولادهم، ليقسمها فيما بين
المسلمين. وإنما أجلاهم عن أرضهم، وقسم أرضهم بين المسلمين..
وعليه..
فلا يصح ما ذكره إلا بالنسبة لبني قريظة؛ فإنهم هم الذين جرى لهم
ذلك..
هذا..
وقد ذكرت هذه الرواية نفسها عن ابن عمر في ذلك المصدر بالذات، وقد
فصل فيها ما جرى لبني قريظة، ولبني النضير على نحو أصح. فذكر جلاء
بني النضير وقتل بني قريظة، وسبي نسائهم وأولادهم، فليراجعها من
أراد([93]).
قال الهيثمي:
«باب
غزوة بني النضير: عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: جاء جبريل إلى
النبي «صلى الله عليه وآله»، وقد كلّ
أصحابه، وهو يغسل رأسه، فقال: يا محمد، قد وضعتم أسلحتكم، وما وضعت
الملائكة بعد أوزارها. فكف رسول الله «صلى الله عليه وآله» شعره
قبل أن يفرغ من غسله؛ فأتوا النضير؛ ففتح الله له.
رواه الطبراني، وفيه نعيم بن حيان، وهو ضعيف، وقد وثقه ابن حبان،
وقال: يخطئ»([94]).
وسياق الحديث يدل دلالة بينة على أن المقصود هو بنو قريظة؛ فإن هذه
القصة إنما حدثت معهم؛ لا مع بني النضير، ولعل هذا من أخطاء نعيم
الذي ذكر ابن حبان: أنه يخطئ، وإن كان ثقة..
وقد جاء في بعض
النصوص:
«وحملوا
النساء والصبيان، وتحملوا على ستمائة بعير، فقال رسول الله «صلى
الله عليه وآله»: هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش»([95]).
وكلمة النبي «صلى الله عليه وآله» هذه تشير إلى أنه «صلى الله عليه
وآله» كان يعرف بدقة وبعمق خصائص الفئات ومزاياها، سواء في ذلك
أولئك الذين عاش معهم منذ نعومة أظفاره، وهم مشركو مكة، وقبائلها،
أو أولئك الذين فرضت عليه الظروف أن يكون له منهم موقف سلبي أو
إيجابي.
وإذا رجعنا إلى التاريخ، ونصوصه، فإننا نستطيع أن نعرف وجه الشبه
بين بني المغيرة في قريش، وبني النضير في اليهود..
فقد ذكرت بعض
النصوص:
أن بني النضير: كانوا من بني هارون([96])،
وذلك مما يزيد في شرفهم وعزهم بالنسبة إلى سائر اليهود، كبني
حارثة، وغيرهم، أما بنو قريظة، فإنهم، وإن كانوا من بني هارون أيضاً،
إلا أن بني النضير كانوا أكثر منهم مالاً، وأحسن حالاً،
وكانوا ألف رجل، وبنو قريظة سبعمائة، وكانوا إذا قتل نضيري قريظياً،
فإنه يدفع نصف الدية ويجبه ويحمم (أي يسود وجهه، ويحمل على جمل،
ويكون وجهه إلى ناحية ذنبه، ويطاف به) وإذا قتل قريظي نضيرياً،
فإنه يدفع الدية كاملة، ويقتل به.
وللنضير القوة والسلاح والكراع([97]).
ومن جهة ثانية:
فإن من الطبيعي أن ينعكس ذلك على نفسيات بني النضير، وأن يشعروا
بالزهو والخيلاء، حتى إننا لا نجد مبرراً
لتكذيب النص الذي يقول:
«إنهم
استقبلوا بالنساء والأبناء والأموال، معهم الدفوف، والمزامير،
والقيان يعزفن خلفهم بزهاء وفخر، ما رؤي مثله من حي من الناس في
زمانهم»([98]).
وعند الدياربكري:
«فعبروا
من سوق المدينة»([99]).
وقال ابن الوردي:
«فخرجوا
ومعهم الدفوف والمزامير تجلداً»([100]).
وقال الواقدي:
«..ثم
شقوا سوق المدينة، والنساء في الهوادج، عليهن الحرير والديباج،
وقطف الخز الخضر، والحمر، قد صف لهم الناس.
فجعلوا يمرون قطاراً
في إثر قطار، فحملوا على ستمائة بعير.
إلى أن قال:
ومروا يضربون بالدفوف، ويزمرون بالمزامير، وعلى النساء المعصفرات
وحلي الذهب،
قال: يقول جبار بن صخر:
ما رأيت زهاءهم لقوم زالوا من دار إلى دار.
ونادى أبو رافع، سلام بن أبي الحقيق ـ ورفع مسك الجمل ـ (في
الحلبية: أن هذا المسك كان مملوءاً
من الحلي) وقال: هذا مما نعده لخفض الأرض ورفعها، فإن يكن النخل قد
تركناه، فإنا نقدم على نخل بخيبر»([101]).
وحسب نص المسعودي:
«..فخرجوا
يريدون خيبر، وهم يضربون بالدفوف، ويزمرون بالمزامير، وعلى النساء
المصبغات، والمعصفرات، وحلي الذهب، مظهرين بذلك تجلداً»([102]).
ولقد كان هذا أمراً
متوقعاً
من فئة لم تزل موضع احترام وتبجيل من اليهود، ولا تريد أن تعترف
بالهزيمة، وبكسر شوكتها، وذهاب عزها، وأفول نجمها.
وقد بلغ هذا العز
والمنعة:
أن المسلمين ما ظنوا أن يخرجوا من ديارهم، كما صرحت به الآية
الكريمة.
وعدا عن ذلك، فقد كان بنو النضير أهل جبروت وقسوة وبغي، وعنجهية،
واعتداد بالنفس، حتى إنهم ليظلمون إخوانهم من بني قريظة، وهم أيضاً
من بني هارون، ظلماً
فاحشاً
ومخالفاً
لأحكام التوراة الصريحة، وحتى لأحكام أهل الجاهلية أيضاً.
ثم لا يوجد بينهم من يأنف من هذا الظلم ويمنع منه، أو يندد به،
ويرفضه، لا من رؤسائهم، ولا ممن هم دونهم، من عقلائهم وأهل الدين
منهم.
هذا باختصار حال بني النضير في قومهم.
أما حال بني المغيرة في قريش، فإنها أيضاً تشبه حالة هؤلاء إلى حد
كبير.
فقد كان بنو المغيرة، من بني مخزوم، وكان العدد والشرف والبيت فيهم([103])،
وكانت قريش ـ فيما زعموا ـ تؤرخ بموت هشام بن المغيرة([104])،
الذي أثنى عليه الكثيرون، وكذا الحارث بن هشام فإنه منهم، وهو موضع
الثناء والتعظيم أيضاً([105]).
ومنهم كذلك الوليد بن المغيرة، الذي هو أحد العظيمين اللذين أشار
إليهما الله تعالى في الآية الكريمة:
﴿وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا
الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾([106]).
وقد رثى أبو طالب «رحمه الله» أبا أمية بن المغيرة فقال:
وقد أيقن
الركب الذي أنت فيهم
إذا رحـلــوا
يـومـاً
بـأنـك
عـاقـر
فسمي زاد الراكب، واسمه حذيفة، وكانت عنه عاتكة بنت عبد المطلب([107]).
وقد ذكر المعتزلي طائفة كبيرة من رجالهم وأمجادهم في الجاهلية،
وشطراً
ممن تقلد منهم مناصب جليلة في حكم الأمويين، وغيرهم، فليراجعه من
أراد([108]).
وإن المتتبع لسيرة رجال بني المغيرة من أمثال خالد بن الوليد، وأبي
جهل، والوليد بن المغيرة وغيرهم ليجد فيهم الكثير من الزهو
والخيلاء، حتى إن خالد بن الوليد حين قتل مالك بن نويرة وزنى
بامرأته في ليلة قتله، قد عاد إلى أبي بكر، وقد غرز في عمامته
أسهماً،
فانتزعها عمر، فحطمها، ثم قال له: أرئاء قتلت امرءاً
مسلماً،
ثم نزوت على امرأته؟! والله، لأرجمنك بأحجارك. والقصة معروفة([109]).
كما أن شدتهم وقسوتهم وجبروتهم تعتبر من الأمور الظاهرة، وقد عبر
أمير المؤمنين «عليه السلام» عنهم بالفراعنة، حين قال:
«..
وقد علمت من قتلت به من صناديد بني عبد شمس، وفراعنة بني سهم،
وجمح، ومخزوم»([110]).
فإن فراعنة بني مخزوم كانوا من بني المغيرة، لأنهم هم الذين كان
العدد والشرف والبيت فيهم، كما ألمحنا إليه فيما سبق.
إذاً،
فلا يجرؤ أحد على مناوأتهم والرد عليهم، إلا إن كان من بني عبد
مناف، الذين لا يدانيهم أحد في الشرف والسؤدد.
هذا كله..
بالإضافه إلى وضعهم المادي المتميز، كما يظهر من ملاحظة حياة
الكثيرين منهم.
وهم بالإضافة إلى ذلك كله،
أهل سياسة وكياسة، يأنس الإنسان إلى حديثهم، ويستلذ الجلوس إليهم،
حيث قد روي أن أمير المؤمنين «عليه السلام» قال:
«أما
بنو مخزوم، فريحانة قريش، تحب حديث رجالهم، والنكاح في نسائهم»([111]).
وبعد ذلك كله:
فقد أصبح واضحاً
إلى حدٍ
ما،
سر جعل بني النضير في اليهود بمنزلة بني المغيرة في قريش.
وأخيراً..
فإن الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» هو الأسوة والقدوة في كل
شيء، وإن معرفته الدقيقة بواقع المجتمع الذي يعيش فيه، ويتعامل
معه.. لتعطينا: أن هذه المعرفة لازمة وضرورية لكل إنسان يصل إلى
موقع القيادة، ويفترض فيه أن يتعامل مع الناس، ويسجل موقفاً
تجاههم؛ فإن العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس([112]).
ويقول البعض:
إن قوله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَآ الَّذِينَ آمَنُواْ
اذْكُرُواْ نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن
يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ
عَنكُمْ..﴾([113]).
قد نزلت في قضية بني النضير، ومحاولتهم الغدر بالنبي «صلى الله
عليه وآله»([114]).
ونقول: إننا نشك في ذلك، لما يلي:
أولاً:
إن نفس هذا القائل قد عاد فذكر بعد بضعة أسطر: أن هذه الآية قد
نزلت في قضية غورث بن الحارث([115]).
وذكرت حوادث أخرى في شأن نزول الآية، فلتراجع في مظانها([116]).
ودعوى البعض:
جواز تكرار النزول([117])،
تحتاج إلى إثبات.
ثانياً:
إن سورة المائدة كانت من آخر ما نزل على النبي «صلى الله عليه
وآله»، فلا يعقل أن يحتفظ بهذه الآية عدة سنوات، معلقة في الهواء،
حتى تنزل سورة المائدة، فيجعلها فيها([118]).
ثالثاً:
إنهم يقولون: إن سورة المائدة قد نزلت دفعة واحدة([119]).
إن من الأمور
الظاهرة لكل أحد:
أن القرآن الكريم، وفي نطاق اهتمامه الكبير بتربية الإنسان، وصقل
فكره، وعقله، ومشاعره، وكل مناحي وجهات شخصيته، ليجعله إنساناً
واعياً،
وقوياً
وغنياً
في كل مواهبه، وطاقاته، قد اختار في أسلوبه التربوي المنحى
والأسلوب الواقعي ليتصل به، ويدخل إلى حياته، وينفذ إلى شخصيته،
وإلى عمق وجوده، عن هذا الطريق، فإن هذا الأسلوب هو الذي يتصل
بالعقل، فيعطيه وضوحاً
ووعياً
وأصالة، ويتفاعل مع الشعور ليمده بالحيوية والفاعلية، وينقله إلى
رحاب الضمير، ليتربى ويتكامل في ظل الوجدان، وتحت حمايته، ليصبح في
حالة متوازنة، مرضية ومقبولة..
وهذا بالذات هو ما يفسر لنا اهتمام الإسلام بالتركيز على الحدث، ثم
ربطه بالحقائق الكلية، بما لها من عموم وشمول، ليصبح ذلك الحدث هو
الوسيلة الواقعية لربط هذا الإنسان بتلك الحقائق، وتفاعله معها.
وهكذا.. يتضح:
أن القرآن حين يتحدث عن الوقائع والأحداث، فإنه يفهمنا: أنه لا
يريد أن يلقي على الإنسان حقائق مجردة، ومنفصلة عن الواقع، ولا
تلامسه ولا تلتقي معه، وذلك حينما تبقى مجرد صورة ذهنية، وتخيلات
مثالية باردة، لا تؤثر في المشاعر، ولا تتصل بالعقل، ولا تتفاعل مع
الوجدان.
وإنما هو يريدها حركة في الفكر، وثورة في الشعور، وحالة متوازنة في
الوجدان، وتجسيداً
واقعياً
لكل ذلك على صعيد السلوك والموقف.
قال تعالى في سورة الحشر:
﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الحَشْرِ مَا
ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ
حُصُونُهُم مِنَ الله فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ
يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ
بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي المُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا
يَا أولِي الأَبْصَارِ﴾([120]).
فنجده تعالى ينسب ما جرى لبني النضير إلى نفسه، ويؤكد على ذلك بصور
مختلفة.. حتى كأن ما فعله المسلمون ليس بشيء يعتد به في موضوع
إلحاق الهزيمة بهذا العدو.
بل إن المسلمين أنفسهم ما كانوا يظنون خروجهم، ولا يتصورونه. كما
أن اليهود أنفسهم كانوا مطمئنين إلى أن حصونهم ستمنعهم. ولكن الله
فتح حصونهم من الداخل، فقذف الرعب في قلوبهم، فلم تنفعهم الحصون
المادية شيئاً.
ومن الواضح:
أن الهزيمة من الداخل هي الأساس للهزيمة المادية، فإذا سقطت
القلوب، وتهاوت، وقذف فيها الرعب، فلسوف لن تنتفع بأي شيء آخر بعد
ذلك، مهما كان قوياً
وكبيراً.
ونفهم من الآية بالإضافة إلى ما تقدم، ما يلي:
1 ـ
إن الحرب النفسية لها دور كبير، بل لها الدور الأكبر في تحقيق
النصر الكبير عسكرياً،
فليلاحظ قوله: وقذف في قلوبهم الرعب.
2 ـ
إن العمل العسكري الناجح، لا بد أن يعتمد على مبدأ المباغتة، من
النواحي التي لا يحسب العدو لها حساباً.
3 ـ
إن الاعتماد على الله في تحقيق النصر، إنما يعني إمكانية مواجهة
العدو حتى في حالة تفوقه العسكري، ومعنى ذلك.. أننا يجب أن لا
ننتظر حتى يتحقق التوازن عسكرياً
وتسليحياً
فيما بين قوى الإيمان وقوى الكفر، بل يمكن المبادرة لمواجهته، حتى
في صورة عدم التكافؤ في الإمكانات المادية.
4 ـ
إن العامل المادي ليس هو القوة الوحيدة، فإن العامل الروحي
والمعنوي له قسط منها، فلا بد من أخذه بنظر الاعتبار.
ويذكر النص
التاريخي:
أن سلام بن مشكم قد نصح حيي بن أخطب بقبول الجلاء من أول الأمر،
حيث تبقى لهم أموالهم ونخلهم، فكان مما قاله له:
«إنا
إنما شرفنا على قومنا بأموالنا وفعالنا، فإذا ذهبت أموالنا من
أيدينا كنا كغيرنا من اليهود في الذلة والإعدام»([121]).
ونقول:
إن هؤلاء يرون:
أن أموالهم هي مصدر عزتهم وعنوان شرفهم..
ولكن الإسلام يقول:
إن مصدر العزة والشرف والكرامة هو الله سبحانه، فعن
الإمام
الصادق «عليه السلام»:
«من
أراد عزاً
بلا عشيرة، وغنى بلا مال، وهيبة بلا سلطان، فلينتقل عن ذل معصية
الله إلى عز طاعته»([122]).
و
«من
أراد أن يكون أعز الناس، فليتق الله عز وجل»([123])،
فإنه
«لا
عز أعز من التقوى»([124])،
و
«من
برئ
من الشر نال العز»([125]).
إلى غير ذلك من النصوص،
التي تجعل من العز وسيلة لتكامل الإنسان في مدارج إنسانيته، وتهذيب
نفسه، وتنزيهها عن كل النقائص، وإبعادها عن كل ما يشين أو يزري
بها.
ثم هي تربط العز بالمنشأ لكل الكمالات، والمصدر لكل فيوضات الخير،
ونزول البركات، ألا وهو الله سبحانه وتعالى، تقدست أسماؤه، وتباركت
ذاته، وتعالت صفاته..
«..وفي
الحديث: يخرج في الكاهنين رجل يدرس القرآن درساً،
لم يدرسه أحد قبله، ولا يدرسه أحد بعده، فكانوا يرونه محمد بن كعب
القرظي الخ..»([126]).
ونحن بدورنا لا نستطيع قبول هذه الرواية،
ولا نرى صحة انطباقها على الشخص المذكور.
فأولاً:
قد اشتهر كثير من الصحابة بدراسة القرآن، وذكرت في الروايات أقوال
منسوبة إلى النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» في حقهم، وأقوال
أخرى منسوبة لغيره أيضاً تشير إلى تفوقهم على محمد بن كعب في دراسة
القرآن،
فراجع ما يروونه في حق أبي بن كعب مثلاً([127])،
وكذا ما يروونه في حق ابن مسعود([128])،
أو علي أمير المؤمنين
«عليه
الصلاة والسلام»([129]).
هذا عدا عما يروونه ويقولونه في حق غير هؤلاء أيضاً.. ومن مثل علي
أمير المؤمنين «عليه الصلاة والسلام»؟ وهو الذي يقول:
«لو
أردت أن أوقر على الفاتحة سبعين بعيراً لفعلت»([130]).
ثانياً:
إننا لم نفهم المقصود من دارسي القرآن ممن سبقوا محمد بن كعب!! فهل
كان القرآن موجوداً
قبل الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله»، وقد درسه الناس، وعرفوه؟!
فإن محمد بن كعب القرظي، قد أسلم على يدي النبي «صلى الله عليه
وآله» وعاش معه!!
ثالثاً:
إن ما ذكروه عن محمد بن كعب يلغي دور عبد الله بن سلام الذي كان من
نفس هؤلاء اليهود، والذي يروون في حقه ـ وإن كان ذلك كذباً
أيضاً ـ:
أنه هو الذي عنده أم الكتاب([131]).
مع أن الصحيح:
هو أنه علي بن أبي طالب «عليه السلام»([132]).
وقد تقدم تحقيق ذلك([133]).
ولعل سر تعظيم محمد بن كعب يرجع إلى أنه لا بد أن يصبح الخبراء في
القرآن، والدارسون له، والواقفون على أسراره
وحقائقه هم أهل الكتاب، وخصوصاً اليهود، الذين لا بد أن تبقى لهم
هيمنتهم العلمية على الناس، ويستمرون في نفث سمومهم، ونشر
أضاليلهم، وتتاح لهم الفرص كلها لتحريف هذا الدين، والتلاعب
بمفاهيمه وأحكامه، وليستهدف ذلك التلاعب والتحريف نفس القرآن، الذي
هو المنشأ والأساس لكل حقائق الإسلام وتشريعاته.
وقد ذكر البعض:
أن صلاة الخوف قد شرعت في بني النضير، وقيل: في ذات الرقاع([134]).
وحيث إننا سوف نتحدث إن شاء الله عن هذا الأمر في غزوة ذات الرقاع،
حيث يذكرون:
أن هذه الصلاة قد شرعت حينها، أو في غزوة الحديبية، كما سنرى،
فإننا نرجئ الحديث عنها إلى هناك.
قال اليعقوبي وغيره:
«..وفي
هذه الغزوة شرب المسلمون الخمر، فسكروا؛ فنزل تحريم الخمر»([135]).
وقال ابن الوردي:
«نزل
تحريم الخمر وهو محاصرهم (قلت): قال في الروضة: إن غزوة بني النضير
سنة ثلاث: وإن تحريم الخمر بعد غزوة أحد والله أعلم»([136]).
عن جابر بن عبد الله (رض) قال: حاصر النبي «صلى الله عليه وآله»
بني النضير، فضرب قبته قريباً
من مسجد الفضيخ، وكان يصلي في موضع الفضيخ ست ليال، فلما حرمت
الخمر خرج الخبر إلى أبي أيوب، ونفر من الأنصار، وهم يشربون فيه
فضيخاً،
فحلوا وقاء السقاء، فهراقوه فيه، فبذلك سمي مسجد الفضيخ([137]).
وروى القمي:
أنه لما نزل تحريم الخمر خرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى
المسجد فقعد فيه، ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينتبذون فيها، فأكفأها
كلها، وقال: هذه كلها خمر، وقد حرمها الله، وكان أكثر شيء أكفئ
يومئذ من الأشربة الفضيخ، فلذلك سمي المسجد ب
«مسجد
الفضيخ»([138]).
وأكثر من ذلك كله جرأة على الله ورسوله «صلى الله عليه وآله» ما
رووه عن ابن عمر: أن النبي «صلى الله عليه وآله» أُتي بجرة فضيخ
بسر، وهو في مسجد الفضيخ فشربه، فلذلك سمي مسجد الفضيخ([139]).
والفضيخ:
عصير العنب، وشراب يتخذ من بسر مفضوخ، ومسجد الفضيخ هو المعروف
بمسجد الشمس.
هذا كله عدا عن
روايتهم:
أن هناك من كان يهدي لرسول الله خمراً
عدة سنوات إلى أن حرمت الخمر([140]).
ونقول:
أولاً:
إن تحريم الخمر ـ كما تقدم في كتابنا هذا ـ قد كان في مكة.. فإن
كان لهذه الرواية حظ من الصحة فلا بد أن يكون الأصحاب قد خالفوا
حكم الله فيها، وارتكبوا الحرام، فنهاهم رسول الله «صلى الله عليه
وآله» عن ذلك، وما ذكر آنفاً
عن أبي أيوب ونفر من الأنصار دليل على صحة ذلك.
ثانياً:
إن منازل بني النضير لم تكن في جهة قباء، ولا مسجد الفضيخ، وذلك
لأنهم يقولون: إن مسجد الفضيخ يقع في شرقي مسجد قباء، على شفير
الوادي، على نشز من الأرض([141]).
وقد تقدم:
أن منازلهم كانت بعيدة جداً عن هذا الموضع. فراجع ما ذكرناه في هذا
الجزء حين الكلام حول شعر حسان بن ثابت في الرواية التي تبين أن
فتح بني النضير كان على يد علي حين قتل عشرة منهم وجاء برؤوسهم إلى
رسول الله «صلى الله عليه وآله».
ثالثاً:
قد روى
أحمد في مسنده، عن ابن عمر: أن النبي «صلى الله عليه وآلـه»
أتي
لـه
بفضيخ في مسجد الفضيخ فشربه، فلذلك سمي مسجد الفضيخ([142]).
ونحن..
وإن كنا نكذب بصورة قاطعة شربه «صلى الله عليه وآله» للفضيخ ـ كيف،
وقد كانت الخمر وكل مسكر قد حرم في مكة، كما أن الخمر مما قد
تسالمت الشرائع على تحريمه([143])
وقد رفض شربها عدد من الناس في الجاهلية كما ذكرناه في الجزء
السادس
من هذا الكتاب،
تحت عنوان: أقوال في تحريم الخمر..
ـ وإن كنا نكذب ذلك ـ
إلا أننا نقول:
لا مانع من أن يؤتى إليه «صلى الله عليه وآله» بذلك، فيرفضه وينهى
عنه، وقد يسمى المكان بما يشير إلى ذلك، لأجل استغراب الناس عمل
ذلك الرجل الذي أتى إلى النبي «صلى الله عليه وآله» بشيء قد حرمه
منذ بُعث، ولا يزال يؤكد تحريمه، ويمنع عنه.
([1])
الآية 14 من سورة الحشر.
([2])
الآية 14 من سورة الحشر.
([3])
الآية 14 من سورة الحشر.
([4])
الآيتان 11 و 12 من سورة الحشر.
([5])
الآية 13 من سورة الحشر.
([6])
الدر المنثور ج6 ص199 عن الديلمي.
([7])
مغازي الواقدي ج1 ص369 والسيرة الحلبية ج2 ص264.
([8])
مغازي الواقدي ج1 ص368.
([9])
الآية 2 من سورة الحشر.
([10])
راجع: الروض الأنف ج3 ص251 ومجمع البيان ج9 ص258 والبحار ج20
ص160 و 161 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص262 والجامع لأحكام
القرآن ج18 ص4 و 5 وأحكام القرآن لابن العربي ج4 ص1766 وراجع:
الكشاف ج4 ص499 والقول الأول موجود في: التبيان ج9 ص558 وكذا
في جامع البيان ج28 ص20 وراجع: غرائب القرآن بهامشه ج28 ص35
ولباب التأويل ج4 ص245 ومدارك التنزيل بهامش نفس الصفحة.
([11])
مجمع البيان ج9 ص258 والبحار ج20 ص161 عنه، وجوامع الجامع ص486
وراجع: مدارك التنزيل (بهامش لباب التأويل) ج4 ص245 وفتح
القدير ج5 ص196 والتفسير الكبير ج29 ص281 والكشاف ج4 ص500.
([12])
مغازي الواقدي ج1 ص374.
([13])
تاريخ الخميس ج1 ص462 وراجع: السيرة الحلبية ج2 ص266 والسيرة
النبوية لدحلان ج1 ص262 ولباب التأويل ج4 ص245 والجامع لأحكام
القرآن ج18 ص4 عن الزهري وعروة بن الزبير، وابن زيد والتفسير
الكبير ج29 ص281 و 280 وقول ابن زيد في: غرائب القرآن المطبوع
بهامش جامع البيان ج28 ص35 وكذا في فتح القدير ج5 ص196.
([14])
الكشاف ج4 ص499 و 500 ومدارك التنزيل، مطبوع بهامش لباب
التأويل ج4 ص245 وراجع: غرائب القرآن بهامش جامع البيان ج28
ص35.
([15])
تفسير القمي ج2 ص359 والبحار ج20 ص169 وتفسير الصافي ج5 ص154
وتفسير البرهان ج4 ص313.
([16])
الجامع لأحكام القرآن ج18 ص5 وراجع: التفسير الكبير ج29 ص280.
([17])
فتح القدير ج5 ص196 وجامع البيان ج28 ص21 والجامع لأحكام
القرآن ج18 ص4.
([18])
راجع المصادر التالية: تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص122
والإكتفاء ج2 ص147 والدر المنثور ج6 ص187 عن البيهقي في
الدلائل، والتفسير الكبير ج29 ص280 وتفسير القرآن العظيم ج4
ص332 ولباب التأويل ج4 ص245 ومدارك التنزيل بهامشه، نفس
الصفحة، والجامع لأحكام القرآن ج18 ص4 و5 وغرائب القرآن بهامش
جامع البيان ج28 ص35.
([19])
التفسير الكبير ج29 ص280.
([20])
راجع على سبيل المثال: تاريخ الأمم والملوك ج2 ص554 والإكتفاء
ج2 ص148 وجامع البيان ج28 ص21 والسيرة النبوية لابن كثير ج3
ص147 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص332 ومنهاج السنة ج4 ص173
وراجع: المغازي للواقدي ج1 ص380 و374 والسيرة الحلبية ج2 ص266.
([21])
النجاف: ما بني ناتئاً فوق الباب، مشرفاً عليه.
([22])
اليهود في القرآن ص78 عن كتاب: اليهود في بلاد العرب ص138
تأليف: ولفنسون.
([23])
راجع: مجمع البيان ج9 ص258 وإرشاد الساري ج7 ص375 وراجع: فتح
الباري ج7 ص254 والبحار ج20 ص160 عنه والتبيان ج9 ص557 ولباب
التأويل ج4 ص245 ومدارك التنزيل بهامشه في نفس الصفحة، وراجع:
الروض الأنف ج3 ص351 والجامع لأحكام القرآن ج18 ص2 و 3 وجوامع
الجامع ص486 وراجع أيضاً: فتح القدير ج5 ص195 والتفسير الكبير
ج29 ص278 و 279 وبعض من تقدم قد ذكر بعض ذلك دون بعض.
([24])
فتح القدير ج5 ص195 وراجع: التفسير الكبير ج29 ص278 و 279.
([25])
مجمع البيان ج9 ص258 والبحار ج20 ص160 عنه.
([26])
راجع: الدر المنثور ج6 ص189 عن عبد الرزاق، وعبد بن حميد،
والبيهقي في الدلائل، وأبي داود، وابن المنذر، ومجمع البيان ج9
ص258 والبحار ج20 ص160 والروض الأنف ج3 ص251 وبهجة المحافل ج1
ص215 و 216 وغرائـب القرآن بهـامش جـامع البيان ج28 ص34
والكشاف ج4 ص499 = = وجوامع الجامع ص486 والمصنف ج5 ص358 و
359 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص332 وراجع: السيرة النبوية
لدحلان ج1 ص262 والتبيان ج9 ص557 عن البلخي، ولباب التأويل ج4
ص245 ومدارك التنزيل بهامشه في نفس الصفحة وجامع البيان ج28
ص19 و 22 وراجع: فتح القدير ج5 ص199 والسيرة الحلبية ج2 ص268.
([27])
الروض الأنف ج3 ص251 وشرح بهجة المحافل ج1 ص216 والسيرة
النبوية لدحلان ج1 ص262 ولباب التأويل ج4 ص245 ومدارك التنزيل
بهامشه في نفس الصفحة وراجع: جامع البيان ج28 ص20 وغرائب
القرآن بهامشه ج28 ص34 والجامع لأحكام القرآن ج18 ص20 وأحكام
القرآن لابن العربي ج4 ص1764 والتفسير الكبير ج29 ص279 والسيرة
الحلبية ج2 ص268.
([28])
عمدة القاري ج17 ص126.
([29])
فتح القدير ج5 ص195 والكشاف ج4 ص499 وراجع: التفسير الكبير ج29
ص278 و 279 وجوامع الجامع ص286.
([30])
الروض الأنف ج3 ص251 وستأتي مصادر أخرى.
([31])
المصنف للصنعاني ج4 ص126 وراجع ج10 ص359 و 360 وراجع: مغازي
الواقدي ج2 ص717 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص371 والبداية
والنهاية ج4 ص219 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص415 وعمدة
القاري ج13 ص306 وفتح الباري ج5 ص240 عن ابن أبي شيبة وغيره،
والموطأ (المطبوع مع تنوير الحوالك) ج3 ص88 وغريب الحديث لابن
سلام ج2 ص67 وراجع وفاء الوفاء ج1 ص320.
([32])
راجع: تاريخ الأمم والملوك ج3 ص21 والكامل في التاريخ ج3 ص224
والإكتفاء ج2 ص271 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص415 والبداية
والنهاية ج4 ص219.
([33])
الإيضاح ص359 وتذكرة الخواص ص62 وسر العالمين ص20 وصحيح
البخاري ج3 ص60 وج4 ص5 و 173 وج1 ص21 و 22 وج2 ص115 والملل
والنحل ج1 ص22 وصحيح مسلم ج5 ص75 والبدء والتاريخ ج5 ص59
والبداية والنهاية ج5 ص227 والطبقات الكبرى ج2 ص244 وتاريخ
الأمم والملوك ج3 ص192 و 193 والكامل في التاريخ ج2 ص320
وأنساب = = الأشراف ج1 ص562 وشرح النهج للمعتزلي ج6 ص51 وتاريخ
الخميس ج2 ص164 ومسند أحمد ج1 ص355 و 324 و 325 والعبر وديوان
المبتدأ والخبر ج2 قسم 2 ص62 والسيرة الحلبية ج3 ص344.
وراجع المصادر التالية: نهج الحق ص273 والصراط المستقيم ج3 ص6
و 3 وحق اليقين ج1 ص181 و 182 والمراجعات ص353 والنص والإجتهاد
ص149 و 163 ودلائل الصدق ج3 قسم 1 ص63 ـ 70.
([34])
راجع المصادر المتقدمة، فقد ذكر عدد منها ذلك، مثل صحيح
البخاري ووفاء الوفاء ج1 ص319 و 321.
([35])
راجع: صحيح البخاري ج2 ص32 و 129 وصحيح مسلم ج5 ص27 ومسند أحمد
ج2 ص149 ووفاء الوفاء ج1 ص320 والسيرة الحلبية ج3 ص58 والروض
الأنف ج3 ص251.
([36])
صحيح مسلم ج5 ص160 والجامع الصحيح للترمذي ج4 ص156 وفيـه: لإن
عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وكنز العمال
ج4 = = ص323 عن ابن جرير في تهذيبه ومسند أحمد ج3 ص345 وج1
ص29 و32 والمصنف للصنعاني ج10 ص359.
([37])
فدعَ: شدخ وشقّ شقاً يسيراً.
([38])
صحيح البخاري ج2 ص77 و 78 وراجع المصادر التالية: كنز العمال
ج4 ص324 وعنه وعن البيهقي، ووفاء الوفاء ج1 ص320 وتاريخ
الإسلام للذهبي (المغازي) ص352 و 353 والبداية والنهاية ج4
ص200 و 220 والإكتفاء ج2 ص271 والمغازي للواقدي ج2 ص716
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص416 والسيرة الحلبية ج3 ص57 و58
والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص378 ومسند أحمد ج1 ص15 بنص أكثر
تفصيلاً، كما هو الحال في بعض المصادر الآنفة الذكر وراجع
أيضاً: زاد المعاد لابن القيم ج2 ص79.
([39])
راجع: السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص369 و 370 وعمدة القاري
ج13 ص306 والإصابة ج2 ص322 وفيه: أن هذا الحديث موجود في
الموطأ وأخرجه الشيخان في باب القسامة، وأسد الغابة ج3 ص179 و
180 والإكتفاء ج2 ص270 والمغازي للواقدي ج2 ص714 و 715 والسيرة
الحلبية ج3 ص57 و 58.
([40])
البداية والنهاية ج4 ص200 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي)
ص352 وفتح الباري ج5 ص240 وعمدة القاري ج13 ص305 والسيرة
النبوية لابن كثير ج3 ص379.
([41])
السيرة النبوية ج3 ص61.
([42])
سنن أبي داود ج3 ص158 والبداية والنهاية ج4 ص200 وأشار إليه في
فتح الباري ج5 ص241 عن أبي يعلى، والبغوي. والسيرة النبوية
لابن كثير ج3 ص380 وكنز العمال ج4 ص325 عن أبي داود، والبيهقي،
وأحمد وراجع: المصنف للصنعاني ج10 ص359.
([43])
المصنف للصنعاني ج4 ص125 وسيأتي الحديث بلفظ آخر بعد قليل تحت
حرف: ط.
([44])
الطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص283.
([45])
طبقات ابن سعد ج2 ص114 وفتح الباري ج5 ص240 وتاريخ المدينة ج1
ص188.
([46])
الأموال ص142 و 162 و 163.
([47])
فتح الباري ج5 ص240.
([48])
كنز العمال ج4 ص322 و 323 عن الأموال، وعن البيهقي، وابن أبي
شيبة وراجع هامش ص144 من كتاب الأموال.
([50])
راجع: كتاب الخراج، للقرشي ص23.
([51])
كنز العمال ج4 ص323 عن ابن جرير في التهذيب، وتقدم نحوه عن
المصنف للصنعاني ج4 ص125.
([52])
الأرف: جمع أرفة، وهي الحدود والمعالم. راجع: النهاية لابن
الأثير ج1 ص26.
([53])
كنز العمال: ج4 ص324 و 325 عن ابن سعد، والمغازي للواقدي: ج2
ص716 و 717 وفي السيرة الحلبية: ج3 ص57، كما في الواقدي.
([54])
راجع: المغازي للواقدي ج2 ص716 و 717.
([55])
السيرة الحلبية ج3 ص57.
([56])
السيرة الحلبية ج3 ص58 ووفاء الوفاء ج1 ص320.
([58])
المصدر السابق، والأموال ص142 و 143 و 144 ووفاء الوفاء ج1
ص320 و 321 وراجع مصادر الحديث ونصوصه في المصادر في الصفحات
المتقدمة.
([59])
وفاء الوفاء ج1 ص321.
([61])
وفاء الوفاء ج4 ص1160 و 1164.
([62])
راجع: وفاء الوفاء ج4 ص1160 و 1302 ومعجم البلدان ج3 ص211.
([63])
راجع: وفاء الوفاء ج4 ص1160 و 1233.
([64])
معجم البلدان ج3 ص211 ومراصد الاطلاع ج2 ص707.
([65])
وفاء الوفاء ج4 ص1184.
([66])
وفاء الوفاء ج4 ص1329.
([67])
وفاء الوفاء ج4 ص1328.
([68])
وفاء الوفاء ج4 ص1212 وراجع ص1328.
([69])
راجع: مراصد الإطلاع ج3 ص1417 ومعجم البلدان ج5 ص345.
([70])
صورة الأرض ص38 ومسالك الممالك ص19.
([71])
راجع كلامه بطوله في السيرة الحلبية ج3 ص58.
([73])
راجع: الجامع لأحكام القرآن ج3 ص280.
([74])
راجع: فتح القدير ج1 ص276 عن سعيد بن منصور، وعبد بن حميد،
وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن مجاهد، وعن الحسن،
والدر المنثور ج1 ص329 عنهم وعن ابن عقدة في غرائب شعبة
والنحاس في ناسخه وعبد بن حميد وسعيد بن منصور، وراجع: الجامع
لأحكام القرآن ج3 ص280 والسيرة الحلبية ج2 ص267 ولباب التأويل
ص185.
([75])
راجع: الجامع لأحكام القرآن ج3 ص280 ولباب التأويل ج1 ص186
ومدارك التنزيل بهامشه ج1 ص185 وفتح القدير ج1 ص276 عن ابن
إسحاق، وابن جرير عن ابن عباس، وكذا أخرج عبد بن حميد عن عبد
الله بن عبيدة نحوه، وكذا أخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير
وابن المنذر عن السدي نحوه والدر المنثور ج1 ص329 عنهم جميعاً
أيضاً.
([76])
راجع: فتح القدير ج5 ص199 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص49 والبدء
والتاريخ ج4 ص213 وتفسير الصافي ج5 ص153 والجامع لأحكام القرآن
ج18 ص2 والمغازي للواقدي ج1 ص380 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص232
والمصنف للصنعاني ج5 ص358 و 359 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص553
و 554 والتبيان ج9 ص557 وأحكام القرآن للجصاص ج3 ص428 وتاريخ
الإسلام للذهبي (المغازي) ص119 وحياة الصحابة ج1 ص398 ومدارك
التنزيل المطبوع بهامش لباب التأويل ج4 ص244 وجامع البيان ج28
ص19 و 20 و 22 والدر المنثور ج6 ص188 و 189 و 187 عن بعض من
تقدم وعن: ابن مردويه والبيهقي في الدلائل، وعبد بن حميد، وأبي
داود، وابن المنذر، والحاكم وصححه. وراجع شعر أمير المؤمنين
«عليه السلام» المذكور في الفصل الأول من هذا الباب وفي السيرة
النبوية لابن هشام ج3 ص208.
([77])
الثقات ج1 ص243 ومرآة الجنان ج1 ص9 والتنبيه والإشراف ص213
وسيرة مغلطاي ص53 والدر المنثور ج6 ص188 عن عبد بن حميد،
وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص233 والجامع لأحكام القرآن
ج18 ص2 وفيه: أن إجلاءهم إلى أذرعات ونجد، وقيل: إلى تيماء
وأريحا، كان على يد عمر.
([78])
التنبيه والإشراف ص213. وقد يظهر منه: أنه «صلى الله عليه
وآله» قد سمح لهم بالذهاب إلى فدك أيضاً، فاختاروا خيبراً.
([79])
الجامع لأحكام القرآن ج18 ص8.
([80])
تاريخ ابن الوردي ج1 ص159 وراجع: أحكام القرآن للجصاص ج3 ص428
وجوامع الجامع ص486 ومجمع البيان ج9 ص255 والبحار ج20 ص157 عنه
عن مجاهد، وقتادة والدر المنثور ج6 ص99 عن ابن المنذر، وابن
إسحاق، وأبي نعيم في الدلائل، والسيرة الحلبية ج2 ص267 وتفسير
القرآن العظيم ج4 ص330 و 333 ووفاء الوفاء ج1 ص297 والكامل في
التاريخ ج2 ص173 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 قسم 2 ص28
والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص201 وتاريخ الأمم والملوك ج2
ص554 والإكتفاء ج2 ص148 وجامع البيان ج28 ص19 وزاد المعاد ج2
ص110 وعمدة القارئ ج17 ص126 وفتح الباري ج7 ص254 ومنهاج السنة
ج4 ص173.
([81])
مناقب آل أبي طالب ج1 ص197.
([82])
السيرة النبوية لدحلان ج1 ص262.
([83])
راجع: غرائب القرآن مطبوع بهامش البيان ج28 ص33 والتفسير
الكبير ج29 ص278 والكشاف ج4 ص498 ص499 ومجمع البيان ج9 ص257
والبحار ج20 ص209 عنه وبهجة المحافل ج1 ص215 ولباب التأويل ج4
ص245.
([84])
تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص122.
([85])
تفسير القمي ج2 ص359 والبحار ج20 ص170 وتفسير الصافي ج5 ص154
وتفسير البرهان ج4 ص313.
([86])
الطبقات الكبرى ج2 ص58 والوفاء ص690 والبحار ج20 ص166 عن
الكازروني وغيره، والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص262 وزاد المعاد
ج2 ص72 ومغازي الواقدي ج1 ص377 والسيرة الحلبية ج2 ص268.
([87])
الطبقات الكبرى ج2 ص57 ومغازي الواقدي ج1 ص376 والسيرة الحلبية
ج2 ص267.
([88])
مغازي الواقدي ج1 ص375.
([89])
راجع: قاموس الرجال ج3 ص118 فما بعدها.
([90])
الآية 11 من سورة الحشر.
([91])
السيرة الحلبية: ج2 ص204.
([92])
مسند أبي عوانة: ج4 ص163.
([93])
مسند أبي عوانة ج4 ص164.
([94])
مجمع الزوائد: ج6 ص125.
([95])
الطبقات الكبرى ج2 ص258 وزاد المعاد ج2 ص72 ومغازي الواقدي ج1
ص375.
([96])
التنبيه والإشراف ص213 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص260 وفتح
القدير ج5 ص195 والجامع لأحكام القرآن ج18 ص2 وتفسير القمي ج1
ص168 والبحار ج20 ص166 و 168 وراجع المصادر الآتية في الهامش
التالي: وذكر في السيرة النبوية ج3 ص212 ذلك في شعر لعباس بن
مرداس. وأحكام القرآن لابن العربي ج4 ص1764 وعمدة القاري ج17
ص125.
([97])
تفسير البرهان ج1 ص472، وراجع: ص473 و 478 وتفسير القمي ج1
ص168 و 169 والبحار ج20 ص166 و 168 وتفسير نور الثقلين ج1 ص523
و524 وجامع البيان ج6 ص154 و 157 و 164 و 165 و 167 وغرائب
القرآن للنيسابوري بهامش جامع البيان ج6 ص145 وتفسير القرآن
العظيم ج1 ص60 والجامع لأحكام القرآن ج6 ص176 و 187 و 191
والتبيان ج3 ص521 وراجع: ص524 و 525 والتفسير الحديث ج11 ص107
ومجمع البيان ج3 ص194 وفتح القدير ج2 ص43 و 44 والتفسير الكبير
ج11 ص325 و 12 و 6 وعون المعبود ج12 ص136 ولباب التأويل ج1
ص468 وفي ظلال القرآن ج2 ص894 والدر المنثور ج2 ص381 و 283 و
284 و 285 و 278 و 288 عن أحمد، وأبي داود، وابن جرير، وابن
المنذر، والطبراني، وابن مردويه، وعبد بن حميد، وابن إسحاق،
وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والحاكم، وصححه، والبيهقي في
سننه.
([98])
السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص201 والبداية والنهاية ج4 ص76
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص148 وتاريخ الخميس ج1 ص462
والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص262 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص554
ومنهاج السنة ج4 ص173.
([99])
تاريخ الخميس ج1 ص462.
([100])
تاريخ ابن الوردي ج1 ص159.
([101])
المغازي للواقدي ج1 ص374 و375 والسيرة الحلبية ج2 ص267.
([102])
التنبيه والإشراف ص213.
([103])
نسب قريش لمصعب ص299.
([104])
نسب قريش ص301 وراجع: شرح النهج للمعتزلي الشافعي ج18 ص300 و
286.
([105])
راجع: شرح النهج للمعتزلي الشافعي ج18 ص287 و 290 و 293 و 294.
([106])
شرح النهج للمعتزلي الشافعي ج18 ص291.
([107])
نسب قريش ص300 وراجع: شرح النهج ج18 ص291.
([108])
راجع: شرح النهج للمعتزلي الشافعي ج18 ص285 و 309.
([109])
تاريخ الأمم والملوك ج3 ص280 وقاموس الرجال ج3 ص491 عنه.
([110])
شرح النهج للمعتزلي ج15 ص84.
([111])
نهج البلاغة بشرح عبده ج3 ص178 الحكمة رقم 120 وراجع مصادر نهج
البلاغة وأسانيده ج4 ص109.
([112])
تحف العقول ص356 والبحار ج75 ص269.
([113])
الآية 11 من سورة المائدة.
([114])
البدء والتاريخ ج4 ص212 وتاريخ الإسلام للذهبي ص221 والسيرة
النبوية لدحلان ج1 ص261 وفتح الباري ج7 ص255 والسيرة الحلبية
ج1 ص264.
([115])
البدء والتاريخ ج4 ص213 ودلائل النبوة لأبي نعيم ص422 و 424
وراجع: السيرة النبوية لدحلان ج1 ص261 والدر المنثور ج2 ص266
عن ابن إسحاق، وأبي نعيم في الدلائل، وابن المنذر، وابن جرير
وعبد بن حميد.
([116])
راجع: الدر المنثور ج2 ص265 و267 والسيرة الحلبية ج2 ص264.
([117])
السيرة الحلبية ج2 ص264.
([118])
راجع: الدر المنثور ج2 ص252 عن أحمد، وأبي عبيد في فضائله
والنحاس في ناسخه، والنسائي، وابن المنذر، والحاكم وصححه، وابن
مردويه والبيهقي في سننه، والترمذي وحسنه، وسعيد بن منصور،
وابن جرير.
([119])
الدر المنثور ج2 ص252، فإنهم قد صرحوا بتاريخ نزول سورة
المائدة، وصرح بأنها قد نزلت دفعة واحدة كل من: أحمد، وعبد بن
حميد، والطبراني، وابن جرير، ومحمد بن نصر في الصلاة، وأبي
نعيم في الدلائل، والبيهقي في شعب الإيمان.
([120])
الآية 2 من سورة الحشر.
([121])
مغازي الواقدي ج1 ص369.
([122])
ميزان الحكمة ج6 ص290 و 291.
([123])
ميزان الحكمة ج6 ص290 و 291.
([124])
ميزان الحكمة ج6 ص290 و 291.
([125])
ميزان الحكمة ج6 ص294.
([126])
الروض الأنف ج3 ص251. لكن بعض المصادر الأخرى قد ذكرت هذا
الحديث، ولم تذكر فيه عبارة: «لم يدرسه أحد قبله» فراجع: سير
أعلام النبلاء ج5 ص68 وتهذيب التهذيب ج9 ص421 والطبقات الكبرى
ج7 ص501.
([127])
الإستيعاب بهامش الإصابة ج1 ص49 وراجع ص50 وتهذيب الأسماء ج1
ص109 وأسد الغابة ج1 ص49 وتهذيب التهذيب ج1 ص188 وراجع:
الإيضـاح لابن شـاذان ص323 و 330 و 231 وفي هـامشـه عن طائفـة
مـن = = المصادر، والجامع الصحيح ج5 ص664 و 665 والجامع لأحكام
القرآن ج1 ص82 ومشكل الآثار ج1 ص350 و 351 وصحيح البخاري ج3
ص147 ومستدرك الحاكم ج3 ص305 وج2 ص224 وتلخيص مستدرك الحاكم
للذهبي بهامشه، والطبقات الكبرى ج2 ص339 ومسند أحمد ج5 ص131
وحلية الأولياء ج1 ص251، وج4 ص187 ومجمع الزوائد ج9 ص312 والدر
المنثور ج6 ص378 والبداية والنهاية ج7 ص340.
([128])
راجع: كشف الأستار ج3 ص250 و 249 ومستدرك الحاكم ج3 ص318
وتلخيص المستدرك للذهبي بهامشه، والإيضاح ص223 و 232 ومجمع
الزوائد ج9 ص287 و 288 عن أحمد، وأبي يعلى، والبزار،
والطبراني، وصفة الصفوة ج1 ص399 والنهاية في اللغة ج3 ص371
ومسند أحمد ج1 ص445 والجامع لأحكام القرآن ج1 ص82 وتذكرة
الحفاظ ج1 ص14 وتفسير القرآن العظيم ج4 (الذيل) ص28 والإصابة
ج2 ص369 والإستيعاب بهامشه ج2 ص320.
([129])
راجع: تذكرة الحفاظ ج1 ص16 ومناقب آل أبي طالب ج2 ص42 والغدير
ج6 ص308 عن: طبقات القراء ج1 ص546 وعن مفتاح السعادة ج1 ص351.
راجع: كشف الأستار ج3 ص250 و 249 ومستدرك الحاكم ج3 ص318
وتلخيص المستدرك للذهبي بهامشه، والإيضاح ص223 و 232 ومجمع
الزوائد ج9 ص287 و 288 عن أحمد، وأبي يعلى، والبزار،
والطبراني، وصفة الصفوة ج1 ص399 والنهاية في اللغة ج3 ص371
ومسند أحمد ج1 ص445 والجامع لأحكام القرآن ج1 ص82 وتذكرة
الحفاظ ج1 ص14 وتفسير القرآن العظيم ج4 (الذيل) ص28 والإصابة
ج2 ص369 والإستيعاب بهامشه ج2 ص320.
([130])
التراتيب الإدارية ج2 ص183، وتفسير البرهان ص16 عن بشارة
المصطفى.
([131])
الإصابة ج2 ص321 والإستيعاب بهامشه ج2 ص383 والدر المنثور ج4
ص69 عن: ابن مردويه، وابن جرير، وابن أبي شيبة، وابن سعد، وابن
المنذر.
([132])
راجع: شواهد التنزيل ج1 ص310 وراجع ص308 و 307 وراجع: مناقب
الإمام علي «عليه السلام» لابن المغازلي ودلائل الصدق ج2 ص135
ونقل عن: العمدة لابن البطريق ص61 وعن غاية المرام ص357 و 360
و 104 عن تفسير الثعلبي، والحبري «مخطوط» وعن الخصائص ص26.
([133])
تقدم ذلك في هذا الكتاب فراجع.
([134])
الجامع للقيرواني ص279 وتاريخ الخميس ج1 ص464 عن شرح صحيح مسلم
للنووي، وعن أسد الغابة.
([135])
تاريخ اليعقوبي ج2 ص49 وراجع: تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي)
ص198 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص200 والجامع لأحكام القرآن
ج18 ص7 وزاد المعاد ج2 ص110 ومنهاج السنة ج4 ص173.
([136])
تاريخ ابن الوردي ج1 ص159 وراجع: أيضاً التنبيه والإشراف ص213.
([137])
تاريخ المدينة لابن شبة ج1 ص69 ووفاء الوفاء ج3 ص821 عنه وعن
ابن زبالة ومرآة الحرمين ج1 ص418.
([138])
البحار ج63 ص387 و 388 وج76 ص132 و 131 ط مؤسسة الوفاء.
([139])
مسند أبي يعلى ج10 ص101 ومسند أحمد ج2 ص106 ومجمع الزوائد ج4
ص12 وج2 ص21.
([140])
راجع: تفسير القرآن العظيم ج1 ص93 عن أبي يعلى، وعن أحمد في
عدة مواضع.
([141])
وفاء الوفاء ج3 ص821 ومرآة الحرمين ج1 ص418.
([142])
مسند أحمد ج2 ص106 ووفاء الوفاء ج3 ص822 عنه، وعن أبي يعلى.
([143])
راجع الكافي ج6 ص395 والوسائل ج17 ص237 باب تحريم شرب الخمر،
والتهذيب ج9 ص102 وراجع: التنقيح الرائع ج1 ص15 وراجع أيضاً:
مفتاح الكرامة ج4 ص2.