أراضي بني النضير والكيد السياسي
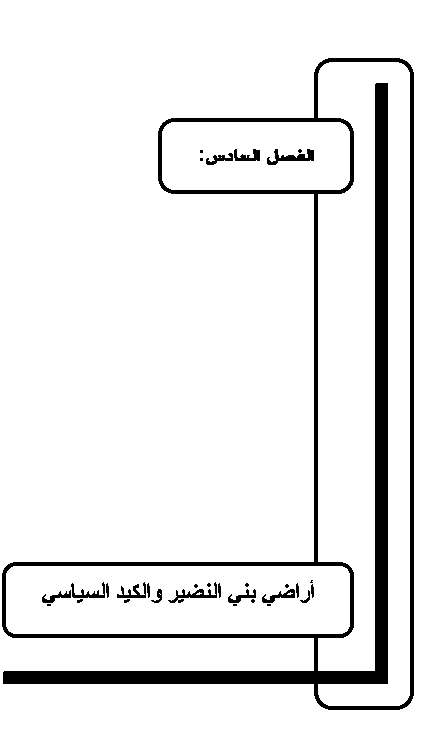
الغاصبون:
وتذكر المصادر:
أن السلطة قد استولت على باقي أموال بني النضير، التي احتفظ بها
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولم يقسمها بين أصحابه، وقد طالب
بها أهل البيت «عليهم
السلام»
فمنعوا منها ثم إن عمر بن الخطاب قد ردها إليهم، بعد سنين من توليه
الحكم.
ولكن حكاية مطالبة أهل بيت النبوة «عليهم
السلام»
للخليفة الثاني بإرجاعها إليهم،
قد تعرضت للدس والتشويه بصورة بشعة ومخجلة.
ونحن نذكر نص الرواية هنا أولاً، ثم نشير إلى بعض وجوه التشويه
فيها، وإن كانت واضحة وظاهرة لكل
أحد.
يقول النص التاريخي، وهو الذي ذكره مسلم بن الحجاج في صحيحه:
«حدثني
عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية: عن مالك، عن
الزهري: أن مالك بن أوس حدثه قال: أرسل إليَّ
عمر بن الخطاب؛ فجئته حين تعالى النهار، قال: فوجدته في بيته جالساً
على سرير، مفضياً
إلى رماله، متكئاً
على وسادة من أدم، فقال لي: يا مالك، إنه قد دف أهل أبيات من قومك،
وقد أمرت فيهم برضخٍ فَخُذْه فاقسمه بينهم.
قال:
قلت: لو أمرت بهذا غيري.
قال:
خذه يا مالك.
قال:
فجاء يرفأ، فقال: هل لك ـ يا أمير المؤمنين ـ في عثمان وعبد الرحمن
بن عوف، والزبير، وسعد؟
فقال عمر:
نعم، فأذن لهم؛ فدخلوا.
ثم جاء فقال:
هل لك في عباس، وعلي؟
قال:
نعم،
فأذن لهما.
فقال عباس:
يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم، الغادر الخائن!
فقال القوم:
أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهم وأرحهم.
(فقال مالك بن أوس: يخيل إلي: أنهم قد كانوا قدموهم لذلك).
فقال عمر:
اتّئدا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون: أن
رسول الله «صلى الله عليه وآلـه»
قـال:
لا نـورث،
مـا
تركنـا
صدقة؟
قالوا:
نعم،
ثم أقبل على العباس، وعلي، فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم
السماء والأرض، أتعلمون: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال:
لا نورث، ما تركناه صدقة؟
قالا:
نعم.
فقال عمر:
إن الله جل وعز كان خص رسوله «صلى الله عليه وآله» بخاصة لم يخصص
بها أحداً غيره، قال:
﴿مَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ
أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ..﴾([1])
(ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا)، قال: فقسم رسول الله
«صلى الله عليه وآله» بينكم أموال بني النضير فوالله، ما استأثر
عليكم، ولا أخذها دونكم، حتى بقي هذا المال؛ فكان رسول الله «صلى
الله عليه وآله» يأخذ منه نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي أسوة المال.
ثم قال:
أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟
قالوا:
نعم. ثم نشد عباساً
وعلياً
بمثل ما نشد به القوم: أتعلمان ذلك؟
قالا:
نعم.
قال:
فلما توفي رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال أبو بكر: أنا ولي
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك،
ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسول الله
«صلى الله عليه وآله»: ما نورث ما تركنا صدقة؛ فرأيتماه كاذباً
آثماً،
غادراً،
خائناً،
والله يعلم: إنه لصادق بار، راشد، تابع للحق.
ثم توفي أبو بكر، وأنا ولي رسول الله «صلى الله عليه وآله» وولي
أبي بكر، فرأيتماني كاذباً،
آثماً،
غادراً،
خائناً،
والله يعلم: إني لصادق بار، راشد، تابع للحق، فوليتها، ثم جئتني
أنت وهذا، وأنتما جميع، وأمركما واحد، فقلتما: ادفعها إلينا.
فقلت:
إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله: أن تعملا فيها
بالذي كان يعمل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأخذتماها بذلك.
قال:
أكذلك؟!
قالا:
نعم.
قال:
ثم جئتماني لأقضي بينكما؛ فوالله، لا أقضي بينكما بغير ذلك، حتى
تقوم الساعة؛ فإن عجزتما عنها؛ فرداها إلي([2]).
زاد في نص آخر قوله:
فغلب علي عباساً
عليها، منعه إياها، فكانت بيد علي، ثم كانت بيد الحسن، ثم كانت بيد
الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم الحسن بن الحسن، ثم زيد بن الحسن.
زاد في نص آخر:
ثم عبد الله بن الحسن بن الحسن([3]).
قال الزهري:
حدثني مالك بن أوس بن الحدثان بنحوه، قال: فذكرت ذلك لعروة، فقال:
صدق مالك بن أوس، أنا سمعت عائشة تقول: أرسل أزواج النبي «صلى الله
عليه وآله» عثمان بن عفان إلى أبي بكر، يسأل لهن ميراثهن من رسول
الله «صلى الله عليه وآله» مما أفاء الله عليه، حتى كنت أردهن عن
ذلك.
فقلت:
ألا تتقين الله، ألم تعلمن: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان
يقول:
«لا
نورث ما تركناه صدقة ـ يريد بذلك نفسه ـ إنما يأكل آل محمد من هذا
المال».
فانتهى أزواج النبي «صلى الله عليه وآله» إلى ما أمرتهن به([4]).
قال ابن كثير:
«ثم
إن علياً والعباس استمرا على ما كانا عليه، ينظران فيها جميعاً إلى
زمان عثمان بن عفان؛ فغلبه عليها علي، وتركها له العباس؛ بإشارة
ابنه عبد الله (رض) بين يدي عثمان ـ كما رواه أحمد في مسنده ـ
فاستمرت في أيدي العلويين»([5]).
ونقول:
إننا وإن كنا لا نستبعد أن يكون علي «عليه السلام» والعباس «رحمه
الله» قد طالبا عمر بن الخطاب بأراضي بني النضير، ولكننا نرى: أن
حكاية هذه القضية بالشكل الآنف الذكر، لا ريب في كونها مكذوبة
ومصنوعة، بهدف تبرئة ساحة الهيئة الحاكمة فيما
أقدمت عليه من مصادرة أموال رسول الله «صلى الله عليه وآله» فور
وفاته، وحرمان ابنته «عليها
السلام» من إرثه.
ولكن مخترعها، أو فقل الذي حرفها، وصاغها بهذا الشكل، لم يكن ذكياً
بالقدر الكافي، ولا له معرفة تؤهله للاحتراس من المؤاخذات الظاهرة
والواضحة؛ تاريخية كانت، أو تفسيرية، أو شرعية، أو غيرها كما سنرى.
والأبدع من ذلك!!:
أننا نجد الرواية قد ذكرت في كتب الصحاح، التي هي أصح الكتب ـ عند
أصحابها ـ بعد القرآن.. فكيف خفي أمرها على مؤلفي هذه الكتب، وهم
الأئمة الكبار والعارفون، والضليعون في فنِّهم،
حسبما يصفهم به أتباعهم ومحبوهم، والآخذون عنهم؟
وقبل أن نشير إلى نقاط الضعف التي في هذه الرواية نذكر القارئ
الكريم بأن ما سوف نذكره من نقاط ـ وإن كان أكثره قد خطر في بالنا
ـ ولكنه أيضاً مما قد تنبه له الآخرون، ولذا فإننا سوف نشير إلى
هؤلاء الذين سبقونا إلى ذلك، ناسبين الكلام إليهم، بل ومعتمدين في
أحيان كثيرة في صياغة العبارة عليهم.. فنقول:
وبعد.. فإنه يرد على الرواية المتقدمة:
أولاً:
أن
رواية مسلم تذكر:
أن العباس، قال لعمر: «اقض بيني وبين هذا الآثم الغادر الخائن».
وهذا مما لا يتصور صدوره من العباس؛ إذ كيف ينسب هذه الأوصاف إلى
من اعتبرته آيه المباهلة نفس النبي الأمين «صلى الله عليه وآله»،
ولمن شهد الله سبحانه له بالطهارة،
وكيف يسبه، وقد علم أن من سبه سب الله ورسوله؟
فلا بد أن يكون هذا القول مكذوباً
على العباس من المنافقين الذين يريدون سب الإمام الحق، على لسان
غيرهم([6]).
ونشير هنا إلى ما يلي:
ألف:
«استصوب
المازري صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث وقال: لعل بعض
الرواة وهم فيها»([7]).
فالمازري إذاً يؤيد ويستصوب تحريف النصوص، وذلك من أجل الحفاظ على
ماء الوجه،
أمام
الحقائق التاريخية الدامغة؛ فإنهم حينما رأوا: أن كذبها صريح إلى
درجة الفضيحة، ورأوا: أنها موجودة في صحاحهم، وتلك فضيحة أخرى أدهى
وأمر ـ نعم حينما رأوا ذلك ـ التجأوا إلى هذا الأسلوب الساقط
والرذل، ألا وهو التحريف والإسقاط، كما اعترف به المازري
واستصوبه..
وهذا الأسلوب لا يزال متبعاً
عند خلف هؤلاء القوم، فنجد الوهابيين يحرفون كتب علمائهم، وغيرها،
وكذلك غيرهم من أولئك الذين يخونون دينهم وأمتهم، بخيانتهم
أماناتهم([8]).
ب:
قال العسقلاني: إن المازري قال:
«أجود
ما تحمل عليه: أن العباس قالها دلالاً
على علي؛ لأنه كان عنده بمنزلة الولد؛ فأراد ردعه عما يعتقد أنه
مخطئ فيه،
وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن عمد.
قال:
ولا بد من هذا التأويل، لوقوع ذلك بمحضر الخليفة، ومن ذكر معه، ولم
يصدر منهم إنكار لذلك، مع ما علم من تشددهم في إنكار المنكر»([9]).
ونقول للمازري:
مرحباً
وأهلاً
بهذا الدلال الوقح والمشين! فهل كل من كان بمنزلة الوالد يحق له أن
يسب الناس، ويتهمهم بالغدر، والخيانة، والإثم؟!.
وأيضاً.. فإن رواية
البخاري تقول:
إنهما قد استبا([10])،
فهل سب علي «عليه السلام» للعباس كان دلالاً
أيضاً؟ وهل كان علي بمنزلة الوالد بالنسبة للعباس؟!.
وهل كان هذا الدلال مما جرت عليه عادة العرب؟!.
وهل يصح الردع عن الخطأ بهذا الأسلوب الفاحش والبذيء؟!.
ثم إننا لم نعلم ما الذي فعله علي «عليه السلام» بأرض بني النضير
حتى استحق الوصف بالغدر والخيانة؟!
فهل فعل فيها غير ما كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يفعله؟!
ولو أنه تعدى في فعله، فهل يكون غادراً،
وخائناً؟!
ولمن يا ترى؟! وهل يمكن أن يظن العباس بعلي أو العكس: أنه يرتكب
الخطأ الفاحش الذي هو على حد الخيانة والغدر عن عمد وقصد؟!.
أسئلة ننتظر الجواب عنها بصورة منصفة ومقنعة، وهيهات.
وثانياً:
قال العلامة المظفر:
«إنه يصرح بأن عمر ناشد القوم ومن جملتهم عثمان؛ فشهدوا بأن رسول
الله «صلى الله عليه وآله» قال: لا نورث.
وهو مناف لما رواه
البخاري([11])
عن عائشة،
أنها قالت:
أرسل أزواج النبي «صلى الله عليه وآله» عثمان إلى أبي بكر، يسألنه
ثمنهن مما أفاء الله على رسوله، فكنت أنا أردهن، الحديث.. فإنه
يقتضي أن يكون عثمان جاهلاً
بذلك، وإلا لامتنع أن يكون رسولاً
لهن، إلا أن يظن القوم فيه السوء».
وهذا أيضاً قد أورده المعتزلي الحنفي([12]).
وقد حـاول المعتزلي
الاعتذار عن ذلك، فقـال:
«اللهم
إلا أن يكـون
عثمان وسعد، وعبد الرحمن، والزبير، صدقوا عمر على سبيل التقليد
لأبي بكر فيما رواه، وحسن الظن. وسموا ذلك علماً
لأنه قد يطلق على الظن اسم العلم».
ثم ذكر:
أنه يجوز أن يكون عثمان في مبدأ الأمر شاكاً
في رواية أبي بكر، ثم يغلب على ظنه صدقه لأمارات
اقتضت تصديقه. وكل الناس يقع لهم مثل ذلك([13]).
ونقول:
ألف:
إن نفس المعتزلي يقول: إن أكثر الروايات: أنه لم يرو خبر
«لا
نورث»
غير أبي بكر، ذكر ذلك أعظم المحدثين([14]).
فمن أين جاءت هذه الإمارات على الصدق. لا سيما مع تكذيب فاطمة له،
وهي المطهرة بنص الكتاب العزيز، وكذلك مع إنكار علي والعباس،
وغيرهما من خيار الأصحاب وأكابرهم؟!
ولو كان لديهم أدنى احتمال بصدق الحديث ـ ولو بأن يحتملوا أن يكون
«صلى الله عليه وآله» قد أسر به إلى أبي بكر ـ لما بادروا إلى
إنكاره، واستمروا على ذلك، حتى لقد توفيت الصديقة الزهراء «عليها
السلام» مهاجرة له لأجل ذلك.
إن المعتزلي وغيره ـ والحالة هذه ـ حين يصدقون حديث لا نورث، فإنهم
يكونون قد طعنوا بالقرآن الذي نزه الزهراء، وعلياً، وأهل البيت
عليهم صلوات ربي وسلامه..
ب:
إن ما ذكر، يبقى مجرد احتمال. ويبقى احتمال أن يكون قد جارى عمر،
وشهد بما لا يعلم، قائماً
وقوياً،
بعد أن كانت السلطة، التي كان عثمان أحد مؤيديها ومعاضديها، تتجه
نحو تثبيت دعوى أبي بكر، وزعزعة موقف آل رسول الله «صلى الله عليه
وآله».
ثالثاً:
قال العلامة الشيخ محمد حسن المظفر «رحمه
الله»:
«لو كان الذين ناشدهم عمر عالمين بما رواه أبو بكر لما تفرد أبو
بكر بروايته عند منازعته فاطمة «عليها السلام». فهل تراهم ذخروا
شهادتهم لعمر، وأخفوها عن أبي بكر، وهو إليها أحوج»؟!([15]).
وحول تفرد أبي بكر برواية الحديث، قال ابن أبي الحديد المعتزلي
الشافعي:
«..إن
أكثر الروايات: أنه لم يرو هذا الخبر إلا أبو بكر وحده، ذكر ذلك
أعظم المحدثين. حتى إن الفقهاء في أصول الفقه أطبقوا على ذلك في
احتجاجهم في الخبر برواية الصحابي الواحد.
وقال شيخنا أبو علي:
لا تقبل في الرواية إلا رواية اثنين كالشهادة. فخالفه المتكلمون
والفقهاء كلهم، واحتجوا عليه بقبول الصحابة رواية أبي بكر وحده:
نحن معاشر الأنبياء لا نورث الخ..»([16]).
رابعاً:
قال العسقلاني ـ وذكر ذلك غيره أيضاً ـ: «وفي ذلك إشكال شديد، وهو:
أن أصل القصة صريح في أن العباس وعلياً «عليه
السلام»،
قد علما: أنه «صلى الله عليه وآله» قال: لا نورث؛ فإن كانا سمعاه
من النبي «صلى الله عليه وآله» فكيف يطلبانه من أبي بكر؟!([17])
وإن كان إنما سمعاه من أبي بكر، أو في زمنه؛ بحيث أفادهما العلم
بذلك، فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر»؟!([18]).
وقال العيني:
«..هذه
القصة مشكلة؛ فإنهما أخذاها من عمر (رض) على الشريطة،
واعترفا بأنه «صلى الله عليه وآله» قال: ما تركناه صدقة؛ فما الذي
بدا لهما بعد ذلك حتى تخاصما»؟!([19]).
وبعد أن ذكر العلامة المظفر «رحمه الله» تعالى،
ما يقرب مما ذكره العسقـلاني،
وأن صريح أحاديـث
البخـاري:
أن العبـاس،
وعلياً
«عليه السلام» قد طلبا الميراث من عمر، مع علمهما بأنه «صلى الله
عليه وآله» قال: لا نورث.. قال:
«..وهو
من الكذب الفظيع؛ لمنافاته لدينهما وشأنهما، وكونه من طلب المستحيل
عادة؛ لأن أبا بكر قد حسم أمره، وكان أكبر أعوانه عليه عمر، فكيف
يطلبان منه الميراث؟!
ومع ذلك، فكيف دفع لهما عمر مال بني النضير؛ ليعملا به عمله، وعمل
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأبي بكر؟. وهما قد جاءاه يطلبان
الميراث، مخالفين لعلمهما، غير مبالين بحكم الله ورسوله، حاشاهما؛
فيكون قدحاً
في عمر»([20]).
واحتمال:
أن يظنا بأن عمر لسوف ينقض قضاء أبي بكر..
قد دفعه المعتزلي
بقوله:
«وهذا
بعيد؛ لأن علياً والعباس ـ في هذه المسألة ـ يتهمان عمر بممالأة
أبي بكر على ذلك، ألا تراه يقول: نسبتماني ونسبتما أبا بكر إلى
الظلم والخيانة؟.
فكيف يظنان:
أنه ينقض قضاء أبي بكر، ويورثهما»؟!([21]).
وأجابوا عن ذلك كله بجوابين:
الأول:
«كأن
المراد: تسألني التصرف فيما كان نصيبك، لو كان هناك إرث»([22]).
وعلى حد تعبير ابن
كثير:
«..كأن
الذي سألوه، بعد تفويض النظر إليهما ـ والله أعلم ـ:
هو أن يقسم بينهما النظر، فيجعل لكل واحد منهما نظر ما يستحقه
بالأرض، لو قدر أنه كان وارثاً..
إلى أن قال:
وكان قد وقع بينهما خصومة شديدة؛ بسبب إشاعة النظر بينهما.
إلى أن قال:
فكأن عمر تحرج من قسمة النظر بينهما بما يشبه قسمة الميراث، ولو في
الصورة الظاهرة، محافظة على امتثال قوله: لا نورث، ما تركناه صدقة».
زاد العيني قوله:
«فمنعهما
عمر القسم؛ لئلا يجري عليها اسم الملك؛ لأن القسم يقع في الأملاك،
ويتطاول الزمان؛ فيظن به الملكية»([23]).
أما الهيثمي،
فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، حين قال:
«إستباب
علي والعباس صريح في أنهما متفقان على أنها غير إرث، وإلا.. لكان
للعباس سهم، ولعلي سهم زوجته،
ولم يكن للخصام بينهما وجه؛ فخصامهما إنما هو لأجل كونها صدقة، وكل
منهما يريد أن يتولاها؛ فأصلح بينهما عمر (رض)، وأعطاها لهما الخ..»([24]).
وقال إسماعيل
القاضي:
إنما تنازعا ـ يعني عند عمر ـ في ولاية الصدقة، وفي صرفها كيف تصرف([25]).
الثاني:
ما أجاب به العسقلاني بقوله:
«إن
كلاً من علي وفاطمة والعباس اعتقد: أن عموم قوله لا نورث، مخصوص
ببعض ما يخلفه دون بعض، ولذلك نسب عمر إلى علي والعباس: أنهما كانا
يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك»([26]).
ونقول:
إن ذلك لا يصح، أما بالنسبة لما عدا الجواب الأخير، فلما يلي:
ألف:
إننا نقول: لو صح ما ذكروه لكان عمر اقتصر على ذكر هذا المعنى ولم
يكن بحاجة إلى المناشدة المذكورة، والاستدلال على عدم كونها إرثاً
بحديث لا نورث.
ب:
قال العسقلاني:
«لكن
في رواية النسائي، وعمر بن شبة([27])،
من طريق أبي البخترى، ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على
سبيل الميراث، ولفظه في آخره: ثم جئتماني الآن تختصمان يقول هذا:
أريد نصيبي من ابن أخي، ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتي، والله،
لا أقضي بينكما إلا بذلك، أي إلا بما تقدم من تسليمها لهما على
سبيل الولاية. وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن خالد، عن
مالك بن أوس نحوه».
ثم ذكر دعوى أبي
داود:
أنهما أرادا من عمر أن يقسمها بينهما للانفراد بالنظر فيما
يتوليان، وأن أكثر الشراح اقتصروا عليه واستحسنوه ثم تنظر فيه بما
تقدم.
ثم إنه بعد ذلك تعجب من ابن الجوزي ومن الشيخ محيي الدين، لجزمهما
بأن علياً والعباس لم يطلبا إلا قسمة النظر والولاية.. مع أن
السياق صريح في أنهما جاءاه مرتين في طلب شيء واحد، ثم اعتذر
بأنهما شرحا اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في البخاري([28]).
ج:
إن العم لا يرث مع وجود البنت لبطلان التعصيب، كما سيأتي.
د:
قول ابن كثير: إنه كان قد وقع بين علي والعباس خصومة شديدة، بسبب
إشاعة النظر بينهما محض رجم بالغيب، إذ ليس في الرواية ما يدل على
أن سبب الخصومة هو ذلك، ولا حدثنا التاريخ بشيء عن السبب المذكور.
بل الأمر على العكس كما تقدم عن العسقلاني.
هـ:
لم نفهم معنى لهذا التحرج المدعى من قبل عمر، فإنه إذا كان
الأنبياء لا يورثون، فإن قسمة النظر بينهما لا تخالف حديث لا نورث
ـ إن صح ـ لا في الظاهر ولا في الباطن، وإذا كان حديث لا نورث
باطلاً،
وكانوا يورثون، فمخالفة الحديث لا ضير فيها ولا حرج.
و:
لم نفهم لماذا لا تصح القسمة إلا في الأملاك ـ كما ذكره العيني ـ
وكيف غفل علي والعباس عن ذلك، وكيف لم يقل لهما عمر، ولا أحد ممن
حضر الخصومة: إن القسمة لا تقع في الأملاك؟!.
ز:
لم نفهم كيف أصبح استباب علي والعباس دليلاً
على كون أرض بني النضير ليست إرثاً؟
أليس الإرث يحتاج إلى القسمة، وقد يقع الخلاف في هذا القسم أو
ذاك؟! فلعل أحدهما يريد هذه القطعة، وذاك يريدها أيضاً، فيقع
الخصام، ويحتاج إلى الفصل بينهما، وإراحة كل منهما من الآخر.
وأما بالنسبة لجواب العسقلاني، فإننا نقول:
ألف:
قد صرح المعتزلي الشافعي:
بأن خبر أبي بكر يمنع من الإرث مطلقاً، قليلاً
كان أو كثيراً، ولا سيما مع إضافة كلمة:
«ما
تركناه صدقة».
وأضاف:
«
فإن قال قائل: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهباً،
ولا فضة، ولا أرضاً،
ولا عقاراً،
ولا داراً..
قيل:
هذا الكلام يفهم من مضمونه: أنهم لا يورثون شيئاً أصلاً،
لأن عادة العرب جارية بمثل ذلك. وليس يقصدون نفي ميراث هذه الأجناس
المعدودة دون غيرها، بل يجعلون ذلك كالتصريح بنفي أن يورثوا شيئاً
ما على الإطلاق»([29]).
وإن كان لنا تحفظ
على إضافته المذكورة، فإن ظاهر قوله:
نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهباً
ولا فضة
الخ..
أنهم ما جاؤوا لأجل جمع حطام الدنيا لأنفسهم، وليورثوه أبناءهم،
وإنما هم زهاد تاركون للدنيا، ولا يجمعون ذهباً
ولا فضة ليقع في ميراثهم لمن بعدهم.
ب:
قول العسقلاني: إن اعتقاد علي والعباس ظلم من خالفهما يدل على
اعتقادهما باختصاص حديث لا نورث ببعض الأموال دون بعض.. لا يصح، إذ
كما يمكن أن يكون ذلك لأجل اعتقادهما بما ذكر، كذلك يمكن أن يكون
لأجل اعتقادهما بعدم صحة أصل الحديث، وأنه مجعول ومختلق.
وهذا الثاني هو الصحيح؛ لإنكار علي
«عليه
السلام»،
وفاطمة «عليها السلام»، والعباس «رحمه الله» هذا الحديث من الأساس،
ومطالبتهم بتركة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، كما هو ظاهر لا
يخفى.
خامساً:
إن العم لا يرث مع وجود البنت، كما هو الحق الذي لا محيص عنه،
وإنما ترث البنت الواحدة نصف التركة بالفرض، والنصف الباقي بالرد
عليها، والتعصيب يعني توريث العصبة النصف ـ كالعم ـ مع البنت، باطل
ولا يصح، وقد استدل العلماء على بطلانه بما لا مزيد عليه؛ فليراجع
في مظانه([30]).
ويبدو:
أن توريث العم ـ مع البنت الذي هو من التعصيب الباطل ـ قد نشأ عن
إرادة تقوية موقف أبي بكر، وإضعاف موقف فاطمة وعلي
«عليهما
الصلاة والسلام».
ويرد هنا سؤال، وهو:
أنه إذا كان العباس لا يرث؛ فلماذا شارك في المطالبة بإرث النبي
«صلى الله عليه وآله» من أبي بكر، ثم من عمر؟!.
وأجاب السيد ابن
طاووس:
بأن هذه المطالبة، بل وحتى إظهار الخصومة مع علي في ذلك عند عمر،
قد كان لأجل مساعدة علي وفاطمة «عليهما السلام»، وقطع حجة أبي بكر،
وإقامة الحجة على عمر في ذلك. ثم ذكر ابن طاووس هنا قصة الجارية
التي قالت للرشيد العباسي: إن علياً «عليه
السلام»
والعباس كانا في هذه القضية كالملكين، اللذين تحاكما إلى داود في
الغنم، حيث أرادا تعريفه وجه الحكم؛ فكذلك أراد علي والعباس تعريف
أبي بكر وعمر: أنهما ظالمان لهما بمنع ميراث نبيهما([31]).
وقد يجاب عن ذلك:
بأن العباس كان يظن في ظاهر الحال أنه يرث النبي «صلى الله عليه
وآله» لعمومته له، وكان علي «عليه السلام» يرفض ذلك، على اعتبار أن
العم لا يرث، فترافعا إلى عمر على هذا النحو ليقيما الحجة عليه.
سادساً:
قال الشيخ المظفر «رحمه الله»:
«إن أمير المؤمنين لو سمع ذلك؛ أي حديث: لا نورث الخ.. فلم ترك
بضعة الرسول أن تطالب بما لا حق لها فيه؟! أأخفى ذلك عنها راضياً
بأن تغصب مال المسلمين؟! أو أعلمها فلم تبال؟! وعدت على ما ليس لها
فيه حق! فيكون الكتاب كاذباً،
أو غالطاً
بشهادته لهما بالطهارة، فلا مندوحة لمن صدق الله، وكتابه، ورسوله
«صلى الله عليه وآله» أن يقول بكذب هذه الأحاديث»([32]).
وقال المعتزلي:
«..وهل
يجوز أن يقال: إن علياً كان يعلم ذلك، ويمكّن زوجته أن تطلب ما لا
تستحقه؟! خرجت من دارها، ونازعت أبا بكر، وكلمته بما كلمته إلا
بقوله، وإذنه ورأيه»!([33]).
سابعاً:
قال المظفر والمعتزلي: «إن أمير المؤمنين «عليه
السلام»
والعباس، لو كانا سمعا من النبي «صلى الله عليه وآله» ما رواه أبو
بكر، حتى أقرا به لعمر؛ فكيف يقول لهما عمر: ـ كما في حديث مسلم ـ:
رأيتما أبا بكر كاذباً،
آثماً، غادراً، خائناً،
ورأيتماني آثماً،
غادراً،
خائناً»([34]).
ثامناً:
قال العلامة الحلي ما حاصله:
إن عمر بن الخطاب قد أخبر: أن علياً
والعباس يعتقدان فيه وفي أبي بكر بأنهما: كاذبان آثمان غادران
خائنان، فإن كان ذلك حقاً،
فهما لا يصلحان للخلافة، وإن كان كذباً،
لزمه تطرق الذم إلى علي والعباس، لاعتقادهما في أبي بكر، وعمر ما
ليس فيهما؛ فكيف استصلحوا علياً «عليه
السلام»
للخلافة؟ مع أن الله قد نزهه عن الكذب والزور وطهره.
وإن كان عمر قد نسب إلى العباس وعلي «عليه
السلام»
شيئاً لا يعلمانه، لزمه تطرق الذم إلى عمر نفسه، لأنه يفتري
عليهما، وينسب إليهما ما لا يعتقدانه.
مع أن البخاري
ومسلماً ذكرا في صحيحيهما:
أن قول عمر هذا لعلي والعباس، قد كان بمحضر مالك بن أوس، وعثمان
وعبد الرحمن بن عوف، والزبير وسعد. ولم يعتذر أمير المؤمنين عن هذا
الاعتقاد الذي نسب إليهما، ولا أحد من الحاضرين اعتذر لأبي بكر
وعمر([35]).
وأجاب البعض عن ذلك:
بأنه قد جاء على لسان عمر على سبيل الفرض والتقدير، والزعم؛ فإن
الحاكم إذا حكم بخلاف ما يرضي الخصم، يقول له: تحسبني ظالماً
ولست كذلك، ولذلك لم يعتذر علي «عليه
السلام»
ولا العباس ولا غيرهما ممن حضر([36]).
ورد عليه العلامة
المظفر «رحمه الله»:
بأن هذا مضحك، إذ كيف لا يكون على سبيل الحقيقة، وهما إنما
يتنازعان عند عمر في ميراث النبي «صلى الله عليه وآله» بعد سبق
رواية أبي بكر وحكمه؟ فإن هذا النزاع بينهما لا يتم إلا بتكذيبهما
لأبي بكر في حديثه، وحكمهما عليه بأنه آثم غادر خائن على وجه
يعلمان: أن عمر عالم بكذب حديث أبي بكر، وأن موافقته له في السابق
كان لسياسة دعته إلى الموافقة، ولو لم يكونا عالمين بأن عمر عالم
بكذب حديث أبي بكر، لم يصح ترافعهما إلى عمر من جديد([37]).
تاسعاً:
إن من المعلوم:
أن الحكام بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد دفعوا الحجر إلى
زوجاته «صلى الله عليه وآله»([38]).
كما أن خلفاء بني العباس قد تداولوا البردة والقضيب([39]).
وقد قال ابن المعتز مخاطباً
العلويين:
ونـحـن ورثـنـا ثيـاب الـنـبــي
فـلـم تـجـذبــون بــأهــدابهـــا
لـكـم رحـم يـا بـنـي بــنــتــه ولـكـن بنـو الـعــم أولى بهـــا([40])
فأجابه الصفي الحلي بقوله:
وقـلـت ورثنــا ثيــاب الـنـبـي
فـكـم تــجــذبــون بـأهـدابهــا
وعـنـدك لا يــورث الأنـبـيــاء فـكـيـف حـظـيـتـم بـأثـوابهـا([41])
وقال الشريف الرضي «رحمه الله»:
وقـلـت ورثنــا ثيــاب الـنـبـي فـكـم تــجــذبــون بـأهـدابهــا
وعـنـدك لا يــورث الأنـبـيــاء فـكـيـف حـظـيـتـم بـأثـوابهـا([42])
كما أنهم دفعوا آلته وبغلته وحذاءه وخاتمه وقضيبه إلى علي «عليه
الصلاة والسلام»([43]).
وعليه فيرد ما أورده
المعتزلي الشافعي هنا حيث قال:
«إذا
كان «صلى الله عليه وآله» لا يورث؛ فقد أشكل دفع آلته ودابته،
وحذائه إلى علي «عليه السلام»، لأنه غير وارث في الأصل،
وإن كان إعطاؤه ذلك لأن زوجته بعرضة أن ترث لولا الخبر، فهو أيضاً
غير جائز؛ لأن الخبر قد منع أن يرث منه شيئاً، قليلا كان أو كثيراً».
(ثم ذكر ما تقدم عنه آنفاً
حين الجواب على ما ذكره العسقلاني، الذي ادَّعى:
أن علياً «عليه السلام» والعباس توهما: أن
«لا
نورث»
ليست عامة).
ثم قال:
«..فإنه
جاء في خبر الدابة والآلة، والحذاء: أنه روي عن النبي «صلى الله
عليه وآله»:
«لا
نورث، ما تركناه صدقة»،
ولم يقل:
«لا
نورث كذا وكذا»
وذلك يقضي عموم انتفاء الإرث عن كل شيء»([44]).
عاشراً:
لقد قال أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا
محمد بن فضيل، عن الوليد بن جميع، عن أبي الطفيل قال: لما قبض رسول
الله «صلى الله عليه وآله» أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أأنت ورثت
رسول الله أم أهله؟!.
فقال:
لا بل أهله.
فقالت:
فأين سهم رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!
فقال أبو بكر:
إني سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول:
«إن
الله إذا أطعم نبياً
طعمة، ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده».
فرأيت أن أرده على المسلمين. قالت: فأنت وما سمعت عن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»([45]).
فنلاحظ:
أن الخليفة يعترف بأن أهل النبي «صلى الله عليه وآله» يرثونه.
وذلك يكذب دعوى:
أن الأنبياء لا يورثون([46]).
ولكنه عاد فادَّعى
أنه يعود إليه لأنه قام بعد الرسول.
ولعل قول فاطمة
«عليها السلام» أخيراً:
فأنت وما سمعت من رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
ظاهر في أنها تشك في صحة الحديث، وأرجعت الأمر إلى الله سبحانه
ليحكم في هذا الأمر.
ولنا أن نحتمل:
أن السلطة قد سارت في موضوع إرث النبي «صلى الله عليه وآله» بخطوات
تراتبية تصعيدية، وربما تكون هذه القضية للزهراء «عليها السلام» مع
أبي بكر من الخطوات في هذا الاتجاه، ثم تلاها غيرها إلى أن انتهوا
إلى إنكار إرثها «عليها السلام» من الأساس.
حادي عشر:
قد اعترض ابن طاووس على دعوى: أن علياً «عليه
السلام»
قد غلب العباس على أرض بني النضير، وقال: إن ذلك غير صحيح.
«لاستمرار
يد علي «عليه السلام» وولده على صدقات نبيهم، وترك منازعة بني
العباس لهم، مع أن العباس ما كان ضعيفاً
عن منازعة علي، ولا كان أولاد العباس ضعفاء عن المنازعة لأولاد علي
في الصدقات المذكورة».
ثم ذكر «رحمه الله» روايتين عن قثم وعن عبد الله ابني عباس، يقرَّان
فيها: أن الحق في إرث رسول الله «صلى الله عليه وآله» لعلي «عليه
السلام»([47]).
ويجب أن لا ننسى مدى حرص الحكام على كسر شوكة علي «عليه السلام»،
وإبطال قوله وقول أهل بيته «عليهم
السلام»،
سواء في ذلك أولئك الذين استولوا على تركة النبي «صلى الله عليه
وآله»، أو الذين أتوا بعدهم من الأمويين أو العباسيين.
ثاني عشر:
قال العلامة: «كيف يجوز لأبي بكر أن يقول: أنا ولي رسول الله، وكذا
لعمر، مع أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» مات وقد جعلهما من
جملة رعايا أسامة بن زيد»([48]).
وأجاب البعض:
أن المراد بالولي: من تولى الخلافة، فإنه يصبح المتصرف في أمور
رسول الله «صلى الله عليه وآله» بعده، وتأمير أسامة عليهما لا
يجعلهما من رعاياه، بل هم جميعاً من رعايا النبي «صلى الله عليه
وآله»([49]).
وهو جواب لا يصح:
فقد قال الشيخ محمد حسن المظفر «رحمه الله»، ما حاصله: إن الولي
للشخص هو المتصرف في أموره؛ لسلطانه عليه ولو في الجملة، كالمتصرف
في أمور الطفل والغائب. ولا يصدق على الوكيل أنه ولي، مع أنه متصرف
في أموره. فلا أقل من أن ذلك إساءة أدب معه «صلى الله عليه وآله»
ولو سلم اعتبار السلطنة في معنى الولي فدعواهما أنها وليا رسول
الله «صلى الله عليه وآله» غير صحيحة، لأن النبي «صلى الله عليه
وآله» لم يستصلحهما حين وفاته إلا لأن يكونا في جملة رعايا أسامة،
فكيف صلحا بعده للإمامة على الناس عامة ومنهم أسامة؟
على أن إضافة الولي إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، من دون
اعتبار السلطنة في معنى الولي، تقتضي ظاهراً: أن تكون الولاية
مجعولة من النبي «صلى الله عليه وآله»، لأنها من إضافة الصفة إلى
الفاعل، لا إلى المفعول، وذلك باطل بالاتفاق،
وإنكار إطلاق الرعية على مثل تأمير أسامة في غير محله([50]).
ثالث عشر:
قال العلامة الحلي ما حاصله:
كيف استجاز عمر أن يعبر عن النبي «صلى الله عليه وآله» للعباس:
تطلب ميراثك من ابن أخيك، مع أن الله تعالى يخاطبه بصفاته، مثل يا
أيها الرسول، يا أيها النبي، ولم يذكره باسمه إلا في أربعة مواضع
شهد له فيها بالرسالة لضرورة تخصيصه وتعيينه..
وقد قال الله تعالى:
﴿لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ
بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً..﴾([51]).
ثم عبر عمر عن ابنته
مع عظم شأنها وشرف منزلتها بقوله:
يطلب ميراث امرأته([52]).
أضف إلى ذلك:
أنه عبر عن أمير المؤمنين «عليه السلام» باسم الإشارة، فقال:
«هذا».
وأجاب البعض:
بأنه:
«إنما
عبر بذلك لبيان قسمة الميراث كيف يقسم أن لو كان هناك ميراث، لا
أنه أراد الغض منهما بهذا الكلام»([53]).
وقال آخر:
هذا القول من عمر قد جاء على طريق محاورات العرب، وهو يتضمن ذكر
علة طلب الميراث، وهو كونه ابن أخيه، وليس فيه إساءة أدب، وعمر لم
يذكر النبي باسمه..
وبالنسبة للزهراء، فإن الأولى ترك ذكر النساء بأسمائهن في محضر
الرجال، فهو متأدب في ترك ذكر اسمها، لا مسيء للأدب بذلك([54]).
ولكنها أجوبة لا
تصح:
فقد قال العلامة المظفر «رحمه الله» تعالى، ما حاصله: إن محاورات
العرب إذا اقتضت التوهين برسول الله «صلى الله عليه وآله»، فلا بد
من تركها، فإنه لا يصح ترك أدب القرآن، والعمل بآداب الأعراب، وأهل
الجاهلية..
وبالنسبة إلى علة الميراث، فإنه لا حاجة إلى ذكرها، وترك الأدب مع
الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله». فهل لم يكن علي «عليه السلام»
والعباس «رحمه
الله»
أو أحد من الحضور يعلم هذه العلة؟!.
هذا..
بالإضافة إلى أنه كان يمكنه ذكر علة الميراث، ومراعاة الأدب معه
«صلى الله عليه وآله» في آن واحد.
وبالنسبة إلى أن عمر لم يذكر النبي «صلى الله عليه وآله» باسمه
الشريف، فإن المقصود: أن تكريمه «صلى الله عليه وآله» مطلوب، وليس
في عبارته ذلك، وقد قال تعالى:
﴿لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ
بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً..﴾.
كما أن تعبيره بـ
«امرأته»
ليس فيه علة الميراث التي هي بنوَّتها
لرسول الله «صلى الله عليه وآله». وقد كان يمكنه احترام الزهراء «عليها
السلام»
بذكر بعض ألقابها. وعدم ذكر النساء بأسمائهن لا يحل المشكلة، فقد
كان يمكنه تجنب اسمها «عليها السلام»، وذكرها ببعض ألقابها المادحة
لها([55]).
قال العقيلي:
«سمعت
علي بن عبد الله بن المبارك الصنعاني يقول: كان زيد بن المبارك لزم
عبد الرزاق، فأكثر عنه، ثم خرق كتبه، ولزم محمد بن ثور،
فقيل له في ذلك، فقال: كنا عند عبد الرزاق، فحدثنا بحديث معمر، عن
الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان الحديث الطويل؛ فلما قرأ قول
عمر لعلي والعباس:
«فجئت
أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك، وجاء هذا يطلب ميراث امرأته من أبيها».
قال عبد الرزاق:
انظروا
إلى الأنوك يقول: تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث
امرأته من أبيها ألا يقول: رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!.
قال زيد بن المبارك:
فقمت،
فلم أعد إليه، ولا أروي عنه.
قال الذهبي:
«لا
اعتراض على الفاروق (رض) فيها، فإنه تكلم بلسان قسمة التركات»([56]).
وقال:
«إن
عمر إنما كان في مقام تبيين العمومة والبنوة، وإلا.. فعمر (رض)
أعلم بحق المصطفى وبتوقيره «صلى الله عليه وآله» وتعظيمه من كل
متحذلق متنطع.
بل الصواب أن نقول
عنك:
انظروا إلى هذا الأنوك الفاعل ـ عفا الله عنه ـ كيف يقول عن عمر
هذا، ولا يقول: قال أمير المؤمنين الفاروق»؟!([57]).
ونقول:
1 ـ
إن بيان العمومة والبنوة ليس ضرورياً
هنا، وذلك لوضوحهما لكل أحد.
2 ـ
إن بيانهما والتكلم بلسان قسمة التركات لا يمنع من الإتيان بعبارة
تفيد توقير رسول الله «صلى الله عليه وآله» واحترامه.
3 ـ
إن التكلم بلسان قسمة التركات في غير محله، لأن العباس لا يرث؛
لبطلان التعصيب..
4 ـ
إذا صح: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لا يورث، فلا حاجة إلى
التحدث بلسان قسمة التركات، لا سيما وأن المطلوب ـ حسب ما يدَّعون
ـ هو قسمة النظر، كما تقدم،
وتقدم بطلانه..
5 ـ
إن زيد بن المبارك لا يعود إلى عبد الرزاق، لأنه رآه ينتصر لرسول
الله «صلى الله عليه وآله»، وينتقد عمر على عدم توقيره للنبي «صلى
الله عليه وآله». وهذا من ابن المبارك عجيب!! وعجيب جداً!!
6 ـ
إن الذهبي، وغيره يغضبون لعمر، ويشتمون عبد الرزاق لتوهينه عمر،
ولا يغضبون لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولا يقبلون حتى
بانتقاد من يتصدى لإهانته «صلى الله عليه وآله».
7 ـ
إنهم يطلبون من عبد الرزاق أن يذكر عمر بألقابه، ولا يطلبون من عمر
أن يذكر النبي بألقابه التي شرَّفه
الله تعالى بها.. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم.
وبعد..
فإن إلقاء نظرة فاحصة على حياة فاطمة الزهراء «عليها السلام»،
تعطينا: أنها «صلوات الله وسلامه عليها»، لم تتغير حياتها ـ بعد
فتح بني النضير وخيبر، وملكها فدكاً
وغيرها ـ عما كانت عليه قبل ذلك، رغم غلتها الكثيرة والوافرة، فهي
لم تعمر الدور، ولم تبن القصور، ولا لبست الحرير والديباج، ولا
اقتنت النفائس، ولا احتفظت لنفسها بشيء. وهكذا كانت حال زوجها علي
«عليه الصلاة والسلام» رغم توفر الأموال له.
بينما نجد:
أن بعض أولئك الذين استفادوا من أموال بني النضير وغيرها قد خلفوا
من الذهب والفضة ما يكسر بالفؤوس، ويكفي أن نذكر هنا:
1 ـ
أن الزبير بن العوام بنى داره المشهورة بالبصرة، وفيها الأسواق،
والتجارات، وبنى دوراً
في الكوفة، ومصر، والإسكندرية، وبلغ ثُمن
ماله خمسين ألـف
دينـار،
وتـرك
ألـف
فـرس،
وألف مملـوك،
وخططاً
بمصر والإسكندرية، والكوفة والبصرة([58]).
وقالوا:
كان للزبير خمسون مليوناً
ومئتا ألف.
وقيل:
بل مجموع ماله سبعة وخمسون مليوناً
وست مئة ألف([59]).
2 ـ
أما عبد الرحمن بن عوف: فقد كان له ألف بعير، وعشرة آلاف شاة،
ومائة فرس، وصولحت إحدى نسائه على ربع ثمن ماله بأربعة وثمانين ألف
دينار([60]).
وعن أم سلمة:
أن عبد الرحمن بن عوف دخل عليها، فقال: يا أمه، قد خفت أن تهلكني
كثرة مالي، وأنا أكثر قريش مالاً الخ..([61]).
وحينما مات ابن عوف جيء بتركته إلى مجلس عثمان؛ فحالت البدر بين
عثمان وبين الرجل القائم في الجهة الأخرى. وفي هذه المناسبة ضرب
أبو ذر كعب الأحبار بالعصا على رأسه فكانت النتيجة هي نفي أبي ذر([62]).
وبعد إخراج وصاياه كلها، فإنه قد ترك مالاً جزيلاً،
من ذلك ذهب قطع بالفؤوس، حتى مجلت أيدي الرجال([63]).
3 ـ
إن عمر بن الخطاب الذي استفاد هو الآخر من أموال بني النضير
وغيرها، كان أيضاً يملك ثروة هائلة في أيام خلافته، بل هو يدَّعي:
أنه كان في مكة من أكثر قريش مالاً كما ذكره ابن هشام، حين الحديث
عن هجرته هو وعياش بن أبي ربيعة، فقد أصدق إحدى زوجاته أربعين ألف
دينار أو درهم([64]).
وقيل:
عشرة آلاف. وأعطى صهراً
له قدم عليه من مكة عشرة آلاف درهم من صلب ماله([65]).
كما أن:
«ابناً
لعمر باع ميراثه من ابن عمر([66])
بمائة
ألف
درهم»([67]).
وفي نص آخر:
أن ثلث مال عمر كان أربعين ألفاً،
أوصى بها. وإن كان الحسن البصري قد استبعد ذلك، واحتمل أن يكون قد
أوصى بأربعين ألفاً
فأجازوها([68]).
لقد كان هذا في وقت كان يعيش الناس فيه أقسى حياة تمر على إنسان،
حتى إن بعضهم لم يكن يملك سوى رقعتين، يستر بإحداهما فرجه،
وبالأخرى دبره([69]).
فهؤلاء يجمعون الأمـوال،
ويتنعمون بهـا،
ثـم
يـرثهـا
عنهم أبنـاؤهم
وزوجاتهم، ليكون لها نفس المصير أيضاً.
وفي المقابل، فإن علياً أمير المؤمنين «عليه الصلاة والسلام»، الذي
وقف على الحجاج مائة عين استنبطها في ينبع([70])،
يروى عنه:
أن صدقات أمواله قد بلغت في السنة أربعين
ألف
دينار([71]).
وكانت صدقاته هذه كافية لبني هاشم جميعاً([72])،
إن لم نقل إنها تكفي أمة كبيرة من الناس من غيرهم، إذا لاحظنا أن
ثلاثين درهماً
كانت كافية لشراء جارية للخدمة، كما قاله معاوية لعقيل. وكان
الدرهم يكفي لشراء حاجات كثيرة بسبب قلة الأموال حينئذٍ، ولغير ذلك
من أسباب..
نعم.. إننا نجد علياً «عليه السلام» لم يلبس ثوباً
جديداً،
ولم يتخذ ضيعة، ولم يعقد على مال، إلا ما كان بينبع، والبغيبغة،
مما يتصدق به»([73]).
كما أنه لم يترك حين وفاته سوى سبع مائة درهم أراد أن يشتري بها
خادماً
لأهله([74]).
وقد أمر برد هذه السبع مائة درهم إلى بيت المال بعد وفاته، كما
ذكره الإمام الحسن «عليه السلام» في خطبته([75])
آنئذٍ،
وعاش ومات، وما بنى لبنة على لبنة، ولا قصبة على قصبة([76]).
وباع سيفه وقال:
«لو
كان عندي ثمن عشاء ـ أو إزار ـ ما بعته»([77]).
ويقول عنه معاوية:
«والله،
لو كان له بيتان، بيت تبن وبيت تبر لأنفذ تبره قبل تبنه»([78]).
وكان مصير تلك الأراضي والأموال والأملاك، أنه «عليه السلام» تصدق
بها، ووقفها على المسلمين، ولم يبق منها شيء حين وفاته «صلوات الله
وسلامه عليه»([79])،
كما هو صريح خطبة ولده السبط حين توفي والده.
وقد قال «عليه
السلام»:
أنا الذي أهنت الدنيا([80]).
وقد كان من أهم أسباب انصراف العرب عن علي «عليه السلام» سيرته في
المال، حيث لم يكن يحابي أحداً في هذا الأمر([81]).
وكذلك كان حال زوجته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء
«عليها
صلوات ربي وسلامه»؛
فإنها لم تزل تتصدق بغلة فدك وغيرها، وتنفق الأموال في سبيل الله
سبحانه، لتعيش هي «عليها السلام» حياة الزهد، والعزوف عن الدنيا،
وعن زبارجها وبهارجها.
وحتى هذه الموقوفات والصدقات؛ فإنها لم تسلم من الظلم والظالمين،
فقد استولى الحكام عليها، ومنعوا من استمرار إنفاقها في سبيل الله،
ومن انتفاع الفقراء والمحتاجين بها، ولتصبح بأيدي خصماء أهل البيت
من بني أمية، الذين كانوا يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع،
على حد تعبير علي «عليه السلام» في خطبته الشقشقية المذكورة في نهج
البلاغة.
وكلمة أخيرة نود
تسجيلها هنا، وهي:
أن بعض الناس يرى في الزهد معنى غير واقعي، ولا سليم.
فيرى:
أن الزهد هو: أن يلبس الإنسان الخشن، ويأكل من فضول طعام الناس،
ويتخلى عن كل شؤون الحياة، فلا يعمل، ولا يسعى، ولا يكد على عياله،
ولا يملك شيئاً من حطام الدنيا.. وذلك لأن عمله، وحصوله على المال
إنما يعني: أنه يحب الدنيا، وليس ذلك من الزهد في شيء.
وإذا كان لا مال لديه، فلا يكون مكلفاً
بشيء، ولا يتحمل أية مسؤولية مالية، لا تجاه نفسه، ولا تجاه غيره.
ونقول:
إن هذا الفهم للزهد، غير مقبول في الإسلام، بل هو خطأ كبير وخطير،
فإن الحصول على المال لا ينافي الزهد ما دام يضعه في مواضعه التي
يريدها الله، فقد روي عن النبي «صلى الله عليه وآله» قوله: نعم
المال الصالح للرجل الصالح([82]).
فالإسلام يقول:
إنك إذا استطعت أن تحصل على المال لتوظفه في قضاء حاجات المؤمنين،
وليكون وسيلة لإحياء الدين، ونشر تعاليمه، ويكون قوة على الأعداء،
وسبباً
في دفع البلاء، فإن ذلك لازم إن لم يكن واجباً
شرعياً،
يعاقب الله على تركه، وعلى عدم التقيد به..
غاية الأمر:
أنه يقول: لا يجوز أن يتحول هذا المال إلى إله يعبد، وإلى سيد
يطاع، وإلى مالك لرقبة صاحبه، فإنه:
«ليس
الزهد أن لا تملك شيئاً، ولكن الزهد أن لا يملكك شيء».
والتعبير عن الزهد بأنه حرية وانعتاق قد ورد عنهم
«عليهم
الصلاة والسلام»
فلتراجع كتب الحديث والرواية([83]).
وهذا بالذات هو المنهج الذي سار عليه النبي «صلى الله عليه وآله»
الذي ملك الفيء والخمس وغير ذلك، ولكنه لم يصبح مملوكاً
لما ملكه.. وكذلك الحال بالنسبة إلى بضعته الصديقة الطاهرة، وعلي
أمير المؤمنين «عليه السلام»، والأئمة الطاهرين من ولده صلوات الله
وسلامه عليهم أجمعين..
الزهراء
عليها السلام..
في مواجهة التحدي:
إن مطالبة علي «عليه السلام» بأموال بني النضير، ومطالبة الزهراء
«عليها
السلام» بفدك، وبسهمها بخيبر، وبسهمها من الخمس، وبإرثها أيضاً من
أبيها الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله».. وإصرارها على تحدي
السلطة في إجراءاتها الظالمة ثم مغاضبتها للغاصبين حتى توفيت، حيث
أوصت أن تدفن ليلاً
ـ إن ذلك كله ـ لا يمكن تفسيره على أنه رغبة في حطام الدنيا، وحب
للحصول على المال.. فإن حياتها وهي الصديقة الطاهرة، والزاهدة،
والفانية في الله، حتى إنها كانت تقوم الليل حتى تورمت قدماها..
وكذلك ما شاع وذاع حول كيفية تعاملها مع الأموال التي كانت تحصل
عليها من فدك وغيرها، وكيف كانت تصرفها ـ إن ذلك ـ لخير دليل على
ما نقول، وأوضح شاهد عليه.
وهذا بالذات هو ما يجعلنا نتساءل عن السر الكامن وراء تلك
المطالبة، وذلك الإصرار. ولعلنا نستطيع أن نفسر ذلك بما يلي:
1 ـ
إن نفس الانتصار للحق، وتأكيده، ورفض الباطل وإدانته أمر مهم
ومطلوب ومحبوب، وهو من القيم والمثل التي لا بد من الالتزام بها
والتأكيد عليها، في مختلف الظروف والأحوال.
2 ـ
إن في موقف فاطمة الزهراء «عليها السلام» في وقت لا يزال فيه
الإسلام طري العود، ويمكن أن يصبح فيه السكوت على الانحراف سبباً
في قبول الناس له على أنه أمر لا يتنافى مع أحكام الشرع والدين ـ
إن في هذا الموقف ـ حفاظاً
على مبادئ الإسلام، وعلى قوانينه وأحكامه، وصيانة له عن الفهم
الخاطئ وعن التحريف..
3 ـ
إن فاطمة «عليها السلام» بموقفها هذا قد أفهمت كل أحد: أنه لا بد
من قول الحق، وإطلاق كلمة
«لا»
في وجه الحاكم، وأنه ليس في منأى عن الحساب والعتاب والعقاب، وأن
الانحراف مرفوض من كل أحد حتى من الحاكم، وليس هو فوق القانون، بل
هو حام للقانون، ومدافع عنه، وأن سلطته وحكمه ليس امتيازاً
له يصول به على الآخرين، ويستطيل به عليهم، وإنما هو مسؤولية، لا
بد أن يطالب هو قبل كل أحد بالقيام بها، وبالالتزام بما يفرض الشرع
عليه الالتزام به في نطاقها..
4 ـ
إن الاعتراض حيث لا بد منه حتى على الحاكم، مهما كان قوياً
وعاتياً،
هو مسؤولية كل أحد حتى النساء بالمقدار الذي يمكن،
ولا يختص ذلك بالرجال.
5 ـ
إن التصدي للمطالبة بالحق وتسجيل الموقف، لا يجب أن ينحصر في صورة
العلم بإمكان الحصول على ذلك الحق، أو احتمال ذلك. بل إن ذلك قد
يجب حتى مع العلم بعدم إمكان الحصول على شيء. فإن فاطمة «عليها
السلام» كانت تعلم بأن مطالبتها لن تجدي شيئاً
في إرجاع ما اغتصب منها إليها، ولكنها مع ذلك قد سجلت موقفاً
حاسماً
وأدانت الانحراف، وتصدت له، وماتت وهي مهاجرة وغاضبة على أولئك
الذين أخذوا حقها، واستأثروا به دونها.
وحتى حين طلب منها أمير المؤمنين أن تستقبلهما، فإنها لم تجب
بالقبول، بل قالت له «عليه السلام»: البيت بيتك، والحرة زوجتك،
افعل ما تشاء.
فدخـلا
عليهـا،
وحـاولا
استرضاءها وبكيا لديهـا،
ولكنهـا
فضحت خطتهما، وأوضحت لهـما،
من خـلال
حملهـا
إيـاهما
على الإقرار بأنهما قد أغضباها، وبأن الله يغضب لغضبها، ويرضى
لرضاها ـ أوضحت لهما: أنها لا تزال غاضبة ساخطة عليهما([84])،
لا سيما وأنهما ما زالا يصران على غصبها حقها، ومنعها إرثها، وسائر
أموالها.
وذلك لأنها عرفت أن بكاءهما وخضوعهما لها إنما يرمي إلى التأثير
عليها عاطفياً،
من دون تقديم أي تراجع عن موقفهما السابق، أو تقديم أي
اعتذار
مقبول عنه.
ومعنى ذلك هو:
أنهما قد أرادا من وراء استرضائهما إياها «عليها السلام»، هو أن
يصبح بإمكانهما دعوى: أن فاطمة قد رضيت، وطابت نفسها، بل وأقرتهما
على ما فعلاه وسلمت لهما بما ادعياه.
ولكن وصيتها بأن تدفن ليلاً،
ثم تنفيذ هذه الوصية من قبل أمير المؤمنين علي «عليه السلام» قد
فوت الفرصة على كل دعوى، وسد السبيل أمام أي تزوير.
فلم يبقَ
أمام أولئك الذين يقدسون هؤلاء الغاصبين ويؤيدونهم إلا الإعلان
بالخلاف، والإصرار على الباطل. بل إن بعضهم لم يستطع إخفاء ما يجنه
من حقد وضغينة، فجاهر بالطعن، والانتقاص، والنيل من مقامها، وحاول
ـ ما أمكنه ـ تصغير عظيم منزلتها..
فأنكر بعضهم كونها واجبة العصمة([85])
لأجل ذلك، رغم أن الكتاب العزيز قد نص على طهارتها، وعلى أنها
بريئة من أي رجس أو رين.. كما أن الحديث المتواتر عن رسول الله
«صلى الله عليه وآله» حول أن الله يغضب لغضبها([86])
يدل على عصمتها كذلك.
وأما لماذا لم يسترجع علي «عليه الصلاة والسلام» فدكاً
وغيرها مما اغتصب منهم «عليهم السلام»، مع أنه كان قادراً
على ذلك أيام خلافته..
فقد ذكرت الروايات الواردة عن الأئمة «عليهم السلام» الأسباب
التالية:
1 ـ
إن الظالم والمظلوم كانا قد قدما على الله عز وجل، وأثاب الله
المظلوم، وعاقب الظالم؛ فكره أن يسترجع شيئاً قد عاقب الله عليه
غاصبه، وأثاب عليه المغصوب (عن
الإمام
الصادق
«عليه
السلام»)([87]).
2 ـ
للاقتداء برسول الله «صلى الله عليه وآله» لما فتح مكة وقد باع
عقيل بن أبي طالب داره؛ فقيل له: يا رسول الله، ألا ترجع إلى
دارك؟.. فقال «صلى الله عليه وآله»: وهل ترك عقيل لنا داراً،
إنَّا
أهل بيت لا نسترجع شيئاً يؤخذ منا ظلماً؛
فلذلك لم يسترجع فدكاً لما ولي (عن
الإمام
الصادق
«عليه
السلام»)([88]).
3 ـ
لأنَّا
أهل بيت لا نأخذ حقوقنا ممن ظلمنا إلا هو (يعني: إلا الله)، ونحن
أولياء المؤمنين، إنما نحكم لهم، ونأخذ حقوقهم ممن ظلمهم، ولا نأخذ
لأنفسنا (عن الإمام الكاظم
«عليه
السلام»)([89]).