|
الخندق في خطة الحرب والدفاع
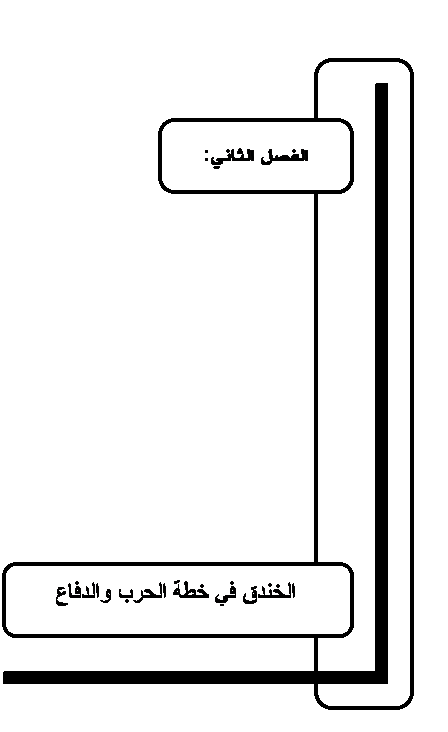
المفاجأة:
1 ـ
إن معرفة الإنسان بعدوِّه
تجعله أقدر على التعاطي معه من موقع القوة والحزم، من خلال ما تهيئ
له تلك المعرفة من قدرة على رسم الخطة السليمة، ثم التنفيذ الدقيق
والواعي.
ولا تقتصر هذه المعرفة المؤثرة على معرفة عناصر الضعف
والقوة في العدة وفي العدد، وسائر النواحي العسكرية، والامتيازات
الحربية. بل تتعداها إلى الإشراف
على خصائص شخصية العدو والمعرفة بطبائعه، وأخلاقياته،
ومبادئه ومفاهيمه، وعاداته وتقاليده ومستواه الفكري والعلمي، وما إلى
ذلك، مما له دور وتأثير في اتخاذ القرار العسكري، أو تسجيل الموقف على
الصعيد السياسي، أو التعامل في مجال السلوك،
وهكذا على الصعد كافة. ثم انعكاسات ذلك كله على التحرك باتجاه حشد
الطاقات، ورسم الخطط، والإعداد
والاستعداد للمواجهة
والتصدي.
فإن
التعامل مع العدو الذي يلتزم بالعهود والمواثيق، يختلف عنه مع من عرف
أن من طبيعته الغدر، وعدم الوفاء. كما أن التعامل مع من يلتزم بعهده
لدوافع دينية وعقيدية ومبدئية يختلف عن التعامل مع من يلتزم بذلك
لدوافع أخرى.. وهكذا الحال في سائر النواحي ومختلف المواضع والمواقع.
2 ـ
ونبينا الأكرم «صلى الله عليه وآله» كان يعرف تماماً
حقيقة ما يفكر به المشركون، واليهود والمنافقون، وسائر
القوى التي تحيط به. ثم هو يعرف طبيعة تركيبتهم السياسية والاجتماعية
وواقعهم الثقافي والإقتصادي.
ثم هو يعرف نهجهم، وأساليبهم
وطموحاتهم وطريقتهم في الحياة.
وقد
أثبتت
له التجربة الحسية في أكثر من موضع وموقع ما ينطوون عليه من غدر
وخيانة، ومن روح أنانية وتآمرية حاقدة وشريرة وغير ذلك من
أوضاع
وحالات.
وهذا الواقع العدائي، والروح التآمرية، وتلك الأعمال
الخيانية التي كانت تهيمن على
أعداء
الله والإنسانية، قد فرضت على النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله»
والمسلمين أن يعيشوا حالة الحذر القصوى، فكان أن بث رسول الله «صلى
الله عليه وآله» عيونه وأرصاده
في طول البلاد وعرضها في الجزيرة العربية، هذا بالإضافة إلى ما كان
يلمسه «صلى الله عليه وآله» من التسديد بالوحي والألطاف
الإلهية به «صلى الله عليه وآله» وبالمسلمين في الفترات الحرجة
والخطيرة.
وهذا ما يفسر لنا ما نشهده من معرفة النبي التامة بواقع
ما يجري حوله، فلم يكن ليفاجئه أمر داهم، بل كان هو الذي يفاجئ أعداءه
ويباغتهم.
فهو
إما يسبقهم
بتوجيه
الضربة الأولى لهم، وإما بمواجهته
لهم
بالخطة التي تبطل كيدهم، وتفشل مؤامراتهم، ومكرهم السيّئ
، ولا يحيق المكر السيّئ
إلا بأهله.
وهذا بالذات هو ما حصل في حرب الخندق، حيث فاجأ
المشركين بحفر الخندق حول المدينة، وتحصين سائرها، الأمر الذي
أحبط
خطتهم، وتسبب لهم بالفشل الذريع، والخيبة القاتلة والمريرة.
3 ـ
أما معرفة
أعداء
النبي «صلى الله عليه وآله»
به
فهي تختلف في مضمونها، وفي آثارها ونتائجها عن معرفته
بهم، فإنهم
وإن
كانوا يعرفون نبوَّته
وصدقه وأمانته،
ولا يشكوُّن
في حقانية ما جاء به.
إلا
أنهم
يجهلون الكثير الكثير من آثار الإسلام، والإيمان، ولا يعرفون الكثير
عما يحدثه الالتزام بتعاليمه وشرائعه من تغييرات عميقة في فكر وروح
الإنسان وفي شخصيته، وفي كل وجوده.
نعم..
إنهم
يعرفون صدق هذا النبي، وصحة نبوته، وحقانية ما جاء به، إلى درجة أن
اليهود يعرفونه كما يعرفون
أبناءهم،
ويجدونه مكتوباً
عندهم في التوراة والإنجيل.
أما المشركون، فقد عاش النبي «صلى الله عليه وآله»
بينهم، وعرفوه طفلاً
ويافعاً،
وشاباً
ومكتهلاً،
وهم الذين سموه بالصادق الأمين،
ورأوا منه الكثير من المعجزات والكرامات والخوارق،
وعاينوا وسمعوا منه من الحجج ما يقطع كل عذر، ويزيل كل شبهة وريب، حتى
لم يعد
أمامهم
إلا البخوع والتسليم، أو الاستكبار والجحود على علم،
فألزموا
أنفسهم
بالخيار الثاني، كما حكاه الله تعالى عنهم:
﴿وَجَحَدُوا بِهَا
وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلماً وَعُلُوّاً..﴾([1]).
فكان من نتيجة ذلك:
أن أصبح محض الحق يواجه محض الكفر والجحود وظهر بذلك
صحة قوله «صلى الله عليه وآله» حين برز علي «عليه السلام» لعمرو بن عبد
ود الذي وضع المشركون فيه كل آمالهم: «برز الإيمان كله إلى الشرك كله».
ولا عجب بعد هذا إذا تعاون أهل الشرك والأوثان
مع اليهود مدَّعي
التوحيد. بل لا عجب إذا رأينا هؤلاء اليهود، الذين يدَّعون
أنهم يعبدون الله، يشهدون لأهل الأوثان
بأنهم أهدى من أهل التوحيد رغم أن ذلك يستبطن اعترافاً
من اليهود ببطلان دينهم وعقيدتهم!!
وبعد ما تقدم:
فإننا
نستطيع
أن
نتفهم بعمق السبب في
أن
هذه الحرب فيما بين المسلمين وأعدائهم لا بد
أن
تكون مريرة وقاسية وتتميز بالشمولية والاتساع، والعمق. ثم برسوخ آثارها
على كل صعيد ما دام
أن
أعداء
الإسلام يرون ضرورة
أن
تستنفذ جميع الطاقات المتوفرة لديهم للهدم وللاستئصال،
والإبادة
الشاملة، فإن
الهدف منها
هو
استئصال محمد ومن معه.
﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ
المَاكِرِينَ﴾([2]).
ويقول المؤرخون:
إنه لما فصلت قريش من مكة إلى المدينة خرج ركب من خزاعة
إلى النبي فساروا من مكة إلى المدينة أربعاً
فأخبروا
النبي «صلى الله عليه وآله» بالأمر.
وذلك
حين ندب رسول الله «صلى الله عليه وآله» الناس، وأخبرهم
الخبر وشاورهم في
أمرهم،
وأمرهم
بالجد والجهاد، ووعدهم النصر، إن هم صبروا واتقوا، وأمرهم
بطاعة الله وطاعة رسوله.
وشاورهم «صلى الله عليه وآله» ـ وكان يكثر من مشاورتهم
في الحرب ـ فقال: أنبرز لهم من المدينة؟ أم نكون فيها ونخندقها علينا؟
أم نكون قريباً ونجعل ظهورنا إلى الجبل؟! فاختلفوا.
[زاد المقريزي
قوله: وكان سلمان الفارسي يرى رسول الله «صلى الله عليه وآله» يهم
بالمقام بالمدينة([3])
ويريد أن يتركهم حتى يردوا ثم يحاربهم على المدينة وفي طرقها فأشار
بالخندق].
فقال سلمان:
يا رسول الله! إنا إذ كنا بأرض
فارس، وتخوفنا الخيل خندقنا علينا، فهل لك يا رسول الله
أن
نخندق؟!
فأعجب
رأي سلمان المسلمين،
وأحبوا الثبات في المدينة.
فركب رسول الله «صلى الله عليه وآله» فرساً
له، ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين، والأنصار، فارتاد موضعاً
ينزله، فكان أعجب المنازل إليه: أن يجعل سلعاً
ـ جبل معروف بسوق المدينة ـ خلف ظهره ويخندق على
المذاد، إلى ذباب، إلى راتج.
فعمل يومئذٍ الخندق.
وندب الناس،
وخبرهم بدنو عدوهم، وعسكرهم إلى سفح سلع([4]).
واختصر ذلك المفيد وابن شهرآشوب،
فقالا:
«فلما سمع النبي «صلى الله عليه وآله» باجتماعهم استشار
أصحابه، فاجتمعوا على المقام بالمدينة وحربهم على
أنقابها»([5]).
ولنا مع هذا الذي يذكره المؤرخون وقفات، وهي التالية:
قد تقدم:
أن
ركباً
من خزاعة قدم إلى المدينة في مدة أربعة أيام فأخبروا النبي «صلى الله
عليه وآله» بمسير الأحزاب إليه.
ولكننا نجد نصاً آخر عن علي
«عليه
السلام»
يقول:
إن النبي «صلى
الله عليه وآله» قد علم بذلك من جهة جبرئيل «عليه السلام» «فخندق على
نفسه ومن معه»([6]).
ولا نستبعد
أن
يكون كلا الأمرين قد حصل.
وقد ذكرنا فيما سبق:
أن
خزاعة كانت ترتبط مع الهاشميين بحلف عقده معها عبد المطلب «رحمه الله»،
وقد بقيت وفية لهذا الحلف وكانت عيبة نصح لرسول الله «صلى الله عليه
وآله».
وقد أشرنا فيما سبق:
إلى
أنها
قد دفعت ثمن هذا الوفاء غالياً
فيما بعد وفاة رسول الله الأكرم «صلى الله عليه وآله»؛
فجزى الله
أنصار
الله، وأنصار
رسوله خير جزاء وأوفاه. إنه ولي قدير، وبالإجابة
حري وجدير.
إن السياق المذكور آنفاً يدل:
على
أن
النبي «صلى الله عليه وآله» هو الذي بادر إلى اقتراح حفر الخندق، ثم
لما اختلف المسلمون،
فتكلم
سلمان الفارسي «رحمه الله» بطريقة بيَّن
لهم فيها وجه الحكمة في اعتماد
إجراء
كهذا، فأعجبهم
ذلك حينئذٍ، فقبلوه واجتمعت كلمتهم عليه.
ولكن كلمات كثير من المؤرخين قد
أظهرت:
أن
سلمان هو المشير بحفر الخندق([7])
من دون
أن
تشير إلى أي تحفظ في ذلك.
وهذا هو ما
استنتجه بعض المشركين حين فوجئوا بالخندق([8]).
بل قال مسكويه:
«فأشار سلمان على رسول الله «صلى الله عليه» لما رآه
يهم بالمقام بالمدينة، ويدبر
أن
يتركهم حتى يردوا، ثم يحاربهم على المدينة وفي طرقها: أن يخندق. ففعل
ذلك»([9]).
لكن مؤرخين آخرين قد عبَّروا
عن شكهم في هذا الأمر، فقال بعضهم: «استشار النبي «صلى الله عليه وآله»
سلمان ـ فيما يزعمون ـ بأمر الخندق»([10]).
وقال آخرون:
«فحفر الخندق. قيل:
أشار
به سلمان»([11]).
وفي مقابل ذلك
نجد ابن إسحاق وكذا غيره ينسب حفر الخندق إلى رسول الله «صلى الله عليه
وآله» ولا يشير إلى مشورة سلمان، لا من قريب ولا من بعيد([12]).
بل
إن
النبي «صلى الله عليه وآله» قد كتب في رسالته الجوابية لأبي سفيان:
«وأما قولك من علَّمنا
الذي صنعنا من الخندق، فإن
الله
ألهمني
ذلك»([13]).
وكل ذلك يجعلنا نميل إلى
أن
كلام الواقدي قد جاء أكثر دقة في هذا المجال. وهو يفسر لنا السر في
كلام ابن إسحاق من جهة، وكلام غيره المقابل له من جهة أخرى.
أما
أولئك الذين ظهر منهم التردد في ذلك فلعلهم لم يقفوا على كلام الواقدي،
ولم يتمكنوا من الجمع بين كلام ابن إسحاق وهو الحجة الثبت في السيرة،
وبين كلام غيره.
ولا نخفي هنا
إعجابنا
بهذا الوعي من سلمان المحمدي، حيث بادر في الوقت المناسب إلى تقديم
تبرير لأولئك
الناس الذين اختلفوا على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، يتوافق مع
طريقة تفكيرهم، حيث قرر لهم:
أن
الخندق المقترح من شأنه
أن
يحد من فاعلية الخيل في الحرب، ويدفع غائلتها، ويصبح الجهد الشخصي
للأفراد هو الذي يقرر مصير الحرب ونتائجها.
فكان
أن
استجاب المسلمون لاقتراح حفر الخندق، وأعلنوا
موافقتهم عليه، وتحملوا مسؤولية الخيار والاختيار، وهذا بالذات هو ما
أراده الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله».
وقد رأينا:
أن
عدداً من المؤرخين قد زعم
أن
الخندق حفر بإشارة سلمان، وإن
كنا نرجح:
أن
النبي «صلى الله عليه وآله» هو الذي بادر إلى اقتراحه فاختلف المسلمون،
فكان دور سلمان
أن
بيَّن
لهم وجه الحكمة في ذلك، حسبما تقدم بيانه عن الواقدي..
ومهما يكن من أمر فقد ظهر:
أن
المشركين قد فوجئوا بالخندق وقالوا عنه: إن هذه المكيدة ما كانت العرب
تكيدها([14])،
ولعل الأنظار قد اتجهت إلى سلمان الفارسي منذئذ.
وسواء أكان ذلك بمشورة سلمان أم لم يكن فإن
ما نريد
أن
نؤكد عليه هو
أن
الإسلام لا يمنع من الاستفادة من تجارب الآخرين ومن خبراتهم في
المجالات الحياتية البناءة،
فقد روي: أن «الحكمة ضالة المؤمن، فاطلبوها ولو عند المشرك تكونوا أحق
بها وأهلها» وفي معناه غيره([15]).
نعم..
إن المؤمن
أحق
بالحكمة من غيره، ما دام أن ذلك الغير قد يستفيد منها لتقوية انحرافه،
وتأكيد موقعه المناوئ للحق وللأصالة
والفطرة.
وقد رأينا:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد
أطلق
الصناع وأصحاب الحرف في خيبر لينتفع بهم المسلمون([16]).
وأمر
النبي «صلى الله عليه وآله» المشركين في بدر، الذين لا يجدون ما يفتدون
به: أن يعلم الواحد منهم عشرة من
أطفال
المسلمين القراءة والكتابة، ويطلق سراحهم في مقابل ذلك([17]).
ولكن هذه الاستفادة مشروطة:
بأن لا تنشأ عنها سلبيات أخرى كما لو كان ذلك يعطي
لأولئك المنحرفين فرصة لتضليل الناس وجرهم إلى مهالك الانحراف، أو
يعطيهم بعض النفوذ والهيمنة أو يجرئهم على التدخل في الشؤون الخاصة
بالمسلمين، وما إلى ذلك.
وهكذا، فإنه يصبح واضحاً:
أن المرفوض
إسلامياً
هو التبعية للآخرين والانبهار الغبي بهم، وتقليدهم على غير بصيرة. وأما
الاستفادة الواعية من منجزاتهم الحيوية لبناء الحياة، والتغلب على
مصاعبها، بصورة تنسجم مع
أحكام
الشرع، ومن دون أن تنشأ عنه سلبيات خطيرة، فذلك أمر مطلوب، ولا غضاضة
فيه.
وحتى لو كان الخندق بإشارة سلمان من الأساس، وكان سلمان
قد استفاد ذلك من بيئته وقومه، الذين ما كانوا على طريقة الإسلام ولا
على دين الحنيفية، فلا ضير ولا غضاضة في قبول مشورته. بل الغضاضة في
ترك العمل بتلك المشورة إذا كانت موافقة للصواب ويتسبب الإعراض
عنها بوقوع المسلمين في مأزق، وهم في غنى عنه ولا مبرر للوقوع فيه. مع
وجود مخرج ليس في العمل به حرج ولا تنشأ عنه أية سلبيات يرغب عنها.
هذا، ولا نرى
أننا
بحاجة إلى التذكير بمبررات مشاورة النبي «صلى الله عليه وآله» أصحابه،
في أمر الحرب، فقد تحدثنا عن ذلك، وعن أسبابه وآثاره الإيجابية في
أوائل غزوة أحد.
غير أننا نشير هنا:
إلى أننا نلمح في طريقة مشاورة النبي «صلى الله عليه
وآله» لأصحابه خصوصيتين رائعتين تجلتا لنا في النص الذي ذكره الواقدي.
إحداهما:
أنه
«صلى الله عليه وآله» هو الذي بادر إلى اقتراح حفر الخندق ثم انتظر
مبادرة سلمان الإقناعية،
متعمداً
أن تسير الأمور بهذه الطريقة، سياسة منه
«صلى الله عليه وآله» لأصحابه، وترويضاً
لعقولهم، وإعداداً
لهم ليبادروا إلى تحمل المسؤولية، ولغير ذلك من أمور.
الثانية:
أنه
«صلى الله عليه وآله» في نفس الوقت الذي يمارس فيه
أسلوب
المشاورة بهدف تحسيس أصحابه بالمسؤولية وإفهامهم
ـ
عملاً،
لا قولاً
فقط ـ أنهم الجزء الحركي والفاعل والمؤثر حتى على مستوى التخطيط،
والقرارات المصيرية، وأن القضية قضيتهم، بما يعنيه ذلك كله من ارتفاع
ملموس في مستوى وعيهم وتفكيرهم السياسي، والعسكري، وغير ذلك من أمور
كانت محط نظره «صلى الله عليه وآله»،
نعم..
إنه
في هذا الحين بالذات يطرح
أمامهم
خيارات من شأنها أن تخرجهم من حالة الضيق والحرج، وتفتح
أمامهم
نوافذ جديدة على
آفاق
رحبة من التدبير العسكري، الذي يحفظ لهم وجودهم، ويبعد عنهم شبح
الهزيمة المرة، أو التعرض لحرب تحمل معها أخطار القتل الذريع، دون
أن
يجدوا في مقابل ذلك أياً من تباشير النصر، أو التفاؤل به.
قد تحدثنا في غزوة أحد في الفصل
الأول منها، في فقرة:
ما هو رأي النبي «صلى الله عليه وآله» في أحد، ما يفيد الاطلاع عليه في
فهم إيجابيات البقاء في المدينة، والتمنع فيها، فيرجى مراجعة ما ذكرناه
هناك.
أما هنا، فنقول:
إنه
لم يطل
الأمر
بالمسلمين، حيث إنهم سرعان ما
أدركوا:
أن
حفر الخندق هو ذلك التدبير الذكي الرائع الذي فوَّت
على عدوهم ما كان يحلم به من منازلتهم ومكافحتهم إلى درجة
إلحاق
الهزيمة بهم ثم استئصالهم وإبادة خضرائهم، وتقويض عزهم.
وقد
أعطى
الخندق المسلمين القدرة على ممارسة التسويف في الوقت، وهو الأمر الذي
لم يكن المشركون قادرين على تحمل التسويف فيه إلى أجل غير مسمى.
وقد رأى المسلمون بأم أعينهم:
1 ـ
كيف
أن
عدوهم لم يستطع الصبر طويلاً،
بسبب بعده عن مصادر الإمداد
البشري والتمويني، مع ملاحظة محدودية طاقاتهم التموينية، لعدم
إمكان
توفير مدخرات كافية لهذا العدد الهائل من الناس، ولكل ما معهم من خيل
وظهر كانوا بحاجة إليه في حربهم. فإن
منطقة الحجاز لم تكن قادرة ـ بحكم طبيعة حياة الناس فيها ـ على توفير
هذا النوع من القدرات والإمكانات بهذا المستوى الكبير والحجم الهائل ـ
ولا أقل من
أن
المشركين لم يفكروا مسبقاً
بإيجاد خطوط تموين لحرب طويلة الأمد،
ولا خططوا أبداً لمثل هذه الحرب، كما
أنهم
لم يعتادوا حروباً
كهذه ولا ألفوها، فمن الطبيعي ـ والحالة هذه ـ
أن
يملوا حرباً
كهذه، وينصرفوا عنها.
2 ـ
إن هذا الخندق قد استطاع
أن
يحفظ لهم وجودهم وكرامتهم، فلم يسجل عليهم عدوهم نصراً
وقد كبت الله به عدوهم وردهم بغيظهم لم ينالوا شيئاً مما كانوا يحلمون
به، دون
أن
يكلف ذلك المسلمين خسائر تذكر، وحرم المشركين بذلك من
إمكانية
إشراك
أعداد
ضخمة في المواجهات مع المسلمين.
3 ـ
ثم وجد المسلمون
أنفسهم
بعد ذلك
أمام
فرص
أكبر،
وحظ
أوفر
من ذي قبل، واستمروا يواصلون جهدهم وجهادهم للحصول على المزيد من أسباب
القوة، والمنعة، والعمل على
إضعاف
عدوهم وتقويض هذا التوافق فيما بين فئاته لصالح بقاء هذا الدين، وترسيخ
دعائمه وأركانه.
4 ـ
إنه «صلى الله عليه وآله» قد جمع بين أن خندق على
المدينة وبين جعل جبل سلع خلف ظهر المسلمين ـ كما سنرى ـ فيكون بذلك قد
استفاد من الموانع الطبيعية، ثم أحدث مانعاً
مصطنعاً
من الجهة الأخرى، لتكتمل خطته بحرمان العدو من أية فرصة للنيل من صمود
المسلمين، أو إحداث أي إرباك، أو تشويش، أو خلخلة، أو مناطق نفوذ وتسلل
في صفوفهم.
وأخيراً:
نجد نصاً عن سلمان الفارسي يصرح فيه بالمبررات لحفر
الخندق، فهو يقول: «يا رسول الله، إن القليل لا يقاوم الكثير في
المطاولة.
قال:
فما نصنع؟
قال:
نحفر خندقاً يكون بيننا وبينهم حجاباً،
فيمكنك منعهم في المطاولة. ولا يمكنهم
أن
يأتونا من كل وجه. فإنَّا
كنا معاشر العجم في بلاد فارس إذا دهمنا دهم من عدونا نحفر الخنادق،
فيكون الحرب من مواضع معروفة.
فنزل جبرئيل
«عليه السلام» على رسول الله «صلى الله عليه وآله» فقال: أشار سلمان
بصواب([18]).
وآخر ما نقوله هنا:
أن حفر الخندق قد أفهم المسلمين: أنه ليس من الضروري أن
يبقى الإنسان أسير الأفكار
والعادات والأساليب
المتداولة في المحيط الذي يعيش فيه، فإذا كان باستطاعته أن يبتكر
أساليب، ويحدث وسائل جديدة، تمكنه من تحقيق أهدافه على النحو الأفضل
والأمثل،
فعليه أن يبادر إلى ذلك، ويكسر حاجز الإستغراب
والإستهجان
والرهبة، ويتحرر من عقدة الحفاظ على القديم، أو على العادة والتراث
لمجرد أنه قديم وتراث، ومن موقع الجمود، والخواء والتقوقع.
أما إذا كان هذا القديم يمثل الأصالة، والعمق
والانتماء، ويعيد للإنسان هويته الحقيقية، ويحول بينه وبين التخلي عن
خصائصه الإنسانية الأصيلة،
فذلك القديم يكون هو الجديد النافع، في مقابل كل ما هو غريب، أو يجر
الإنسان إلى غربة حقيقية، تبعده عن واقعه وتجرده من خصائصه الإنسانية
الأصيلة،
ليعيش في الظلام والضياع حيث الشقاء والبلاء، وحيث الوحشة والوحدة
والغربة، بكل ما لهذه الكلمات من معنى؛
فالتجديد الإيجابي
البناء هو الأصالة ذاتها.
أما التجديد الذي يفقد الإنسان أصالته، فهو الذي يمثل
العودة إلى الوراء، وهو حقيقة التغرب والإنحطاط،
والسقوط والتراجع. وهو بالتالي الكارثة الحقيقية والمدمرة له إن في
الحاضر أو في المستقبل.
أضف إلى ما تقدم:
أن التعارف فيما بين الشعوب المختلفة حين ينتهي إلى
توظيف حصيلة تجاربها الحياتية لاستكمال سماتها الأصيلة
للحياة بكل امتداداتها وعلى مختلف المساحات في الآفاق الرحبة، فإن
هذا التعارف يصبح ضرورة لا بد منها ولا غنى عنها لأية
أمة تريد لنفسها الخير والسعادة والفلاح. وتريد كذلك
أن
تستثمر ذلك كله في خط التقوى والعمل الصالح. وفي صراط حصحصة الحق ليكون
هو الملاذ، والرجاء، في كل شدة ورخاء.
وقد قال تعالى:
﴿..وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوباً
وَقَبَائِل لتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ..﴾([19]).
قد تقدم:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد ركب فرساً
وخط لهم الخندق وقد بينت النصوص التاريخية لنا مواضع الخندق وخصوصياته
ومواصفاته بشيء من التفصيل، ونحن نذكر طائفة من هذه النصوص فنقول:
قال الواقدي:
«كان الخندق
ما بين جبل بني عبيد بخربى، إلى راتج. قال: وهذا أثبت الأحاديث عندنا»([20]).
وفي نص آخر:
«من المذاد،
إلى ذباب، إلى راتج»([21]).
وعند القمي:
«فأمر «صلى
الله عليه وآله» بمسحه من ناحية أحد إلى راتج»([22]).
وفي نص أكثر تفصيلاً:
«حفر النبي «صلى الله عليه وآله» الخندق طولاً، من أعلى
وادي بطحان، غربي الوادي، مع الحرة، إلى غربي مصلى العيد، ثم إلى مسجد
الفتح، ثم إلى الجبلين الصغيرين، اللذين في غربي الوادي. ومأخذه قول
ابن النجار».
إلى أن قال:
«والحاصل: أن
الخندق كان شامي المدينة، من طرف الحرة الشرقية، إلى طرف الغربية»([23]).
وروي بسند معتبر، عن عمرو بن عوف
قال:
«خط رسول الله
«صلى الله عليه وآله» الخندق عام الأحزاب من أجم الشيخين (السمر) طرف
بني حارثة، حتى بلغ المذاد (المداحج)»([24]).
والمذاد بطرف
منازل بني سلمة، مما يلي مسجد الفتح، ومنازلهم في جهة الحرة الغربية([25]).
قال السمهودي:
«سيأتي أن الشيخين أطمان
شامي المدينة بالحرة الشرقية، أما المداحج فلا ذكر لها في بقاع
المدينة»([26]).
وأقول:
لعل كلمة «المداحج» تصحيف لكلمة «المذاد»، ولعل كلمة:
«السمر»، تصحيف لكلمة «الشيخين».
«وذكروا: أن
الخندق له أبواب، فلسنا ندري أين موضعها»([27]).
وحسب نص آخر:
«جعل له رسول الله «صلى الله عليه وآله» أبواباً، وجعل
على الأبواب حرساً»([28]).
ولكن كعب بن مالك قد
أشار
إلى وجود خندقين، فهو يقول:
بـبـاب خـنـدقـيـن كـأن
أســداً شـوابـكـهـن يـحـمـين العرينـا([29])
ويقول ضرار بن الخطاب:
كـأنـهـم
إذا صــالــوا وصــلنا بـبـاب خـنـدقــين مصـافحونا([30])
وقال الفرزدق:
بـدر له
شاهد والشعب من أحد والخندقان ويوم الفتح قد علموا([31])
وذكر القمي:
أن
عدد الأبواب كان ثمانية([32])
«والخندق فيه قناة، يأتي
من عين قباء إلى النخل الذي بالسنح، حوالي مسجد الفتح.
وفي الخندق نخل
أيضاً.
وانطمَّ
أكثره،
وتهدمت حيطانه»([33]).
وذكروا أيضاً:
أنه
قد «بلغ طول الخندق نحواً
من خمس آلاف ذراع وعرضه تسعة
أذرع،
وعمقه سبعة
أذرع»([34]).
ونحن إذا راجعنا الواقع الجغرافي
للمدينة، فإنه يتضح:
أن
الخندق قد ضرب على المدينة في مواقع من الجهة الغربية والشمالية
أما
الجهة الشرقية والجنوبية فقد شبكت بالبنيان، ولم يخندق المسلمون عليها.
ولعل ذلك يرجع إلى
أن
المواقع التي تستوعب
ألوف
الفرسان، وتصلح
أن
تكون ساحة حرب ونزال هي المنطقة الواقعة بالقرب من ثنيات الوداع شمال
غرب المدينة حتى تنتهي بجبل أحد. وهي منطقة واسعة ومسطحة ومكشوفة،
وليست فيها عراقيل مهمة، وهي المنطقة التي حفر الخندق فيها.
أما سائر المناطق حول المدينة فلم تكن تصح لذلك، ولا
سيما بالنسبة لجيوش كبيرة تعد بالألوف،
من فرسان ورجالة، بالإضافة إلى ما يتبع هذه الجيوش من دواب وخيول تحمل
أزوادهم
وأمتعتهم،
وتحمل الرجالة منهم أيضاً في سفرهم الطويل.
ذلك لأن سائر المناطق حول المدينة كان فيها من الجبال
والأودية،
ومن التضاريس والأشجار
والحجارة ما يحد من قدرة تلك الجيوش الغازية على الحركة الفاعلة،
والمؤثرة، ويفقدها الكثير من الامتيازات الحربية، ويحرمها من الاحتفاظ
بزمام المبادرة، ويفوِّت
عليها نصراً
تطمع إلى تحقيقه.
ويوضح ذلك:
أنه
كانت توجد في الجهة الشرقية حرة واقم
وفي الجهة الغربية حرة الوبرة، وهي مناطق
وعرة
فيها صخور بركانية وتمثل حواجز طبيعية،
وكان في جهة الجنوب
أشجار
النخيل وغيرها بالإضافة إلى الأبنية
المتشابكة،
وكل ذلك لا يتيح لجيش المشركين
أن
يقوم بنشاط فاعل وقوي ضد المسلمين.
وحيث
إن
بعض المواضع في جهتي الشرق والجنوب كان يمثل النقطة الأضعف من غيرها،
الأمر الذي يحمل معه احتمالات حدوث تسلل تكتيكي للعدو، يهدف إلى
إرباك
الوضع العسكري والنفسي للمسلمين، فقد كان لا بد من سد تلك الثغرة، ورفع
النقص، وتفويت الفرصة على العدو، حتى لا يضطر المسلمون لتوزيع قواهم
وبعثرتها هنا وهناك بطريقة عشوائية، أو من شأنها
أن
تضعف فيهم درجة الصمود والتصدي في ساحة الصراع الحاسم في ميدان الكر
والفر الأول والأساس.
فكان
أن
بادر المسلمون إلى تشبيك المدينة بالبنيان وذلك في مواقع الضعف المشار
إليها. وهذه الإجراءات
كلها قد حالت دون استخدام قوات كبيرة في مهاجمة المدينة إلا من جهة
الخندق، وهي قد
أصبحت
مشلولة بسبب حفر الخندق تجاه العدو
فيها.
غير أن هذا الذي ذكرناه:
لا يعني
أن
يمر القادم من مكة على ثنية الوداع، وهي الجهة الشمالية للمدينة. فإن
طريق المسافرين، الذين تضمهم في الغالب قوافل صغيرة محدودة العدد، ليس
كطريق الجيوش الضخمة التي تضم ألوفاً كثيرة من الناس ومن وسائل النقل
المختلفة، حسبما
ألمحنا
إليه.
وبذلك يتضح:
أن
من الممكن
أن
نتفهم
أنه
لا مانع من
أن
تأتي
الجيوش إلى جهة ثنية الوداع من جهة الشام، ولكن المسافرين يأتون من
طريق آخر. ولا يمر القادم من مكة على ثنية الوداع ولا يراها، كما جاء
في النص التاريخي([35]).
يقول مصطفى طلاس:
«وبحفر الخندق استطاعت قيادة الجيش الإسلامي
أن
تعزل قوات العدو عن مكان التجمع الرئيسي للقوات المدافعة عن المدينة، وأن
تحول بينها وبين اقتحام مداخل المدينة، لأن هذه المداخل
أصبح
من الممكن حراستها بعد حفر الخندق.
وقد
أفادت
قوات الثورة الإسلامية من مناعة جبل سلع، الذي كان إلى يسارها وإلى
الخلف، كما
أفادت
من وعورة حرة الوبرة لحماية جناحها الأيسر،
ومن وعورة حرة واقم
لحماية
جناحها الأيمن،
ومن الحرة الجنوبية وجبل عسير لحماية المؤخرة»([36]).
وكان سائر المدينة مشبكاً
بالبنيان، شبكوها من كل ناحية، وهي كالحصن([37]).
قال في خلاصة الوفاء:
«كان أحد
جانبي المدينة عورة، وسائر جوانبها مشبكة بالبنيان والنخيل، لا يتمكن
العدو منها»([38]).
ثم
إنه
«صلى
الله عليه وآله»:
«اختار ذلك الجانب المكشوف للخندق،
وجعل معسكره تحت جبل سلع»([39]).
وبذلك يكون
«صلى
الله عليه وآله»:
قد سد الثغرات التي يمكن للعدو
أن
يتسلل منها ليحدث
إرباكاً
خطيراً
في معسكر المسلمين.
ثم جعل للخندق أبواباً، وجعل على الأبواب حرساً،
بطريقة تمنع من التسلل، ومن التواطؤ عليه كما سنرى.
ثم اختار الجانب المكشوف للخندق، وجعل معسكره تحت جبل
سلع، مستفيداً
منه كمانع طبيعي يصعب
على العدو اجتيازه لمهاجمة المسلمين.
وقال المؤرخون:
«وجعل
المسلمون يعملون مستعجلين، يبادرون قدوم العدو عليهم»([40]).
الأقوال في مدة حفر الخندق وهي التالية:
كان حفر الخندق:
ستة أيام
وحصنه([41]).
وقيل:
بضع عشر ليلة([42]).
وقيل:
شهراً أو قريباً من شهر.
قال البعض:
وهو
أثبت([43]).
ووقع عند موسى بن عقبة:
أنهم
أقاموا
في عمل الخندق قريباً من عشرين ليلة([44]).
وعند الواقدي:
أربعاً
وعشرين([45]).
وجزم النووي في الروضة:
أنهم
حفروه في خمسة عشر يوماً([46]).
وصرح القمي:
بأنه
«صلى الله عليه وآله» قد فرغ من حفر الخندق قبل قدوم قريش والأحزاب
بثلاثة أيام([47]).
ونقول:
إن الأرقام التي تقول:
إنهم
أقاموا
يعملون في الخندق عشرين يوماً
أو شهراً أو نحو ذلك، يبدو
أنها
بعيدة عن الصواب، لأن
المفروض
أن
ركب خزاعة قد خرج إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» بعد
أن
فصلت قريش من مكة إلى المدينة،
وبقي أربعاً
حتى وصل إليها، وأبلغ الرسول بالأمر..
ولنفترض:
أن
مسير قريش إلى المدينة قد استغرق أربع أضعاف الأربعة أيام المذكورة،
فتكون قد وصلت إلى المدينة خلال ستة عشر يوماً
فمع حذف الأربعة أيام الأولى لمسيرة ركب خزاعة فإنه
يبقى اثنا عشر يوماً تم حفر الخندق فيها، فكيف يقال:
إن
العمل في الخندق قد استمر عشرين أو أربعاً
وعشرين أو ثلاثين يوماً؟!
هذا..
ولكن يمكننا
أن
نخفي دهشتنا وإعجابنا
بهذا الإنجاز الضخم والسريع جداً، مع ملاحظة ضعف الوسائل والإمكانات
المتوفرة للعاملين في حفر الخندق آنئذٍ، بالإضافة إلى وجود المثبطين عن
العمل، كما سنرى.
فحيا الله هذه الهمم، وبورك لهم جهادهم المبارك والرائد
تحت قيادة وفي طاعة رسول الإسلام الأعظم والأكرم «صلى الله عليه وآله».
وقد اتضح من خلال النصوص المتوفرة لدينا:
أن
العدو وإن
كان قد فرض على النبي وعلى المسلمين معركة غير متكافئة من حيث العدد
والعدة،
واختار هو التوقيت لحشد جيوشه وتحزيب
أحزابه.
ولكنه بمجرد وصوله إلى المدينة:
فقد زمام المبادرة ليصبح في يد النبي والمسلمين بصورة
نهائية. فأصبح
«صلى الله عليه وآله» يتحكم بمسار الحرب، وهو يفرض على عدوه الموقع
الذي يريد، في هذا المكان أو في ذاك، ولا يملك عدوه
أية
وسيلة للتغيير في المواقع والمواضع فلا يمكنه
أن
يجر المسلمين إلى هذا الموقع أو إلى ذلك الموقع.
كما
أنه
«صلى الله عليه وآله» أصبح يتحكم بالزمام والتوقيت للحرب، ولا يستطيع
عدوه
أن
يهاجمه في وقت لا يرغب هو بدخول الحرب فيه.
ثم
إنه
«صلى الله عليه وآله» قد أصبح قادراً على اختيار الوسيلة الحربية التي
تلائمه، وتنسجم مع ظروفه وقد
أسقط
العتاد والعدة الحربية للعدو من الخيول وغيرها من الفاعلية المؤثرة وأصبحت
عبئاً
على العدو، لا بد
أن
يهيئ العدو لها ظروف بقائها وصيانتها من التلف في مصابرته على الحصار
الطويل، الذي كان يستنزف طاقته وصبره، حتى انتهى
الأمر به إلى هزيمة مخزية، كما سيتضح.
وهذه هي ثمرة التخطيط الواعي والمسؤول، وثمرة الإدراك
الواعي للواقع وللظروف المحيطة، التي كان لا بد من التعامل معها
والتغلب على سلبياتها، والاستفادة من
إيجابياتها
على
النحو
الأكمل
والأفضل
والأمثل.
([1])
الآية 14 من سورة النمل.
([2])
الآية 30 من سورة الأنفال.
([3])
لا ندري من أين فهموا: أنه كان يرى ذلك، ولو كان حقاً يرى ذلك
فلا ندري من أين فهموا أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان
يهم بالمقام في المدينة؟!.
([4])
راجع: المغازي للواقدي ج2 ص444 والإمتاع ج1 ص219 و 221 والسيرة
الحلبية ج2 ص311 وألمح إلى ذلك في: الثقات ج1 ص265 و 266
وراجع: سبل الهدى والرشاد ج4 ص514 و 515.
([5])
مناقب آل أبي طالب ج1 ص197 والإرشاد ص51 وكشف الغمة للأربلي ج1
ص202 والبحار ج20 ص251.
([6])
الخصال (باب السبعة) ج2 ص268 والبحار ج20 ص244 عنه.
([7])
راجع: وفاء الوفاء ج1 ص300 وج 4 ص1206 والثقات ج1 ص266
والتنبيه والإشراف ص216 وسيرة مغلطاي ص56 والكامل في التاريخ
ج2 ص178 والوفاء ص693 وتاريخ الخميس ج1 ص481 و 479 والروض
الأنف ج3 ص276 وشرح النهج للمعتزلي ج18 ص35 وأنساب الأشراف ج1
ص343 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص134 وج 1 ص198 وتاريخ الأمم
والملوك ج2 ص234 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص50 وفتح الباري ج7 ص301
وعيون الأثر ج2 ص57 والبحار ج20 ص251 و 218 و 197 وج 41 ص8.
ومجمع البيان ج8 ص340 ونهاية الأرب ج17 ص168 وتفسير القمي ج2
ص177 وإعلام الورى (ط دار المعرفة) ص99 والخرايج والجرايح ج1
ص152 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص3 وبهجة المحافل ج1 ص263
والسيرة الحلبية ج2 ص311 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص514 وحدائق
الأنوار ج2 ص515 والإرشاد للمفيد ص51 وزاد المعاد ج2 ص117
ومختصر التاريخ ص43 وحبيب السير ج1 ص359 وسعد السعود ص138.
([8])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج4 ص530 وتفسير القمي ج2 ص182 وبحار
الأنوار ج20 ص224 والمغازي للواقدي ج2 ص470 ونهاية الأرب ج17
= = ص173 وراجع: الإرشاد للمفيد ص52 وكشف الغمة للأربلي ج1
ص202 وإعلام الورى (ط دار المعرفة) ص100 وراجع: السيرة الحلبية
ج2 ص315. وتاريخ اليعقوبي ج2 ص50 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص5
وراجع: تاريخ الخميس ج1 ص484.
([9])
تجارب الأمم ج1 ص149.
([10])
البدء والتاريخ ج4 ص217 وراجع: إعلام الورى ص90.
([11])
راجع: تاريخ ابن الوردي ج1 ص160 والعبر وديوان المبتدأ والخبر
ج2 قسم 2 ص29 والبداية والنهاية ج4 ص95 والمختصر في أخبار
البشر ج1 ص134 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص182 و 183 وراجع
قول ابن هشام في السيرة النبوية ج3 ص235 وراجع: جوامع السيرة
النبوية ص150.
([12])
راجع: السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص226 وجوامع السيرة النبوية
ص148 وعيون الأثر ج2 ص55 وتهذيب سيرة ابن هشام ص189 ودلائل
النبوة للبيهقي ج3 ص399 عن ابن عقبة وص 409 والسيرة النبوية
لابن كثير ج3 ص182 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص234 وشرح
الأخبار ج1 ص292.
([13])
الإمتاع ج1 ص240 وخاتم النبيين ج2 ص942.
([14])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج4 ص530.
([15])
أمالي الشيخ الطوسي ج2 ص238 وتحف العقول ص138 و 292 وغرر الحكم
ج1 ص394 والبحار ج75 ص34 و 38 و 307 وج 2 ص17 و 96 و 97 ومواضع
أخرى منه. وراجع: دستور معالم الحكم ص19 والمجروحون ج1 ص105
والتراتيب الإدارية ج2 ص348.
([16])
راجع: التراتيب الإدارية ج2 ص75 وستأتي إن شاء الله بقية
المصادر في غزوة خيبر.
([17])
مسند أحمد بن حنبل ج1 ص247 وتاريخ الخميس ج1 ص395 والسيرة
الحلبية ج2 ص193 والروض الأنف ج3 ص84 والطبقات الكبرى ج2 ق1
ص14 والتراتيب الإدارية ج2 ص348 وج 1 ص48 و 49 عن السهيلي، وعن
المطالع النصرية في الأصول الخطية، لأبي الوفا نصر الهوريني،
وعن الإمتاع للمقريزي ص101.
([18])
تفسير القمي ج2 ص177 والبحار ج20 ص218.
([19])
الآية 13 من سورة الحجرات.
([20])
المغازي للواقدي ج2 ص450 ـ 452 وراجع: السيرة الحلبية ج2 ص312.
([21])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج4 ص515 والمغازي للواقدي ج2 ص445
والثقات ج1 ص266.
([22])
تفسير القمي ج2 ص177 وبحار الأنوار ج20 ص218 وقال الطبرسي في
مجمع البيان ج8 ص342 وعنه في بحار الأنوار ج20 ص203 «كان اسم
الموضع الذي حفر فيه الخندق: المذاد».
([23])
وفاء الوفاء ج4 ص1204 والفقرة الأخيرة ص1206 أيضاً وتاريخ
الخميس ج1 ص481 والعبارة الأخيرة في السيرة النبوية لدحلان ج2
ص3.
([24])
راجع: تاريخ الأمم والملوك ج2 ص235 ودلائل النبوة للبيهقي ج3
ص418 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص515.
([25])
وفاء الوفاء ج4 ص1205.
([27])
المغازي للواقدي ج2 ص452 وراجع: السيرة الحلبية ج2 ص312 وتاريخ
اليعقوبي ج2 ص50.
([28])
المصادر السابقة، وسبل الهدى والرشاد ج4 ص515.
([29])
سبل الهدى والرشاد ج4 ص554 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص267
ووفاء الوفاء ج4 ص1206.
([30])
السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص266.
([31])
مناقب آل أبي طالب ج4 ص174.
([32])
تفسير القمي ج2 ص179 وعنه في بحار الأنوار ج20 ص220.
([33])
وفاء الوفاء ج4 ص1204 وتاريخ الخميس ج1 ص481.
([34])
الرسول العربي وفن الحرب لمصطفى طلاس ص240 و 241 والسيرة
النبوية للندوي ص281.
([35])
راجع: وفاء الوفاء ج4 ص1172 و1170 وزاد المعاد ج3 ص10
والتراتيب الإدارية ج2 ص130.
([36])
مصطفى طلاس: الرسول العربي وفن الحرب ص234.
([37])
راجع: السيرة الحلبية ج2 ص315 ومغازي الواقدي ج2 ص450 وراجع
ص446 ووفاء الوفاء ج4 ص1205 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص524.
([38])
تاريخ الخميس ج1 ص481 وراجع: السيرة الحلبية ج2 ص315 ووفاء
الوفاء ج4 ص1206.
([39])
تاريخ الخميس ج1 ص481 والسيرة الحلبية ج2 ص315.
([40])
السيرة الحلبية ج2 ص411. والمغازي للواقدي ج2 ص445 وراجع:
الكامل في التاريخ ج2 ص178. وراجع البدء والتاريخ ج4 ص217.
وفتح الباري ج2 ص302.
([41])
المغازي للواقدي ج2 ص454 وسيرة مغلطاي ص56 والوفا ص693 وتاريخ
الخميس ج1 ص482 وحبيب السير ج1 ص360 والسيرة النبوية لدحلان ج2
ص4 وإمتاع الأسماع ج1 ص224 ونهاية الأرب ج17 ص170 وعيون الأثر
ج2 ص57 ووفاء الوفاء ج4 ص1204 و 1208 و 1209 و 1205.
([42])
السيرة الحلبية ج2 ص314 وعيون الأثر ج2 ص57 ووفاء الوفاء ج4
ص1209.
([43])
المصدر السابق ووفاء الوفاء ج4 ص1209 عن الهدى لابن القيم وكذا
في المواهب اللدنية ج1 ص111 وفتح الباري ج7 ص302.
([44])
المواهب اللدنية ج1 ص112 وتاريخ الخميس ج1 ص482 وعنه والسيرة
النبوية لدحلان ج2 ص4 وراجع: السيرة الحلبية ج2 ص314 ووفاء
الوفاء ج4 ص1208 راجع فتح الباري ج7 ص32.
([45])
المصادر السابقة وعيون الأثر ج2 ص57 ووفاء الوفاء ج1 ص1208 و
1209.
([46])
راجع: المصادر السابقة في الهامش ما قبل السابق.
([47])
تفسير القمي ج2 ص179 والبحار ج20 ص221.
|