|
من المدينة.. إلى عسفان
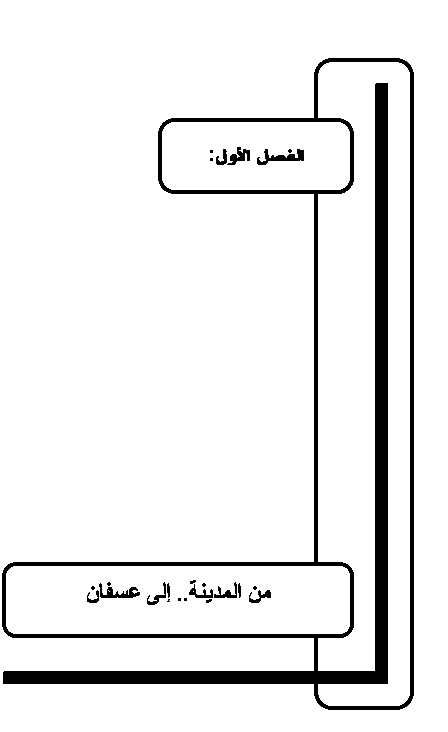
الحديبية:
اسماً
وموقعاً:
الحديبية بتخفيف الياء، تصغير حدباء، وهي اسم بئر أو
شجرة، سمي
باسمها المكان الذي تقع فيه، قرية قريبة من مكة، أكثرها واقع في الحرم،
وهناك المسجد المعروف بمسجد الشجرة، وبين الحديبية والمدينة تسع مراحل
وبينها وبين مكة مرحلة واحدة، أي تسعة أميال([1]).
ومجمل الحديث في أمر الحديبية:
أن النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» رأى في منامه:
أنه دخل مكة هو وأصحابه، آمنين، محلقين رؤوسهم، ومقصرين. وأنه دخل
البيت، وأخذ مفتاحه، وأدى عمرته، وعرَّف
مع المعرفين([2])
(أي جعل على الناس عرفاء).
فلما أخبر «صلى الله عليه وآله» أصحابه بما رأى فرحوا،
وظنوا أنهم يدخلون مكة في عامهم ذاك. ثم أخبرهم أنه يريد الخروج
للعمرة، فتجهزوا للسفر، واستنفر «صلى الله عليه وآله» العرب إلى ذلك
وأهل البوادي من الأعراب حول المدينة، من أَسْلَمَ: من غفار، وجهينة،
ومزينة، وأسلَمْ، ثم خرج «صلى الله عليه وآله» معتمراً.
وكان خروجه من منزله بعد أن اغتسل ببيته، ولبس ثوبين،
وركب راحلته القصوى من عند بابه، وأحرم هو وغالب من معه من ذي الحليفة،
بعد أن صلى ركعتين في المسجد هناك. وبعض أصحابه أحرم بالجحفة. ثم ركب
راحلته، من باب المسجد، وانبعثت به وهو مستقبل القبلة.
وكان خروجه «صلى الله عليه وآله» في ذي القعدة.
وقيل:
خرج في شهر رمضان.
وخرجت أم سلمة، وأم عمارة، وأم منيع، وأم عامر الأشهلية،
ومعه المهاجرون والأنصار، ومن لحق بهم من العرب، وأبطأ عنه كثير منهم
وسلك طريق البيداء.
وساق «صلى الله عليه وآله» معه الهدي، سبعين بدنة. وبعد
أن صلى الظهر في ذي الحليفة أشعر عدة منها، وهي موجهات إلى القبلة في
الشق الأيمن من سنامها. ثم أمر ناجية بن جندب (وفي معالم التنزيل:
ناجية بن عمير) فأشعر الباقي، وقلدهن، أي علق برقابهن كل واحدة نعلاً.
وأشعر المسلمون بدنهم، وقلدوها.
وكان الناس سبع مائة رجل.
وقيل:
ألفاً وأربع مئة.
وهناك أقوال أخر سوف نشير إليها إن شاء الله تعالى.
وسار حتى بلغ عسفان([3]).
وقبل أن نتابع الحديث عن هذا الحدث الكبير نلقي نظرة
على بعض الخصوصيات والأمور التي تذكر من بداية خروج النبي «صلى الله
عليه وآله» من المدينة إلى حين وصوله إلى عسفان.
فنقول:
وأول ما يواجهنا من ذلك هو دلالات هذا التحرك الجديد،
الذي يدلنا على الأمور التالية:
1 ـ
إن خروج النبي «صلى الله عليه وآله» محرماً، معظماً
للبيت، زائراً له، من شأنه أن يطمئن أهل مكة، ومن حولها إلى أنه «صلى
الله عليه وآله» لا يريد الحرب في تحركه هذا، وأن بإمكانهم أن يشعروا
بالأمن من هذه الجهة.
ولكن ذلك لا يمنع من أن يعتبر هذا التحرك في الوقت ذاته
تحدياً لزعماء الشرك، وإقداماً جريئاً، بل هو الغاية التي ما بعدها
غاية في الجرأة.. على أمرٍ يستبطن كسر عنفوان الشرك، وهو يدل على شعور
المسلمين بالقوة والعزة، إلى حد أنهم يقتحمون على عدوهم داره، ولا
يخشونه.
2 ـ
وفيه أيضاً تأكيد على حق الناس بمقدساتهم، وبممارسة عباداتهم بحرية
تامة، وفق ما يعتقدونه وحسبما ثبت لهم.
3 ـ
وفيه أيضاً إظهار لقريش على أنها باغية ومعتدية، وأنها لا تملك من
المنطق والحجة ما يبرر لها ذلك، بل حجتها في هذا البغي هو ما تتوسل به
من قوة وقهر، وما تمارسه من ظلم وعدوان..
4 ـ
والأهم من ذلك هو كسر هيبة الشرك والمشركين، وقريش بالذات في المنطقة
كلها، وإفساح المجال للناس للاعتقاد بأن بإمكانهم التفكير بعيداً عن
الضغوط التي يمارسها عليهم الآخرون، وأن بإمكانهم أن يختلفوا مع قريش
وأن يخالفوها إذا وجدوا الحق في خلافها.
5 ـ
إن الناس حين يشعرون بقوة هذا الدين، فإنهم إن لم يتجرأوا على الدخول
فيه، سوف تكون لهم الجرأة على الدخول في تحالفات معه، خصوصاً القبائل
القريبة من المدينة، وسيتريثون كثيراً في اتخاذ قرار التحالف مع
أعدائه، والدخول إلى جانبهم، في حروبهم ضده.
وقد ذكرت النصوص:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» رأى في المنام: أنه دخل مكة هو وأصحابه
آمنين، محلقين رؤوسهم، مقصرين، وأنه دخل البيت، وأخذ مفتاحه، الخ..
وقد تحققت رؤيا الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله»
ولكن في عام آخر وقد أشار القرآن إلى ذلك حين قال: ﴿لَقَدْ
صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ
الحَرَامَ إِن شَاء اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ
وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ
مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً﴾.
كما أن في القرآن حديثاً عن الرؤيا وعن تأويلها، في
أكثر من موضع. وذلك مثل: ما حكاه سبحانه عن رؤيا إبراهيم عليه وعلى
نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: أنه يذبح ولده إسماعيل وتأويلها.
ورؤيا يوسف أحد عشر كوكباً، والشمس والقمر وتأويلها.
ومن المعلوم:
أن رؤيا الأنبياء «عليهم السلام» هي طرائق الوحي الإلهي
إليهم.
وتحدث القرآن الكريم أيضاً:
عن رؤيا صاحبي السجن وتأويل يوسف الصديق «عليه السلام»
لها.
ورؤيا عزيز مصر ﴿سَبْعَ
بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاَتٍ
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ﴾..
ثم تأويل يوسف لهذه الرؤيا..
فالرؤيا وتأويلها، وارتباطها بالواقع الخارجي، أمر ثابت
لا مرية فيه، ولا شبهة تعتريه إذا كانت رؤيا من نبي أو وصي، وقد تصدق
وقد تكون أضغاث أحلام، إذا كانت من غيره.
نعم..
إن ذلك كله مما لا مجال لدفعه، ولا للنقاش فيه.. وفي
النصوص القرآنية، والنبوية، وكذلك ما روي عن الأئمة الطاهرين «عليهم
السلام»، الكثير مما يؤيده ويدل عليه..
وقد ذكروا:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان كثير الرؤيا.
ولا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح([4]).
وما ذلك إلا لأن الرؤيا هي من طرائق الوحي للأنبياء «عليهم السلام»،
حسبما تقدم.
والرؤيا هي من وسائل هداية البشر، وتذكيرهم بالله، وهي
رحمة إلهية لهم، ولأجل ذلك تجد أنه حتى الذي لا يبالي كثيراً بأمور
دينه يحدثك عن أنه رأى النبي «صلى الله عليه وآله»، أو رأى أحد الأئمة
الطاهرين «عليهم السلام»، أو رأى الجنة، أو النار، أو غير ذلك مما من
شأنه أن يذكِّره بالله، وبالآخرة.
كما أن الكثير من هؤلاء يتأثرون بما يرونه فيتوب بعضهم
إلى الله تعالى، ويؤوب إليه سبحانه، ويعيد النظر في حساباته.
وقد ورد في الأحاديث الشريفة ما يدل على ذلك أيضاً، فقد
روي عن الإمام أبي جعفر «عليه السلام»: أن الرؤيا الصالحة من البشارات
المقصودة في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ
آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الحَياةِ
الدُّنْيَا..﴾([5]).
وعن فائدة الرؤيا ودورها في هداية الناس، وفي تذكيرهم
نقول:
روي عن الصادق
«عليه
السلام»
أنه قال:
«إذا كان العبد على معصية الله عز وجل، وأراد الله به خيراً، أراه في
منامه رؤيا تروعه، فينزجر بها عن تلك المعصية، وإن الرؤية جزء من
سبعين جزءاً من النبوة»([6]).
ويدل على خصوصية التدبير الإلهي فيما يتعلق بارتباط
الرؤيا بالواقع، وصدقها تارة، وعدم صدقها أخرى ما روي عن الإمام الصادق
«عليه السلام» أنه قال للمفضل:
«فكر يا مفضل في الأحلام، كيف دبر الأمر فيها!! فمزج
صادقها بكاذبها؛ فإنها لو كانت كلها تصدق، لكان الناس كلهم أنبياء..
ولو كانت كلها تكذب لم يكن فيها منفعة، بل كانت فضلاً
لا معنى له.
فصارت تصدق أحياناً، فينتفع بها الناس في مصلحة يهتدى
لها، أو مضرة يتحذر منها. وتكذب كثيراً، لئلا يعتمد عليها كل الاعتماد»([7]).
وجاء في الحديث الذي ذكر قصة الحسن بن عبد الله، وأنه
اهتدى على يد أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، قوله:
«وكان قبل ذلك يرى الرؤيا الحسنة، وترى له، ثم انقطعت عنه الرؤيا. فرأى
ليلة أبا عبد الله «عليه السلام» فيما يرى النائم؛ فشكى إليه انقطاع
الرؤيا، فقال: لا تغتم، فإن المؤمن إذا رسخ في الإيمان رفع عنه الرؤيا»([8]).
وهذا يشير إلى أن الهداية إذا تمت لم يعد للرؤيا حاجة.
وهذا في غير ما يراه الأنبياء «عليهم السلام»، حيث إن
رؤياهم صلوات الله وسلامه عليه من طرائق الوحي إليهم، حسبما أشرنا
إليه.
عن الحسن بن عبد الرحمن، عن أبي
الحسن
«عليه
السلام»،
قال:
إن الأحلام لم تكن فيما مضى من أول الخلق، وإنما حدثت.
فقلت:
وما العلة في ذلك؟!
فقال:
إن الله عز ذكره بعث رسولاً إلى أهل زمانه، فدعاهم إلى عبادة الله
وطاعته.
فقالوا:
إن فعلنا كذا، فما لنا؟! فوالله، ما أنت بأكثرنا مالاً،
ولا بأعز عشيرة.
فقال:
إن أطعتموني أدخلكم الله الجنة، وإن عصيتموني أدخلكم
الله النار.
فقالوا:
وما الجنة؟ وما النار؟!
فوصف لهم ذلك، فقالوا:
متى نصير إلى ذلك؟!
فقال:
إذا متم.
فقالوا:
لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاماً ورفاتاً..
فازدادوا له تكذيباً، وبه استخفافاً.
فأحدث الله عز وجل فيهم الأحلام، فأتوه فأخبروه بما
رأوا، وما أنكروا من ذلك.
فقال:
إن الله عز وجل ذكره أراد أن يحتج عليكم بهذا. هكذا تكون أرواحكم إذا
متم، وإن بليت أبدانكم تصير الأرواح إلى عقاب حتى تبعث الأبدان([9]).
وآخر كلمة نقولها هنا هي:
أن الكثيرين ممن قد يظن ظان بأنهم قد عاشوا في بيئة
الانحراف، ولم يصل إلى مسامعهم النداء الإلهي، ولم يكن هناك من
يذكِّرهم بالله تعالى، ويخوِّفهم من عقابه، ويرشدهم إلى جزيل ثوابه،
ويعرِّفهم على فواضل نعمائه، وبديع صنعه، وباهر آياته وآلائه.. ويلفت
نظرهم إلى ألطافه ورحماته، ونعمه، وبركاته..
إن هؤلاء لا يمكن الجزم بأن الله تعالى لم يُرِهِم في
منامهم، أو في يقظتهم، ما يرشدهم إليه، ويدلهم عليه.. فإن لله الحجة
البالغة، والبراهين الساطعة، والآيات البينات، والدلالات الباهرات..
ولسنا بحاجة إلى التأكيد على:
أن من المعجزات الكبرى لرسول الله «صلى الله عليه وآله» هي رؤياه في
مناسبة الحديبية، التي كانت هي الإطلاقة القوية، وهي العامل الأعمق
تأثيراً في صناعة هذا الحدث الفريد، الذي غيَّر وجه التاريخ..
لقد بدأ النبي «صلى الله عليه وآله» كل إنجازه العظيم،
وكل عملية التغيير بهذه الرؤيا، التي أثرت على روحيات أصحابه
ومعنوياتهم، ونقلتهم إلى أجواء جديدة فيها الكثير من الصور الرائعة،
التي باتت تراود خواطرهم، ويحتاج الربط فيما بينها إلى نظام علاقات
تتبلور فيه خصائصها، وتنسجم فيه ميزاتها، وتتعانق ملامحها، وتتجاذب
أطياف السعادة آفاقها الرحبة..
وهذه الرؤيا بالذات، وطريقة تداولها، هي التي أربكت
حركة النفاق وفضحت المنافقين..
ووضعت إيمان أهل الإيمان على المحك، فنجح من نجح عن
جدارة واستحقاق.
وأخفق من أخفق عن تقصير، وعن قلة تدبير، وخطل رأي،
وخمول ضمير..
هذا بالإضافة إلى أن هذه الرؤيا قد جرَّت أهل الشرك
والكفر إلى مزالق خطيرة، لم يحسبوا لها حساباً، ووضعتهم في مواقع
الحيرة والتيه، حتى أظهر الله الحق، وأهل الحق. وفتح الله لنبيه فتحاً
مبيناً، فتح به القلوب، وأزال كل رين وريب منها وعنها، وكشف عن الأبصار
وعن البصائر كل الغشاوات، وبطلت الترهات، وفُضِحت الأضاليل، والأباطيل،
وأسفر الصبح لذي عينين.
فكانت هذه الرؤيا ـ المعجزة ـ هي الحجة البالغة،
والبرهان القاطع، والبلسم الشافي، ولله الحمد..
وعن الحركة العملية لرسول الله «صلى الله عليه وآله»
نقول:
1 ـ
إنهم يقولون: قد اغتسل رسول الله «صلى الله عليه وآله»
قبل الشروع في السفر، ولبس ثوبين، وركب راحلته من عند باب بيته..
ولعل هذه التصرفات التي لم تعهد منه في سائر أسفاره، هي
للتأكيد على أن هذا السفر يختلف عن غيره مما سبقه، فهو سفر له حرمته،
وله مراسمه الخاصة به، التي تتوافق مع حالة التعظيم والتقديس لبيت الله
عز وجل، من حيث إنه يمهد لإطلالة على واحة من العبادات الروحية بما
يناسبها من حركات، وتصرفات..
وقد ظهر من رؤياه التي أخبر بها أصحابه، ومن إعلانه
لوجهة سيره، أن الهدف هو أداء مراسم العمرة، ما يؤكد هذه الحقيقة،
ويزيل أي احتمال في أن تكون هناك أهداف قتالية، وعمليات حربية..
بل إن قوله في رؤياه:
إنه يعرِّف مع المعرِّفين، أي أنه يحضر عرفة، دليل قاطع
على أن المراد ليس هو العمرة، وإنما هو أداء مراسم الحج التي تتضمن
الوقوف بعرفات. وليس في العمرة ذلك.
فإخباره لهم:
أنه يريد العمرة دليل على أن هذا السفر ليس هو التعبير
لتلك الرؤيا التي أخبرهم بها. فما معنى امتناعهم عن الإحلال حينما
أمرهم بذلك؟! وما معنى استدلالهم عليه بتلك الرؤيا التي تضمنت إسقاط
دعواهم هذه بصورة دقيقة وصريحة؟!
وقد أكد هذه الأجواء أنه «صلى الله عليه وآله» قد أحرم
من ذي الحليفة، وصلى بالمسجد الذي بها ركعتين، وركب من باب المسجد
هناك، وانبعثت به راحلته، وهو مستقبل القبلة، وأشعر البدن هناك وهي
موجهات إلى القبلة، وقلدها، وكذلك فعل المسلمون معه.
فهذه الأجواء كلها تشير إلى أنه لا يريد حرب أحد، فإن
المحرم لا يحارِب.
2 ـ
وكل ذلك يجعل مشركي مكة أمام خيار صعب، ومحرج، فإن البيت للناس كلهم،
وهؤلاء القوم قد جاؤوا لزيارة بيت ربهم، فكيف يمكن دفعهم عنه، فضلاً عن
مواجهتهم بالحرب؟! بل كيف يمكن منعهم من تأدية مناسكهم، ولو من دون
قتال؟!
إن ذلك سيفضح قريشاً بين العرب، وسوف يقلل من مستوى
الثقة بها، وسيظهر المسلمين أنهم مظلومون وممنوعون من أبسط حقوقهم..
خصوصاً، وأن هذا الإجراء قد جاء في الأشهر الحرم التي
يمنع القتال فيها، من كل أحد. وقد كانت قريش بالذات بحاجة إلى هذه
الأشهر، من أجل مراجعة علاقاتها مع المحيط الذي تعيش فيه، ثم من أجل
تجاراتها في موسم الحج، والتأكيد على ارتباطاتها، وعلاقاتها وتحالفاتها
مع القبائل الوافدة.. ليكون لها بذلك بعض القوة في حربها مع محمد «صلى
الله عليه وآله» الذي لم يزل يسجل عليها النصر تلو النصر، ولم تزل تخسر
مواقعها لصالحه، وينحسر نفوذها عنها ليحتل رسول الله «صلى الله عليه
وآله» مواقع هذا النفوذ، ولكن دون أن تتمكن من انتزاع تلك المواقع منه،
لأنه يحتلها بالدين، وبالإيمان، ويكون التزام الناس معه من موقع
التقديس له، والطاعة لله
تعالى،
لا لأجل المصالح الفردية، والفئوية، أو القبلية، ولا لغير ذلك من غايات
دنيوية..
3 ـ
والأمرُّ والأدهى بالنسبة لقريش: أنه «صلى الله عليه وآله» قد جاءها
بجموع كثيرة من العباد، ومن مختلف القبائل، ومن كثير من البلاد،
ليكونوا شهوداً على ما تمارسه من ظلم واضطهاد ليس ضد النبي «صلى الله
عليه وآله» وحسب، وإنما ضد جميع الذين أتوا معه، لا لذنب أتوه إليها،
بل لمجرد أنهم يقولون: ربنا الله..
ويقولون:
إنه «صلى الله عليه وآله» قد استعمل على المدينة ابن أم
مكتوم.
وقيل:
أبا رهم، كلثوم بن الحصين.
وقيل:
نميلة بن عبد الله الليثي..
وقيل:
استعمل ابن أم مكتوم وأبا رهم جميعاً، فكان ابن أم
مكتوم على الصلاة، وكان أبو رهم حافظاً للمدينة([10]).
ونقول:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد استعمل ابن أم مكتوم
على المدينة عدة مرات.. مع أن هذا الرجل كان ضريراً. فاختيار هذا الرجل
الضرير بالذات يشير إلى أن كونه أعمى لا يسلب منه الأهلية للتصدي
للأمور حتى الحساسة منها، إذا كان فقد بصره، أو ابتلاؤه بأية عاهة
أخرى، لا يمنع من قيامه بما يوكل إليه من مهام. فما معنى تعطيل طاقاته،
وهدر قدراته لأجلها؟!
وربما يزيد هذا الأمر وضوحاً إذا كان قد تصدى ابن أم
مكتوم للصلاة وغيرها من شؤون الناس.. وأوكل أمر الحراسة والحفظ إلى أبي
رهم، فإنه لا يشترط سلامة النظر في إمامة الجماعة، ولا في تقريب وجهات
النظر لحل خلافات الناس..
والذي نلاحظه هنا:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد استنفر العرب، والأعراب
حول المدينة بما فيهم أسلم وغفار، وجهينة، ومزينة..
وقد حدثنا عكرمة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِمَّنْ
حَوْلَكُم مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ..﴾([11]).
أن المراد بهذه الآية:
جهينة، وأشجع، وأسلم، وغفار([12])
وزاد بعض المفسرين مزينة([13]).
وهذا هو ما قاله المفسرون أيضاً، وزاد الثعالبي على
هؤلاء:
مزينة، وعصية، ولحيان([14])
فإذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» قد دعا هذه
القبـائـل وغيرهـا للمشاركة معه في سفره ذاك، فإن ذلك يستبطن رفع مستوى
الأمن لسكان المدينة في مدة غيابه «صلى الله عليه وآله»، لأنه إذا كان
لكل تلك القبائل جماعات تحت سمع وبصر رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
فإن الذين يبقون في ديارهم منهم سوف لن يجرؤوا على مهاجمة المدينة، وهم
يعلمون أن طائفة من قبيلتهم عند رسول الله «صلى الله عليه وآله».
وتحرك المنافقين في غيابه «صلى الله عليه وآله» ليس
بالأمر المستبعد ففي غزوة تبوك اضطر النبي «صلى الله عليه وآله» إلى أن
يبقي علياً «عليه السلام» مكانه في المدينة خوفاً من أن يتحرك
المنافقون في غيبته حركة خطيرة على مستوى الأمن العام للمدينة وأهلها..
هذا كله.. لو فرضنا:
أن الذين رافقوا رسول الله «صلى الله عليه وآله» في
عمرته تلك هم خصوص الخلَّص من مؤمني تلك القبائل، أو خليطاً منهم ومن
المنافقين، أما إذا كان المنافقون هم الذين رافقوه «صلى الله عليه
وآله» لأسباب، ومطامع معينة، فإن احتمالات مهاجمة الباقين الذين هم في
الأكثر مؤمنون ستصبح ضئيلة، وبلا مبرر.
والنتيجة ـ على كلا الحالين ـ هي:
أن هذا التدبير النبوي كان على درجة كبيرة من الأهمية، والواقعية.
وسيكون من يتولى المدينة في غياب رسول الله «صلى الله
عليه وآله» غير مطالب بكثير من الجهد في الحراسة والحفظ..
ذكرت النصوص:
أن جماعات من الأعراب الذين كانوا حول المدينة، وكذلك
غيرهم قد تثاقلوا عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، خشيةً من قريش أن
يحاربوه، أو أن يصدوه عن البيت، كما صنعوا، وقالوا: أنذهب إلى قوم قد
غزوه في عقر داره بالمدينة، وقتلوا أصحابه، فنقاتلهم؟!
واعتلُّوا بالشغل بأهاليهم وأموالهم، وأنه ليس لهم من
يقوم بذلك. فأنزل الله تعالى تكذيبهم في اعتذارهم هذا، فقال: ﴿يَقُولُونَ
بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ..﴾
([15]).
وذكرت النصوص أيضاً:
أنه
«صلى الله عليه وآله» سلك طريق البيداء، ومر فيما بين
مكة والمدينة بالأعراب من بني بكر، ومزينة، وجهينة، فاستنفرهم فتشاغلوا
بأموالهم، وقالوا فيما بينهم: يريد محمد يغزو بنا إلى قوم معدين في
الكراع والسلاح، وإنما محمد وأصحابه أكلة جزور، لن يرجع محمد وأصحابه
من سفرهم هذا أبداً، قوم لا سلاح معهم ولا عدد([16]).
ونقول:
1 ـ
ظاهر كلامهم هذا: أنهم أناس يحبون أنفسهم، ويهتمون بمصالحهم، وأن
إيمانهم ليس خالصاً، ولا صحيحاً، لأنهم قد اتخذوا قرارهم بعدم المسير
مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» حين وجدوا أن أعداءه أقوياء إلى حد
أنهم غزوه في عقر داره، وقتلوا أصحابه..
2 ـ
إنهم قد صرحوا: بأن دعوة رسول الله «صلى الله عليه وآله» لهم للعمرة هي
في واقعها دعوة لهم للمشاركة في الحرب.
3 ـ
إنهم يريدون الإبقاء على خط الرجعة إلى التفاهم مع قريش، إن كانت هي
المنتصرة في نهاية الأمر، مع كونهم آمنين جانب المسلمين لإظهارهم: أنهم
على دينهم.
ولكن الله قد فضحهم بما أنزل من آيات تحكي قصتهم، وتشير
إلى مكرهم هذا، وتدل عليه، لكي لا يظنوا أنهم قد خدعوا الله ورسوله،
ولكنه سبحانه لم يوصل الأمور إلى نقطة اللاعودة، بل هو يبقي الباب
مفتوحاً، والمجال مفسوحاً أمامهم لإعادة النظر في حساباتهم، مقدماً لهم
بإخباراته الغيبية عما أسروه من تزوير وتدبير ماكر، الدليل المقنع لهم:
بأن هذا النبي «صلى الله عليه وآله»، متصل بالله العالم بالسرائر،
والواقف على ما في القلوب والضمائر، ليسهل عليهم أمر التوبة والعودة
إليه.
قالوا:
«وكان الناس سبع مائة رجل.
وقيل:
كانوا أربع عشرة مائة.
وقيل:
خمس عشرة.
وقيل:
ست عشرة.
وقيل:
كانوا ألفاً وثلاث مائة.
وقيل:
وأربع مائة.
وقيل:
وخمس مائة وخمسة وعشرين.
وقيل:
ألف وسبع مائة.
وقيل:
ألف وثمان مائة»([17]).
ونقول:
قد يقال:
إن الرواية القائلة: إن الذين ساروا معه كانوا سبع مائة رجل هي
الراجحة، فقد روى البخاري وغيره عن النبي «صلى الله عليه وآله» قوله:
«اكتبوا لي كل من تلفظ بالإسلام، فكتب حذيفة بن اليمان له ألفاً وخمس
مائة رجل».
وفي رواية:
ونحن ما بين الست مائة إلى السبع مائة.
قال الدماميني:
قيل: كان هذا عام الحديبية([18]).
وإنما رجحنا رواية السبع مائة، لأن
المفروض:
أن كثيراً من العرب وكذلك غيرهم من الأعراب حول المدينة، وكذلك جماعات
من أهل المدينة أنفسهم، لم يسيروا معه «صلى الله عليه وآله» في وجهه
ذاك، حسبما قدمناه..
مع ملاحظة:
أن كثيرين ممن أسلموا كانوا في أرض الحبشة آنئذٍ.
ومع ضرورة إبقاء جماعة قادرة على حراسة المدينة في
غيابه «صلى الله عليه وآله».
ويبقى أمام الباحث أمر هام, وهو أنه لا بد من اكتشاف
العناصر الأساسية, التي من خلالها انطلق القرار النبوي بدعوة الناس إلى
العمرة, والخروج من المدينة بمعظم العناصر القادرة على الحماية,
والمؤثرة في حسابات القوة والضعف, حتى خلت المدينة أمام الطامعين
والطامحين, والحاقدين والموتورين من قبائل الشرك في المنطقة..
وخلت أيضاً أمام يهود خيبر, الذين يبعدون عنها حوالي
ثمانين ميلاً, والذين قد يقال: إنهم كانوا قادرين على دخول الحرب مع
الإسلام والمسلمين بعشرة ألاف مقاتل, إن لم يكن من اليهود وحدهم, فمنهم
ومن القبائل المتحالفة معهم في المنطقة..
واليهود من أشد الناس حقداً على الإسلام, بعد أن رأوا
ما حل بإخوانهم بني النضير , وقينقاع, وقريظة..
فكيف أمكن أن يتخذ النبي
«صلى الله عليه وآله»
قراره بالخروج بأكثر المقاتلين إلى هذه المسافات البعيدة, وترك المدينة
في هذا المحيط المعادي, الذي يتربص بها الدوائر؟!.
ولعلنا نستطيع أن نجيب على هذه التساؤلات على النحو
التالي:
1 ـ
أما بالنسبة لقبائل العرب المحيطة بالمدينة فإن السرايا الكثيرة التي
حركها الرسول
«صلى الله عليه وآله»
قبل الحديبية مباشرة لضرب القوة المعادية, والمتآمرة والمتربصة بهم
شراً قد حسمت الأمور مع هؤلاء الأعداء, بصورة تامة.. وقد أضعفتهم وشلت
حركتهم من الناحية الاقتصادية.. وأرعبتهم, وأسقطت كبرياءهم، وجعلتهم
يعيشون حالة اليأس من إمكانية النيل من هذه القوة الضاربة, وأدركوا أن
التمادي في التصدي لها لا يفيد إلا تعريض أنفسهم للمزيد من النكبات,
والبلايا، والرزايا.
فالرأي الصواب هو:
أن ينأوا بأنفسهم عن التعرض لها، حتى حينما تخلو ربوعها من المقاتلين,
لأن مهاجمتهم للمدينة سوف يصاحبه تعرضهم لمن تبقَّى فيها من النساء,
والأطفال, وسبيهم, واستلاب أموالهم، ذلاً شاملاً، وعقاباً صارماً
وحازماً, لا طاقة لأحد به،
فقد عوَّدهم
المسلمون:
أنهم يلاحقون من يعتدي عليهم، وينزلون به القصاص العادل
ولا يستطيع أن يفوتهم في كل زمان ومكان..
2 ـ
وأما بالنسبة لليهود فالأمر لا يختلف عن ذلك أيضاً..
وقد جرب إخوانهم من بني النضير، وقينقاع وقريظة، نقض
العهود، والتحدي والتعدي على المسلمين, فنزلت بهم الضربات الماحقة
والساحقة, في مرات ثلاث، كانت كل واحدة أقسى عليهم من سابقتها..
ولا يزال يهود خيبر, وتيماء وغيرهما يعيشون الهلع من أن
يكون مصيرهم هو نفس مصير أولئك.. وقد نبههم رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
بصورة قوية وحاسمة حينما جربوا القيام بخطوات عملية تؤدي إلى توجيه
ضرباتهم للمسلمين, فقد أنزل المسلمون ضربتهم القاضية بزعمائهم
الغادرين, الذين تصدوا لهذا الأمر.. فقتلوا أبا رافع سلام بن أبي
الحقيق وأسير بن رزام.. وغيرهما ممن تقدم الحديث عنهم في هذا الكتاب.
3 ـ
ومن جهة أخرى, فإن التجارب قد أظهرت لهم: أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
لا يترك لهم ولا لغيرهم ثغرة ينفذون منها تمكنهم من الإيقاع بالمسلمين
بسهولـة, بـل هو
يراعي أدق التفاصيـل,
ولا يهمـل
الاحتيـاط
لأي طارئ.
وأظهرت الوقائع في بدر, وأُحد,
والخندق وغيرها:
كيف تحول ما كان يراه الناس يتعرض للبوار والدمار، والفناء
المحتم,
إلى نصر مؤزر، وفتح مبين، ومدهش.
من أجل ذلك كله:
فإنهم
كانوا
غير مستعدين للمغامرة معه, بل لا بد من حساب الأمور
بدقة, ولا بد لهم من رصد خططه «صلى الله عليه وآله»,
حتى لا
تنتهي الأمور
إلى
مفاجآت
ماحقة
لهم..
كما أن عليهم أن يعرفوا:
أن القوة الضاربة والمقاتلة لم يصبها أي وهن أو ضعف، بل هي لو عرفت
أنهم قد اعتدوا على من خلَّفوه من نساء وأطفال وأموال، سوف يتضاعف
اندفاعها وحماستها لإنزال أقسى الضربات بهم. وقد رأى الناس من هذا
الجيش العجائب في الحالات العادية، فكيف إذا تطورت الأمور على هذا
النحو المثير.
وذلك كله يوضح:
أن
لا خوف على المدينة من
أحد
في غياب رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
حتى لو استمرت غيبته
شهراً، أو
شهرين
أو
أكثر..
فلا معنى لخوف الأعراب، ولا معنى لأن يتصوروا أن محمداً وأصحابه اكلة
جزور لقريش، وأنه لن يرجع هو وأصحابه من سفره هذا إلا إذا كان ثمة من
يبث الشائعات، ويخوف الناس لمصلحة قريش.
لقد اعتقد كثير من المنافقين:
أنه ليس من مصلحتهم أن يكونوا مع النبي «صلى الله عليه وآله» في سفره
ذاك, لأن ظواهر الأمور تشير إلى:
أن مشركي مكة لن يمكِّنوا
رسول الله «صلى الله عليه وآله» من دخول مكة, وأن الحرب واقعة بينهم
وبين المسلمين لا محالة.. وليس من مصلحتهم
تعريض أنفسهم لأخطار جسام في مناطق بعيدة عن بلادهم؛ لأن الدائرة ستدور
على المسلمين. من أجل ذلك صاروا يتعللون بأعذار واهية تتعلق بأشغالهم،
وبأموالهم، وأهليهم..
ولكن بعضهم قد خرج مع رسول الله «صلى الله عليه وآله»
في ذلك السفر ربما اعتماداً على علاقاته بمشركي مكة, وإحساسه بالأمن من
جهتهم، لو أنهم انتصروا في الحرب.. مع شعوره بضرورة الحضور؛ لأن زعامته
وموقعه لا يسمحان له بالتخلف، ويجعلانه محرجاً أمام أقرانه، وأمام رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، وربما لغير ذلك من أسباب..
قالوا:
«ولم يكن مع المسلمين سلاح إلا السيوف في القُرُب.
والسيوف هي سلاح المسافر، وقال عمر بن الخطاب:
أتخشى يا رسول الله من أبي سفيان وأصحابه، ولم تأخذ
للحرب عدتها؟!
فقال
«صلى
الله عليه وآله»:
لست أحب أن أحمل السلاح معتمراً. وكان معهم مائتا فرس»([19]).
وذكر الطبري:
أنه لما خرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالهدي، وانتهى إلى ذي
الحليفة (وهو موضع مسجد الشجرة، حيث يحرم أهل المدينة، يقع على بعد ستة
أميال من مسجد النبي «صلى الله عليه وآله») قال عمر: يا رسول الله،
تدخل على قوم هم لك حرب بغير سلاح ولا كراع؟
قال:
فبعث النبي «صلى الله عليه وآله» إلى المدينة، فلم يدع
فيها كراعاً ولا سلاحاً إلا حمله، فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل الخ..
ثم ذكر:
أنه «صلى الله عليه وآله» أرسل خالداً إلى عكرمة، فحاربه فهزمه حتى
أدخله حيطان مكة([20]).
ونقول:
أولاً:
إن هذا الكلام غير صحيح لأن خالداً لم يكن قد أسلم
حينئذٍ بل كان لا يزال على الكفر، ويحارب مع أهل مكة، ويقود جيوشهم.
وكان طليعة خيل المشركين ومعه مائتا فارس في الحديبية([21]).
ثانياً:
قد صرحت النصوص: بأن النبي «صلى الله عليه وآله» لم
يأخذ معه من السلاح إلا السيوف في القرب([22])،
وهي سلاح المسافر.
ونقول أيضاً:
1 ـ
إن من الواضح: أن ما يقوله وما يفعله رسول الله «صلى
الله عليه وآله» حجة ودليل على الأحكام، وعلى السياسات، وعلى
الاعتقادات، وعلى المفاهيم، وعلى كل ما يمكن استفادته منه بطرق
الاستفادة والدلالة التي يرضاها العقلاء بما هم عقلاء. ولم تزل
البيانات الإلهية والنبوية تتوالى وتؤكد قولاً وعملاً على أن للبيت
حرمته، ولمكة شرفها، ومكانتها.
وهذا بالذات هو ما يفسر لنا قوله «صلى الله عليه وآله»
لعمر بن الخطاب، حين سأله عن ذلك: لست أحب أن أحمل السلاح معتمراً..
ولو أنه «صلى الله عليه وآله» قد أبدى أي تسامح في هذا
الأمر ـ ولو بإظهار السلاح في حال اعتماره ـ لوجدت الظلمة والطغاة لا
يكتفون بحمل السلاح، وإخافة الناس، وإنما هم يسفكون الدم الحرام،
ويستحلون البلد الحرام في الشهر الحرام!! بسبب، وبدون سبب!!
2 ـ
إن اللافت هنا: هو مطالبة عمر بن الخطاب نبي الرحمة
بإشهار سلاحه، والاستعداد للحرب، في حين أننا لم نجد غيره قد طالب بمثل
ذلك.. فهل خاف عمر على نفسه من بطش قريش؟!
أم أنه رأى أن عدم الاستعداد للحرب يخالف طريقة العقلاء
الذين يحتاطون في مثل هذه المواقف؟! فأراد أن يعرف إن كان للنبي «صلى
الله عليه وآله» تدبير آخر، يستطيع أن يدفع به غائلة قريش، ويحبط
مساعيها العدوانية؟!
أو أنه اعتقد:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان غافلاً حقاً عن هذا الأمر الخطير،
فأراد أن يوجه نظره إليه، ليعدَّ للحرب عدتها قبل فوات الأوان، وقبل أن
يحدث ما لم يكن بالحسبان؟!
أو أنه احتمل أن في الأمر سراً، وأن الأمور تسير وفق
تدبير غيبي ومعجزة إلهية.. فأراد أن يطمئن إلى واقعية هذا الاحتمال..
إننا نترك تحديد ما هو الراجح من هذه الاحتمالات إلى
القارئ الكريم الذي سوف يختار ما يتوافق مع ما عرفه في هذا الرجل من
خصائص، ومن طبائع، وسمات.
وقالوا:
إنه «صلى الله عليه وآله» بعث من ذي الحليفة عيناً له
من خزاعة، يقال له: بسر بن سفين، يخبره عن قريش([23]).
وجعل عباد بن بشر في عشرين راكباً من المهاجرين والأنصار طليعة له([24]).
وقد كان بسر بن سفين حديث عهد بالإسلام؛ لأنه أسلم في
شوال، فاختاره عيناً لأن من رآه لا يظن به ذلك لعدم اشتهار إسلامه.
والاستفادة من العيون والأرصاد لمعرفة تحركات العدو،
والتحرز من أن يأخذهم العدو على حين غفلة هو مقتضى الحزم والحكمة.
وأما جعل الطلائع، فللأمن من غائلة الكمائن، من أجل أن
تُشاغل الطليعة ذلك الكمين، حتى إذا بلغ الخبر الجيش، فإنه يتأهب
لمعالجة الموقف، بالقوة اللازمة، والخطة المناسبة..
وفي بعض المحال أقبلوا نحو رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، وكان بين يديه ركوة يتوضأ منها، فقال: ما لكم؟!
قالوا:
يا رسول الله، ليس عندنا ماء نشربه، ولا ماء نتوضأ منه
إلا ما في ركوتك.
فوضع رسول الله «صلى الله عليه وآله» يده في الركوة.
فجعل الماء يفور من بين أصابعه الشريفة أمثال العيون([25]).
قال جابر:
فشربنا، وتوضأنا، ولو كنا مائة
ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة([26]).
وقالوا:
«وإنما لم يخرجه «صلى الله عليه وآله» بغير ملابسة ماء
في إناء، تأدباً مع الله تعالى؛ لأنه المنفرد بابتداع المعدومات من غير
أصل»([27]).
ونقول:
إن إظهار الكرامة الإلهية لرسول الله «صلى الله عليه
وآله»، ليس أمراً عشوائياً، بحيث يكون بمناسبة وبلا مناسبة.. بل هو أمر
هادف، يراد منه أيضاً الربط على القلوب، وصيانة الإيمان من التعرض
للاهتزاز في مواجهة التحديات الكبرى، والكوارث والأزمات الحادة، التي
تتمخض عن نكبات تزعزع وتزلزل، وتبعث اليأس والهزيمة في النفوس.
ثم يراد منه أيضاً:
إزالة الشبهة، في حين تحجز المحاذير المختلفة عن
التصريح ببعض الحيثيات والغايات لبعض المواقف، بسبب حساسية الظرف تارة،
ولتلافي سوء استفادة الأعداء من ذلك أخرى، وربما يكون ذلك بسبب عدم
توفر المستوى المطلوب من الوعي، وعدم توفر حسن تقدير الأمور، والعجز عن
التدقيق في مناشئها وفي غاياتها، وإدراك ذلك وتوظيفه في حركة الواقع
بصورة سليمة وقويمة..
فلا يبقى ثمة من وسيلة تحفظ للمؤمنين إيمانهم، حين
تختلط عليهم الأمور، سوى أن يتلمسوا بوجدانهم، ويشعروا بكل وجودهم، وأن
يحسوا بكل قواهم الباطنية، ويشاهدوا بأم أعينهم حقيقة اللطف الإلهي،
والكرامة الربانية لرسول الله «صلى الله عليه وآله» ليكون هذا الارتباط
بالغيب عن طريق الحواس الظاهرية هو الضمانة لحفظ التوازن في الباطن،
بعد أن عجزت عقولهم عن الإمساك بأسباب هذا التوازن، بسبب فقدها لبعض ما
يفيدها في ذلك..
وقد كانت الأمور في غزوة الحديبية ـ بما تفرضه
الخصوصيات والأحوال ـ تتجه نحو اتخاذ قرار يصعب فهمه على الكثيرين،
ويصعب أيضاً توضيح مناشئه وغاياته ونتائجه. كما أن أصحاب الأهواء
والأغراض الدنيئة، وخصوصاً من أهل النفاق، قد يجدونها فرصة سانحة
لإشاعة شبهاتهم، ونشر أباطيلهم، بنحو يصعب رتق الفتق الذي قد يتمكنون
من إحداثه، بسبب استغلالهم السيئ لظرف صعب ودقيق.
وقد أظهرت الوقائع:
أنه حتى الذين يزعمون أنهم في مواقع القرب من موقع
القرار قد أعلنوا تشكيكاً خطيراً، حين كان الرسول «صلى الله عليه وآله»
يكتب الكتاب في الحديبية حسبما سيأتي توضيحه.. فكانت هناك سياسات إلهية
دقيقة تقضي بحفظ وحدة الناس، وترسيخ إيمانهم، وتقوية يقينهم، وقد بدأت
بإخبار الناس بأمر الرؤيا التي رآها رسول الله «صلى الله عليه وآله»
فيما يرتبط بدخوله مع أصحابه مكة على النحو الذي وصفه لهم.
ولكن كانت هناك أمور أيضاً لابد من إبقائها على حالة من
الغموض، ليمكن الوصول إلى أفضل النتائج، وحفظ مستوى الاندفاع لدى
أصحابه «صلى الله عليه وآله» ومن جاء معه، وإثارة أجواء تتسم بالقوة
والتفاؤل فيما بينهم، وكذلك إثارة أجواء صعبة، وحساسة لدى مشركي قريش،
تختلط فيها الحيرة بالدهشة، مع إثارة جو من الإبهام والغموض، الذي لا
يسمح لقريش بالكثير من المناورة والحركة..
ومن هذه الأمور:
أن لا يخبرهم في بداية الأمر بأن الذي رآه سوف لا يتحقق
في مسيره ذاك، بل هو سيتحقق في وقت لاحق..
وطبيعي أن يكون لظهور هذا التأجيل في تحقق الرؤيا
لأصحابه وقعاً غير عادي، قد لا يمكنهم معه حفظ ذلك المستوى من الصفاء
والاندفاع، والحيوية، والسكينة والطمأنينة، التي تمكنهم من متـابعة
الموقف بقوة وفاعليـة. مع ملاحظة: أنه لا توجد أية مصلحة في كشف كل
الحقيقة لهم، بل قد يكون ضرر ذلك عظيماً وجسيماً.
فكان لا بد من تدخل الغيب الإلهي، والسعي إلى تجسيده
لهم، لكي يتلمسوه ويحسوا به بوجدانهم، ومشاعرهم، وبكل كيانهم ووجودهم،
ليكون هو الحافظ والحامي لهم، من تسويلات نفوسهم، ومن وسوسات الشياطين،
ومن كيد المنافقين.
فكان نبع الماء من بين أصابعه الشريفة هو أحد مفردات
ربطهم بذلك الغيب كما هو ظاهر.
وذكروا:
أنه «صلى الله عليه وآله» قدم الهدي. وسار، فلقي في طريقه طائفة من بني
نهد، فدعاهم إلى الإسلام، فأبوا. وأهدوا له لبناً من نعمهم.
فقال:
لا أقبل هدية مشرك.
فابتاعه المسلمون منهم([28]).
ونقول:
قد تقدمت الإشارة:
إلى هذا الأمر في الفصل الذي تحدثنا فيه عن أبي طالب رضوان الله تعالى
عليه..
ونعود فنذكر القارئ هنا:
بأنه «صلى الله عليه وآله» قد عاش في كنف عبد المطلب أولاً، ثم في كنف
أبي طالب، وقد كان لهما الأيادي البيضاء عليه «صلى الله عليه وآله»..
فلولا أنهما كانا على رأس أهل الإيمان في زمانهما لم يجعل الله تعالى
لهما نعمة عند النبي «صلى الله عليه وآله»، تستحق الجزاء منه «صلى الله
عليه وآله».
والذي يثير العجب هنا:
أنه رغم كون أبي بكر مسلماً، ورغم كون النبي «صلى الله عليه وآله» يقبل
الهدية من المسلم، فإنه لم يقبل الناقة من أبي بكر في ليلة الهجرة إلا
بالثمن، مع أنه «صلى الله عليه وآله» كان بأمس الحاجة إليها، ليتمكن من
النجاة عليها من كيد قريش.
فهل كان «صلى الله عليه وآله» يخشى من أن يمنَّ عليه
أبو بكر بهذا العطاء؟!..
أم أنه قد أشفق على أبي بكر أن يرزأه شيئاً من ماله؟!..
أم أنه وجد في هذا المال شبهة، فأراد أن يتحرز من
الارتطام بها؟!
أم أن للقضية منحى آخر، لا بد من صـرف النظر عن
إظهـاره، والتدقيق في البحث عنه؟!..
لا ندري، غير أننا نقول:
إننا لسنا بحاجة إلى أن ننتظر المزيد من الدلالات
والإشارات إلى واقع الأمر لكي ندري!!
وحين التقى النبي «صلى الله عليه وآله» ببني نهد، ابتاع
المسلمون منهم ـ كما زعموا ـ ثلاثة أضُبّ، فأكل منها قوم قبل أن
يحرموا، وأما المحرمون، فسألوا رسول الله «صلى الله عليه وآله»
عنها، فقال:
«كلوا، فكل صيد البر لكم حلال في الإحرام، تأكلونه، إلا
ما صدتم، أو صيد لكم»([29]).
ونقول:
أولاً:
إن الرواية قد صرحت: بأنه «صلى الله عليه وآله» قد أباح
لهم أن يأكلوا ما سألوه عنه، معللاً ذلك بأن أكل صيد البر حلال في
الإحرام، إلا ما صادوه أو صيد لهم..
ولكن يجب أن يكون مفهوماً:
أن في الرواية درجة الإبهام، إذ ليس فيها تصريح بما
أباح لهم أكله.. بل جاء الجواب في كلامه «صلى الله عليه وآله» تابعاً
للسؤال، ولم يذكر في الرواية أية صيغة للسؤال المطروح.
فإن كانوا قد قالوا له:
هل يجوز لنا أن نأكل الضب ونحن محرمون؟ فإن الجواب يكون
هو أن أكل الضب مباح حال الإحرام..
وإن كانوا قد قالوا:
هل يجوز لنا أكل الصيد حال الإحرام؟ فالجواب يكون
بإباحة ذلك لهم.
والمناسب لطبيعة الحال هو السؤال الثاني؛ لأنهم إنما
يشكُّون في جواز أكل الصيد حال الإحرام، سواء أكان ضباً أم غيره، فليس
لخصوصية كونه ضباً أية مدخلية في شكهم هذا، بل الإحرام هو السبب في
شكهم بجواز أكل ما يصطاد لهم. ولأجل ذلك جاء الجواب موافقاً لهذه
الحقيقة، حيث قال: كل صيد البر لكم حلال في الإحرام، إلا ما صدتم أو
صيد لكم..
ويشهد لذلك قوله:
«كل صيد البر لكم حلال» فإن المقصود حلية الصيد الذي
يكون جامعاً لشرائط الحلية في نفسه، إذ لا إشكال في عدم حلية أكل لحم
الخنزير، حتى لو اصطاده المحلون منهم.
ثانياً:
روى مسلم، عن ابن عباس، قال: أهدت خالتي أم حفيد إلى
رسول الله «صلى الله عليه وآله» سمناً، وأقطاً، وأضباً، فأكل من السمن
والأقط، وترك الضب تقذراً الخ..
([30]).
فإذا كانت قذارة الضب إلى هذا الحد، فإن ذلك يجعله من
الخبائث التي لا يجوز أكلها..
خصوصاً إذا علمنا:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» حين أُخْبِر بأن ما يهم
بمدِّ يده إليه، هو ضب؛ رفع يده، ولم يأكل.
وقد
زعموا:
أنه سئل عن ذلك، فقال: لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه([31]).
ولأجل ذلك قالوا:
إن من يقول بحرمته يقول: كان هذا (يعني عدم التحريم)
قبل نزول قوله تعالى: ﴿..وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الخَبَآئِثَ..﴾
والضب من جملته، لأنه «صلى الله عليه وآله» كان يستقذره([32]).
ثالثاً:
قد رووا أيضاً عن جابر، قال: أتي رسول الله «صلى الله
عليه وآله» بضب، فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري، لعله من القرون التي
مسخت([33]).
وعن أبي سعيد الخدري، قال:
قال رجل: يا رسول الله، إنا بأرض مَضَبَّة، فما تأمرنا؟
أو فما تفتينا؟
قال
«صلى
الله عليه وآله»:
ذُكر لي: أن أمَّةً من بني إسرائيل مسخت.
فلم يأمر، ولم ينه.
قال أبو سعيد:
فلما كان بعد ذلك قال عمر: إن الله عز وجل لينفع به غير
واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه
رسول الله «صلى الله عليه وآله»([34]).
وسأل عنه أعرابي النبي «صلى الله عليه وآله» مرتين، فلم
يجبه، وأجابه في الثالثة، فقال: يا أعرابي، إن الله لعن، أو غضب على
سبط من بني إسرائيل، فمسخهم دواب، يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا
منها، فلست آكلها، ولا أنهى عنها([35]).
وعن ثابت بن وديعة، قال:
أُتي النبي «صلى الله عليه وآله» بضب، فقال: أمة مسخت([36]).
وفي توضيح ذلك نقول:
ألف:
إنه يستوقفنا هنا زعمهم: أن النبي «صلى الله عليه وآله»
قال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت.. فإننا لا نشك في كونه كلاماً
محرفاً؛ لأن النبي «صلى الله عليه وآله» معصوم عن النسيان، وعن القول
بغير علم.. ولم يكن الله تعالى ليحجب عن نبيه علماً ينفعه، أو تحتاج
الأمة إلى معرفة حكمه، فلا معنى لما يذكرونه من إحجامه «صلى الله عليه
وآله» عن الأمر والنهي، استناداً إلى عدم معرفته بالحقيقة. ولا معنى
لاعترافه بالجهل في أمر يحتاج الناس إلى معرفة حكمه، وتحديد الموقف
منه.
ب:
إننا نستطيع أن نقول: إن المسوخ، وإن كانت لا تعيش أكثر
من ثلاثة أيام، بعد مسخها، ولكن المهم هو أن تلك المخلوقات التي مسخت
على صورتها، يراعى في أحكامها هذه الحقيقة، ومن ذلك عدم جواز أكلها.
ج:
وعن المسخ على صورة الضب نقول: روي عن النبي «صلى الله
عليه وآله»: أن رجلاً من الأعراب كانت خيمته على ظهر الطريق، وكان
إذا
مرت به قافلة تسأله عن الطريق إلى مقصدها، يرشدها إلى
خلاف ذلك المقصد، فإن أراد القوم المشرق ردهم إلى المغرب، وإن أرادوا
المغرب ردهم إلى المشرق،
وتركهم يهيمون([37]).
وهذا يناسب ما يقال عن الضب من أنه لا يهتدي لجحره،
ويضرب في تحيره المثل.. وقد كان الرجل الممسوخ لا يرشد الناس إلى
طريقهم، ويشير عليهم بما يحيرهم، ويتركهم يهيمون.
د:
وأخيراً.. فإن الرواية التي ذكرناها قد ذكرت عن عمر بن
الخطاب: أنه كان يصر على تحليل أكل الضب، وإقناع الناس بذلك، وتذليل
الصعوبات أمامهم فيه.
ولعل رغبته هذه هي التي دعت الآخرين إلى ترجيح فتوى
التحليل، والتخفيف من حدة دلالة النصوص المانعة، والله هو العالم.
والرجوع إلى أهل البيت «عليهم السلام» في مثل هذه
الأمور، وفي كل الأمور هو الصحيح، وهو المتعَيِّن، فإن أهل بيت النبوة
أدرى، والاتباع لهم أصوب وأحرى.
ورووا:
أنه أهدي لرسول الله «صلى الله عليه وآله» حمار وحشي وهو بالأبواء، أو
بودَّان، فرده على صاحبه، فلما رأى ما في وجهه، قال: إنَّا لم نرده
عليك إلا أنَّا حرم([38]).
وأهدى بعض الأعراب من ودان:
معيشاً، وعتراً، وضغابيس، فجعل «صلى الله عليه وآله» يأكل الضغابيس
والعتر، وأعجبه، وأدخل على أم سلمة منه الخ..([39]).
ونقول:
إن كان المراد بالضغابيس هو صغار الثعالب، فلا شك في
عدم صحة هذه الرواية؛ لأن أكل الثعلب حرام.
وإن كان المراد بها الضبع، أو أية دابة أخرى يحرم أكلها
فكذلك.
وأما إن كان المراد بها صغار القثاء([40])،
أو غيره من النباتات التي تؤكل، فلا إشكال..
وأما العتر، فإن كان المراد به الذبيحة، فإن الذابح إذا
كان مشركاً، فلا يجوز الأكل من ذبيحته أيضاً..
علي
 ساقي العطاشى في الجحفة:
ساقي العطاشى في الجحفة:
قال الشيخ المفيد:
روى إبراهيم بن عمر، عن رجاله، عن فايد مولى عبد الله بن سالم، قال:
لما خرج رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
في عمرة الحديبية نزل الجحفة، فلم يجد بها ماء، فبعث سعد بن مالك
بالروايا، حتى إذا كان غير بعيد رجع سعد بالروايا، فقال: يا رسول الله،
ما أستطيع أن أمضي، لقد وقفت قدماي رعباً من القوم!
فقال له النبي
«عليه
وآله السلام»:
اجلس.
ثم بعث رجلاً آخر، فخرج بالروايا حتى إذا كان بالمكان
الذي انتهى إليه الأول رجع، فقال له النبي
«عليه
السلام»:
«لم
رجعت»؟.
فقال:
والذي بعثك بالحق، ما استطعت أن أمضي رعباً.
فدعا رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات
الله عليهما فأرسله بالروايا، وخرج السقاة وهم لا يشكون في رجوعه، لما
رأوا من رجوع من تقدمه.
فخرج علي
«عليه
السلام»
بالروايا حتى ورد الحرار([41])
فاستقى، ثم أقبل بها إلى النبي
«صلى الله عليه وآله»
ولها زجل([42]).
فكبر النبي
«صلى الله عليه وآله»
ودعا له بخير»([43]).
ونقول:
1 ـ
إن هذين الرجلين اللذين أرسلهما النبي
«صلى الله عليه وآله»
بالروايا لم يثبتا أمام هواجس الخوف التي انتابتهما، ولم يلقيا بالاً،
ولا أعارا اهتماماً لكل تلك المعجزات التي أظهرها لهم رسول الله
«صلى الله عليه وآله»..
حيث يفترض أن يدفعهما التفكر فيها، والتفاعل معها إلى خوض اللجج، وبذل
المهج في سبيل تحقيق ما رغب إليهما النبي الكريم
«صلى الله عليه وآله»
في تحقيقه، فكانت نفساهما أحب إليهما من الله ورسوله، وجهاد في سبيله.
وكان علي «عليه السلام» على العكس منهما، قوياً في ذات
الله، مؤثراً رضا الله ورسوله على كل ما في هذه الدنيا من زبارج
وبهارج.
2 ـ
إن هذه الحادثة تذكِّرنا بما جرى بعد ذلك في خيبر،
حينما ذهب الرجلان ـ أبو بكر أولاً، وعمر ثانياً ـ بأمر الرسول «صلى
الله عليه وآله» لمناجزة اليهود، ثم رجعا منهزمين مع من كان معهما،
يجبن بعضهم بعضاً.
ويذكِّرنا أيضاً:
بما جرى قبل ذلك في بني قريظة، حيث ذهب نفس الرجلين
أيضاً ـ أعني أبا بكر وعمر ـ لمناجزة اليهود، ثم رجعا مع من كان معهما
منهزمين، يجبن بعضهم بعضاً.
3 ـ
وإن كتمان اسم الرجل الثاني الذي أرسله «صلى الله عليه
وآله» بالروايا، ورجع خائفاً منهزماً بأوهامه وهواجسه، يثير فضولنا،
وتأخذنا الاحتمالات والظنون فيه يميناً وشمالاً.. خصوصاً مع ما عرفناه
وألفناه من تستر هؤلاء القوم على أسماء من يحبونهم، حين يجدون أن
التصريح بها يضر بسمعتهم وبمكانتهم.
قالوا:
ولما بلغ رسول الله «صلى الله عليه وآله» الجحفة أمر
بشجرة، فقمَّ ما تحتها، فخطب الناس، فقال: «إني كائن لكم فرطاً، وقد
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبداً: كتاب الله، وسنة نبيه»([44]).
ونقول:
إن كان هذا هو حديث الثقلين الشائع والذائع، الذي أحرج
أهل السنة، فأخرجهم عن جادة الإنصاف والاعتدال، فهو النص المحرف له، أو
هو نص آخر، يشبهه، زعموا: أنه هو، من أجل إبطال الحق، وتأييد الباطل.
فخاب فألهم، وطاش كلمهم. وتوضيح هذا الأمر يحتاج إلى بعض التفصيل، الذي
لا مجال له في سياق كهذا، غير أننا نقول:
الظاهر:
أن كلمة «الثقلين»
هي بفتح الثاء المشددة والقاف بعدها.
قال ابن حجر الهيثمي:
«سمى رسول الله «صلى الله عليه وآله» القرآن وعترته
ثَقَلين، لأن الثَّقَل كل نفيس خطير مصون. وهذان كذلك، إذ كل منهما
معدن العلوم الدينية، والأسرار والحكم العلية، والأحكام الشرعية؛ ولذا
حث رسول الله «صلى الله عليه وآله» على الاقتداء والتمسك بهما، والتعلم
منهما.
وقيل:
سميا ثِقْلين، لثقل وجوب رعايتهما»([45]).
أو رعاية حقوقهما، قال الشريف الرضي
في المجازات النبوية:
تسمية الكتاب والعترة بالثقلين، وواحدهما ثقل، وهو متاع المسافر الذي
يصحبه إذا رحل، ويسترفق به إذا نزل، فأقام عليه الصلاة والسلام الكتاب
والعترة مقام رفيقيه في السفر، ورفاقه في الحضر، وجعلهما بمنزلة المتاع
الذي يخلفه بعد وفاته([46]).
إنه لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، والحكم بأنها هي
حديث الثقلين المعروف وهي رواية: «كتاب الله، وسنة نبيه» بل المعتمد
عند جهابذة العلم والرواية هو حديث الثقلين المروي بأسانيد صحيحة، وله
نصوص متقاربة، منها ما ورد في صحيح مسلم، من أنه «صلى الله عليه وآله»
قال في غدير خم:
«يوشك أن يأتي رسول ربي، فأجيب. وإني تارك فيكم
الثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، خذوا بكتاب الله
واستمسكوا به ـ فحث على كتاب الله ورغب فيه ـ ثم قال: وأهل بيتي.
أذكِّركم الله في أهل بيتي، أذكِّركم الله في أهل بيتي الخ..» أو نحو
ذلك([47]).
وقد ذكر السخاوي:
أن حديث الثقلين هذا مروي عن:
1 ـ
أبي سعيد الخدري.
2 ـ
زيد بن أرقم.
3 ـ
جابر.
4 ـ
حذيفة بن أسيد الغفاري.
5 ـ
خزيمة بن ثابت.
6 ـ
سهل بن سعد.
7 ـ
ضميرة.
8 ـ
عامر بن أبي ليلى.
9 ـ
عبد الرحمن بن عوف.
10 ـ
عبد الله بن عباس.
11 ـ
عبد الله بن عمر.
12 ـ
عدي بن حاتم.
13 ـ
عقبة بن عامر.
14 ـ
علي «عليه السلام».
15 ـ
أبي ذر.
16 ـ
أبي رافع.
17 ـ
أبي شريح الخزاعي.
18 ـ
أبي قدامة الأنصاري.
19 ـ
أبي هريرة.
20 ـ
أبي الهيثم بن التيهان.
21 ـ
أم سلمة.
22 ـ
أم هاني بنت أبي طالب.
23 ـ
رجال من قريش([48]).
وقد زاد صاحب العبقات على ما تقدم؛ الأسماء التالية:
24 ـ
الحسن بن علي «عليه السلام».
25 ـ
سلمان الفارسي (المحمدي).
26 ـ
حذيفة بن اليمان.
27 ـ
زيد بن ثابت.
28 ـ
عبد الله بن حنطب
29 ـ
جبير بن مطعم
30 ـ
البراء بن عازب
31 ـ
أنس بن مالك
32 ـ
طلحة بن عبيد الله
33 ـ
سعد بن أبي وقاص
34 ـ
عمرو بن العاص
35 ـ
سهل بن سعد
36 ـ
أبا أيوب الأنصاري
37 ـ
فاطمة الزهراء «صلوات الله وسلامه عليها»
38 ـ
أبا ليلى الأنصاري([49]).
وقد صرحوا:
بأن النبي «صلى الله عليه وآله» قد قال هذا القول في
مواطن عديدة، فقد قاله في عرفة في حجة الوداع، وقاله في المدينة في
مرضه الذي توفي فيه. وقاله في غدير خم، وقاله بعد انصرافه من الطائف([50]).
وقد صرحوا:
بأنه مروي عن نيف وثلاثين صحابياً([51]).
وقد ظهر مما تقدم:
أنه مروي عن ما يقرب من أربعين.
وقد اعتبر ابن حجر الهيثمي الحديث المروي عن ثمانية من
الصحابة متواتراً([52])،
فكيف إذا كان مروياً عن ثمانية وثلاثين صحابياً؟! أو أكثر حسبما
ذكرناه؟
إن من الواضح:
أن حديث: «كتاب
الله وعترتي»
متواتر.
وأما حديث:
«وسنتي»
فليس كذلك، فلو كانا متعارضين لوجب تقديم المتواتر.
على أن حديث «كتاب
الله وعترتي»
لا ينافي حديث «وسنتي»..
بل هما حديثان مستقلان لا يضر أحدهما بالآخر، ولو سلمنا ارتباطهما فهو
ارتباط لا يضر، حيث يكون أحدهما موضحاً، أو مقيداً للآخر، ويكون
المعنى:
أن سنة الرسول «صلى الله عليه وآله» التي يوصي بها هي
التي تنقلها العترة، وهي التي تحفظ من الضلال؛ لأن العترة معصومة عن
الخطأ والسهو والنسيان، وعن كل نقص وعيب وخلاف..
أما السنة التي يأتي بها أمثال:
أبي هريرة أو سمرة بن جندب، أو كعب الأحبار، أو عمرو بن
العاص، أو معاوية وأضرابهم، فلا يؤمن عليها من أن تكون قد تعرضت
للتحريف، أو التزييف..
فيكون في هذين الحديثين دلالة على الحجة، وعلى طريق
ثبوتها..
1 ـ
وحديث الثقلين نفسه يدل على عصمة العترة «عليهم السلام»، لأنه «صلى
الله عليه وآله» جعلها عدلاً للقرآن، في كون التمسك بها يوجب الأمن من
الضلال، فلو كانوا «عليهم السلام» يسهون، أو يخطئون، أو ينسون، أو
يكذبون ـ والعياذ بالله ـ أو يحتمل ذلك في حقهم لم يكن التمسك بهم من
موجبات الأمن من الضلال عن الحق..
2 ـ
قد أكد هذا الحديث أن هذه العصمة لهم ثابتة ومستمرة إلى
حين الورود على الحوض، وهو يدل على بقائهم في موقع الهداية للأمة ما
دامت الدنيا باقية، وذلك إنما يكون ببقائهم فيها بصورة فعلية، وعلى قيد
الحياة، تماماً كما هو الحال بالنسبة لبقاء القرآن..
3 ـ
إن هذا لا يكون إلا ببقاء إمامتهم وحضورهم.. وليكن هذا أحد الإرشادات
إلى حياة الإمام المهدي «عليه السلام» إلى أن يرث الأرض ومن عليها.
قال الهيثمي:
«في أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل
منهم للتمسك إلى يوم القيامة. كما أن الكتاب العزيز كذلك»([53]).
4 ـ
يضاف إلى ذلك: أنه لو جاز عليهم الخطأ لفارقوا القرآن، مع أن هذا
الحديث يقول: إنهما لن يفترقا حتى يردا على النبي «صلى الله عليه وآله»
الحوض..
5 ـ
إن التعبير بأن القرآن والعترة لن يفترقا.. يعطي: أن القرآن يكون مع
العترة ويصدقهم، ولا يكون مع غيرهم في مقابلهم أبداً، وأنه لا يتضمن أي
شيء يخالف أقوالهم، وأفعالهم، كما أنهم هم أيضاً لا يفارقون القرآن..
وهذا معناه:
أن القرآن والسنة يحتاجان إلى حافظ ومبين، يشرحهما، ويبين ناسخهما من
منسوخهما، والمحكم من المتشابه فيهما، ويكشف عن غوامضهما، وينفي
تحريفات المبطلين عنهما..
6 ـ
لو كان الرجوع إلى الكتاب والسنة من دون رجوع للعترة يحفظ الأمة من
الضلال، لم يختلف الناس بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولم
يتفرقوا إلى عشرات الفرق، ولم يختلفوا في أحكامهم واعتقاداتهم و.. و..
الخ..
كما أنه لو كان الرجوع إلى الكتاب والسنة من دون العترة
كافياً، لم يبق معنى لقوله تعالى: ﴿..فَاسْأَلُواْ
أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾([54])
فإنه إذا وجب السؤال، وجاء الجواب، فلا بد من الأخذ به، والعمل على
طبقه، وهذا يستلزم ثبوت العصمة للمسؤول، إذ لولا ذلك لجاز أن يخطئ في
الإجابة، ولا معنى لإيجاب الأخذ بالخطأ، ولا لإيجاب العمل به..
ومن الواضح:
أن المقصود بالعترة ليس جميع أقارب رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، بل المراد بهم قد بيَّنه «صلى الله عليه وآله» بقوله: «وعترتي
أهل بيتي»
كما صرحت به النصوص الكثيرة لحديث الثقلين.
وذلك يشير:
إلى ما ورد في آية التطهير، التي أثبتنا أن المراد بأهل البيت «عليهم
السلام» فيها هم: «أهل
بيت النبوة»
وقد دل حديث الكساء، وحديث الأئمة بعدي اثنا عشر وغيرهما، على أنهم:
فاطمة، وعلي، والحسنان.. ثم الأئمة التسعة من ذرية الحسين «عليهم
السلام»، فراجع كتابنا: «أهل
البيت في آية التطهير».
وأخيراً:
فقد قال السمهودي: «وهذا الخبر يفهم منه وجود من يكون أهلاً للتمسك من
أهل البيت والعترة الطاهرين في كل زمان»([55]).
وقد ذكر العلامة الوشنوي كلاماً يفيد في توضيح هذا
المعنى فراجع([56]).
([1])
الإستبصار ج2 ص177 ومعجم البلدان ج2 ص229.
([2])
راجع: تفسير مجاهد ج2 ص603 ومعاني القرآن ج6 ص511 وسبل الهدى
والرشاد ج5 ص33.
([3])
السيرة الحلبية ج3 ص9 و 10
وتاريخ الخميس ج2 ص16 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص321 و
322 والبداية والنهاية ج4 ص175 وطبقات ابن سعد ج2 ص72 والمنتظم
ج3 ص267 والكامل في التاريخ ج2 ص86 والمغازي للواقدي ج2 ص517
وتاريخ الأمم والملوك للطبري ج2 ص270 وشرح المواهب للزرقاني ج3
ص169 وجوامع السيرة النبوية لابن حزم ص164 والإكتفاء ج2 ص233.
وراجع: العبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 قسم2 ص34وتاريخ الإسلام
للذهبي (المغازي) (ط سنة 1410 هـ) ص364 و 365 والبدء والتاريخ
ج4 ص224 وعيون الأثر (ط سنة 1406 هـ) ج2 ص113 و 114 والسيرة
النبوية لدحلان (ط سنة1415 هـ) ج1 ص481 وسبل الهدى والرشاد ج5
ص33 و 34، وراجع: النص والإجتهاد ص166 ومسند أحمد ج4 ص323
والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص235 وصحيح ابن خزيمة ج4 ص290 وشرح
معاني الآثار ج4 ص174 والمعجم الكبير ج20 ص16 ونصب الراية ج4
ص238 وجامع البيان ج26 ص124 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج4
ص200 و 209 وتاريخ خليفة بن خياط ص48 وأسد الغابة ج2 ص93
والإصابة ج1 ص425 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص313.
([4])
البحار ج58 ص182 وج18 ص195 و 227 وج70 ص103 ومكارم الأخلاق
ص292 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص42 والنص والإجتهاد ص420 ومستدرك
سفينة البحار ج4 ص21 وأضواء على الصحيحين ص242 ومسند أحمد ج6
ص153 و 232 وعن صحيح البخاري ج1 ص3 وج6 ص87 وج8 ص67 وعن صحيح
مسلم ج1 ص97 والمستدرك للحاكم ج3 ص183 والسنن الكبرى للبيهقي
ج9 ص6 وشرح صحيح مسلم للنووي ج2 ص197 وفتح الباري ج12 ص318
والديباج على مسلم ج1 ص182 ومسند أبي داود الطيالسي ص207
والمصنف للصنعاني ج5 ص321 ومسند ابن راهويه ج2 ص314 وراجع كتاب
الأوائل لابن أبي حاتم ص88 والذرية الطاهرة النبوية ص34 وأسباب
نزول الآيات ص5 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج20 ص118 وتفسير
القرآن العظيم لابن كثير ج3 ص25 وج4 ص564 والدر المنثور ج6
ص368 والثقات ج1 ص49 وأسد الغابة ج1 ص18 وج5 ص436 وتذكرة
الحفاظ للذهبي ج3 ص1117 وسير أعلام النبـلاء ج17 ص630
والبـدايـة والنهايـة ج3 ص5 و 7 و 9 و 142 وج4 ص258 والعبر
وديوان المبتدأ والخبر ج1 ص476 وج2 ق2 ص6 والعدد = = القوية
ص341 وعن عيون الأثر ج1 ص114 والسيرة النبوية لابن كثير ج1
ص385 و 387 و 404 وج2 ص106 وج3 ص429 وسبل الهدى والرشاد ج1 ص15
و 16 وج2 ص228 و 232.
([5])
البحار ج58 ص152 وراجع: مجمع البيان ج5 ص120.
([6])
الإختصاص ص241 وهناك نصوص مختلفة ومتنوعة دلت على ذلك فراجع:
البحار ج58 ص167 إلى آخر ذلك الفصل.
([7])
البحار ج58 ص183 وج3 ص85 وتوحيد المفضل ص43 وراجع: مستدرك
سفينة البحار ج2 ص84 وج4 ص19.
([8])
البحار ج58 ص189 وج48 ص53 وبصائر الدرجات ص275.
([9])
البحار ج58 ص189 و 190 وج6 ص243 وج14 ص485 والكافي ج8 ص90 وشرح
أصول الكافي ج11 ص474 وتفسير نور الثقلين ج2 ص410 وقصص
الأنبياء للجزائري ص515.
([10])
راجع: السيرة الحلبية ج3 ص9 والسيرة النبوية لدحلان (ط سنة
1415 هـ) ج1 ص181 وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ج3 ص172 وسبل
الهدى والرشاد ج5 ص33.
([11])
الآية 101 من سورة التوبة.
([12])
الدر المنثور ج3 ص271 عن ابن المنذر وتفسير النسفي ج2 ص142
والسراج المنير للشربيني ج1 ص646 والبحار ج22 ص41 وتفسير مجمع
البيان ج5 ص114 وتفسير جوامع الجامع ج2 ص91 وتفسير الثعالبي ج3
ص208 وفتح القدير ج2 ص401، وورد ذلك أيضاً في: أسباب النزول
للواقدي ص174 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج8 ص240، وقال
المعتزلي في شرح النهج: وليست هذه الآية عامة في كل الأعراب بل
خاصة ببعضهم وهم جهينة وأسلم، وأشجع، وغفار، فراجع: ج13 ص181.
([13])
جوامع الجامع ج1 ص627 والجامع لأحكام القرآن ج8 ص240 وتفسير
أبي السعود ج4 ص97 وروح البيان ج3 ص493 ومجمع البيان ج5 ص66
وراجع: فتح القدير ج2 ص398 و 401 عن عكرمة، بإضافة مزينة،
والبحار ج22 ص41 وتفسير مجمع البيان ج5 ص114 وأسباب نزول
الآيات ص174 والدر المنثور ج3 ص271 وتفسير الثعالبي ج3 ص208.
([14])
تفسير الثعالبي ج2 ص150.
([15])
السيرة الحلبية ج3 ص9.
([16])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص34 وموسوعة التاريخ الإسلامي ج2 ص602.
([17])
السيرة الحلبية ج3 ص9 وتاريخ الخميس ج2 ص16 والسيرة النبوية
لابن هشام ج3 ص322 والمواهب اللدنية (ط دار الكتب العلمية) ج1
ص266 و 267 وجوامع السيرة النبوية لابن حزم ص164 والمنتظم ج3
ص167 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) (ط سنة 1410 هـ) ص364 و
365 و 366 والبدء والتاريخ ج4 ص224 وعيون الأثر (ط سنة 1406
هـ) ج2 ص114 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص321 و 313 والسيرة
النبوية لدحلان (ط سنة 1415 هـ) ج1 ص481 و 482 وتاريخ الأمم
والملوك ج2 ص171 وشرح المواهب للزرقاني ج3 ص169 ـ 173 وسبل
الهدى والرشاد ج9 ص70 و 71 ومسألتان في النص على علي ج2 ص24
ومسند أحمد ج4 ص323 و 48 و 290 وصحيح ابن خزيمة ج4 ص290 و 291
وج1 ص66 وشرح معاني الآثار ج4 ص174 ونصب الراية ج4 ص238 وجامع
البيان ج26 ص124 وتفسير
القرآن العظيم لابن كثير ج4 ص197 و 200 و 209 والدر المنثور ج6
ص244 و 68 والبداية والنهاية ج4 ص188 و 194 و 195 وعن صحيح
البخاري ج4 ص170 وج5 ص62 و 63 وعن صحيح مسلم ج5 ص190 وج6 ص25
والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص235 وج6 ص326 وج9 ص223 وعن فتح
الباري ج6 ص467 وج7 ص339 وج10 ص88 وصحيح ابن حبان ج11 ص127
وج14 ص479 ودلائل النبوة ص120 والطبقات الكـبرى ج1 ص179 وج2
ص99 و 100 وتـاريـخ خليفة بن خيـاط ص48 = = و 49 والشفا بتعريف
حقوق المصطفى ج1 ص286 و 288 والمصنف لابن أبي شيبة ج8 ص512
وتأويل مختلف الحديث ص219 ودلائل النبوة ص121 ونظم درر السمطين
ص71 وكنز العمال ج12 ص367 وتاريخ مدينة دمشق ج36 ص436.
([18])
راجع: صحيح البخاري ج2 ص116 وصحيح مسلم ج1 ص91 ومسند أحمد ج5
ص384 وسنن ابن ماجة ج2 ص1337 والتراتيب الإدارية ج2 ص251 و 252
وج1 ص220 ـ 223 وعن المصنف لابن أبي شيبة ج15 ص69.
([19])
السيرة الحلبية ج3 ص9 وشرح المواهب للزرقاني ج3 ص173.
([20])
تاريخ الأمم والملوك ج2 ص272.
([21])
الإصابة ج1 ص417 وصحيح البخاري وجميع المصادر التي ذكرناها في
الهامش الأول في هذا الفصل، وكذلك المصادر التي ستأتي في
الفصول التالية. وراجع أيضاً: سبل الهدى والرشاد ج5 ص36.
([22])
راجع جميع المصادر التي تحدثت عن غزوة الحديبية.
([23])
تاريخ الخميس ج2 ص16 والمواهب اللدنية (ط دار الكتب العلمية)
ج1 ص267 وتاريخ الإسلام للذهبي ص366 والسيرة النبوية لدحلان ج1
ص482 وشرح المواهب للزرقاني ج3 ص174 وسبل الهدى والرشاد ج5
ص34.
([24])
تاريخ الخميس ج2 ص16
والمنتظم ج3 ص267 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص34.
([25])
السيرة الحلبية ج3 ص9 وعيون الأثر (ط سنة 1406 هـ) ج2 ص114.
([26])
السيرة الحلبية ج3 ص10 وعيون الأثر ج2 ص114.
([27])
السيرة الحلبية ج3 ص10.
([28])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص34.
([29])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص34.
([30])
صحيح مسلم ج6 ص69 وراجع:
سنن ابن ماجة (مطبوع بحاشية السندي) ج2 ص296 و 297 وراجع: صحيح
البخاري (ط المكتبة الثقافية) ج9 ص197.
([31])
راجع: صحيح مسلم ج6 ص68 وسنن الدارمي ج2 ص128 وعن البخاري (ط
المكتبة الثقافية) ج7 ص176 وص129، كتاب الصيد والذبائح باب 33
والموطأ كتاب الإستئذان، وأحمد في مسنده، والنسائي، وأبي داود.
([32])
حاشية السندي على سنن ابن ماجة ج2 ص297.
([33])
صحيح مسلم ج6 ص70 وراجع:
سنن ابن ماجة (بحاشية السندي) ج2 ص296.
([34])
صحيح مسلم ج6 ص70 وراجع:
سنن ابن ماجة (بحاشية السندي) ج2 ص297.
([36])
سنن الدارمي ج2 ص27 وفي هامشه عن أبي داود، والنسائي، وأحمد،
والبيهقي.
([37])
البحار ج62 ص227 عن الإختصاص.
([38])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص35 وعن البخاري ج4 ص31 رقم 1825 و 2573
وعن صحيح مسلم ج2 ص850 والنسائي، ومالك، والترمذي.
([39])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص35.
([40])
ترتيب القاموس ج3 ص28.
([41])
الحرار: جمع حرة، وهي أرض ذات أحجار سود نخرة. الصحاح ج2 ص626.
([42])
الزجل: رفع الصوت الطرب. لسان العرب ج11 ص302.
([43])
الإرشاد للمفيد (ط مؤسسة
آل البيت) ج1 ص121 و 122 والبحار ج20 ص359 وموسوعة التاريخ
الإسلامي ج2 ص623 وكشف الغمة ج1 ص210 والإصابة ج3 ص199 ومناقب
آل أبي طالب ج2 ص88 وكشف اليقين ص139.
([44])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص36 وفي هامشه عن البخاري ج4 ص12 وعن
صحيح مسلم ج2 ص861 والحديث في الموطأ (بشرح السيوطي) ج2 ص208
كتاب القدر والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص603 وفيض القدير ج3
ص340 ومستدرك الحاكم ج1 ص93 وتنبيه الغافلين ص43 وميزان
الإعتدال ج2 ص302 والكامل ج4 ص69 والضعفاء للعقيلي ج2 ص251
والعلل ج1 ص9 وكمال الدين ص235 والبحار ج23 ص132 وكنز العمال
ج1 ص173 ـ 187 والجامع الصغير ج1 ص505 و 506 والسنن الكبرى
للبيهقي ج10 ص114 والجامع لأخلاق الرواة ج1 ص166 وسنن
الدارقطني ج4 ص160 والعهود المحمدية ص635 وطبقات المحدثين
بإصبهان ج4 ص68 وعن تاريخ الأمم والملوك للطبري ج2 ص403 وذكر
أخبار إصبهان ج1 ص103 والعبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون
ج2 ق2 ص59.
([45])
الصواعق المحرقة ص226 و 227 وراجع تيسير الوصول.
([46])
المجازات النبوية ص218.
([47])
صحيح مسلم ج7 ص123 وتيسير
الوصول ج1 ص16 والنهاية في اللغة لابن الأثير ج3 ص177 والصواعق
المحرقة، والجامع الصحيح للترمذي ج5 ص621 و 622 والطرائف ص114
ـ 122 ومسند أحمد ج5 ص182 و 189 و 190 وج4 ص371 و 366 وج3 ص17
و 26 و 14 و 59 ومستدرك الحاكم ج3 ص148 و 110 و 109 و 533
وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه) والدر المنثور ج2 ص60
والمعجم الكبير ج5 ص186 و 187 وج3 ص63 و 66 ونوادر الأصول ص68
وكنز العمال (ط أولى) ج1 ص48 وتهذيب الكمال ج10 ص51 وتحفة
الأشراف ج2 ص278 ومشكاة المصابيح ج3 ص258 وسنن الدارمي ج2 ص310
والسنة لابن أبي عاصم ص629 و 630 والسنن الكبرى ج2 ص148
ومصابيح السنة ج2 ص205 والبداية والنهاية ج5 ص206 و 209 وج7 ص9
وكشف الأستار عن زوائد البزار ج3 ص221 وسمط النجوم العوالي ج2
ص502 وتهذيب اللغة للأزهري ج9 ص78 ولسان العرب ج4 ص538 ومجمع
الزوائد ج9 ص156 و 163 وترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ
دمشق (بتحقيق المحمودي) ج1ص45 وعن السيرة الحلبية ج3 ص308 ونظم
درر السمطين ص231 و 232 والمنهاج في شرح صحيح مسلم ج15 ص180
وفيض القدير ج3 ص14 وشرح المواهب اللدنية ج7 ص5 و 8 والمرقاة
في شرح المشكاة ج5 ص600 ونسيم الرياض في شرح الشفاء ج3 ص410
وعن أشعة اللمعات في شرح المشكاة ج4 ص677 وذخائر العقبى ص16
وغرائب القرآن ج1 ص347 والفصول المهمة لابن الصباغ ص24
والخصائص للنسائي ص30 وكفاية الطالب ص11 و 130 والطبقات الكبرى
ج2 ص194 وأسد الغابة ج2 ص12 وج3 ص147 وحلية الأولياء ج1 ص355
وتذكرة الخواص ص332 والعقد الفريد والسراج المنير في شرح
الجامع الصغير ج1 ص321 وشرح الشفاء = = للقاري (مطبوع بهامش
نسيم الرياض) ج3 ص410 ومنتخب كنز العمال (مطبوع مع مسند أحمد)
ج1 ص96 و 101 وج2 ص390 وج5 ص95 وعن تفسير الرازي ج3 ص18 وعن
تفسير النيسابوري ج1 ص349 وتفسير الخازن ج1 ص257 وج4 ص94 و 21
وتفسير القرآن العظيم ج4 ص113 وج3 ص485 وشرح النهج للمعتزلي ج6
ص130 وفضائل الصحابة ص22 وتحفة الأشراف ج11 ص263 و 255 والسنن
الكبرى للبيهقي ج7 ص30 وج10 ص114 ومسند ابن الجعد ص397 ومنتخب
مسند عبد بن حميد ص114 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص51 ومسند أبي
يعلى ج2 ص297 و 303 ومسند ابن خزيمة ج4 ص63 والمعجم الصغير ج1
ص131 و 135 والمـعجم الأوسط ج3 ص374 وج4 ص33 والغديـر ج1 ص30 و
176 وج3 ص297 وج10 ص278 وفدك في التاريخ ص98 ومستدرك سفينة
البحار ج1 ص508 وج3 ص86 وأمان الأمة من الاختلاف ص126 و 130 و
132 و 135 ونهج السعادة ج3 ص96 وج8 ص417 ومسند الإمام الرضا ج1
ص106 و 108 ودرر الأخبار ص40 ومكاتيب الرسول ج1 ص358 و 553
ومواقف الشيعة ج1 ص33 وج3 ص474 وتفسير أبي حمزة الثمالي ص5
وتفسير العياشي ج1 ص5 وتفسير القمي ج1 ص173 وج2 ص345 والتبيان
ج9 ص474 وتفسير مجمع البيان ج7 ص267 وج9 ص340 وكشف اليقين ص188
و 426 وسبل الهدى والرشاد ج11 ص6 وج12 ص232 و 396 وتفسير جوامع
الجامع ج1 ص411 والتفسير الصافي ج1 ص21 وج2 ص69 وتفسير الميزان
ج1 ص12 وج3 ص86 وج16 ص319 وج17 ص45 والكنى والألقاب ج1 ص262
وشواهد التنزيل ج2 ص42 واختيار معرفة الرجال ج1 ص85 وج2 ص484 و
485 والدرجات الرفيعة ص451 والضعفاء للعقيلي ج2 ص250 وج4 ص362
والكامل ج6 ص67 وتاريخ مدينة دمشق ج19 ص258 وج41 ص19 وج54= =
ص92 وسير أعلام النبلاء ج9 ص365 وكشف الغمة ج2 ص172 ونهج
الإيمان ص202 وحياة الإمام الحسين للقرشي ج1 ص79 وحياة الإمام
الرضا للقرشي ج1 ص9 ولمحات في الكتاب والحديث والمذهب للصافي
ص137 ومجموعة الرسائل ج1 ص56 و 189 وج2 ص47 و 49 و 51. وراجع:
بصائر الدرجات ص433 و 434 ودعائم الإسلام ج1 ص28 وعيون أخبار
الرضا ج1 ص34 و 68 والخصال ص66 والأمالي للصدوق ص500 وكمال
الدين وتمام النعمة ص64 و 234 و 235 و 236 و 238 و 239 و 240 و
278 ومعاني الأخبار ص90 وشرح أصول الكافي ج1 ص34 وج5 ص166
والوسائل ج1 ص2 وج18 ص19 ومستدرك الوسائـل ج3 ص355 وج7 ص255
وج11 ص374 وكتـاب سليم بن قيس ص201 ومسند الرضا ص68 و 210
ومناقب أمير المؤمنين ج1 ص148 وج2 ص112 و 115 و 116 و 117 و
135 و 136 و 137 و 140 والمسترشد للطبراني الشيعي ص559 ودلائل
الإمامة ص20 والهداية الكبرى ص18 وشرح الأخبار ج1 ص99 وج2 ص379
و 502 وج3 ص12 ومائة منقبة ص161 والإرشاد ج1 ص233 والأمالي
للمفيد ص135 والأمالي للطوسي ص162 و 255 و 548 والإحتجاج ج1
ص191 و 216 و 391 وج2 ص147 و 252 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص3
والعمدة لابن البطريق ص68 و 69 و 98 و 102 و 118 والتحصين ص636
وسعد السعود لابن طاووس ص228 وإقبال الأعمال ج2 ص242 والطرائف
لابن طاووس ص114 و 115 ومشكاة الأنوار ص11 والصراط المستقيم ج2
ص32 وكتاب الأربعين للشيرازي ص363 و 364 و 365 و 367 والفصول
المهمة في أصول الأئمة ج1 ص549 وحلية الأبرار ج2 ص328 ومدينة
المعاجز ج2 ص382 وبحار الأنوار ج2 ص100 و 104 و 226 و 285 وج5
ص21 وج10 ص369 وج16 ص337 وج22 ص311 و 476 وج23 ص107 و 108 و
109 = = و 113 و 117 و 526 وج23 ص133 و 134 و 136 و 140
و 141 و 145 و 146 و 147 وج24 ص324 وج25 ص237 وج28 ص262 و 287
وج30 ص588 وج31 ص376 و 415 وج35 ص184 وج36 ص315 و 331 و 338
وج37 ص114 و 129 وج47 ص399 وج86 ص13 و 27 ونور البراهين ج1
ص384 وكتاب الأربعين للماحوذي ص41 و 68 والعوالم (الإمام
الحسين) ص605 و 734 ومناقب أهل البيت ص82 و 173 و 171 وخلاصة
عبقات الأنوار ج1 ص27 و 28 و 30 و 58 وج2 ص3 و 8 و 47 والنص
والإجتهاد ص13 والمراجعات ص72 و 73 و 262 والسقيفة للمظفر
ص188، وراجع: كتب اللغة مادة ثقل، مثل: القاموس المحيط، وتاج
العروس، والمناقب المرتضوية ص96 و 97 و 100 و 472 ومدارج
النبوة لعبد الحق الدهلوي ص520. ونقله: الشيخ محمد قوام
الدين الوشنوي في حديث الثقلين عن أكثر من تقدم، وعن الصواعق
المحرقة ص75 و 78 و 99 و 90 و 136 وعن ينابيع المودة ص18 و 25
و 30 و 32 و 34 و 95 و 115 و 126 و 199 و 230 و 238 و 301
وإسعاف الراغبين (بهامش نور الأبصار) ص10 وعن فردوس الأخبار
للديلمي ونقله صاحب العبقات عن عشرات المصادر الأخرى، فراجع
حديث الثقلين ص22 ـ 29 فراجع.
([48])
حديث الثقلين للوشنوي ص13 عن الإستجلاب لشمس الدين السخاوي.
([49])
حديث الثقلين ص14 عن عبقات الأنوار المجلد الخاص بحديث
الثقلين.
([50])
الصواعق المحرقة (ط سنة 1385 هـ) ص148 و 149.
([51])
راجع: الصواعق المحرقة (ط سنة 1385 هـ) ص148 و 149 والجامع
الصحيح للترمذي ج2 ص220 و 221.
([52])
الصواعق المحرقة (ط سنة 1385 هـ) ص21.
([53])
الصواعق المحرقة (ط سنة 1385 هـ) ص149، وراجع: الفصول المهمة
لابن الصباغ ص310 ونور الأبصار ص28 وينابيع المودة (ط سنة 1301
هـ) ج2 ص414.
([54])
الآية 43 من سورة النحل.
([55])
حديث الثقلين للعلامة الوشنوي ص22 عن السمهودي.
([56])
حديث الثقلين للعلامة الوشنوي ص19 فما بعدها.
|