|
من عسفان.. إلى الحديبية
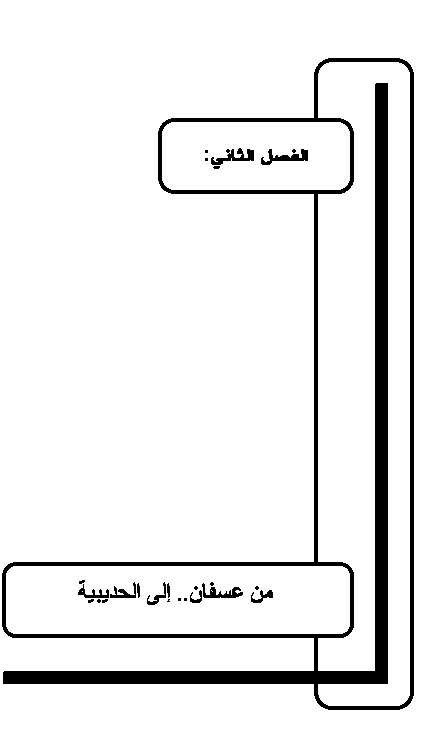
بـدايـة:
في هذا الفصل نذكر أولاً النصوص التي ذكرها المؤرخون
وكتَّاب السيرة، ثم نعقبها ببعض التوضيحات، أو التصحيحات، أو
المناقشات، التي نرى أن من المفيد الاطلاع عليها..
والنصوص هي التالية:
قال الصالحي الشامي وغيره:
روى الخرائطي في الهواتف، عن ابن عباس،
قال: لما توجه رسول الله «صلى الله عليه وآله» يريد مكة
عام الحديبية، قدم عليه بِشر بن سفيان العتكي، فقال له: «يا بشر، هل
عندك علم أن أهل مكة علموا بمسيري»؟
([1]).
فقال:
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني لأطوف بالبيت في ليلة كذا وقريش في
أنديتها، إذ صرخ صارخ من أعلى جبل أبي قبيس ـ ليلة أمر رسول الله «صلى
الله عليه وآله» بالمسير ـ بصوت أسمع أهل مكة:
هـيـوا لِـصَـاحِبِـكُمْ مِثْلي صَحَـابَتِهِ
سِيرُوا إليه وكونوا معشراً كُرَمَا
بعد الطواف وبعد السعي في مهـل وأن يَحُـوزَهُـمُ مـن مـكـة
الحَرَمَا([2])
شاهت وجوهكم من معشر تكـل لا يـنـصـرون إذا مـا حاربوا صنما
فارتجت مكة، واجتمع المشركون، وتعاقدوا ألا يدخل عليهم
بمكة في عامهم هذا.
فبلغ رسول الله «صلى الله عليه وآله» فقال:
«هذا الهاتف سَلْفَعُ ـ شيطان الأصنام ـ يوشك أن يقتله الله (تعالى) إن
شاء الله عز وجل».
فبينما هم كذلك إذ سمعوا من أعلى الجبل صوتاً، وهو
يقول:
شـاهت وجوه رجال حالفوا صَنَمَاً
وخـاب سَـعْـيـُهُـمُ ما قَصَّرَ الهِمَمَا
إني قـتـلـت عــدو الله سَـلْـفَـعَـةً شيطـان أوثـانـكم سحقاً
لمن ظلما
وقـد أتـاكــم رســول الله في نـفر وكـلـهـم محـرم لا يسفكون
دما([3])
قالوا:
ولما بلغ المشركين خروج رسول الله «صلى الله عليه وآله»
راعهم ذلك، فاجتمعوا وتشاوروا، فقالوا: أيريد محمد أن يدخلها علينا في
جنوده معتمراً، فتسمع العرب أنه قد دخل علينا عنوة، وبيننا وبينه من
الحرب ما بيننا؟! والله لا كان هذا أبداً ومنا عين تطرف.
ثم قدموا خالد بن الوليد في مائتي فارس إلى كراعِ
الغميم، واستنفروا من أطاعهم من الأحابيش، وأجلبت ثقيف معهم، وخرجوا
إلى بَلْدَح، وضربوا بها القباب والأبنية، ومعهم النساء والصبيان،
فعسكروا هناك، وأجمعوا على منع رسول الله «صلى الله عليه وآله» من دخول
مكة ومحاربته، ووضعوا العيون على الجبال، وهم عشرة أنفس يوحي بعضهم إلى
بعض الصوت الخفي: فعل محمدٌ كذا وكذا، حتى ينتهي إلى قريش بِبَلْدَح([4]).
ورجع بشر بن سفيان الذي بعثه
«صلى الله عليه وآله»
عيناً له من مكة، وقد علم خبر مكة والقوم، فلقي رسول
الله «صلى الله عليه وآله» بغدير الأشطاط وراء عُسْفَان فقال: يا رسول
الله!! هذه قريش سمعت بمسيرك، فخرجوا ومعهم العُوذُ المَطَافِيل، قد
لبسوا جلود النمور، وقد نزلوا بذي طوى، يعاهدون الله لا تدخلها عليهم
أبداً، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدمها إلى كراع الغميم.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا
بيني وبين سائر العرب، فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا، وإن أظهرني
الله تعالى عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم
قوة، فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله تعالى
به حتى يظهره الله (تعالى) أو تنفرد هذه السالفة»([5]).
النبي
 يشاور أصحابه:
يشاور أصحابه:
ثم قام رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»
في المسلمين، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال:
«أما بعد: يا معشر المسلمين، أشيروا عليَّ، أترون أن
نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم»؟.
وقال:
«فإن قعدوا، قعدوا موتورين محروبين، وإن يأتونا تكن
عُنُقاً ـ وفي لفظ: عيناً ـ قطعها الله، أم ترون أن نؤم البيت، فمن
صدنا عنه قاتلناه»؟.
فقال أبو بكر (رضي الله عنه):
الله ورسوله أعلم، يا رسول الله إنما جئنا معتمرين، ولم
نجئ لقتال أحد، ونرى أن نمضي لوجهنا، فمن صدنا عن البيت قاتلناه.
ووافقه على ذلك أسيد بن الحضير.
وروى ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة عن أبيه، ومحمد بن
عمر عن شيوخه: أن المقداد بن الأسود (رضي الله عنه) قال بعد كلام أبي
بكر:
إنَّا والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو
إسرائيل لنبيها: ﴿اذْهَبْ
أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون».
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«فسيروا على اسم الله»([6]).
ودنا خالد بن الوليد في خيله حتى نظر إلى رسول الله
«صلى الله عليه وآله» وأصحابه، فصف خيله فيما بين النبي «صلى الله عليه
وآله» وبين القبلة، فأمر «صلى الله عليه وآله» عباد بن بشر فتقدم في
خيله، فقام بإزائه، فصف أصحابه، وحانت صلاة الظهر، فأذن بلال، وأقام،
فاستقبل النبي «صلى الله عليه وآله» القبلة، وصف الناس خلفه، فركع بهم
ركعة وسجد، ثم سلم، فقاموا على ما كانوا عليه من التعبئة.
فقال خالد بن الوليد:
قد كانوا على غِرَّة، لو حملنا عليهم أصبنا منهم. ولكن
تأتي الساعة صلاة أخرى هي أحب إليهم من أنفسهم وأبنائهم.
فنزل جبريل بين الظهر والعصر بهذه الآية: ﴿وَإِذَا
كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ
مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ
فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ
يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ
وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ
أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً
وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن
مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ
حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً﴾([7]).
فحانت صلاة العصر، فصلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»
صلاة الخوف([8]).
النبي
 يخالف العدو في الطريق:
يخالف العدو في الطريق:
روى البزار بسندٍ رجاله ثقات، عن أبي سعيد الخدري
مختصراً، ومحمد بن عمر عن شيوخه، قالوا: لما أمسى رسول الله «صلى الله
عليه وآله» قال: «تيامنوا، في هذا العَصَل.
وفي رواية اسلكوا ذات اليمين بين ظهور الحَمْض، فإن
خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة»([9]).
كره رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»
أن يلقاه، وكان بهم رحيماً، فقال:
«تيامنوا فأيكم يعرف ثنية ذات الحنظل»؟
فقال بريدة بن الحُصَيْب الأسلمي:
أنا يا رسول الله عالم بها.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«اسلك أمامنا».
فأخذ بريدة في العصل ـ قبل جبال سَرَاوِع ـ قبل المغرب،
فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيراً
لقريش، فسلك بريدة بهم طريقاً وعراً أجرل([10])
بين شعاب، وسار قليلاً تُنَكِّبُه الحجارة، وتعلقه
الشجر، وصار حتى كأنه لم يعرفها قط.
قال:
فوالله، إني كنت أسلكها في الجمعة مراراً، فنزل حمزة بن
عمرو الأسلمي، فسار بهم قليلاً، ثم سقط في خمر الشجر، فلا يدري أين
يتوجه، فنزل عمرو بن عَبْدِنُهْم الأسلمي، فانطلق أمامهم حتى نظر رسول
الله «صلى الله عليه وآله» إلى الثنية، فقال: هذه ثنية ذات الحنظل»؟
فقال عمرو:
نعم يا رسول الله.
فلما وقف به على رأسها تحدر به.
قال
عمرو:
فوالله إن كان لتهمني نفسي وحدها، إنما كانت مثل الشراك
فاتسعت لي حين برزت، فكانت فجاجاً لاحبة. ولقد كان الناس تلك الليلة
يسيرون جميعاً معطفين من سعتها يتحدثون، وأضاءت تلك الليلة حتى كأنا في
قمر([11]).
وروى مسلم عن جابر مختصراً، وأبو نعيم عن أبي سعيد،
وابن إسحاق عن الزهري، ومحمد بن عمر عن شيوخه:
قال أبو سعيد:
خرجنا مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» عام الحديبية
حتى إذا كنا بعسفان سرنا من آخر الليل حتى أقبلنا على «عقبة ذات
الحنظل».
قال جابر:
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: من يصعد ثنية
المِرار، فإنه يُحَطُّ عنه ما حُطَّ عن بني إسرائيل؟([12]).
فكان أول من صعد خيل من الخزرج، ثم تبادر الناس بعد.
وقال أبو سعيد:
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «مثل هذه الثنية
الليلة كمثل الباب الذي قال الله تعالى لبنى اسرائيل: ﴿..وَادْخُلُواْ
الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ..﴾([13])»([14]).
وقال ابن إسحاق:
إن المسلمين لما أن خرجوا من الأرض الصعبة، وأفضوا إلى
أرض سهلة، قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «قولوا نستغفر الله
ونتوب إليه».. فقالوا ذلك.
فقال «صلى الله عليه وآله»:
«والله إنها لَلْحِطَّة التي عرضت على بني إسرائيل فلم
يقولوها»([15]).
قال أبو سعيد:
ثم قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «لا يجوز هذه
الثنية الليلة أحد إلا غفر له».
فلما هبطنا نُزُلَنَا فقلت:
يا رسول الله، نخشى أن ترى قريش نيراننا.
فقال:
لن يروكم([16]).
فلما أصبحنا صلى بنا صلاة الصبح، ثم
قال:
«والذي نفسي بيده لقد غفر للركب أجمعين إلا رويكباً
واحداً على جمل أحمر التقت عليه رحال القوم ليس منهم»([17]).
وقال جابر:
قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «كلكم مغفور له
إلا صاحب الجمل الأحمر»([18]).
قال أبو سعيد:
فطلب في العسكر فإذا هو عند سعيد بن زيد بن عمرو بن
نفيل، والرجل من بني ضمرة من أهل سيف البحر، يظن أنه من أصحاب رسول
الله «صلى الله عليه وآله».
فقيل لسعيد:
إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال: كذا وكذا.
فقال له سعيد:
ويحك!! اذهب إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» يستغفر
لك([19]).
وقال جابر:
فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله «صلى الله عليه
وآله»
فقال:
والله، لأن أجد ضالتي أحب إليَّ من أن يستغفر لي صاحبكم([20]).
وقال أبو سعيد:
فقال: بعيري والله، أهم من أن يستغفر لي.
إذاً هو قد أضل بعيراً له، فانطلق يطلب بعيره بعد أن
استبرأ العسكر، وطلبه فيهم، فبينا هو في جبال سراوع إذ زلقت به نعله،
فتردى فمات، فما علم به حتى أكلته السباع.
قال أبو سعيد:
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» يومئذ: «سيأتيكم
أهل اليمن كأنهم قطع السحاب. هم خير أهل الأرض»([21]).
ونقول:
إن لنا على النصوص المتقدمة ملاحظات عديدة، بعضها
للتوضيح، وبعضها للتصحيح، نذكر منها ما يلي:
وأما عدول النبي
«صلى الله عليه وآله»
عن الطريق, وعدم مواجهته طليعة المشركين التي كانت بقيادة خالد، فلعله
يرجع إلى عدة أسباب..
منها:
أنه لم يرد أن يواجه تلك الطليعة لكي يتجنب أي اشتباك
معها, يمكن أن يدفع بالأمور إلى حيث تصبح الحرب مع قريش أمراً مفروضاً
لا يمكن تجنبه، وقد يمكن لقريش أن تشيع: أن أصحابه، أو بعضهم هم الذين
تسببوا بنشوب الحرب.
ومنها:
أن ذلك يمثل ضربة لعنفوان قوى الشرك, حيث إن طلائعهم,
وكذلك عيونهم المنتشرة في كل مكان، لم تغن عنهم شيئاً..
ومنها:
أنه لا يريد أن يشعر المشركون بأنهم قادرون على التحكم
بقرار الحرب, وأنهم قد فرضوا عليه أن يتحرك وفق ما رسموه له, مما يعني:
أن خططهم ناجحة من الناحية العسكرية.
ومنها:
أنه يريد أن يربك حركتهم العسكرية, ويعرفهم: أنهم غير
قادرين على التحكم في مسار الأمور, مما يعني: أن أخطار المواجهة معه لا
يمكن الاستهانة بها.. وأنهم لا يستطيعون ضمان النجاح في أي شيء..
قد ذكرت بعض النصوص المتقدمة:
أن الخزاعي الذي أرسله النبي «صلى الله عليه وآله»
عيناً له على قريش قد عاد
إليه، فقال: «إني تركت كعب بن لؤي، وعامر بن لؤي قد جمعوا لك جموعاً،
وهم مقاتلوك، وصادوك عن البيت.
فقال النبي «صلى الله عليه وآله»:
أشيروا عليَّ، أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين
أعانوهم، فنصيبهم؟
فإن قعدوا الخ..»([22]).
فالذي جمع الجموع ـ وفق ما قاله هذا النص ـ هو
قبائل
عامر وكعب ابنا لؤي.. مع أن أبا سفيان هو الذي يجمع
الجموع، ويريد أن يقاتل النبي «صلى الله عليه وآله» ويصده عن البيت..
فما معنى نسبة هذا الأمر إلى هؤلاء
بهذا التهويل والمبالغة؟!
على أن المذكور في النص الآخر هو قريش،
وأن استشارته أصحابه إنما هي حين قدم خالد بمن معه..
وأما الحديث عن صرخة شيطان الأصنام
«سلفع»([23])؛
فهو حديث غريب وعجيب([24])،
إذ فيه:
أولاً:
أن الأبيات المنسوبة إلى
«سلفع»
في غاية الركاكة والسقوط، والبيت الثاني منها ليس له لون، ولا طعم، ولا
رائحة..
وكذلك الحال بالنسبة للأبيات الأخرى، إذ لا نجد معنى
مقبولاً أو معقولاً لقوله في البيت الأول:
«ما
قصر الهمما».
ثانياً:
لماذا لم يقتل هذا الهاتف شيطان الأصنام قبل هذه
الحادثة، فلم يقتله في حرب بدر، أو قبل الهجرة، أو في أحد، أو في حمراء
الأسد، أو الخندق، أو غير ذلك؟!
ولماذا لم يكن سلفع الشيطان يخبر أهل مكة بتحركات رسول
الله
«صلى الله عليه وآله»
ضدهم؟!
ثالثاً:
كيف علم بسر (أو بشر) بن سفيان الذي أرسله النبي
«صلى الله عليه وآله»
من ذي الحليفة إلى مكة عيناً له: أن صرخة الشيطان كانت ليلة مسير رسول
الله
«صلى الله عليه وآله»
إليهم؟ وكيف حضر في مكة ساعة هذه الصرخة؟! مع أن بسر بن سفيان لم يكن
في مكة حين مسير النبي
«صلى الله عليه وآله»
إليها؟!.
ولو فرضنا:
أنه كان فيها، فكيف جاء من مكة كل هذه المسافة قبل أن
يجاوز رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
ذا الحليفة.
وإذا كان قد عاد إليه، وكانت عودته قبل قتل سلفع، حتى
أبلغه بصرخته، فقال له رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
يوشك أن يقتله الله.. فلماذا تأخر قتل سلفع، كل هذه المدة؟!
رابعاً:
إن بسر بن سفيان هو الذي يحدث النبي
«صلى الله عليه وآله»
بهذه الأحداث، وهو الذي يقول: فبلغ النبي ذلك، فأخبر أن هذا سلفع يوشك
أن يقتله الله إن شاء الله.
ثم قال:
فبينما هم كذلك إذ صوت الهاتف الثاني الذي أخبرهم بأنه
قتل سلفعاً، فما معنى قوله: فبينما هم كذلك؟!
هل معناه:
أنهم كانوا لا يزالون في مجالسهم وأنديتهم؟!
فكيف يكون ذلك الخبر قد وصل إلى رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
ليقول في حق سلفع ما قال؟!
فإن ظاهر قوله:
بلغ رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
أنه بلغه بالطرق العادية.
خامساً:
إن كلام سلفع لم يتضمن أي خبر لقريش عن تحركات رسول
الله
«صلى الله عليه وآله»،
ولم يخبرهم في شعره بأن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
يقصدهم بالحرب، أو أنه يقصد دخول مكة.
بل غاية ما فيه:
أنه يطلب منهم أن يجهزوا جيشاً يشتمل على ضِعْفِ أصحاب
رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
وأن يسيروا إلى حربه، فما معنى قول الرواية: إنهم لما سمعوا ذلك الشعر
«ارتجت
مكة، واجتمع المشركون، وتعاقدوا: أن لا يدخل عليهم بمكة في عامهم هذا»؟!
سادساً:
إذا كان رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
لا يريد إعلام قريش بمسيره، لكي يفاجئها بالأمر، ويجعلها أمام الأمر
الواقع، ليربكها، ويشعرها بالعجز، والضعف، حيث يكون قد وجه لها صدمة
روحية، حتى إذا استجاب لمطالبها، فإنه يكون في موقع المتفضل الرحيم بها..
نعم..
إذا كان الأمر كذلك.. فلماذا يتدخل هذا الهاتف الثاني
ليفسد خطط رسول الله «صلى الله عليه وآله»، أو ليؤثر سلباً عليها، وذلك
حين أخبر أهل مكة بمسيره «صلى الله عليه وآله» إليهم، وأنه على حال
الإحرام، وما إلى ذلك؟!
وقد ذكرت الروايات المتقدمة:
أن قريشاً ومن تابعها من ثقيف، وغيرها من القبائل قد
تجمعوا في مكان يقال له: (بلدح)، وعسكروا هناك، ووضعوا العيون على
الجبال، وتستمر الرواية لتقول: إن بسر بن سفيان الذي لقي النبي
«صلى الله عليه وآله»
بغدير الأشطاط، وراء عسفان قد قال للنبي الأعظم
«صلى الله عليه وآله»:
إنهم
«قد
نزلوا بذي طوى».
ومن الواضح:
أن (بلدح) هو واد غربي مكة ـ كما يقول ياقوت([25]).
وأما ذو طوى، فهو:
واد في طريق التنعيم إلى مكة([26]).
ويستوقفنا هنا:
قول رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب. ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر
العرب، فإن هم أصابوني الخ..
ونقول:
إن نظرة منصفة إلى واقع الحال
تعطينا:
أن هذا الكلام من رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
ما هو إلا رسالة ذات مغزى عميق ودقيق، يريد الرسول
«صلى الله عليه وآله»
أن يوصلها إلى الناس، من أجل سوقهم نحو هدف يريد أن يصل إليه، وأن يحصل
عليه..
ويتضح ذلك من خلال البيان التالي:
أنه
«صلى الله عليه وآله»
قد بدأ كلامه بما يلتقي مع ما يعانيه الناس العاديون من شدائد
إقتصادية، وضغوطات عاطفية، واجتماعية وأمنية، وخسائر في الأنفس، وفي
الأموال، وفي العلاقات.. وغير ذلك..
حيث قال عن قريش:
«لقد
أكلتهم الحرب»!!..
مع ما في ذلك من إظهار درجة من العطف على هؤلاء الذين يظلمون أنفسهم،
ويظلمون غيرهم، وهم قريش، أو على الأقل، فيه إيحاء، بأن من الممكن
التجاوز عما مضى، وأن الأمور بينه وبين قريش لم تصل إلى نقطة اللا
رجوع..
ثم قدم خيارات يجد فيها من يتعرض لهذه المعاناة متنفساً
مقبولاً وحلاً معقولاً، ينسجم مع ما يصبو ويشتاق إليه من حب السلامة
والراحة..
ولكن من الواضح:
أن هذه الخيارات وإن كانت سوف تؤثر على مستوى ثقة العرب
بقريش، وعلى علاقاتهم بها، ولكنها خيارات واقعية، تحمل معها الخلاص من
العناء والشقاء، والبلاء وما يجري على قريش والمشركين، فإنما على نفسها
جنت براقش.. وتلك هي نتائج الإثم والبغي والعدوان.
يضاف إلى ذلك:
أن الأخذ بهذه الخيارات، من شأنه أن يوزع القوى، فيسهل
على المظلومين مواجهة الظلم، لأن القوى حين تكون متفرقة فإنها لا تملك
نفس القوة حين تكون مجتمعة، فإنه إذا قضي على قوة العرب الذين هم حول
قريش فلن تنفع قريشاً قوتها.. خصوصاً مع تنامي قوة الإسلام، واتساع
رقعته، وازدياد نفوذه.
والخلاصة:
أنه
«صلى الله عليه وآله»
يقدم لقريش خيارات، لو عملت بها، فسوف تجد نفسها في أحضان الإسلام، ولن
تقوى على مقاومته، ولا تجد مناصاً من الدخول فيه، وسوف تكون بأمس
الحاجة إلى حمايته، والاستظلال بظله..
فالأمور التي طرحها
«صلى الله عليه وآله»
لا يمكن تجاهلها، بل لا بد من أن يعلق في أذهان الناس شيء منها، ويثير
ذلك بلابل في صدورهم، وتبدأ من ثم الاقتراحات التي تنسجم مع أجواء تلك
الخيارات، فتضعف العزائم عن خوض الحروب، وتنقاد النفوس لقبول حلول
تقرِّبهم من أجواء السلم، والقبول بما كان مجرد تخيله يعد جريمة
وخيانة، وعاراً عندهم..
وقد كانت المبادرة إلى العمرة، وإلى الإحرام، وسوق
الهدي، تهدف إلى إثارة هذه الأجواء، حيث فرض عليهم الرضا بأن يعاهدوه
ويصالحوه.. ورضوا أيضاً بأن يدخل إلى الحرم، ويحج البيت في سنة لاحقة..
مع أن التفكير الذي كان سائداً إلى تلك اللحظة هو لزوم قتله، وكل من
معه.. فالتنزل والقبول بما هو أدنى من ذلك يعتبر إنجازاً عظيماً.
ولا شك في أن الخيارات السابقة التي طرحها الرسول
«صلى الله عليه وآله»،
وتحدثنا عنها آنفاً، قد أسهمت في إثارة هذه الأجواء التي ساعدت على
الوصول إلى تلك النتائج الباهرة والفتح العظيم..
النبي
’
يستشير أصحابه:
1 ـ
وقد تقدم: أنه
«صلى الله عليه وآله»
قد استشار أصحابه في هذه المناسبة أيضاً. وقد أظهرت هذه المشورة أنه لم
يكن لدى المسلمين ميل للقتال، ولا كانوا يتسترون بالإحرام، ويضمرون
العدوان، حينما تمكنهم الفرصة. وقد كان لا بد من تسجيل وإظهار هذه
الحقيقة للأجيال، فلم يعد يمكن للذين لا يؤمنون أن يقولوا: إن أقوال
النبي
«صلى الله عليه وآله»
لا تعكس ما في ضميره، لأنه رجل سياسي، ومنطق السياسة التي درجوا عليها،
هو المكر والخداع، وانتهاز الفرص السانحة.
2 ـ
إننا نعتقد: أن مشورة أبي بكر بعدم القتال، كانت تنسجم
مع سياساته الرامية إلى تعزيز قريش، وحفظ عنفوانها، وعدم المساس
برموزها، كما ظهر من مشورته في حرب بدر، سواء بالنسبة لأصل الحرب، أم
بالنسبة لسعيه لإنقاذ أسرى قريش من القتل.
3 ـ
وكان لهذه التدخلات أثرها الضاغط على رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
والمثير فيما بين المسلمين سلبيات كبيرة ومتنوعة، من حيث تأثيرها على
مستوى الثقة والقناعة، ومن ثم على الطاعة والانقياد والرضا من قبل عامة
المسلمين بقرارات النبي الأكرم
«صلى الله عليه وآله».
4 ـ
لقد كان موقف المقداد في بدر وفي الحديبية، الذي هو
الإعلان بالتسليم المطلق لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
هو الموقف الصحيح والصائب، الذي كان النبي
«صلى الله عليه وآله»
يريد له أن يتنامى وأن يشيع ويتأكد ويتجذر فيما بين المسلمين. ليصبح
خلقهم وسجيتهم الظاهرة في كل حين، وكل وقت، وفي كل موقف.
5 ـ
إن قوله
«صلى الله عليه وآله»:
أترون أن نميل على ذراري هؤلاء؟ يراد به إظهار الخلق النبيل والسامي
لأهل الإيمان، وأنهم يتعاملون مع الأمور بمنطق المبادئ والقيم، لا
بمنطق الأهواء والغرائز، وردات الفعل. فإنه
«صلى الله عليه وآله»
قد أوضح: أن هناك قبائل قد انضمت إلى قريش لتحارب معها، وتركوا ذراريهم
خلفهم بلا حام ولا كفيل. وهذا خطأ فادح، لأن المفروض بالمحارب: أن يحسب
حساب عدوه، ولا يدع ماله وعياله يقعان في معرض الاستباحة!! فها هو رسول
الله
«صلى الله عليه وآله»
يعرض الأمر على من معه، ويستدرجهم بسؤاله لهم إلى الإعلان بأنهم طوع
إرادته، ورهن إشارته، ليرى الناس كيف يعفُّ ويعفو ولا يقدم على أي عمل
يتناقض مع مبادئه ودينه رغم قدرته عليه.
من أجل ذلك نقول:
إن موقف المقداد هو الموقف الصحيح، فإن الإعلان بالطاعة
ـ خصوصاً في مثل هذه المواقف ـ أمر مطلوب؛ حسبما أوضحناه، كما أنه يدخل
الرعب واليأس في قلوب الأعداء، وتضعف توقعاتهم بزعزعة وحدة الذين جاؤوا
لحربهم..
أما جواب أبي بكر، فهو يعني:
أن في أصحاب النبي «صلى الله عليه وآله» من يتجرأ عليه، ويبادر إلى رسم
الطريق له، ويطلب منه أن يكون بأمره، ورهن إشارته ويجعل نفسه في موقع
من يعرف الرأي الصائب، ويتوهم أنه قد عرف ما لم يعرفه رسول الله «صلى
الله عليه وآله»..
وهذا الأمر يطمع العدو في المسلمين، ويدفعه إلى التفكير
في التدخل في سياساتهم، بإلقاء الآراء المختلفة إليهم ليثير البلبلة في
أفكارهم،
ويلقي الشبهات لديهم في صوابية قرارات
القيادة، ومدى إدراكها لما يجب فعله أو يجب تركه. وهذا خلل خطير وكبير
تداركه المقداد
رحمه الله،
ورضي عنه وأرضاه.
وقد حاول البعض أن يدَّعي:
«أن
في عامة تصرفات الرسول
«صلى الله عليه وآله»,
ما يدل على مشروعية الشورى, وضرورة تمسك الحاكم بها.
وعمل النبي
«صلى الله عليه وآله»
هنا يدل على طبيعة هذه الشورى, والمعنى الذي شرعت من أجله. فالشورى في
الشريعة الإسلامية مشروعة, ولكنها ليست ملزمة، وإنما الحكمة منها
استخراج وجوه الرأي عند المسلمين, والبحث عن مصلحة قد يختص بعلمها
بعضهم دون بعض, أو استطابة لنفوسهم.
فإذا وجد الحاكم في آرائهم ما سكنت نفسه إليه, على ضوء
دلائل الشريعة الإسلامية وأحكامها، أخذه, وإلا كان له أن يأخذ بما شاء,
شرط أن لا يخالف نصاً في كتاب ولا سنة، ولا إجماعاً للمسلمين..
ولقد وجدنا أن النبي«صلى
الله عليه وآله»
استشار أصحابه في الحديبية, وأشار عليه أبو بكر بما قد علمت.
قال له:
إنك يا رسول الله خرجت عامداً لهذا البيت, فتوجه له,
فمن صدنا عنه قاتلناه.
ولقد وافقه النبي
«صلى الله عليه وآله»
في بادئ الأمر, ومضى مع أصحابه, متوجهاً إلى مكة، حتى إذا بركت الناقة,
وعلم أنها ممنوعة, ترك الرأي الذي كان قد أشير به عليه.
وأعلن قائلاً:
والذي نفسي بيده، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات
الله إلا أعطيتهم إياها.
وحينئذ تحول العمل عن ذلك الرأي الذي أبداه أبو بكر إلى
أمر الصلح والموافقة على شروط المشركين، دون أن يستشير في ذلك أحداً».
إلى أن قال:
فهذا
«يدل
أيضاً على أن الشورى إنما شرعت للتبصر بها، لا للإلزام أو التصويت على
أساسها»([27]).
ونقول:
إن لنا على هذا الكلام عدة ملاحظات، نذكر منها ما يلي:
1 ـ
إنه ليس في تصرفات النبي
«صلى الله عليه وآله»
ما يدل على ضرورة تمسك الحاكم بالشورى، بل غاية ما تدل عليه: أنه يباح
للحاكم أن يمارسها.
2 ـ
إنه ليس في تصرفاته
«صلى الله عليه وآله»
ما يدل على أن الحاكم ملزم بالأخذ بما يشيرون به عليه، فقد يأخذ بمشورة
أحدهم، وقد لا يأخذ بمشورة أحد منهم أصلاً، بل يأخذ برأي نفسه.
3 ـ
إن حكمة ممارسة الشورى لا تنحصر بما ذكره ذلك البعض، بل
قد تشمل إظهار نوايا بعض من يدلون بآرائهم فيها، لكي يعرف الناس تلك
النوايا، ليمكنهم تمييز المخلص من غيره، والذكي من الغبي، والشجاع من
الجبان، و.. و..
4 ـ
إن النبي
«صلى الله عليه وآله»
لم يكن بحاجة إلى رأي أحد؛ لأنه عقل الكل، ومدبر الكل، وفوق الكل. ولا
يمكن أن يختص أحد بعلم شيء دونه.. فاستشارته للناس لا يمكن أن تكون
لأجل معرفة الصواب من الخطأ، أو لأجل علم اختص به سواه.
5 ـ
إن من أعظم الموبقات والجرائم في حق النبي الأعظم
«صلى الله عليه وآله»
هو القول بإمكان أن يأخذ برأي يخالف نصاً في الكتاب، أو السنة، أو
الإجماع، فإن هذا يدل على انتفاء صفة العصمة عنه، ومن موجبات فقد الثقة
بما يقول ويفعل..
وهذا القائل الذي نحن بصدد مناقشة كلامه ليس فقط لم
يستثن النبي
«صلى الله عليه وآله»
من هذه المقولة، بل هو قد صرح: بأنه قاصد له فيها، حيث قال بعد حوالي
أربع صفحات في إشارة منه إلى عباراته الآنفة الذكر، وموضحاً مراده فيها
ما يلي:
«قد علمت فيما سبق: أن تصرفات النبي «صلى الله عليه
وآله» لا تكتسب قوة الحكم الشرعي، إلا إذا أقرها الكتاب بالسكوت عليها,
أو التأكيد لها. ولقد أقرَّ
الكتاب كل بنود المصالحة إلا ما يتعلق برد النساء إلى بلاد الكفر, فلم
يقرُّه,
وذلك على فرض دخوله في بنود الاتفاقية
وشروطها»([28]).
على أننا لم نفهم وجهاً لقوله:
مخالفة الرسول
«صلى الله عليه وآله»
للسنة، فإن السنة هي نفس قول النبي
«صلى الله عليه وآله»
وفعله وتقريره..
كما أننا لم نفهم الوجه في مخالفة النبي
«صلى الله عليه وآله»
للإجماع، وكيف يمكن أن يتحقق ذلك.
وهذا يسقط الحقيقة التي تقول:
إن قول الرسول
«صلى الله عليه وآله»
وفعله وتقريره حجة بنفسه على العباد، كما أنه يثير الشك والشبهة في ما
يصدر عنه
«صلى الله عليه وآله»،
ويحتاج نفس قوله وفعله إلى مراجعة على أهل الاختصاص والاجتهاد لإجراء
مقارنة بينه وبين الآيات، والاطلاع على الإجماعات التي قد تكون في
حياته، أو تنشأ بعد وفاته، ليتم عرض كلامه عليها, وقياسه عليها!!
6 ـ
وأما ما زعمه هذا القائل: من أن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
قد أخذ برأي أبي بكر أولاً، ثم لما بركت الناقة, وعلم أنها ممنوعة ترك
ذلك, وتحول إلى أمر الصلح والموادعة،
فهو غير صحيح:
فإن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
شاورهم، وسمع مشورة أبي بكر, ومشورة المقداد, ثم قال: امضوا على بركة
الله، فليس في كلامه أية دلالة على ما عقد العزم عليه، بل بقي متمسكاً
بقوله: إنه لم يأت لقتال أحد, بل جاء للعمرة وزيارة البيت, وقال:
«إن
قريشاً قد نهكتهم الحرب, وأضرت بهم , فإن شاؤوا ماددتهم مدة, أو يخلوا
بيني وبين الناس, وإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا, وإلا
فقد جمُّوا الخ..».
فلماذا ينسب هذا الرجل لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»
أمراً لم يكن؟
ولماذا يريد أن يظهر الخطأ والتقلب والاختلاف في مواقف
الرسول
«صلى الله عليه وآله»،
من دون أي شاهد أو دليل إلا ما تنسجه يد التعصب لفريق بعينه، حتى لو
أدى ذلك: إلى الاستهانة به
«صلى الله عليه وآله»؟!
وقد تقدم أيضاً زعمهم:
أن خالداً دنا حتى نظر إلى رسول الله
، فأمر «صلى الله عليه وآله» عباد بن بشر فتقدم في خيله، فقام بإزاء
خالد، فصف أصحابه، وحانت صلاة الظهر، فصلى النبي «صلى الله عليه وآله»
بهم ركعة، ثم قاموا الخ..([29]).
ونقول:
إننا نشك في صحة ذلك، استناداً إلى ما يلي:
أولاً:
إن خالد بن الوليد لا يجرؤ على التقدم إلى حد أن يصف
خيله قبالة رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
إذا كان معه مائتا راكب فقط، وكان المسلمون أضعاف هذا العدد..
ثانياً:
ما معنى: أن يصل خالد ويصف خيله بين النبي
«صلى الله عليه وآله»
وبين القبلة؟!
وأين كانت خيل المسلمين في هذه اللحظة؟!
وكيف لم تبادر للوقوف في وجهه بمجرد ظهوره؟!
ولماذا لم تمنعه من أن يصف خيله؟!
ثالثاً:
إذا كانت خيل المسلمين بقيادة عباد بن بشر قد اصطفت
بإزاء خالد، فمعنى ذلك: أن المسلمين ملتفتون إلى عدد أفراد من معه،
عارفون بمواقعه، مراقبون له.
فما معنى قول خالد,
حين رأى النبي
«صلى الله عليه وآله»
يصلي بمن معه:
«قد
كانوا على غرة لو حملنا عليهم، أصبنا منهم»؟.
رابعاً:
أين كان علي بن أبي طالب
«عليه
السلام»
عن ساحة القتال آنئذٍ؟!
ولماذا قدم النبي
«صلى الله عليه وآله»
عباد بن بشر، ولم يقدم علياً، الذي كانت تخشاه قريش كل الخشية؟!
ألم يكن علي «عليه السلام» هو القائد العام في تلك
الغزوة، كما كان في غيرها؟!
خامساً:
إن الآية القرآنية تقول: ﴿حَافِظُواْ
عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِله قَانِتِينَ﴾([30])،
وعلى هذا الأساس نقول:
ما معنى قول خالد عن صلاة العصر:
إنها أحب إلى المسلمين من أنفسهم وأبنائهم؟!
فهل أمر الله للناس بالمحافظة على الصلاة الوسطى يجعل
هذه الصلاة أحب إلى المسلمين من أنفسهم وأموالهم, ثم تصبح الصلوات
الأخرى أقل أهمية من هذه الصلاة؟!..
سادساً:
ما معنى: أن يركع النبي
«صلى الله عليه وآله»
بهم ركعة، ويسجد ويسلم في صلاة الظهر؟! فهل أصبحت صلاة الظهر ركعة
واحدة؟! أم أن هذه هي صورة صلاة الخوف؟!
وإذا كانت صلاة الخوف، فما معنى
قولهم:
إن آية صلاة الخوف قد نزلت في صلاة العصر، لا في صلاة
الظهر؟!
سابعاً:
بالنسبة لنزول آية صلاة الخوف في هذه المناسبة نقول:
إن هناك روايات تعارض الرواية المذكورة، فقد:
1 ـ
روي عن سليمان اليشكري: أنه سأل جابر بن عبد الله عن
إقصار الصلاة، أي يوم أنزل؟!
فقال جابر بن عبد الله:
وعير قريش آتية من الشام، حتى إذا كنا بنخل جاء رجل من القوم الخ([31]).
2 ـ
عن ابن عباس: أن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
قد صلى صلاة الخوف يوم بطن نخلة([32]).
قال ياقوت الحموي:
بطن نخل: قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة([33]).
3 ـ
وعن ابن عباس أيضاً: أن النبي
«صلى الله عليه وآله»،
قد صلاها بذي قرد.. ([34])
وقد تقدم ذلك.
4 ـ
عن عائشة، وعن صالح بن خوات، عمن صلى مع رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
أنه
«صلى الله عليه وآله»
قد صلاها في غزوة ذات الرقاع([35]).
وهذا هو المروي عن أبي عبد الله الصادق
«عليه
السلام»([36]).
5 ـ
عن جابر: أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
صلاها وهو محاصر بني محارب بنخل([37]).
وبعد ما تقدم نقول:
كيف يصح قول مجاهد:
إنه
«صلى الله عليه وآله»
صلى صلاة الخوف بعسفان، والمشركون بضجنان،
«فلم
يصل رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
صلاة الخوف قبل يومه ولا بعده»؟!([38]).
وكيف يمكن الاطمئنان إلى صحة ما ورد في تلك الرواية، من
أن صلاة الخوف قد نزلت في غزوة الحديبية سنة ست؟!
ثامناً:
إننا إذا أردنا أن نلزم هؤلاء الناس بما ألزموا به
أنفسهم، فإننا نقول:
إنهم هم أنفسهم قد صرحوا:
بأن صلاة الخوف قد نزلت في السنة السابعة([39])،
أي بعد غزوة الحديبية بسنة. فما معنى دعواهم هنا: أنها شرعت ونزلت
الآية في غزوة الحديبية..
تاسعاً:
إن دعواهم: أن صلاة العصر كانت أحب إلى المسلمين من
أنفسهم وأبنائهم، لم نجد ما يثبتها في التاريخ العملي، الذي يمكِّن
خالداً من انتزاع هذه الصورة عنهم، والتصريح بها أمام جيشه..
يضاف إلى ذلك:
أنه إذا كانت آية: ﴿حَافِظُواْ
عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى..﴾
هي المنشأ لما قاله عن صلاة العصر، فإننا نقول:
إن المروي عن أهل البيت
«عليهم
السلام»
هو: أن المقصود بالصلاة الوسطى هو: صلاة الظهر([40]).
وإذا أخذنا بالرواية التي تقول:
إن الإمام الصادق، وكذلك الإمام الباقر
«عليهما
السلام»
قد قرآ:
«حافظوا
على الصلوات والصلاة الوسطى، وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين»([41])،
فأضاف
«عليه
السلام»
كلمة
«وصلاة
العصر»
لأجل التفسير والبيان، وربما ليعلمنا: بأن هذا التفسير قد أنزله الله
تعالى، وليس قرآناً، بل هو بمثابة الحديث القدسي، الذي هو من عند الله
تعالى، ولكنه ليس من القرآن..
فنقول:
إن هذه الرواية تجعل صلاة الظهر في مستوى صلاة العصر،
فما معنى كونها أحب إلى المسلمين من أنفسهم وأبنائهم؟!.
ولعل الرواية الأقرب إلى الإعتبار هي: تلك التي رواها
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الإمام الصادق
«عليه
السلام»:
أنها نزلت لما خرج رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
إلى الحديبية، يريد مكة.
فلما وقع الخبر إلى قريش بعثوا خالد بن الوليد في مائتي
فارس، كميناً، يستقبل رسول الله ، فكان يعارض النبي
«صلى الله عليه وآله»
على الجبال.
فلما كان في بعض الطريق، وحضرت صلاة الظهر، فأذن بلال،
فصلى رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
بالناس، فقال خالد بن الوليد: لو كنا حملنا عليهم، وهم في الصلاة
لأصبناهم، فإنهم لا يقطعون صلاتهم، ولكن تجيء لهم الآن صلاة أخرى، وهي
أحب إليهم من ضياء أبصارهم، فإذا دخلوا في الصلاة أغرنا عليهم.
فنزل جبرئيل
«عليه
السلام»
على رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
بصلاة الخوف في قوله: ﴿وَإِذَا
كُنتَ فِيهِمْ..﴾
الآية([42]).
فليس في هذه الرواية أي شيء مما أوجب الإشكال على
الرواية الأخرى التي ناقشناها آنفاً سوى هذه العبارة الأخيرة، التي قد
يفهم منها أن الآية قد نزلت وأن تشريع صلاة الخوف قد حصل في هذه
المناسبة.. مع أن هناك رواية عن أهل البيت
«عليهم
السلام»
تصرح: بأن ذلك قد كان في غزوة ذات الرقاع([43]).
ويمكن تجاوز هذا الإشكال إذا كان
المراد:
أن جبرئيل
«عليه
السلام»
قد نزل على رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
وأخبره بنية المشركين، وأن تكليفك يا
محمد الآن هو:
أن تعمل بالآية المباركة التي أنزلناها عليك في غزوة
ذات الرقاع.. وليس المراد أن تشريع هذه الصلاة قد بدأ في الحديبية.
ولكن يبقى التساؤل الذي سجلناه حول قول خالد، عن صلاة
العصر: إنها أحب إليهم من ضياء عيونهم.. فما هذه الخصوصية لصلاة العصر،
ومن الذي عرَّف خالداً هذا الأمر عن المسلمين؟ هذا ما لم نستطع أن
نهتدي إلى وجهه. والله هو العالم بالحقائق.
وقد لوحظ:
أنه
«صلى الله عليه وآله»
قد أوضح للناس، أو أظهر في العديد من المواضع: الرعاية الغيبية لهم،
وأخبرهم بالعديد من القضايا التي لا تعرف إلا بالإخبار الإلهي،
والتوقيف.. مثل ما تقدم، من أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
أخبر المسلمين: أن قريشاً لن ترى نيرانهم حين جاوز ثنية ذات المرار،
وقد تقدم الحديث عن أن ثنية الحنظل قد اتسعت للمسلمين، فكانت فجاجاً
لاحبة (أي واسعة)، بعد أن كانت ضيقة مثل الشراك.
وأن رسول الله «صلى الله عليه وآله»
قد ذكر لهم:
أن هذه الثنية مثل باب حطة لبني إسرائيل، وأخبرهم عن
رجل لم يكن من المسلمين، وهم يظنونه مسلماً مثلهم، وهو موجود بينهم.
وغير ذلك مما تقدم.
فإن ذلك كله وسواه مما ذكرناه في الفصل السابق ومما
سيأتي، ما هو إلا توطئة للتقليل من وقع المفاجأة التي سوف يسقط فيها
الكثيرون، وذلك حين يظهر لهم: أنهم سوف لن يدخلوا المسجد في عامهم
هذا.. وأنهم قد أخطأوا حين ظنوا: أن ما أخبرهم به النبي
«صلى الله عليه وآله»
سوف يتحقق في نفس هذا المسير..
وقد فاجأهم هذا الأمر، إلى حد: أنهم امتنعوا عن طاعة
أمر رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
بالإحلال في مواضعهم، والتأهب للعودة كما سنرى..
ولعله لولا ما رأوه من مزيد عناية الله تعالى بهم، ومن
معجزات وكرامات إلهية لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»
لتجاوز الأمر حدود الشك إلى ما هو أعظم وأدهى، وأشر وأضر على دينهم
ويقينهم.
النبي
 عارف بالأمور ويستعين بالعارفين:
عارف بالأمور ويستعين بالعارفين:
تقول النصوص:
إن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
هو الذي أخبرهم بأن خالد بن الوليد قد وصل في خيل لقريش إلى الغميم ـ
طليعة لقريش ـ ولم يظهر من إخباره هذا أنه قد تلقى ذلك من العيون.. وإن
كان ذلك محتملاً. ثم إنه
«صلى الله عليه وآله»
قد سلك طرقاً معينة استطاع باختياره لها أن يفاجئ خالد بن الوليد، حتى
لتقول الرواية:
«فوالله،
ما شعر بهم خالد، حتى إذا هم بقترة ـ أي بغبارـ الجيش فانطلق يركض
نذيراً لقريش».
وهذه المفاجأة من شأنها أن ترهب خالداً ومن معه، وأن
تربكهم بحيث يفلت زمام المبادرة من يدهم..
وقد ظهر مما تقدم:
أن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
كان عارفاً بالمسالك، مطَّلعاً على المفاوز، بأسمائها ومواصفاتها، فهو
يأمر أصحابه بسلوك فجاج معينة، ويوجه مسيرتهم في اتجاهات محددة، ولكنه
مع ذلك يطلب من بريدة أن يكون هو الدليل للناس. ويحمل هذا التصرف من
الدلالات والمعاني ما لا يخفى..
لكن رواية سلوك المسلمين إلى ثنية ذات الحنظل قد تضمنت
فقرة نرى أنها مقحمة في الرواية، لأسباب لا تخفى، فقد قالت الرواية:
إنه
«صلى الله عليه وآله»
قال لأصحابه:
اسلكوا ذات اليمين بين ظهور الحمض، فإن خالد بن الوليد
بالغميم في خيل لقريش طليعة.
«كره
رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
أن يلقاه، وكان بهم رحيماً».
ونقول:
صحيح أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
كان رحيماً، ولكن بالمؤمنين. أما المشركون المحاربون لله ولرسوله
ولدينه، فالنبي
«صلى الله عليه وآله»
كان شديداً عليهم، ولا يتساهل معهم، إلا بمقدار ما يكون ذلك ضرورياً
لدفع أذاهم عن أهل الإيمان، وتأليفهم على الإسلام. وقد وصف تعالى
المؤمنين بقوله: ﴿..
أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ..﴾
([44]).
فما معنى حشر هذه الكلمة المنسوبة إلى رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
في هذا الموضع؟!
ثم إن من الواضح:
أنه
«صلى الله عليه وآله»
لم يأت قريشاً محارباً، وإنما جاء معتمراً، محرماً، فلا مكان للحديث عن
الرحمة لقريش..
كما أن الاستفادة من عنصر المفاجأة من شأنه أن يسقط
مقاومة العدو، ويضيِّع
عليه فرصة تسديد ضربته، ويجعله في حالة ضياع وارتباك. ومن شأن هذا:
أن يحفظ للمسلمين هيبتهم وقوتهم، وهيمنتهم، ويصون لهم سلامتهم.
ومن جهة ثالثة:
إن خالداً ومن معه
ـ
أنفسهم
ـ
كانوا يعرفون أن لقاء المسلمين في ساحة الحرب لن يكون
في مصلحتهم، خصوصاً بملاحظة الفارق الكبير في حجم القوة فيما بين
الفريقين، فإن المسلمين كانوا أضعاف المشركين، وفيهم علي «عليه السلام»
الذي عرفوه في بدر، وفي أحد، والخندق، و.. فهل تراهم يجازفون بأرواحهم
في مثل هذه الأحوال؟!
إن غاية ما تستطيع هذه الطليعة فعله هو مشاغلة المسلمين
لبعض الوقت، وإعاقة حركتهم إلى أن تأتي قريش وحلفاؤها إلى نجدتها..
وقد رووا أيضاً:
أن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
قد أعطى ثنية ذات المرار صفة باب حطة الذي كان لبني إسرائيل، وأن من
يصعدها يحط عنه ما يحط عن بني إسرائيل. وأنه لا يجوز أحد في تلك الليلة
هاتيك الثنية إلا غفر له.. وأنه قد غفر للركب أجمعين إلا رويكباً
واحداً على جمل أحمر الخ..
ونقول:
إن لنا تساؤلات ههنا لا بد من طرحها، نذكر منها ما يلي:
1 ـ
لقد قال تعالى: ﴿وَإِذْ
قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ
شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ
نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، فَبَدَّلَ
الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا
عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ
يَفْسُقُونَ﴾([45]).
وقد أخبر النبي «صلى الله عليه
وآله»:
أن كل ما كان في الأمم السالفة سيكون في هذه الأمة
مثله.
وفي نص آخر:
لتركبن
سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، ومطابق النعل
بالنعل، حتى لو دخل أولئك جحر ضب لدخل هؤلاء فيه.
وفي بعض الروايات:
لا تخطئون طريقهم، ولا يخطئكم
سنة بني إسرائيل([46]).
وفي
رواية أخرى:
أن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
لما خرج إلى خيبر (وفي حديث إلى حنين) مر على شجرة،
يقال لها: ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم.
فقالوا:
يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.
فقال لهم النبي «صلى الله عليه
وآله»:
هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة.
والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم([47]).
وهذا معناه:
أن موضوع باب حطة المذكور هنا سيقع مشابهاً لما كان في
بني إسرائيل، حيث تذكر الروايات: أن
بني إسرائيل
قد أخطأوا خطيئة، فأحب الله أن ينقذهم منها، إن تابوا، فقال لهم:
إن انتهيتم إلى باب القرية، فاسجدوا وقولوا حطة. تنحط
عنكم خطاياكم.
فأما المحسنون، ففعلوا ما أمروا به.
وأما الذين ظلموا فزعموا:
«حنطة
حمراء»
الخ.. ([48]).
أي أنهم بدل أن يقولوا:
حطة.
قالوا:
حنطة حمراء، تجاهلاً واستهزاءً.
والمراد بقولهم:
«حطة»
هو: حط عنا ذنوبنا يا الله.
وتطبيق ذلك على أصحاب رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
في الحديبية، معناه:
أن جماعة الخلص من المؤمنين هم الذين أطاعوا الله
ورسوله في قضية الحديبية، أما الذين ظلموا فبدَّلوا
قولاً غير الذي قيل لهم،
ولم يقبلوا ما جاءهم به رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
واستخفوا به. فإعطاء وسام المغفرة للجميع لا يتلاءم مع ما أخبر الله
ورسوله به من أن قوم النبي
«صلى الله عليه وآله»
سوف يفعلون مثل فعل بني إسرائيل..
2 ـ
إن من الواضح: أن مجرد مسيرهم وفق دلالة الدليل،
ووصولهم إلى ثنية المرار لا يكفي لاعتبار ذلك بمثابة باب حطة. بل هذا
بمثابة خروج بني إسرائيل من أرض التيه، ونجاتهم منها..
فلا بد أن يتعرضوا لامتحان يشبه ما تعرض له بنو
إسرائيل، فإذا
اجتازوه،
استحقوا
المغفرة للخطايا،
تماماً كما استحقها الذين أمروا بأن يدخلوا باب حطة سجداً، وأن يطلبوا
حط الذنوب عنهم. وهذا ما لم يحصل من المسلمين بعد، فلماذا يبادر رسول
الله
«صلى الله عليه وآله»
ويمنحهم هذه المغفرة؟! في حين أن المغفرة تحتاج إلى التوبة، ولم يظهر
منهم بعد الذنب، ما يدل على التوبة، أو يشير إليها.
3 ـ
لقد كان بين المسلمين أيضاً أناس من المنافقين، وقد
اعتبروا عبد الله بن أبي كان رأسهم وقد حضر أيضاً الحديبية، فهل غفر
الله له أيضاً؟! كما هو صريح العبارة المؤكدة على أن المغفرة قد نالت
كل الحاضرين بدقة تامة، باستثناء رجل واحد، هو راكب الجمل الأحمر؟!
ويدل على حضور ابن أُبي في غزوة
الحديبية قولهم:
إن قريشاً بعثت في الحديبية إلى أُبي بن سلول: إن أحببت أن تدخل فتطوف
في البيت، ففعل، فقال له ابنه عبد الله: يا أبت أذكرك الله ألا تفضحنا
في كل موطن؛ تطوف، ولم يطف رسول الله
«صلى الله عليه وآله»؟!
فأبى حينئذٍ، وقال:
لا أطوف حتى يطوف رسول الله
«صلى الله عليه وآله».
وفي لفظ:
إن لي في رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
أسوة حسنة.
فلما بلغ رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
امتناعه (رض) أثنى عليه بذلك([49]).
كما أن الجد بن قيس كان في ذلك الجمع أيضاً. وكان يرمى
بالنفاق، وقد قالوا: إنه نزل في حقه في غزوة تبوك ما يدل على نفاقه.
بل هم يقولون:
إنه حين جرت بيعة الرضوان تخلف عنها، ولم يتخلف عنها غيره.
قال بعض من حضر:
كأني
أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته، يستتر بها من الناس([50]).
فلماذا لم يستثنه النبي
«صلى الله عليه وآله»
ممن غفر له من الحاضرين في الحديبية؟!
بل إننا نلاحظ:
أن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
قد أخذ البيعة في الحديبية من بعض من حضر ثلاث مرات.. أو مرتين كما كان
الحال بالنسبة لسلمة بن الأكوع وغيره..
والبعض.. وإن كان يعتبر ذلك فضيلة لسلمة، ويظنه تنويهاً
بشجاعته التي أظهرها في غزوة ذي قرد..
إلا أننا نشك كثيراً في صحة هذا
التعليل، فإنهم يقولون:
إن كثيرين من الصحابة كانوا أفضل من ابن الأكوع، ولأجل ذلك هم لا يرضون
بتفضيل ابن الأكوع على ما يدَّعون أنهم العشرة المبشرون بالجنة، وهم
يرون: أن أبا بكر، وعمر, وعثمان، وعلياً
«عليه
السلام»،
أفضل من سلمة بن الأكوع بمراتب.
وأما شجاعة سلمة.. فلا شك في أنها لا تصل إلى مستوى
شجاعة أبي دجانة، أو زيد بن حارثة، أو ابن رواحة، أو الزبير، أو أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب
«عليه
السلام».
فلماذا خصه النبي
«صلى الله عليه وآله»
بأخذ البيعة منه ثلاث مرات دون هؤلاء، ودون غيرهم، من أصحاب المواقف
المشهورة؟!
على أننا قد قدمنا:
أن ما يذكرونه عنه في غزوة ذي قرد لا يصح، والشواهد
كلها على خلافه..
من أجل ذلك كله وسواه نقول:
إننا لا نجد تفسيراً مقبولاً أو معقولاً لطلب البيعة
منه أكثر من مرة إلا أنه
«صلى الله عليه وآله»
كان يتخوف من نكثه، فأراد أن يحرجه بذلك أمام المئات من صحابته، وأن
يشير له: بأنه
«صلى الله عليه وآله»
عالم بدخيلة نفسه، فعليه أن يلزم حده، ويقف عنده.
([1])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص36 و 37 والإصابة ج1 ص429.
([2])
الموافق لقواعد اللغة هو «الحرمُ» بالرفع.
([3])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص36.
([4])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص37.
([5])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص37 وراجع: السيرة النبوية لابن هشام ج3
ص356 والسيرة الحلبية ج3 ص12 والسيرة النبوية لدحلان ج2 والنص
والإجتهاد ص167 والكامل ج2 ص75 ومكاتيب الرسول ج3 ص87 ومسند
أحمد ج4 ص323 وكنز العمال ج4 ص439 وتفسير القرآن العظيم لابن
كثير ج4 ص209 وتاريخ الأمم والملوك للطبري ج2 ص272، والبداية
والنهاية ج4 ص189 وعن عيون الأثر ج2 ص115 وموسوعة التاريخ
الإسلامي ج2 ص605 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص313.
([6])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص37
وشرح النهج للمعتزلي ج14 ص111 وكنز العمال ج10 ص484 والسنن
الكبرى للبيهقي ج10 ص109 والمصنف للصنعاني ج5 = = ص331 والسنن
الكبرى للنسائي ج5 ص264 وصحيح ابن حبان ج11 ص217 والمعجم
الكبير ج20 ص10 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج4 ص212 والدر
المنثور ج6 ص76 وتاريخ مدينة دمشق ج57 ص225.
([7])
الآية 102 من سورة النساء.
([8])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص38 وج8 ص250 وموسوعة التاريخ الإسلامي
ج2 ص607 ومستدرك الوسائل ج6 ص518 والبحار ج20 ص348 وج83 ص110
والنص والإجتهاد ص165 وراجع: مسند أحمد ج4ص59 و 60 والسنن
الكبرى للبيهقي ج3 ص254 والمصنف للصنعاني ج2 ص505 ومسند أبي
داود الطيالسي ص192 والمصنف لابن أبي شيبة ج2 ص351 والسنن
الكبرى للنسائي ج1 ص596 والمنتقى من السنن المسندة ص68 وشرح
معاني الآثار ج1 ص318 والمعجم الكبير ج5 ص213 و 214 و 215 و
216 وسنن الدارقطني ج2 ص47 وكنز العمال ج8 ص415 وتفسير القمي
ج2 ص310 والتبيان ج3 ص311 وتفسير مجمع البيان ج3 ص177 والتفسير
الصافي ج1 ص494 وج5 ص33 وتفسير كنز الدقائق ج2 ص606 وتفسير
الميزان ج5 ص64 وج18 ص264 وجامع البيان ج5 ص338 و 349 ومعاني
القرآن ج2 ص179 وأحكام القرآن ج2 ص331 وعن أسباب نزول الآيات
ص120 وزاد المسير ج2 ص182 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج5
ص364 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج1 ص561 وتفسير الجلالين
ص285 والدر المنثور ج2 ص211 و 214 ولباب النقول ص70 وفتح
القدير ج1 ص509 وتهذيب الكمال ج34 ص161 والبداية والنهاية ج4
ص93 و 94 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص157.
([9])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص37 ومسند أحمد ج4 ص328 وعن صحيح البخاري
ج3 ص178 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص218 وعن فتح الباري ج5 ص243
والمصنف للصنعاني ج5 ص331 وصحيح ابن حبان ج11 ص217 والمعجم
الكبير ج20 ص10 وإرواء الغليل ج1 ص55 وتفسير مجمع البيان ج9
ص195 وتفسير الميزان ج18 ص465 وجامع البيان ج26 ص127 وتفسير
القرآن العظيم لابن كثير ج4 ص212 والدر المنثور ج6 ص76 وتاريخ
مدينة دمشق ج57 ص226 وأسد الغابة ج4 ص198 والسيرة النبوية لابن
كثير ج3 ص330.
([10])
أجرل: الجرل الحجارة. وقيل: الشجر مع الحجارة، أنظر لسان العرب
ج1 ص603.
([11])
ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ج4 ص165.
([12])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص39
والكافي ج8 ص322 وشرح أصول الكافي ج12 ص448 والبحار ج20 ص365
وج83 ص111 ومستدرك سفينة البحار ج2 ص31 وعن صحيح مسلم ج8 ص123
والديباج على مسلم ج6 ص139 وتحفة الأحـوذي ج10 ص247 ومسند أبي
يعـلى ج3 ص394 والمعجـم الأوسط ج3 = = ص178 وكنز العمال ج10
ص384 وتفسير نور الثقلين ج5 ص65 وتفسير القرآن العظيم لابن
كثير ج4 ص203 وتاريخ مدينة دمشق ج11 ص229.
([13])
الآية 58 من سورة البقرة، وراجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص39.
([14])
الآية 58 من سورة البقرة، وراجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص39.
([15])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص39 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج1
ص103 والدر المنثور ج1 ص71.
([16])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص39.
([17])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص39.
([18])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص37 وعن صحيح مسلم ج8 ص123 والمستدرك
للحاكم ج4 ص83 والديباج على مسلم ج1 ص139 وتحفة الأحوذي ج10
ص247 و 248 ومسند أبي يعلى ج3 ص394 والمعجم الأوسط ج3 ص178
وكنز العمال ج1 ص102 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج4 ص202 و
203 وتاريخ مدينة دمشق ج11 ص229 و 230 وج35 ص85 ومناقب أهل
البيت ص462 وسنن الترمذي ج5 ص358 ومجمع الزوائد ج9 ص161 ومعرفة
علوم الحديث ص216 وضعيف سنن الترمذي ص518.
([19])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص35 و 36 عن مسلم في صفات المنافقين رقم
(12) والبيهقي في دلائل النبوة ج4 ص109 وذكر ابن كثير في
التفسير ج4 ص202 وصاحب الجمل أن هذا المنافق هو: الجد بن قيس.
([20])
وعن صحيح مسلم ج8 ص123 والمستدرك للحاكم ج4 ص83 والديباج على
مسلم ج6 ص139 وتحفة الأحوذي ج10 ص248 ومسند أبي يعلى ج3 ص394
والمعجم الأوسط ج3 ص178 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج4
ص202 و 203 وتاريخ مدينة دمشق ج11 ص229 و 230.
([21])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص36 ـ 40.
وفي
المصادر بعض النصوص، فراجع: مسند أحمد ج4 ص82 ومجمع الزوائد
ج10 ص54 وفتح الباري ج8 ص77.
([22])
تاريخ الإسلام (المغازي) ص366.
([23])
مسند أحمد ج4 ص328 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص218 وج10 ص109
وعن فتح الباري ج5 ص242 والمصنف للصنعاني ج5 ص330 والسنن
الكبرى للنسائي ج5 ص171 وصحيح ابن حبان ج11 ص217 وجامع البيان
ج26 ص126 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج4 ص212 والدر
المنثور ج6 ص76 وتاريخ مدينة دمشق ج57 ص225 وسبل الهدى والرشاد
ج5 ص37.
([24])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص36 والإصابة ج1 ص151.
([25])
معجم البلدان (ط سنة 1388 هـ) ج1 ص480 والبحار ج18 ص37 ومقدمة
فتح الباري ص88 وتاريخ مدينة دمشق ج25 ص298 وج39 ص77 والسيرة
النبوية لابن كثير ج1 ص159.
([26])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص82 وعن فتح الباري ج7 ص108 وتاريخ مدينة
دمشق ج9 ص508.
([27]
) فقه السيرة (ط دار الفكر) ص324 و 325.
([29])
الدر المنثور ج2 ص211 عن عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن أبي
شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، وأبي داود، والنسائي، وابن جرير،
وابن أبي حاتم، والدارقطني، والطبراني، والحاكم وصححه،
والبيهقي عن أبي عياش الزرقي.
وفي
الدر المنثور: عن الترمذي وصححه، وابن جرير عن أبي هريرة، وفي
الدر المنثور أيضاً ج2 ص213 عن البزار، وابن جرير، والحاكم
وصححه عن ابن عباس.
([30])
الآية 238 من سورة البقرة.
([31])
الدر المنثور ج2 ص211 عن ابن جرير، وعبد بن حميد, وشرح معاني
الآثار ج1 ص317 وصحيح ابن حبان ج7 ص136 وجامع البيان ج5 ص334
وعن تاريخ الأمم والملوك للطبري ج2 ص227.
([32])
الدر المنثور ج2 ص212 عن ابن جرير، وابن أبي حاتم، والطبراني,
والمعجم الكبير ج12 ص195 وجامع البيان ج5 ص344.
([33])
معجم البلدان ج1 ص449 وتفسير كنز الدقائق ج2 ص604 وتاريخ مدينة
دمشق ج39 ص423 ومعجم قبائل العرب ج1 ص22.
([34])
الدر المنثور ج2 ص212 عن عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن
حميد، وابن جرير، والحاكم وصححه.
([35])
الدر المنثور ج2 ص212 عن أبي داود، وابن حبان، والحاكم وصححه،
والبيهقي، ومالك، والشافعي، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد،
والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والدارقطني
ودعائم الإسلام ج1 ص199 ومستدرك الوسائل ج6 ص516 ومناقب آل أبي
طالب ج1 ص170 وعوالي اللئالي ج2 ص62 والبحار ج20 ص176 و 178
وج83 ص112 واختلاف الحديث ص527 ومسند أحمد ج6 ص275 وعن صحيح
البخاري ج5 ص51 والسنن الكبرى للبيهقي ج3 ص265 وشرح صحيح مسلم
ج6 ص128 وعن فتح الباري ج7 ص321 و 326 و 327 والديباج على مسلم
ج2 ص425 وعون المعبود ج4 ص81 والمصنف للصنعاني ج2 ص503 وصحيح
ابن خزيمة ج2 ص303 وصحيح ابن حبان ج7 ص124 ونصب الراية ج2 ص294
و 295 وموارد الظمآن ص155 وكنز العمال ج8 ص419 وإرواء الغليل
ج2 ص292 وجامع البيان ج5 ص341 وأحكام القرآن ج1 ص544 وج2 ص330
والجامع لأحكام القرآن ج5 ص368 وتفسير القرآن العظيم ج1 ص560
وأسد الغابة ج1 ص22 وتفسير الثعالبي ج2 ص291 و 293 والثقات ج1
ص258 والعبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون ج2 ق2 ص29
وموسوعة التاريخ الإسلامي ج2 ص424 و 607 وإعلام الورى ج1 ص189
وسبل الهدى والرشاد ج5 ص180 و 181 و 185 وج12 ص60.
([36])
تفسير البرهان ج1 ص411 عن من لا يحضره الفقيه.
([37])
الدر المنثور ج2 ص213 عن الدارقطني وص214 عن ابن جرير، وابن
أبي شيبة.
([38])
الدر المنثور ج2 ص214 عن ابن أبي شيبة، وابن جرير, والمصنف
لابن أبي شيبة ج2 ص350.
([39])
الدر المنثور ج2 ص214 عن أحمد, ومسند أحمد ج3 ص384 وعن صحيح
البخاري ج5 ص51 ومجمع الزوائد ج2 ص196 وعن فتح الباري ج7 ص324
ومسند ابن راهويه ج1 ص31 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص181 وج8 ص252
وج8 ص252 وج12 ص63.
([40])
راجع: تفسير البرهان ج1 ص230 و 231.
([41])
تفسير البرهان ج1 ص231 عن تفسير القمي والعياشي.
([42])
البرهان (تفسير) ج1 ص411.
([43])
راجع البرهان (تفسير) ج1 ص411 ومن لا يحضره الفقيه ج1 ص293
ووسائل الشيعة ج5 ص479 والكافي ج3 ص456 وتهذيب الأحكام ج3
ص172.
([44])
الآية 29 من سورة الفتح.
([45])
الآيتان 58 و 59 من سورة البقرة.
([46])راجع
هذه الأحاديث في: البحار ج5 ص22 وج13 ص180 وج22 ص390 وج24
ص350 وج28 ص7 و 30 و 282 و 2 وج29 ص450 وج36 ص284 و ج51 ص253
وج52 ص110 وج53 ص72 و 141 والتاج الجامع للأصول ج1 ص43 والسيرة
النبوية لابن هشام ج4 ص893 وإعلام الورى ج2 ص93 والسيرة
النبوية ج3 ص616 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص314 واللمعة البيضاء
ص396 ودعائم الإسلام ج1 ص1 والإيضاح ص426 والمسترشد ص229
وأمالي المفيد ص135 والصراط المستقيم ج3 ص107 ومستدرك سفينة
البحار ج5 ص185 وراجع: المستدرك للحاكم ج4 ص455 ومجمع الزوائد
ج7 ص261 والمصنف لابن أبي شيبة ج8 ص634 وشرح النهج للمعتزلي ج9
ص286 والجامع الصغير ج2 ص401 وكنز العمال ج11 ص134 وتفسير
العياشي ج1 ص303 ومجمع البيان ج7 ص405 وج10 ص308 والتفسير
الصافي ج2 ص26 ونور الثقلين ج1 ص606 ومسند أحمد ج3 ص74
والإعتصام بالكتاب والسنة ج8 ص151 و 57 والميزان (تفسير) ج2
ص108 وج3 ص380 وتفسير القرآن للصنعاني ج2 = = ص235 والجامع
لأحكام القرآن ج7 ص273 وج8 ص97 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص364
وج4 ص523 والدر المنثور ج6 ص56 والتاريخ الكبير ج4 ص163
والثقات ج6 ص191 والبداية والنهاية ج4 ص372 والعبر وديوان
المبتدأ والخبر لابن خلدون ج2 ق2 ص46.
([47])
عوالي اللآلي ج1 ص314 وكتاب الأربعين للشيرازي ص266 ومسند أحمد
ج5 ص218 وصحيح ابن حبان ج15 ص94 والصراط المستقيم ج3 ص107 وسنن
الترمذي ج3 ص322 وسنن أبي داود الطيالسي ص191 والمصنف للصنعاني
ج11 ص369 ومسند الحميدي ج2 ص375 والمصنف لابن أبي شيبة ج8 ص634
والسنن الكبرى للنسائي ج6 ص346 ومسند أبي يعلى ج3 ص30 والمعجم
الكبير للطبراني ج3 ص243 و 244 والبيان في تفسير القرآن ص221
والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص893 والبداية والنهاية ج4 ص372
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص616.
([48])
البحار ج9 ص185 وج13 ص180 و 181 و 183 و 187 عن قصص الأنبياء
وراجع: مجمع البيان ج1 ص118 ـ 120 ومجمع الزوائد ج6 ص314 وفتح
الباري ج8 ص229 وتفسير الإمام العسكري ص260 و 545 ومجمع البيان
ج1 ص230 وجوامع الجامع ج1 ص180 والتفسير الصافي ج1ص136
والتفسير الأصفى ج1 ص39 وكنز الدقائق ج1 ص255 وجامع البيان ج1
ص433 وتفسير القرآن العظيم ج1 ص103 والدر المنثور ج1 ص71
والبداية والنهاية ج1 ص379 وقصص الأنبياء للجزائري ص299.
([49])
السيرة الحلبية ج3 ص18 وستأتي بقية المصادر لذلك إن شاء الله
تعالى.
([50])
السيرة الحلبية ج3 ص17 وستأتي مصادر أخرى لذلك إن شاء الله.
|