|
تعـمـد صـنع الـمـعـجـزة
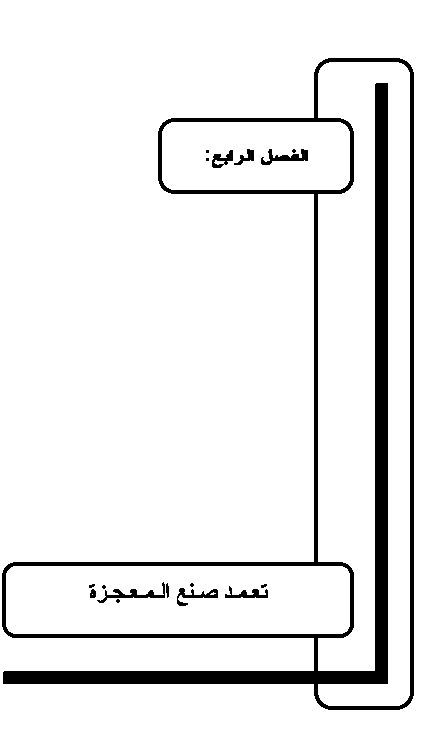
تعمد صنع المعجزة:
قالوا:
إنه لما بركت ناقة رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
المسماة بـ
«القصواء»
في ذلك المكان، نزل رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
بأقصى الحديبية على ثمد([1])
من ثمادها ظنون([2])
قليل الماء يتبرَّض([3])
الناس ماءه تبرُّضاً، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه.
فاشتكى الناس إلى رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
قلة الماء، وفي لفظ:
«العطش»،
فانتزع سهماً، من كنانته، فأمر به، فغرز في الماء، فجاشت بالرَّواء حتى
صدروا عنها بعطن([4]).
قال المِسْوَر:
وإنهم ليغترفون بآنيتهم جلوساً على شفير البئر.
قال محمد بن عمر:
والذي نزل بالسهم ناجية بن الأعجم ـ رجل من أسلم،
ويقال: ناجية بن جندب وهو سائق بُدن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
وقد روي: أن جارية من الأنصار قالت لناجية وهو في القليب:
يـا أيهــا المـاتـح دلــوي
دونـكــا إني رأيـت الـنـاس يحـمـدونـكـا
يـثـنـون خـيراً ويـمـجـدونـكــا
فقال ناجية وهو في القليب:
قــد عـلـمـت جـاريـة يـمانــيــه
أني أنــا المـاتـح واسـمـي نـاجـيه
وطـعـنـة ذات رشـــاش واهـيـه طـعـنـتـهـا تحت صدور العاديه([5])
قال محمد بن عمر:
حدثني الهيثم بن واقد، عن عطاء بن مروان، عن أبيه قال:
حدثني أربعة عشر رجلاً ممن أسلم من أصحاب رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
أنه ناجية بن الأعجم،
يقول:
دعاني رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
حين شُكي إليه قلة الماء، فأخرج سهماً من كنانته، ودفعه إليَّ، ودعا
بدلو من ماء البئر، فجئته به، فتوضأ فمضمض فاه، ثم مجَّ في الدلو ـ
والناس في حر شديد ـ وإنما هي بئر واحدة، قد سبق المشركون إلى بَلْدَح
فغلبوا على مياهه، فقال:
«انزل
بالدلو فصبها في البئر، وأثر ماءها بالسهم».
ففعلت، فوالذي بعثه بالحق ما كدت أخرج حتى يغمرني، وفارت كما تفور
القدر، حتى طمت واستوت بشفيرها، يغترفون من جانبها حتى نهلوا من آخرهم.
وعلى الماء يومئذٍ نفر من المنافقين، منهم عبد الله بن
أُبي.
فقال أوس بن خولى:
ويحك يا أبا الحباب!! أما آن لك أن تبصر ما أنت عليه؟
أبعد هذا شيء؟
فقال:
إني قد رأيت مثل هذا.
فقال أوس:
قبحك الله، وقبح رأيك!
فأقبل ابن أُبي يريد رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، فقال:
«يا
أبا الحُبَاب: أنَّى رأيت مثلما رأيت اليوم»؟
فقال:
ما رأيت مثله قط.
قال:
«فلم
قلته»؟
فقال ابن أُبي:
يا رسول الله استغفر لي، فقال ابنه عبد الله بن عبد
الله: يا رسول الله استغفر له، فاستغفر له([6]).
فقال عمر:
ألم ينهك الله ـ يا رسول الله ـ أن تصلي عليهم أو
تستغفر لهم؟!
فأعرض عنه رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
وأعاد عليه، فقال له:
«ويلك
إني خيِّرت فاخترت، إن الله يقول: ﴿اسْتَغْفِرْ
لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ الله لَهُمْ..﴾([7]).
فلما مات عبد الله، جاء ابنه إلى رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
فقال:
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن رأيت أن تحضر جنازته.
فحضر رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
وقام على قبره، فقال له عمر: ألم ينهك الله أن تصلي على أحد منهم»([8]).
وروى ابن إسحاق، ومحمد بن عمر، عن البراء بن عازب (رضي
الله عنهما) قال: أنا نزلت بالسهم.
وروى أحمد، والبخاري، والطبراني، والحاكم في الإكليل،
وأبو نعيم عن البراء بن عازب، ومسلم عن سلمة بن الأكوع، وأبو نعيم عن
ابن عباس، والبيهقي عن عروة، قال البراء: كنا مع رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
بالحديبية أربع عشرة مائة، ـ والحديبية: بئر ـ فقدمناها وعليها خمسون
شاة ما ترويها فتبرضها، فلم نترك فيها قطرة.
قال ابن عباس:
وكان الحر شديداً، فشكى الناس العطش، فبلغ ذلك النبي
«صلى الله عليه وآله»،
فأتاه، فجلس على شفيرها، ثم دعا بـ
«إناء».
وفي لفظ:
بـ
«دلو»
فتوضأ في الدلو، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد ثم إنها
أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا.
قال البراء:
ولقد رأيت آخرنا أُخرج بثوب خشية الغرق، حتى جرت نهراً([9]).
وقال ابن عباس، وعروة:
ففارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها، وهم جلوس
على شفيرها.
وروى البخاري في المغازي، وفي الأشربة، عن جابر بن عبد
الله، عن سلمة بن الأكوع (رضي الله عنهما) قالا: عطش الناس يوم
الحديبية ورسول الله
«صلى الله عليه وآله»
بين يديه ركوة.
وقال جابر في رواية:
وقد حضر العصر، وليس معنا ماء غير فضلة، فجعل في إناء،
فأتي به رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
فتوضأ منها، ثم أقبل الناس نحوه، فقال رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
«ما
لكم»؟
قالوا:
يا رسول الله، ليس عندنا ماء نتوضأ به، ولا نشرب إلا ما
في ركوتك. فأفرغتها في قدح، ووضع رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
يده في القدح، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا
وتوضأنا،
فقال سالم بن أبي الجعد:
فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟
قال:
لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة([10]).
قالوا:
ولما ارتحلوا أخذ البراء بن عازب ذلك السهم، فجف الماء([11]).
ولنا مع ما تقدم عدة وقفات، هي التالية:
النبي
 يصنع المعجزة:
يصنع المعجزة:
قرأنا في النصوص السابقة:
أنه
«صلى الله عليه وآله»
لا يكتفي بالدعاء ليزيد لهم ذلك الماء القليل. بل هو ينتزع سهماً من
كنانته، ويطلب منهم أن يغرزوه في موضع خروج الماء. ثم تجري عملية غرزه،
على يد أحدهم، الذي اعتبر ذلك بمثابة فضيلة له، وأرادوا من التاريخ أن
يسجلها له..
وليكون ذلك تخليداً لهذه الكرامة الإلهية الظاهرة
لرسوله الأكرم
«صلى الله عليه وآله»..
واختيار هذه الطريقة في استنباط الماء له مراميه
ودلالاته، ولعل مما يشير إليه هو الأمور التالية:
1 ـ
إنه يظهر بوضوح تام: أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
قد تصدى للتصرف التكويني بصورة عملية، بطريقة تدلل على أن ذلك من شؤونه
وداخل تحت إرادته واختياره. وليس هو مجرد دعاء قد استجاب الله تعالى له
في خصوص هذا المورد وانتهى الأمر.. وقد تكون هناك مصلحة في الاستجابة
له في موضع آخر ومناسبة أخرى، وقد لا تكون.
2 ـ
إن استمرار وجود السهم في البئر أمام أعين المستفيدين
من مائه سوف يبقي القضية ماثلة أمام أعينهم، وسيعطيهم ذلك النفحة
الروحية الغامرة التي يحتاجون إليها، خصوصاً في هذا الأمر الذي
سيواجهون فيه المفاجآت التي تمس غرورهم، ويحتاجون في إعادة توازنهم
الروحي إلى مثل تلك النفحات.
3 ـ
إن المعرفة الحسية تبقى أقوى تأثيراً في الناس
العاديين، من المعرفة التصورية، خصوصاً مع بقاء مكونات هذه المعرفة
ماثلة للعيان مدة من الزمن. ومع اقترانها بحركات متنوعة، وأعمال
مختلفة، وجهد جسدي لإنتاجها، ولو من خلال الذين حملوا ذلك السهم،
ونزلوا به إلى البئر وغرسوه فيها..
4 ـ
ويعزز هذا الأمر ويقويه ويرسخه في وجدان الناس، السعي
لتسجيل ذلك الحدث المرتبط بالغيب في الشعر العربي الذي يلامس مشاعر
الإنسان وأحاسيسه، حتى لو كان الذين يبذلون تلك المحاولة يريدون
توظيفها في مجالات، لا يحق لهم التعرض لها، ولا المساس بها.
قد رأينا:
أن الروايات قد اختلفت في من نزل بالسهم إلى البئر، هل
هو البراء بن عازب، أو ناجية بن الأعجم، أو ناجية بن جندب، أو خالد بن
عبادة الغفاري؟
وقد لاحظنا:
أن ثمة تسابقاً في نسبة ذلك الأمر إلى هذا، أو ذاك،
وأنشدت أسلم أبياتاً من الشعر، نسبتها لناجية([12]).
وزعمت أسلم أيضاً:
أن جارية من الأنصار قالت شعراً في ذلك([13]).
ولعل سبب هذا التسابق هو ظنهم:
أن ذلك يتضمن إثبات فضيلة لفاعله. فأراد كل فريق أن يجر
النار إلى قرصه، وينسب الفضل إلى نفسه..
غير أننا نتوقف هنا عند أمرين:
الأول:
أن ثمة شكاً كبيراً في صحة ما زعموه، من نزول أي من
الناس إلى تلك البئر.
فقد روي أيضاً:
أن الناس لما لم يبق في العين قطرة ـ وكان الحر شديداً
ـ شكوا العطش، فبلغ ذلك النبي «صلى الله عليه وآله»، فأتى تلك البئر،
فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء أو بدلو، فتوضأ فيه، ثم مضمض، ودعا، ثم
صبه فيها([14]).
وفي نص آخر عن ناجية بن جندب:
أنه
«صلى الله عليه وآله»
نزل على الحديبية، وهي تنزح، فألقى فيها سهماً أو سهمين من كنانته، ثم
بصق فيها، ثم دعا فعادت عيونها([15]).
وعن أوس بن خولي:
توضأ في الدلو، ثم أفرغه فيها، وانتزع السهم، ثم وضعه
فيها.
وعن عروة:
توضأ في الدلو، وصبه في البئر، ونزع سهماً من كنانته،
فألقاه فيها، ففارت([16]).
فذلك كله يدل على:
أنه لم يرسل أحداً إلى البئر، لا بالدلو، ولا بالسهم، بل هو
«صلى الله عليه وآله»
الذي جاء إلى البئر، وألقى فيها هذا، وصب فيها ذاك، وبصق فيها..
الثاني:
لنفترض صحة الرواية التي تقول: إن النبي
«صلى الله عليه وآله»
قد كلف شخصاً بأمر السهم والدلو.
إلا أننا نقول:
إن ذلك لا يحمل معه منح أي وسام أو فضيلة لذلك الشخص،
ولا يدل على الاعتراف له بشيء من الفضل والكرامة، ما لم يصاحب ذلك
إشارة أو دلالة أخرى تظهر هذه الخصوصية فيه..
بل ربما يكون هناك من الدلالات ما
يشير إلى:
أن من كلفه النبي «صلى الله عليه وآله» بذلك هو الذي يحتاج إلى تثبيت
اليقين، وإزالة الريب عن قلبه..
وعلى هذا الأساس نقول:
إنه لا دليل على:
أن من كلف بغرس السهم في البئر، كان من هذا الفريق أو
من ذاك، حتى نجد شواهد أخرى تشير إلى ذلك.
ويظهر من النصوص السابقة:
أن العيون الغزيرة والمياه الكثيرة قد كانت في بلدح،
حيث نزل المشركون.. أما الحديبية فكانت المياه شحيحة فيها، وإنما هي
بئر واحدة([17]).
وما أشبه الليلة بالبارحة فإن المشركين في بدر، كانوا
على عيون الماء، ولم يكن لدى المسلمين ماء.. وقد سقى الله المسلمين
الماء بالمعجزة في بدر، وفي الحديبية كان المشركون على العيون الغزيرة
والعذبة.. والمسلمون كانوا بلا ماء، فسقاهم الله تعالى بالمعجزة أيضاً.
ثم كانت النتائج بين بدر والحديبية متشابهة، فقد نصر
الله المسلمين فيهما معاً، وكان لهم في الحديبية أعظم الفتح. وهكذا كان
الحال في بدر.
وقد اختلفوا في الشخص الذي تولى مهمة غرس السهم في بئر
الحديبية.
فالبراء بن عازب يقول:
أنا نزلت بالسهم([18]).
وروي:
أن خالد بن عبادة الغفاري([19])
قال ذلك عن نفسه.
وروي:
أن الذي نزل به هو ناجية بن الأعجم.. حسبما روي عنه أنه
قاله([20]).
ورواية أخرى تقول:
إنه ناجية بن جندب، سائق بُدن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»([21]).
وقد يمكن ترجيح:
أن يكون اسم الذي نزل إلى البئر هو ناجية وذلك استناداً
إلى أبيات الشعر المتقدمة، التي صرح فيها باسم ناجية..
غير أننا نقول:
أولاً:
إن غاية ما يدل عليه هذا الشعر هو: أن الماتح للناس كان
اسمه ناجية.. وقد يكون الماتح هو نفسه الذي نزل بالسهم، وقد يكون
الماتح شخصاً، والذي نزل بالسهم شخصاً آخر.
غير أن مما لا شك فيه:
أن ناجية كان في البئر حين قيل هذا الشعر، وأنه قد كان
ثمة حاجة إلى استخراج الماء من البئر، قبل أن يفيض منها إلى خارجه.
ثانياً:
إن ثمة تناقضاً يثير الشبهة في صحة أصل نزولهم، فالشعر
يقول: إن ناجية بن جندب كان يمتح الماء للناس، وكان الناس يمدحونه
ويمجدونه على ذلك.
بينما رواية ناجية بن الأعجم تقول:
إن الماء فاض، حتى كاد يغمره قبل أن يتمكن من الخروج من
البئر، وصار الناس يفترقون من جانبها حتى نهلوا عن آخرهم.. فلم تكن
هناك حاجة لوجود ماتح أصلاً.
كما أن رواية البراء قد صرحت:
بأن البئر فاضت حتى جرت نهراً.
وقال بعضهم:
إن وجه الجمع بين تلك الروايات المتناقضة في من نزل
بالسهم، هو: أنهم جميعاً قد تعاونوا على ذلك([22]).
إن صحة هذا الجمع تتوقف على الصعوبة البالغة في النزول
إلى البئر، بحيث يحتاج النازل إليها إلى مساعدة، مع أنه لا دليل يثبت
ذلك.
ولو فرضنا:
صحة ذلك، وأنهم عاونوا حامل السهم على النزول، فهل يصح
قول كل واحد منهم: إنه هو الذي نزل بالسهم؟!..
أما قول الزرقاني:
تعاونوا على ذلك بالحفر وغيره، فهو غير ظاهر الوجه.
فما معنى هذا الكلام؟! أوليست الحفرة كانت موجودة؟!
وكانت بئراً واحدة، حسبما صرحوا به؟!..
أم أن تلك البئر كانت قد ردمت، وكانت بحاجة إلى حفر
جديد؟! فلماذا كان الناس حولها ويتبرضونها؟! ولماذا لم تصرح الروايات
بغير تثوير موضع الماء بالسهم؟! ولماذا؟! ولماذا؟!
ثم إن الروايات قد ذكرت:
أنه
«صلى الله عليه وآله»
قد توضأ، ومضمض فاه، ثم مج في الدلو، وبعثها فصبت في البئر، وأثير
ماؤها بالسهم([23]).
ونقول:
1 ـ
إن في هذا الحديث تأكيداً على قداسة أشخاص اختارهم
الله، واصطفاهم، واجتباهم، وعلى أن لمباشرة هؤلاء الأشخاص للأشياء
تأثيراً في نمائها، وفي حلول البركة فيها..
2 ـ
إن هذا الفعل من رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
يستبطن دعوة عفوية للناس إلى أن يكون كل همهم هو تزكية نفوسهم،
وتطهيرها، لتكتسب طرفاً من هذه القداسة، التي يعلمون أنها وليدة ذلك
الطهر، ولو في بعض مراتبها.. وأنها صنيعة هذا القرب من الله، ورهينة
رضاه..
3 ـ
هذا كله بالإضافة إلى ما أشرنا إليه مرات كثيرة من أن
ظهور هذه المعجزات والكرامات هام جداً في الربط على قلوب المؤمنين، وفي
قطع دابر التسويلات الباطلة التي يثيرها المنافقون، ويخدعون بها
الكثيرين من البسطاء الطيبين والغافلين أو من الهمج الرعاع الذين
يميلون مع الريح، ولا يميِّزون الصحيح الصريح، من المريض والقبيح..
والكلمة المنسوبة إلى ابن أبي في هذا الموقف وهي قوله:
«قد
رأيت مثل هذا»
وجدت آذاناً صاغية، تلقفتها، وتركت لها أثراً في قلوبهم، ودمرت أو فقل
اخترقت جدار السكينة في نفوسهم..
وعن استغفار الرسول الأكرم
«صلى الله عليه وآله»
لابن أبي، حين طلب منه أن يستغفرله، نقول:
قد يقال:
إنه لا يصح، وذلك لما يلي:
أولاً:
إنه لا ريب في أن المنافق مشرك في واقعه وحقيقته، فإن
كان ابن أبي منافقاً، فالمفروض: أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
كان عارفاً به، فكيف يستغفر له، وقد أنزل الله النهي عن الإستغفار
للمشركين؟
ثانياً:
إنه حتى لو لم تكن آية النهي عن الإستغفار للمشركين قد
نزلت آنئذٍ، فإن المنع من ذلك كان ثابتاً في دين الحنيفية، التي كان
رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
يتعبد بها، فلم يكن يجوز له أن يفعل ذلك، حتى لو كان ذلك المشرك غير
مظهر لشركه..
وقد قال تعالى مشيراً إلى ذلك: ﴿وَمَا
كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ
وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِله
تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾([24]).
ثالثاً:
إنهم يزعمون: حسبما تقدم في الجزء السابق: أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
قد نهى عن الاستغفار لأمه في غزوة بني لحيان، وقد كان ذلك قبل
الحديبية.
بل هم يزعمون:
أن قوله تعالى: ﴿مَا
كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ
لِلْمُشْرِكِينَ..﴾([25])
قد نزلت قبل الهجرة بثلاث سنوات([26]).
ولم تقيِّد الرواية هذا النهي
بما يوجب التفريق
بين المشرك المستتر بشركه، والمشرك المعلن به..
غير أننا نقول:
إنه لا بد من تقييد هذه الآية
وسواها، بأن المقصود هو:
الشرك المعلن دون سواه، لأن المطلوب من النبي
«صلى الله عليه وآله»
هو معاملتهم بما يوجبه ظاهر حالهم.. لا بما علمه
«صلى الله عليه وآله»
من خلال علمه الخاص، وهو علم النبوة..
فإذا كانوا يعلنون أنهم على الإسلام، يمارسون شعائره،
فلا يجوز إنكار ذلك عليهم، ولا فضح أمرهم، وذلك تأليفاً لهم على
الإسلام، ولكي يعيشوا في أجوائه، ليدخل الإيمان في قلوبهم بصورة
تدريجية، وليمكن أيضاً لأبنائهم وعشائرهم ومن يلوذ بهم، أو يتصل بهم أن
يعيشوا مع المسلمين، وليروا بأم أعينهم محاسن هذا الدين، كما هو ظاهر.
فالنهي عن الاستغفار للمشرك، إنما هو بالنسبة للمعلن
بشركه، لا للمتستر به..
ولو أراد أن يتنكر للمنافقين لم يكن معنى لوضع سهم
المؤلفة قلوبهم، وذلك واضح لا يخفى.
وقد ذكروا:
أن جماعة من المنافقين قد حضروا في الحديبية..
وقد صرحت الروايات المتقدمة، وكذلك الرواية الآتية تحت
عنوان
«التوحيد،
والاعتقاد بالأسباب»
وكذلك روايات أخرى، أشرنا إليها في الفصل السابق ـ صرحت جميعها ـ:
بوجود المنافقين مثل ابن أُبي، والجد بن قيس وغيرهما في غزوة الحديبية،
وبأنهم قد صدرت منهم أمور دعت الرسول الأعظم
«صلى الله عليه وآله»
إلى اتخاذ مواقف تناسب الحال..
وقد قرأنا آنفاً:
أن ابن أُبي كان على الماء في نفر من المنافقين، وأنه
سئل عن المعجزة التي أظهرها رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
ـ فيما يرتبط بفيضان الماء ـ فادَّعى أنه رأى مثل هذا.. ثم اعترف لرسول
الله
«صلى الله عليه وآله»:
أنه لم ير مثله قط.
وأنه طلب من رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
أن يستغفر له، فاستغفر
«صلى الله عليه وآله»
له([27]).
ونقول:
إنه إذا كان هؤلاء المنافقون قد حضروا الحديبية، وإذا
كانت بيعة الرضوان قد حصلت في هذه المناسبة، وبايع جميع من كان مع رسول
الله
«صلى الله عليه وآله»
ـ بمن فيهم المنافقون ـ وإذا كانوا جميعهم يدخلون الجنة باستثناء صاحب
الجمل الأحمر حسبما تقدم، فإن السؤال الذي يلح بطلب الإجابة الصحيحة
والصريحة هو التالي:
إنه بناءً على ذلك، وبناءً على قول أهل السنة بعدالة
جميع الصحابة، استناداً إلى آيات بيعة الشجرة وهي قوله تعالى:
﴿لَقَدْ
رَضِيَ اللهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ
الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ
عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً﴾([28]).
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ
الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللَّهِ
فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ
وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً
عَظِيماً﴾([29]).
فإن ابن أُبي وجميع من حضر في الحديبية ممن هم على
شاكلته، لابد أن يحكم بصحة إيمانهم استناداً إلى ذلك. ولا يجوز لأهل
السنة إطلاق القول بنفاقه أصلاً، فضلاً عن دعواهم: أنه كان رأس
المنافقين في المدينة.
ويؤكد هذا الأمر ويزيده وضوحاً لنا، وتعقيداً بالنسبة
إلى أصول أهل السنة: أنهم يقولون: إن الله سبحانه قال لرسوله
«صلى الله عليه وآله»
بالنسبة للمنافقين: ﴿وَلاَ
تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ
قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِالله وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ
فَاسِقُونَ﴾([30]).
وبعدما تقدم:
فإنه يرد على أهل السنة سؤال آخر، وهو: إذا لم يكن
هؤلاء هم المنافقون! فمن المقصود بالآيات التي تحدثت عن المنافقين في
سورة
«المنافقون»
و
«البقرة»
و
«التوبة»
وفي
«آل عمران»
و.. و.. وتحدث عنهم رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
في مناسبات كثيرة كما يظهر من مراجعة كتاب الدر المنثور وغيره من كتب
التفسير بالمأثور، فضلاً عن غيرها من كتب الحديث والتاريخ، وما إلى
ذلك؟!
وبناء على ما تقدم نقول:
إن هناك حلولاً لهذه المعضلة، نذكر منها ما يلي:
1 ـ
أن يأخذوا بمذهب أهل البيت
«عليهم
السلام»
في عدد التكبير في صلاة الميت حيث رووا: أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
كان يكبر على المنافقين أربعاً، وعلى صحيحي الإيمان خمساً..
2 ـ
أن يعترفوا: بأن آية بيعة الرضوان لا تدل على عدالة
جميع من بايع رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
بل على عدالة خصوص المؤمنين منهم، ولابد من معرفة صحة الإيمان في كل
واحد منهم بدليل آخر..
ومما يزيد هذا الاستدلال إشكالاً:
أن الآية الأخرى قد أشارت إلى احتمالات نكث البيعة من
قبل بعض من بايع رسول الله «صلى الله عليه وآله»..
3 ـ
أن يتراجعوا عن الحكم بنفاق ابن أُبي، والجد بن قيس،
وغيرهما ممن حضر الحديبية، ويحكموا بأنهم أصحاب إيمان صحيح..
فإذا اختاروا هذا الحل، فإنهم يكونون قد خالفوا حقيقة
ثابتة من الناحية التاريخية، وعليهم بالإضافة إلى ذلك أن يبيِّنوا لنا
من هو المقصود بالآيات التي وردت في سورة
«المنافقون»،
وفي سورة
«البقرة»،
وفي سورة
«آل عمران»،
وفي سورة
«التوبة»
و.. و..؟! ومن هم المقصودون بكلام رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
في هذا الشأن؟!
ثم إن عليهم إذا ادَّعوا عدم نفاق
ابن أُبي:
أن يبيِّنوا لنا سبب سعي عمر لمنع رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
من الصلاة على ابن أُبي، ولماذا لم يستجب له الرسول الأكرم
«صلى الله عليه وآله»
حين طلب منه عمر الامتناع عن ذلك؟!
وزعموا:
أن أبا سفيان قال لسهيل بن عمرو: قد بلغنا أنه ظهر
بالحديبية قليب([31])
فيه ماء. فقم بنا ننظر إلى ما فعل محمد. فأشرفا على القليب، والعين
تنبع تحت السهم، فقالا: ما رأينا كاليوم قط. وهذا من سحر محمد قليل([32]).
وصرحت نصوص أخرى:
بأن قريشاً قد جاءت إلى الحديبية، لا خصوص أبي سفيان.
ونقول:
إن كان ذلك قد حصل قبل الصلح، فيرد عليه:
أن أبا سفيان لا يجرؤ على المجيء إلى الحديبية إذا كان
رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
فيها، خصوصاً مع وجود تلك الجموع معه، فإنهم لن يسكتوا عن وجود رجلين
غريبين يظهران فيما بينهم، بل لا بد أن يتعرفوا عليهما، فإذا عرفوهما
فسيكون لهم شأن معهما، وأي شأن.
وإن كان ذلك قد حصل بعد الصلح، وبعد ارتحال رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
ومن معه من المسلمين..
فيرد عليه:
أنهم يقولون: إن البراء بن عازب قد انتزع ذلك السهم من
موضعه، وذلك حين ارتحال الرسول
«صلى الله عليه وآله»
والمسلمين عنه.. فجف الماء كأن لم يكن هناك شيء([33]).
ولكننا مع ذلك نقول:
إن أبا سفيان كان يعرف الحديبية، وأنها لا ماء فيها،
فإذا كان مع النبي
«صلى الله عليه وآله»
ألف وأربع مائة أو خمس مائة رجل، ومعهم رواحلهم ودوابهم، وربما طائفة
من النساء، فلا بد أن يحتاجوا إلى الكثير من الماء الذي يعرف أنه غير
متوفر في الحديبية.
وهذا يقرِّب إلى الذهن أن يكونوا قد سمعوا بأمر البئر،
وبمعجزة رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
ودفعهم ذلك إلى الذهاب إلى هناك بعد رحيله
«صلى الله عليه وآله»،
فرأوا أنها قد غارت أيضاً، لكي يتبين لهم أن البركات مرهونة به
«صلى الله عليه وآله».
ولكن عنادهم دفعهم إلى الجحود، واعتبار ذلك من السحر.
ولعلهم أرادوا إطلاق هذه الشائعة، لكي لا يتأثر الناس
بما سمعوه عن معجزات وكرامات حصلت لرسول الله
«صلى الله عليه وآله».
روى الشيخان وأبو عوانة، والبيهقي عن زيد بن خالد
«رضي
الله عنه»
قال: خرجنا مع رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
عام الحديبية، فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى بنا النبي
«صلى الله عليه وآله»
الصبح، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟
قلنا:
الله ورسوله أعلم.
قال:
قال الله عز وجل:
«أصبح
من عبادي مؤمن وكافر، فأما المؤمن: من قال: مطرنا برحمة الله وبفضل
الله، فهو مؤمن بي وكافر بالكواكب.
وأما من قال:
مُطرنا بنجم كذا ـ وفي رواية:
بنوء كذا وكذا ـ فهو مؤمن بالكواكب كافر بي»([34]).
وفي نص آخر:
أصبح الناس رجلان مؤمن بالله كافر بالكواكب، وكافر
بالله مؤمن بالكواكب.
قال محمد بن عمر:
وكان ابن أُبي بن سلول قال: هذا نوء الخريف، مُطرنا
بالشعرى.
وروى ابن سعد، عن أبي المليح، عن
أبيه، قال:
أصابنا يوم الحديبية مطر لم يبل أسافل نعالنا، فنادى
منادي رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
أن صلوا في رحالكم([35]).
ونقول:
إن الأمر هنا يحتاج إلى بعض التوضيح، وذلك على النحو
التالي:
لقد كان العرب يعتقدون:
أن الأنواء هي التي تحدث المطر، أو الريح.
والأنواء ثمانية وعشرون في كل سنة.
والنوء عبارة عن غروب نجم مع الفجر، وطلوع رقيبه من
المشرق من أنجم المنازل، وذلك يحصل في كل ثلاثة عشر يوماً إلا الجبهة ـ
النجم المعروف ـ فإن لها أربعة عشر يوماً.
وكان هذا الاعتقاد راسخاً في العرب، وكان لا بد من
إزالته، ليصح الاعتقاد بالتوحيد، وتزول عنهم رواسب الشرك، وعوارضه..
ولم يزل القرآن يصرح بأن الله هو الذي ينزل الغيث، وهو
الذي يزجي السحاب، ويرسل السماء عليهم مدراراً، وهو الذي يرسل الرياح.
فقال تعالى: ﴿يُرْسِلِ
السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً﴾([36]).
وقال: ﴿إِنَّ
اللهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾([37]).
وقال: ﴿وَهُوَ
الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾([38]).
وقال: ﴿أَلَمْ
تَرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ
يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ
وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ
بِهِ مَن يَشَاء وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاء يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ
يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾([39]).
وعن الرياح يقول: ﴿وَأَرْسَلْنَا
الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾([40]).
ويقول: ﴿وَهُوَ
الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾([41]).
ويقول: ﴿وَمَن
يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾([42]).
ويقول: ﴿اللهُ
الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي
السَّمَاء كَيْفَ يَشَاء﴾([43]).
سعي الرسول
 لاقتلاع هذا الاعتقاد:
لاقتلاع هذا الاعتقاد:
وقد حفلت كتب الحديث والتاريخ وغيرها بالنصوص الواردة
عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، والتي تدين هذا الاعتقاد،
وتدعو للتخلص منه..
وهذا المورد الذي نحن بصدد الحديث عنه هو أحد مفردات
الدعوة، حيث أخبرهم النبي
«صلى الله عليه وآله»
عن الله سبحانه: أن من يقول مُطرنا بنجم كذا، أو بنوء كذا، فهو كافر
بالله.
وليس المراد هنا:
كفر النعمة، كما يحاول البعض أن يدّعي، بل المراد الكفر
الحقيقي، لأنه يريد أن يذكر لهم منطق أهل الجاهلية، لكي يقرر: أن
القول: بأن الفاعل الحقيقي للمطر وللريح هو النوء الفلاني، كفر صريح لا
يلتقي مع الإيمان بشيء.
وقد روي عن النبي «صلى الله عليه
وآله» قوله:
«لو
أمسك الله المطر عن الناس سبع سنين، ثم أرسله، لأصبحت طائفة كافرين،
قالوا: هذه بنوء الدبران»
أو المجدح كما ورد في الروايات([44]).
مع أن انقطاع المطر عنهم سبع سنين يدل على: أن الأنواء
لا تأثير لها، لأن الأنواء موجودة طيلة هذه السنين السبع كلها. ولم
يؤثر وجودها في نزول المطر.
وقد ذكر السيوطي في كتابه:
«الدر
المنثور»
ج6 ص162 ـ 164 أحاديث كثيرة عن عشرات المصادر، صريحة بإدانة ـ وبعضها
يصرح بكفر ـ من يصرُّ على أن التأثير في المطر هو للأنواء، فراجع.
واللافت هنا:
أنه رغم كثرة تعرض النبي
«صلى الله عليه وآله»
لإدانة هذا الاعتقاد فقد نقل عن عمر بن الخطاب أنه قال: مُطرنا كذا.
واعتذر عنه الحلبي:
بأنه لعله لم يبلغه النهي عن ذلك([45]).
ولكن من الواضح:
أن عمر كان حاضراً في الحديبية، كما صرح به الحلبي
نفسه.
وربما يقال:
إن هذا الاعتذار يبقى مجرد احتمال.
وهناك احتمال آخر، وهو: أنه قد قال ذلك على سجيته،
متأثراً بما كان يعتقده في الجاهلية..
ولعل من ذكر:
أن المراد هو: كفر النعمة، وأن النهي ليس نهي تحريم بل
هو نهي كراهة([46])
قد أراد حفظ ماء الوجه للخليفة الثاني
في قوله هذا..
والله هو العالم بحقيقة الحال.
([1])
الثمد: الماء القليل الذي لا مادة له.
([2])
الظنون: أي الشحيحة، أو القليلة الماء.
([3])
يتبرَّضون الماء: ينتظرون خروجه، وهو قليل.
([4])
العطن: مبرك الإبل حول
الماء، والمراد: أنهم قد رووا، أو رويت إبلهم حتى بركت حول
الماء راجع: البحار ج20 ص331 ومسند أحمد ج4 ص329 وعن صحيح
البخاري ج3 ص178 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص219 وعن فتح الباري
ج5 ص245 والمصنف للصنعاني ج5 ص332 والمصنف لابن أبي شيبة
ج8 ص513 وصحيح ابن حبـان ج11 ص218 والمعجم الكـبير ج20 ص10 =
= والفايق في غريب الحديث ج1 ص300 وعن كنز العمال ج10 ص490
وإرواء الغليل ج1 ص55 وتفسير مجمع البيان ج9 ص195 وتفسير
الميزان ج18 ص265 وجامع البيان ج26 ص127 وزاد المسير ج7 ص160
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج4 ص212 والدر المنثور ج6 ص76
والطبقات الكبرى ج2 ص96 وتاريخ مدينة دمشق ج57 ص226 وعن تاريخ
الأمم والملوك للطبري ج2 ص274 والبداية والنهاية لابن كثير ج4
ص198 وج6 ص106 وموسوعة التاريخ الإسلامي ج2 ص609 والسيرة
النبوية لابن كثير ج3 ص330 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص40 وج7 ص370
وج9 ص449.
([5])
مناقب آل أبي طالب ج1 ص91 والبحار ج18 ص37 وأسد الغابة ج5 ص5
وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص273 والبداية والنهاية ج4 ص189 وعن
السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص776 والسيرة النبوية لابن كثير
ج3 ص315 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص40.
([6])
تفسير القمي ج1 ص302 وتفسير نور الثقلين ج2 ص248 وتفسير
الميزان ج9 ص356 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص41 وكتاب سليم بن قيس
ص239 والبحار ج38 ص326.
وقد
ورد: أنه لما أكثر عليه عمر بن الخطاب، قال له رسول الله «صلى
الله عليه وآله»: «إن قميصي لا يغني عنه من الله شيئاً، وإني
أؤمل أن يدخل في الإسلام بسببه كثير »، فيروى أنه أسلم ألف من
الخزرج. (تفسير السراج المنير ج1 ص612 للخطيب الشربيني وأسباب
النزول للواحدي ص193 وروح المعاني للآلوسي ج10 ص154).
([7])
الآية 80 من سورة التوبة.
([8])
تفسير الميزان ج9 ص35 وتفسير القمي ج1 ص302 وتفسير الصافي ج2
ص364 وكتاب سليم بن قيس ص239 والبحار ج22 ص97 وج30 ص148 وج31
ص633.
([9])
قال الصالحي الشامي: أخرجه البخاري 7/505 (4150).
([10])
قال الصالحي الشامي: أخرجه
البخاري في صحيحه الحديث رقم 4152 وراجع فيما تقدم: سبل الهدى
والرشاد ج5 ص40 ـ 42 وج9 ص448 والإصابة ج3 ص541 والسيرة
الحلبية ج3 ص11 و 12 والمنتظم ج3 ص268، والعبر وديوان المبتدأ
والخبر ج2 ق2 ص34 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص273 و 274 والسيرة
النبوية لابن هشام ج3 ص324 و 325 والمواهب اللدنية ج1 ص268
والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص484 وتاريخ الإسلام للذهبي
(المغازي) ص367 و 375 و 376 و 377 و 378 و 379 و 380 و 381 و
382 وسنن الدارمي ج1 ص14 وعن صحيح مسلم ج6 ص26 ونظم درر
السمطين ص71 وعن كنز العمال ج12 ص367 ومسند أحمد ج3 ص329
والمصنف لابن أبي شيبة ج8 ص512 وصحيح ابن خزيمة ج1 ص66 وصحيح
ابن حبان ج14 ص481 ودلائل النبوة ص121 وجامع البيان ج26 ص93
وجامع أحكام القرآن ج16 ص276 وتاريخ مدينة دمشق ج36 ص436
والبداية والنهاية ج4 ص195 وج6 ص106 والشفا بتعريف حقوق
المصطفى ج1 ص286 وعن عيون الأثر ج2 ص114 والسيرة النبوية لابن
كثير ج3 ص325. وراجع: نهاية الأرب ج17 ص222 والطبقات الكبرى
لابن سعد ج2 ص98.
([11])
السيرة الحلبية ج3 ص12 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص91 والبحار ج18
ص38.
([12])
راجع: تاريخ الأمم والملوك ج2 ص273 وأسد الغابة ج5 ص5 وعن
السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص776.
([13])
الإصابة ج3 ص541 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص325 والبداية
والنهاية ج4 ص189 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص40 وأسد الغابة ج5 ص5
وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص273 والسيرة النبوية لابن كثير ج3
ص315 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص91 والبحار ج18 ص37.
([14])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص41
و 73 و 74 وج9 ص449 عن البخاري، وأحمد، والطبراني، ومسلم، وأبي
نعيم، والحاكم في الإكليل، والبيهقي، والسيرة النبوية لدحلان
ج1 ص484 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص375 وشرح المواهب
للزرقاني ج3 ص181 والخرائج والجرائح ج1 ص123 ومناقب آل أبي= =
طالب ج1 ص91 والبحار ج18 ص37 وج20 ص346 و 357 ومستدرك سفينة
البحار ج2 ص230 وتفسير مجمع البيان ج9 ص183.
([15])
الإصابة ج3 ص541 عن الحسن
بن سفيان في مسنده، وعن ابن مندة في المعرفة، وابن السكن،
والطبراني، والمصنف لابن أبي شيبة ج8 ص517 والمعجم الكبير ج2
ص179 وعن كنز العمال ج10 ص476 و 477 وتاريخ الجرجاني ص163.
([16])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص73 وج9 ص449 وراجع: المنتظم ج3 ص268
وجوامع السيرة النبوية ص164 و 165 وتاريخ الإسلام للذهبي ص376
و 377 وشرح المواهب للزرقاني ج3 ص181 والبحار ج18 ص37 وعن فتح
الباري ج5 ص245.
([17])
تاريخ الإسلام (المغازي)
ص376 وشرح المواهب للزرقاني ج3 ص180 والبحار ج20 ص346 وعن فتح
الباري ج5 ص245 ومجمع البيان ج9 ص183.
([18])
راجع: السيرة النبوية لابن كثير ج3 ص315 والسيرة النبوية
لدحلان (ط دار إحياء التراث) ج1 ص484 وشرح المواهب للزرقاني ج3
ص181 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص41 و 73 والإصابة ج3 ص541 والسيرة
الحلبية ج3 ص12 وجوامع السيرة النبوية ص165 والعبر وديوان
المبتدأ والخبر لابن خلدون ج2 قسم2 ص34 وتاريخ الأمم والملوك
ج2 ص273 والسيرة النبوية لإبن هشام ج3 ص324 وأسد الغابة ج1
ص172 وج5 ص4 وعن عيون الأثر ج2 ص116 وعن فتح الباري ج5 ص245.
([19])
السيرة الحلبية ج3 ص12
وسبل الهدى والرشاد ج5 ص73 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص484
وشرح المواهب للزرقاني ج3 ص181 وعن فتح الباري ج5 ص245.
([20])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص40 و 41 وراجع ص40 والإصابة ج3 ص541
والسيرة الحلبية ج3 ص12 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص484 وشرح
المواهب للزرقاني ج3 ص181 وعن فتح الباري ج5 ص245 والطبقات
الكبرى ج4 ص315 وموسوعة التاريخ الإسلامي ج2 ص609.
([21])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص40 والإصابة ج3 ص541 والسيرة النبوية
لدحلان ج1 ص484 وشرح المواهب للزرقاني ج3 ص181 ومجمع الزوائد
ج6 ص145 والبداية والنهاية ج4 ص189 والجامع لأحكام القرآن ج16
ص275 وعن السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص776 وعن عيون الأثر ج2
ص115 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص315 وعن فتح الباري ج5
ص245 والطبقات الكبرى ج4 ص315.
([22])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص73 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص484 وشرح
المواهب للزرقاني ج3 ص181 والإصابة (ط دار الكتب العلمية) ج2
ص206 وعن فتح الباري ج5 ص245.
([23])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص41 و 73 والسيرة الحلبية ج3 ص12 وجوامع
السيرة النبوية ص165 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص273 والسيرة
النبوية لابن هشام ج3 ص324 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص315
وراجع: كنز العمال (ط الهند) ج10 ص303 و 304 والبحار ج18 ص31 ـ
38 ومسند أحمد ج4 ص290 والبداية والنهاية ج6 ص16 والمغازي
للواقدي ج2 ص588 وعن البخاري ج4 ص234 و ج5 ص156 وعن فتح الباري
ج6 ص425 وعن السيرة النبوية لدحلان ج2 ص215.
([24])
الآية 114 من سورة التوبة.
([25])
الآية 6 من سورة المنافقون.
([26])
راجع: كتابنا >ظلامة
أبي طالب<،
وقد تقدم في الجزء السابق من هذا الكتاب، حين الحديث عن
استغفار النبي «صلى الله عليه وآله» لأمه: أن هذه الآية: إنما
نزلت لتأكيد إيمان أبي طالب «رحمه الله» فراجع.
([27])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص41 والسيرة الحلبية ج3 ص12 وكتاب سليم
بن قيس ص239 والبحار ج38 ص326 وج22 ص97 وج30 ص148 وج31 ص633
وتفسير القمي ج1 ص302 والتفسير الصافي ج2 ص364 وتفسير نور
الثقلين ج2 ص248.
([28])
الآية 18 من سورة الفتح.
([29])
الآية 10 من سورة الفتح.
([30])
الآية 84 من سورة التوبة.
([32])
السيرة الحلبية ج3 ص12 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص91 والبحار ج18
ص37.
([33])
نفس المصادر السابقة.
([34])
الديباج على مسلم ج1 ص89 وصحيح ابن حبان ج1 ص417 وتفسير مجمع
البيان ج10 ص28 والجامع لأحكام القرآن ج7 ص229 والبداية
والنهاية ج4 ص194 وزاد المسير ج7 ص249 والعبر وديوان المبتدأ
والخبر لابن خلدون ج8 ص521 والمغازي ج2 ص589 و 590 وموسوعة
التاريخ الاسلامي ج2 ص611 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص42 وراجع:
تذكرة الفقهاء (ط جديد) ج4 ص223 والذكرى للشهيد الأول ص252
ومغني المحتاج ج1 ص326= = ونيل الأوطار ج1 ص337 ونيل الأوطار
ج4 ص160 والوسائل ج8 ص272 ومستدرك الوسائل ج6 ص195 والجواهر
السنية ص169 ومستدرك سفينة البحار ج10 ص158 وعن صحيح البخاري
ج2 ص23 والسنن الكبرى للبيهقي ج3 ص357 ومسند أبي الجعد ص423
والسنن الكبرى للنسائي ج6 ص229 وصحيح ابن حبان ج3 ص503
والأذكار النووية ص182 وكنز العمال ج3 ص636 وإرواء الغليل ج3
ص144 وزاد المسير ج7 ص294 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص427 وج3
ص333.
([35])
راجع النصوص المتقدمة في: سبل الهدى والرشاد ج5 ص42 وقال في
هامشه: أخرجه البخاري 5/259 (4147) وأخرجه مسلم في الإيمان
(125) والبيهقي في دلائل النبوة 4/131.
ونضيف
نحن المصادر التالية: المنتظم ج3 ص273 والسيرة ج3 ص25 ومسند
أحمد ج5 ص74 وسنن ابن ماجة ج1 ص302 والسنن الكبرى للبيهقي ج3
ص71 وعون المعبود ج3 ص273 والمصنف لابن أبي شيبة ج2 ص137 وصحيح
ابن خزيمة ج3 ص80 وصحيح ابن حبان ج5 ص435 ـ 348 والمعجم الأوسط
ج8 ص346 والمعجم الكبير ج1 ص188 و 189 وموارد الظمآن ص123 = =
وعن كنز العمال ج8 ص309 والطبقات الكبرى ج2 ص105 والتاريخ
الكبير ج2 ص21 وعن عيون الأثر ج2 ص125.
([36])
الآية 52 من سورة هود والآية 11 من سورة نوح.
([37])
الآية 34 من سورة لقمان.
([38])
الآية 28 من سورة التوبة.
([39])
الآية 43من سورة النور.
([40])
الآية 22 من سورة الحجر.
([41])
الآية 57 من سورة الأعراف ونحوها الآية 48 من سورة الفرقان.
([42])
الآية 63 من سورة النمل.
([43])
الآية 48 من سورة الروم.
([44])
البحار ج55 ص329 وراجع ص327 ـ 330 والدر المنثور ج6 ص163
وراجع: السيرة الحلبية ج3 ص25 والبرهان (تفسير) ج4 ص283 وصحيح
ابن حبان ج13 ص500 ومسند أحمد ج3 ص7 وراجع: سنن النسائي ج3
ص165 ومسند الحميدي ج2 ص331 والسنن الكبرى للنسائي ج1 ص564 وج6
ص230 وراجع: مسند أبي يعلى ج2 ص482 وصحيح ابن حبان ج13 ص501
وكتاب الدعاء ص298 وموارد الظمآن ص160 وعن كنز العمال ج3 ص636
وتفسير القرآن للصنعاني ج3 ص274 والتاريخ الكبير ج7 ص55 وتهذيب
الكمال ج19 ص290.
([45])
راجع: السيرة الحلبية ج3 ص25.
|