|
بــيــانــات تــمــهــيــديــــــة
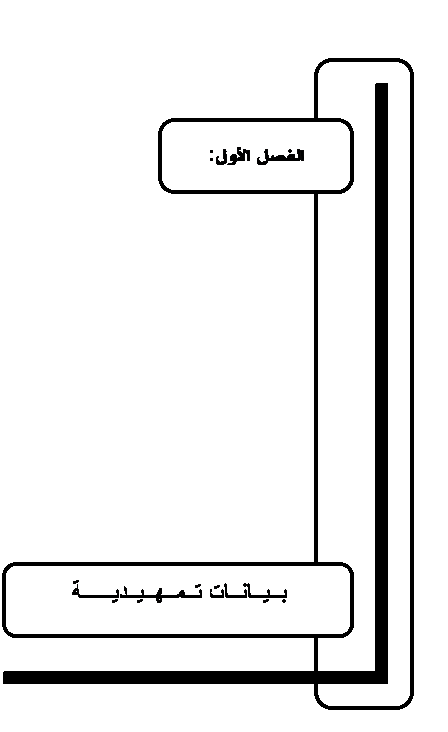
وفي سنة ست([1])
أو في سنة سبع([2])
كان إرسال النبي
«صلى الله عليه وآله»
الرسل إلى ستة من الملوك، الذين يتحكمون في شعوب الأرض، فقد أرسل في ذي
الحجة الحرام، أو في أواخره([3])
أو في المحرم([4])
ستة نفر في يوم واحد([5])
فخرجوا مصطحبين([6]).
وقد كتب إليهم وإلى غيرهم من الملوك، والرؤساء، في داخل
بلاد الإسلام وخارجها.
وكانت اللغة التي كتب إليهم بها هي العربية، والتي هي
لغة القرآن والإسلام.
والملوك الستة الذين كتب النبي «صلى الله عليه وآله»
إليهم هم:
1 ـ
النجاشي، ملك الحبشة.
2 ـ
قيصر، ويقال: هرقل، عظيم الروم.
3 ـ
كسرى، حاكم فارس والمدائن.
4 ـ
المقوقس، صاحب الإسكندرية (مصر).
5 ـ
الحارث، والي تخوم الشام ودمشق.
6 ـ
ثمامة بن أثال، وهوذة بن علي الحنفيان، ملكا اليمامة،
وقائداها.
أما الذين حملوا الكتب إلى هؤلاء فهم:
1 ـ
عمرو بن أمية الضمري، إلى النجاشي.
2 ـ
دحية بن خليفة الكلبي، إلى قيصر.
3 ـ
عبد الله بن حذافة السهمي، إلى كسرى.
4 ـ
حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، إلى المقوقس.
5 ـ
الشجاع بن وهب الأسدي، إلى الحارث بن أبي شمر
الغسَّاني.
6 ـ
وسليط بن عمرو العامري، إلى ثمامة وهوذة.
والظاهر هو:
أنه قد كان ثمة رهبة شديدة وخوف عظيم لدى بعض المسلمين
من هذا الأمر، حتى إن الرسل أنفسهم أظهروا تثاقلاً عن تنفيذ أمر رسول
الله
«صلى الله عليه وآله».
وقد يكون من أسباب ذلك خوفهم من بطش أولئك الملوك بهم، وذلك في سورة
غضب شديد توقَّعوها منهم حين تسليم الرسائل إليهم، فقد قالوا: إن رسول
الله
«صلى الله عليه وآله»
خرج على أصحابه ذات يوم بعد عمرته التي صد عنها يوم الحديبية، فقال:
يا أيها الناس، إن الله بعثني رحمة وكافة؛ فأدوا عني
يرحمكم الله، ولا تختلفوا عليَّ كما اختلف الحواريون على عيسى!!
وقال:
«انطلقوا
ولا تصنعوا كما صنع رسل عيسى بن مريم».
فقال أصحابه:
وكيف اختلف الحواريون يا رسول الله؟!.
فقال:
دعاهم إلى الذي دعوتكم إليه.. فأما من بعثه مبعثاً
قريباً فرضي وسلَّم، وأما من بعثه مبعثاً بعيداً، فكره وجهه، وتثاقل.
فشكى ذلك عيسى إلى الله تعالى؛ فأصبح المتثاقلون، كل
واحد منهم يتكلم بلسان الأمة التي بعث إليها([7]).
وقد اعتبر الواقدي:
أن من معجزات رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
أنه حين بعث النفر الستة إلى الملوك:
«أصبح
كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثهم إليهم».
وقالوا:
«كان
ذلك معجزة لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»..»([8]).
وعلى كل حال.. فإن هذا الحديث يدل:
على أنه قد جرى لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»
مع من أرسلهم إلى الملوك، نفس ما جرى لعيسى مع الحواريين .. فظهر مصداق
ما أخبر به رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
من أن هذه الأمة سوف تسير على سنن من قبلها حذو القذة بالقذة، ومطابق
النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا فيه..
إن ههنا سؤالاً يفرض نفسه، ويلح بطلب الإجابة عليه،
وهو: أن الله سبحانه قد بعث محمداً
«صلى الله عليه وآله»
نذيراً للبشر كلهم، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، قال تعالى: ﴿وَمَا
أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾([9]).
وكان
«صلى الله عليه وآله»
يكلم كل قوم بلسانهم، فلماذا كتب لملوك الأرض كلهم باللغة العربية، ولم
يكتب لهم بلغاتهم الخاصة بهم؟!
والجواب:
أولاً:
من الطبيعي أن الإسلام يملك قيماً حضارية ومبادئ
إنسانية يريد لها أن تحكم العالم، وتهيمن عليه، فلا غرو أن يسعى لفرض
لغته ومصطلحاته الخاصة به على الشعوب كلها، واللغة هي الصلة بين جميع
أتباع هذا الدين من هذه الأمة التي يفترض فيها أن تعيش تلك القيم،
وترتكز في تعاملها وسلوكها إلى تلك المبادئ. لأن المطلوب هو: أن تتحول
تلك المبادئ والقيم إلى مشاعر وأحاسيس، وأن يكون لها دور في صنع خصائص
الشخصية الإنسانية، وتصبح هي عينه التي ينظر بها، وأذنه التي يسمع بها،
ولسانه المعبر عن حقيقته الباطنية، وحركته العفوية، وتكوّن لمحاته،
ولفتاته، وكل مظهر من مظاهر الحياة والوعي لديه.
وتكون الكلمة، واللغة، والمصطلح الإيماني هي ذلك المحرك
القوي، الذي يطلق في حنايا الروح، وفي أعماق الضمير والوجدان الإنساني
شحناته الرافدة لمشاعره وأحاسيسه، والغامرة لها بفيوضات من معاني
القيم، والمثل العليا.
ومن أجل ذلك كله، نقول:
إنه لا بد من أن تفرض لغة القيم نفسها على البشرية
كلها، وإن احتفظت الشعوب بلغاتها الخاصة بها فإنما ذلك من أجل أن تكون
وسيلتها في تلبية حاجاتها في مفردات ومجالات ليست لها علاقة مباشرة
بمعاني القيم ونظام المثل والمبادئ.
ولهذا كتب النبي
«صلى الله عليه وآله»
إلى ملوك العالم باللغة العربية، ولم يكتب لهم بلغاتهم التي يتكلمون
بها.
ثانياً:
إن وحدة اللغة فيما يرتبط بالقيم الإنسانية ومناهج
الدين، تعطي الشعوب الإحساس الوجداني العميق بالرابط القيمي فيما بينها
وبين الشعوب الأخرى، وتؤكد شعورها بالقواسم المشتركة في مفردات الدين
والإيمان..
ولذلك أنزل الله القرآن، وهو كتاب العالم بأسره، باللغة
العربية، وجعل لقراءته ثواباً، ورتب أحكاماً، كما أنه قد شرع الصلاة،
والأدعية، والزيارات، وبعض العقود وغيرها باللغة العربية أيضاً.
ثالثاً:
إن الأمم الراقية تسعى لنشر لغتها في الشعوب على مستوى
العالم بأسره، وذلك على حد قول العلامة الأحمدي «رحمه الله»:
«إعمالاً
للسيادة، وتثبيتاً للعظمة»([10]).
ويعدُّ هذا من أسباب قوة الدعوة، وثباتها، وتعزيزها في
وجدان الناس، وفي عقولهم، وفي حياتهم العملية أيضاً..
وقد يلاحظ:
أن كتب النبي
«صلى الله عليه وآله»،
ورسائله، وعهوده، وإقطاعاته، تختلف وتتفاوت من حيث اشتمالها على
الألفاظ الوحشية والغريبة فيها تارة، وخلوها من ذلك أخرى، ومن حيث
سهولة التعبير وحزونته فيها، وغير ذلك من خصوصيات..
والسبب في ذلك هو:
أنه «صلى الله عليه وآله» كان يكلم
الناس، ويكتب لهم على قدر عقولهم، وحسبما ألفوه من لغاتهم، ويصوغ لهم
العبارات، ويورد التراكيب وفق ما هو متداول فيما بينهم، فأوجب ذلك
اختلاف كلماته معهم، ورسائله لهم، من حيث وعورة الألفاظ وعذوبتها،
وسهولة التراكيب وتعقيدها «اتساعاً في الفصاحة، واستحداثاً للإلفة
والمحبة، فكان يخاطب أهل الحضر بكلام ألين من الدهن، وأرق من المزن،
ويخاطب أهل البدو بكلام أرسى من الهضب، وأرهف من القضب»([11]).
وكلا هذين النوعين من الكلام بليغ وفصيح، فإن الغريب
والوحشي لم يكن وحشياً ولا غريباً بالنسبة للذين خاطبهم به، بل هو فصيح
بالنسبة إليهم، بل هذا النمط هو أعلى درجات البلاغة والفصاحة عندهم.
بل قد يقال:
إن ما ظهر في لهجات ولغات كثير من القبائل من هنات
وهنات([12])
كان يعدُّ هو الفصاحة بعينها بالنسبة لتلك القبائل.
ولغة قريش فقط هي التي سلمت من أمثال هذه الهنات، فكانت
هي الأفصح، والأجمل، والأصفى، وكان
«صلى الله عليه وآله»
من قريش، فكان
«صلى الله عليه وآله»
أفصح العرب، أو أفصح من نطق بالضاد حسبما روي عنه([13]).
لا ريب في أن الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة في
أول البعثة النبوية الشريفة كانوا قليلين..
ولكن توسع الإسلام، خصوصاً بعد
الهجرة، وظهور حاجة الناس في كثير من شؤون حياتهم وعلاقاتهم إلى
القراءة والكتابة، وتشجيع الإسلام على تعلُّمها. وقد بلغ النبي «صلى
الله عليه وآله» في حثه على كتابة العلم، وعلى كتابة القرآن، والسنة،
قد بلغ الغاية، وأوفى على النهاية، إلى حد أن جعل فداء الأسير في بدر،
هو أن يعلِّم عشرة من أطفال المسلمين القراءة والكتابة([14]).
وكان
«صلى الله عليه وآله»
أمر عبد الله بن سعيد بن العاص: أن يعلم الناس الكتابة بالمدينة، وكان
محسناً([15]).
وقد ذكر العلامة الأحمدي «رحمة الله) » في كتابه «مكاتيب
الرسول» العديد ممن صرحوا: بأنهم كتبوا لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»
في مختلف المجالات، فلا بأس بمراجعة ذلك الكتاب.
وكانت طريقته
«صلى الله عليه وآله»
في كتابة رسائله وغيرها، هي: أنه يملي، والكاتب يكتب، ولم نجد ما يدل
على: أنه
«صلى الله عليه وآله»
قد كتب بيده إلا ما تقدم عن البراء بن عازب في قصة الحديبية، حيث قال:
«فأخذ
رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
وليس يحسن يكتب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله الخ..»
([16]).
وقد قالوا:
إن الروايات الأخرى قد صرحت:
بأن علياً
«عليه
السلام»
قد امتثل أمر رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
وكتب ما أمر به.
فيكون المراد:
أنه أمر علياً
«عليه
السلام»
بالكتابة، فكتب، وما فعله رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
هو: أنه محا الكلمة السابقة فقط.
ولكن ذلك لا يعني:
أنه
«صلى الله عليه وآله»
لم يكن يعرف القراءة والكتابة، عن طريق التعليم الإلهي الموجب لظهور
المعجزة له في ذلك.. كما أثبتناه في كتابنا
«مختصر
مفيد»([17]).
وكان عدم تصديه لكتابة رسائله وغيرها مراعاة للعرف
السائد آنذاك، ولذلك لم يكن الخلفاء بعده يتصدون للكتابة بأنفسهم
أيضاً، بل كانوا يملون على الكاتب، وهو يكتب.. إلا إذا كانت هناك ضرورة
لتصديهم للكتابة بأنفسهم..
وقد زعموا:
أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
كان في مدة من الزمن يكتب:
«باسمك اللهم».
ثم صار يكتب:
«بسم الله».
ثم صار يكتب:
«بسم الله الرحمن».
ثم صار يكتب:
«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».
فقد روي عن الشعبي، أنه قال:
كان أهل الجاهلية يكتبون:
«باسمك اللهم».
فكتب النبي
«صلى الله عليه وآله»
أول ما كتب:
«باسمك اللهم»،
حتى نزلت: ﴿..بِسْمِ
اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا..﴾
([18])،
فكتب:
«بسم الله».
ثم نزلت: ﴿قُلِ
ادْعُواْ اللهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ..﴾([19]).
فكتب:
«بسم الله الرحمن».
ثم أنزلت الآية التي في طس: ﴿إِنَّهُ
مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾([20]).
فكتب:
«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»([21]).
زاد في السيرة الحلبية بعد قوله:
فكتب أول ما كتب:
«باسمك اللهم
وكتب ذلك في أربعة كتب»([22]).
ونقول:
إننا بغض النظر عن الطعون التي ربما يشار إليها فيما
يتعلق بالشعبي نفسه، فضلاً عمن يروي عنه، وبقطع النظر عن أن الشعبي لم
يكن حاضراً ولا ناظراً لما كان يجري في زمن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
نقول:
أولاً:
إن آية: ﴿بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
قد نزلت قبل سورة النمل، وقبل آية: ﴿قُلِ
ادْعُواْ اللهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ..﴾
وقبل آية: ﴿..بِسْمِ
اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا..﴾.
بل هي قد بدأت تنزل مرة بعد أخرى من أول البعثة، وإلى حين وفات النبي ،
وكان
«صلى الله عليه وآله»
ولم يزل منذ بعثه الله نبياً يصلي ويقرأ بفاتحة الكتاب، المشتملة على
آية: ﴿بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.
وقد ذكرنا في كتابنا
«حقائق هامة حول القرآن الكريم»:
أن المروي عن الإمام الصادق «عليه السلام»([23])،
وعن ابن عباس ، وعثمان بن سعيد بن جبير:
أنهم كانوا لا يعرفون (أو كان النبي لا يعرف) انتهاء
السورة السابقة، وبدء السورة اللاحقة إلا بنزول: ﴿بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾([24]).
فلماذا عمل «صلى الله عليه وآله»،
واستن بآية: ﴿..بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا..﴾ واستن
بآية: ﴿قُلِ ادْعُواْ اللهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ..﴾ ولم
يعمل ولم يستن بـ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ التي
رافقته في جميع السور منذ بعثته، وإلى حين وفاته؟!..
ثانياً:
يضاف إلى ذلك: أن كتب الله تعالى كلها قد افتتحت بقوله
تعالى: ﴿بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.
وكانت هذه الكلمة أول كل كتاب نزل من السماء، فلماذا لم يستن بها رسول
الله
«صلى الله عليه وآله»
كما استن بآية: ﴿..بِسْمِ
اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا..﴾،
وبغيرها من الآيات المتقدمة؟!
فراجع الحديث المروي عن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ:
مفتاح كل كتاب
»([25]).
وعن الإمام الصادق «عليه السلام»:
ما أنزل الله من السماء كتاباً إلا وفاتحته
«بسم الله الرحمن الرحيم»([26]).
وعن الإمام الباقر «عليه السلام»:
أول كل كتاب نزل من السماء:
«بسم الله الرحمن الرحيم»([27]).
ثالثاً:
ومع غض النظر عن هذا وذاك، فإننا لم نجد هذه الكتب
المبدوءة بـ
«باسمك اللهم»
أو بـ
«بسم الله»
أو بـ
«بسم الله الرحمن» رغم
بحثنا عنها، وما ادَّعاه الحلبي، لو صدقناه فيما ادَّعاه، لم نستطع أن
نجد له شاهداً يثبته، ولا مصداقاً يمكن الاعتماد عليه..
رابعاً:
قال العلامة الأحمدي
«رحمه
الله»:
«أما
ما نقل عنه
«صلى الله عليه وآله»
من الكتب، وليس فيها البسملة، فمن آفات الرواة، وتلخيص الناقلين، وعدم
اهتمامهم ببعض الأمور.
وأما ما أخرجه السيوطي من كتابه
«صلى الله عليه وآله»
لأهل نجران، فسيأتي الكلام عليه في ذكر وفد نجران. مع أن المنقول في
جمهرة رسائل العرب ج1 ص76 عن صبح الأعشى ج6 ص38 و 381 هكذا:
«بسم
الله الرحمن الرحيم، إله إبراهيم..»
الخ..
وأضف إلى ما ذكرنا:
ما سيأتي من أن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
كتب للداريين بمكة، سنة خمس أو ست، من البعثة، أو قبلها، وفيه: بسم
الله الرحمن الرحيم»
انتهى([28]).
ويلاحظ:
أن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
كان في كتبه يقدم اسمه الشريف موصوفاً بوصف الرسالة أو النبوة، فيكتب
مثلاً: من محمد رسول الله إلى فلان، أو من محمد النبي لفلان، أو هذا ما
كتبه النبي محمد لفلان..
ويصرح باسم المرسل إليه، وربما
وصفه:
بأنه عظيم الروم مثلاً، أو صاحب مملكة كذا، أو نحو ذلك.
وذلك ـ كما يقول العلامة الأحمدي
«رحمه
الله»
ـ تعظيماً منه للنبوة، وترفيعاً لمقام الرسالة.. إلى أن قال: إذ كما
يجب على غيره أن يعظِّم ساحتها المقدسة السامية، يلزم على نفسه الكريمة
أيضاً أن يحفظها ويصونها، وأن لا يضعها ولا يذلها.
ألا ترى:
أنه يجب عليه
«صلى الله عليه وآله»
أن يصلي على نفسه في الصلاة، وأن يشهد لنفسه بالنبوة، فيقول: أشهد أن
محمداً عبده ورسوله، واللهم صل على محمد وآل محمد؟
وليس ترفيعاً، أو إكباراً، أو إعظاماً في الحقيقة، بل
هو وضع للشيء في موضعه([29]).
وقد أغضب تقديمه اسمه الشريف على اسم المكتوب له، كسرى
ملك الفرس، فمزق كتاب رسول الله
«صلى الله عليه وآله»([30]).
كما أن أخا قيصر، أو ابن عمه، أراد أن يخرق كتاب رسول
الله
«صلى الله عليه وآله»
لنفس السبب، فمنعه قيصر من ذلك، وقال له:
«إنك
أحمق صغير، أتريد أن تمزق كتاب رجل قبل أن أنظر فيه؟! ولعمري، إن كان
رسول الله لَنَفْسُهُ أحق أن يبدأ بها مني»([31]).
وكان يكتب أيضاً:
«سلم
أنت»
أو
«سلام
عليك»
أو
«سلام
على من آمن بالله».
وكان يكتب:
«أحمد
الله إليك»
أو
«أحمد
إليك الله»
أي أهدي إليك حمد الله. وكان ذلك تحية يكتبونه في افتتاح كتبهم([32]).
وكذلك كان يكتب أمير المؤمنين علي
«عليه
السلام»،
وأم سلمة في كتابها إلى عائشة حين نهتها عن الخروج قبل وقعة الجمل.
ويقولون:
إنه
«صلى الله عليه وآله»
قد اتخذ الخاتم في سنة ست، وبه ختم الكتب التي أرسلها إلى الملوك،
يدعوهم فيها إلى الإسلام..
وزعم المؤرخون:
أنه
«صلى الله عليه وآله»
لما أراد أن يكتب إلى الملوك، قيل له: إنهم لا يقبلون كتاباً إلا
بخاتم، أو مختوماً. فصاغ النبي
«صلى الله عليه وآله»
خاتماً من ذهب. واقتدى به ذوو اليسار من أصحابه فصنعوا خواتيم من ذهب.
فلما لبس رسول الله «صلى الله عليه وآله» خاتمه، لبسوا
أيضاً خواتيمهم.
فجاء جبرئيل «عليه السلام» من الغد،
وقال:
لبس الذهب حرام لذكور أمتك. فطرح النبي «صلى الله عليه
وآله» خاتمه، وطرح أصحابه أيضاً خواتيمهم.
ثم اتخذ رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
خاتماً حلقته وفَصُّه من فضة، ونقش فيه محمد رسول الله: محمد سطر،
ورسول سطر، والله سطر. ونهى أن ينقش عليه أحد.
واقتدى به أصحابه، فاتخذوا خواتيمهم من فضة([33]).
ونقول:
1 ـ
إن اتخاذ الخاتم والختم في آخر الكتاب، إنما هو من أجل
المنع من الزيادة فيه.
كما أن ختمه بعد طيه وجعل الختم على شيء رطب من الطين
ونحوه، إنما هو من أجل أن لا يفضه حامله أو غيره، ويطلع على ما فيه غير
المكتوب إليه، ولكي لا يزاد فيه، ولا تحرَّف بعض كلماته([34]).
2 ـ
إن حديث: أنه «صلى الله عليه وآله» قد اتخذ أولاً
خاتماً من ذهب، ولبسه حتى جاءه جبرئيل، وأخبره أن الذهب حرام على ذكور
الأمة.. لا يمكن قبوله.
أولاً:
إن النبي
«صلى الله عليه وآله»
لا يفعل شيئاً من تلقاء نفسه.
فإن كان قد فعل ذلك حقاً فلا بد أن يكون قد فعله عن أمر
الله تعالى، وبإذن منه..
ثانياً:
إن النبي
«صلى الله عليه وآله»
لم يكن لينفق أموالاً على خاتم له من ذهب، وهو ما لا يقدم على اتخاذه
إلا ذوو اليسار من أصحابه، كما صرحت به الرواية، بل كان يساوي نفسه في
مأكله وملبسه ومشربه بالضعفاء منهم، كما هو معلوم في سيرته..
والصحيح:
هو أنه اتخذ خاتماً من فضة، فاقتدى به من شاء من
أصحابه.
النبي
 يؤرخ رسائله:
يؤرخ رسائله:
وقد ذكرنا في هذا الكتاب:
أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
قد وضع التاريخ الهجري، وأنه كان يؤرخ به رسائله، وغيرها..
فراجع فصل:
أعمال تأسيسية في مطلع الهجرة، لتجد صحة ما ذكرناه.
إن الكتب التي أرسلها النبي
«صلى الله عليه وآله»
إلى الملوك قد تضمنت دعوتهم إلى توحيد الله تعالى وإلى الإسلام..
ولم نجد فيها:
أية إشارة إلى الحرب، ولا إلى إلزامهم بالجزية لو
امتنعوا عن الإسلام.. وذلك لأن الهدف هو نشر الدين بإطلاق نداء الضمير،
والوجدان، والفطرة، والالتزام بحكم العقل، وإتمام الحجة عليهم.. والقصد
إنما هو إلى إسعاد الناس، وتوجيههم نحو الحياة الكريمة والطيبة، حيث
العظمة والمجد، والسؤدد، من دون أن تكون هناك أي امتيازات ظالمة لأحد.
وليس القصد الاستيلاء على بلاد الناس ولا قهرهم، أو
إذلالهم، أو أي نوع من أنواع الإيذاء لهم..
من أجل ذلك نلاحظ:
أن هؤلاء لم ينأوا في الأكثر بأنفسهم عن الإسلام، بل
قَبِلَهُ بعضهم، وأجاب بعضهم بجواب لين، ظهرت فيه أمارات التردد، بسبب
وساوس شيطانية، ومخاوف غير واقعية على ملكهم وسلطانهم، أو على بعض
امتيازاتهم فيه.
وما أشبه الليلة بالبارحة، حيث كان المستضعفون في مكة
قد قبلوا الإسلام في بدء الدعوة، فلما عرف أسيادهم والمستكبرون من
عظمائهم وأشرافهم بالأمر، لاموهم على ذلك، ومنعوهم منه، وواجهوا من أصر
على موقفه بالعنف والقسوة البالغة.
فقد ذكروا:
أنه لما أظهر رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
الإسلام أسلم أهل مكة كلهم، وكانوا يجتمعون على الصلاة حتى ما يستطيع
بعضهم أن يسجد من كثرة الزحام، وضيق المكان، حتى قدم رؤوس قريش: الوليد
بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام ـ بالطائف في أراضيهم ـ فقالوا: تدعون
دين آبائكم؟! فكفروا([35]).
وهذا بالذات ما جعل ملوك الأرض ـ باستثناء بعضهم ـ
يواجهون دعوته
«صلى الله عليه وآله»
لهم، بمزيد من التروي، والمرونة، وأرسلوا إليه بكتب نضحت بالإكرام
والإعظام، وبعثوا إليه بالتحف والهدايا، وقد قال قيصر لأخيه حين طلب
منه أن يرمي الكتاب من يده: أترى أرمي كتاب رجل يأتيه الناموس الأكبر؟!
وقد أسلم النجاشي ملك الحبشة.
والمنذر بن ساوى ملك البحرين.
وأسلم فروة عامل قيصر على عمَّان.. فلما بلغ قيصر ذلك
أخذه واستتابه، فأبى، فقتله.
وأسلم جيفر وعبد ابنا جلندى، ملكا عُمَان.
وأسلم ضغاطر أسقف الروم بعد قراءة كتاب الرسول
«صلى الله عليه وآله»
إلى قيصر.
وأجابه ملوك حِمْيَرَ ووفدوا عليه.
وأسلم أقيال حضرموت.
وأسلم عمال كسرى بالبحرين واليمن.
وقال المقوقس:
إني قد نظرت في أمر هذا النبي، فوجدته لا يأمر بمزهود
فيه، ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال، ولا الكاهن
الكذاب، ووجدت معه آلة النبوة، بإخراج الخبأ، والإخبار بالنجوى،
وسأنظر.
وأعطاه أساقفة نجران الجزية.
وأجابه ملك أيلة ويهود مقنا، إما بالإسلام، أو الجزية([36]).
إن مخاطبة الملوك في أي شأن من الشؤون، حتى ما كان منها
عادياً ومألوفاً، ليست على حد مخاطبة سائر الناس. بل هي محفوفة
بالأخطار، لا بد من حساب كل مفرداتها وفقراتها بدقة بالغة، وبحساسية
متناهية.
وذلك بسبب الأخلاق الخاصة التي يكتسبها هؤلاء الملوك من
الأجواء المحيطة بهم، والتي يغذيها شعورهم بالعظمة، وبالقوة، بجميع
مكوناتها ومظاهرها، فيبتلي الملوك من خلال استمرار هذا الشعور بالبأو،
وبالكبر، والاستعلاء، والزهو، وما إلى ذلك..
يضاف إلى ذلك:
أن شعورهم بعدم مسؤوليتهم عما يقومون به من تصرفات، من
شأنه أن يسهل عليهم البطش، وتظهر عليهم الرعونة إلى حد الإفراط في
اتخاذ القرارات المتهورة ضد الأشخاص، والجماعات الصغيرة، فيستضعفونها،
ويقهرونها بسلطانهم ويهيمنون عليها ببطشهم وجباريتهم.
ويتعاظم هذا الخطر ويبلغ أقصى مداه حينما يواجه هؤلاء
الملوك دعوة إلى أمر قد يرون أنه يستبطن تقليص نفوذهم، أو يحدُّ من
سلطانهم، ويقلل إلى حد ما من هيبتهم، أو يكسر من شوكتهم، أو يقيد إطلاق
يدهم في الأمور وفي التصرفات السلطانية..
فإذا أحسوا بشيء من ذلك، أو راودتهم شكوك، أو حتى بعض
الأوهام فيه، فإن حرصهم على محو هذه الدعوة وكل من يقف وراءها من
الوجود، سيكون بلا حدود، ولن تقيده قيود، أو تحول دونه موانع أو سدود.
وهذا يعطي:
أن دعوة الأنبياء والمصلحين من أتباعهم للملوك
والجبارين في منتهى الصعوبة، وغاية الدقة، وأقصى درجات الحساسية، وأن
أي إخلال في ذلك يؤدي إلى حرمان هذا النوع من الناس الذين تتحكم فيهم
تلك العاهات النفسية من الهداية، كما أن ذلك يحركهم إلى حرمان غيرهم
منها، بما يثيرونه من أجواء مشحونة بالتحدي لا يجرؤ معها كثير من الناس
على المبادرة بخطوة في هذا الاتجاه؛ بسبب أخطار لا يملكون القدرة على
دفعها عن أنفسهم، ولا يستطيعون التحرز منها، ولا يمكنهم تحملها.
وإذا راجعنا نصوص الرسائل التي كتبها رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
إلى ملوك الأرض، فإننا نجدها في غاية الدقة في مراعاة حالات أولئك
الملوك، فهي خالية عن أية إثارة لهم، ولا تعطيهم أية فرصة للتخلص أو
التملص من مسؤولية النظر في صحة ما يدعوهم إليه، والتعاطي معه
بمسؤولية، وتعقل.
وإذا ما ظهر من بعض أولئك الجبابرة أي تصرف غير متوازن،
فإنما كان ذلك منه لاعتبارات اختلقها لنفسه، إنطلاقاً من عدوانيته،
وانسجاماً مع جباريته, ومن دون أي مبرر وجده في طريقة تعاطي رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
معه، أو في المضامين التي وجدها في خطابه
«صلى الله عليه وآله»،
الذي أرسله إليه..
ونحن من أجل وضوح ما نرمي إليه بصورة عملية، نلقي نظرة
على بعض تلك الرسائل، مقتصرين على رسائله
«صلى الله عليه وآله»
لأربعة منهم وهم:
1 ـ
ملك الفرس.
2 ـ
ملك الروم.
3 ـ
ملك مصر.
4 ـ
ملك الحبشة.
([1])
تاريخ الخميس ج2 ص29 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص288 والكامل
لابن الأثير ج2 ص210 والجامع للقيرواني ص287 والبداية والنهاية
ج4 ص262 والبحار ج20 ص382 ومروج الذهب ج2 ص289 وفتح الباري ج8
ص98 وج10 ص274 وسفينة البحار ج1 ص376 وتحفة الأحوذي ج7 ص417
ومكاتيب الرسول ج2 ص398 وميزان الحكمة ج4 ص3209 والطبقات
الكبرى ج1 ص258 وتاريخ مدينة دمشق ج45 ص430 والشفا بتعريف حقوق
المصطفى ج1 ص315 وسبل الهدى والرشاد ج11 ص344.
([2])
تاريخ الخميس ج2 ص29 عن الوفاء، والمواهب اللدنية، وأسد الغابة
ج1 ص62 والطبقات الكبرى (ط دار صادر) ج1 ص258 والتنبيه
والإشراف ص225 وتاريخ أبي الفدا ج1 ص148 والطبقات الكبرى ج1 ق2
ص15 ووفاء الوفاء ج1 ص315 والثقات لابن حبان ج2 ص6 وأعيان
الشيعة ج1 ص243 وعن فتح الباري ج10 ص 274 وعن الكامل لابن عدي
ج4 ص1565 وتاريخ مدينة دمشق ج27 ص357 وسبل الهدى والرشاد ج11
ص344.
([3])
تاريخ الخميس ج2 ص29 وراجع: تاريخ الأمم والملوك ج2 ص288.
([4])
تاريخ الخميس ج2 ص29.
([5])
تاريخ الخميس ج2 ص29 عن المواهب اللدنية.
([6])
تاريخ الخميس ج2 ص29 عن المنتقى وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص288
والبحار ج20 ص382.
([7])
تاريخ الخميس ج2 ص29 و 30 عن الإكتفاء وكنز العمال (ط الهند)
ج10 ص418 و 419 و (ط مؤسسة الرسالة) ج10 ص633 و 634 و 635 وج11
ص644 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص254 و 255 والمعجم الكبير
ج25 ص232 و 233 وعن ج20 ص8 والكامل لابن عدي ج4 ص1561 وحياة
الصحابة ج1 ص101 والتراتيب الإدارية ج1 ص190 و 191 ونشأة
الدولة الإسلامية ص75 والطبقات الكبرى (ط ليدن) ج1 ق2 ص15 و 19
والسيرة الحلبية ج3 ص241 والسيرة النبوية لدحلان (مطبوع مع
الحلبية) ج3 ص56 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص289 والآحاد
والمثاني ج1 ص445 والأحاديث الطوال ص60 ومكاتيب الرسول ج1 ص184
و 185 وموسوعة التاريخ الإسلامي ج2 ص650.
([8])
تاريخ الخميس ج2 ص29 عن الواقدي.
([9])
الآية 4 من سورة إبراهيم.
([10])
مكاتيب الرسول ج1 ص84.
([11])
مكاتيب الرسول ج1 ص80 وكنز العمال ج10 ص617 والسيرة النبوية
لدحلان ج2.
([12])
راجع: دائرة المعارف ج6 ص277 ـ 281 والوسيط في الأدب العربي.
([13])
راجع: الإختصاص ص83 وشرح الشفاء للقاري ج1 ص195 والسيرة
النبوية لابن هشام ج1 ص178 وشرح أصول الكافي ج9 ص322 ونور
البراهين ج1 ص120 ومكاتيب الرسول ج1 ص81 وتذكرة الموضوعات ص87
وكشف الخفاء ج1 ص200 وتفسير القرآن العظيم ج1 ص32 وسبل الهدى
والرشاد ج1 ص429 وج2 ص103 والقاموس المحيط ج1 ص6 ومغني اللبيب
ج1 ص114والسيرة النبوية لدحلان ج2 وغير ذلك.
([14])
التراتيب الإدارية ج1 ص84 و 49 عن المطالع النصرية للهوريني،
وعن السهيلي، ومسند أحمد ج1 ص247 والروض الأنف ج3 ص83 والإمتاع
ص101 وتاريخ الخميس ج1 ص395 والسيرة الحلبية ج2 ص193 وطبقات
ابن سعد (ط ليدن) ج2 ق1 ص14 ونظام الحكم في الشريعة والتاريخ
الإسلامي (الحياة الدستورية) ص48 والبحار ج19 ص355 والمستدرك
للحاكم ج2 ص140 ومجمع الزوائد ج4 ص96 والبداية والنهاية ج3
ص397 والسيرة النبوية لابن كثير ج2 ص512.
([15])
نسب قريش لمصعب الزبيري ص174 والإصابة ج1 ص344 عنه والإستيعاب
(مطبوع مع الإصابة) ج2 ص372 وأسد الغابة ج3 ص175 وراجع: السنة
قبل التدوين ص299 ومكاتيب الرسول ج1 ص105 و 394.
([16])
راجع: البحار ج20 ص372 و 352 ومسند أحمد ج4 ص298 والكامل في
التاريخ ج2 ص204 والأموال ص158 وسنن الدارمي ج2 ص238 والسنن
الكبرى للبيهقي ج8 ص5 وكنز العمال (ط الهند) ج10 ص303 والمصنف
لابن أبي شيبة ج14 ص435 والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج8
ص93 و 96 وصحيح البخاري ج4 ص71 وج5 ص84 وصحيح مسلم ج5 ص174
والتراتيب الإدارية ج1 ص173 وشرح الشفاء للقاري ج1 ص727 و 729
والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص34.
([17])
مختصر مفيد ج1 ص11.
([18])
الآية 41 من سورة هود.
([19])
الآية 110 من سورة الإسراء.
([20])
الآية 20 من سورة النمل.
([21])
راجع: المصادر التالية: الدر المنثور ج5 ص106 و 107 عن عبد
الرزاق، وابن سعد، وابن أبي شيبة، وأبي عبيد في فضائله، وابن
أبي حاتم، وابن المنذر، وأبي داود في المراسيل، وكنز العمال
(ط الهند) ج10 ص194 والتنبيه والإشراف ص225 والعقـد الفريـد ج4
ص158 والـتراتيـب الإداريـة ج1 ص140 = = ومستدرك الوسائل ج8
ص432 و 433 والسيرة الحلبية ج3 ص20 وج1 ص249 والجامع لأحكام
القرآن ج1 ص92 وج13 ص194 والوزراء والكتاب للجهشياري ص13 و 14
والطبقات الكبرى ج1 ص263 والمصنف لابن أبي شيبة ج14 ص105
وأحكام القرآن للجصاص ج1 ص8 والمراسيل لأبي داود ص90 والتفسير
الكبير للرازي ج1 ص200 وروح المعاني ج1 ص27 وثمرات الأوراق
(بهامش المستطرف) ج2 ص105 وعمدة القاري ج5 ص291.
([22])
السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج2 ص769.
([23])
تفسير العياشي ج1 ص19 ومصباح الفقيه (كتاب الصلاة) ص76 والبحار
ج89 ص236 ونور الثقلين ج1 ص6.
([24])
راجع: الدر المنثور ج1 ص7
وج3 ص208 عن أبي داود، والبزار، والدارقطني في الإفراد،
والطبراني، والحاكم، وصححه، والبيهقي في المعرفة، وفي شعب
الإيمان، وفي السنن الكبرى، وعن أبي عبيد، والواحدي، وفتح
الباري ج9 ص39 وتفسير القرآن العظيم ج1 ص16 ونيل الأوطار ج2
ص228 ومستدرك الحاكم ج1 ص231 و 232 وصححه على شرط الشيخين،
وتلخيص المستدرك للذهبي، بهامشه، وأسباب النزول للواحدي ص9 و
10 والسنن الكبرى ج2 ص42 و 43 ومحاضرات الأدباء المجلد الثاني،
الجزء 4 ص433 والإتقان ج1 ص78 وبحوث في تاريخ القرآن وعلومه
ص56 و 57 وراجع ص55 عن بعض من تقدم، والجامع لأحكام القرآن ج1
ص95 وعمدة القاري ج5 ص292 ونصب الراية ج1 ص327 والمستصفى ج1
ص103 وفواتح الرحموت (بهامشه) ج2 ص14 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص34
والتفسير الكبير ج1 ص208 وغرائب القرآن بهامش الطبري ج1 ص77
والمصنف للصنعاني ج2 ص92 ومجمع الزوائد ج6 ص310 وج2 ص109 عن
أبي داود, والبزار, وكنز العمال ج2 ص368 عن الدارقطني في
الإفراد، والتمهيد في علوم القرآن ج1 ص212 عن الحاكم
واليعقوبي، وسنن أبي داود ج1ص209 والمنتقى ج1 ص380 وتبيين
الحقائق ج1 ص113 وكشف الأستار ج3 ص40 ومشكل الآثار ج2 ص53
والمراسيل لأبي داود السجستاني ص90 وأحكام القرآن
للجصاص ج1 ص15 وذكر أخبار إصبهان لأبي نعيم ج2 ص356 والمستدرك
على الصحيحين ج2 ص611 والكـامـل لابن = = عدي ج6 ص3039 وج3
ص1039 والضعفاء الكبير للعقيلي ج2 ص35 والمعجم الكبير ج12 ص82
والبيان في تفسير القرآن ص442 وعن فتح الباري ج9 ص35 وتفسير
أبي حمزة الثمالي ص106 والدر المنثور ج1 ص7.
([25])
كنز العمال (ط الهند) ج10 ص493 والدر المنثور ج1 ص10 ومكاتيب
الرسول ج1 ص56 وميزان الحكمة ج2 ص1366 وج3 ص2664 والجامع
الصغير ج1 ص481 وشرح مسند أبي حنيفة ص5 وفيض القدير ج3 ص294
وفتح القدير ج1 ص19.
([26])
جامع أحاديث الشيعة ج5 ص116 و 117 عن الكافي، والمحاسن، وعن
السيرة الحلبية ج3 ص240 ومستدرك الوسائل عن العياشي، ونور
الثقلين ج1 ص6 = = وج2 ص238 عن العياشي، والكافي، والبرهان ج1
ص42 والوسائل ج4 ص747 والبحار ج82 ص20 وج89 ص236 وج92 ص234 و
236 وتفسير العياشي ج1 ص19 وتفسير كنز الدقائق ج1 ص31، وراجع:
مكاتيب الرسول للأحمدي ج1 ص56 وج3 ص505 و 506 عن مصادر كثيرة.
([27])
الكافي ج3 ص313 والوسائل (ط دار الإسلامية) ج4 ص746 ومكاتيب
الرسول ج1 ص56 وتفسير نور الثقلين ج1 ص6 وج3 ص84 وتفسير كنز
الدقائق ج1 ص31.
([28])
مكاتيب الرسول ج1 ص65 وج3 ص505 و 509 والآحاد والمثاني ج5 ص12
وتاريخ مدينة دمشق ج11 ص65.
([29])
راجع: مكاتيب الرسول ج1 ص67 و 68.
([30])
المعجم الكبير ج4 ص225 ودلائل النبوة لأبي نعيم ص153 وعن فتح
الباري ج8 ص165 وكنز العمال ج10 ص585 و 635 وتاريخ مدينة دمشق
ج17 ص209 وسير أعلام النبلاء ج2 ص552 والبداية والنهاية ج4
ص304 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص505 وسبل الهدى والرشاد
ج11 ص353.
([31])
مكاتيب الرسول ج1 ص69 والدر المنثور ج4 ص156 ومجمع الزوائد ج5
ص308 وج8 ص236.
([32])
راجع: مكاتيب الرسول ج1
ص67 و 68 وج2 ص373 و 649 وج3 ص548 وأشار في هامشه إلى:
التراتيب الإدارية ج1 ص137 و 138 عن صبح الأعشى، وإكمال الدين
ص571 والغارات ج1 ص210 وكنز الفوائد ص249 والبحار ج22 ص87 وج51
ص249 وعن ج74 ص162 والمستـدرك للحـاكم ج3 = = ص273 والمعجم
الصغير ج1 ص151 وكنز العمال ج15 ص746 وتاريخ الأمم والملوك ج2
ص385 ومجمع البحرين ج1 ص569.
([33])
تاريخ الخميس ج2 ص29. وراجع: البداية والنهاية ج5 ص356 وج6 ص2
= = و 3 و4 والبحار ج7 ص202 و 204 وسنن أبي داود ج4 ص88 و 89
والطبقات الكبرى (ط ليدن) ج1 ق2 ص165 وعن فتح الباري ج10 ص269
والسيرة الحلبية ج3 ص240 و 241 والسيرة النبوية لدحلان (مطبوع
مع الحلبية) ج3 ص55 و 56 والتراتيب الإدارية ج1 ص179.
([34])
راجع: الجامع الصغير للقيرواني ص287 والسيرة الحلبية ج3 ص240
والسيرة النبوية لدحلان (مطبوع مع الحلبية) ج3 ص55.
([35])
تاريخ يحيى بن معين ج3 ص53 ومستدرك الحاكم ج3 ص490 ومكاتيب
الرسول ج1 ص188 ومجمع الزوائد ج2 ص284 وعن فتح الباري ج2 ص455
والمعجم الكبير ج20 ص5 وكنز العمال ج1 ص411 وتاريخ مدينة دمشق
ج57 ص155 وعن الإصابة ج6 ص42.
([36])
راجع: مكاتيب الرسول ج1 ص189 و 190 وج2 ص422 ونصب الراية ج6
ص564 وموسوعة التاريخ الإسلامي ج2 ص663.
|