|
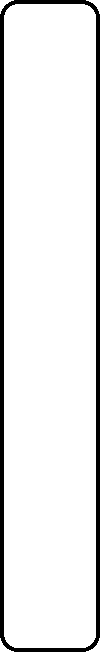 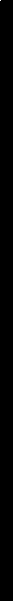 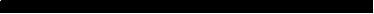 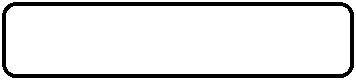 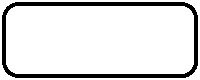
مـن المـديــنــة إلـى خــيــبـــر
فقد كانت هدنة الحديبية قد أعطت الانطباع بأن المسلمين
قد أصبحوا قوة كبيرة، فرضوا هيبتهم في المنطقة بأسرها.. الأمر الذي دعا
قريشاً إلى القبول بالهدنة، بعد أن أنهكتها الحروب المتتالية معهم..
بل إنه
«صلى الله عليه وآله»
أصبح يعمل على نشر دعوته في كل بقاع الدنيا، وهو يرسل إلى أعظم ملوك
الأرض ـ طالباً منهم الدخول في دينه ـ في خطاب قوي وحازم.
ولم يعد في المحيط الذي يعيش فيه قوة كبيرة متماسكة،
يمكن أن يحسب لها حساب، إلا يهود منطقة خيبر، الذين كانوا قادرين على
تجهيز عشرة آلاف مقاتل، بل أكثر من ذلك. وهي قوة لا يستهان بها، إذ
لديهم حصون منيعة، وقدرات إقتصادية، ولسوف تكون المواجهة صعبة معهم،
ولا سيما إذا أرادوا اتباع أسلوب التسويف، وإتلاف الوقت، بالاستفادة من
الحصون الكثيرة التي تحت يدهم، التي كان فيها من المؤن، والأقوات ما
يكفي لأشهر طويلة.
وليبقى الجيش الإسلامي، الذي لم يكن يملك الكثير من
ذلك، ليبقى في العراء يعيش الملل، ويكابد لحظات الانتظار الطويلة،
والثقيلة، دون أن تلوح له في الأفق بارقة أمل، وليرهقه الخمول والكسل،
حيث لا مجال له للقيام بأي عمل..
وكانت استعراضات يهود خيبر لقوتهم، وظهور اغترارهم بها،
وركونهم إليها، قد لفتت الأنظـار، ولعلها تركت آثاراً على بعض الضعفـاء
في المنطقة، مثل غطفان، وسواها.
ولكن الأمور قد سارت في غير الاتجاه الذي توقعوه، إذ
سرعان ما تهاوت أحلامهم، ودكت حصونهم، وخابت آمالهم، وأنجز الله تعالى
لنبيه وعده، ونصر جنده، وهزم جموع اليهود وحده، وكانت كلمة الله هي
العليا، وكلمة الباطل هي السفلى. كما سنبينه في سياق حديثنا هذا.
إن الذي يراجع المصادر والموسوعات
التاريخية، والحديثية، يلاحظ:
أن ثمة فرقاً بين ما دوَّنوه من أحداث، وأشاروا إليه من جزئيات وتفاصيل
في تاريخهم لمرحلة ما قبل الحديبية وخيبر، ثم في تاريخهم للحديبية
ولخيبر فما بعدهما..
حيث يلاحظ:
أن المرحلة السابقة تُعْرَضُ فيها الأحداث بما لها من
طابع كلي وعام، ولا تجد فيها من الاستغراق في الجزئيات والتفاصيل ما
يقترب إلى مستوى ما حفلت به الأحداث المتأخرة عن الحديبية..
ولعل من أسباب ذلك هو:
أن الحديبية قد أفسحت المجال لاختلاط المسلمين مع غيرهم
في التجارات، وإنشاء العلاقات، وجَهَر بالإسلام من كان متستراً به،
ودخلت فئات كثيرة في هذا الدين، أو كانت تتهيأ لذلك، وهي تقوم برصد
حركة الواقع، وبملاحقة الأمور بعين الرضا والقبول.. إما بهدف تحصيل
القناعة والاعتقاد التام، أو من أجل الحفاظ على المصالح، والحصول على
الامتيازات، أو ما إلى ذلك..
وبعد وفاة رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
حاول كل أولئك الذين يريدون أن يبرروا لمواقف وسياسات، وممارسات،
وأقاويل، ومذاهب بعينها ـ حاولوا ـ أن يرجعوا إلى هذه الفترة التي
عاشوها مع رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
واستفادوا من مشاهداتهم لحركاته وسكناته، ومواقفه، وكل أحواله منها،
فاتخذوا منها مرتكزاً لإنشاء منظومة التعاليم والتوجيهات والسياسات،
والمذاهب الاعتقادية، والفقهية، التي لم تكن لتجد طريقها إلى عقل،
ووجدان وحياة الناس لو لم تستمد شرعيتها من حياته
«صلى الله عليه وآله»،
ومن أقواله، وأفعاله، ومواقفه..
أما الفترة التي سبقت هذا المفصل التاريخي فقد غاب عنها
أكثر هؤلاء، وجهلوا الكثير من جزئياتها وتفاصيلها، فأنتج ذلك عجزاً عن
التوسل بها في إنشاء تلك المنظومة، وفق ما يريدون، وعلى حسب ما يشتهون.
وبعد هذه الإلماحة السريعة نقول:
خيبر اسم منطقة تقع على ثلاثة أيام من المدينة، على
يسار الحاج القادم من الشام. وبينها وبين المدينة ثمانية برد (والبريد
أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، وكل ميل أربعة آلاف خطوة، وكل خطوة
ثلاثة أقدام).
والخيبر بلسان اليهود:
هو الحصن، ولذا سميت خيابر أيضاً([1]).
وفي هذه المنطقة حصون ومزارع، ونخل
كثير، حتى قالوا:
كان في الكتيبة أربعون ألف عذق. وتوصف خيبر بكثرة التمر([2]).
وفي خيبر ثمانية حصون، هي:
النطاة، والوطيح، والسلالم، والكتيبة، والشق، والصعب،
وناعم، والقموص.
قال الماوردي وغيره:
«وكان أول حصن فتحه رسول الله «صلى الله عليه وآله»
فيها ناعم، ثم القموص، ثم حصن الصعب بن معاذ. وكان أعظم حصون خيبر،
وأكثرها مالاً، وطعاماً، وحيواناً، ثم الشق، والنطاة، والكتيبة.
فهذه الحصون الستة فتحها النبي
«صلى الله عليه وآله»
عنوة، ثم افتتح الوطيح والسلالم، وهو آخر فتوح خيبر صلحاً، بعد أن
حاصرهم.
وملك من هذه الحصون الثمانية ثلاثة
حصون:
الكتيبة، والوطيح، والسلالم. أما الكتيبة، فأخذها بخمس الغنيمة، وأما
الوطيح والسلالم فهما مما أفاء الله عليه؛ لأنه فتحهما صلحاً، فصارت
هذه الحصون الثلاثة بالفيء»([3]).
ولكن هذا الكلام الأخير غير مقبول في فقه أهل البيت
«عليهم
السلام»،
وسيأتي البحث عن ذلك إن شاء الله.
كما أن ما ذكره:
من أن فتح حصن الصعب قد كان بعد فتح حصن القموص غير
دقيق، كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
قال الصالحي الشامي:
«ولابن زبالة حديث: «ميلان في ميل من خيبر مقدس».
وحديث:
«خيبر
مقدسة والسوارقية مؤتفكة».
وحديث:
«نعم
القرية في سنيات الدجال خيبر»..»([4]).
والسوارقية:
«قرية
أبي بكر، بين مكة والمدينة، وهي نجدية، فيها مزارع ونخل كثير»([5]).
ونقول:
إن الحديث عن كون خيبر نعم القرية في زمن الدجال موضع
ريب وشك، ولعله من أفائك اليهود أنفسهم.
إلا أن يكون المقصود بهذا الحديث:
أنها تكون موضعاً مأموناً، بسبب وجود سبعين ألفاً من اليهود مع الدجال،
على كل رجل منهم ساج وسيف محلى([6]).
ومن الطبيعي:
أن يهتم يهود خيبر بأمر الدجال، ما دام أن الدجال يأتمر
بأوامرهم، وينتهي إلى مقاصدهم..
وربما تكون هذه الأحاديث من موضوعات اليهود لتعظيم
البلاد التي كانوا يسكنونها، وللإيحاء بأن حرب النبي
«صلى
الله عليه وآله»
لهم فيها كانت انتهاكاً لحرمة ما هو مقدس..
على أننا لا ندري:
ما الذي جعل قرية أبي بكر
«مؤتفكة»؛
أي تفعل الأفك والافتراء، دون سائر القرى والله هو العالم..
لما قدم رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
إلى المدينة من الحديبية، وذلك في ذي الحجة ـ كما قال ابن إسحاق ـ من
سنة ست، مكث بها عشرين ليلة، أو قريباً منها، ثم خرج في المحرم إلى
خيبر.
وكان الله عز وجل وعده إياها، وهو بالحديبية، فقد نزلت
عليه سورة الفتح، فيما بين مكة والمدينة، وفيها قوله تعالى: ﴿وَعَدَكُمُ
الله مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ﴾([7])
يعني خيبر([8]).
وعن ابن عباس:
أقام بعد الحديبية في المدينة عشر ليال([9]).
وعن سليمان التيمي:
خمسة عشر يوماً([10]).
وقيل:
أقام شهراً وبعض شهر([11]).
وقال مالك:
كانت خيبر سنة ست، وإليه ذهب محمد بن حزم. والجمهور ـ
كما في زاد المعاد ـ أنها في السابعة([12]).
ويمكن الجمع:
بأن من أطلق سنة ست فإنما جاء كلامه بناءً على ابتداء السنة من شهر
الهجرة الحقيقي وهو ربيع الأول. وابن حزم من هؤلاء أيضاً، فإنه يرى:
ابتداء السنة الهجرية من شهر ربيع الأول([13]).
ونقل الحلبي عن الجمهور:
أنه سار إلى خيبر بعد أن مضى من محرم السنة السابعة
عشرون يوماً، أو قريب من ذلك([14]).
وقال محمد بن موسى الخوارزمي:
غزاها النبي
«صلى الله عليه وآله»
حين مضى ست سنين وثلاثة أشهر وواحد وعشرون يوماً للهجرة([15]).
وهذا معناه:
أنها كانت في آخر جمادى الأولى، بناءً على: أن أول
السنة محرم، أو في آخر جمادى الثانية بناءً على: أن أول السنة الهجرية
هو ربيع الأول.
قيل:
إن غزوة خيبر كانت في شهر صفر([16]).
وقيل:
في ربيع الأول([17]).
وقيل:
في جمادى الأولى([18]).
وقيل أيضاً:
إنها في شهر رمضان([19]).
ولعل سبب هذا القول الأخير هو:
تصحيف كلمة حنين بكلمة خيبر. فإن النبي
«صلى الله عليه وآله»
قد سار إلى حنين بعد الفتح، وقد كان الفتح في شهر رمضان([20]).
وقالوا:
إنه
«صلى الله عليه وآله»
أقام يحاصر خيبر بضع عشرة ليلة، إلى أن فتحها في صفر([21]).
وسيأتي:
أن ذلك غير دقيق، وأن حصارها قد تعدى الأيام إلى الأشهر
كما سنرى، ولعله يتحدث عن حصار بعض حصونها فقط..
وقد روي عن ابن عباس:
أنه
«صلى الله عليه وآله»
أقام بخيبر ستة أشهر يجمع بين الصلاتين([22]).
وعنه أيضاً:
أنه أقام بها أربعين يوماً، وسنده ضعيف([23]).
وأن حساب أيام الحصار للحصون المختلفة، وفق ما ورد في
النصوص التاريخية، والروائية
يعطي:
أن الحصار قد دام عشرات الأيام.. وإن لم يصل إلى ستة أشهر..
قال الواقدي:
أمر رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
أصحابه بالخروج، فجدوا في ذلك، واستنفروا مَنْ حوله ممن شهد الحديبية،
يغزون معه.
وجاء المخلَّفون عنه في غزوة الحديبية ليخرجوا معه رجاء
الغنيمة، ولأنها ريف الحجاز طعاماً وودكاً وأموالاً، فقال
«صلى الله عليه وآله»:
«لا
تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد، فأما الغنيمة فلا»([24]).
ثم أمر منادياً ينادي بذلك، فنادى به([25]).
ونقول:
1 ـ
إن غزوة الحديبية كانت بمثابة امتحان للكثيرين، من حيث
إن نتائجها لم تكن واضحة لكثير من الناس الذين يرصدون سير الأمور فيها.
مع أن الحقيقة هي:
أنه قد كان فيها ما لم يكن متوقعاً، فإن النتائج كانت
باهرة على أكثر من صعيد، وفي أكثر من اتجاه.
2 ـ
ومن النتائج التي ظهرت: أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
قد أصبح قادراً على المبادرة لإزالة الشوكة الجارحة من خاصرة الكيان
الإسلامي، المتمثلة باليهود، الذين ما فتئوا يسعون في إثارة الناس ضده،
ويحرضون القبائل المختلفة على حربه، ويشاركون في هذه الحروب بالمال
والرجال، وإفساد القلوب، وتسميم الأجواء باستمرار.
3 ـ
إن العدو الذي كان له امتداد طبيعي في المنطقة، بسبب
موقعه من المقدسات، وبسبب علاقاته، ونفوذه الديني والتجاري، والاجتماعي
في المنطقة ـ إن هذا العدو ـ قد لُجم، وأُقصي عن موقع التأثير المباشر،
وتهيأت الفرصة لكثير من الناس لممارسة حرياتهم، في التعرف على دعوة
الإسلام عن قرب، ومن دون خوف أو رهبة من أحد..
وأصبح بإمكان الكيان الإسلامي أن يرتب أوضاعه الداخلية،
وأن يعالج المشاكل التي يفرضها عليه، أو يخلقها له أعداؤه الذين يعيشون
في محيطه، أو في المحيط القريب منه، والشديد التأثير عليه..
4 ـ
إن الإنجاز الذي حققه المسلمون في الحديبية قد أذكى
فيهم الطموح، وبعث فيهم ثقة بأنفسهم، وأعطاهم حيوية ونشاطاً غير عادي.
وبدا للكثيرين منهم أن رحلتهم إلى خيبر كانت رحلة الاستيلاء على
المغانم، والفوز بها.
وقد رسخ هذا الاعتقاد لدى الكثيرين منهم الوعد الإلهي
بهذه المغانم، فقد قال تعالى: ﴿وَعَدَكُمُ
اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ..﴾([26]).
حيث فسرت هذه الآية بما مكنهم الله تعالى منه في خيبر..
حسبما تقدم في أواخر الحديث عن صلح الحديبية..
5 ـ
إن ما فعله المخلفون في قضية الحديبية كان شديد الخطورة
في أكثر من اتجاه، فعدا عن أنه يعبر عن ضعفهم الإيماني، وعن حبهم
للدنيا، فإنه يجرئ الآخرين على ممارسة هذا الأسلوب في التعاطي مع أوامر
رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
الأمر الذي يمهد لاختلالات خطيرة، ربما تؤثر على الكيان الإسلامي كله.
6 ـ
ثم إن النداء بحرمان هؤلاء، وبتخصيص أولئك، لا بد أن
يثير الشعور لدى أهل الحديبية بالعزة والكرامة، ويقابله شعور آخر
بالخزي وبالذنب لدى الذين تخلفوا حرصاً على الحياة بالأمس، وشدوا
الرحال طمعاً بالغنيمة اليوم.
وكفى بذلك محفزاً لمزيد من التضحية والإقدام لأولئك،
ورادعاً عن تكرار ما حدث لدى هؤلاء، ودرساً لغيرهم ممن لعلهم يسيرون
على نفس الطريق.
وقال ابن هشام وغيره:
إنه
«صلى الله عليه وآله»
استخلف على المدينة
«نميلة»
ـ بالتصغير ـ ابن عبد الله الليثي([27]).
وقيل:
بل استخلف سباع بن عُرفُطة ـ بضم العين والفاء([28]).
وقيل:
أبا ذر([29]).
ولعل سبب هذه الاختلافات الكثيرة في أمثال هذه الأمور
هو: أن الرواة كانوا يروون من حفظهم، وكانت الغزوات كثيرة، والمعلومات
غزيرة، فيتفق أن يختلط الأمر على بعض الرواة بين غزوة وأخرى..
كما أنه قد يكون هناك سياسات أو عصبيات، أو مصالح لدى
بعض الفئات تقضي بإقصاء فريق، وبإعطاء المواقف، وإيكال المهمات إلى
فريق آخر..
وقد ادَّعى أنس:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله»
قد قال لأبي طلحة، حين أراد الخروج إلى خيبر: التمسوا لي غلاماً من
غلمانكم يخدمني، فخرج أبو طلحة مُرْدِفي، وأنا غلام قد راهقت، فكان
رسول الله «صلى الله عليه وآله» إذا نزل خَدَمْتُه، فسمعته كثيراً ما
يقول: إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل، والجبن،
وضلع الدين، وغلبة الرجال([30]).
ومما يؤيد أن يكون أول اتصال لأنس
بالنبي «صلى الله عليه وآله» في خيبر: أنهم يقولون: إنه غزا مع النبي
«صلى الله عليه وآله» ثماني غزوات فقط([31]).
وهذا يكذب ما زعموه، من أن أمه أتت به إلى النبي
«صلى الله عليه وآله»
وقالت له: هذا غلام كاتب.
قال:
فخدمته تسع سنين فما قال لشيء صنعته: أسأت، أو بئس ما
صنعت([32]).
وفي رواية أخرى:
أنها قالت: هذا أنس غلام يخدمك فاقبله.
وذكروا:
أنه خرج معه
«صلى الله عليه وآله»
إلى بدر يخدمه([33]).
نعم، وقد كان أنس يستحق هذه الأوسمة، فإنه كان على
السقاية في البحرين من قبل أبي بكر([34]).
وكان يبث أقاويل تفيد في تأييد خلافة مناوئي علي «عليه
السلام»، ويحجب حقائق حساسة، يستفيد من حجبها وإنكارها هذا الفريق
بالذات.
فهو من أجل هذا وذاك يستحق أن تزجى له المدائح، وأن
تسطر له المآثر، ليصبح كلامه أكثر وقعاً، وأعظم أثراً..
وقد استحق من جهة أخرى أن يدعو عليه أمير المؤمنين
«عليه
السلام»
بسبب كتمانه حديث الغدير مرة، وحديث الطير أخرى، ولموقفه من طلحة
والزبير في حرب الجمل ثالثة، فأصيب بالبرص، وعدَّ في جملة البرصان!!([35]).
ولكن كل أباطيلهم وأضاليلهم لم تستطع حجب الحقيقة، فقد
روي عن الصادق
«عليه
السلام»
أنه قال: ثلاثة كانوا يكذبون على النبي
«صلى الله عليه وآله»:
أبو هريرة، وأنس بن مالك، وامرأة([36]).
وأخرج
«صلى الله عليه وآله»
معه إلى خيبر أم المؤمنين أم سلمة
«رحمها
الله»([37]).
مع أنها كانت معه في غزوة الحديبية أيضاً..
ولنا وقفة مع هذا الأمر بالذات:
فإنه إذا كان
«صلى الله عليه وآله»
يقرع بين نسائه، لتعيين التي تخرج معه في سفره كما يدَّعون، فإن القرعة
تكون قد وقعت على أم سلمة مرتين..
وإذا كان الله تعالى يسدد نبيه
«صلى الله عليه وآله»،
لتصيب قرعته ما يحبه الله تعالى، أو ما فيه مصلحة لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
فإن هذا يدل على اجتماع هذين الأمرين معاً في حق أم سلمة رضوان الله
تعالى عليها؛ فإن هذه المرأة الفاضلة، والتي هي أفضل نساء النبي
«صلى الله عليه وآله»
بعد خديجة، كان الله يحبها وكانت المصلحة تقضي بأن تكون هي دون سواها
معه في غزوتين هما من أخطر ما مر برسول الله
«صلى الله عليه وآله»
وبالمسلمين، وأشده حساسية، ويحتاج النبي
«صلى الله عليه وآله»
فيه إلى هدوء البال، وإلى إبعاد أي نوع من أنواع الأذى أو النكد،
والمنغصات له..
وكما كان واضحاً أنه: ﴿وَمَا
كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ
أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ..﴾([38])
بل لا بد من الطاعة والإنقياد.
فإن من الواضح أيضاً:
أن لا حق للنساء بمرافقة أزواجهن في السفر من الناحية الشرعية، ويستطيع
الزوج أن يختار أيتهن شاء لمرافقته.. ولكن الرسول
«صلى الله عليه وآله»
التزم بالقرعة بينهن.
فذلك يعني:
أنه قد جعل لهن ما يشبه الحق، رفقاً منه بهن، وعطفاً منه عليهن..
وإنما جعل
«صلى الله عليه وآله»
طريقاً للتعيين ـ مع علمه بأن الله تعالى هو الذي يتولى تسديده، وهو
الذي يختار له ـ من أجل تسكين خواطرهن، وعدم إثارة أي من المشاعر
السلبية لديهن، حتى لو كن يظلمن أنفسهن وغيرهن، ويظلمن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
أيضاً في ذلك..
ولولا ما ذكرنا، لأمكن أن يقال:
لقد كان بإمكانه
«صلى الله عليه وآله»
أن لا يُخرج معه منهن أحداً، أو أن يخرجهن في أسفاره بصورة متوالية،
وفق تراتبية القَسْم والليلة لهن، أو وفق قرعة تحدد هذه التراتبية.
قال الصالحي الشامي:
ولما تجهز رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
والناس، شق على يهود المدينة الذين هم موادعو رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
وعرفوا أنه إن دخل خيبر أهلك أهل خيبر، كما أهلك بني قينقاع، والنضير،
وقريظة.
ولم يبق أحد من يهود المدينة له على أحد من المسلمين حق
إلا لزمه، وطالبه به.
وعن ابن أبي حدرد، بسند صحيح:
أنه كان لأبي الشحم اليهودي خمسة دراهم.
ولفظ الطبراني، والواقدي:
أربعة دراهم، في شعير أخذه لأهله فلزمه.
فقال:
أجلني، فإني أرجو أن أقدم عليك فأقضيك حقك إن شاء الله، قد وعد الله ـ
تعالى ـ نبيه أن يغنمه خيبر.
فقال أبو الشحم حسداً وبغياً:
أتحسبون أن قتال خيابر مثل ما تلقون من الأعراب؟ فيها:
ـ والتوراة ـ عشرة آلاف مقاتل.
وترافعا إلى رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
فقال رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
«أعطه
حقه».
قال عبد الله:
والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها.
قال:
أعطه حقه.
قال:
وكان رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
إذا قال ثلاثاً لم يراجع.
قال عبد الله:
فخرجت، فبعت أحد ثوبي بثلاثة دراهم، وطلبت بقية حقه، فدفعت إليه، ولبست
ثوبي الآخر. وأعطاني ابن أسلم بن حريش ـ بفتح الحاء وكسر الراء ـ ثوباً
آخر.
ولفظ الطبراني:
فخرج به ابن أبي حدرد إلى السوق، وعلى رأسه عصابة، وهو
يأتزر بمئزر، فنزع العمامة عن رأسه فأتزر بها، ونزع البردة فقال: اشتر
مني هذه، فباعها منه بالدراهم، فمرت عجوز فقالت: ما لك يا صاحب رسول
الله
«صلى الله عليه وآله»؟
فأخبرها.
فقالت:
ها دونك هذا البرد، فطرحته عليه.
فخرجت في ثوبين مع المسلمين، ونفلني الله ـ تعالى ـ من
خيبر، وغنمت امرأة بينها وبين أبي الشحم قرابة، فبعتها منه([39]).
ونقول:
1 ـ
إن يهود المدينة قد جربوا حظهم في الحرب مع رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
ورأوا بأم أعينهم كيف أن الله تعالى نصره عليهم..
وعرفوا مسبقاً نتائج حركته باتجاه خيبر.. وقد كانت ردة الفعل لديهم
غريبة وعجيبة، من حيث إنها اقتصرت على السعي لحفظ أموالهم مهما كانت
زهيدة، حتى ما كان بمقدار أربعة دراهم في شعير، فصاروا يلحون بمطالبة
غرمائهم، ويلزمونهم بدفعها، وكأنهم يظنون: أن انتصار المسلمين في خيبر
سوف ينشأ عنه ضياع تلك الأموال..
وربما كان المحفز على تفكيرهم هذا
هو:
اعتقادهم أن ضعف وحاجة المسلمين إليهم، وحاجتهم إلى تسكين الأوضاع،
التي كانت دقيقة وحساسة بسبب القوة الضاربة التي كانت لليهود في
المنطقة، هو الذي يفرض على المسلمين الوفاء بالعهود، وقضاء الديون.
فهم قد قاسوا المسلمين على أنفسهم، فإن هذا بالذات هو
طريقة وديدن اليهود في التعامل مع الآخرين، وهذه هي معاييرهم وأساليبهم
حيث إنهم يخضعون لقوة المال، أو لقهر السلطان، أو سيمارسون مكراً
واستدراجاً، أو ما إلى ذلك.
وقد فاتهم أن المسلمين ـ حتى العاديين منهم ـ إنما
يتعاملون معهم ومع غيرهم بالمبادئ والقيم، وبموجبات الأخلاق والذمم.
ولقد صدق الذي قال:
وكل إناءٍ بالذي فيه ينضح.
2 ـ
ورغم خوف اليهود الشديد من أن يكون مصير أهل خيبر مثل
مصير بني قينقاع والنضير وقريظة، وقد رأوا بأم أعينهم، كيف أن المسلمين
قد انتصروا على أعدائهم، رغم كثرة العدد، وحسن العدة لدى أولئك
الأعداء، مع قلة في العدد وضعف في العدة في جانب المسلمين.
وقد تكرر هذا النصر أكثر من مرة ومرتين، فلا مجال لأن
يتوهم أحد أن الصدفة هي التي فرضته، بل هو سنة إلهية، ولطف رباني أجراه
الله على أيديهم، ولهج به القرآن، وأصبح تشريعاً يفرض على المسلمين
الالتزام بمقتضياته.
نعم، رغم ذلك كله، فإن اليهود
توهموا:
أن كثرة العدد سيكون لها شأن في مسار الحرب، ومصير القائمين بها.
وقال المؤرخون أيضاً:
وجاء أبو عبس ابن جبر، فقال:
يا رسول الله، ما عندي نفقة، ولا زاد، ولا ثوب أخرج فيه، فأعطاه رسول
الله
«صلى الله عليه وآله»
شقة سنبلانية: (جنسٌ من الغليظ، شبيه بالكرباس).
قال سلمة:
خرجنا مع النبي
«صلى الله عليه وآله»
إلى خيبر، فسرنا ليلاً، فقال رجل من القوم، لعامر بن
(سنان) الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلاً شاعراً، فنزل
يحدو بالقوم، يقول:
اللـهم لـولا أنت مـا
اهتـديـنـــا ولا تـصـدقـنــا ولا صـلـيـنــــا
فـاغـفـر فـداء لـك مـا اتـقـيـنـا وألــقــين سـكـيـنــة
عـلـيــنــا
وثـبــت الأقــدام إن لاقـيــنـــا إنــا إذا صــيـــح
بـنــا أتــيـنــا
وبـالـصـيـاح عــولــوا عـلـيـنـا
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«من
هذا السائق»؟
قالوا:
عامر بن الأكوع.
قال:
«يرحمه
الله».
وفي رواية:
«غفر
لك ربك».
قال:
وما استغفر رسول الله «صلى الله عليه وآله» لإنسان يخصه
إلا استشهد.
فقال عمر، وهو على جمل:
وجبت يا رسول الله، لولا أمتعتنا بعامر.
وفي نص آخر:
أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
هو الذي طلب ذلك من عامر، فقال عامر: يا رسول الله، قد تولى قولي. أي
الشعر.
فقال له عمر:
إسمع، وأطع. فنزل يرتجز الخ..([40]).
وروى الحارث بن أبي أسامة، عن أبي
أمامة، والبيهقي عن ثوبان:
أن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
قال في غزوة خيبر:
«من
كان مضعفاً أو مصعباً فليرجع».
وأمر بلالاً فنادى بذلك، فرجع ناس، وفي القوم رجل على
صعب، فمر من الليل على سواد فنفر به فصرعه، فلما جاؤوا به رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
قال:
«ما
شأن صاحبكم»؟.
فأخبروه، فقال:
«يا
بلال، ما كنت أذنت في الناس، من كان مضعفاً أو مصعباً فليرجع»؟
قال:
نعم. فأبى أن يصلي عليه.
زاد البيهقي:
وأمر بلالاً فنادى في الناس:
«الجنة لا تحل لعاص» ثلاثاً([41]).
قال محمد بن عمر:
وبينا رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
في الطريق في ليلة مقمرة، إذ أبصر رجلاً يسير أمامه عليه شيء يبرق في
القمر، كأنه في شمس وعليه بيضة، فقال رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
«من
هذا»؟.
فقيل:
أبو عبس بن جبر.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«أدركوه».
قال:
فأدركوني فحبسوني، فأخذني ما تقدم وما تأخر، فظننت أنه
قد أنزل فيَّ أمر من السماء، فجعلت أتذكر ما فعلت حتى لحقني رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
فقال:
«ما
لك تقدم الناس لا تسير معهم»؟.
قلت:
يا رسول الله، إن ناقتي نجيبة.
قال:
فأين الشُّقيقة التي كسوتك؟
قلت:
يا رسول الله، بعتها بثمانية دراهم، فتزودت بدرهمين
وتركت لأهلي درهمين، وابتعت هذه البردة بأربعة دراهم.
فتبسم رسول الله «صلى الله عليه
وآله» ثم قال:
«أنت
والله يا أبا عبس وأصحابك من الفقراء. والذي نفسي بيده، لئن سلمتم
وعشتم قليلاً ليكثرن زادكم، وليكثرن ما تتركون لأهليكم، ولتكثرن
دراهمكم وعبيدكم، وما ذلك لكم بخير».
قال أبو عبس:
فكان والله كما قال رسول الله
«صلى الله عليه وآله».
قال سويد بن النعمان:
إن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
لما وصل إلى الصهباء ـ وهي أدنى خيبر ـ صلى العصر، ثم دعا بالأزواد،
فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثُريَ، فأكل رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
وأكلنا معه. ثم قام إلى المغرب، فمضمض ومضمضنا، ثم صلى، ولم يتوضأ.
رواه البخاري([42])
والبيهقي.
زاد محمد بن عمر:
ثم صلى بالناس العشاء، ثم دعا بالأدلاء، فجاء حُسَيْل بن خارجة، وعبد
الله بن نعيم الأشجعي، فقال رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
لحُسَيْل: يا حُسَيْل: امض أمامنا حتى تأخذ بنا صدور الأودية، حتى تأتي
خيبر من بينها وبين الشام، فأحول بينهم وبين الشام، وبين حلفائهم من
غطفان.
فقال حُسَيْل:
أنا أسلك بك، فانتهى به إلى موضع له طرق، فقال: يا رسول
الله، إن لها طرقاً تؤتى منها كلها.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«سمها
لي».
وكان رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
يحب الفأل الحسن، والاسم الحسن، ويكره الطيرة، والاسم القبيح.
فقال:
لها طريق يقال لها: حزن، وطريق يقال لها: شاش، وطريق
يقال لها: حاطب، فقال رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
«لا
تسلكها».
قال:
لم يبق إلا طريق واحد يقال له: مرحب، فقال رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
«اسلكها»([43]).
ونقول:
إن لنا ههنا وقفات هي التالية:
قد ذكرت الرواية المتقدمة:
أن الشعر المذكور:
«اللهم
لولا أنت ما اهتدينا»
إنما هو لعامر بن الأكوع.
مع أنه قد روي في الصحاح، ومنها
كتاب البخاري، في كتاب الجهاد:
أنه من شعر عبد الله بن رواحة([44]).
قال الصالحي الشامي:
«فيحتمل
أن يكون هو وعامر تواردا على ما تواردا عليه، بدليل ما وقع لكل منهما
مما ليس عند الآخر، واستعان عامر ببعض ما سبقه إليه ابن رواحة»([45]).
ويحتمل أيضاً:
أن يكون عامر قد أخذه كله من ابن رواحة؛ لأنه مجرد
حادٍ، يختار ما يناسبه من الحداء، ولو كان قد نطق به أو نظمه غيره.
هذا, ولا معنى لقوله في ذلك الشعر
مخاطباً الله تعالى:
«فاغفر
فداء لك ما اتقينا»،
إذ لا معنى لأن يفدي أحد اللهَ بالنفس, لأن ذلك يستبطن توقع حلول مكروه
بالمفدي ـ ليجعل المتكلم نفسه فداء له من ذلك ـ وهذا يستبطن جواز
الفناء على الله تعالى، وأنه لو لم يحصل الفداء له, لأمكن أن تحل
المصيبة به, تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.
وقد يقال:
إن الذي كان يرتجز لرسول الله «صلى
الله عليه وآله»
في
أسفاره
هو البراء بن
مالك، لا عامر بن الأكوع.
ويجاب:
بأن المقصود: أنه كان يرتجز له في غالب أسفاره, أو في
بعضها كما صرحت به بعض الروايات([46]).
وقد ذكرت الروايات المتقدمة:
أن عمر بن الخطاب قد خاف على عامر, حتى قال لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
لولا أمتعتنا بعامر. وذلك لأن النبي
«صلى الله عليه وآله»
كان إذا استغفر لإنسان استشهد.
غير أننا نقول: إن ذلك لا يمكن قبوله:
فأولاً:
لم يثبت: أنه «صلى الله عليه وآله» استغفر لعامر, فقد
اختلفت الروايات في ذلك، حيث يقول بعضها: إنه «صلى الله عليه وآله»
قال: يرحمه الله.
ثانياً:
لنفرض: أنه قد ثبت استغفار النبي «صلى الله عليه وآله»
لعامر, ولكن قولهم: إنه ما استغفر «صلى الله عليه وآله» لإنسان يخصه
إلا استشهد..
لا يمكن أن يصح, لأن كتب الحديث والتاريخ مشحونة
بالأخبار المصرحة باستغفاره
«صلى الله عليه وآله»
للكثيرين من صحابته, ولم يصبهم شيء, بل عاشوا بعده عشرات السنوات,
فراجع:
1 ـ
استغفاره
«صلى الله عليه وآله»
لأبي بكر([47]).
2 ـ
واستغفاره لأبي موسى الأشعري([48]).
3 ـ
واستغفاره
«صلى الله عليه وآله»
لحذيفة, ولأمه([49]).
4 ـ
واستغفر للمقصرين في الحديبية.
وغير ذلك..
إن هناك أموراً قد يستهين الإنسان بها, فلا يطيع
الأوامر الصادرة بشأنها, زعماً منه: أنه قادر على تجاوز سلبياتها..
غير أن هذا المنطق:
مرفوض في الإسلام جملة وتفصيلاً, لأكثر من جهة:
فأولاً:
ليس بالضرورة أن يكون ما اعتقد أنه المبرر لقرارات
القيادة هو المبرر الحقيقي لها فعلاً؛ لأن للقيادة آفاقها, وعلاقاتها,
ووسائلها التي تمكنها من المواجهة الصحيحة، من خلال رصد الأمور بصورة
أدق وأشمل، يمكِّنها من وضع كل الأمور في مواضعها الصحيحة وفي الدائرة
الأوسع في المحيط الذي تتحرك فيه, ضمن سلسلة من الدواعي والمقتضيات
التي ربما لا تخطر للآخرين على بال، أو لا تمر لهم في خيال, بحكم
محدودية نظرتهم, وضآلة حجم معارفهم، وقلة اطلاعهم على ذلك كله..
ثانياً:
إنه حين يكون لدى كثيرين من الناس مراكب تصعب السيطرة
عليها, وتحتاج إلى بذل جهد, وربما إلى تعاون, وتعاضد, فذلك معناه إشغال
الناس عن قضيتهم الأساس, في شأن داخلي غير ذي جدوى, تضيع فيه الجهود,
التي يفترض توفيرها لتصرف في سبيل ما هو أهم، ونفعه أعم, هذا عدا عما
ينشأ عن ذلك من تشويش في الفكر, وإخلال بالنظام العام.
ثالثاً:
إن عدم صلاة رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
على ذلك الذي لم يمتثل للأمر, قد أظهر أن خلاف هذا الرجل لم يكن ناشئاً
عن مجرد حالة عفوية, أو تلبية لرغبة شخصية, أو نتيجة غفلة حدثت له، أو
نحو ذلك.
بل كان قاصداً لهذا الخلاف، عامداً إليه, وربما يصل ذلك
إلى حد المؤامرة الهادفة إلى إحداث بلبلة، وتشويش، وإخلال.
بالإضافة إلى:
إسقاط حرمة الأوامر النبوية, وتجريء الناس على خلافه «صلى الله عليه
وآله», وعصيان أوامره, والاستهانة بتوجيهاته..
ولعل هذا هو السبب في:
أنه
«صلى الله عليه وآله»
قد رفض أن يشرفه بالصلاة عليه.
ورابعاً:
إن الإعلان بطريقة النداء في الناس: لا تحل الجنة لعاص،
لا بد أن يكون له تأثيره القوي في ردع الناس عن محاكاة ذلك العاصي في
فعله, وبالتالي فرض الالتزام بالنظام, وتنفيذ القرارات الصادرة،
بانضباطية تامة، وبدقة وأمانة.
وقد ذكرت الروايات قصة أبي عبس مع رسول الله «صلى الله
عليه وآله»..
ووجدنا أنها تشير إلى عدة أمور، نذكر منها:
1 ـ
أنه
«صلى الله عليه وآله»
قد بادر إلى السؤال عن حالة رأى أنها قد خالفت النَظْم الطبيعي لمسيرة
الجيش, وهي انفراد أبي عبس عن الناس، وتقدُّمه عليهم.
وإن لم يكن النبي
«صلى الله عليه وآله»
قد ألزم الناس برعاية نَظْمٍ بعينه, ولكن ذلك لا يعني
السماح بالحالة التي قد تبدو نشازاً بحسب ما جرت عليه طريقة الناس في
حالات كهذه..
وجاء تفسير أبي عبس كافياً وربما مرضياً لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»؛
فإن الاستعانة بالناقة النجيبة يريح رسول الله
«صلى الله عليه وآله»,
في مسير كهذا..
2 ـ
ثم أتبع
«صلى الله عليه وآله»
سؤاله الأول بسؤال آخر يفضي إلى إعطاء توضيحات عن لباس أبي عبس المميز،
الذي يثير أكثر من شبهة وسؤال عن مكونات أبي عبس, وعن روافده ومصادره.
فالبريق القوي, يضخم التصورات ويوهم: أن أبا عبس قد أصاب كنزاً, أو
استولى على ثروة بطريقة قد تكون مشروعة، وقد لا تكون!!
ومهد رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
للإجابة المقنعة, والقاطعة لكل احتمال، وظن وشبهة، حين ضمَّن سؤاله
تعريف الناس بمصدر المال، حتى لم يعد أبو عبس بحاجة إلى تقديم إثبات
بذلك, بل اقتصرت مهمته على بيان موارد مصارف ذلك المال, وصحة تصرفه
فيه.. وبذلك يكون
«صلى الله عليه وآله»
قد جنَّبَه غضاضة الإحساس بأن ثمة تهمة تموج في نظرات الناس إليه, وأنه
يحتاج إلى إعداد وسائل دفعها عن نفسه..
3 ـ
ثم إنه
«صلى الله عليه وآله»
قد تقدم خطوة أخرى باتجاه حسم الأمر لصالح أبي عبس, حين أعلن براءة أبي
عبس من أية شبهة من هذا القبيل, وبيَّن أنه يعيش حالة الفقر والحاجة
حقاً، ليس وحده, وإنما هو وأصحابه الفقراء.
4 ـ
ثم شفع ذلك بالإخبار عن أمر غيبي, من شأنه: أن يفرح
الكثيرين من الناس من طلاب الدنيا، حيث أخبره: أنه هو وأصحابه، إن
سلموا وعاشوا فسيكثر زادهم, وما يتركونه لأهليهم, وستكثر دراهمهم
وعبيدهم.
وقد تضمن هذا الخبر الإشارة إلى أمرين:
أحدهما:
أنه قد إشار إلى احتمال سلامتهم وبقائهم على قيد
الحياة, ولكنه لم يجزم لهم بذلك.
حيث قال:
لئن سلمتم وعشتم، وذلك لكي يعطيهم الفرصة لإخلاص النية
في الجهاد, وليمكنهم من الإقدام على ما فيه احتمالات الشهادة, ولا
يحرمهم من السعي لنيل هذا المقام الجليل..
الثاني:
أنه قد بيَّن لهم: أن تحقيق ما يخبرهم به لا ينبغي أن
يكون من أسباب اغترارهم بأنفسهم, وتخيُّل أن ذلك عطية وكرامة إلهية
لهم, بسبب رفعة مقامهم في طاعته، وعلو درجتهم في الإخلاص له..
بل ذلك امتحان وابتلاء, لا بد لهم من أن يحذروا منه,
حتى لا يقعوا في فخ الركون إلى الدنيا, والاغترار بزبارجها، وبهارجها..
وبذلك يكون قد أعطاهم القاعدة الصحيحة في التعامل مع
الكثرات الدنيوية, ومنحهم النظرة الصائبة، والتقييم السليم لمثل هذا
الأمر الخطير..
ورووا:
أن إحدى النساء اللواتي حضرن خيبر قالت: فأردفني رسول
الله
«صلى الله عليه وآله»
على حقيبة رحله. قالت: فلما كان الصبح، وأناخ راحلته،
ونزلت عن حقيبة رحله، وإذا بها دم مني.
وكانت أول حيضة حضتها.
قالت:
فتقبضت إلى الناقة، واستحييت.
فلما رأى رسول الله «صلى الله عليه
وآله» حالي، قال:
ما لك، لعلك نفست؟
قلت:
نعم.
قال:
فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحاً،
ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمرتحلك.
قالت:
فكنت لا أطهر من حيضة إلا جعلت في
طهري ملحاً. وأوصت أن يجعل ذلك في غسلها حين ماتت([50]).
ونقول:
إننا نشك في صحة هذه الرواية، بل لا نرتاب في كذبها،
وذلك لما يلي:
أولاً:
لا معنى لجعل الملح في طهرها، ولا في غسلها، فإن غسل
الدم الذي أصاب حقيبة الرحل بالماء والملح شيء، وجعله في طهرها شيء
آخر..
على أننا لا ندري داعياً لوضع الملح في الماء، فإن
الماء يكفي لغسل حقيبة الرحل..
ثانياً:
إنه لا ريب في أن بلوغ البنت إنما هو بإتمامها تسع
سنين.. والفتيات إنما يحضن ـ غالباً ـ في سن الثالثة عشرة.
ومن الواضح:
أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
لا يمكن أن يردف خلفه من تكون في هذه السن، أو أقل من ذلك أيضاً..
وقد تحدثنا عن موضوع بلوغ الفتاة بشيء من التفصيل في
غزوة بني قريظة، فراجع..
ثالثاً:
إن الكل يعلم: أن علياً
«عليه
السلام»
كان لا يلقي السلام على الشابة من النساء([51])
فكيف برسول الله
«صلى الله عليه وآله»([52]).
وورد النهي عن الجلوس في مجلس تقوم عنه المرأة حتى يبرد([53]).أة
فهل يرضى بأن يردف خلفه فتاة في سن من تحيض؟!
رابعاً:
ما معنى: أن يردف النبي «صلى الله عليه وآله» هذه
الفتاة الأجنبية عنه، ولماذا لم يردف زوجته أم سلمة، أو أياً من زوجاته
في أية غزوة من الغزوات؟!
وهل لم يوجد من يتبرع بارتداف هذه الفتاة سوى رسول الله
«صلى الله عليه وآله»؟!
ومن كان يردف أم زياد الأشجعي، التي خرجت إلى خيبر في
خمسة نسوة ليداوين الجرحى، ولغير ذلك، فأسهم لهن تمراً؟!([54]).
بل لقد حضر خيبر عشرون امرأة.
فلماذا لم يجعل هذه الفتاة معهن؟! أو مع زوجته أم سلمة
في هودجها؟!
خامساً:
هل ارتدفها
«صلى الله عليه وآله»
على ناقته، أم على فرسه، أم على حماره؟!
فقد تقدم:
أنهم قد اختلفوا في أنه: هل كان النبي
«صلى الله عليه وآله»
راكباً فرساً، أم حماراً مخطوماً برسن من ليف، وتحته أكاف من ليف!!
وقد ذكرنا ما يدل:
على هذا وذاك فيما يأتي تحت عنوان:
«وصول
النبي
«صلى الله عليه وآله»
إلى خيبر».
وقد رجحوا:
أنه قد ركب الحمار في الطريق إلى خيبر، ثم ركب الفرس،
حين نشب القتال..
وأما الحديث الذي صرح:
بأن الناقة مأمورة، فلا دلالة فيه على أنه
«صلى الله عليه وآله»
كان راكباً عليها.
وحتى لو دل على ذلك، فإنه يصبح متعارضاً مع حديث ركوبه
للحمار، أو الفرس، حسبما أوضحناه..
وفي جميع الأحوال نقول:
إذا كان راكباً للفرس، فلماذا لا تركب هي على الناقة،
أو الحمار؟ وإن كان راكباً على الحمار فيمكن أن تركب هي الناقة أو
الفرس، وكذا لو كان قد ركب الناقة، فالحمار والفرس صالحان للركوب، فلا
حاجة ـ في جميع الأحوال ـ إلى إردافها خلفه
«صلى الله عليه وآله»..
وعن حديث طلب النبي «صلى الله عليه
وآله» من الدليل:
أن يأخذ بهم في صدور الأودية, حتى يأتي بهم إلى خيبر من جهة الشام،
نقول:
1 ـ
إنه
«صلى الله عليه وآله»
يكون بذلك قد تحاشى الظهور على قمم الجبال, وعلى جوانبها التي تظهر
للرائي البعيد, لكي يتحاشى رؤية الناس لجيشه الضارب, ويكون في منأى عن
مواقع الرصد التي ربما يكون العدو قد أقامها في المواقع المشرفة..
2 ـ
إنه
«صلى الله عليه وآله»
قد اختار أن يسلك الدليل طريقاً تؤدي بهم إلى خيبر من جهة الشام, وهو
الطريق الذي يشعر اليهود بالأمن من جهته، ولا يشعرون بالحاجة إلى رصده
بدقة وبفعالية..
3 ـ
إنه
«صلى الله عليه وآله»
قد أوضح أيضاً: أنه يريد أن يقطع عن اليهود المدد من جهة الشام، سواء
أكان المدد مالاً، أم رجالاً، أم عتاداً، أم طعاماً، أم غير ذلك.
4 ـ
إنه
«صلى الله عليه وآله»
يريد أيضاً: أن يحول بين اليهود وبين حلفائهم من غطفان، وسيأتي: أن هذا
هو ما حصل بالفعل، وذلك حين جاءت غطفان لمعونتهم، ثم تراجعت خوفاً من
أن يتمكن
«صلى الله عليه وآله»
من مهاجمة ديارهم وأهليهم.
واللافت هنا قولهم:
إن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
قد طلب من الدليل أن يسمي له الطرق إلى خيبر؛ لأنه كان
يحب الفأل الحسن، فسماها له، فاختار أحدها.
ونقول:
أولاً:
إن من الواضح: أن طلب تسميتها ليس بالضرورة أن يكون من
أجل أن يتفاءل بأسمائها، فإن ذلك بعيد عن شأن النبي «صلى الله عليه
وآله» ومقامه. وقد تكلمنا عن بعض ما يرتبط بذلك في جزء سابق من هذا
الكتاب.
ثانياً:
إن من جملة الطرق التي سماها الدليل طريقاً باسم
«شاس»
وليس في هذه الكلمة التفاؤل، أو التشاؤم.
ثالثاً:
من أين ثبت لهم: أنه
«صلى الله عليه وآله»
قد رفض السير في تلك الطريق من منطلق التشاؤم والتفاؤل؟ فقد يكون الغرض
هو:
1 ـ
أن يظهر خبرة الدليل، وأنه قادر على إنجاز المهمة التي
أوكلت إليه.
2 ـ
أن يوجهه إلى الطريق الأكثر أمناً، والأشد ملاءمة
للأهداف المتوخاة.
3 ـ
أن يعرف الناس بأنه
«صلى الله عليه وآله»
عالم بمسالك تلك البلاد، وإن لم يكن قد وطئتها قدمه من قبل.
روى أصحاب الكتب الستة، عن أبي موسى الأشعري، قال:
أشرف الناس على واد، فرفعوا أصواتهم بالتكبير: «الله أكبر، الله أكبر،
لا إله إلا الله».
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«اربعوا
على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنكم تدعون سميعاً قريباً،
وهو معكم».
وأنا خلف دابة رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فقال:
«يا
عبد الله بن قيس».
قلت:
لبيك يا رسول الله، فداك أبي وأمي.
قال:
«ألا
أدلُّك على كلمة من كنز الجنة»؟.
قلت:
بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي.
قال:
«لا
حول ولا قوة إلا بالله»([55]).
ونقول:
هناك حالات تنتاب الجماعات، وهي تواجه قضاياها الكبرى،
لا يصح الانسياق معها، بل لا بد من معالجتها والتخلص منها. ومن هذه
الحالات: أن اجتماعها مع بعضها البعض قد يشعرها بالقوة بدرجة قد تتجاوز
حدود قوتها الطبيعية، الأمر الذي يهيئ لوقوعها في براثن الغفلة عن بعض
الثغرات التي تعاني منها.. وربما يكون ذلك سبباً في تدني مستوى قوتها
بصورة كبيرة وخطيرة..
وقد ظهر مصداق ذلك في حرب حنين، حيث تلاشت قوة المسلمين
أو كادت، بسبب هذا الشعور بالذات. فقد قال تعالى: ﴿لَقَدْ
نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ
أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ
عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ﴾([56]).
ومن هذه الحالات أيضاً، هيمنة العقل الجماعي على تلك
الجماعة، وتدني مستوى تفكيرها ليصل إلى أضعف حالاته..
ويزيد هذه الحالة حدةً فيهم، تعالي الصرخات، واختلاط
الأصوات، والصخب، والعجيج والضجيج.
وهذا يفسر لنا:
أمره
«صلى الله عليه وآله»
لأصحابه بأن يربعوا على أنفسهم، ويخففوا من غلوائهم، ويخفضوا أصواتهم،
حتى لو كانوا يجهرون بكلمة
«الله
أكبر».
فقد كان ثمة حاجة إلى الهدوء والتعقل، ليمكن النظر إلى
الأمور والأحجام، والقدرات بواقعية واتزان، بعيداً عن الانتفاخات
والتضخيمات الصوتية وغير الواقعية..
ثم.. إنه «صلى الله عليه وآله» صرح لهم بالحقيقة وطلب
منهم ترديدها في عملية تلقين عفوية للنفس، وإدراك للعقل، وتلمس
للوجدان، حين دلهم على كلمة هي من كنز الجنة، يتعلمون منها: أن قدرتهم
ليست بكثرة جمعهم، ولا بجودة سلاحهم، ولا بقدراتهم الذاتية وشجاعتهم؛
إذ «لا حول ولا قوة إلا بالله».
روى ابن إسحاق، عن أبي مغيث بن عمرو، ومحمد بن عمر عن
شيـوخـه، قالوا: إن رسول الله
«صلى الله عليه وآلـه»
لمـا أشرف على خيـبر ـ وكان وقت الصبح ـ قال لأصحابه:
«قفوا».
فوقفوا.
فقال:
«اللهم
رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب
الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما أذرين، فإنَّا نسألك من خير هذه
القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. أقدموا باسم الله».
وكان يقولها لكل قرية يريد دخولها.
ورواه النسائي، وابن حبان عن صهيب([57]).
ونقول:
إن هذا الدعاء قد جاء ليحدث تغييراً جذرياً في أهداف
هؤلاء القادمين إلى بلاد أعدائهم. إذ إن الإنسان حين يتخذ صفة المقاتل،
ويعد للقتال عدته، ويحمل سلاحه، ويشرف على بلد عدوه، فإنه لا يحدث نفسه
إلا بالنزال والقتال، ولا يفكر إلا بالموت أو الحياة، وبالنصر أو
الهزيمة، ولا يحلم إلا بالغنائم والسبايا.
ولذلك يوقف النبي «صلى الله عليه وآله» أصحابه، ويوجههم
إلى الله تعالى، ليفهمهم أنه تعالى هو المهيمن والمشرف على إيصال كل
شيء إلى كماله، من حيث هو الرب المدبر الحكيم، والخبير العليم، والرؤوف
الرحيم، وهو القاهر فوق عباده..
فحلول هذا الجيش بهذا البلد لا ينبغي أن يكون بهدف
الحصول على المغانم، والاستيلاء على البلاد والعباد.
بل يجب أن يكون الهدف هو الحصول على
الخير:
خير البلد وخير أهله، وتجنب الشر: شر البلد وشر ما
فيه.. سواء أكان الشر من الناس، أم من غيرهم.
ويلاحظ أيضاً:
أن هذا الدعاء قد أظهر للداعين ولغيرهم: أن الهيمنة
الإلهية كما تشمل السماوات والأرض، من حيث هي موجودات كونية، فإنها
تشمل ما أظللن، وما أقللن من موجودات، لها وظائف ومهمات، فيهما على حد
سواء..
وأفاد أن هذه السلطة تشمل أيضاً حتى الموجودات المتمردة
والطاغية، وتشمل من وقع تحت تأثيرها.. فهو تعالى رب الشياطين وما
أضللن.. كما أنها تشمل ما له حركة وتصرف، وما يكون محلاً للحركة
والتصرف، وإن لم يكن من الموجودات العاقلة والمختارة، فهو رب الرياح
وما أذرين.
فإذا كانت الهيمنة لله تعالى على ذلك كله، فلا بد من أن
يتوجه الناس إليه في حاجاتهم. وقد حدد رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»
هذه الحاجات في دعائه، بأنها الحصول على الخير، وتجنب الشر..
ثم إنه
«صلى الله عليه وآله»
قال:
«أقدموا
باسم الله..».
فإذا كان إقدامهم متمازجاً مع اسم الله تعالى، وملابساً
له، فلا بد أن يلتزموا بخطه تعالى، وأن لا يشذوا عنه، فيكون معهم في كل
حركة، وكل سكون، وكل موقف.
وما أحوجهم إلى استحضار الله تعالى في مواقفهم هذه التي
ينسى الإنسان فيها أكثر الأشياء قرباً منه، فينسى حتى الطعام والشراب،
وينسى الأهل والأولاد، وينسى المال والمقام، وينسى.. وينسى.. وكل هذا
النسيان لا ضير فيه، إذا كان ذاكراً لله سبحانه، مستشعراً لوجوده،
منسجماً معه.. ولأجل ذلك قال لهم
«صلى الله عليه وآله»:
«أقدموا
باسم الله..».
وذكروا:
أن عبد الله بن أُبي أرسل إلى اليهود يخبرهم: بأن
محمداً سائر إليكم، فخذوا حذركم، وأدخلوا أموالكم حصونكم، واخرجوا إلى
قتاله، ولا تخافوا منه، إن عددكم كثير، وقوم محمد شرذمة قليلون، عُزَّل
لا سلاح معهم إلا قليل.
فلما علم بذلك يهود خيبر أرسلوا وفداً إلى غطفان
يستمدونهم كما سيأتي([58]).
ونقول:
إن توجيهات ابن أُبي لهم، وتحريضه إياهم على التصدي
لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»
قد استندا إلى عدة أمور، نشير منها إلى الأمرين التاليين:
1 ـ
كثرة عددهم، وقلة عدد جيش المسلمين، مع أن ابن أُبي
والناس كلهم قد شاهدوا كيف ينتصر المسلمون في حروبهم، وخصوصاً في بدر،
رغم قلة عددهم، وكثرة عدد جيش عدوهم المهاجم.
وقد بيَّن القرآن هذه الحقيقة في موارد كثيرة، وصرح:
بأن العشرة من المسلمين قادرون على أن يغلبوا مائة، فيما لو تدرعوا
بالصبر والإيمان.
قال تعالى أيضاً: ﴿كَم
مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ الله..﴾([59])
2 ـ
إنه قد ركز على السلاح، كعنصر حاسم في المعركة بين
الإيمان والكفر.
غير أن من الواضح:
أن للسلاح في نوعه وفي مقداره بعض التأثير في الحرب.
ولكن قد أثبتت الوقائع أيضاً:
أن الكلمة الأخيرة، والفاصلة ليست له، وإنما هي للعزيمة
والإيمان بالقضية، والالتجاء إلى الله سبحانه، بالإضافة إلى مفردات
كثيرة من منظومة القيم، والمفاهيم، والاعتقادات، والنظرة إلى الكون
وإلى الحياة، ومستوى تربية النفس، ودرجة التفاعل مع تلك القيم، ودرجات
رسوخ تلك النظرات والاعتقادات في كيان الإنسان، وفي أعماق وجوده..
أرادت غطفان، وسيدهم عيينة بن حصن، أن يعينوا أهل خيبر
ـ وكانوا أربعة الآف ـ لما سمعوا بمجيئه
«صلى الله عليه وآله»
إليهم، فأرسلوا كنانة ابن أبي الحقيق، وهوذة بن قيس، في أربعة عشر
رجلاً إلى غطفان، يستمدونهم، وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر إن غلبوا على
المسلمين.
فجمعوا أربعة آلاف مقاتل ـ كما في بعض المصادر ـ ثم
خرجوا ليظاهروا يهود خيبر.
ويقال:
إن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
أرسل إليهم: أن لا يعينوهم على أن يعطيهم من خيبر شيئاً سماه لهم، وهو
نصف ثمارها تلك السنة، وقال لهم:
«إن
الله قد وعدني خيبر».
فأبوا، وقالوا:
جيراننا وحلفاؤنا.
فلما ساروا قليلاً سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حساً
ظنوه القوم، أي ظنوا أن المسلمين أغاروا على أهليهم، فألقى الله الرعب
في قلوبهم.
وحسب نص الواقدي:
سمعنا صائحاً ـ ثلاث مرات ـ لا ندري من السماء، أو من
الأرض: أهلكم أهلكم بحفياء (أو حيفاء ـ موضع قرب المدينة)، فإنكم قد
خولفتم إليهم.
فرجعوا على الصعب والذلول، أي مسرعين على أعقابهم،
فأقاموا في أهلهم وأموالهم، وخلوا بين رسول الله «صلى الله عليه وآله»
وبين أهل خيبر.
وفي رواية:
سمعوا صوتاً يقول: أيها الناس، أهليكم خولفتم إليهم،
فرجعوا فلم يروا لذلك نبأ([60]).
زاد في نص آخر:
أنهم قالوا:
«فعلمنا:
أن ذلك من قبل الله، ليظفر محمد بيهود خيبر»([61]).
بل ذكر بعضهم:
أن عيينة بن حصن قد جاء إلى خيبر في أربعة آلاف، فدخلوا
مع اليهود في حصون النطاة، قبل قدوم رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
بثلاثة أيام. فلما قدم رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
خيبر أرسل إليهم سعد بن عبادة وهم في الحصن.
فلما انتهى سعد إلى الحصن ناداهم: إني أريد أكلِّم
عيينة بن حصن.
فأراد عيينة أن يدخله الحصن، فقال
مرحب:
لا تُدخله فيرى خلل حصننا، ويعرف نواحيه التي يؤتى
منها، ولكن تخرج إليه.
فقال عيينة:
لقد أحببت أن يدخل فيرى حصانته، ويرى عدداً كثيراً.
فأبى مرحب أن يدخله، فخرج عيينة إلى باب الحصن.
فقال سعد:
إن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
أرسلني إليك، يقول: إن الله قد وعدني خيبر فارجعوا، وكفوا، فإن ظهرنا
عليها فلكم تمر خيبر سنة.
فقال عيينة:
إنَّا والله ما كنا لنسلم حلفاءنا لشيء، وإنَّا لنعلم
ما لك وما معك مما ههنا طاقة، هؤلاء قوم أهل حصون منيعة، ورجال عددهم
كثير، وسلاح. إن قمت هلكت ومن معك، وإن أردت القتال عجلوا عليك بالرجال
والسلاح.
ولا والله، ما هؤلاء كقريش، وقوم ساروا إليك، إن أصابوا
غِرَّة منك فذاك الذي أرادوا وإلا انصرفوا، وهؤلاء يماكرونك الحرب
ويطاولونك حتى تملهم.
فقال سعد بن عبادة:
أشهد ليحصرنك في حصنك هذا حتى تطلب الذي كنا عرضنا
عليك، فلا نعطيك إلا السيف، وقد رأيت يا عيينة من قد حللنا بساحته من
يهود يثرب، كيف مُزقوا كل ممزق!
فرجع سعد إلى رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
فأخبره بما قال.
وقال سعد:
يا رسول الله، لئن أخذه السيف ليسلمنهم، وليهربن إلى
بلاده، كما فعل ذلك قبل اليوم في الخندق.
فأمر رسول الله «صلى الله عليه
وآله» أصحابه:
أن يوجهوا إلى حصنهم الذي في غطفان، وذلك عشيةً وهم في
حصن ناعم، فنادى منادي رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
أن أصبحوا على راياتكم عند حصن ناعم الذي فيه غطفان.
قال:
فرعبوا من ذلك يومهم وليلتهم، فلما كان بعد هذه من تلك
الليلة سمعوا صائحاً يصيح، لا يدرون من السماء أو الأرض: يا معشر
غطفان، أهلكم أهلكم!! الغوث، الغوث بحيفاء ـ صِيح ثلاثة ـ لا تربة ولا
مال!
قال:
فخرجت غطفان على الصعب والذلول، وكان أمراً صنعه الله
لنبيه.
فلما أصبحوا أُخبر كِنانة ابن أبي الحُقيق ـ وهو في
الكتيبة ـ بانصرافهم، فسقط في يديه([62]).
ونقول:
1 ـ
إن قبيلة غطفان أصرت على أن تنصر اليهود، لأمرين، هما:
أنهم جيرانهم، وأنهم حلفاؤهم.
والإستجابة لنداء الجيرة والحلف ليس بأولى من الاستجابة
لما يوجبه العقل، وتفرضه الفطرة، فإن غطفان كانت على الشرك الذي هو ظلم
عظيم، وتأباه العقول، وتنفر منه الفطرة..
فكان من المفروض:
أن تستجيب ـ قبل كل شيء ـ لنداء العقل والفطرة، لتكتشف
صحة ما جاء به رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
فتسير في خط طاعة الله سبحانه، موالية لأوليائه، ومعادية لأعدائه،
ومحاربة لهم بكل قوة وصرامة وحزم. فلا عهد فوق عهد الله تعالى، ولا
جوار لأحد في معصية الله سبحانه وتعالى.
2 ـ
إنه إذا كان اليهود قد وعدوا غطفان بشطر ثمار خيبر، فإن
النبي
«صلى الله عليه وآله»
قد وعدهم بنفس ما وعدوهم به، مع فارق عظيم وهام، وهو: أن اليهود كانوا
معروفين بالغدر.
أما النبي
«صلى الله عليه وآله»
فكان الصادق الأمين، والوفي بالوعود والعهود..
3 ـ
إن اليهود إنما وعدوهم: بأن يعطوهم شطر ثمار خيبر، ولكن
بشرط أن يعينوهم، ويحاربوا معهم، ولا بد أن يقتل من يقتل منهم، وأن
تنشأ العداوات، والثارات، والإحن بينهم وبين المجتمع الإسلامي كله..
أما النبي
«صلى الله عليه وآله»
فلم يكلفهم بالحرب، بل اكتفى منهم بالكف وعدم الإقدام على مساعدة
اليهود، فلا قتلى، ولا عداوات، ولا إحن، ولا أحقاد..
مع ملاحظة:
أن طلب اليهود العون يشير إلى ضعفهم أمام عدوهم، وطلب
النبي
«صلى الله عليه وآله»
منهم اعتزال الحرب، والحياد يشير إلى استغنائه عنهم، وإلى ثقته بالنصر
على أعدائه. فكانت الاستجابة لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»
هي الأصلح لهم حتى في حسابات الربح والخسارة الدنيوية.
4 ـ
ولعل الحس الذي سمعته غطفان، وخافت أن يكون في أهليها،
قد جاء ليؤكد شدة خوفهم، ومدى رعبهم في قبال جيش المسلمين، على قاعدة:
﴿يَحْسَبُونَ
كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ﴾([63]).
لمجرد أنهم علموا بتوجه المسلمين نحو خيبر، رغم أنهم يعرفون: أن طريق
النبي
«صلى الله عليه وآله»
الآتي من المدينة إلى خيبر لا تمرُّ بهم، لأن طريق غطفان إلى خيبر كانت
من جهة الشام.
وقد استطاع النبي
«صلى الله عليه وآله»
في هذا الالتفاف اللافت: أن يقطع هذه الطريق عليهم، كما أسلفنا..
5 ـ
إن غطفان لم تكن صادقة فيما ادَّعته: من أنها تريد أن
تستجيب لنداء الجيرة والعهد، حيث قالوا: هم جيراننا وحلفاؤنا. فإنه إذا
كان هذا هو دافعهم الحقيقي فلماذا يكلفون اليهود نصف ثمار خيبر؟ فإنها
إذا كانت تريد أن تفي بالتزاماتها الأخلاقية، وتستجيب لنداء الجيرة،
وتنفذ عهدها فيما بينهم وبينها، فلا حاجة إلى هذه الأموال..
بل إن قبولها من المتبرع بها، فضلاً عن المطالبة بها،
عيب، وعار، وخسة، وصغار.
6 ـ
وإذا كانت غطفان قد خافت من إغارة المسلمين على ديارها
وأهلها، فقد كان بإمكانها أن ترسل سرية ـ ولو رمزية ـ من رجالها،
لمساعدة اليهود، قضاءً لحق الجيرة، ووفاءً بالعهد والحلف. ويبقى
الآخرون لدفع المهاجمين المحتملين.
فإذا كان ثمة من هجوم، فإن باستطاعة هؤلاء أن يشاغلوا
المهاجمين إلى أن يرسلوا إلى حلفائهم وجيرانهم من اليهود ليعينوهم مع
باقي الرجال الذين ذهبوا لنجدتهم، وإن لم يهاجمهم أحد، فإنهم يكونون قد
وفوا بالتزاماتهم، ودفعوا عن جيرانهم، ووفوا بعهودهم، لو صح أنه كانت
لهم معهم عهود!!
7 ـ
إن كلمة بـ
«حيفاء»
قد صحفت فصارت
«جنفا»،
كما سيأتي حينما قال النبي
«صلى الله عليه وآله»
لبني فزارة عندما هددوه بالقتال إن لم يعطهم الغنائم:
«موعدكم
حيفا».
حيث أراد
«صلى الله عليه وآله»
أن يذكرهم بهذا النداء السماوي، ليفهمهم أن الله تعالى هو الذي يدافع
عنه، أو يهيء له الأمور.
8 ـ
ثم إن النداء الذي سمعته غطفان، قد عرَّفهم: أن الله
سبحانه يريد أن يظفِّر نبيه الأكرم
«صلى الله عليه وآله»
بيهود خيبر.. وقد كان هذا الأمر كافياً لهم ليعودوا إلى أنفسهم،
وليؤمنوا بالله، وبرسوله، وأن يتهافتوا لنصرة هذا الرسول العظيم على
أعدائه وأعدائهم..
ولكنهم لم يفعلوا ذلك، بل استمروا على الكفر والجحود،
ولو وجدوا الفرصة لخرجوا إلى حرب رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
وإلى نصرة أعداء الله تعالى..
وهذا هو الخذلان الإلهي، والخيبة والخسران. نعوذ بالله
من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
9 ـ
وسيأتي: أن العرب وقريشاً قد شاركوا اليهود في الحرب ضد
الإسلام والمسلمين..
بل في بعض النصوص الآتية تصريح:
بأن عدد الذين واجههم المسلمون في خيبر كان أربعة عشر ألفاً..
10 ـ
إن الظاهر: أن هذه الأعداد الكبيرة كانت موزعة على
الحصون المختلفة، وكانوا قد قرروا أن لا يخرجوا للقتال في ساحات الحرب
والنزال.. فكان رأيهم هذا وبالاً عليهم أيضاً..
([1])
راجع: تاريخ الخميس ج2 ص42 وراجع: تهذيب المقال ج5 ص421 وتاج
العروس ج3 ص168.
([2])
راجع: السيرة الحلبية ج3 ص31 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص152 ووفاء
الوفاء ج4 ص1210.
([3])
الأحكام السلطانية ج1 ص200 وراجع: المغازي للواقدي ج2 ص670 و
671 ووفاء الوفاء ج4 ص1209 وعمدة الأخبار ص315 وتاريخ الأمم
والملوك = = ج2 ص302 والكامل في التاريخ ج2 ص221 والسيرة
الحلبية ج3 ص والسيرة النبوية لدحلان (مطبوع مع الحلبية) ج3 ص
والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص351.
([4])
راجع ما تقدم في: سبل الهدى والرشاد ج5 ص152 ووفاء الوفاء ج4
ص1210.
([5])
مراصد الاطلاع ج2 ص751 ووفاء الوفاء ج4 ص1238 ومعجم البلدان ج3
ص276.
([6])
وفاء الوفاء ج1 ص62 عن أحمد، والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد
رجال الصحيح، ومسند أحمد ج3 ص292 والآحاد والمثاني ج2 ص449
وكنز العمال ج12 ص248.
([7])
الآية 20 من سورة الفتح.
([8])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص115 و 152 و 153 عن ابن عقبة،
وابن إسحاق، وراجع: السيرة الحلبية ج3 ص31 والبحار ج21 ص1
وتاريخ الخميس ج2 ص43.
([9])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص153.
([10])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص153.
([11])
السيرة الحلبية ج3 ص31.
([12])
الإمتاع للمقريزي ج1 ص310 وراجع: تاريخ الخميس ج2 ص42 وسبل
الهدى والرشاد ج5 ص152 و 153 و السيرة الحلبية ج3 ص31.
([13])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص 153 وراجع: تاريخ الخميس ج2 ص42 عن
المواهب اللدنية.
([14])
السيرة الحلبية ج3 ص31.
([15])
معجم البلدان ج2 ص409 و 410.
([16])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص152 و 153 والمغازي للواقدي ج2 ص634.
([17])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص 153 وراجع: المغازي للواقدي ج2 ص634.
([18])
تاريخ الخميس ج2 ص42.
([19])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص153.
([20])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص 153.
([21])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص152 وتاريخ الخميس ج2 ص42.
([22])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص156 عن الطبراني في الأوسط.
([23])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص156 عن البيهقي.
([24])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص115 والسيرة الحلبية ج3 ص31 والإمتاع
للمقريزي ص310 والمغازي للواقدي ج2 ص634.
([25])
السيرة الحلبية ج3 ص31 والإمتاع للمقريزي ص310 والمغازي
للواقدي ج2 ص634.
([26])
الآية 20 من سورة الفتح.
([27])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص115 عن ابن هشام، والسيرة الحلبية ج3
ص31 والإمتاع ص310.
([28])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص115عن أحمد، وسعيد بن منصور، والبخاري
في التاريخ الصغير، وابن خزيمة، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي
عن أبي هريرة، والتاريخ الصغير ج1 ص43 ودلائل النبوة للبيهقي
ج4 ص198 والسيرة الحلبية ج3 ص31 والإصابة ج2 ص13 والإمتاع ص310
والمغازي للواقدي ج3 ص636 وتاريخ الخميس ج2 ص42.
([29])
الإمتاع ص310 والمغازي للواقدي ج2 ص637.
([30])
مسند أحمد ج3 ص159 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص115 والسنن الكبرى
ج9 ص125 وسنن النسائي ج8 ص274 وعن البخاري ج11 ص177 (6363)
والسيرة الحلبية ج3 ص31.
([32])
أسد الغابة ج1 ص128.
([33])
السيرة الحلبية ج3 ص31 والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج1 ص72
وراجع: الإصابة ج1 ص71.
([35])
راجع: إختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) ص45 والمعارف لابن
قتيبة ص580 والإرشاد للمفيد ص166 و 167 والخصال ص219 والأمالي
للصدوق المجلس 26 ص106 و 521 و 522.
([36])
الخصال ج1 ص189 و 190 والإيضاح ص541 والبحار ج2 ص217 وج22 ص102
و 242 وج31 ص640 عن الخصال وج108 ص31 ومعجم رجال الحديث ج4
ص151 وج11 ص79 ومستدرك سفينة البحار ج9 ص81.
([37])
السيرة الحلبية ج3 ص31 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص وتاريخ الخميس
ج2 ص42.
([38])
الآية 36 من سورة الأحزاب.
([39])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص115 و 116 عن الواقدي عن شيوخه، وعن
أحمد، والطبراني، ومسند أحمد ج3 ص423 ومجمع الزوائد ج4 ص129
والطبراني في المعجم الصغير ص234 والمغازي للواقدي ج2 ص634 و
635، وراجع: نيل الأوطار ج9 ص182 وفيض القدير ج5 ص195 وتاريخ
مدينة دمشق ج27 ص343 وأسد الغابة ج3 ص142.
([40])
راجع: السيرة الحلبية ج3 ص31 وراجع: المغازي للواقدي ج2 ص638 و
639 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص116 وفي الهامش: وأخرجه البخاري ج7
ص530 (4196) وأخرجه مسلم ج3 ص1427 (123/1802).
([41])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص116 و 117 وفي هامشه قال: أخرجه البخاري
ج7 ص530 (4196) وأخرجه مسلم ج3 ص1427 (123/1802)، والبيهقي في
الدلائل ج4 ص201 وراجع: السيرة الحلبية ج3 ص31 و 32 و 53 و 54
والبحار ج21 ص2 و 3 وبغية الباحث ص99 وغريب الحديث ج1 ص717
والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج3 ص29.
([42])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص117 وفي هامشه عن البخاري ج7 ص529
(4195) والمغازي للواقدي ج2 ص635 و 636 وراجع: الموطأ لمالك ج1
ص26 ومسند أحمد ج3 ص462 وعن صحيح البخاري ج1 ص59 وج4 ص13 وج5
ص72 وج6 ص198 والسنن الكبرى للبيهقي ج1 ص160 والمصنف للصنعاني
ج1 ص178 عن البخاري من طريق مالك والحميدي = = عن ابن عيينة،
وشرح معاني الآثار ج1 ص66 وصحيح ابن حبان ج3 ص432 والمعجم
الكبير ج7 ص87 وكنز العمال ج9 ص505 وأسد الغابة ج2 ص381 ومعجم
ما استعجم ج3 ص844.
([43])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص117 و 118 والمغازي للواقدي ج2 ص639
وتاريخ الخميس ج2 ص42.
([44])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص153 والبخاري (المغازي ص38) و (الأدب
ص90) وصحيح مسلم (الجهاد ص123) ومسند أحمد ج4 ص48.
([45])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص153.
([46])
السيرة الحلبية ج3 ص32.
([47])
مسند أحمد ج5 ص65 وعن صحيح البخاري (فضائل أصحاب النبي ص5).
([48])
عن صحيح البخاري (دعوات ص19 الترجمة ص49 المغازي ص55) وصحيح
مسلم (فضائل الصحابة ص165).
([49])
مسند أحمد ج5 ص391 و 392.
([50])
السيرة الحلبية ج3 ص56 و
57 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص387 ومسند أحمد ج6 ص380 وسنن
أبي داود ج1 ص78 والسنن الكبرى للبيهقي ج2 ص407 والبداية
والنهاية ج4 ص232 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص804.
([51])
راجع: الكافي ج5 ص535 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص461 والوسائل (ط
دار الإسلامية) ج8 ص458 ومستدرك الوسائل ج8 ص373 وج14 ص290
ومكارم الأخلاق ص235 ومشكاة الأنوار للطبرسي ص247 والبحار ج101
ص37 وجواهر الكلام ج11 ص118 وج29 ص99 وجامع المقاصد ج12 ص34
ومسالك الأفهام ج7 ص56 ومجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ج2 ص495
وج3 ص121 والحدائق الناضرة ج9 ص83 ومستند الشيعة ج16 ص61.
([52])
راجع: الكافي ج2 ص648 والبحار ج40 ص235 وج16 ص215 و 229
والوسائل (ط دار الإسلامية) ج8 ص452 وفي هامشه عن من لا يحضره
الفقيه ج2 ص52.
([53])
راجع: الوسائل (ط دار الإسلامية) ج14 ص185 وفي هامشه عن الكافي
(الفروع) ج2 ص77 وعن من لا يحضره الفقيه ج2 ص183.
([54])
مسند أحمد ج5 ص271 وفي التراتيب الإدارية ج2 ص511 عن أبي داود:
حنين بدل خيبر. ولعله تصحيف؛ لأجل عدم وجود نقط للحروف في تلك
الأزمنة.
([55])
سبل الهدى والرشاد ج 5 ص 150 وفي هامشه عن: البيهقي ج2 ص184
وابن أبي عـاصم ج1 ص274 والطبري ج8 ص147 وابن السني (512) وعبد
= = الرزاق (9244) وانظر البداية والنهاية ج4 ص213 وراجع:
السيرة الحلبية ج3 ص33 ومسند أحمد ج4 ص418 و 402 وج5 ص265 وعن
صحيح البخاري ج5 ص75 وج7 ص169 وعن صحيح مسلم ج8 ص74 ومجمع
الزوائد ج10 ص98 والديباج على مسلم ج6 ص59 ومسند أبي داود ص326
ومنتخب مسند عبد بن حميد ص192 والسنن الكبرى للنسائي ج4 ص398
وج6 ص7 وكتاب الدعاء للطبراني ص472 وسير أعلام النبلاء ج8 ص332
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص404.
([56])
الآية 25 من سورة التوبة.
([57])
سبل الهدى والرشاد ج 5 ص118 وقال في هامشه: أخرجه ابن خزيمة
(2565) والبخاري في التاريخ الكبير ج6 ص472 والطبراني في
الكبير ج8 ص39 والبيهقي في الدلائل ج4 ص204 وابن السني (518).
وراجع: السيرة الحلبية ج3 ص32 و 33 والبحار ج21 ص1 و 14 وج73
ص249 وعن مجمع البيان ج9 ص200 والإمتاع ص310 والمغازي للواقدي
ج2 ص642 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص176 والمزار ص52 والأمان من
الأخطار ص132 ومدينة المعاجز ج1 ص173.
([58])
راجع: تاريخ الخميس ج2 ص42 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص364.
([59])
الآية 249 من سورة البقرة.
([60])
السيرة الحلبية ج3 ص51 والإمتاع ص313 وراجع: المغازي للواقدي
ج2 ص642 و 650 وتاريخ الخميس ج2 ص42 والبحار ج21 ص30 عن
الخرائج والجرائح والإصابة ج3 ص254 و 301.
([61])
البحار ج21 ص30 وج21 ص30 والخرايج والجرايح ج1 ص164.
([62])
المغازي للواقدي ج2 ص650 و 651.
([63])
الآية 4 من سورة المنافقون.
|