|
غـنـائـم وســبـايا خـيـبـر
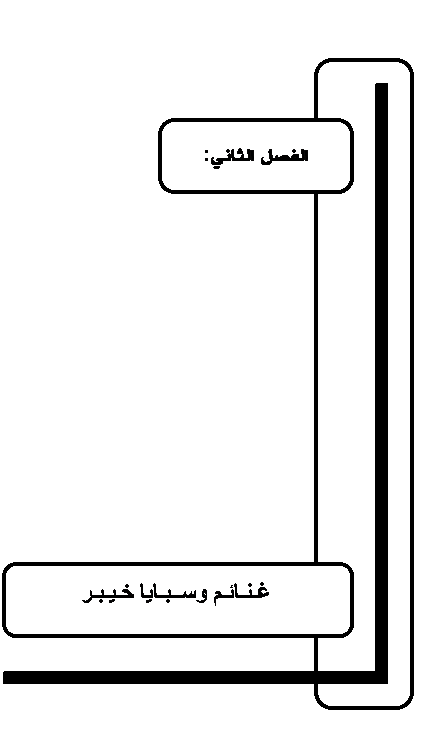
النبي
 يرضخ للنساء:
يرضخ للنساء:
قال الحلبي:
«ورضخ «صلى الله عليه وآله»
للنساء، أي وكن عشرين امرأة، فيهن صفية عمته «صلى الله عليه وآله»، وأم
سليم، وأم عطية الأنصارية»([1]).
وقال ابن إسحاق:
وشهد خيبر مع رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»
من نساء المسلمين فرضخ لهن من الفيء، ولم يضرب لهن بسهم([2]).
وروى ابن إسحاق، عن امرأة من غفار
قالت:
أتيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» في نسوة من بني
غفار فقلن: يا رسول الله، قد أردنا الخروج معك إلى وجهك هذا ـ وهو يسير
إلى خيبر ـ فنداوي الجرحى، ونعين المسلمين ما استطعنا.
فقال:
«على
بركة الله تعالى».
قالت:
فخرجنا معه.
قالت:
فلما فتح رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»
خيبر رضخ لنا من الفيء، وأخذ هذه القلادة فوضعها في عنقي، فوالله لا
تفارقني أبداً. وأوصت أن تدفن معها([3]).
وعن عبد الله بن أنيس قال:
خرجت مع رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»
إلى خيبر ومعي زوجتي ـ وهي حبلى ـ فنفست في الطريق، فأخبرت رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»،
فقال:
«انقع
لها تمراً، فإذا أَنْعَمَ بَلُّه، فامرثه لتشربه».
ففعلت، فما رأت شيئاً تكرهه.
فلما فتحنا خيبر أحذى النساء ولم يسهم لهن، فأحذى زوجتي
وولدي الذي ولد([4]).
وعن عمير مولى أبي اللخم قال:
شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا فيَّ رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»،
فأمر بي فقلدت سيفاً، فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من
خُرثي المتاع([5]).
ونقول:
إننا لا نستطيع أن نصدق أن يكون
«صلى
الله عليه وآله»
هو الذي وضع القلادة في عنق تلك المرأة، إلا أن تكون من محارمه
«صلى
الله عليه وآله»،
ولكننا لم نجد ما يدل على ذلك..
عن موسى بن عقبة، عن الزهري:
أن بني فزارة ممن قدم على أهل خيبر ليعينوهم، فراسلهم
رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن لا يعينوهم، وسألهم أن يخرجوا عنهم،
ولهم من خيبر كذا وكذا، فأبوا عليه.
فلما أن فتح الله خيبر أتاه من كان
هناك من بني فزارة، فقالوا:
حظنا والذي وعدتنا.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«حظكم ـ أو قال: «لكم ذو الرقيبة»، جبل من جبال خيبر.
فقالوا:
إذاً نقاتلك.
فقال:
«موعدكم جنفا».
فلما أن سمعوا ذلك من رسول الله «صلى الله عليه وآله»
خرجوا هاربين([6]).
وقالوا:
كان أبو شُيَيْم المزني يقول: لما نفرنا إلى أهلنا مع
عيينة بن حصن، فرجع بنا عيينة، فلما كان دون خيبر عرسنا من الليل،
ففزعنا.
فقال عيينة:
أبشروا، إني رأيت الليلة في النوم أني أعطيت ذو الرقيبة
ـ جبلاً بخيبر ـ قد والله أخذت برقبة محمد «صلى الله عليه وآله».
فلما أن قدمنا خيبر، قدم عيينة، فوجدنا رسول الله «صلى
الله عليه وآله» قد فتح خيبر.
فقال عيينة:
يا محمد! أعطني مما غنمت من حلفائي، فإني قد خرجت عنك وعن قتالك.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«كذبت، ولكن الصياح الذي سمعت أنفرك إلى أهلك.
قال:
أحذني يا محمد.
قال:
«لك ذو الرقيبة».
قال عيينة:
وما ذو الرقيبة؟
قال:
«الجبل الذي رأيت في منامك أنك أخذته».
فانصرف عيينة.
فلما رجع إلى أهله جاءه الحارث بن
عوف، وقال:
ألم أقل لك: تُوضِعُ في غير شيء؟! فوالله، ليظهرن محمد
على ما بين المشرق والمغرب. يهود كانوا يخبروننا بهذا، أشهد لسمعت أبا
رافع سلام بن مشكم يقول: إنا لنحسد محمداً على النبوة، حيث خرجت من بني
هارون، وهو نبي مرسل، ويهود لا تطاوعني على هذا، ولنا منه ذبحان، واحد
بيثرب، وآخر بخيابر([7]).
ونقول:
1 ـ
إنها للوقاحة الظاهرة أن يرفض الفزاريون طلب النبي
«صلى الله عليه وآله»
بأن لا يعينوا اليهود عليه، ثم لما انتصر على اليهود جاؤوا ليطالبوه
بما كان قد ذكره لهم، ورفضوه.
وإن هذا منهم أشبه بالإحتيال المفضوح، بل هو نوع من
الإستخفاف بالآخرين، والتسلط عليهم، وكأنهم يظنون: أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
يخضع لهذا النوع من الابتزاز الوقح.. ولا يلتفت إلى وجه المغالطة فيه.
وقد رفض «صلى الله عليه وآله» طلبهم، فظنوا:
أن التهديد بالقتال يضعف عزيمته، ويشتري السلم معهم بالمال، ففعلوا
ذلك، وهددوه بالقتال.. فجاءهم الجواب الصاعق الذي أرعبهم.
2 ـ
وأما لماذا هرب الفزاريون حين قال لهم رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
موعدكم
«جنفا»؟
فإنما هو لأن أهلهم كانوا مقيمين بموضع قرب المدينة اسمه
«حيفاء»
أو
«حفياء»([8])
وقد صحفه الناقلون فصار
«جنفا».
وحينما كانوا ذاهبين لنصرة اليهود، سمعوا صائحاً لا
يدرون، أمن السماء هو أم من الأرض، ينادي:
«أهلكم،
أهلكم بحيفاء، فإنكم قد خولفتم إليهم».
فخافوا على أهليهم، وألقى الله سبحانه الرعب في قلوبهم،
فرجعوا إليهم، ولم ينصروا حلفاءهم..
فكأن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
حين ذكَّرهم بذلك، قد أفهمهم أن هذا الأمر مرعي من قِبَلهِ تعالى، وأنه
لا طاقة لهم بحرب الله ورسوله..
ولعل قول النبي «صلى الله عليه
وآله» لهم:
«موعدكم
حيفاء»،
قـد أفهمهم بالإضافة إلى ذلك: أنه
«صلى الله عليه وآله»
قد قبل بمبدأ القتال، وعدم الخضوع للابتزاز، وأنه قد عقد العزم على
غزوهم في عقر دارهم، فليجمعوا، وليستعدوا ما شاؤوا..
فلما وجدوا:
أن القضية انتهت إلى هذا الحد أرعبهم ذلك، فخرجوا هاربين.. لأنهم رأوا
بأم أعينهم ما جرى ليهود خيبر وغيرهم.
3 ـ
إن تذكير النبي
«صلى الله عليه وآله»
لعيينة بمنامه ـ الذي تضمن: أنه أخذ ذا الرقيبة ـ قد أفهمه: أنه
«صلى الله عليه وآله»
كان على علم بمقالته القبيحة بعد استيقاظه:
«قد
والله أخذت برقبة محمد».
وبذلك يكون
«صلى الله عليه وآله»
قد وجه صفعة قوية لعيينة، لم يجد معها بداً من الإنصراف الذليل.
4 ـ
إن حديث الحارث بن عوف لعيينة، عن إخبارات اليهود لهم
بشأن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وبأنه يظهر على ما بين المشرق
والمغرب.. وأنه سيذبحهم مرتين، ثم رؤية الناس صدق هذه الأخبار، وتجسد
مضمونها على أرض الواقع ـ إن ذلك ـ من شأنه أن يصعِّب على هؤلاء الناس
الإقدام على مناوأته «صلى الله عليه وآله»، لأنهم سيجدون في أنفسهم
التردد، والنفور من حرب يعلمون مسبقاً بنتائجها.
قال الحلبي:
وروي: أنه
«صلى الله عليه وآله»
لما فتح خيبر أصاب حماراً أسود، فقال له رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
ما اسمك؟
قال:
يزيد بن شهاب، أخرج الله من نسل جدي ستين حماراً كلهم لا يركبهم إلا
نبي، وقد كنت أتوقعك لتركبني. لم يبق من نسل جدي غيري، ولم يبق من
الأنبياء غيرك. قد كنت لرجل يهودي فكنت أعثر به عمداً، وكان يجيع بطني،
ويضرب ظهري.
فقال له النبي «صلى الله عليه
وآله»:
فأنت يعفور.
وكان رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
يبعثه إلى باب الرجل، فيأتي الباب فيقرعه برأسه، وإذا خرج صاحب الدار
أومأ إليه أن: أجب رسول الله
«صلى الله عليه وآله».
فلما مات رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
ألقى بنفسه في بئر، جزعاً عليه
«صلى الله عليه وآله»،
فمات([9]).
ونقول:
أولاً:
قالوا: لقد ضعفوا هذا الخبر.
فقال ابن حبان:
هذا خبر لا أصل له، وأسناده ليس بشيء.
وقال ابن الجوزي:
لعن الله واضعه، فإنه لم يقصد إلا القدح في الإسلام، والإستهزاء به.
وقال العماد ابن كثير:
هذا شيء باطل، ولا أصل له من طريق صحيح ولا ضعيف.
وسئل المزي عنه، فقال:
ليس له أصل، وهو ضحكة، وقد أودعه كتبهم جماعة، منهم القاضي عياض في
الشفاء، والسهيلي في روضه. وكان الأولى ترك ذكره، ووافقه على ذلك
الحافظ ابن حجر([10]).
غير أن لنا تعليقاً على هذا الذي ذكروه، فإننا وإن لم
نناقش في ضعف سند هذا الخبر.
لكن من الواضح:
أن ضعفه لا يعني كونه موضوعاً ومختلقاً.
فما معنى قولهم:
لعن الله واضعه؟
وقولهم:
لا أصل له،
وقولهم:
هو ضحكة الخ..؟!
واما قولهم:
إنه وضع بقصد القدح في الإسلام، والإستهزاء به، فلم نعرف وجهه، فإن
الله تعالى ذكر كلام النملة، والهدهد مع سليمان، وقال: ﴿وَمَا
مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا
أُمَمٌ أَمْثَالُكُم﴾([11]).
والروايات التي تحدثت عن كلام الحيوانات مع الأنبياء
«عليهم
السلام»،
وعن بعض التصرفات الهامة لتلك الحيوانات تفوق حد التواتر.
ثانياً:
إن عمدة ما يرد على هذا الحديث: هو أنه قد ورد: أن
المقوقس هو الذي أهدى يعفوراً لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»([12]).
فما معنى قولهم:
إن النبي
«صلى الله عليه وآله»
أصابه في خيبر، وكان منه ما تقدم؟!
روى الشيخان عن عبد الله بن مغفل،
قال:
أصبت جراباً.
وفي لفظ:
دلِّي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته، وقلت: لا أعطي
أحداً منه شيئاً، فالتفت فإذا رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
فاستحييت منه، وحملته على عنقي إلى رحلي وأصحابي، فلقيني صاحب المغانم
الذي جعل عليها ـ وهو أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري كما في الحلبية ـ
فأخذ بناحيته، وقال: هَلُمَّ حتى نقسمه بين المسلمين.
قلت:
لا والله، لا أعطيك.
فجعل يجاذبني الجراب، فرآنا رسول الله «صلى الله عليه
وآله» نصنع ذلك، فتبسم ضاحكاً، ثم قال لصاحب المغانم: «لا أبا لك، خل
بينه وبينه».
فأرسله، فانطلقت به إلى رحلي وأصحابي، فأكلناه([13]).
قال ابن إسحـاق:
وأعطى رسـول الله
«صلى الله عليه وآله»
ابن لقيـم ـ بضم اللام، قال الحاكم: واسمه عيسى العبسي ـ حين افتتح
خيبر ما بها من دجاجة وداجن([14]).
ونقول:
أولاً:
إذا كان قد دلِّي جراب من شحم، فالمفروض: أن يدلَّى من فوق الحصن، ونحن
لا ندري لماذا يدلِّي اليهود جراباً من شحم إلى خارج حصنهم؟!
فهل هو صدقة منهم؟ أم هدية؟!
وأي إنسان كان يحب المسلمين إلى حد أنه يرمي لهم بجراب
من شحم؟!
أم أنهم قد استغنوا عن ذلك الشحم، فأرادوا التخلص منه؟!
ولماذا يتخلصون منه بهذه الطريقة؟ ألم يكن يمكنهم إفراغ
محتوياته، بطريقة تمنع من استفادة المسلمين منها؟
ولماذا لم يحذر المسلمون من هذا الجراب؟ أو لماذا لم
يحذِّر النبي
«صلى الله عليه وآله»
المسلمين منه؟! فلعلهم قد جعلوا السم في ذلك الشحم، وأرادوا الإيقاع
بهم بهذه الطريقة.
ثانياً:
ما معنى: أن يواجه النبي
«صلى الله عليه وآله»
صاحب المغانم بهذه العبارة القاسية:
«لا
أبا لك..»
كما ورد في بعض المصادر؟
فهل رأى أنه قد أساء الفعل، حين منع ابن مغفل من
الإستقلال بالجراب؟!
أم أنه كان يمارس وظيفته؟!
ثالثاً:
لماذا اختص ابن لقيم بالدجاج والدواجن في خيبر؟! ولماذا
لم يعط
«صلى الله عليه وآله»
منها سائر المسلمين؟
وهل كان ابن لقيم مشهوراً بتربية الدواجن والدجاج؟
ومن الدواجن الحمير والبغال، والإبل، والبقر، فهل أعطى
ذلك كله لابن لقيم؟!
ولنفترض:
أن المقصود خصوص الدجاج والطيور، فهل هذا هو ما تفترضه
القسمة العادلة بين الشركاء في الغنيمة؟
ويقولون:
مات صحابي في خيبر، فقال
«صلى الله عليه وآله»:
صلوا على صاحبكم، وامتنع من الصلاة عليه، فتغيرت وجوه الناس لذلك،
فقال: إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله.
ففتشنا متاعه، فوجدنا خرزاً من خرز اليهود، لا يساوي
درهمين.
ونلاحظ هنا:
أولاً:
إن صحابية هذا الصحابي لم تمنعه من أن يغلّ، وهو أمر
محرم..
فما معنى حكم بعض الفئات بعدالة جميع الصحابة؟!
كما أن صحابيته هذه لم تشفع له عند رسول الله «صلى الله
عليه وآله»،
فحرمه من شرف الصلاة عليه..
ثانياً:
إن النبي
«صلى الله عليه وآله»
قد صلى على عبد الله بن أبي، الذي يصفونه بأنه كان رئيس المنافقين..
فكيف لا يصلي على هذا الرجل الذي دفعه طمعه إلى إخفاء خرز لا يساوي
درهمين؟!.. فإن ذلك لا يوجب خروجه من الدين!!
وهل كل من فعل محرماً لا يصلي عليه النبي
«صلى الله عليه وآله»؟!
أم أن ذلك يختص بهذا النوع من الذنوب؟!
بل إن نفس أن مبادرته «صلى الله عليه وآله» إلى فضح ذلك
الرجل بعد موته في أمر كهذا، لهو أمر لافت للنظر، ومثير للتساؤلات حول
صحة هذه الرواية.
إلا أن يقال:
إنه
«صلى الله عليه وآله»
أراد بعمله هذا إيقاف الناس على خطورة هذا الأمر الذي قد يرونه هيناً،
وهو عند الله عظيم. وتتأكد الحاجة إلى هذا البيان الحاد، إذا أصبح
الغلول ظاهرة مستشرية في الناس، إلى حد أنها تنذر بعواقب وخيمة..
ولكن هذا يبقى أيضاً مجرد احتمال، يحتاج إلى ما يؤكده
ويؤيده.
وعن أنس، قال:
لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس
بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل أرض وعقار، فقاسمهم الأنصار على أن
أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام، ويكفوهم العمل والمؤنة.
وكانت أم أنس أعطت رسول الله «صلى الله عليه وآله»
أعذاقاً لها، فأعطاهن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أم أيمن مولاته،
أم أسامة بن زيد.
فلما فرغ رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
من أهل خيبر، وانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم
التي كانوا قد منحوهم من ثمارهم، ورد رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
إلى أمي أعذاقها([15]).
وفي رواية عن أم أنس، قالت:
فسألت رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
فأعطانيهن، فجاءت أم أيمن، فجعلت الثوب في عنقي، وجعلت تقول: كلا والله
الذي لا إله إلا هو، لا يعطيكهن وقد أعطانيهن.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«يا
أم أيمن، اتركي، ولك كذا وكذا»،
وهي تقول: كلا، والله الذي لا إله إلا هو.
فجعل يقول:
«لك
كذا وكذا، ولك كذا».
وهي تقول:
كلا، والله الذي لا إله إلا هو، حتى أعطاها عشرة أمثالها، أو قريباً من
عشرة أمثالها([16]).
ونقول:
1 ـ
إن هذا الحادثة
تفيد:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» إنما
كان يرجع تلك الأموال إلى الذين كانوا يطالبون بها..
ولعل هذا الأمر قد صدر من أفراد قليلين، ممن شحت نفوسهم
على بعض ما أعطوه من حطام الدنيا.
ونزيد في توضيح ذلك ببيان:
أن الذين حكموا الناس بعد النبي
«صلى الله عليه وآله»
هم فريق من المهاجرين، الذين سعوا إلى هذا الأمر، وحصلوا على السلطة،
بعد أن استعانوا بآلاف المقاتلين من بني أسلم وغيرهم. وقد ضربوا من أجل
ذلك فاطمة الزهراء
«عليها
السلام»،
وأسقطوا جنينها، فكانت بذلك صلوات الله عليها الصديقة الشهيدة.
وكان قد نافسهم في هذا الأمر الزعيم الخزرجي سعد بن
عبادة الأنصاري.
وكان إحسان الأنصار إليهم حينما هاجروا, ونزلوا عليهم
من موجبات شعورهم بالضيق, والإحراج..
فيُظنّ قوياً أنهم أشاعوا:
أن المهاجرين قد أرجعوا إلى الأنصار ما كانوا قد منحوهم إياه من
ثمارهم؛ لكي لا يكون للأنصار فضل عليهم، أو يد عندهم..
مع أن الحقيقة هي:
أن الذين أرجعت إليهم منائحهم هم أفراد قليلون طلبوا من المهاجرين ذلك,
فأعاد إليهم رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
ما كانوا قد طلبوه..
ومن غير البعيد أيضاً:
أن يكون هؤلاء المطالبون هم من أولئك الأنصار الذين
كانوا يؤيدون الفريق المناوئ لعلي
«عليه
السلام»
منذ عهد الرسول
«صلى الله عليه وآله»,
والمؤيد للمهاجرين الحاكمين، والذين استمروا على تأييدهم لهم، وسعيهم
لإلحاق الأذى بعلي
«عليه
السلام»
ومحبيه، حتى إلى ما بعد وفاة النبي
«صلى الله عليه وآله»..
كأسيد بن حضير ـ قريب أبي بكر ـ ومن هم على شاكلته.
2 ـ
ونلاحظ: أن الرواية قد دلت: على قسوة ظاهرة لدى أم أنس, التي رأت بأم
عينيها أن أم أيمن ـ وهي المرأة التي شهد لها رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
بأنها من أهل الجنة([17])
ـ لا تريد أن تتخلى عن حقها في تلك النخلات, فإن من يعطي شيئاً يفقد
حقه فيه بعد تصرف الموهوب له فيه ببيع، أو هبة، أو نحو ذلك..
واستمرت أم أنس على موقفها بالمطالبة, والإصرار على
انتزاعها منها..
3 ـ
إن موقف النبي
«صلى الله عليه وآله»
يدل على أن لا حقَّ لأم أنس بتلك النخلات، لأنه قد بذل لأم أيمن عوضاً
عنها أضعافاً حتى رضيت، ولو كان لها حق بها لانتزعها من أم أيمن،
وأعطاها إياها، تماماً كما فعل مع سمرة بن جندب حينما قلع النخلة
وألقاها إليه ـ رغم أنها ملك له ـ لكنه أصر على أن يدخل إليها من دون
استئذان أصحاب الدار التي كانت تلك النخلة فيها، ورفض بيعها لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
فراجع([18]).
وعن شداد بن الهاد:
أن رجلاً من الأعراب جاء إلى رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
فآمن واتبعه، فقال: أهاجر معك.
فأوصى به النبي
«صلى الله عليه وآله»
بعض أصحابه.
فلما كانت غزوة خيبر، غنم رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
شيئاً قسمه لهم، وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم،
فلما جاء دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟
فقالوا:
قسم قسمه لك رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
فخذه.
فجاء به رسول الله «صلى الله عليه
وآله» فقال:
ما هذا؟
قال:
«قسم
قسمته لك».
قال:
ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أُرْمَى ههنا ـ
وأشار إلى حلقه ـ بسهم، فأموت، فأدخل الجنة.
فقال:
«إن
تصدق الله يصدقك».
ثم نهضوا إلى قتال العدو، فأتي به رسول الله «صلى الله
عليه وآله» يحمل، وقد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي «صلى الله عليه
وآله»: «هو هو».
قالوا:
نعم.
قال:
«صدق
الله، فصدقه».
فكفنه النبي
«صلى الله عليه وآله»
في جبته، ثم قدمه، فصلى عليه.
وكان مما ظهر من صلاته:
«اللهم
هذا عبدك وابن عبدك، خرج مهاجراً في سبيلك، قتل شهيداً، أنا عليه شهيد»([19]).
ونقول:
إن صنيع هذا الرجل يذكِّرنا بأم أنس، وهي تصر على
انتزاع النخلات من أم أيمن، رغم أنه ليس من حقها ذلك.
ويذكرنا أيضاً:
بأولئك الذين كانوا السبب فيما جرى على المسلمين في واقعة أحد، حيث
جعلهم رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
على ثغرة في الجبل، ليأمن مباغتة العدو لهم منها.. وأوصاهم بأن لا
يتركوها، حتى لو رأوا المسلمين يقتلون..
فلما دارت الحرب، وفرَّ المشركون، ورأوا المسلمين
يجمعون الغنائم، تركوا مراكزهم طمعاً بالغنيمة، فجاءهم العدو من تلك
الثغرة بالذات، وأوقع بالمسلمين هزيمة نكراء، وقتل منهم العشرات، حوالي
سبعين رجلاً.
ويذكرنا أيضاً هذا الموقف:
بقول المعتزلي عن سعد بن أبي وقاص في مقارنته مع علي «عليه السلام»:
«هذا
يجاحش على السلب، ويأسف على فواته، وذاك لا يلتفت إلى سلب عمرو بن عبد
ود، وهو أنفس سلب، ويكره أن يبز السبيَّ ثيابه»([20]).
وقالوا:
إن النبي
«صلى
الله عليه وآله»
أعطى أبا سفيان بن حرب من غنائم خيبر ـ وكان شهدها معه ـ مائة بعير,
وأربعين أوقية, وزنها له بلال([21]).
ونحن لا نشك في عدم صحة ذلك:
لإن
أبا سفيان لم
يظهر الإسلام إلا في فتح مكة, وذلك في السنة الثامنة من
الهجرة, ولم يحضر خيبر, التي كانت في سنة سبع، بل كان في مكة آنئذٍ..
ولعل الصحيح:
أنه أعطاه من غنائم حنين.
لكن الرواة صحفوا كلمة حنين، فصارت: «خيبر»، لتقاربهما
في الرسم.
وربما يكون المقصود:
أنه
«صلى
الله عليه وآله»
قد أرسل بعض الأموال إلى مكة، وذلك حين ابتلي المكيون بالحاجة التي
بلغت بهم إلى حد المجاعة, ولعل بعض ما أرسله إليها كان من بقايا غنائم
خيبر أيضاً.
ولعل هذا هو ما أشير إليه، فيما رواه عبد الله بن عمرو
الخزاعي، عن أبيه قال:
«دعاني
رسول الله
«صلى
الله عليه وآله»,
وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان بمكة قبل الفتح, فقال: التمس
الخ..»([22])،
وفي بعض الروايات بعد الفتح([23]).
ويقولون:
إن عبد الله بن رواحة كان خارص رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
في خيبر.
وقد ذكر البعض:
أن هناك من ناقش في هذا الحديث، فقال: إنما خرص([24])
عليهم عبد الله عاماً واحداً، ثم استشهد في مؤتة، فكان جبار بن صخر هو
الذي يخرص([25]).
ونقول:
إن قول ذلك البعض:
إن ابن رواحة قد خرص عاماً واحداً، ثم مات غير مقبول؛ إذ من القريب
جداً أن يكون
«صلى الله عليه وآله»
قد صالح كثيراً من اليهود في منطقة خيبر وغيرها، على أن يستمروا في
العمل بالنخل ويعطوه شطراً من ثمارها، وكان ابن رواحة هو الخارص لثمرة
نخيلهم في الأعوام التي سبقت استشهاده..
فقولهم:
إنما خرص عليهم عاماً واحداً إنما يصح؛ بالنسبة لأولئك الذين صولحوا في
وقعة خيبر..
ولا مجال لقبول ما زعموه:
من أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
قد رد على اليهود صحائف التوراة التي كانت من الغنيمة، حينما طلبوها
منه([26]).
إذ لا يجوز الإبقاء على كتب الضلال، إن كانت هي التوراة المزعومة، التي
كتبوها بأيديهم، وقالوا: إنها من عند الله تعالى، وما هي من عنده
سبحانه..
ولو فرض محالاً أنهم وجدوا بعض نسخ التوراة الحقيقية،
فلا يصح تمكين اليهود منها، لأنهم لا يهتدون بهديها، بل هم يدنسونها،
ويثيرون الشبهات حولها.
قال الطبرسي:
«وأخذ
علي
«عليه
السلام»
في من أخذ صفية بنت حيي، فدعا بلالاً، فدفعها إليه، وقال له: لا تضعها
إلا في يدي رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
حتى يرى فيها رأيه.
فأخرجها بلال، ومرَّ بها إلى رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
على القتلى، وقد كادت تذهب روحها، فقال
«صلى الله عليه وآله»:
أنزعت منك الرحمة يا بلال؟! ثم اصطفاها لنفسه، ثم أعتقها وتزوجها»([27]).
وفي نص آخر:
أن صفية سبيت هي وبنت عم لها، وأن بلالاً مر بهما على قتلى يهود، فلما
رأتهم بنت عم صفية صاحت، وصكت وجهها، وحثت التراب على رأسها.
فلما رآها «صلى الله عليه وآله»
قال:
اعزبوا عني هذه الشيطانة.
وقال «صلى الله عليه وآله» لبلال:
أنزعت منك الرحمة يا بلال، حتى تمر بامرأتين على قتلى رجالهما؟!([28]).
وتحسن الإشارة إلى الأمور التالية:
1 ـ
هل كان بلال ملتفتاً وقاصداً إيذاء هاتين المرأتين
بالمرور بهن على قتلاهما؟! أم أنه مر من هناك على سبيل الصدفة، باعتبار
أن هذا هو الطريق المعتاد له؟! أو الذي ينساق الإنسان لسلوكه، لقربه،
وسهولته مثلاً؟
2 ـ
هل صكت تلك المرأة وجهها، وصاحت، وحثت التراب على رأسها
بالقرب من رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
حتى احتاج إلى إبعادها عن مجلسه؟!
وهل كان مجلسه
«صلى الله عليه وآله»
قريباً من مواضع قتلى اليهود؟
أم أن صياحها، وصكها لوجهها، و.. قد استمر ولم يتوقف
إلى أن بلغت مجلسه
«صلى الله عليه وآله»؟!..
فإن كان الأمر كذلك:
فلماذا لم يأمرها بلال بالسكوت قبل الوصول؟!
وإن لم تطعه في ذلك، فلماذا يمكِّنها من الوصول إليه
«صلى الله عليه وآله»،
وهي على تلك الحال؟!..
3 ـ
لو صح أن بلالاً قد مر بهما على قتلى يهود، فلماذا يفسر
ذلك بأنه كان بقصد إيذائهما، ودفعهما إلى الانفعال والبكاء، بهدف
التلذذ بآلامهما الشخصية، وليكون ذلك من مظاهر قسوة القلب كما هو ظاهر؟
فإننا لم نعهد في بلال مثل هذه القسوة البالغة إلى حد أن الرحمة نزعت
من قلبه.
فإن كان قد مرَّ بهما فعلاً من هناك، فلا بد أن يكون
ذلك من غير تعمد منه، فلماذا ينسب إليه على لسان رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
أن الرحمة قد نزعت من قلبه؟!
إلا أن يقال:
إن النبي
«صلى الله عليه وآله»
لا يقصد إثبات هذه القسوة لبلال، بل أراد
«صلى الله عليه وآله»
أن يقول له: إن هذا الفعل يشبه فعل من نزعت الرحمة من قلبه، فكان
المفروض أن يلتفت إلى ذلك، كما أن عليه عدم الوقوع في المستقبل بما
يشبه ما وقع فيه هذه المرة.
4 ـ
إن إرسال علي «عليه السلام» صفية إلى رسول الله «صلى
الله عليه وآله» أراد به أن يحفظ لها عزتها وكرامتها على قاعدة: إرحموا
عزيز قوم ذل.. كما أنه أراد أن لا يتنافس فيها المتنافسون، ويتحاسد
فيها الطامحون والطامعون..
وقد جاء علي
«عليه
السلام»
بصفية، كما نصت عليه الروايات، وبتعبير آخر: أصاب في خيبر سبايا، اصطفى
منهن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
صفية بنت حيي، فجعلها عند أم سليم، حتى اهتدت وأسلمت، ثم أعتقها، وجعل
عتقها صداقها.
وقالوا:
إنه
«صلى الله عليه وآله»
خيَّرها بين أن يعتقها، فترجع إلى من بقي من أهلها، أو تسلم، فيتخذها
لنفسه. فاختارت الإسلام، وأن تكون زوجة له
«صلى الله عليه وآله».
فأعتقها، وتزوجها، وجعل عتقها صداقها.
وزعموا:
تارة: أنها وقعت في سهم دحية، ثم ابتاعها
«صلى الله عليه وآله»
منه بتسعة أرؤس.
وزعموا أخرى:
أن دحية طلبها من رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
فوهبها له([29]).
وفي البخاري:
أنهم لما جمعوا السبي طلب دحية جارية من رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
من السبي، فقال: اذهب فخذ جارية.
فأخذ صفية، فجاء رجل إلى النبي «صلى
الله عليه وآله»، فقال:
يا رسول الله، أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنضير؟! لا تصلح إلا لك.
فقال:
ادعوا بها، فجاء بها، فأمره النبي
«صلى الله عليه وآله»
بأن يأخذ جارية أخرى من السبي([30]).
فأخذ أخت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق([31]).
ونحن نرجح الروايات التي تقول:
إن علياً «عليه السلام» جاء بها إلى النبي «صلى الله
عليه وآله»، فاصطفاها في جملة ما اصطفاه، فهذا هو المشهور، والمروي،
وهو الذي يمكن الإطمينان إليه..
ولعل دحية قد اختارها أولاً قبل إخراج الصفى من
الغنيمة، ولم يكن يحق له ذلك، ولم يرضَ رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
منه بهذا التصرف والإختيار.
بل لعل الأظهر:
أنه
«صلى الله عليه وآله»
كان قد اصطفاها، ولم يعلم دحية بذلك، ثم جرى التصحيح بإعلامه بالأمر،
ورواية البخاري الآنفة الذكر تشهد لهذا وتؤكده..
وإنما أخذت صفية من حصن القموص،
وقيل:
كان اسمها زينب، قبل أن تسبى، فلما صارت في الصفى التي كان رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
يصطفيها: سميت صفية.
ويلاحظ هنا:
أولاً:
لا شك في أن كل ما في هذا الوجود ملك لله تعالى، يعطيه
لمن يشاء، وفق ما تقتضيه حكمته ورحمته، ولطفه، فلا مانع من أن يعطي
نبيه الأعظم
«صلى الله عليه وآله»
ما شاء، كرامة منه تعالى له، ولطفاً به، وحضاً للناس على محبته،
وتعظيمه وتكريمه..
ثانياً:
قد يكون في الغنيمة ما يناسب شأن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
ويكون في تخصيصه به مصلحة للناس أنفسهم، من حيث إنه يوجب هداية فريق
منهم، أو دفع بلاء عن بعضهم، أو تلافي شحناء، أو نزاع، أو أن فيه
إبعاداً لهم عن أجواء تهيئ للتحاسد، أو للتنافس الذي لا يقوم على أساس
صحيح، أو ما إلى ذلك..
ثالثاً:
إن لبعض المقامات شؤوناً تناسبها، فلا بد من مراعاتها،
بإعطائها ما تستحقه، والإلتزام بموجباتها، فإن الإنسجام مع المقتضيات
الواقعية، يبقى هو الخيار الأصح الذي لا بد من الأخذ به..
والكاشف عن هذه المقتضيات؛ هو الله تعالى العالم
بالحقائق، لأنه هو البارئ والخالق. فلا بد من الأخذ منه، والطاعة له
فيما يأمر به، وينهى عنه.
رابعاً:
أما حديث تسميتها بصفية بعد اصطفاء رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
لها، فهو غير دقيق، لما ورد: من أن دحية بن خليفة الكلبي كان قد أخذ
صفية أولاً، فاعترض أحدهم على ذلك، وقال: يا رسول الله، أعطيت دحية
صفية؟!([32]).
فهذه العبارة تدل على:
أن اسم صفية كان ثابتاً لها قبل أن يصطفيها النبي
«صلى الله عليه وآله»
فراجع.
قالوا:
ولما دخل النبي
«صلى الله عليه وآله»
بصفية، رأى بأعلى عينها خضرة، فسألها عنها، فأخبرته: أنها قالت لزوجها
ابن أبي الحقيق ـ وهي عروس ـ: إنها رأت القمر (والشمس كما في رواية
أخرى) في حجرها، أو على صدرها، فلطمها، وقال: تتمني ملك العرب؟!..
وفي رواية:
أنها رأت ذلك حين نزل النبي
«صلى الله عليه وآله»
خيبر([33]).
ونقول:
1 ـ
إن النبي
«صلى الله عليه وآله»
دخل بصفية، وهو راجع من خيبر إلى المدينة.. ولا شك في أنه
«صلى الله عليه وآله»
كان قد رآها قبل ذلك الوقت، وذلك حين اصطفاها، أو حين جاء بها دحية،
وأعطاه غيرها عوضاً عنها. فلماذا لم يرَ الخضرة فوق عينها آنذاك؟!
2 ـ
إن رؤيتها للشمس والقمر، أو للقمر في حجرها، أو على صدرها، لا تشير إلى
ملك العرب بشيء، فلماذا لا يفسِّر ـ زوجها ـ تلك الرؤيا بملك الفرس، أو
الروم، أو القبط، أو بنفسه، أو بغيره من ملوك اليهود وعظمائهم؟!
3 ـ
قد اختلفت روايات هذه القضية، فهل هي أخبرت زوجها، فلطمها؟ أم أخبرت
أباها فلطمها؟!
ولا مجال للقول بأنها أخبرت هذا تارة، وذاك أخرى.. لأن
اخضرار العين قد حصل من ضربة واحد منهما، لا من كليهما..
ثم هل رأت القمر في حجرها؟! أم رأت الشمس والقمر على
صدرها؟!
4 ـ
إذا صح تفسير رؤية القمر في حجرها بملك العرب، فكيف يمكن تفسير رؤية
الشمس والقمر معاً على صدرها؟!.. فهل تفسر بأنها سوف يتزوجها اثنان؟!
أم واحد؟!
5 ـ
ذكروا أيضاً: أن
هذه الحادثة قد حدثت لجويرية
زوج النبي
«صلى الله عليه وآله»، حيث رأت
قبل زواجها بالنبي
«صلى الله عليه وآله»
أن
القمر قد وقع في حجرها([34])..
فأي هذين هو الصحيح؟!
6 ـ
إن اخضرار العين يزول خلال أيام، فكيف استمر عشرات
الأيام ومن حين نزول النبي
«صلى الله عليه وآله»
خيبر؟! كما ذكرته بعض الروايات.
7 ـ
لعل الصحيح في هذه القضية:
هو ما روي، من أنه حين اقتلع علي
«عليه
السلام»
باب الحصن، اهتز الحصن حتى سقطت لوجهها، فشجها جانب السرير، فأصابها ما
أصابها، حسبما تقدم([35]).
وهذا الاهتزاز هو مما صنعه الله كرامة لعلي
«عليه
السلام»،
وإمعاناً في إقامة الحجة على اليهود.
وزعموا:
أنه «صلى الله عليه وآله» قال لصفية ـ حينما انتهت إليه
ـ: يا صفية، أما إني أعتذر إليك مما صنعت بقومك، إنهم قالوا لي: كذا،
وكذا إلخ..
وما زال «صلى الله عليه وآله»
يعتذر إليها، حتى ذهب ذلك من نفسها([36]).
ونقول:
لا ندري إن كان يصح الاعتذار عن فعل واجب أمر الله
تعالى به؟!
وإذا كان
«صلى الله عليه وآله»
أراد أن يوضح لها الحقيقة، ويخرجها من حالة الجهل، ويسلَّ سخيمتها، فإن
ذلك لا يصح أن يسمى اعتذاراً!!
وإذا كانت قد أسلمت، واعتقدت بأنه
«صلى الله عليه وآله»
نبي الله، الذي لا ينطق عن الهوى، والذي هو في طاعة الله سبحانه وتعالى
في كل قول وفعل، فلماذا الإعتذار؟
أليس ذلك كافياً في إقناعها بأن ما فعله حق؟!
قالوا:
ولما قطع النبي
«صلى الله عليه وآله»
ستة أميال من خيبر، أراد أن يعرس بصفية، فأبت، فوجد النبي
«صلى الله عليه وآله»
في نفسه.
فلما سار ووصل إلى الصهباء، مال إلى دوحة هناك،
فطاوعته. فقال لها: ما حملك على إبائك حين أردت المنزل الأول؟!
قالت:
يا رسول الله، خشيت عليك قرب يهود([37]).
ونقول:
أولاً:
كيف خشيت عليه
«صلى الله عليه وآله»
ذلك وهو بين أصحابه، وحوله جيش عرمرم يفديه بنفسه، وعنده علي
«عليه
السلام»
قاتل مرحب، وسائر أبطال اليهود، وقالع باب خيبر؟
نعم، هل يمكن أن يصل إليه
«صلى الله عليه وآله»
غريب، ثم لا يسأل أحد ذلك الغريب عن حاله، وعما جاء به؟
ثانياً:
لقد أقام النبي
«صلى الله عليه وآله»
بقرب اليهود، وفي عقر دارهم عشرات الأيام، وقد حاربهم، وانتقم منهم،
وشل حركتهم، ولم يتمكنوا من فعل أي شيء ضده..
فلماذا تخشاهم عليه بعد أن أذلهم، وفرق جمعهم، وأباد
خضراءهم، ثم غادرهم، وابتعد عنهم، وأصبح ظهور كل غريب فيما بين
المسلمين مثاراً للريبة، وموجباً للمبادرة لاعتقاله، وللتحقيق معه؟!
وزعموا:
أنه لما تزوج النبي
«صلى الله عليه وآله»
بصفية بات أبو أيوب تلك الليلة، متوشحاً بسيفه يحرسه، ويطوف بتلك
القبة، حتى أصبح
«صلى الله عليه وآله»،
فرأى مكان أبي أيوب، فسأله عن ذلك، فقال: يا رسول الله، خفت عليك من
هذه المرأة، قتلت أباها وزوجها، وقومها، وهي حديثة عهد بكفر، فبت
أحفظك.
فقال «صلى الله عليه وآله»:
اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني([38]).
ونقول:
أولاً:
إن لنا أن نتساءل: أين كان علي
«عليه
السلام»
في تلك الليلة؟! ولماذا لم يبادر إلى حراسة رسول الله
«صلى الله عليه وآله»؟!
مع أن الخوف عليه
«صلى الله عليه وآله»
ـ كما قال أبو أيوب ـ كان على درجة كبيرة من الظهور والوضوح..
وقد كان
«عليه
السلام»
يحرسه في المدينة، وفي بدر، ولا يغفل عن تفقد أحواله.. كما أنه كان هو
الذائد عنه في أحد، وفي كل موقع أحسَّ فيه بالحاجة إلى ذلك..
ولماذا لا يطلب رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
نفسه هذه الحراسة من أصحابه؟! فإن ما قاله أبو أيوب لم يكن ليغيب عنه
«صلى الله عليه وآله»!!
ثانياً:
إننا لا نستطيع أن نؤكد جدوى حراسة أبي أيوب.. فإن
النبي
«صلى الله عليه وآله»
كان مع زوجته في داخل خيمته، ولا يتسنى، ولا يجوز لأبي أيوب أن يطَّلع
على ما يجري بينهما، خصوصاً في ليلة الزواج..
وهي إن كانت تُبَيِّتُ أمراً، فلا بد أن تخفيه عن
زوجها، وهو معها. فكيف لا تخفيه عن غيره؟
وإن استطاعت أن تُلحِقَ بزوجها ضرراً دون أن يجد الفرصة
للدفاع عن نفسه، فستحرص على أن ينتهي الأمر قبل ارتفاع أي صوت..
ولذلك نقول:
إنه سوف لا تنفعه
«صلى الله عليه وآله»
نجدة أبي أيوب، ولا نجدة غيره له، بل هي سوف تأتي بعد فوات الأوان.
([1])
السيرة الحلبية ج3 ص56 وعن الطبقات الكبرى ج8 ص456 وراجع:
النهاية ج2 ص228.
([2])
السيرة الحلبية ج3 ص56 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص144 وراجع:
الإيضاح ص187 ومواقف الشيعة ج3 ص389 وكتاب المسند ص207 و 319
وعن مسند أحمد ج1 ص308 و 352 وعن صحيح مسلم ج5 ص197 وعن سنن
أبي داود ج1 ص620 وسنن الترمذي ج3 ص57 والسنن الكبرى للبيهقي
ج6 ص332 وج9 ص22 و 30 والمصنف لابن أبي شبة ج7 ص667 ومسند أبي
يعلى ج5 ص42 والمنتقى من السنن المسندة ص273 والمعجم الكبير
ج10 ص336 ونصب الراية ج4 ص284 وتاريخ المدينة ج2 ص648 وعن
تاريخ الأمم والملوك ج2 ص304 وعن البداية والنهاية ج4 ص232 وعن
السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص804 والسيرة النبوية لابن كثير
ج3 ص387.
([3])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص144 وفي هامشه عن مسند أحمد ج6 ص380
ودلائل النبوة للبيهقي ج2 ص407 وعن الطبقات الكبرى لابن سعد ج8
ص214 وعن البداية والنهاية ج4 ص204 وعن أبي داود، والسيرة
النبوية لابن كثير ج3 ص388 والمغازي للواقدي ج2 ص686.
([4])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص144 عن الواقدي، ودلائل النبوة للبيهقي
ج4 ص243 وعن البداية والنهاية ج4 ص205، والسيرة النبوية لابن
كثير ج3 ص388 والمغازي للواقدي ج2 ص686.
([5])
سبل الهدى والرشاد ج9 ص129 وج5 ص144 عن أبي داود ج3 ص75 (2730)
ومسند أحمد ج5 ص223 وسنن ابن ماجة ج2 ص952 والمستدرك للحاكم ج1
ص327 وج2 ص131 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص53 وتحفة الأحوذي ج5
ص141 وعون المعبود ج7 ص286 ومسند أبي داود ص169 والمصنف لعبد
الرزاق ج5 ص228 وموارد الظمآن ص402 والمصنف لابن أبي شيبة ج7
ص666 وج8 ص523 والسنن الكبرى للنسائي ج4 ص365 وكنز العمال ج4
ص537 وصحيح ابن حبان ج11 ص162 والمعجم الكبير ج17 ص67 ونصب
الراية ج4 ص285 وإرواء الغليل ج5 ص68 والسير الكبير ج3 ص896
وعن الطبقات الكبرى ج2 ص114 وعن أسد الغابة ج4 ص139.
([6])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص137 ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص248
ومعجم البلدان ج2 ص172 والسيرة الحلبية ج3 ص51 ومعجم قبائل
العرب ج3 ص919.
([7])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص138 وفي هامشه عن: دلائل النبوة للبيهقي
ج4 ص249. والمغازي للواقدي ج2 ص675 والسيرة الحلبية ج3 ص51 وعن
البداية والنهاية ج4 ص240 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص401.
([8])
راجع: وفاء الوفاء ج2 ص292.
([9])
راجع: السيرة الحلبية ج3 ص58 و 59 والبحار ج16 ص100 وج17 ص404
و 416 وكذا في حياة الحيوان للدميري، وعلل الشرائع ج1 ص167
وتفسير نور الثقلين ج2 ص359 والبحار ج22 ص457 وعن الشفا بتعريف
حقوق المصطفى ج1 ص315 وسبل الهدى والرشاد ج11 ص420.
([10])
البحار ج16 ص8 والسيرة الحلبية ج3 ص59.
([11])
الآية 38 من سورة الأنعام.
([12])
البحار ج16 ص108 وج20 ص383 وج21 ص48 وعن المنتقى في مولد
المصطفى، حوادث سنة سبع، وعن السيرة الحلبية ج3 ص281 وعن
السيرة النبوية لدحلان (بهامش الحلبية) ج3 ص71 والإصابة ج3
ص531 وج4 ص335 و 404، وراجع: تاريخ الخميس ج2 ص38 وعن مناقب آل
أبي طالب ج1 ص146 وتاريخ خليفة بن خياط ص52 وتاريخ مدينة دمشق
ج3 ص235 وعن تاريخ الأمم والملوك ج2 ص307 وعن عيون الأثر ج2
ص394 وسبل الهدى والرشاد ج7 ص406.
([13])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص143وفي هامشه عن: البخاري ج6 ص255
(3153) وعن مسلم ج3 ص1393 (72/1772) والسيرة الحلبية ج3 ص40 عن
السيرة النبوية لابن هشام، والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص369
وعن صحيح مسلم ج5 ص163. وراجع: مسند أحمد ج4 ص86 وج5 ص55 و 56
وسنن الدارمي ج2 ص234 وعن سنن أبي داود ج1 ص612 وسنن النسائي
ج7 ص236 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص59 وج10 ص9 ومسند أبي داود
ص123 والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص682 وج8 ص524 والسنن الكبرى
للنسائي ج3 ص71 ونصب الراية ج4 ص268 وكنز العمال ج4 ص539 وعن
الكامل ج2 ص276 وعن البداية والنهاية ج4 ص222 وعن صحيح
البخـاري ج4 ص61 وج5 ص75 وج6 ص227 وعن فتـح = = الباري ج9 ص524
وعون المعبود ج7 ص264 والجامع لأحكام القرآن ج7 ص127 وعن تفسير
القرآن العظيم لابن كثير ج2 ص21.
([14])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص144.
([15])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص150 و 151 عن الشيخين، والحافظ، ويعقوب
بن سفيان، وصحيح ابن حبان ج14 ص192 وعن صحيح البخاري ج3 ص144
وعن صحيح مسلم ج5 ص162 والجامع لأحكام القرآن ج18 ص26.
([16])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص151
وفي هامشه: عن البخاري ج7 ص474 (4120) وعن مسلم ج 3 ص1391
(70/1771) ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص288 ومسند أحمد ج3 ص219.
وعن صحيح البخاري ج3 ص144 (ط دار الفكر) وعن صحيح مسلم (ط دار
الفكر) ج5 ص163 وعن فتح الباري ج5 ص180 ومسند أبي يعلى ج7 ص122
و 124 وصحيح ابن حبان ج10 ص359 وعن تفسير القرآن العظيم لابن
كثير ج4 ص359 وعن الطبقات الكبرى ج8 ص225 وتذكرة الحفاظ ج2
ص436 وسير أعلام النبلاء ج2 ص225 وج11 ص474 وعن البداية
والنهاية ج4 ص92 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص154 والمحلى
ص164 والجامع لأحكام القرآن ج18 ص26.
([17])
راجع: قاموس الرجال ج10 ص387 عن أنساب الأشراف ج2 ص224
والإستغاثة ج1 ص9 وحديث نحن معاشر الأنبياء ص28 والطرائف ص249
ومواقف الشيعة ج2 ص406 وتفسير القمي ج2 ص155 واللمعة البيضاء
ص300 و 309 و 839 وعن الإحتجاج ج1 ص121 وعن كتاب سليم بن قيس
ص354 والخرائج والجرائح ج1 ص113 والبحار ج17 ص379 وج29 ص116 و
128 وج30 ص352 وتفسير نور الثقلين ج4 ص186 وبيت الأحزان ص133
والأنوار العلوية ص292 ومجمع النورين ص117 و 134 والإصابة ج8
ص359.
([18])
الكافي ج5 ص292 و 294 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص233 و 103
والتهذيب ج7 ص147 والوسائل ج17 ص340 و 341 وراجع: البحار ج2
ص267 وج22 ص134 وج100 ص127 والفائق ج2 ص442 ومصابيح السنة
للبغوي ج2 ص14 والنظم الإسلامية ص321 عن أبي داود، وعن عون
المعبود ج2 ص352 والكنى والألقاب ج3 ص30 والإيضاح ص542 والفصول
المهمة في أصول الأئمة ج1 ص672 وشرح النهج للمعتزلي ج4 ص78
ومعجم رجال الحديث ج9 ص320.
([19])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص147 و 148 عن النسائي، والبيهقي، والسنن
الكبرى للبيهقي ج4 ص16 والمصنف لعبد الرزاق ج5 ص276 والمعجم
الكبير ج7 ص271 وتهذيب الكمال ج17 ص234.
([20])
راجع: شرح النهج للمعتزلي ج14 ص237 ملخصاً.
([21])
التراتيب الإدارية ج1 ص412 عن الإستيعاب، والطبقات الكبرى ج7
ص406 وتاريخ مدينة دمشق ج23 ص435 وج59 ص67 وج6 ص241 وأسد
الغابة ج5 ص112.
([22])
التراتيب الإدارية ج1 ص225 وراجع ص 390 و391 وفي (ط أخرى) ج1
ص444 عن أبي داود، ومكاتيب الرسول ج1 ص28 وعن سنن أبي داود ج2
ص448 ومسند أحمد ج5 ص289، وكذلك في السنن الكبرى للبيهقي ج10
ص129 وعن عون المعبود ج13 ص142 ومكارم الأخلاق ص120 وفي المعجم
الكبير ج17 ص36 وكنز العمال ج9 ص176 وفي كشف الخفاء ج1 ص69
والطبقات الكبرى (ط دار صادر) ج4 ص296 وتاريخ مدينة دمشق ج45
ص424 وأسد الغابة ج4 ص14 وتهذيب الكمال ج15 ص369 وسير أعلام
النبلاء ج3 ص180 وعن الإصابة ج4 ص459.
([23])
مكاتيب الرسول ج1 ص28 وعن سنن أبي داود ج2 ص448 ومسند أحمد ج5
ص289 والسنن الكبرى للبيهقي ج10 ص129 والمعجم الكبير ج17 ص36
وكشف الخفاء ج1 ص69 والطبقات الكبرى (ط دار صادر) ج4 ص296 وأسد
الغابة ج4 ص14 وتهذيب الكمال ج15 ص369.
([24])
خرص النخلة: قدَّر ما عليها.
([25])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص133 وج8 ص397 والسيرة الحلبية ج3 ص57
وتاريخ الخميس ج2 ص56 وعن السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص814
ومجمع الزوائد ج3 ص76 والمعجم الكبير ج2 ص270 وكنز العمال ج15
ص540 وعن الإصابة ج1 ص559 وعن تاريخ الأمم والملوك ج2 ص306 وعن
البداية والنهاية ج4 ص230 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص384.
([26])
تاريخ الخميس ج2 ص55 ومصادر كثيرة أخرى.
([27])
البحار ج21 ص22 عن إعلام الورى ج1 ص208 وقصص الأنبياء للراوندي
ص345.
([28])
السيرة الحلبية ج3 ص43 و
44، وراجع: إمتاع الأسماع ص321 والبحار ج21 ص5 وتفسير مجمع
البيان ج9 ص203 وعن تاريخ الأمم والملوك ج2 ص302 وعن البداية
والنهاية ج4 ص224 وعن السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص799
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص374 والأنوار العلوية ص198
والسير الكبير ج1 ص281.
([29])
السيرة الحلبية ج3 ص43 والبحار ج38 ص241 ومسند أحمد ج3 ص102
وعن صحيح البخاري ج1 ص98 وعن صحيح مسلم ج4 ص145 وعن سنن أبي
داود ج2 ص31 وسنن النسائي ج6 ص133 وعن فتح الباري ج7 ص360
ومسند ابن راهويه ج4 ص31 والسنن الكبرى للنسائي ج3 ص335 وج4
ص138 وج6 ص442 وعن أسد الغابة ج5 ص490 وسير أعلام النبلاء ج2
ص232 وعن البداية والنهاية ج4 ص224 وعن عيون الأثر ج2 ص137 و
390 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص373.
([30])
السيرة الحلبية ج3 ص43 عن البخاري وفي البخاري ج7 ص360 وفي
المغازي باب غزوة خيبر، وفي (ط دار الفكر) ج1 ص98 وصحيح مسلم
(ط دار الفكر) ج4 ص146 ومسند أحمد (ط دار صادر) ج3 ص102 ونيل
الأوطار ج8 ص112 وسنن النسائي ج6 ص133 وعن فتح الباري ج7 ص360
والسنن الكبرى للنسائي ج3 ص335 وج4 ص138 والمحلى ج9 ص116 ومسند
ابن راهويه ج4 ص31 والبداية والنهاية ج4 ص224 وعيون الأثر ج2
ص390 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص373.
([31])
السيرة الحلبية ج3 ص43 عن الأم للشافعي، عن الواقدي، وعن فتح
الباري (المقدمة) ص303 وج1 ص405.
([32])
راجع: السيرة الحلبية ج3 ص43 عن البخاري ومصادر كثيرة أخرى
تقدمت.
([33])
راجع: السيرة الحلبية ج3 ص44 وعن الطبقات الكبرى ج8 ص121
والسير الكبير ج1 ص281 وعن الإصابة ج8 ص210 و 211 وعن أسد
الغابة ج5 ص490 وعن عيون الأثر ج2 ص391 والبحار ج21 ص6 و 33
وتفسير مجمع البيان ج9 ص203 وعن تاريخ الأمم والملوك ج2 ص302
وعن البداية والنهاية ج4 ص224 وعن السيرة النبوية لابن هشام ج3
ص799 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص374 والأنوار العلوية ص198
وزوجات النبي ص100 ومجمع الزوائد ج9 ص250 والآحاد والمثاني ج5
ص441 والمعجم الكبير ج24 ص67 وسبل الهدى والرشاد ج11 ص215
وموارد الظمآن ص413 وتاريخ مدينة دمشق ج3 ص221 وفتوح البلدان
ج1 ص26 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص138 وصحيح ابن حبان ج11
ص608.
([34])
المستدرك للحاكم ج4 ص27 والبحار ج20 ص290 ومستدرك سفينة البحار
ج4 ص27 والمنتخب من ذيل المذيل ص101 والبداية والنهاية ج4 ص182
وموسوعة التاريخ الإسلامي ج2 ص582 وإعلام الورى ج1 ص196 و 197
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص303 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص347
وج11 ص210 و211.
([35])
البحار ج21 ص40 عن مشارق أنوار اليقين، والسيرة الحلبية ج3 ص44
وحلية الأبرار ج2 ص161 ومدينة المعاجز ج1 ص426 وشجرة طوبى ج2
ص293 ومجمع النورين ص177.
([36])
السيرة الحلبية ج3 ص44 ومجمع الزوائد ج9 ص15 و 251 و 252
والآحاد والمثاني ج5 ص445 ومسند أبي يعلى ج13 ص37 و 38 والمعجم
الأوسط ج6 ص345 والمعجم الكبير ج24 ص67 وكنز العمال ج13 ص637
وتاريخ مدينة دمشق ج3 ص385 وفتوح البلدان ج1 ص27 وعن البداية
والنهاية ج4 ص227 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص378 وسبل
الهدى والرشاد ج11 ص215.
([37])
السيرة الحلبية ج3 ص44 وعن الإصابة ج8 ص210 وعن الطبقات الكبرى
ج8 ص121.
([38])
السيرة الحلبية ج3 ص44 وعن البداية والنهاية ج4 ص242 وعن
السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص802 وعن عيون الأثر ج2 ص402
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص402.
|