|
خالد يبيد بني جذيمة
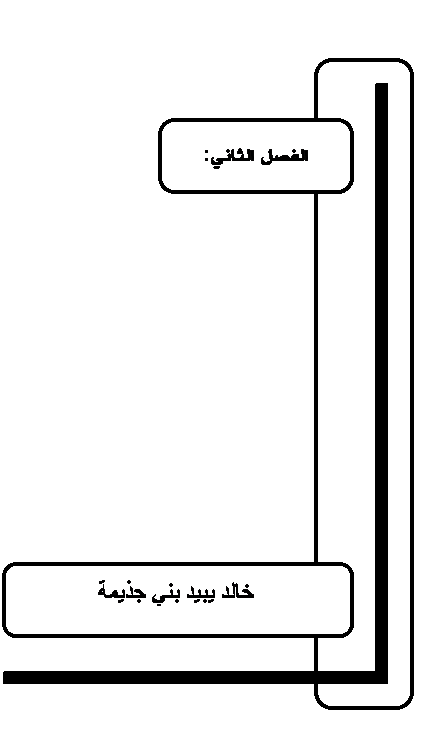
وذكروا:
أن قصة بني جذيمة قد حصلت بعد الفتح.
قال البلاذري:
إنها كانت في شوال([1]).
وقالوا:
كان بنو جذيمة ـ وهم قبيلة من عبد القيس أسفل مكة
بناحية يلملم ـ وقد كانوا أصابوا في الجاهلية من بني المغيرة نسوة،
وقتلوا عمّ خالد، فأرسل إليهم النبي «صلى الله عليه وآله» خالد بن
الوليد، بعد أن رجع من هدم العزى، داعياً لا مقاتلاً([2]).
فاستقبلوه وعليهم السلاح، وقالوا:
يا خالد، إنَّا لم نأخذ السلاح على الله وعلى رسوله،
ونحن مسلمون، فانظر، فإن كان بعثك رسول الله «صلى الله عليه وآله»
ساعياً فهذه إبلنا وغنمنا فاغد عليها.
فقال:
ضعوا السلاح.
قالوا:
إنَّا نخاف منك أن تأخذنا بإحنة الجاهلية، وقد أماتها
الله ورسوله.
فانصرف عنهم بمن معه، فنزلوا قريباً، ثم شن عليهم
الخيل، فقتل وأسر منهم رجالاً.
ثم قال:
ليقتل كل رجل منكم أسيره.
فقتلوا الأسرى.
وجاء رسولهم إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
فأخبره بما فعل خالد بهم، فرفع «عليه السلام» يده إلى السماء وقال:
«اللهم إني أبرء إليك مما فعل خالد».
وبكى، ثم دعى علياً «عليه السلام»،
فقال:
اخرج إليهم، وانظر في أمرهم. وأعطاه سفطاً من ذهب، ففعل
ما أمره، وأرضاهم([3]).
وروى ابن إسحاق، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي
الله عنهم ، ومحمد بن عمر عن ابن سعد، قال: بعث رسول الله «صلى الله
عليه وآله» خالد بن الوليد ـ حين افتتح مكة ـ داعياً ولم يبعثه
مقاتلاً، وبعث معه ثلاثمائة وخمسين رجلاً من المهاجرين والأنصار (ومعه
قبائل من العرب) سليم بن منصور، ومدلج بن مرة، فوطئوا بني جذيمة (بن
عامر بن عبد مناة بن كنانة) فلما رآه القوم أخذوا السلاح، فقال خالد:
ما أنتم؟
قالوا:
مسلمون، قد صلينا، وصدقنا، وبنينا المساجد في ساحاتنا،
وأذَّنَّا فيها.
قال:
فما بال السلاح عليكم؟
قالوا:
«إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونوا
هم، فأخذنا السلاح».
فقال خالد:
ضعوا السلاح، فإن الناس قد أسلموا([4]).
فقال رجل من بني جذيمة، يقال له:
جحدم: «إنه والله خالد. وما يطلب محمد من أحد أكثر من
أن يقر بالإسلام، ونحن مقرون بالإسلام، وهو خالد، لا يريد بنا ما يراد
بالمسلمين»([5]).
«ويلكم يا بني جذيمة، إنه خالد، والله ما بعد وضع
السلاح إلا الأسار، وما بعد الأسار إلا ضرب الأعناق، والله لا أضع
سلاحي أبداً».
فأخذه رجال من قومه، فقالوا:
«يا جحدم، أتريد أن تسفك دماءنا؟ إن الناس قد أسلموا،
ووضعت الحرب أوزارها، وأمن الناس».
فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه، ووضع القوم السلاح لقول
خالد([6]).
وقال أبو جعفر، محمد بن علي رضي
الله عنهم:
فلما وضعوا السلاح أمرهم خالد عند ذلك، فكتفوا، ثم
عرضهم على السيف، فقتل من قتل منهم([7]).
وقالوا:
فلما كان السحر نادى خالد: من كان معه أسير فليدافه.
والمدافة الإجهاز عليه بالسيف.
وفي المواهب اللدنية:
من كان معه أسير فليقتله.
فأما بنو سليم فقتلوا كل من كان في أيديهم.
وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أساراهم([8]).
وعن إبراهيم بن جعفر المحمودي، قال:
قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «رأيت كأني لقمت
لقمة من حيس، فالتذذت طعمها، فاعترض في حلقي منها شيء حين ابتلعتها،
فأدخل عليٌّ يده، فنزعه».
فقال أبو بكر الصديق:
يا رسول الله، هذه سرية من سراياك، تبعثها فيأتيك منها
بعض ما تحب، ويكون في بعضها اعتراض، فتبعث علياً فيسهله([9]).
قال ابن إسحاق:
ولما أبى جحدم ما صنع خالد، قال: يا بني جذيمة ضاع
الضرب، قد كنت حذرتكم ما وقعتم فيه([10]).
قال:
وحدثني أهل العلم: أنه انفلت رجل من القوم، فأتى رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، فأخبره الخبر، فقال رسول الله «صلى الله
عليه وآله»: «هل أنكر عليه أحد»؟
قال:
نعم، قد أنكر عليه رجل أبيض، ربعة، فنهمه خالد، فسكت
عنه.
وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب، فراجعه، فاشتدت
مراجعتهما.
فقال عمر بن الخطاب:
يا رسول الله، أما الأول فابني عبد الله، وأما الآخر،
فسالم مولى أ بي حذيفة([11]).
قال عبد الله بن عمر في حديثه
السابق:
«فلما قدمنا على رسول الله «صلى الله عليه وآله» ذكرنا
ذلك له، فرفع يديه وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد». مرتين([12]).
قال أبو جعفر، محمد بن علي رضي الله
عنهم:
فدعا رسول الله «صلى الله عليه وآله» علي بن أبي طالب
رضوان الله عليه، فقال: «يا علي، اخرج إلى هؤلاء القوم، فانظر في
أمرهم، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك».
فخرج علي «عليه السلام» حتى جاءهم، ومعه مال قد بعث به
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فودى لهم الدماء، وما أصيب لهم من
الأموال، حتى إنه لودى لهم ميلغة الكلب، حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا
مال إلا وداه، بقيت معه بقية من المال، فقال لهم عليٌّ حين فرغ منهم:
«هل بقي لكم مال لم يؤد إليكم»؟
قالوا:
لا.
قال:
فإني أعطيكم من هذه البقية من هذا المال، احتياطاً
لرسول الله «صلى الله عليه وآله» مما لا يعلم ومما لا تعلمون».
ففعل، ثم رجع إلى رسو ل الله «صلى الله عليه وآله»،
فأخبره الخبر فقال: «أصبت وأحسنت».
ثم قام رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فاستقبل القبلة
قائماً شاهراً يديه، حتى إنه ليرى ما تحت منكبيه، يقول: «اللهم إني
أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد». ثلاث مرات([13]).
وذكر الواقدي:
أن علياً «عليه السلام» جاءهم بالمال الذي أعطاه إياه
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فودى لهم ما أصاب خالد، ودفع إليهم ما
لهم، وبقي لهم بقية من المال، فبعث علي «عليه السلام» أبا رافع إلى
رسول الله «صلى الله عليه وآله» ليستزيده، فزاده مالاً، فودى لهم كل ما
أصاب([14]).
ولما رجع علي «عليه السلام» إلى رسول الله «صلى الله
عليه وآله» قال له: ما صنعت يا علي؟!
فأخبره، وقال:
يا رسول الله، قدمنا على قوم مسلمين، قد بنوا المساجد
بساحتهم، فوديت لهم كل من قتل خالد حتى ميلغة الكلاب الخ..([15]).
وقال بعض بني جذيمة أبياتاً يذكر فيها غدر خالد بهم،
ومنها:
ولولا مقال القوم للقوم
أسلـموا للاقـت سليـم يوم ذلك ناطحــا
لما صعهم بشر وأصحاب جحدم ومرة حتى يتركوا البرك ناضحا([16]).
قال ابن عبد البر عن قصة خالد هذه:
«وخبره في ذلك (بذلك) من صحيح الأثر»([17]).
وبعد..
فإن مهمة سرية الدعوة هي التلطف في توضيح الحقائق
للناس، وإقناعهم، بإيراد الدلائل والشواهد التي تقطع كل عذر..
فما معنى:
أن يسأل الرجل عن دينه، هل هو كافر أو مسلم، حتى إذا
قال: إن كنت كافراً فمه.
فيقال له:
إن كنت كافراً قتلناك.
ثم يقتلونه، من دون أن يعرضوا عليه أي شيء من دعوة
الإسلام؟!
بل إنهم ليقتلونه حتى بعد أن عرفوا:
أنه عشق امرأة فلحقها..
ولم يمهلوه إلا بمقدار أن يلقي عليها نظرة واحدة، ثم
يقدموه للقتل.
فعن ابن أبي حدرد الأسلمي، وعن عبد الله بن عصام
(المزني) عن أبيه، وعن ابن عباس: قال ابن أبي حدرد: كنت يومئذٍ في خيل
خالد بن الوليد.
وقال عصام:
لحقنا رجلاً فقلنا له: كافر، أو مسلم؟
فقال:
إن كنت كافراً فمه؟
قلنا له:
إن كنت كافراً قتلناك.
قال:
دعوني أقضي إلى النسوان حاجة.
وقال ابن عباس:
فقال: إني لست منهم، إني عشقت امرأة، فلحقتها، فدعوني
أنظر إليها نظرة، ثم اصنعوا بي ما بدا لكم.
وذكر الواقدي ما ملخصه:
أن بني سليم طاردوا غلاماً ليقتلوه، فقتل منهم رجلين،
ولم يقدروا عليه. ثم ظهر لهم في اليوم التالي، وطلب الأمان، وعرض فرسه،
فعرفه بنو سليم أنه غريمهم بالأمس، فناوشوه عامة النهار، حتى أعجزهم،
وكر عليهم، ثم عرض عليهم ان يعطوه عهد الله وميثاقه إذا نزل أن يصنعوا
به ما يصنعون بالظعن، فإن قتلوهن قتلوه، وإن استحيوهن استحيوه، فأعطوه
ذلك. وكانت النساء والذرية في يد خالد..
فلما نزل غدروا به، وجعلوه مع الأسرى من الرجال، فطلب
منهم أن يأخذوا برمته إلى نسيات هناك، ثم يردونه([18]).
قال ابن أبي حدرد:
فقال فتى من بني جذيمة ـ وهو في سني وقد جمعت يداه إلى
عنقه برمة، ونسوة مجتمعات غير بعيد منه ـ يا فتى.
فقلت:
ما تشاء؟
قال:
هل أنت آخذ بهذه الرمة، فقائدي إلى هؤلاء النسوة حتى
أقضي إليهن حاجة، ثم تردني بعد فتصنعوا بي ما بدا لكم؟
قال:
قلت: والله ليسير ما طلبت.
فأخذت برمته، فقدته بها حتى أوقفته عليهن.
فدنا إلى امرأة منهن.
قا ل ابن عباس:
فإذا امرأة طويلة أدماء، فقال: اسلمي حبيش على نفد من
العيش.
أريـتـك إذ
طالبتكم فوجـدتكـم بحلـيـة أو ألفـيـتـكم بـالخـوانـق
ألم يــك أهــلاً أن يـنول عاشـق تـكلف إدلاج السـرى
والـودائـق
فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا معـا أثيـبـي بود قبل إحـدى
الصفـائق
أثيبي بود قبل أن يشحط النـوى ويـنـأى لأمـر
بالحـبـيـب المفارق
زاد ابن إسحاق، ومحمد بن عمر:
فـإني لا ضـيـعـت سـر أمـانـــة
ولا راق عيني عنـك بعـدك رائـق
سوى أن ما نال العشيرة شـاغـل عن الـود إلا أن يـكـون
الـتـوامق
قال ابن هشام:
وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر البيتين الأخيرين منها له.
انتهى.
فقالت:
نعم، وأنت فحييت سبعاً وعشراً وتراً، وثمانياً (ثمانين)
تترى.
قال ابن أبي حدرد:
ثم انصرفت به، فضربت عنقه.
وقال عصام:
فقربناه، فضربنا عنقه، فقامت المرأة إليه حين ضربت
عنقه، فأكبت عليه، فما زالت تقبله حتى ماتت عليه([19]).
وقال ابن عباس:
فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت.
فلما قدموا على رسول الله «صلى الله عليه وآله» أخبره
الخبر، فقال: «أما كان فيكم رجل رحيم»؟([20]).
ونحن نكتفي هنا بذكر ثلاثة أمور هي التالية:
إن ما صنعه هذا الفتى من بني جذيمة، يثير إعجاب كل منصف
أريب، وعاقل لبيب، يعطي القيمة لصفات الرجولة، والشجاعة والشمم، فهو قد
دافع عن نفسه دفاع الأبطال، وأعرب عن شجاعة وبسالة رائعة.
ثم هو قد أعرب عن احترامه للعهود والمواثيق، وألزم نفسه
بها، رغم أنه يعرف أن الذين يحاربون، ويطاردونه، إنما يفعلون ذلك
عدواناً وتجبراً، وبلا أي مبرر.
وقد كان بإمكان هذا الفتى أن ينجو بنفسه،ولكن محبته
لتلك المرأة، وسكونه إلى العهد الذي أخذه من محاربيه، هو الذي دفعه إلى
هذا الاستسلام النبيل.
ولكن هذا الفتى لم يلق من محاربيه ما توقعه من وفاء
بعهود الله ومواثيقه، بل وجد الغدر اللئيم، والفعل الذميم، مع أن هؤلاء
قد وطأوا تلك البلاد على أساس أنهم دعاة للإسلام، ويريدون تقديم صورة
مشرقة ومشرِّفة عن هذا الدين.
وبعد.. فإن من البديهي:
أن للإنسانية سماتها وتجلياتها، التي تتناسب مع
حقيقتها. وأن العاطفة والرحمة الإنسانية هي إحدى هذه السمات، وتوهجها
يكون من هذه التجليات..
وحين تُفْقَدُ الرحمة، فإن الإنسانية تفقد معناها
ومغزاها، ولابد أن ينتقص تبعاً لذلك كل ما يرتبط بذلك من حقوق،
وامتيازات، وأن ينحط ما نشأ عنها من مقامات ودرجات.
وحين تجلت سمات الإنسانية في علي «عليه السلام» لكل أحد
بالتصدق بالخاتم بالصلاة، أعلن الله تعالى له أعظم مقام، ألا وهو مقام
الولاية العظمى على البشر، في قوله تعالى:
{إِنَّمَا
وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ
يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}
([21]).
وحين ظهر الخلل في معنى الرحمة الإنسانية في ذلك
{الَّذِي
يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ}.
جاء الإعلان الإلهي: بأن ذلك من سمات ذلك
{الَّذِي
يُكَذِّبُ بِالدِّينِ}..
وأن ذلك من شأنه ان يخل حتى بالتكوين الفكري والاعتقادي.. إلى حد انه
ينتهي بما يوجب خروجه عن الدين والإيمان، قال تعالى:
{أَرَأَيْتَ
الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ
وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ}
([22]).
ولأجل ذلك..
جاء الإستفهام الإنكاري الذي يشير إلى فقدان سمات الإنسانية لدى هؤلاء،
فلا جرم أن تصدر منهم هذه الأعمال الفظيعة والشنيعة.
عن سلمة بن الأكوع، قال:
قدم خالد بن الوليد على النبي «صلى الله عليه وآله» بعد
ما صنع ببني جذيمة ما صنع، وقد عاب عبد الرحمن بن عوف على خالد ما صنع.
قال:
يا خالد، أخذت بأمر الجاهلية في الإسلام، قتلتهم بعمك
الفاكه؟! وأعانه عمر بن الخطاب على خالد.
فقال خالد:
أخذتهم بقتل أبيك([23]).
وفي لفظ:
فقال: إنما ثأرت بأبيك([24]).
فقال عبد الرحمن:
كذبت والله، لقد قتلت قاتل أبي([25])،
وأشهدت على قتله عثمان بن عفان.
ثم التفت إلى عثمان، فقال:
أنشدك الله، هل علمت أني قتلت قاتل أبي؟
فقال عثمان:
اللهم نعم.
ثم قال عبد الرحمن:
ويحك يا خالد، ولو لم أقتل قاتل أبي أكنت تقتل قوماً
مسلمين بأبي في الجاهلية؟
قال خالد:
ومن أخبرك أنهم أسلموا؟
فقال:
أهل السرية كلهم يخبرونا أنك قد وجدتهم بنوا المساجد،
وأقروا بالإسلام، ثم حملتهم على السيف.
قال:
جاءني رسول رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن أغير
عليهم.
وعند ابن إسحاق (وقد قال بعض من
يعذر خالداً أنه) قال:
ما قاتلت حتى أمرني بذلك عبد الله بن حذافة السهمي،
وقال: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم
من الإسلام، انتهى([26]).
فقال عبد الرحمن:
كذبت على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وغالظ عبد
الرحمن.
قال ابن إسحاق:
فبلغ ذلك رسول الله «صلى الله عليه وآله»([27]).
انتهى.
فأعرض رسول الله «صلى الله عليه وآله» عن خالد، وغضب
عليه، وقال: «يا خالد، ذر لي أصحابي، متى ينكأ المرء؟ ينكأ المرء ولو
كان لك أحد ذهباً تنفقه قيراطاً قيراطاً في سبيل الله لم تدرك غدوة أو
روحة من غدوات أو روحات عبد الرحمن»([28]).
أو:
لم تدرك غدوة أحدهم ولا روحته.
وعند ابن إسحاق:
غدوة رجل من أصحابي([29]).
وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري،
قال:
كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء،
فسبه خالد، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «لا تسبوا أصحابي فإن
أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»([30]).
ولنا مع هذه النصوص وقفات عديدة نذكر منها ما يلي:
ونقول:
تقدم اعتراض عمر وعبد الرحمن بن عوف، وسالم مولى أبي
حذيفة، وكذلك عبد الله بن عمر على خالد..
وسيأتي الحديث عن اعتراض عمار عليه أيضاً.
غير أن لاعتراض عبد الرحمن بن عوف، وعمار بن ياسر أهمية
خاصة هنا..
فأما بالنسبة لعمار، فلأن له خصوصيته،
ومقامه،
وموقعه المتميز فيما بين المسلمين، ولدى الصفوة من أصحاب
رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
وسنشير إلى اعتراضه هذا فيما يأتي إن شاء الله تعالى.
وأما اعتراض عبد الرحمن بن عوف، فأهميته تكمن في أنه
يأتي من إنسان له ثأر عند بني جذيمة، علماً بأن المقتول هو أبوه. والأب
أقرب إلى الإنسان من العم، فإذا كان من قتل أبوه وهو ولي دمه يؤنب
خالداً على ما فعل.. فكيف يمكن أن يعذر خالد فيما أقدم عليه، وليس هو
ولي الدم، وإنما هو مجرد معتدٍ متعمدٍ للباطل، طامح للجريمة؟!
وهناك أمر آخر، وهو:
أن إرسال خالد وابن عوف لدعوة بني جذيمة وغيرهم إلى
الله تعالى، من شأنه أن يطمئن أولئك الناس إلى أن أمر الجاهلية قد
انتهى، وأن أحداً لا يؤخذ بإحنة، ولا يلاحق بجريرة، وأن المنطقة بأسرها
قد دخلت في عهد جديد، ينعم الناس فيه بالأمن، والسلام، والسلامة في
الدين، وفي الدنيا..
ولو أن آخرين جاؤوا لدعوة بني جذيمة إلى الإسلام، فإنهم
لن يقتنعوا بأن من لهم عندهم ثارات قد تخلوا عن الطلب بها..
وذلك كله يظهر:
أنه لا مناص من إرسال خالد، وابن عوف.
قال الشيخ المفيد «رحمه الله» عن
إرسال خالد إلى بني جذيمة:
إنه
«صلى الله عليه وآله»
أرسله إليهم
«يدعوهم
إلى الله عز وجل. وإنما أنفذه إليهم للترة التي كانت بينه وبينهم، وذلك
أنهم كانوا أصابوا في الجاهلية نسوة من بني المغيرة، وقتلوا الفاكه بن
المغيرة، عم خالد بن الوليد، وقتلوا أبا عبد الرحمن بن عوف للترة
أيضاً، التي كانت بينه وبينهم.
ولولا ذلك ما رأى رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
خالداً أهلاً للإمارة على المسلمين»([31]).
أي وكان عليه
«صلى الله عليه وآله»
أن يتعامل مع الأمور وفق ظواهرها.. وليس وفق ما يطلع عليه من غيب، لا
يتيسر لغيره الاطلاع عليه.. كما أشرنا إليه غير مرة.
ولكن ما صنعه خالد قد ضيع الأهداف التي توخاها رسول
الله
«صلى الله عليه وآله»
من إرساله.. وخالد هو الذي يتحمل مسؤولية ما صنع، ولذلك برئ
«صلى الله عليه وآله»
إلى الله من فعله ثلاث مرات.
النبي
 نصير
المظلومين: نصير
المظلومين:
ولكن علياً
«عليه
السلام»
قد رتق ذلك الفتق، واصلح ما أفسده خالد، وبيّن لبني جذيمة وللعرب
جميعاً، ولغيرهم: أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
لا يمكن أن يكون نصيراً للظالمين، بل هو مع المظلوم في السراء والضراء،
وفي الشدة والرخاء، ينصره بيده، وبلسانه، وبماله، وبجاهه، وبكل ما يقدر
عليه..
وقد تقدم في النص المتقدم ذكر:
الغميصاء:
وهي موضع في بادية العرب قرب مكة كان يسكنه بنو جذيمة
بن عامر.
وقوله:
ما أنتم؟ قال: في النهر. الظاهر: أنه سألهم عن صفتهم.
أي مسلمون أنتم أم كفار؟ ولهذا أتى بما، ولو أراد غير ذلك لقال: من
أنتم؟ وقد استعمل «ما» فيمن يعقل وهو شائع.
قد يقول قائل:
إنه إذا كانت هذه سرية دعوة لا سرية قتال، فلماذا هذه
الكثرة في عدد أفرادها؟!
ويمكن أن يجاب:
بأن سرية الدعوة قد تحتاج ايضاً إلى من يحميها من تآمر
المتآمرين،
ومغامرة الطائشين، والذين يريدون إثارة الفتن، ويرون ان من مصلحتهم
إبقاء
التوتر مهيمنا على الاجواء العامة، فيبادرون الى الاخلال بالأمن،
ثم يتحينون الفرصة، فقد تأتي الأيام بمفاجآت يمكنهم من خلالها تحقيق
بعض ما يصبون إليه..
على أن الدعوة أيضاً قد تحتاج إلى أناس كثيرين يتفرقون
في الأحياء، وفي القبائل، وفي الأرياف، والقرى، ويحاولون إقناع الناس،
أفراداً وجماعات، بالحق.. ويقدمون لهم الدلائل والشواهد المختلفة.
وقد يسأل سائل أيضاً:
عن السبب في
إرسال سرايا للدعوة،
في حين أن السرايا الأخرى تتخذ عادة منحى
قتالياً،
أو استطلاعياً وقائياً..
ويجاب:
بأن فتح مكة قد فرض هذا الإجراء،
فلم يعد للمشركين قدرة على المواجهة،
فقد
أصبح
من الضروري تعريف الناس بدعوة الإسلام،
لتسهيل إعلانهم الدخول فيه، حتى لا يبقى الناس في ذلك المحيط مذبذبين
بين الإتجاهات المختلفة، فإن تحديد انتمائهم أمر مهم جداً في تحقيق
الإستقرار النفسي، والانضباط الإجتماعي والسياسي في المنطقة بأسرها.
إذا كانت البعثات تهدف إلى تحديد هذا الإنتماء، فإن من
الضروري: أن تكون بقيادة شخصيات قرشية، بل الأولى هو: أن تكون من
الأشخاص الذين يخاف الناس بطشهم، ونكايتهم،
لأن
الدعوة
إذا جاءت
من قبل خصوص هؤلاء، فذلك يدعو الناس للإطمينان إلى أن
دخولهم في هذا الدين ليس فيه أية خطورة
عليهم،
ولا يعد مغامرة، وتعريضاً لأنفسهم لخطر أخذهم على حين غرة من قبل
جبابرة الجاهلية وطغاتها..
وقد كان خالد هو أحد هؤلاء الذين لا مناص من الإستفادة
منهم في هذا المجال. وأية شخصية أخرى، فإنها لا تستطيع أن تقوم بهذه
المهمة، ولا توجب الاستجابة لدعوتها أية سكينة أو طمأنينة عند الناس.
وقد أظهر كلام جحدم:
أن خالداً كان معروفاً بغدراته، وأن الاستسلام له يحمل
أخطار الغدر بهم..
وهذا يدل على:
أن غدر خالد، إنما كان سجية له، فلا مجال لأن يحسب ذلك
على الإسلام، أو ينسب إليه.
ولعل الذي عزز خوف جحدم بالإضافة إلى معرفته بخالد،
وبسجاياه معرفته أيضاً: بأن لخالد ثاراً جاهلياً على بني جذيمة، لا بد
أن يطلبه منهم، خصوصاً.. وأن خالداً كان حديث الإسلام، ولم يدخل
الإسلام عن قناعة وإنما رهبة من عواقب الإصرار على المناوأة، ورغبة
بالحصول على شيء من حطام الدنيا.
فمن أجل ذلك كله:
دعا جحدم قومه إلى الحذر من استدراج خالد لهم. تمهيداً
للإنتقام منهم.
قد تقدم:
أن بني جذيمة قد صرحوا: بأنهم مسلمون. فما معنى
ادِّعاء: أنهم لم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، بل قالوا: صبأنا.
فعن ابن عمر:
أن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
بعث خالداً إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا:
أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع
إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا
أسيره.
قال ابن عمر:
فقلت: والله، لا أقتل أسيري، ولا
يقتل أحد من أصحابي أسيره([32]).
ونقول:
إن من الواضح:
أن كلمة أسلمنا هي كلمة عربية، لا يجهلها، ولا يعجز عن
التلفظ بها أحد من العرب.
وهي ليست اسماً لشيء بعينه، ولا هي اشتقاق خاص، يمكن أن
يتحاشاه بنو جذيمة، دون غيرهم.. فإن كانوا يتحاشون من استعمال هذه
الكلمة، فإن ذلك كان بعد ظهور الإسلام، حيث إن تحاشيهم لها لا يزيد عن
تحاشي سائر القبائل العربية، التي حاربت الإسلام والمسلمين.
وحتى لو كان لهم حساسية خاصة، وهجران قوي لهذه الكلمة
بالذات، فإن ذلك لا يمنعهم من النطق بها عند الضرورة، وحيث يوجب
إصرارهم على تركها قتلهم.. فإن بإمكانهم تقليد الآخرين في نطقها، ولو
مثل تقليد غير العربي للعربي في نطق الألفاظ العربية..
ولنفترض:
أنهم رفضوا الإسلام حقاً، فبأي حق يقاتلهم خالد،
ويقتلهم، ويأسرهم، ثم يقتل الأسرى منهم؟!
على أنهم يقولون:
إن القوم قد صرحوا: بأنهم مسلمون، وبأنهم قد أذنوا
وصلوا، وبنوا المساجد في ساحاتهم، فما هو المبرر لقتلهم بعد هذا كله؟!
إن خالداً يعترف لابن عوف:
بأنه قتل بني جذيمة انتقاماً منهم، لقتلهم عوفاً أبا
عبد الرحمن بن عوف، ولكن ابن عوف يرفض ذلك، ويقول له: إنه قد قتلهم
بعمه الفاكه بن المغيرة، ويسكت خالد عن إجابته، حيث لم يجد ما يدافع به
عن نفسه.
كما أن الروايات قد صرحت:
بأنه قتلهم كان على دفعتين:
الأولى:
حين زعم أنهم لم يسلموا.
والثانية:
حين قتل من أسرهم منهم.
ولكن خالداً زعم:
أن رسولاً قد أتاه بأمر من النبي «صلى الله عليه وآله»
نفسه يطلب منه أن يقتلهم.
فقال له عبد الرحمن بن عوف:
كذبت على رسول الله «صلى الله عليه وآله».
وقد بلغ ذلك رسول الله «صلى الله عليه وآله» ولكنه لم
ينصر خالداً، ولم يصدقه فيما ادَّعاه، بل أظهر غضبه منه، وأعرض عنه،
وانتصر لعبد الرحمن بن عوف..
على أن الروايات الأخرى قد صرحت
بأنهم قالوا:
إنهم مسلمون، وإنهم يصلون، ويؤذنون، وقد بنوا المساجد،
وقد صلوا مع خالد مرتين.. قبل أن يوقع بهم كما ذكرته الرواية الصحيحة
عن الإمام الباقر «عليه السلام»([33]).
ثم إن الأسرى كانوا يصلون حتى في حال أسرهم قبل أن يأمر
خالد بقتلهم.
قال الواقدي:
«وباتوا في وثاق، فكانوا إذا جاء وقت الصلاة يكلمون
المسلمين، فيصلون ثم يربطون، فلما كان وقت السحر، والمسلمون قد اختلفوا
بينهم، فقائل يقول: ما نريد بأسرهم؟! نذهب بهم إلى النبي «صلى الله
عليه وآله»، وقائل يقول: ننظر: هل يسمعون أو يطيعون، ونبلوهم، ونخبرهم.
والناس على هذين القولين الخ..»([34]).
وقد واجه عبد الرحمن بن عوف خالداً بهذه الحقيقة، ولم
يستطع أن ينكرها، فادَّعى: أن النبي «صلى الله عليه وآله» أمرهم
بقتلهم.
وقد كذبه عبد الرحمن بن عوف في دعواه هذه.
فلماذا يتجرأ خالد على مقام النبوة، وينسب إلى نبي الله
تعالى الكذب؟! وكيف يمكن أن تقول فئة من الناس: إن خالداً من الصحابة
العدول، وهو يقتل الأبرياء، ويكذب على رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
أو يسب أصحابه؟!
تقدم:
أن خالداً قال لعبد الرحمن بن عوف، حين لامه على فعلته:
إنما ثأرت بأبيك.
وهذا معناه:
أن الأمر لم يكن مجرد حصول اشتباه في فهم كلمة: «المدافة»
التي أطلقها خالد ـ حسب زعمهم ـ لأصحابه في وقت السحر.. بل كان قتلاً
مقصوداً ومتعمداً..
ومع غض النظر عن ذلك، إذا كان هؤلاء القوم مسلمين،
ويصلون ويؤذنون، وقد بنوا المساجد في الساحات، فما هو الداعي إلى
أسرهم، وشد أكتافهم، وتسليمهم لأصحابه؟! ألا يعد هذا غدراً ظاهراً
بهم؟!
وألم يكن بإمكان خالد أن يستغني عن أسرهم بأن يتحقق من
صحة ما ادَّعوه: من أنهم يصلون، ويؤذنون، وأنهم أقاموا المساجد في
ساحاتهم؟! فيطلب منهم أن يصلوا أمامه، وأن يؤذنوا، وأن يدلوه على
المساجد التي أقاموها ليراها بنفسه.
وأما زعمه:
أنه قتلهم انتقاماً للفاكه بن المغيرة، فهو غريب وعجيب
من إنسان ينسب نفسه إلى الإسلام!! فإن الفاكه قد قتل في الجاهلية، وهو
مشرك مهدور الدم، ولعله كان هو المعتدي عليهم، أو كان قد قتل ثأراً لدم
قتيل آخر. ولا شيء يثبت أنه قتل مظلوماً.
على أن المؤرخين قد صرحوا:
بأن بني جذيمة قد دفعوا دية الفاكه ودية عوف إلى قريش.
فلماذا يعود عبد الرحمن بن عوف لقتل قاتل أبيه، وهو قد
أخذ ديته، ثم يعود خالد لقتل أربع مائة غلام من بني جذيمة([35]).
وحتى لو قتل مظلوماً، فإن الإسلام يجب ما قبله.
ولو أراد النبي «صلى الله عليه وآله» أن يؤاخذ الناس
بما صدر منهم قبل إسلامهم لقتل معظم الناس، بل لوجب قتل الناس كلهم،
لأن جريمة الشرك نفسها تقتضي قتلهم. فضلاً عما سوى ذلك مما ارتكبوه، أو
مارسوه..
ولنفترض:
أن قاعدة الإسلام يجب ما قبله، قد عطلت بالنسبة لمن
يقتل مظلوماً، إذا أصر ولي الدم على الإنتقام.. فإن ذلك أيضاً لا يبرر
ما فعله خالد لعدة أسباب:
أحدها:
أن خالداً لم يكن ولي دم الفاكه بن المغيرة.
الثاني:
أن عليه أن يرفع الأمر إلى رسول الله «صلى الله عليه
وآله».
الثالث:
أن عليه أن يقتصر على قتل القاتل نفسه دون سواه،
الرابع:
أن لا يتعدى القتل إلى التمثيل أو التعذيب في الكيفية
التي يجريها.
1 ـ
تقدم: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال لخالد حين
تلاحى مع عبد الرحمن بن عوف دعوا لي أصحابي. أو لا تسبوا أصحابي.
ولعل هذه هي الرواية الصحيحة.
وسواء أكان النبي «صلى الله عليه
وآله» قد قال:
دعوا، أو قال: لا تسبوا، فإن خالداً قد تناول شخص ذلك
الصحابي، وآذاه بلسانه، ولم يكن خالد يتورع عن سب أصحاب النبي «صلى
الله عليه وآله».
2 ـ
قد يقال: إن هذه الكلمة تشير إلى أن النبي «صلى الله
عليه وآله» لا يعد خالداً من أصحابه، فضلاً عن أن يكف عنهم لسانه،
وسبَّه.
فدعوى:
أن كل من رأى النبي «صلى الله عليه وآله» مميزاً فهو
صحابي تصبح موضع ريب.
ويدل على ذلك:
أن قوله في الرواية نفسها: إن أحدكم لو أنفق مثل أحد
ذهباً ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفه، فإن هذا الخطاب يشمل خالداً بلا
ريب، فلو أنه كان هو من الصحابة لم يكن معنى لخطابه بمثل هذا الكلام.
3 ـ
إن ابن عوف، وإن كان في ذلك الوقت ممن يصح أن يعد من
أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولكن لا يعني بقاءه وكذلك سائر
أصحابه «صلى الله عليه وآله» على حال الإستقامة بعد وفاته أيضاً.
ويدل على ذلك حديث:
ليردن علي الحوض أقوام، فيختلجون دوني، فأقول: رب
أصحابي.
فيقال:
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
وفي بعض نصوص الحديث:
إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقري،
زاد في بعضها قوله:
فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم([36]).
وإذا راجعنا نصوص ما جرى من خالد على مالك بن نويرة
وأصحابه، وعلى بني جذيمة، فإننا نشهد ظاهرة مثيرة وهي: أن ثمة تشابهاً
في عرض ما جرى بين القضيتين في عدة مفاصل أساسية.
فقد رأوهم يصلون، ويؤذنون في كلا الواقعتين.
وحبسوا في ليلة باردة، وقتلوا لأن خالداً أمر أصحابهم
بأن يدفئوا أسراهم، ففهموا ذلك على أنه أمر بالقتل.
وكلمة «أدفئوا في لغة كنانة تعني القتل».
وسمع خالد الواعية بعد ان فرغوا منهم.
واعترض على خالد في قتلهم رجلان،
هما:
عبد الله بن عمر، وسالم مولى أبي حذيفة في بني جذيمة،
أو عبد الله بن عمر وأبو قتادة في قصة مالك وأصحابه. وقد كره خالد
كلامهما في كلتا الحادثتين.
بل إن أبا قتادة قد عاهد الله أن لا يشهد مع خالد حرباً
أبداً بعد قصة مالك بن نويرة.
وتذكر رواية قصة مالك أيضاً:
سياقاً يتوافق كثيراً مع سياق قصة بني جذيمة، فإن أصحاب
خالد واجهوا أصحاب مالك تحت الليل، فأخذ أصحاب مالك السلاح، فقال أصحاب
خالد: إنَّا مسلمون.
فقالوا:
ونحن المسلمون.
قلنا:
فما بال السلاح معكم؟
قالوا:
فما بال السلاح معكم؟
قلنا:
فإن كنتم كما تقولون، فضعوا السلاح.
فوضعوا السلاح لقول خالد الخ..([37]).
وهذا السياق بعينه موجود في قصة بني جذيمة كما تقدم.
فهل سبب هذا التشابه هو:
أن محبي خالد أرادوا أن يقرنوا بين أبي بكر في نصرته
لخالد ودفاعه عنه، وبين حادثة بني جذيمة، حيث لم يقتل النبي «صلى الله
عليه وآله» خالداً حين أوقع بهم؟!
وقد ظهر في الأبيات المنقولة، خصوصاً في البيتين اللذين
قال ابن هشام: إن أهل العلم بالشعر ينكرونهما لذلك القائل، ظهر فيها
الإقواء، في القافية، فجاءت مرفوعة بدل أن تكون مكسورة، فقراءة المرفوع
مكسوراً إقواء في الشعر.
إن محبي خالد قد عذروا خالداً فيما فعله ببني جذيمة
بأنه اجتهد فأخطأ، رغم اعترافه لعمر: بأن الأمر ليس كذلك، ورغم أنه قد
اعترف لابن عوف بأنه قد قتلهم استجابة للإحن الجاهلية، فقد قال
العامري:
«وإنما أنكر النبي «صلى الله عليه وآله» على خالد، لأنه
لم يتثبت في أمرهم. ثم عذره في إسقاط القصاص، لأن (أي قولهم: صبأنا)
ليس تصريحاً في قبول الدين. وقد سأل عمر أبا بكر في خلافته قتل خالد بن
الوليد بمالك بن نويرة، فقال: لا أفعل، لأنه متأول الخ..»([38]).
فتراه يصرح:
بأن هذا هو نفس ما عذره به أبو بكر لقتله مالك بن نويرة
وأصحابه. ثم إقدامه على الزنى بزوجة مالك في نفس ليلة قتله، كما تنبأ
به مالك نفسه، في نفس ليلة قتله..
وعلى كل حال، فقد قالوا:
إنه لما بلغ ذلك أبا بكر وعمر، قال عمر لأبي بكر: إن
خالداً قد زنى، فاجلده.
قال أبو بكر:
لا، لأنه تأول فأخطأ.
قال:
فإنه قتل مسلماً، فاقتله.
قال:
لا، إنه تأول فأخطأ.
ثم قال:
يا عمر! ما كنت لأغمد سيفاً سله الله عليهم([39]).
ولكن ليت شعري كيف يجيب هؤلاء على الأسئلة التالية:
كيف يصح الإجتهاد مع وجود النص على أن رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، لم يرسله مقاتلاً، وإنما أرسله داعياً؟!
وكيف يصح الإجتهاد، مع النهي الصريح عن قتل المسلمين؟!
فإنه لا يحل قتل المسلم إلا في كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو
تعمده قتل مسلم([40]).
أو فساد في الأرض([41])،
وكل ذلك لم يكن..
وإذا كان بنو جذيمة لم يحسنوا أن
يقولوا:
«أسلمنا»، فقالـوا:
«صبأنـا»
ـ كما زعم أنصار خالد ومحبوه ـ فإن صلاتهم، وأذانهم، ومساجدهم شاهد صدق
على إسلامهم.
ولو قيل:
إن ذلك لا يمنع من ارتدادهم بعد صلاتهم وأذانهم، فيصح
قتلهم..
فإننا نقول:
قد تقدم:
أن خالداً قال لهم: ما أنتم؟
قالوا:
مسلمون.
ولو أنهم كانوا قد عادوا إلى الإرتداد، فلماذا اعترض
الناس على خالد حين قتلهم؟!
ولماذا غضب عليه رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!
ولماذا برئ إلى الله من فعل خالد ثلاث مرات؟!
ولماذا لامه عمر، وعبد الرحمن بن عوف، وعمار، وعبد الله
بن عمر، وسالم مولى أبي حذيفة؟!
ولماذا لم يقتل أحد من الأنصار أسيره؟!
ولماذا يعتذر خالد عن قتلهم:
بأنه يريد أخذ ثار عوف؟!
ولماذا.. ولماذا..
ومن جهة أخرى:
كيف يمكن لهؤلاء إثبات اجتهاد خالد، وهو كان حديث عهد
بالإسلام؟ إلا أن يكون هؤلاء يرون أن الإجتهاد ـ كالنبوة ـ مقام إلهي
يمنحه الله لمن يشاء!!
وأخيراً نقول:
إن زعمهم:
أن خالداً تأول فأخطأ، فيه جرأة كبيرة على خالد ـ بنظرهم طبعاً ـ وهو
ذنب يستغفرون الله منه، فقد كان ينبغي أن يقولوا فيه مثل ما قالوه في
قاتل علي أمير المؤمنين «عليه السلام»، فقد افتروا على ابن ملجم،
فزعموا: أنه مجتهد مأجور على ما فعل.
وقال محمد بن جرير الطبري في
التهذيب:
«ولا خلاف بين أحد من الأمة أن ابن ملجم قتل علياً
متأولاً مجتهداً مقدراً على أنه على صواب»([42]).
وهذا هو نفس ما عذروا به أبا الغادية قاتل عمار بن ياسر([43]).
قال الخطابي:
«يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم للعدول عن لفظ الإسلام،
ولم ينقادوا إلى الدين، فقتلهم متأولاً. وأنكر عليه النبي «صلى الله
عليه وآله» العجلة، وترك التثبت في أمرهم، قبل أن يعلم المراد من
قولهم: صبأنا»([44]).
وهو كلام بارد، وتأويل فاسد.
فأولاً:
إن مهمة خالد هي دعوتهم إلى الله تعالى، وتقريب مفاهيم
الإسلام إلى أذهانهم، وإقامة الحجة عليهم، من خلال الأدلة والشواهد.
فإن لم يرق لهم الدخول في الإسلام، فليس له أن يقاتلهم،
فضلاً عن أن يغدر بهم، ثم ياسرهم، ويعرضهم على السيف.
ثانياً:
لا ندري كيف يجوز له أو لغيره الإجتهاد في مورد يحكم
فيه العقل بلزوم الإحتياط بمراجعة النبي الكريم «صلى الله عليه وآله».
الذي لم يفوض إليه أن يعمل باجتهاده، سواء أخطأ فيه، أم أصاب.
ثالثاً:
إنه حتى لو أن خالداً لم يستعجل في أمر بني جذيمة، بل
تثبت من قصدهم بكلمة «صبأنا»، وعلم أنهم قد رفضوا الإسلام، فإن قرار
قتلهم أو استبقائهم لا يعود إليه. فالتثبت في أمرهم، ومعرفة مرادهم من
كلمة صبأنا لا يفيد في دفع اللوم عن خالد.
رابعاً:
قد تقدم: أنهم صرحوا بأنهم مسلمون، وصلوا مع خالد عدة
صلوات قبل أن يغدر بهم، وبنوا المساجد في الساحات، ورفعوا الأذان،
وكانوا بعد أسرهم يطلبون من المسلمين أن يمكنوهم من الصلاة، فكانوا
يحلونهم من كتافهم، فإذا صلوا أعادوهم إليه.
خامساً:
قد اعترف خالد لعمر، واعترف لعبد الرحمن بن عوف: بأنه
قد قتلهم لأحن، وثارات، وعصبيات جاهلية.
واعتراض عبد الرحمن بن عوف على خالد، وجواب خالد له يدل
على أن قتل بني جذيمة لم يكن بسبب الفهم الخاطئ من قبل بني كنانة، فإن
خالداً لم يعتذر بذلك، بل اعتذر بأنه أراد أن يقتل قاتل عوف والد عبد
الرحمن بن عوف.
كما أن السبب في قتلهم إن كان هو الفهم الخاطئ من قبل
بني كنانة، فإن ملامة عبد الرحمن لخالد تصبح بلا معنى، فإن الخطأ في
الفهم يعتبر عذراً مقبولاً عند الناس.
على أنه لو صح ذلك، فإن اتهام عبد الرحمن بن عوف لخالد
بأن ما فعله من أمر الجاهلية، وأنه أراد أن يأخذ بثأر عمه الفاكه بن
المغيرة يصبح من البهتان الذي يقتضي مبادرة النبي «صلى الله عليه وآله»
إلى ردع ابن عوف عنه؛ فإنه من الظلم الظاهر، ومن المنكر السافر.
وكل هذا الذي ذكرناه:
يجري أيضاً بالنسبة لاعتراض ابن عمر وسالم مولى أبي
حذيفة.. فقد كان على خالد أن يعتذر لهما: بأنه لا ذنب له فيما جرى.. بل
الآخرون هم المخطئون في فهم كلامه، فإن كان ثمة من لوم، فيجب أن يوجه
إليهم، إن صح لوم من يخطئ في فهم الكلام الموجه إليه.
إن التناقض الظاهر فيما بين الروايات في عرضها لما جرى
لبني جذيمة يشير إلى أن ثمة رغبة في تعمية الأمور، وإثارة الشبهات حول
حقيقة وحجم ما جرى، فعسى ولعل، ولعل وعسى يفيد ذلك في إعادة شيء من ماء
الوجه لخالد، ولو أمام البسطاء والسذج من الناس.
ونحن لا نريد أن نفيض في إظهار هذه التناقضات، بل نكل
ذلك إلى القارئ الكريم نفسه. فإن وضوح ذلك يدعونا إلى توفير الوقت لما
هو أهم، ونفعه أعم.
وزعموا:
أنه لما كان وقت السحر، نادى خالد: من كان معه أسير
فليدَافِّه، والمدَافَّة: الإجهاز عليه بالسيف.
ونقول:
من الذي قال:
إن كنانة والعرب حول مكة تقول: أدفئوا، بمعنى اقتلوا؟
فإننا لم نجد شاهداً على ذلك سوى ما في هذه الرواية.
غير أنهم ذكروا:
أن قولهم: أدفأ الجريح بمعنى أجهز عليه، وقالوا: إن هذه
لغة يمانية([45]).
وبنو مدلج وكنانة كانتا تعيشان في منطقة مكة، وليستا
يمانيتين.
كما أن الأسرى لم يكونوا جرحى،
ليقال:
إنهم فهموا من هذه الكلمة لزوم الإجهاز على من كان
جريحاً منهم!!
وقد صرحت الروايات:
أن الذين كانوا مع خالد بن الوليد هم:
1 ـ
من المهاجرين والأنصار.
2 ـ من بني سليم بن منصور.
3 ـ
ومن بني مدلج بن مرة.
ومن الواضح:
أن بني سليم بن منصور ينتهون إلى قيس بن عيلان بن مضر..
فأين كنانة من هؤلاء؟!
والمهاجرون هم عموماً من قريش.
والأنصار هم من الأوس والخزرج، فالذين كانوا من كنانة
هم بنو مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة، وهؤلاء قلة قليلة، يعرفون
لغة قريش، ويعرفون أن المتكلم معهم قرشي.
فلو صح:
أن أحداً من كنانة ممن كان حاضراً قد وقع في الغلط
فعلاً، فالمفروض هو: أن ينهاه رفقاؤه عن قتل أسيره، ويعرِّفوه معنى
كلام خالد.
ثم إننا لا ندري لماذا اختار خالد وقت السحر ليأمر
أصحابه بقتل أسراهم؟ هل كان يريد أن يفرغ من هذا الأمر، وحينما يكون
الأتقياء من صحابة النبي «صلى الله عليه وآله» نائمين، لا يشعرون بما
يجري، حتى يفرغ من جريمته؟!
لأن الظاهر:
أن خالداً كان يخاف من ثورة كثير من الصحابة ضده، لو
أنهم شهدوا تلك الجريمة النكراء، والفضيحة الصلعاء، والشنعاء.
ويكفي أن التاريخ لم يستطع أن يصرح لنا إلا باسم رجلين
اعترضا على خالد فيما صنع، ومن غير المعقول أن يمالئه على هذه الجريمة
ثلاث مائة وخمسون رجلاً قد صحبوا رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
وعرفوا ورأوا بعضاً من سياساته ومواقفه!!
فمن المتوقع أن يكثر المعترضون عليه، ولو لأجل التنصل
من المسؤولية عما يحدث، وتسجيل موقف رافض، ولو على مستوى الشكليات.
كما أننا نستفيد من قول رسول الله
«صلى الله عليه وآله»:
أما كان فيكم رجل رحيم؟! شاهداً ومؤيداً لما ذكرناه.
فإن الذين مارسوا القتل ـ على ما يظهر ـ قد وقع
الإختيار عليهم بعناية ودقة. أي أن خالداً قد سلم الأسرى لأناس يعرفهم
بالقسوة، وبعدم الرحمة، حسبما أشارت إليه كلمات رسول الله «صلى الله
عليه وآله».
إن من الأمور التي قررها الإسلام، وضع دماء الجاهلية،
وعدم أخذ الناس بها. ربما لأنها إنما أريقت لا لأجل إحقاق حق، وإبطال
باطل، وإنما انطلاقاً من عصبيات مقيتة وثأراً يأخذ البريء بذنب المسيء،
ونصرة لمفاهيم جاهلية وغير إنسانية.
والمتأمل في ما فعله خالد يجد:
أنه لا يخرج عن هذا السياق، إن يكن يُغرقُ فيه، ويَغرَقُ في وحوله
النتنة، وتبتهج روحه لما ينبعث منه من روائح عفنة.
ولا يشك أي مطلع منصف في أن رسول الله «صلى الله عليه
وآله» قد غضب مما جناه خالد، ولم يكتف بالإعراض، بل شفع ذلك بتكرار
البراءة إلى الله من فعله ثلاث مرات. ثم هو قد واجهه باللوم على ما بدر
منه تجاه عبد الرحمن بن عوف الذي اعترض عليه بسبب ما صدر منه.
غير أن ثمة سؤالاً يبقى بحاجة إلى جواب.. وهو:
لماذا لم يأخذ النبي «صلى الله عليه وآله» خالداً
بجريمته، ما دام أنه قد كان من المؤكد: أنه إنما قتل جماعة من
المسلمين، وأنه لم يكن صادقاً حينما ادَّعى عليهم الكفر.. وأنه قد كذب
على رسول الله «صلى الله عليه وآله» بادِّعائه: أنه «صلى الله عليه
وآله» هو الذي أمره بقتلهم؟!
ولعل الصواب أن يتضمن الجواب ما يلي:
إننا لا نريد أن نقول:
إن قتل خالد يحبط مسعى النبي «صلى الله عليه وآله»
لاستقطاب مستضعفي المنطقة، من حيث إن ذلك سيثير أمام الدعوة الإسلامية
ألف مشكلة ومشكلة، حين تتحرك زعامات قريش في إعلام مسموم، يرمي إلى
إثارة الشبهات في حقانية هذا الدين، وفي صحة قرارات النبي الكريم «صلى
الله عليه وآله»..
ولكننا نريد أن نكتفي بالقول:
بأن ادِّعاء خالد: أن بني جذيمة كانوا كفاراً حين
قتلهم، قد كان بهدف إيجاد الشبهة في أن يكون قد اشتبه عليه الأمر، فظن
كفرهم، فقتلهم.
وهو وإن كان مخطئاً في ذلك بلا ريب، إلا أن خطأه هذا لا
يبرر الاقتصاص لهم منه. بل هو يوجب أن يديهم إمام المسلمين، وهو رسول
الله «صلى الله عليه وآله» من بيت المال.
وقد بادر «صلى الله عليه وآله» إلى دفع الدية لهم،
وتعويضهم عن كل ما فقدوه.
والقرائن والدلالات وإن كانت متضافرة على تكذيب هذه
المزعمة. ولكنها مزعمة تكفي لدفع غائلة الاقتصاص من خالد، فإن الحدود
تدرأ بالشبهات.
وقد أشرنا مرات عديدة إلى:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» لا يتعامل مع الناس على
أساس علم الشاهدية، أو العلم الخاص الذي يمنحه الله تعالى إياه، وإنما
يتعامل معهم وفق ما تؤدي إليه الوسائل العادية المتوفرة لديهم، فهو
يقضي بين الناس بالأيمان والبينات، وبما يوجبه الإقرار، وما يراه
بعينه، ويسمعه بأذنه..
وتوضيح آخر نضيفه هنا، وهو:
أن خالداً، وإن كان منهياً عن القتال، لأن سريته سرية
دعوة لا سرية قتال. وقد أخطأ في قتاله لبني جذيمة بلا ريب.
ولكن هناك أمران يفرضان تعاملاً خاصاً، يتناسب مع
مقتضياتهما وهما:
أولاً:
أن المسلم لا يقتل بالكافر.. فادِّعاء كفرهم يجعل
خالداً الذي قتلهم عمداً في مأمن من القصاص. أي أن هؤلاء، وإن كانوا
مسلمين في واقع الأمر، ولكن خالداً يدَّعي: أنه إنما قتلهم لظنه فيهم
الكفر.. وهذه شبهة توجب دفع القصاص، كما قلنا.
ثانياً:
إنه لا يجوز الإقدام على أي تصرف يثير الشبهة في صحة
ودقة وصوابية التصرفات، التي تصدر عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»..
فلا يجوز له أن يفعل ما يوجب شكهم في نبوته، أو اتهامه في عصمته..
ولعل ذلك هو بعض فوائد عدم السماح له بأن يتعامل مع
الناس بعلم الشاهدية.
قال البلاذري، والواقدي:
مكث رسول الله «صلى الله عليه وآله» معرضاً عن خالد
حيناً، وخالد يتعرَّض له «صلى الله عليه وآله»، ويحلف ما قتلهم على ترة،
ولا عداوة، وإنه لم يسمع منهم تشهّداً.
قال البلاذري:
فرضي «صلى الله عليه وآله» عنه وسماه بعد ذلك سيف الله.
قال الواقدي:
فلما قدم علي ووداهم، أقبل رسول الله «صلى الله عليه
وآله» على خالد، فلم يزل عنده من علية أصحابه حتى توفي «صلى الله عليه
وآله»..
ثم ذكر حديث:
لا تسبوا خالداً، فإنما هو سيف من سيوف الله سله على
المشركين([46]).
ونقول:
قد تحدثنا في موضع سابق من هذا الكتاب عن تسمية خالد بـ
«سيف الله»، وأنه أمر مكذوب، وأن خالداً إنما سل سيفه على المسلمين في
قضية بني جذيمة، وفي يوم البطاح حين قتل مالك بن نويرة، ولم نجد له أية
نكاية في المشركين، بل كان هو السبب في هزيمة المسلمين في مؤتة، بعد أن
كان النصر منهم على أعظم أمبرطورية في ذلك العصر قاب قوسين أو أدنى، ثم
كان بعد ذلك الرجل الذي تولى إخضاع المسلمين لأبي بكر، وقتلهم على ذلك
بلا رحمة ولا شفقة!!
وغضب النبي «صلى الله عليه وآله» وإعراضه عن خالد، لعله
لأجل دلالة الناس عن حقيقة: أن خالداً ليس صادقاً فيما يدَّعيه.
وأن الشبهة التي أراد أن يتلطى خلفها وإن كانت توجب درء
الحد عنه في ظاهر الأمر، ولكنها شبهة قائمة على الخداع والتضليل، ولذلك
عامله «صلى الله عليه وآله» وفق ما ادَّعاه لنفسه من جهة.. ثم بيَّن له
الحقيقة والواقع، ليفهمه: أن القبول منه لا يعني أنه قد تمكن من خداع
النبي «صلى الله عليه وآله» من جهة أخرى، فلا يظنن أنه قادر على
التلاعب بقرارات النبي «صلى الله عليه وآله» والمسلمين، والتأثير على
سياساتهم، بما يدبره من مكائد ومصائد. فهو إنسان مكشوف ومعروف لدى رسول
الله «صلى الله عليه وآله»..
فلئن دفع عن نفسه القتل بما خادع به النبي «صلى الله
عليه وآله» والمسلمين هذه المرة، فإنه قد لا يسلم من ذلك فيما لو سولت
له نفسه ذلك مرة أخرى.
([1])
أنساب الأشراف ج1 ص181 وراجع: فتح الباري ج8 ص45 وعمدة القاري
ج17 ص313 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص147 وإمتاع الأسماع ج2
ص6 وأعيان الشيعة ج1 ص278 عيون الأثر ج2 ص209 وسبل الهدى
والرشاد ج6 ص197 و 200.
([2])
تاريخ الخميس ج2 ص97 وراجع: البحار ج21 ص140 وإعلام الورى ج1
ص227 والمبسوط للسرخسي ج20 ص143 ومكاتيب الرسول ج1 ص228 فتح
الباري ج8 ص45 وعمدة القاري ج17 ص313 والطبقات الكبرى لابن سعد
ج2 ص147 وأعيان الشيعة ج1 ص278 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص 200.
([3])
البحار ج21 ص140 وإعلام الورى (ط سنة 1399 هـ) ص119 و (ط مؤسسة
آل البيت لإحياء التراث) ج1 ص228. وراجع حديث قتل خالد لبني
جذيمة في: البداية والنهاية ج4 ص359 وسبل الهدى والرشاد ج6
ص200 ومسند أحمد ج2 ص150 و 151 والمحلى لابن حزم ج10 ص368
والكامل في التاريخ ج2 ص255 و 256 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص61
والمغازي للواقدي ج2 ص875 وعن فتح الباري ج5 ص45 وصحيح البخاري
ج5 ص107 وسنن النسـائي ج8 ص237 وفتـح البـاري ج8 ص45 والسنـن =
= الكبرى للنسائي ج3 ص474 وج5 ص177 وصحيح ابن حبان ج11 ص54
وكنز العمال ج1 ص317 وتفسير القرآن العظيم ج1 ص548 وتاريخ
مدينة دمشق ج16 ص233 وإحقاق الحق (الأصل) ص276 ومصادر كثيرة
أخرى.
([4])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص200 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص71
وتاريخ الأمم والملوك (ط دار المعارف) ج3 ص66 و 67 وراجع:
أنساب الأشراف ج1 ص381 والمغازي للواقدي ج3 ص875 وتاريخ الخميس
ج2 ص97 و 98 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص147 وعيون الأثر ج2
ص209 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص210 .
([5])
المغازي للواقدي ج3 ص876.
([6])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص200 عن ابن إسحاق، والواقدي، وراجع:
المنمق ص259 وتاريخ الخميس ج2 ص98 والإستيعاب (بهامش الإصابة)
ج1 ص153 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص72 و (ط مكتبة محمد علي
صبيح) ج4 ص882 وتاريخ الأمم والملوك (ط دار المعارف) ج3 ص67 و
(ط مؤسسة الأعلمي) ج2 ص341 وشرح الأخبار ج1 ص309 والغدير ج7
ص168 وكتاب المنمق ص216 و 217 والبداية والنهاية ج4 ص358
وأعيان الشيعة ج1 ص278 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص591.
([7])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص200 وراجع: تاريخ الخميس ج2 ص98 والسيرة
النبوية لابن هشام ج4 ص72 و (ط مكتبـة محمد علي صبيح) ج4 ص882
= = وتاريخ الأمم والملوك (ط دار المعارف) ج3 ص67 و (ط مؤسسة
الأعلمي) ج2 ص341 وأعيان الشيعة ج1 ص278 و 409 والبداية
والنهاية ج4 ص358 وكشف الغمة ج1 ص220 والسيرة النبوية لابن
كثير ج3 ص591.
([8])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص200 عن أحمد، والبخاري، والنسائي،
وتاريخ الخميس ج2 ص97 عن المواهب اللدنية، والمغازي للواقدي ج3
ص876 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص148 وأعيان الشيعة ج1 ص278
وراجع: السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص210.
([9])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص200 و 201 عن ابن هشام، والسيرة النبوية
لابن هشام ج4 ص72 و (ط مكتبة محمد علي صبيح) ج4 ص883 وتاريخ
الخميس ج2 ص98 والغدير ج7 ص169.
([10])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص201 وتاريخ الخميس ج2 ص98 والسيرة
النبوية لابن هشام ج4 ص73 و (ط مكتبة محمد علي صبيح) ج4 ص884
وتاريخ الأمم والملوك (ط دار المعارف) ج3 ص68 و (ط مؤسسة
الأعلمي) ج2 ص342 والبداية والنهاية ج4 ص359 والسيرة النبوية
لابن كثير ج3 ص593.
([11])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص201 وتاريخ الخميس ج2 ص98 والسيرة
النبوية لابن هشام ج4 ص72 و (ط مكتبة محمد علي صبيح) ج4 ص883
والبداية والنهاية ج4 ص358 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص592.
([12])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص201 عن أحمد، والبخاري، ومسلم، وراجع
المصادر المتقدمة.
([13])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص201 وأشار في هامشه إلى: البخاري ج4
ص122، والنسائي ج8 ص237 وأحمد في المسند ج2 ص151 والبيهقي في
السنن ج9 ص115. وراجع: الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج1 ص153
ودلائل الصدق ج3 ق1 ص33 و 34 والإصابة ج1 ص318 و 227 وج2 ص81
والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص147 و 148 والبداية والنهاية ج4
ص358 والسيرة = = النبوية لابن كثير ج3 ص592 وتاريخ الأمم
والملوك (ط دار المعارف بمصر) ج3 ص67 و 68 و (ط مؤسسة الأعلمي)
ج2 ص342 والغدير ج7 ص169 وكتاب المنمق ص217 وأعيان الشيعة ج1
ص278 و 409 والكامل في التاريخ ج2 ص173 والغدير ج7 ص168 و 169
والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص72 و 73 و (ط مكتبة محمد علي
صبيح) ج4 ص884 وتاريخ أبي الفداء ج1 ص145 وأسد الغابة ج3 ص102
والمغازي للواقدي ج3 ص882 وتاريخ الخميس ج2 ص98 والمنمق ص259 و
260 وراجع: الثقات لابن حبان ج2 ص62 و 63
.
([14])
المغازي للواقدي ج3 ص882 وراجع: إمتاع الأسماع ج2 ص7.
([15])
المغازي للواقدي ج3 ص882.
([16])
السيرة النبوية لابن هشام ج4 ص74 و 75 و (ط مكتبة محمد علي
صبيح) ج4 ص885 وراجع: الإصابة ج1 ص645 ومعجم البلدان ج4 ص214
وكتاب المنمق ص253 و (نسخة مخطوطة) ص212 والمماصعة: المضاربة
بالسيوف. والبرك: الإبل الباركة.
([17])
الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج1 ص153 و (ط دار الجيل) ج3 ص428
والنص والإجتهاد ص461 والغدير ج7 ص168 والإكمال في أسماء
الرجال للتبريزي ص56.
([18])
المغازي للواقدي ج3 ص878 و 879.
([19])
راجع: تاريخ الأمم والملوك (ط دار المعارف) ج3 ص68 و 69 و (ط
مؤسسة الأعلمي) ج2 ص343 وتاريخ الخميس ج2 ص98 و 99 وسبل الهدى
والرشاد ج6 ص201 و 202 والمغازي للواقدي ج3 ص878 ـ 880 والسيرة
النبوية لابن هشام ج4 ص76 و 77 و (ط مكتبة محمد علي صبيح) ج4
ص886 والبداية والنهاية ج4 ص360 والسيرة النبوية لابن كثير ج3
ص595 وعيون الأثر ج2 ص210 والمنمق ص253 ـ 255 و 258 و 259
وراجع: فتح الباري ج8 ص46 وتاريخ مدينة دمشق ج27 ص338 و 339
والإصابة ج4 ص49 .
([20])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص202 عن ابن هشام، وعن ابن إسحاق، وابن
سعد، والنسائي، وراجع: البيهقي في الدلائل ج5 ص118 والطبراني
في الكبير ج11 ص370. وراجع: المغازي للواقدي ج3 ص878 ـ 880
وتاريخ الخميس ج2 ص98 و 99 ومجمع الزوائد ج6 ص210 وفتح الباري
ج8 ص46 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص201 والمعجم الأوسط ج2 ص196
وكشف الخفاء للعجلوني ج2 ص264 والبداية والنهاية ج4 ص361
وعيونالأثر ج2 ص211 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص597 والسيرة
الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص214.
([21])
الآية 55 من سورة المائدة.
([22])
الآيات 1 ـ 3 من سورة الماعون.
([23])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص202 وكنز العمال ج13 ص223 وتاريخ مدينة
دمشق ج16 ص234 وسير أعلام النبلاء ج1 ص371.
([24])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج6 ص202 و 203 والسيرة النبوية لابن
هشام ج4 ص73 و 74 و (ط مكتبة محمد علي صبيح) ج4 ص884 وعيون
الأثر ج2 ص210 وراجع: المنمق ص260 و (مخطوطة) ص217 وتاريخ
الأمم والملوك (ط دار المعارف) ج3 ص68 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج2
ص342 والمغازي للواقدي ج3 ص880 والكامل في التاريخ ج2 ص256
والبداية والنهاية ج4 ص359 وأعيان الشيعة ج1 ص278 والسيرة
النبوية لابن كثير ج3 ص593 و 594.
([25])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص202 وراجع: المنمق ص260 والمغازي
للواقدي ج3 ص880 وكنز العمال ج13 ص223 وتاريخ مدينة دمشق ج16
ص234 وسير أعلام النبلاء ج1 ص371.
([26])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص203 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص73
وتاريخ الأمم والملوك (ط دار المعارف) ج3 ص68 والمغازي للواقدي
ج3 ص880 وتاريخ الخميس ج2 ص98 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة)
ج3 ص211 وكنز العمال ج13 ص223 وتاريخ مدينة دمشق ج16 ص234 وسير
أعلام النبلاء ج1 ص371.
([27])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص202 و 203 عن الواقدي، وأبي سعد
النيسابوري في الشرف، والحاكم في الإكليل، وابن عساكر، وعن
الكامل في التاريخ ج2 ص173 والمغازي للواقدي ج3 ص880.
([28])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص203 وفي هامشه عن: تهذيب تاريخ دمشق ج5
ص103 وعن كنز العمال الحديث رقم (33497) والمغازي للواقدي ج3
ص880 وراجع: كنز العمال ج11 ص716 ح(33498) وج13 ص223 وتاريخ
مدينة دمشق ج16 ص234 وإمتاع الأسماع ج2 ص7 والسيرة الحلبية (ط
دار المعرفة) ج3 ص211.
([29])
السيرة النبوية لابن هشام ج4 ص74 و (ط مكتبة محمد علي صبيح) ج4
ص884 والكامل في التاريخ ج2 ص173 و (ط دار صادر) ص256 وتاريخ
الأمم والملوك (ط دار المعارف) ج3 ص68 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج2
ص342 وراجع: شرح الأخبار ج1 ص310 والبداية والنهاية ج4 ص359
وعيون الأثر ج1 ص210 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص593
والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص211.
([30])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص203 عن ابن إسحاق، وقال في هامشه: أخرجه
البخاري في كتاب المناقب (3673) وأحمد في المسند ج3 ص11
والبيهقي في = = السنن ج1 ص203 وراجع: الإستيعاب ج1 ص8 و 18
والبداية والنهاية ج7 ص183 والمحلى لابن حزم ج1 ص28 ونيل
الأوطار ج9 ص229 و 230 والإيضاح لابن شاذان ص507 وكتاب
الأربعين ص314 وخلاصة عبقات الأنوار ج3 ص167 ومواقف الشيعة ج2
ص254 وسنن أبي داود ج2 ص404 وشرح مسلم للنووي ج16 ص93 وتحفة
الأحوذي ج8 ص338 وج10 ص246 وعون المعبود ج11 ص333 وكتاب السنة
ص464 والمعجم الأوسط ج1 ص212 والتمهيد ج20 ص251 والكفاية في
علوم الرواية ص65 وشرح النهج ج20 ص11 واللمع للسيوطي ص87 و 88
وكنز العمال ج11 ص528 وج14 ص73 و 74.
([31])
الإرشاد للمفيد ج1 ص139
والبحار ج21 ص139.
([32])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص200
وتاريخ الخميس ج2 ص97 عن صحيح البخاري، والمحلى لابن حزم ج10
ص368 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص115 والبداية والنهاية ج4 ص359
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص593 والمعتصر من المختصر ج1
ص216 والديات للشيباني ج1 ص50 ونيل الأوطار ج8 ص9 والطرائف
لابن طاووس ص394 ومسند أحمد ج2 ص151 وسنن النسائي ج8 ص237 وفتح
الباري ج270 ص46 والمصنف للصنعاني ج5 ص221 و 222 والسنن الكبرى
للنسائي ج3 ص474 وج5 ص177 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص567 ونهج
الحق وكشف الصدق ص322.
([33])
الأمالي للشيخ الصدوق (ط سنة 1398 هـ) ص152 و 153 والبحار ج21
ص 142 وج101 ص423 و 424 ومستدرك الوسائل ج18 ص366 و 367 وعلل
الشرائع (ط سنة 1385 هـ) ج2 ص 473 و474.
([34])
المغازي للواقدي ج3 ص876.
([35])
المنمق ص164 و 248 والسيرة النبوية ج4 ص74.
([36])
راجع ألفاظ الحديث في: صحيح البخاري (ط محمد
علي
صبيح) ج6 ص69 و 70 و 122 وج8 ص136 و 148 و 150 و 151 و 149 و
169 و 202 وج9 ص58 و 59 و 63 و 64 و (ط دار الفكر) ج5 ص192 و
240 وج7 ص195 و 206 و 207 و 208 وج8 ص87 وصحيح مسلم ج1 ص58 و
150 وج7 ص67 و 68 و 70 و 71 و 96 و 122 و 123 وج8 ص157 ومسند
أحمد ج1 ص235 و 253 و 384 و 402 و 406 و 407 و 425 و 439 و 453
وج3 ص28 و 102 و 281 وج5 ص48 و 50 و 339 و 388 و 393 و 400 و
412 وكنز العمال (ط الهند) ج11 رقم (1416) و (2416) و (2472) و
(ط مؤسسة الرسالة) ج4 ص543 وج5 ص126 وج11 ص177 وج13 ص239 وج14
ص358 و 417 و 418 و 419 و 433 و 434 و 435 و 436 والمصنف
للصنعاني ج11 ص407 والمغازي للواقدي ج1 ص410 والإستيعاب (بهامش
الإصابة) ج1 ص159 و 160 و (ط دار الجيل) ج1 ص164 والجمع بين
الصحيحين رقم (131) و (267). وراجع:= = الإقتصاد للشيخ الطوسي
ص213 وعيون أخبار الرضا «عليه السلام» ج1 ص93 وشرح أصول الكافي
ج12 ص131 و 378 و 379 وكتاب سليم بن قيس (تحقيق الأنصاري) ص163
و 270 وشرح الأخبار ج1 ص228 وج2 ص277 وكتاب الغيبة للنعماني
ص54 والمسترشد ص229 والإفصاح للشيخ المفيد ص51 والتعجب
للكراجكي ص89 وكنز الفوائد للكراجكي ص60 والعمدة لابن البطريق
ص466 و 467 والطرائف لابن طاووس ص376 و 377 و 378 والملاحم
لابن طاووس ص75 والصراط المستقيم ج2 ص81 وج3 ص107 و 140 و 230
وعوالي اللآلي ج1 ص59 ووصول الأخيار إلى أصول الأخبار ص65 و 66
و 67 والصوارم المهرقة ص10 وكتاب الأربعين للشيرازي ص140 و 240
و 262 و 263 و 264 والبحار ج8 ص16 و 27 وج23 ص165 وج28 ص19 و
24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 127 و 282 وج29 ص566 وج31 ص145
وج37 ص168 وج69 ص148 ومناقب أهل البيت «عليهم السلام»
للشيرواني ص394 و 395 والنص والإجتهاد ص524 و 525 وجامع أحاديث
الشيعة ج26 ص103 والغدير ج3 ص296 ومستدرك سفينة البحار ج6 ص175
ومكاتيب الرسول ج1 ص576 ومواقف الشيعة ج3 ص208 وميزان الحكمة
ج2 ص1062 وج3 ص2188 وسنن ابن ماجة ج2 ص1016 سنن الترمذي ج4 ص38
وج5 ص4 وسنن النسائي ج4 ص117 والمستدرك للحاكم ج3 ص501 وج4
ص452 وشرح مسلم للنووي ج3 ص136 وج4 ص113 وج15 ص64 ومجمع
الزوائد ج3 ص85 وج9 ص367 وج10 ص365 وفتح الباري ج11 ص333 وج13
ص3 وعمدة القاري ج15 ص243 وج18 ص217 وج19 ص65 وج23 ص106 و 137
و 140 وج24 ص176 وتحفة الأحوذي ج7 ص93 وج9 ص6 و 7 ومسند أبي
داود الطيالسي ص343 والمصنف لابن أبي= = شيبة ج7 ص415 وج8 ص139
و 602 ومسند ابن راهويه ج1 ص379 ومنتخب مسند عبد بن حميد ص365
وتأويل مختلف الحديث ص217 والآحاد والمثاني ج5 ص352 والسنن
الكبرى للنسائي ج1 ص669 وج6 ص339 و 408 ومسند أبي يعلى ج7 ص35
و 40 و 434 وج9 ص102 و 126 وصحيح ابن حبان ج16 ص344 والمعجم
الأوسط ج1 ص125 وج6 ص351 وج7 ص166 والمعجم الكبير ج7 ص207 وج12
ص56 وج17 ص201 وج23 ص297 ومسند الشاميين ج3 ص16 و 310 وج4 ص34
ومسند الشهاب ج2 ص175 والإستذكار لابن عبد البر ج5 ص111
والتمهيد لابن عبد البر ج2 ص291 و 292 و 293 و 301 و 308 وج19
ص222 ورياض الصالحين للنووي ص138 وتخريج الأحاديث والآثار ج1
ص241 وتغليق التعليق لابن حجر ج5 ص185 و 187 والجامع الصغير
للسيوطي ج2 ص449 وفيض القدير ج5 ص450 وتفسير جوامع الجامع ج3
ص856 ومجمع البيان ج10 ص459 والتفسير الأصفى ج2 ص1483 والتفسير
الصافي ج1 ص369 وج5 ص382 وج7 ص566 وتفسير نور الثقلين ج5 ص680
وتفسير كنز الدقائق ج2 ص195 وتفسير الميزان ج3 ص380 وتفسير
القرآن للصنعاني ج2 ص371 وجامع البيان ج4 ص55 وتفسير ابن أبي
حاتم ج4 ص1254 ومعاني القرآن للنحاس ج2 ص382 وتفسير الثعلبي ج3
ص126 وج10 ص308 وتفسير السمعاني ج2 ص77 وج6 ص290 وتفسير البغوي
ج2 ص76 وزاد المسير ج8 ص320 والجامع لأحكام القرآن ج4 ص168 وج6
ص361 و 377 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص124 وج3 ص261 وج4 ص595
والدر المنثور ج2 ص349 وج5 ص96 وج17 ص211 وج22 ص45 وطبقات
المحدثين بأصبهان ج3 ص234 وعلل الدارقطني ج5 ص96 وج7 ص299
وتاريخ مدينة دمشق = = ج20
ص372 وج36 ص8 وج47 ص117 وسير أعلام النبلاء ج1 ص120 وتاريخ
المدينة لابن شبة ج4 ص1251 والبداية والنهاية ج6 ص231 وإمتاع
الأسماع ج3 ص305 و 306 وج14 ص222 و 223 وبشارة المصطفى للطبري
ص217 والدر النظيم ص444 ونهج الإيمان لابن جبر ص583 والعدد
القوية للحلي ص198 وسبل الهدى والرشاد الصالحي ج10 ص96 وينابيع
المودة للقندوزي ج1 ص398 والنصائح الكافية لمحمد بن عقيل ص164
و 165.
([37])
تاريخ الأمم والملوك (حوادث سنة 11 هـ) ج3 ص279 وقد تقدمت مصادر ذلك.
([38])
بهجة
المحافل للعامري ج1 ص444.
([39])
راجع: تاريخ ابن شحنة (روضة المناظر) (مطبوع بهامش الكامل)
حوادث سنة 11 هـ ج7 ص165 و (في ط أخرى لروضة المناظر) ج1 ص191
و 192 وتاريخ أبي الفداء ج1 ص158. وراجع: تاريخ الخميس ج2 ص209
وشرح المواقف ج8 ص358 والغدير ج7 ص160 وراجع: كنز العمال ج5
ص247 ومرآة الجنان ج2 ص120 وفيات الأعيان ج6 ص15 وتاريخ مدينة
دمشق ج16 ص257 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص503 والكنى والألقاب
ج1 ص42.
([40])
راجع: مشكاة المصابيح ج2 ص285 وسنن ابن ماجة ج2 ص847 ومصابيح
السنة ج2 ص502 والديات لابن أبي عاصم ص9 وعن صحيح البخاري ج6
ص2521 وعن صحيح مسلم ج2 ص37 و (ط دار الفكر) ج5 ص187 وج8 ص43
وراجع: تاريخ مدينة دمشق ج35 ص212 والمحلى لابن حزم ج11 ص68
وميزان الحكمة ج3 ص2499 وسنن أبي داود ج2 ص327 والسنن الكبرى
للبيهقي ج8 ص128 وعمدة القاري ج18 ص203 وج24 ص61 وعون المعبود
ج12 ص5 والمصنف لابن أبي شيبة ج6 ص417 ونصب الراية ج4 ص109
والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج2 ص96 وكنز العمال ج1 ص87 و
92 وشرح مسند أبي حنيفة ص359 وكشف الخفاء ج2 ص367 وأحكام
القرآن ج2 ص98 و 292 وأضواء البيان ج3 ص134 وتاريخ الإسلام
للذهبي ج3 ص445.
([41])
كما
نصت عليه الآية الكريمة:
{إِنَّمَا
جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ
فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ
يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}
(الآية 33 من سورة المائدة).
([42])
راجع: تاريخ الخميس ج2 ص98 وراجع: مغني المحتاج ج4 ص124 وتلخيص
الحبير ج4 ص46 والمحلى لابن حزم ج10 ص484 والجوهر النقي ج8 ص58
وخلاصة عبقات الأنوار ج3 ص61 والغدير ج1 ص323 وج9 ص393 وج10
ص341 والمجموع للنووي ج19 ص197 والمبسوط للسرخسي ج26 ص175
والشرح الكبير ج10 ص76 والنص والإجتهاد ص13.
([43])
المحلى لابن حزم ج1 ص484 والجوهر النقي (مطبوع بهامش سنن
البيهقي) ج8 ص158 والغدير ج1 ص328 وسماء المقال في علم الرجال
للكلباسي ج1 ص20.
([44])
الفصل في الملل والأهواء والنحل ج4 ص161 وراجع: فتح الباري ج8
ص46 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص211 ومرقاة المفاتيح
ج7 ص487.
([45])
راجع: أقرب الموارد ج1 ص339.
([46])
أنساب الأشراف للبلاذري ج1 ص381
والمغازي للواقدي ج3 ص883 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص203 ومجمع
الزوائد ج9 ص349 ومسند أبي يعلى ج13 ص143 وتاريخ مدينة دمشق
ج16 ص243 وإمتاع الأسماع ج2 ص7 والمطالب العالية ج16 ص309
وفضائل الصحابة ج2 ص815.
|