نهايات حرب الطائف
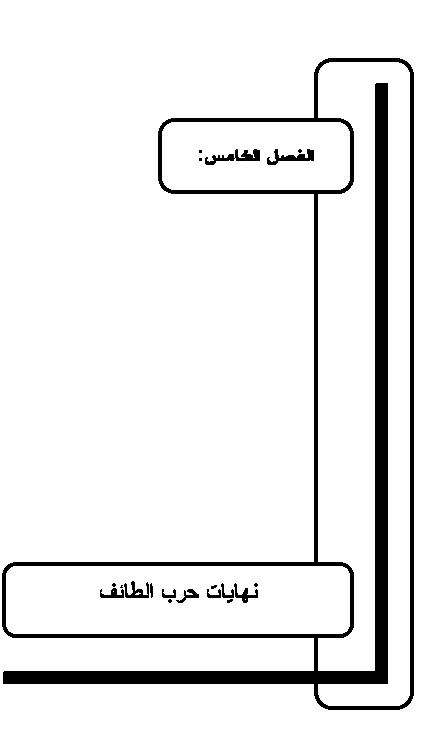
عن أبي هريرة قال:
لما مضت خمس عشرة من حصار الطائف، إستشار رسول الله
«صلى الله عليه وآله» نوفل بن معاوية الديلي، فقال: «يا نوفل ما ترى في
المقام عليهم».
قال:
يا رسول الله، ثعلب في جحر، إن
أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك([1]).
ثم إن خولة بنت حكيم السلمية، وهي
امرأة عثمان بن مظعون، قالت:
يا رسول الله، أعطني، إن فتح الله عليك الطائف ـ حلي
بادية بنت غيلان، أو حلي الفارعة بنت عقيل.. وكانتا من أحلى نساء ثقيف.
فروي:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال لها: «وإن كان
لم يؤذن لنا في ثقيف يا خولة»؟
فخرجت خولة، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فدخل على رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، فقال: يا رسول الله ما حديث حدثتنيه خولة؟
زعمت أنك قلته؟
قال:
«قد قلته».
قال:
«أوما أذن فيهم»؟
قال:
«لا».
قال:
أفلا أؤذن الناس بالرحيل؟
قال:
«بلى».
فأذن عمر بالرحيل([2]).
وفي نص آخر:
أنها قالت: يا رسول الله، ما يمنعك أن تنهض إلى أهل
الطائف؟!
قال:
لم يؤذن لنا الآن فيهم، وما أظن أن نفتحها الآن([3]).
وروى الشيخان عن ابن عمرو أو ابن
عمر قال:
لما حاصر رسول الله «صلى الله عليه وآله» الطائف، ولم ينل منهم شيئاً،
قال: «إنا قافلون غداً إن شاء الله تعالى.
فثقل عليهم، وقالوا:
أنذهب ولا نفتح؟
وفي لفظ:
فقالوا: لا نبرح أو نفتحها.
فقال:
«اغدوا على القتال».
فغدوا، فقاتلوا قتالاً شديداً،
فأصابهم جراح، فقال:
«إنا قافلون غداً إن شاء الله تعالى».
قال:
فأعجبهم، فضحك رسول الله «صلى الله عليه وآله». أي تعجباً من سرعة تبدل
رأيهم حين رأوا: أن رأي رسول الله «صلى الله عليه وآله» أبرك وأنفع([4]).
قال عروة كما رواه البيهقي:
وأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» الناس أن لا
يسرحوا ظهرهم، فلما أصبحوا، ارتحل رسول الله «صلى الله عليه وآله»
وأصحابه، ودعا حين ركب قافلاً وقال: «اللهم اهدهم، واكفنا مؤنتهم»([5]).
وقالوا:
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» لأصحابه، حين
أرادوا أن يرتحلوا: «قولوا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق
وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده».
فلما ارتحلوا واستقبلوا قال:
«قولوا: آيبون، إن شاء الله، تائبون، عابدون، لربنا حامدون»([6]).
وعن مدة الحصار نقول:
قال أنس:
إنهم حاصروا الطائف أربعين ليلة، واستغربه في البداية([7]).
وقال ابن إسحاق:
إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» حاصر أهل الطائف
ثلاثين ليلة أو قريباً من ذلك، ثم انصرف عنهم، ولم يؤذن فيهم.
فقدم وفدهم في رمضان فأسلموا([8]).
قال اليعقوبي وابن إسحاق:
«وحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة([9]).
وقيل:
عشرين يوماً([10]).
وقيل:
بضع عشرة ليلة»([11]).
قال ابن حزم:
وهو الصحيح بلا شك([12]).
وقيل:
حاصرهم تسعة عشر يوماً([13]).
وقيل:
ثمانية عشر يوماً([14]).
وعن عبد الرحمن بن عوف:
حاصر الطائف في عشرة، أو سبع عشرة([15]).
وعنه:
فحاصرهم سبع عشرة، أو ثماني عشرة ليلة([16]).
أو سبعة عشر أو تسعة عشر يوماً([17]).
وعنه أيضاً:
ثمانية عشر أو تسعة عشر يوماً([18]).
وقيل:
خمسة عشر يوماً([19]).
قالوا:
وكأن الحكمة في أنه لم يؤذن له «صلى الله عليه وآله» في
فتح الطائف ذلك العام أن لا يستأصل أهل ذلك الحصن قتلاً، فأخر الله
أمرهم، حتى جاؤوا طائعين مسلمين»([20]).
ونقول:
إن لنا وقفات عديدة مع ما تقدم، نذكر منها ما يلي:
قد ذكرت الروايات المتقدمة:
أنه «صلى الله عليه وآله» أمر أصحابه بالرحيل وفك
الحصار، معللاً ذلك بأنه لم يؤذن لهم في أهل الطائف..
غير أننا نقول:
أولاً:
تقدم وسيأتي: ما يدل على أن أهل الطائف هم الذين طلبوا
من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يبتعد عن حصنهم، حتى يأتيه وفدهم.
فذهب إلى مكة، فجاءه وفدهم بإسلامهم..
فإن كان «صلى الله عليه وآله» قد
قال لأصحابه:
«إنه لم يؤذن له فيهم»، فهو يقصد هذا المعنى..
وفي غير هذه الصورة، فإن رجوع النبي «صلى الله عليه
وآله» عن حصارهم معناه: إظهار العجز والضعف، وربما يشجع ذلك بعض الفئات
في المنطقة على الإلتفاف حولهم، وتشجيعهم وشد أزرهم على المقاومة
والصمود في وجه الإسلام والمسلمين..
ثانياً:
إنه لا مبرر لإعلان هذا العجز في الوقت الذي فتح فيه
«صلى الله عليه وآله» حصون خيبر، وقتل علي «عليه السلام» مرحب اليهودي،
واقتلع الباب الحجري لأهم حصونها، واقتحم الحصن..
فأين هو عن علي «عليه السلام»؟ ولماذا لا يرسله إلى حصن
الطائف لقلع بابه، وفتحه، واقتحامه وقتل أفرس فرسانه فيه؟!
فلماذا أعلن الرحيل بمجرد حضور علي «عليه السلام» من
سراياه التي كان قد أرسله فيها، حتى لقد قالوا: «فلما قدم علي، فكأنما
كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» على وجل فارتحل، فنادى سعيد بن
عبيد: ألا إن الحي مقيم. أي ونحن مرتحلون لأننا لسنا من أهل الحي([21]).
غير أننا نحتمل:
أنه «صلى الله عليه وآله» لم يرد أن يخبر الناس بمراسلة
أهل الطائف له بالإبتعاد عن حصنهم، لكي يأتوه مسلمين مستسلمين، فاكتفى
بقوله: إنه لم يؤذن له فيهم.. وهو كلام صحيح، فإنهم إذا كانوا قد
أبلغوه بعزمهم على الإستسلام، فالله سبحانه لا يأذن له فيهم، بل يجب
إفساح المجال لهم لتنفيذ ما عقدوا العزم عليه..
ولعل السبب في إخفاء ذلك عن الناس:
أنه أراد أن يحفظ بعض ماء الوجه لأهل الطائف، بالإضافة
إلى: أنه أراد أن يبعد أهل الطمع عن روائح الغنيمة التي سيرون أنها قد
فاتتهم، ولربما يتعرض الناس لبعض التعديات الحانقة منهم، بل قد يفكرون
بإثارة حالات من الشغب تؤدي إلى تصعيب اتخاذ أولئك المحاصرين القرار
بقبول الإسلام والاستسلام.
وفي بعض النصوص:
أن عمر بن الخطاب كلَّم رسول الله «صلى الله عليه وآله»
في النهوض إلى أهل الطائف.
فقال «صلى الله عليه وآله»:
«لم يؤذن لنا في قتالهم».
فقال:
«كيف نقبل في قوم لم يأذن الله فيهم»؟!([22]).
ولا ندري على من يعترض عمر بن الخطاب!! هل يعترض على
الله سبحانه، لأنه لم يأذن بأهل الطائف؟! أم يعترض على رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، لأنه أقبل بهم إلى قوم لم يأذن الله تبارك وتعالى
فيهم؟! رغم علم كل أحد: أن النبي «صلى الله عليه وآله» معصوم، ومسدد
بالوحي، ولا يفعل إلا ما يريده الله، وما يأمره به تبارك وتعالى..
ألم يكن بإمكان هذا الرجل أن يفهم القضية بتقدير أن
الله سبحانه أراد أن يري أهل ثقيف هذا المقدار من الإرادة، والعزم،
والتصميم، لكي يهيأهم لقبول الإسلام طوعاً، ويوفر على المسلمين وعليهم
خسائر في الأرواح والأموال، وفي جهات مختلفة أخرى؟!
غير أن رواية أخرى، قد ذكرت:
أنه بعد اعتراض عمر بن الخطاب على النبي «صلى الله عليه
وآله» في مناجاته علياً «عليه السلام» بمجرد وصوله.. وسمع الجواب، ثم
اعترض عليه بما جرى في الحديبية، قالوا:
«لما قدم علي «عليه السلام»، فكأنما كان رسول الله «صلى
الله عليه وآله» على وجل فارتحل.
فنادى سعيد بن عبيد ألا إن الحي مقيم، فقال ـ يعني عمر
بن الخطاب ـ:
لا أقمت ولا ظعنت، فسقط فانكسر فخذه»([23]).
ولا نريد ان نسجل أي تعليق على هذه الحادثة، فإنها
بنفسها تحكي عن نفسها، ولاسيما بعد ملاحظة ما سيأتي من قول لنا عن
اعتراضاته على مناجاة النبي «صلى الله عليه وآله» لعلي «عليه السلام».
أما بالنسبة لقولهم:
إن المسلمين رفضوا التحول عن حصن الطائف، فأمرهم «صلى
الله عليه وآله» بأن يغدوا على القتال، فأصابتهم جراحات، فرضوا
بالإرتحال، فضحك «صلى الله عليه وآله»..
فهو كلام غير مقبول:
أولاً:
إن مجرد أن تصيبهم بعض الجراحات، لا يبرر أن يفرحوا
بالإرتحال عن الطائف، بعد أن كانوا رافضين لذلك أشد الرفض.
ثانياً:
كيف ينسب هؤلاء إلى الصحابة هذه المعصية الظاهرة،
الممتثلة بتمردهم على أوامر رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ورفضهم
الطاعة له بصورة فجة وبعيدة عن اللياقة، والأدب؟!
مع أن هؤلاء ما فتئوا ينزهون الصحابة عن كل شين وعيب،
ويسعون لإبعادهم عن كل شبهة وريب، ويعلنون: أنهم جميعاً عدول، ومطيعون
لله وللرسول.
ثالثاًَ:
قلنا: إن النبي «صلى الله عليه وآله» انصرف منتصراً عن
الطائف. بوعدٍ من أهل الطائف، بأن يأتيه وفدهم لحسم الأمور وفق الشروط
التي يضعها هو «صلى الله عليه وآله».
رابعاً:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد علم أصحابه أن يقولوا
حين انصرافهم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده،
وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده»..
فلماذا لم يعترضوا عليه بالقول:
إننا لم نر نصراً، ولم يتحقق وعد الله تعالى لنا، ولم
تحل الهزيمة بعدونا، ولم نر هذا العز في حصارنا للطائف، بل رجعنا
خائبين، غير منتصرين؟!
وسيأتي:
أن هذا الدعاء الذي علمه النبي «صلى الله عليه وآله»
لجنده دليل على صحة رواية الشيخ الطوسي في أماليه، والتي صرحت: بحصول
هذا النصر للنبي الكريم «صلى الله عليه وآله»..
قالوا:
واستشهد من أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» في
الطائف اثنا عشر رجلاً([24])،
سبعة من قريش، وأربعة من الأنصار، ورجل من بني ليث([25])،
وهم:
سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية.
وعرفطة ـ بضم العين المهملة ـ بن حباب، حليف لهم من
الأسد بن عوف.
ويزيد بن زمعة بن الأسود. جمح به فرسه إلى حصن الطائف
فقتلوه.
وعبد الله بن أبي بكر الصديق. رماه أبو محجن بسهم، فلم
يزل جريحاً حتى مات بالمدينة بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله» وهو
غير شهيد عند الشافعية، لأنه توفي بعد انقضاء الحرب بمدة مديدة.
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي، رمي في
الحصن.
وعبد الله بن عامر بن ربيعة. حليف لهم.
والسائب بن الحارث بن قيس السهمي، وأخوه عبد الله بن
الحارث بن قيس.
وجليحة بن عبد الله.
وثابت بن الجذع (أو سالم بن الجذع) واسمه ثعلبة السلمي.
والحارث بن سهل بن أبي صعصعة.
والمنذر بن عبد الله بن نوفل([26]).
وذكر في العيون هنا:
رُقيم بن ثعلبة، مع ذكره له فيمن استشهد بحنين، تبع
هناك ابن إسحاق، وهنا ابن سعد([27]).
وقيل:
وكان من استشهد بالطائف أحد عشر رجلاً([28]).
وقد عدُّوا عبد الله بن أبي بكر في جملة شهداء الطائف،
بدعوى: أنه أصابه سهم أبي محجن، وطاوله ذلك الجرح إلى أن مات في خلافة
أبيه([29]).
ونقول:
إننا لا ندري مدى صحة ما زعموه من أمر جرح عبد الله
بسهم أبي محجن بالطائف. ولا مانع من أن يصح هذا الزعم منهم، مع احتمال
أن يكون ذلك من مصنوعات محبي أبي بكر، لكي لا يفوته فضل تقديم الشهداء
من الأهل والأبناء، بعد ان فاتته فضائل الصمود في ساحات الجهاد، حيث
ابتلي بالفرار من الزحف في مختلف المقامات التي فر فيها الناس، مثل:
أحد، وخيبر، وحنين، وسواها مما ذكرنا في ثنايا هذا الكتاب طائفة منه عن
المصادر الموثوقة عند السنة والشيعة على حد سواء..
وما دمنا نتحدث عن موت عبد الله بن أبي بكر، متأثراً
بسهم أبي محجن، يحسن بنا أن نشير إلى أمرٍ ينسبونه إلى أمير المؤمنين،
دون أن يبينوا وجه الصواب فيه..
وهذا الأمر هو:
أن عمر بن الخطاب تزوج عاتكة بنت زيد في سنة 12 للهجرة،
وقبل وفاة زوجها عبد الله، فأولم عليها ودعا أصحاب رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، وفيهم علي «عليه السلام»، فاستأذن عمر أن يكلمها، فقال:
نعم.
فقال لها «عليه السلام» يا عدية نفسها، أين قولك؟! (أي
في رثائها لزوجها عبد الله):
فآلـيـت لا
تنـفـك عيني حزينـة عليـك ولا يـنـفك جلدي أصفراً
فقالت:
لم أقل هكذا، وبكت، وعادت إلى حزنها.
فقال له عمر:
يا أبا الحسن، ما أردت إلا إفسادها علي.
أو قال:
ما دعاك إلى هذا يا أبا حسن، كل النساء يفعلن هذا.
فقال:
قال الله تعالى:
{يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللهَ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ}([30])»([31]).
ونقول:
إن هذا اتهام خطير من عمر، يوجهه إلى علي أمير
المؤمنين، يتضمن من الطعن في دينه وفي استقامته
«عليه السلام».
والحقيقة هي:
أن ثمة أموراً هامة دعت أمير المؤمنين «عليه السلام»
إلى هذه المبادرة، التي نحتمل قوياً أنها لم تنقل إلينا بدقة وأمانة.
ولعل من هذه الأمور:
1 ـ
أن عاتكة كانت قد آلت ألا تتزوج بعد عبد الله بن أبي
بكر([32]).
ولعل متعلق هذا اليمين كان راجحاً إذا كانت تعلم أن
زواجها سيكون ـ بحكم ظروف معينة ـ سيكون من رجل سوف يؤثر على دينها، أو
على مكانتها..
2 ـ
إن عاتكة كانت قد أخذت طائفة من مال عبد الله بن أبي
بكر ـ أو حديقة أو أرض ـ مقابل أن لا تتزوج أحداً بعده.
فقد روى بسند حسن، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، قال:
«كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل تحت عبد الله بن
أبي بكر الصديق، فجعل لها طائفة من ماله على أن لا تتزوج بعده ومات.
فأرسل عمر إلى عاتكة:
إنك قد حرمت عليك ما أحل الله لك.
فردي إلى أهله الذي أخذتيه،
وتزوجي، ففعلت، فخطبها عمر فنكحها»([33]).
وحكى يحيى بن حاطب رؤيا عن ربيعة بن آمنة بعد موت عبد
الله، وقيل وفاة أبي بكر، مفادها: أن أبا بكر مات وأن عمر بعث إلى
عاتكة. ليتزوجها.. وأن منامه قد تحقق فزجره عمر.
قال:
«وكانت تحت عبد الله بن أبي بكر، فأصيب يوم الطائف،
فجعل لها طائفة من ماله على أن لا تنكح بعده»([34]).
لكن ما ذكرته الرواية:
من أن عاتكة قد ردت المال إلى أهله، ثم خطبها عمر،
وتزوجها، غير صحيح.
والصحيح هو:
أنها بقيت محتفظة بتلك الأراضي والأموال حتى طالبتها
عائشة بها.
فقد روي عن خالد بن سلمة:
«إن عاتكة بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكر، وكان
يحبها، فجعل لها بعض أرضيه على أن لا تزوج بعده، فتزوجها عمر بن
الخطاب، فأرسلت إليها عائشة: أن ردّي علينا أرضنا»([35]).
وكانت عاتكة قد قالت حين مات عبد الله بن أبي بكر:
آليـت([36])
لا تـنـفـك نفسي حزينـة عـليـك ولا ينـفـك جلدي أغـبرا
قال:
فتزوجها عمر بن الخطاب، فقالت عائشة:
آليـت([37])
لا تـنـفـك عيني قريـرة عـليـك ولا ينـفك جلدي أصفرا
ردي علينا أرضنا([38]).
3 ـ
روى ابن سور، عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن علي
بن زيد: أن عاتكة بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكر، فمات عنها،
واشترط عليها أن لا تزوج بعده، فتبتلت، وجعلت لا تزوج، وجعل الرجال
يخطبونها، وجعلت تأبى، فقال عمر لوليها: اذكرني لها.
فذكره لها، فأبت عمر أيضاً.
فقال عمر:
زوجنيها. فزوجه إياها.
فأتاها عمر، فدخل عليها، فعاركها حتى غلبها على نفسها،
فنكحها، فلما فرغ قال: أف، أف، أف. أفف بها. ثم خرج من عندها، وتركها
لا يأتيها.
فأرسلت إليه مولاة لها:
أن تعال، فإني سأتهيأ لك([39]).
وهذه الرواية على جانب كبير من الأهمية، حيث تضمنت:
إتهاماً خطيراً للخليفة الثاني عمر بن الخطاب بأحد
أمرين:
إما الجهل الذريع أحكام الله، الذي أوقعه في وطء
الشبهة.. ويتبع ذلك اتهام الصحابة بذلك، حيث سكتوا جميعاً عن عمله هذا،
باستثناء علي أمير المؤمنين «عليه السلام»، إما جهلاً منهم بالحكم،
وإما ممالأة له، خوفاً ورهبة منه.
وإما أنه كان يعلم بالحكم، وقد أقدم على مخالفته،
وارتكاب جريمة الزنى. وهذا أمر خطير بالنسبة لخليفة لمسلمين، الذي
يتلقى الناس أفعاله بالرضا والقبول والتسليم، ويأخذونها عنه على أنها
موافقة لشرع الله تبارك وتعالى.. ويتبع ذلك إلقاء قدر كبير من اللوم
على الصحابة الذين سكتوا ولم يعلنوا بالنكير عليه..
وأما محاولة الإيحاء بسلامة تصرفه
هذا من خلال تصريح الرواية:
بأنه أمر وليها بأن يزوجه إياها، ففعل فلذلك جاءها عمر
فعاركها حتى غلبها على نفسها، فنكحها، فيكون قد فعل ذلك بمن هي زوجته
شرعاً..
فيجاب عنها:
بأنهم قد صرحوا: بأنه ليس للولي أن
يزوج المرأة الثيب بدون إذنها. ولا بد في إذنها من تصريحها بالرضا. ولو
فعل ذلك، فإن رفضت بطل العقد([40]).
والمفروض:
أن عاتكة قد رفضت قبل العقد وبعده، حتى لقد اضطر عمر
إلى العراك معها حتى غلبها على نفسها. فكيف يمكن تصحيح هذا العقد، أو
الحكم بمشروعية هذا الوطء؟!
علي
×
يخطب عاتكة، والحسين
 يتزوجها: يتزوجها:
وزعموا:
أن عاتكة تزوجت بعدة أشخاص كلهم مات عنها، تزوجها زيد
بن الخطاب فقتل باليمامة. فتزوجها عمر فقتل، ثم الزبير فقتل.
وزعموا أيضاً:
أن علياً
«عليه السلام» خطبها بعد موت الزبير، فقالت:
إني لأضن بك عن القتل..
أو قالت:
يا أمير المؤمنين، أنت بقية الناس، وسيد المسلمين، وإني
أنفس بك عن الموت، فلم يتزوجها([41]).
بل لقد قالوا أيضاً:
إن الحسين
«عليه السلام» قد خطبها، وتزوجها، بعد الزبير، فقتل
عنها، فرثته كما رثت عبد الله بن أبي بكر، وعمر بن الخطاب والزبير،
فقالت:
واحسـيـنـاً ولا نسيـت
حسينـاً أقـصـدتـــه أسـنـــة الأعــــداء
غـادروه بكــربــلاء صـريعـاً جـــادت المـزن في ذرى
كربـلاء([42])
ويقولون:
إن مروان خطبها بعد الحسين «عليه السلام»، فقالت: ما
كنت متخذة حما بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله»([43]).
بل لقد زعموا:
أن عمر قال: من أراد الشهادة، فليتزوج عاتكة([44]).
ونقول:
إن ذلك لا يصح، فلاحظ ما يلي:
أولاً:
بالنسبة لما نسبوه إلى عمر من أنه قال: من أراد الشهادة
فليتزوج عاتكة.. نلاحظ: أنه لم يكن قد مات عن عاتكة إلا عبد الله بن
أبي بكر، أما زيد بن الخطاب، فيشك في أن يكون قد تزوجها من الأساس([45]).
فما معنى أن يقول عمر:
من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة؟!
ثانياً:
إن زواجها بالحسين بن علي «عليهما السلام»، واستشهاده
عنها، ثم رثاءها إياه، ثم خطبة مروان لها بعده، يقتضي: أن تكون قد عاشت
إلى ما بعد سنة ستين أو إحدى وستين. مع أن هناك من يصرح: بأنها قد ماتت
في أوائل خلافة معاوية، أي في سنة اثنتين وأربعين للهجرة([46])،
أي قبل استشهاد الحسين «عليه السلام»، بما يقرب من عشرين سنة.
وقالوا:
«إن عمر استفتى علياً «عليه السلام» في أمر عاتكة،
فأفتاه: بأن تردَّ الحديقة لورثة عبد الله بن أبي بكر، وتتزوج، ففعلت،
وتزوجها عمر، فذكرّها علي «عليه السلام» بقولها:
آليـــت لا
تـنـفـك نفسي حزينـة عـليـك ولا ينـفـك جلدي أغـبرا
ثم قال:
{كَبُرَ
مَقْتاً عِندَ اللهَ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ}([47])»([48]).
ونقول:
إن من الواضح:
أن موقف علي «عليه السلام» من عاتكة، وقراءته للآية
الكريمة: {كَبُرَ
مَقْتاً عِندَ اللهَ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ}
يدل على: أنه يرى أن ما فعلته كان أمراً بالغ السوء، وأنه مما يمقته
الله تعالى، وهذا لا ينسجم مع القول: بأنه «عليه السلام» قد أفتى لها
بجواز ذلك، إذا ردت الحديقة إلى ورثة زوجها عبد الله بن أبي بكر. فإن
الله لا يمقت من يفعل الحلال، فضلاً عن أن يكون ذلك من المقت الكبير
عند الله تعالى.
يضاف إلى ذلك:
أنه لم يأمرها بالتكفير عن قسمها، ولا أشار في تلك
الفتوى إلى هذا القسم بشيء!!
وقد ذكرنا في بعض فصول هذا الكتاب:
أن عمر بن الخطاب كان مغرماً بالنساء بشكل غير مألوف،
وقد قال محمد بن سيرين: إن عمر قال: ما بقي فيَّ شيء من أمر الجاهلية
إلا أني لست أبالي أي الناس نكحت، وأيهم أنكحت([49]).
وقد أتى جارية له، فقالت:
إني حائض، فوقع بها فوجدها حائضاً، فأتى النبي «صلى
الله عليه وآله»، فأخبره، فقال: يغفر الله لك يا أبا حفص! تصدق بنصف
دينار([50]).
وهو الذي نزل فيه قوله تعالى:
{عَلِمَ
اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ..}([51])،
وذلك أنه قبل حلية الرفث إلى النساء ليلة الصيام، واقع أهله في إحدى
الليالي، ثم غدا على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأخبره.
فقال له «صلى الله عليه وآله»:
«لم تكن حقيقاً بذلك يا عمر»، فنزلت الآية»([52]).
والكلام حول هذا الموضوع يطول، فالإكتفاء بهذه الإشارة
أولى وأجمل، إن شاء الله تعالى..
قالوا:
لما دخل ذو القعدة([53])،
خرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» من الطائف فأخذ على دحنا، ثم على
قرن المنازل، ثم على نخلة، ثم خرج إلى الجعرانة، وهي على عشرة أميال من
مكة([54])،
وقيل: على سبعة أميال من مكة([55]).
قال سراقة بن جعشم:
لقيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» وهو منحدر من
الطائف إلى الجعرانة، فتخلصت إليه، والناس يمضون أمامه أرسالاً، فوقفت
في مقنب من خيل الأنصار، فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون: إليك إليك،
ما أنت؟ وأنكروني.
حتى إذا دنوت، وعرفت أن رسول الله «صلى الله عليه وآله»
يسمع صوتي، أخذت الكتاب الذي كتبه لي أبو بكر، فجعلته بين إصبعين من
أصابعي، ثم رفعت يدي به، وناديت: أنا سراقة بن جعشم، وهذا كتابي.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«هذا يوم وفاء وبر، ادنوه».
فأدنيت منه، فكأني أنظر إلى ساق رسول الله «صلى الله
عليه وآله» في غرزه كأنها الجمارة، فلما انتهيت إليه سلمت، وسقت الصدقة
إليه، وما ذكرت شيئاً أساله عنه إلا أني قلت: يا رسول الله، أرأيت
الضالة من الإبل تغشى حياضي وقد ملأتها لإبلى هل لي من أجر إن سقيتها؟
قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»:
«نعم، في كل ذات كبد حرى أجر».
قال محمد بن عمر:
وقد كان رسول الله «صلى الله عليه
وآله» كتب لسراقة كتاب موادعة، سأل سراقة إياه، فأمر به فكتب له أبو
بكر، أو عامر بن فهيرة([56]).
ونقول:
وسراقة هو الذي تبع رسول الله «صلى الله عليه وآله» حين
الهجرة، فساخت قوائم فرسه بالأرض، فطلب من النبي «صلى الله عليه وآله»
أن يكتب له كتاب أمان، وهو هذا الكتاب الذي نتحدث عنه.
وقد أظهر النص المتقدم:
أن ثمة خلافاً حول الشخص الذي كتب الكتاب لسراقة بأمر
رسول الله «صلى الله عليه وآله».. هل هو أبو بكر، أو غيره؟!
وقد شكك العلامة الأحمدي «رحمه
الله» في صحة ما يدّعى:
من أن أبا بكر كان من كتّاب رسول الله «صلى الله عليه
وآله». إذ لا يوجد أي شاهد على ذلك سوى ما يزعمونه من كتابته لكتاب
سراقة الآنف الذكر، وهذا مشكوك لسببين:
أحدهما:
أن ابن عبد ربه، وغيره لم يذكروا أبا بكر في جملة من
كان يحسن الكتابة في صدر الإسلام([57]).
الثاني:
أنه قد قال جمع: إن الكاتب لهذا الكتاب هو عامر بن
فهيرة([58]).
وما ذكر في السيرة الحلبية:
أنه «يمكن أن يكون كتب عامر بن فهيرة أولاً، فطلب سراقة
أن يكون أبو بكر هو الذي يكتب، فأمره «صلى الله عليه وآله» بكتابة ذلك([59]).
فأحدهما كتب في الرقعة من الأدم، والآخر كتب في العظم
أو الخرقة.
ولا يخفى بُعد ما في هذا التأويل، مع عدم الدليل على
ذلك».
بل لو صح هذا لتناقله الناس، ورووه لنا، لأن الإصرار
على أن يكون ابا بكر هو الكاتب للكتاب أمر لافت للنظر.
عن
أبي رهم الغفاري قال:
بينا رسول الله «صلى الله عليه وآله» يسير وأنا إلى جنبه، وعليّ نعلان
غليظان، إذ زحمت ناقتي ناقة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ويقع حرف
نعلي على ساق رسول الله «صلى الله عليه وآله» فأوجعته، فقال رسول الله
«صلى الله عليه وآله»: «أوجعتني أخر رجلك»، وقرع رجلي بالسوط.
فأخذني ما تقدم من أمري وما تأخر، وخشيت أن ينزل فيَّ
قرآن لعظم ما صنعت.
فلما أصبحنا بالجعرانة، خرجت أرعى الظهر وما هو يومي،
فرقاً أن يأتي رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ورسول الله يطلبني،
فلما روَّحت الركاب سألت.
فقيل لي:
طلبك رسول الله «صلى الله عليه وآله».
فقلت:
إحداهن والله، فجئت وأنا أترقب.
فقال:
«إنك أوجعتني برجلك، فقرعتك بالسوط فأوجعتك، فخذ هذه
الغنم عوضاً عن ضربي».
قال أبو رهم:
فرضاه عني كان أحب إليّ من الدنيا وما فيها.
وقال:
فأعطاني ثمانين نعجة بالضربة التي ضربني([60]).
ونقول:
1 ـ
كيف يصح هذا وهم يقولون: إن أبا رهم الغفاري لم يحضر
غزوة الفتح، وحنين والطائف؛ لأن النبي «صلى الله عليه وآله» كان قد
استخلفه على المدينة، فلم يزل بها حتى انصرف رسول الله «صلى الله عليه
وآله» من الطائف([61]).
فإما أن يكون المقصود أبا رهم آخر، وتكون كلمة «الغفاري» مقحمة من
الرواة، جرياً على عادتهم في إضافة توضيحات، بالاستناد إلى ما هو مرتكز
في أذهانهم.
أو تكون هذه الرواية مكذوبة من الأساس.
أو يقال:
إن أبا رهم لم يتول المدينة في مناسبة الفتح. بل تولاها
رجل آخر حسبما تقدم.
2 ـ
إن إعطاء النبي «صلى الله عليه وآله» لأبي رهم ثمانين
نعجة بالضربة التي ضربه إياها يثير أسئلة عديدة، حيث يقال: إذا كان قد
أعطاه هذه النعاج. لأجل إبراء ذمته من ضربته، فكيف يبادر النبي «صلى
الله عليه وآله» إلى إعطاء عوض بهذا الحجم؟!
وهل كان النبي «صلى الله عليه وآله» يضرب الناس
بالإستناد إلى ردة فعل لاشعورية، غير مدروسة، ولا خاضعة لضابطة؟!
وإذا كان ذلك الرجل قد أوجع النبي «صلى الله عليه
وآله»، ولم يكن لدى النبي «صلى الله عليه وآله» سبيل إلى التخلص من
معرته إلا بقرعه بالسوط، فما هو الضير في ذلك؟! شرط أن يبقى في الحدود
المسموح بها شرعاً وهي إشعار ذلك الرجل: بأن عليه أن يلتفت إلى نفسه،
ولا يؤذي الآخرين..
3 ـ
بالنسبة لتخوف أبي رهم من نزول القرآن فيه نقول:
إننا لم نجد مبرراً لهذا التخوف، فإن القضية لا تعدو أن
تكون أمراً غير مقصود لا يؤاخذ الله عليه، فكيف إذا كان قد أوجب لهم
الضيق والألم حين ظهر لهم وعرفوه؟! إن الله تعالى أكرم وأحلم وأرحم مما
يظنون..
ويقولون:
بينا رسول الله
«صلى الله عليه وآله» يسير ليلاً، بواد بقرب الطائف،
وذلك حين منصرفه عنها، إذ غشي سدرة في سواد الليل، وهو في وسن النوم،
فانفرجت السدرة له نصفين، فمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بين
نصفيها، وبقيت منفرجة على حالها([62]).
ونقول:
بديهي:
أن المعجزات والكرامات كانت تحدث وفق خطة إلهية هادفة،
ولم تكن مجرد هبات تأتي على غير انتظار، ومن دون وجه مصلحة، بل المصلحة
كانت هي المحور الأساس لها..
ويلاحظ:
أنه كلما كان النبي «صلى الله عليه وآله» يريد ان يقدم
على أمر حساس وكبير، ربما تأخذ الناس الشبهات والأوهام فيه يميناً
وشمالاً، أو كلما أراد أن يعالج أمراً يشكِّل خطراً على إيمان الناس،
فإنك تجد المعجزة أو الكرامة تظهر لهم، وتضبط حركتهم، وتعطيهم السكينة
والطمأنينة، وتعيدهم على حالة التوازن، وهي من مظاهر رحمة الله تعالى
بهم.
وقضية السدرة التي انفرجت لرسول الله «صلى الله عليه
وآله» تأتي في هذا السياق. فهي أمر صنعه الله تعالى لنبيه «صلى الله
عليه وآله»، لكي تتهيأ القلوب لتقبُّل الإجراء الذي سيتخذه في أمر
الغنائم، فلا يعطي منها الأنصار، ويخص بها المؤلفة قلوبهم. فإنه أجراء
سيكون قاسياً على المسلمين، الذين يرون أنهم أحق بها من كل أحد، لأنهم
تحملوا أعباء الأسفار، ولاقوا الأهوال والأخطار في حروب أثارها ضدهم
نفس هؤلاء الذين يأخذون غنائمها الآن، كما تؤخذ الغنيمة الباردة.
فإذا رأى هؤلاء هذه المعجزة لرسول الله «صلى الله عليه
وآله»، ثم بقيت آثارها ماثلة أمامهم، ويرونها بأعينهم، ويتحسسونها بكل
جوارحهم، فإن ذلك سيسهل عليهم قبول ذلك القرار الذي سيكون في غاية
الصعوبة عليهم، حيث سيشعرون في أجواء هذه المعجزة أنه ليس قراراً من
شخص الرسول «صلى الله عليه وآله»، بقدر ما هو قرار إلهي حكيم، وإن لم
يعرفوا وجه الحكمة فيه..
2 ـ
إن ما ذكرته الرواية: من انه «صلى الله عليه وآله» قد
اقتحم السدرة وهو في وسن النوم مما لا يمكن قبوله.. فإن قائل ذلك إنما
يتحدث عن حدسٍ وتخمين، لا عن حس ويقين.. فإن المفروض: أنهم يسيرون في
ظلمة الليل، فكيف رأى ذلك الشخص هذا الوسن في عين رسول الله «صلى الله
عليه وآله»؟!
ولم لا يقول:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد تعمد اقتحام السدرة،
ممتثلاً أمر الله تعالى له بذلك، لكي يصنع الله تعالى هذه المعجزة له
من أجل هذه المصلحة التي تهدف إلى حفظ إيمان الناس الذين معه، وإلى
صيانتهم من الوقوع في الأوهام المضلة؟!
ولكن هؤلاء الرواة يقيسون الأمور
على أنفسهم، ويرون:
أن حال رسول الله «صلى الله عليه وآله» يشبه حالهم.. مع
أن الأمر ليس كذلك.
([1])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص387 عن الواقدي، والسيرة الحلبية ج3
ص118 و (ط دار المعرفة) ص82 والإصابة ج4 ص291 والإستيعاب
(بهامش الإصابة) ج4 ص290 والسيرة النبوية لدحلان (ط دار
المعرفة) ج2 ص114 وعون المعبود ج8 ص184 وتاريخ الأمم والملوك
ج2 ص355 والبداية والنهاية ج4 ص401 والسيرة النبوية لابن كثير
ج3 ص662 وفتح الباري ج8 ص36 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص159
والكامل في التاريخ ج2 ص267 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص663
وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص599 وإمتاع الأسماع ج14 ص23 وعيون
الأثر ج2 ص232.
([2])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص387 عن ابن إسحاق، والسيرة الحلبية ج3
ص118 و (ط دار المعرفة) ص82 وتاريخ الخميس ج2 ص111 والسيرة
النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص114 وعون المعبود ج8 ص185
والبداية والنهاية ج4 ص401 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص662
وفتح الباري ج8 ص36 وإمتاع الأسماع ج14 ص25 وج14 ص22 والسيرة
النبوية لابن هشام ج4 ص922 والإستيعاب ج4 ص1832.
([3])
السيرة الحلبية ج3 ص118 و (ط دار المعرفة) ص81 وإمتاع الأسماع
ج14 ص21.
([4])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص388 عن البخاري، ومسلم، وقال في هامشه:
أخرجه البخاري (4325)، ومسلم في الجهاد باب غزوة الطائف (82)،
والبيهقي في الدلائل ج5 ص169.
وراجع: تاريخ الخميس ج2 ص111 و 112 والسيرة الحلبية ج3 ص118 و
(ط دار المعرفة) والسيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2
ص114 وشرح مسلم للنووي ج12 ص123 و 124 والمغني لابن قدامة ج10
ص545 ومسند أحمد ج2 ص11 وصحيح البخاري ج5 ص102 وصحيح البخاري
ج7 ص93 وصحيح مسلم ج5 ص169 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص43 وعمدة
القاري ج17 ص304 وج22 ص149 وج25 ص151 وجزء سفيان بن عيينة ص53
ومسند الحميدي ج2 ص309 والمصنف لابن أبي شيبة ج8 ص543 = =
ومسند أبي يعلى ج10 ص150 وصحيح ابن حبان ج11 ص101 ومعرفة علوم
الحديث ص95 وأحكام القرآن لابن العربي ج3 ص477 وتاريخ مدينة
دمشق ج37 ص256 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص595 والبداية
والنهاية ج4 ص401 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص661.
([5])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص388 والبداية والنهاية ج4 ص402 وإمتاع
الأسماع ج14 ص21 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص597 والسيرة
النبوية لابن كثير ج3 ص663 وعون المعبود ج8 ص185 ومسند أحمد ج3
ص157 وصحيح مسلم ج3 ص107.
([6])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص388 عن الواقدي، وتاريخ الخميس ج2 ص112
والسيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص114 وعيون الأثر
ج2 ص232 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص82 والطبقات
الكبرى لابن سعد ج2 ص159 وإمتاع الأسماع ج2 ص25 وج14 ص23.
([7])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص388 عن أحمد، ومسلم، وراجع: عمدة القاري
ج17 ص305 وإمتاع الأسماع ج2 ص22 وج8 ص388 وسبل السلام ج4 ص54
والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص191 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص600
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص673.
([8])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص388 وتاريخ الخميس ج2 ص111 والسيرة
النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص114 وإعلام الورى ص124 و
(ط آل البيت لإحياء التراث) ج1 ص235 والبحار ج21 ص168 و 169
وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص596 والسيرة النبوية لابن كثير ج3
ص663 والبداية والنهاية ج4 ص402 وإمتاع الأسماع ج14 ص24 وراجع:
عمدة القاري ج12 ص137 وج17 ص305 وعيون الأثر ج2 ص231 وراجع:
سبل السلام ج4 ص54.
([9])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص388 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص64 وعون
المعبود ج6 ص10 والجامع لأحكام القرآن ج8 ص66 وتاريخ الأمم
والملوك ج2 ص354 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص592 والبداية
والنهاية ج4 ص120 و 397 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2
ص47 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص920 والسيرة النبوية لابن
كثير ج3 ص201 و 656 وتاريخ خليفة بن خياط ص54 وراجع: سبل
السلام ج4 ص54.
([10])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص388 وعمدة القاري ج17 ص305.
([11])
السيرة النبوية لابن كثير ج3 ص656 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص388
وراجع: الإرشاد للمفيد ج1 ص153 وعمدة القاري ج17 ص305
والمستجاد من الإرشاد (المجموعة) ص93 وإمتاع الأسماع ج2 ص22
والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص47 وموسوعة الإمام علي بن
أبي طالب «عليه السلام» في الكتاب والسنة والتاريخ لمحمد
الريشهري ج1 ص257 عن: كشف الغمة ج1 ص223 وعن إعلام الورى ج1
ص387 وعن كشف اليقين ص175.
([12])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص388 وتاريخ الخميس ج2 ص110 وراجع: إعلام
الورى ص124 والإرشاد للمفيد ج1 ص153 والبحار ج21 ص164 و 168
وج41 ص95 وعن مناقب آل أبي طالب ج1 ص605 و 606.
([13])
إمتاع الأسماع ج2 ص22 وج8 ص388 وج14 ص20.
([14])
السيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص112 والسيرة
الحلبية ج3 ص116 و (ط دار المعرفة) ص78 وعمدة القاري ج17 ص305
وعيون الأثر ج2 ص231 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص158 وإمتاع
الأسماع ج2 ص22 وج8 ص388 وج14 ص20.
([15])
البحـار ج21 ص152 وج40 ص30 والأمـالي للطـوسي ص516 وراجع: = =
عمدة القاري ج17 ص305 وعيون الأثر ج2 ص231 وراجع: والسيرة
النبوية لابن هشام ج4 ص920 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص656.
([16])
الأربعون حديثاً لمنتجب الدين بن بابويه ص26 والمستدرك للحاكم
ج2 ص120 ومجمع الزوائد ج9 ص134 والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص498
ومعجم الرجال والحديث لمحمد حياة الأنصاري ج2 ص106 وتاريخ
مدينة دمشق ج42 ص342 و 243 ومناقب علي بن أبي طالب للأصفهاني
ص254 وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» في الكتاب
والسنة والتاريخ ج9 ص434 وشرح إحقاق الحق ج6 ص450 وج31 ص112
وج33 ص79.
([17])
خلاصة عبقات الأنوار ج1 ص296 والإمام علي بن أبي طالب «عليه
السلام» للرحماني ص284 ومجمع الزوائد ج9 ص163 ومعجم الرجال
والحديث لمحمد حياة الأنصاري ج2 ص5 وتاريخ مدينة دمشق ج42 ص343
وينابيع المودة ج1 ص124 وج2 ص402 وشرح إحقاق الحق ج6 ص450 وج17
ص16 وج24 ص209.
([18])
مناقب آل أبي طالب «عليه السلام» للكوفي ج1 ص488 والأمالي
للطوسي ص504 والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص543 ومسند أبي يعلى ج2
ص165 وكنز العمال ج13 ص163 وشرح إحقاق الحق ج17 ص16 و 17 وج22
ص481 و 482 والإكمال في أسماء الرجال للخطيب التبريزي ص139
وفضائل أمير المؤمنين «عليه السلام» لابن عقدة الكوفي ص191.
([19])
عمدة القاري ج17 ص305 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص47
وعيون الأثر ج2 ص231 وفتوح البلدان ج1 ص65 وإمتاع الأسماع ج8
ص388 وج14 ص20.
([20])
السيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص114.
([21])
إعلام الورى ص124 و (ط مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم) ج1
ص235 والبحار ج21 ص169 و 176 وراجع: تاريخ الأمم والملوك ج2
ص355 والكامل في التاريخ ج2 ص267 والبداية والنهاية ج4 ص402
وإمتاع الأسماع ج14 ص32 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص922
والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص662.
([22])
السيرة الحلبية ج3 ص118 و (ط دار المعرفة) ص81.
([23])
إعلام الورى ص124 و (ط مؤسسة آل البيت) ج1 ص235 والبحار ج21
ص169 و 176.
([24])
تاريخ الخميس ج2 ص112 وراجع: السيرة النبوية لدحلان (ط دار
المعرفة) ج2 ص114 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص158 وتاريخ
الأمم والملوك ج2 ص355 والكامل في التاريخ ج2 ص267 وعيون الأثر
ج2 ص231 والبداية والنهاية ج4 ص402 والسيرة النبوية لابن هشام
ج4 ص924 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص664 وتاريخ خليفة بن
خياط ص56 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص78.
([25])
تاريخ الخميس ج2 ص112 وراجع: السيرة النبوية لدحلان (ط دار
المعرفة) ج2 ص114 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص355 والبداية
والنهاية ج4 ص402 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص924 والسيرة
النبوية لابن كثير ج3 ص664.
([26])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص388 و 389 وراجع: تاريخ الخميس ج2 ص110
و 112 وتاريخ خليفة بن خياط ص55 و 56 والسيرة النبوية لابن
هشام ج4 ص923 و 924 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص663 الطبقات
الكبرى لابن سعد ج2 ص152 والبداية والنهاية ج4 ص402.
([27])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص389 وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج2
ص152.
([28])
إمتاع الأسماع ج2 ص25.
([29])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص389 والسيرة الحلبية ج3 ص118 و (ط دار
المعرفة) ص82 والآحاد والمثاني ج1 ص468 والإستيعاب ج3 ص874
والثقات ج2 ص171 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص474 والكامل في
التاريخ ج2 ص341 وتاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص49 والوافي
بالوفيات ج17 ص49 والبداية والنهاية ج6 ص372.
([30])
الآيتان 2 و 3 من سورة الصف.
([31])
راجع: السيرة الحلبية ج3 ص118 والإصابة ج4 ص357 والإستيعاب
(مطبوع بهامش الإصابة) ج4 ص365 و 366 و (ط دار الجيل) ص1878
وأسد الغابة ج5 ص498 وكنز العمال ج16 ص553 والفائق في غريب
الحديث ج3 ص203 وخزانة الأدب ج10 ص405.
([32])
البداية والنهاية ج8 ص23 و (ط دار إحياء التراث) ص26 والغدير
ج10 ص38 وكنز العمال ج13 ص633 والطبقات الكبرى لابن سعد ج8
ص265 والإصابة ج8 ص228.
([33])
الطبقات الكبرى لابن سعد (ط ليدن) ج8 ص193 و 194 و (ط دار
صادر) ص265 و 266 والإصابة ج4 ص357 و (ط دار الكتب العلمية) ج8
ص228 ومنتخب كنز العمال (مطبوع مع مسند أحمد) ج5 ص279 وكنز
العمال ج13 ص633.
([34])
الطبقات الكبرى لابن سعد (ط ليدن) ج8 ص194 و (ط دار صادر) ص265
و 266 وكنز العمال ج13 ص633 والإصابة ج8 ص228.
([35])
الطبقات الكبرى لابن سعد (ط ليدن) ج8 ص194 و (ط دار صادر)
ص266.
([38])
الطبقات الكبرى لابن سعد (ط ليدن) ج8 ص194 و (ط دار صادر)
ص266.
([39])
الطبقات الكبرى لابن سعد (ط ليدن) ج8 ص194 و (ط دار صادر) ص265
وكنز العمال ج13 ص633 ومنتخب كنز العمال (مطبوع بهامش مسند
أحمد) ج5 ص279 والغدير ج10 ص38.
([40])
راجع: الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ص30 حتى 37 وراجع: حاشية
الدسوقي ج2 ص227 والمجموع للنووي ج16 ص165 و 170 وبدائع
الصنائع ج2 ص244 ونيل الأوطار ج6 ص252 و 253 وصحيح البخاري ج8
ص63 وعمدة القاري ج20 ص128 وكتاب الأم للشافعي ج5 ص20 والجوهر
النقي ج7 ص115 و 116 والمحلى ج9 ص459 ومعرفة السنن والآثار ج5
ص241 والإستذكار ج5 ص398 و 402 والتمهيد ج19 ص79 و 100 و 318
والكافي لابن عبد البر ص232 وفيض القدير ج1 ص76 ومجمع الزوائد
ج4 ص279 والآحاد والمثاني ج4 ص386 والجامع الصغير ج1 ص7.
([41])
الإصابة ج4 ص357 و (ط دار الكتب العلمية) ج8 ص227 والإستيعاب
(مطبوع مع الإصابة) ج4 ص366 و (ط دار الجيل) 1876 ـ 1880 وأسد
الغابة ج5 ص499 والدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص321
والبداية والنهاية ج8 ص64 و (ط دار إحياء التراث العربي) ج6
ص389 وراجع ص26 ج7 ص157 والأعلام ج3 ص242 وراجع: المعارف لابن
قتيبة ص246 والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص112 وأنساب الأشراف
ص260 والسيرة الحلبية ج3 ص83.
([42])
راجع: الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص321 و 322 ومعجم
البلدان للحموي ج4 ص445 وشرح إحقاق الحق ج27 ص491 وراجع:
الإستيعاب = = ج4 ص1880 وراجع: الوافي بالوفيات ج16 ص319.
([43])
راجع: الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص321 و 322 وعن تذكرة
الخواص ص148.
([44])
الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص321 وراجع: الطبقات
الكبرى ج3 ص112 والوافي بالوفيات ج16 ص319 والسيرة الحلبية ج3
ص83.
([45])
الإصابة ج4 ص357 والإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج4 ص365 و (ط
دار الجيل) ص1878 وأسد الغابة ج5 ص498. وراجع أغلب المصادر
المتقدمة فإنها ذكرت أن عمر تزوج عاتكة بعد عبد الله بن أبي
بكر، إضافة إلى روايات استفتاء علي «عليه السلام» في أمر
زواجها بعمر.
([46])
البداية والنهاية ج8 ص26.
([47])
الآية 3 من سورة الصف.
([48])
راجع: الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص321 وراجع: أسد
الغابة ج5 ص498 وكنز العمال ج16 ص553، وفيه أن عاتكة هي التي
استفتته.
([49])
راجع: كنز العمال ج16 ص534 والمصنف للصنعاني ج6 ص152 والطبقات
الكبرى ج3 ص289 والغدير ج10 ص37 والمصنف لابن أبي شيبة ج3 ص433
و 466.
([50])
راجع: المحلى ج2 ص188 وسنن ابن ماجة ج1 ص213 وكنز العمال ج16
ص566 والسنن الكبرى للبيهقي ج1 ص316 والغدير ج10 ص37 وبغية
الباحث عن زوائد مسند الحارث ص46.
([51])
الآية 178 من سورة البقرة.
([52])
الجامع لأحكام القرآن ج2 ص210 وجامع البيان للطبري ج2 ص96 و (ط
دار الفكر) ص225 وتفسير القرآن العظيم ج1 ص220 والغدير ج10 ص38
وتخريج الأحاديث والآثار ج1 ص115 والدر المنثور ج1 ص197 وتفسير
الآلوسي ج2 ص64.
([53])
البحار ج21 ص181 ومجمع البيان ج5 ص18 و 19 و (ط دار الفكر) ص35
وتفسير الميزان ج9 ص232 وتفسير الثعلبي ج5 ص24 وتفسير البغوي
ج2 ص279 وتفسير القرآن العظيم ج1 ص235 ومجمع البحرين ج1 ص590.
([54])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص389.
([55])
سبل الهدى والرشاد ج2 ص262 وج5 ص360 ومجمع البحرين ج3 ص247 و
(ط سنة 1408هـ) ج1 ص376 وتارج العروس ج6 ص201 وكشف اللثام (ط
ق) ج1 ص307 (ط ج) ج5 ص219 والحدائق الناضرة ج14 ص456 وكشف
الغطاء (ط ق) ج2 ص448 والمصباح المنير ج1 ص141 مادة «جعر».
([56])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص389 وراجع: السيرة النبوية لابن كثير ج2
ص114 والسيرة الحلبية ج3 ص119 والبداية والنهاية ج5 ص18 و 348
و 351 والجامع للقيرواني ص268 والسيرة النبوية لابن هشام ج2
ص134 والمغازي للواقدي ج3 ص941 والتراتيب الإدارية ج1 ص123
والمعجم الكبير ج7 ص158 و 159 ودلائل النبوة لأبي نعيم ص278
وراجع: أسد الغابة ج2 ص265 وإمتاع الأسماع للمقريزي ج2 ص26 و
27.
([57])
مكاتيب الرسول ج1 ص106 و 117 وراجع: العقد الفريد ج4 ص157 و
158 وراجع: فتوح البلدان ص660 و (ط مكتبة النهضة المصرية) ج3
ص583 والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج8 ص120 و 199 و.
([58])
مكاتيب الرسول ج1 ص146 و 168 عن المصادر التالية: المصنف لعبد
الرزاق ج5 ص394 والشفاء للقاضي ج1ص687 ومسند أحمد ج4 ص176
والدر = = المنثور ج3 ص244 عن عبد الرزاق، وأحمد، وعبد بن
حميد، والبخاري، وابن المنذر، وابن أبي حاتم من طريق الزهري عن
عروة عن عائشة. وراجع: البخاري ج5 ص76 والمستدرك للحاكم ج3 ص7
والبداية والنهاية ج3 ص185 وج5 ص348 وراجع: فتح الباري ج7 ص188
والسيرة الحلبية ج2 ص48 وعمدة القاري ج17 ص48 والتراتيب
الإدارية ج1 ص123 والمعجم الكبير للطبراني ج7 ص157 و (ط دار
إحياء التراث) ص133. وراجع: تاريخ مدينة دمشق ج4 ص342 والبداية
والنهاية (ط دار إحياء التراث العربي) ج5 ص370 و 373 وإمتاع
الأسماع ج1 ص60 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص685 و 691 وسبل
الهدى والرشاد ج3 ص248 وج5 ص389 وج11 ص385 والسيرة الحلبية (ط
دار المعرفة) ج2 ص220 وصحيح ابن حبان ج14 ص186 والثقات ج1 ص123
وتاريخ الإسلام للذهبي ج1 ص326.
([59])
مكاتيب الرسول ج1 ص146 عن الحلبي، وراجع: السيرة الحلبية (ط
دار المعرفة) ج2 ص220.
([60])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص390 عن الواقدي، وابن إسحاق، وراجع:
مكارم الأخلاق لابن ابي الدنيا ص123 وتاريخ الأمم والملوك ج2
ص360 والبداية والنهاية ج4 ص407 والسيرة النبوية لابن كثير ج3
ص672 والطبقات الكبرى لابن سعد ج4 ص244.
([61])
الإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج4 ص69 و (ط دار الجيل) ج3 ص1327
وراجع: الإصابة ج4 ص71 وتاريخ خليفة بن خياط ص60 والبحار ج28
ص170 والوافي بالوفيات ج24 ص270 وأسد الغابة ج5 ص197.
([62])
السيرة الحلبية ج3 ص119 و (ط دار المعرفة) ص83 والبحار ج17
ص375 ومستدرك سفينة البحار ج5 ص8 وإعلام الورى ج1 ص88.
|