أحــداث وقــضـــــــأيـــــــــا
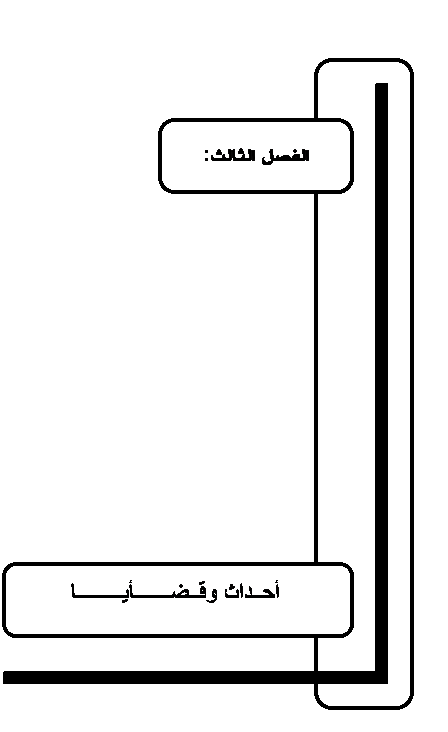
وأقام «صلى الله عليه وآله» بالمدينة ما بين ذي الحجة
إلى رجب([1]).
قالوا:
وحج بالناس في تلك السنة ـ وهي سنة ثمان ـ عتَّاب بن
أسيد.
وذلك:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لما فتح مكة استعمله
عليها للصلاة والحج([2])،
فحج بالناس تلك السنة على ما كان عليه الناس في الجاهلية([3])،
ثم كانت غزوة تبوك.
ونقول:
قد يقال:
لماذا لم يبقَ «صلى الله عليه وآله» في مكة إلى ذي
الحجة الذي أصبح على الأبواب، ولم يكن قد بقي لحلوله سوى أيام قليلة،
ليحج هو بالناس؟!.
مع أنه «صلى الله عليه وآله» حين عاد إلى المدينة لم
يقم بعمل أساسي، طيلة أكثر من سبعة أشهر.
وقد يمكن أن يكون الجواب:
أنه «صلى الله عليه وآله» يريد أن يتلافى ما كان قد جرى
في مؤتة، بإفهام الروم، وخصوصاً بعد فتح مكة، وامتداد نشاطه إلى مناطق
اليمن: أنه بعد مؤتة لم ينكفىء إلى الداخل، لأنه يشعر بالضعف والعجز عن
مواجهتهم، وأن مؤتة لم تفرز لديه شعوراً من هذا القبيل، بل توجه إلى
الداخل ليهييء أسباب القوة، وليزيل أعتى قوى الشرك في المنطقة، ثم هو
بعد ذلك لم يزل راصداً لتحركات كل من تحدثه نفسه بالعدوان، أو
بالإنتقاص من حقه، وحق أهل الإسلام، بل وسائر المستضعفين في الأرض.
وقد ذكروا في جملة أحداث السنة
الثامنة:
صنع المنبر لرسول الله «صلى الله عليه وآله» بعد أن كان
يقف حين يخطب عند جذع كان هناك. فلما ترك النبي «صلى الله عليه وآله»
الجذع سمعوا له حنيناً..
وقد تقدمت هذه القضية بشيء من التفصيل في أحداث السنة
السابعة للهجرة، فأغنانا ذلك عن الإعادة هنا.
وذكروا في أحداث السنة التاسعة
للهجرة في شهر رجب موت النجاشي ملك الحبشه، واسمه أصحمة. وأن النبي
«صلى الله عليه وآله» أخبر المسلمين بموته في نفس اليوم الذي مات فيه.
وصفَّهم وصلى عليه، وكبّر عليه أربع تكبيرات، وقال: استغفروا لأخيكم([4]).
ولكننا قد تحدثنا عن هذا الأمر في أحداث السنة السابعة.
فراجع فصل: شخصيات.. وأحداث إلى عمرة القضاء.
وقلنا:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد كبر عليه خمساً..
وذكرنا تفاصيل أخرى تحسن مراجعتها.
قالوا:
وفي السنة التاسعة باع بعض المسلمين أسلحتهم، وقالوا:
انقطع الجهاد.
فقال
«صلى الله عليه وآله»:
لا ينقطع الجهاد حتى ينزل عيسى بن مريم([5]).
ونقول:
إن في بيع هؤلاء أسلحتهم دلالة واضحة على قصر نظرهم
وعدم التزامهم بتوجيهات قيادتهم، فهم قد باعوا أسلحتهم دون أن يراجعوا
النبي «صلى الله عليه وآله» ليستجيزوه بذلك، أو ليعرفوا رأيه فيما
يقدمون عليه..
ثم إن مما يؤكد ضيق أفق تفكيرهم:
أنهم ظنوا أن
أقصى ما يريده الله ورسوله هو: دخول الإسلام إلى مكة والحجاز، ولا شيء
أكثر من ذلك، مع أن الله تعالى لم يزل يقول لنبيه الكريم: إنه مرسل
للبشرية جمعاء، فقد قال تعالى: {نَذِيراً
لِّلْبَشَرِ}([6])،
{لِيَكُونَ
لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً}([7])،
{إِنْ هُوَ
إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ}([8])،
{وَمَا هُوَ
إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ}([9])،
{وَمَا
أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}([10])
وغير ذلك..
ودخول جزيرة العرب في الإسلام، وردُّ تحديات سكانها،
وسقوط الشرك، واستسلام رموزه لا يعني شمول دعوة الإسلام للعالم كله،
ولا يمنع من ظهور تحديات أعتى وأقوى من قبل قوى الإستكبار في دولتي
الأكاسرة والقياصرة وسواهما، ممن يمكن أن يجد في نفسه القوة لمواجهة
أهل الإيمان.
وبعد انصراف النبي «صلى الله عليه وآله» من الطائف قدم
كعب بن زهير على النبي «صلى الله عليه وآله» فأنشده قصيدته التي أولها:
بانـت سعاد
فقلبي اليـوم متـبـول مـتـيـم إثــرهــا لم يـفـد
مكبـول
وأسلم بعد أن كان النبي «صلى الله عليه وآله» قد أهدر
دمه([11]).
وقد روى البيهقي، وأبو بكر محمد بن القاسم بن بشار،
وأبو البركات عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي الأسعد الأنباريان، قال:
خرج كعب وبجير ابنا زهير حتى أتيا أبرق العراف (العراق)، فقال بجير
لكعب: أثبت في عجل هذا المكان، حتى آتي هذا الرجل، يعني رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، فأسمع ما يقول.
فثبت كعب، وخرج بجير، فجاء رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، فسمع كلامه فآمن به.
وذلك:
أن زهير بن أبي سلمى ـ فيما يزعمون ـ كان يجالس أهل
الكتاب، فسمع منهم أنه قد آن مبعث نبي.
ورأى زهير في منامه:
أنه قد مد سبباً من السماء، وأنه قد مد يده ليتناوله
ففاته، فأوله بالنبي «صلى الله عليه وآله» يبعث، وأنه في آخر الزمان لا
يدركه، وخبّر بنيه بذلك، وأوصاهم إن أدركوا النبي «صلى الله عليه وآله»
أن يسلموا.
ولما اتصل خبر إسلام بجير لأخيه أغضبه ذلك، فقال:
ألا
أبـلـغـن عني بجـيراً رسـالــة فهل لك فيما قلت ويحك
هل لكـا
فـبـين لنـا إن كنـت لست بفاعـل عـلى أي شـيء غـير ذلـك دلكــا
على خلق لم تلق (تلف) أماً ولا أباً عـلـيـه ولم تـدرك
عـلـيه أخاً لكـا
فإن أنـت لم تفـعـل فلست بآسف ولا قـائـل إمـا عـثـرت
لعـاً لكــا
سقـاك بهـا المــأمــون كأسا روية فانهـلـك المـأمـون
مـنـها وعلكا([12])
وفي الإستيعاب:
شـربـت
بكـأس عنـد آل محـمـد وانـهـلـك المـأمـور فيها وعلكا([13])
وبعث بها إلى بجير، فلما أتت بجيراً كره أن يكتمها رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، فأنشده إياها، فقال رسول الله «صلى الله
عليه وآله»: «سقاك بها المأمون! صدق، وإنه لكذوب، وأنا المأمون».
وأهدر دمه، وقال:
من لقي كعباً فليقتله، فكتب بجير إلى أخيه يذكر أن رسول
الله «صلى الله عليه وآله» قد أهدر دمه، وقال: من لقي كعباً فليقتله،
وليقول له: النجاء، وما أراك تنفلت.
ثم كتب إليه بعد ذلك:
اعلم أن رسول الله لا يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا
الله، وأن محمداً رسول الله إلا قبل ذلك منه، وأسقط ما كان قبل ذلك،
فإذا جاءك كتابي هذا فأسلم، وأقبل([14]).
وذكر ابن إسحاق:
أن بجيراً كتب إليه:
فمن مبـلـغ كعبـاً فهل لك في التي تـلـوم
عـلـيـها باطلاً وهي أحـزم
إلى الله لا العزى ولا اللات وحـده فـتـنـجو إذا كـان النجاء
وتسـلـم
لدى يوم لا تـنـجو ولست بمفلت من الناس إلا طـاهر القلب مسلم
فـديـن زهـير وهـو لا شـيء دينـه وديـن أبـي سـلـمـى عـليّ
محــرم
فلما بلغ كعباً الكتاب ضاقت به الأرض، وأشفق على نفسه.
وأرجف به من كان في حاضره من عدوه، فقالوا: هو مقتول، فلما لم يجد من
شيء بداً قال قصيدته التي مطلعها:
بانـت سعـاد فـقـلبي اليوم
متبول مـتـيـم إثـرهـا لم يـفـد مـكـبول([15])
قال العسقلاني:
وأسلم كعب، وقدم حتى أناخ بباب المسجد، قال: فعرفت رسول
الله «صلى الله عليه وآله» بالصفة، فتخطيت حتى جلست إليه فأسلمت، ثم
قلت: الأمان يا رسول الله، أنا كعب بن زهير.
قال:
أنت الذي تقول، والتفت إلى أبي بكر، فقال: كيف قال.
فذكر الأبيات الثلاثة، فلما قال:
فانهلك المأمور، قلت: يا رسول الله، ما هكذا قلت، وإنما
قلت: المأمون.
قال مأمون والله، وأنشده القصيدة([16])..
إلى أن يقول فيها:
نـبـئـت أن
رسـول الله أوعـدني والـعـفو عنـد رسـول الله مـأمول
وفيها:
إن الـرسـول
لنـور يستضاء بـه مـهـنـد من سيـوف الله مسـلــول
فكساه رسول الله «صلى الله عليه وآله» بردة له،
فاشتراها معاوية من ولده، فهي التي يلبسها الخلفاء في الأعياد.
وقد مدح فيها المهاجرين، ولم يذكر الأنصار، وفيها:
في فتية من قريش
قـال قائلـهم بـبـطـن مـكـة لمـا أسلموا زولـوا
فكلمته الأنصار، فصنع فيهم شعراً([17]).
ونقول:
إن لنا هنا بعض الوقفات والإيضاحات، وهي كما يلي:
ذكرت بعض الروايات:
أن كعب بن زهير قدم المدينة، فسأل عن أرقّ أصحاب رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، فدل على أبي بكر، فأخبره خبره، فمشى أبو
بكر، وكعب على أثره، وقد التثم، حتى صار بين يدي النبي «صلى الله عليه
وآله»، فقال: رجل يبايعك.
فمد النبي «صلى الله عليه وآله» يده، فمد كعب يده،
فبايعه وأسفر عن وجهه، فأنشده قصيدته..([18]).
وهي رواية نشك في صحتها، وذلك لما يلي:
أولاً:
إن ما تقدم عن العسقلاني يبين: أن كعباً قد وصل مباشرة
إلى رسول «صلى الله عليه وآله»، ولم يتوسط له أحد، لا أبو بكر، ولا
غيره.
ثانياً:
إن الوساطة التي تذكرها هذه الرواية لم يكن لها أثر،
حيث إن الرجل جاء ملثماً، وقد مشى إلى النبي «صلى الله عليه وآله» حتى
صار عنده فبايعه، ولم نجد أبا بكر قد شفع له، أو تكلم في أمره، أو هوّن
من جرمه، أو دفع أحداً عنه، أو نحو ذلك.
ثالثاً:
هل صحيح أن أبا بكر كان أرقّ أصحاب رسول الله «صلى الله
عليه وآله»؟! فلماذا إذن أصرّ على حرب الذين لم يعترفوا بخلافته، وسفك
دماءهم، وسبى نساءهم، بل أباح تلك النساء لقائد جيشه خالد بن الوليد،
ليزني بهن في ليلة قتل أزواجهن، كما جرى لزوجة مالك بن نويرة، حيث زنى
خالد بزوجته بعد قتله مباشرة، واعتبر أبو بكر فاعل ذلك سيف الله
المسلول على أعدائه، ومنحه وسام الإجتهاد، لكي يثيبه على فعله هذا
ثواباً واحداً على الأقل.
ولم تتحرك عاطفة أبي بكر، ولم تظهر رقته لرأس مالك بن
نويرة، وهو يجعل أثفية للقِدْرِ التي كان خالد يهيّيء فيها وليمة زناه
بزوجة ذلك المقتول صاحب الرأس في ليلة قتله.
رابعاً:
هل كان أبو بكر أرق من رسول الله «صلى الله عليه
وآله»؟! وهل يحتاج النبي «صلى الله عليه وآله» إلى من يرققه على
الآخرين، في حين أنه هو الذي صرحت الآيات: بأن نفسه كانت تذهب حسرات
على من يتخذ سبيل الشرك والإنحراف، حتى لقد خاطبه الله تعالى بقوله:
{فَلَا
تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ}([19])،
وقال سبحانه: {فَلَعَلَّكَ
بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا
الحَدِيثِ أَسَفاً}([20]).
إلا أن يقال:
إن كعب بن زهير كان لا يعرف الكثير عن رسول الله «صلى
الله عليه وآله»..
خامساً:
قد صرحت الروايات المتقدمة: بأن بجيراً قد ذهب إلى
النبي «صلى الله عليه وآله» وأسلم، ثم كتب إلى أخيه كعب بن زهير يخبره
بأن من عادة النبي «صلى الله عليه وآله»: أنه لا يأتيه أحد يشهد أن لا
إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، إلا قبل ذلك منه، وأسقط ما كان
قبل ذلك([21]).
فلماذا يريد ترقيق رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!
ولماذا يبحث عن أرقّ رجل في المدينة؟! فإنه كان يعلم أن المشكلة
محلولة..
وإنما قدم كعب إلى المدينة على هذا الأساس.
سادساً:
قد يقال: إن كعباً إنما خاف أن يقتله أحد من المسلمين
تنفيذاً لأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله»، الذي أهدر دمه، فكان
يحتاج إلى من يحميه من الناس إلى أن يصل إلى رسول الله «صلى الله عليه
وآله»..
وجوابه:
أن هذا غير وارد، فإن المفروض: أن كعباً قد دخل
المدينة، وصار يسأل عن أرق الناس، حتى وصل إلى أبي بكر، ولم يقتله
أحد.. فلماذا لا يصل إلى النبي «صلى الله عليه وآله» بنفس الطريقة؟!
وهل كان وصوله إلى أبي بكر أيسر من وصوله إلى النبي «صلى الله عليه
وآله».
على أنهم يذكرون:
أنه جاء إلى النبي «صلى الله عليه وآله» متلثماً، ولم
يعترضه أحد، فماذا لو أنه أتى إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»
متلثماً من أول الأمر، وقبل أن يوسط أحداً من الناس.
سابعاً:
قال القسطلاني: إن كعب بن زهير «لما لم يجد من شيء بداً
قال قصيدته التي يمدح بها رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ويذكر خوفه،
وإرجاف الوشاة به من عدوه، ثم خرج حتى قدم المدينة، فنزل على رجل كانت
بينه وبينه معرفة، من جهينة. فغدا به إلى رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، فقال: هذا رسول الله، فقم إليه واستأمنه.
فقام حتى جلس إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فوضع
يده في يده ـ وكان «صلى الله عليه وآله» لا يعرفه، فقال: يا رسول الله،
إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك تائباً مسلماً، فهل أنت قابل منه، إن
انا جئتك به؟
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
نعم.
قال:
أنا يا رسول الله كعب بن زهير».
قال ابن إسحاق:
فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أنه وثب عليه رجل من
الأنصار وقال: يا رسول الله، دعني وعدو الله أضرب عنقه.
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»:
دعه عنك، فإنه قد جاء تائباً نازعاً.
قال:
فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم([22]).
ثم ذكر شطراً من قصيدته حتى انتهى إلى قوله الذي يمدح
فيه قريشاً ويهجو الأنصار، وهو:
في عـصـبـة من قـريـش قـال
قائلها بـبـطـن مـكـة لمـا أسلـموا زولوا
يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم
ضـرب إذا عـرّد السـود الـتـنابيل
قال ابن إسحاق:
قال عاصم بن عمرو بن قتادة: فلما قال كعب: «إذا عرد
السود التنابيل»، وإنما عنى معشر الأنصار لما كان صاحبهم صنع به، وخص
المهاجرين بمدحته، غضب عليه الأنصار، فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار:
مـن
سـره كـرم الحيـاة فـلا يــزل في مـقـنـب من صـالحي
الأنصـار
البـاذلـين نـفـوسـهـم لـنـبـيـهم يـوم الهـيـاج وفـتـيـــة
الأحـبـار
والضاربين الناس عن أحياضهم بـالمـشـرق وبـالـقـنـــا
الخـطــار
والـنـاظـريـن بـأعـين محـمـــرة كـالجمر غــير كـلـيـلـة
الأبصـار
يـتـطـهـرون كـأنـه نـسـك لهـم بـدمـاء مـن عـلـقـوا مـن
الكفار
لـو يـعـلـم الأقـــوام علمي كله فيهم لصدقـني الـذيـن
أمــاري([23])
فهذا النص يشير إلى أمرين:
أحدهما:
أن كعب بن زهير قد أعد قصيدته قبل أن يقدم المدينة،
ويدخل على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ثم تلاها عليه «صلى الله
عليه وآله» في نفس هذا المجلس، فلا يصح زعم هذا النص أنه قد هجا
الأنصار في هذه القصيدة بالذات، لأجل أن أحدهم لما رآه عند النبي «صلى
الله عليه وآله» قال له: دعني وعدو الله أضرب عنقه.
الثاني:
إنه يقول: إن كعباً قد نزل على رجل من جهينة كانت بينه
وبينه معرفة، فأخذه الجهني إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله».. فلا
يصح قولهم: إنه نزل على أبي بكر، وإن أبا بكر هو الذي اصطحبه إلى النبي
«صلى الله عليه وآله».
وعن سبب إهدار النبي «صلى الله عليه وآله» دم كعب بن
زهير نقول:
لقد كان للشعر تأثيره العميق، وللشعراء دورهم الحساس في
حياة الناس، وفي مشاعرهم وفكرهم، وبلورة مواقفهم. فالشاعر يستطيع أن
يكون له دوره القوي، والفاعل ـ بل والحاسم أحياناً ـ في هداية الناس
وضلالهم، وفي عزهم وذلهم، وإلحاق الخزي والعار بهم، لمجرد اختراع
اخترعه، أو حديث وهمي ابتدعه، أو إفك صنعه، أو بهتان وضعه.
فالشاعر تاجر فاجر، يتاجر بأعراض الناس، ويبتزهم،
ويعتدي على كراماتهم بالظلم والطغيان، وبالإفك والبهتان عليهم في وضح
النهار، من دون أن يرمش له جفن، أو أن يتكدر له خاطر..
والشاعر يوقظ غرائز الناس ويثيرها، ويستخف عقولهم،
ويتلاعب بأهوائهم، والشاعر معتد أثيم، وعتل زنيم. يقول ما لا يفعل،
ويخوض مع الخائضين، ويهيم في ظلمات الجهل، ووهم الهوى مع الهائمين..
قال تعالى:
{وَالشُّعَرَاء
يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ
يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ}([24]).
وكان كعب بن زهير قد شرع يحرك حربة شعره التضليلي، الذي
يرتكز إلى الإفك والبهتان، وينضح بالإثم والعدوان ليسددها إلى قلب
الهدى، وعنوان السداد والرشاد، ليختطف منه نوره الباهر، ووضوحه وبهاءه
الظاهر، ليجعله أسيراً بأيدي الأهواء، حيث تتحكم به النفوس الطامحة وهي
غارقة في حمأة شهواتها، ورهينة لدى الغرائز الجامحة في نزواتها.
وقد كان خُلُق رسول الله «صلى الله عليه وآله» آية من
آيات الجمال والكمال، الذي شهد به القاصي والداني، واعترف به العدو
والصديق.
ورغم كل الحقد الذي كان يعتلج في صدورهم، فإن ذلك الخلق
الرضي كان يجتذبهم إلى هذا الدين، ويزيل غيظهم، ويذهب بحقدهم، لأنه كان
يلامس وجدانهم، ويخاطب عقولهم، وينسجم مع فطرتهم.
وقد حاول كعب بن زهير:
أن يستخف عقول الناس، ويستثير فيهم أهواءهم وغرائزهم،
لكي يهيمن على مشاعرهم، ويقيم الحواجز والسدود التي تعزل ضمائرهم
وفطرتهم، وتحجبها عن ملامسة ذلك الخلق الرضي، حتى لا يبقى للناس سبيل
هداية، ولا بصيص نور رشاد، ولا سداد، من دون أن يقدم أي مبرر لفعله
هذا، مهما كان تافهاً وسخيفاً، سوى أن خُلُق النبي «صلى الله عليه
وآله» يخالف خُلُق الآباء ومن تابعهم، فقال:
على خلق لم
تلق (تلف) أماً ولا أباً عـلـيـه ولم تـدرك عـليـه أخـاً
لكا
إن كعب بن زهير قد اقترف بفعله الرخيص هذا أعظم
الجرائم، وأقبحها، من حيث إنه يريد أن يحرم الناس من الحياة ويسوقهم
إلى البوار والهلاك، في الدنيا والآخرة، فلماذا لا يهدر النبي «صلى
الله عليه وآله» دمه؟! ويأمر كل من رآه بأن ينفذ حكم الله فيه؟! إلا أن
يتوب وينيب إلى الله، ويتخلى عن هذا الظلم الظاهر، والعدوان السافر على
الناس في أعز شيء لديهم.. فإن
{مَن
قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً}([25]).
وقد ذكرت النصوص المتقدمة:
شراء معاوية من ولد كعب بن زهير تلك البردة التي كساها
النبي «صلى الله عليه وآله» كعباً. وأن الخلفاء كانوا يلبسونها في
الأعياد.
ولكن مما لا شك فيه:
أن معاوية لم يكن من أهل الإعتقاد برسول الله «صلى الله
عليه وآله» إلى الحد الذي يدعوه للتبرك بآثاره، والإهتمام بشرائها
وتوريثها لمن بعده.. كيف!! وهو الذي أقسم على دفن اسم رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، وإسقاطه من الأذان.. فقال حين سمع الأذان: لا والله،
إلا دفناً دفناً([26]).
وقد كان معاوية من الطلقاء، ومن طلاب الدنيا، وقد تآمر
على عثمان حتى قتل، وحارب وصي رسول الله «صلى الله عليه وآله»..
ويكفيه:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» دعا عليه؛ بأن لا
يشبع الله له بطناً([27]).
وقد لعنه ولعن أباه وأخاه، فقال:
لعن الله الراكب، والقائد،
والسائق([28]).
فشراء معاوية للبردة إنما هو لأجل أن يتخذ منها شركاً
يصطاد به قلوب الناس، ويعمِّي عليهم الأمور، وليوحي لهم: بأنه يقدِّس
الرسول، ويحفظ آثاره، ويتبرك بها.
وقد تقدم:
أن كعب بن زهير مدح قريشاً في قصيدة بانت سعاد، ولم
يذكر الأنصار، فلم يرق ذلك للأنصار، فكلموه في ذلك، فقال فيهم شعراً..
وما نريد أن نشير إليه هنا هو:
أن ذكر كعب لقريش في قصيدته، وهو يعلم: أن قريشاً لم
تزل تحارب رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى فتح مكة، يشير إلى هيمنة
قريش على عقول الناس في المنطقة، وإلى أن أحداً منهم لا يجرؤ على
تخطيها.
ولعله إنما ذكر قريشاً في قصيدته لكي يأمن جانبها،
ويسلم من غوائل غضبها عليه، حين يمدح عدوها.. كما أن إهمال الأنصار
ربما يكون لإرضاء قريش أيضاً، لكي لا يثير حفيظتها ضده..
وهذا يشير أيضاً:
إلى أن ما حققه المسلمون بقيادة رسول الله «صلى الله
عليه وآله» من انتصارات هائلة على اليهود والمشركين وقريش، لم يستطع أن
يزيل كل آثار ذلك الإنبهار والضعف أمام الهيمنة القرشية.. ولعل هذه
الآثار قد بقيت إلى ما بعد عشرات السنين من ذلك التاريخ.
مثلهم في ذلك كمثل الذي يكون عبداً لرجل، ثم يعتقه، فإن
شعوره بالضعف أمام الذي كان سيده لا يزول بسهولة، بل يبقى عبر السنين
والأحقاب، بعد حصوله على حريته.
وقد لاحظ الإسلام هذه الخصوصية وراعاها في أحكامه التي
شرعها لهذه الحالات كما يعلم بالمراجعة..
وفي السنة التاسعة، في شهر ذي القعدة، وبعد أن رجع
النبي «صلى الله عليه وآله» من تبوك مات عبد الله بن أُبي، بعد أن مرض
عشرين يوماً([29]).
وقيل:
قتل في السنة الخامسة من الهجرة([30]).
فعن عمر بن الخطاب، وابن عباس:
أنه لما مات عبد الله بن أُبي بن سلول سأل ابنه عبد
الله النبي «صلى الله عليه وآله» أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه، فأعطاه،
ثم سأله أن يصلي عليه.
فلما قام رسول الله «صلى الله عليه وآله» وثب عمر، فأخذ
ثوبه «صلى الله عليه وآله»، وقال: أعلى عدو الله عبد الله بن أُبي
القائل كذا وكذا والقائل كذا وكذا الخ..؟!
(أو
قال:
يا رسول الله، أتصلي على ابن أُبي، وقد قال يوم كذا
وكذا وكذا؟! ثم عدد عليه قوله).
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
أخر عني يا عمر!
فلما أكثرت عليه قال:
إني خُيِّرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين
غفر له لزدت عليها([31]).
وفي نص آخر:
ومشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه، فعجبت لي ولجرأتي على رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، والله ورسوله أعلم، فوالله ما كان إلا
يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان
{وَلاَ
تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ
قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ
فَاسِقُونَ}([32]).
وفي نص آخر للبخاري:
«فلما أراد أن يصلي جذبه عمر، فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على
المنافقين؟
فقال:
أنا بين خيرتين»([33]).
وفي نص آخر:
فقال «صلى الله عليه وآله»: وأين؟
فقال:
{اسْتَغْفِرْ
لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ..}([34]).
فقال:
فإني سأزيد على سبعين.
فأنزل الله:
{وَلاَ
تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ
قَبْرِهِ..}
الآية.. فأرسل إلى عمر فأخبره([35]).
وفي نص آخر:
لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله
إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه،
فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله «صلى الله عليه وآله»
ليصلي عليه، فقام عمر، فأخذ بثوب رسول الله «صلى الله عليه وآله» فقال:
يا رسول الله «صلى الله عليه وآله»، أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي
على المنافقين.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
إنما خيرني الله تعالى، وقال:
{اسْتَغْفِرْ
لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
سَبْعِينَ مَرَّةً..}
وسأزيد على السبعين.
قال:
إنه منافق.
فصلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأنزل الله
تعالى: {وَلاَ
تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ
قَبْرِهِ..}
فترك الصلاة عليهم([36]).
وفي نص آخر عن عمر:
«فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره»([37]).
وفي بعض الروايات:
أن ابن أُبي هو الذي طلب من النبي «صلى الله عليه وآله» قميصه ليكفن
فيه، وأنه «صلى الله عليه وآله» نفث في جلده، ودلاه (ونزل) في قبره([38]).
وربما يكون قد طلب من النبي «صلى الله عليه وآله» ذلك
في حياته، ثم أكد ولده هذا الطلب بعد وفاته، وكذلك الحال بالنسبة لما
قيل: من أن ابن أُبي: أوصى أو طلب من النبي «صلى الله عليه وآله» أن
يكفنه وأن يصلي عليه
([39]).
ونقول:
أولاً:
إن سياق رواياتهم المزعومة تلك يعطي: أن القرآن قد نزل
بموافقة عمر، وتخطئة رسول الله «صلى الله عليه وآله».. ولا شك في أن
هذا من ترهاتهم وأباطيلهم الجريئة، التي تهدف إلى الحط من مقام رسول
الله «صلى الله عليه وآله» من أجل رفع شأن عمر بن الخطاب، فما أشبههم
بذلك الذي يحرق البلاد والعباد من أجل أن يشعل سيجارة.
ثانياً:
لقد تحدثت الروايات أن عمر يواجه رسول الله «صلى الله عليه وآله» بأمر
ليس له واقع، وهو: أن الله تعالى قد نهاه عن الصلاة على المنافقين..
وقد رد النبي «صلى الله عليه وآله»
ذلك:
بأن الله تعالى لم ينهه، وإنما خيّر بين أمرين..
بل تقدم:
أنه «صلى الله عليه وآله» سأل عمر، فقال: أين؟
فلما قرأ آية الإستغفار لهم بيَّن
له رسول الله «صلى الله عليه وآله»:
أن الآية لا تدل على ذلك.
ونحن لا يمكن أن نقبل بأن يكون النبي «صلى الله عليه
وآله» قد أخطأ في فهم الخطاب الإلهي، ففسره بغير معناه..
والصحيح هو:
أن الذي أخطأ في فهم الخطاب الإلهي، هو عمر بن الخطاب
نفسه.. وأخطأ خطأً آخر يمس جوهر العقيدة، حين نسب إلى رسول الله «صلى
الله عليه وآله» الخطأ في فهم وحي الله تبارك وتعالى، أو حين واجهه
باتهامه بأنه يخالف أمر الله تعالى له بعدم الصلاة على المنافقين.
ثالثاً:
إن الأخطر من ذلك كله.. أنه لم يقبل من رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، بل أصر على منعه، وأخذ بثوبه، وقام في صدره يصده عما
يريد فعله.
بل إن النبي «صلى الله عليه وآله» أمره بأن يؤخر عنه،
فلم يفعل، بل أصرَّ وأصَّر حتى أكثر عليه، حتى أخبره بأن الله تعالى قد
خيره..
فلماذا لا يمتثل أمر النبي «صلى الله عليه وآله»، ويصرّ
على فرض رأيه عليه؟!
أم أنه يرى أن الله تعالى قد أخطأ حين خيَّر نبيه، وأن
عليه سبحانه وتعالى أن يبدل أمره هذا ليوافق رأي عمر؟!
ولماذا يقدم بين يدي رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
والله تعالى يقول: {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهَ
وَرَسُولِهِ}([40]).
فهل كان يرى نفسه أعلم من النبي «صلى الله عليه وآله»،
أو أن رأيه أصوب من رأيه؟!
أم أنه يرى أن النبي «صلى الله عليه وآله» يفعل المنكر،
ويريد أن ينهاه عنه؟!
رابعاً:
إن قوله تعالى:
{اسْتَغْفِرْ
لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
سَبْعِينَ مَرَّةً..}
لا يقصد به النهي عن الإستغفار، بل المقصود هو: بيان أن هذا الإستغفار
لا ينفع المنافقين، ولا يوجب المغفرة لهم من الله في الآخرة.
ولكن ذلك لا يعني أن لا تكون له فوائد ومنافع أخرى، كما
سنشير إليه عن قريب.
خامساً:
إن النهي عن الصلاة على المنافقين إنما نزل بعد قصة
الصلاة على ابن أُبي بالإجماع([41]).
فكيف يتهم النبي «صلى الله عليه وآله» بأنه منهي عن
الصلاة عليهم.
سادساً:
فإنهم يقولون: إنه قد كانت لابن أُبي يد عند رسول الله
«صلى الله عليه وآله»([42]).
وأحب أن يكافئه عليها.
وقد تقدم:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» يطلب من الله أن لا يكون
لكافر ولا لمشرك عليه يد يستحق عليها الشكر والمكافأة، فلو كان منافقاً
لكان مشركاً، فكيف تكون له يد عند رسول الله «صلى الله عليه وآله».
وقد روي عن الشعبي:
أن عمر كان
بعد ذلك يقول: أصبت في الإسلام هفوة ما أصبت مثلها قط. أراد رسول الله
«صلى الله عليه وآله» أن يصلي على عبد الله بن أُبي، فأخذت بثوبه، فقلت
له: والله، ما أمرك الله بهذا، لقد قال الله لك:
{اسْتَغْفِرْ لَهُمْ
أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ
مَرَّةً..}.
قال:
«فقال رسول الله: خيرني ربي، فقال:
{اسْتَغْفِرْ
لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
سَبْعِينَ مَرَّةً..}..»
([43]).
واللافت هنا:
أن الأمر لا يقتصر على ابن أُبي إذ إن الروايات تتحدث
عن اعتراضات أخرى على رسول الله «صلى الله عليه وآله» في صلاته على
آخرين من الصحابة أيضاً، فراجع..
([44]).
وقد ذكرنا فيما سبق:
أنه يبدو أن ثمة تضخيماً لشأن ابن أُبي في موضوع
النفاق، حتى لقد اعتبروه رأس المنافقين في المدينة، لكي يهونوا بذلك من
شأن نفاق غيره.
والذي يظهر لنا من هذه الواقعة:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يريد بصلاته هذه تحقيق عدة أمور،
نذكر منها:
1 ـ
أن يكرم عبد الله بن عبد الله بن أُبي «رحمه الله»، ويدفع عنه أذى بعض
الناس، الذين كان يروق لهم إذلال أهل الإيمان، بذكر آبائهم بما يراه
الناس من أسباب التنقص للأبناء.
2 ـ
روي: «أنهم ذكروا القميص، فقال النبي «صلى الله عليه
وآله»: وما يغني عنه قميصي وصلاتي؟ والله، إني لأرجو أن يسلم به أكثر
من ألف من الخزرج الخ..»([45]).
وهذا النص يشير إلى:
أن الخزرج لم يكونوا كلهم قد دخلوا في الإسلام إلى ذلك الوقت.
3 ـ
إن المروي بسند صحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله «عليه السلام»: أن
النبي «صلى الله عليه وآله» دعا عليه، ولم يدع له([46]).
ولعلك تقول:
إن الدعاء عليه لا ينسجم مع ما ذكر آنفاً من أن الغرض هو تكريم ابنه
عبد الله بن عبد الله بن أُبي..
ولا مع منع أَلْسِنَةِ السوء من أن تؤذي ابنه.
ولا مع ترغيب الخزرج بالإسلام، حتى إنه «صلى الله عليه
وآله» ليرجو أن يسلم بسبب إلباسه قميصه أكثر من ألف منهم!!
والجواب:
إن الدعاء لا يجب أن يكون بصورة معلنة وظاهرة، بحيث يسمعه سائر الناس،
فلعله أخفت في صلاته، أو في دعائه عليه فقط.
([1])
إعلام الورى ص128 و (ط مؤسسة آل البيت لإحياء التراث) ج1 ص243
والبحار ج21 ص174 ومجمع البيان ج9 ص192 وتاريخ مدينة دمشق ج2
ص32 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص366 والكامل في التاريخ ج2 ص276
والبداية والنهاية ج5 ص6 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص943
والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص4.
([2])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص69 و 77 عن الماوردي في حاويه، في
السير والحج، وراجع: أسد الغابة ج3 ص358 ووج5 ص55 وتهذيب
الكمال ج19 ص283 والإصابة ج4 ص356 و 357 وج6 ص415 وتهذيب
التهذيب ج7 ص82 والوافي بالوفيات ج19 ص289 وأعيان الشيعة ج1
ص278 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص936 وإعلام الورى ج1 ص243
وفتح الباري ج8 ص65 ومعرفة السنن والآثار ج3 ص491 والإستيعاب
ج3 ص1023 والطبقـات الكـبرى ج2 ص145 وج5 ص446 وتاريـخ خليفة بن
خيـاط = = ص56 والمسترشد للطبري ص129 والبحار ج28 ص169 مغني
المحتاج ج4 ص372 وإعانة الطالبيين ج4 ص241.
([3])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص70.
([4])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص71 و 72 عن البخاري ومسلم.
([5])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج12 ص72.
([6])
الآية 36 من سورة المدثر.
([7])
الآية 1 من سورة الفرقان.
([8])
الآية 27 من سورة التكوير، والآية 87 من سورة ص، والآية 104 من
سورة يوسف.
([9])
الآية 52 من سورة القلم.
([10])
الآية 107 من سورة الأنبياء.
([11])
الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج3 ص297 و 298.
([12])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص70 والإصابة ج3 ص295.
([13])
الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج3 ص298.
([14])
الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج3 ص298 وسبل الهدى والرشاد ج12 ص70
والإصابة ج3 ص295.
([15])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص71 وراجع: الإستيعاب (بهامش الإصابة)
ج3 ص297 ـ 299.
([17])
راجع: الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج3 ص297 و 298 والإصابة ج3
ص296.
([18])
الإصابة ج3 ص295 و 296.
([19])
الآية 8 من سورة فاطر.
([20])
الآية 6 من سورة الكهف.
([21])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص70 والإصابة ج3 ص295 والإستيعاب (بهامش
الإصابة) ج3 ص298.
([22])
المواهب اللدنية (بشرح الزرقاني) ج4 ص56 ـ 58.
([23])
راجع: المواهب اللدنية (بشرح الزرقاني) ج4 ص62.
([24])
الآيات 24 ـ 26 من سورة الشعراء.
([25])
الآية 32 من سورة المائدة.
([26])
الوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج1 ص38 والبحار ج33 ص169 و 170
والغدير ج10 ص283 و 284 ووضوء النبي «صلى الله عليه وآله» ج1
ص208 وعن مروج الذهب ج3 ص454 و (ط أخرى) ج2 ص341 والموفقيات
للزبير بن بكار 576 ـ 577 والنصائح الكافيـة ص116 وشرح = =
النهج للمعتزلي ج9 ص238 و (ط دار إحياء الكتب العربية) ج5 ص129
و 130 وموسوعة التاريخ الإسلامي ج1 ص47 و 48 وكشف الغمة ج2 ص45
و 46 وكشف اليقين للعلامة الحلي ص474 و 475 وقاموس الرجال ج9
ص20 وبهج الصباغة ج3 ص193.
([27])
الوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج1 ص58 ومستدرك الوسائل ج1 ص22
وشرح الأخبار ج2 ص47 و 166 و 536 والمناقب لابن شهرآشوب ج1
ص140 والعمدة لابن البطريق ص456 والطرائف لابن طاووس ص504 وعين
العبرة لأحمد ابن طاووس ص59 والصراط المستقيم ج3 ص47 ووصول
الأخيار إلى أصول الأخبار لوالد البهائي ص78 وكتاب الأربعين
للشيرازي ص632 والبحار ج22 ص248 وج33 ص190 و 194 و 195 و 209
وج44 ص76 و 77 ومناقب أهل البيت للشيرواني ص465 و 466 والغدير
ج2 ص144 وج11 ص79 و 89 ومستدرك سفينة البحار ج5 ص339 ومكاتيب
الرسول ج1 ص118 و 161 و 650 وصحيح مسلم ج8 ص27 وشرح مسلم
للنووي ج16 ص152 وتحفة الأحوذي ج4 ص128 ومسند أبي داود
الطيالسي ص359 وخصائص أمير المؤمنين «عليه السلام» للنسائي ص23
وشرح النهج للمعتزلي ج15 ص176 وأبو هريرة لشرف الدين ص98 و 202
وشيخ المضيرة لأبي رية ص208 ومعجم رجال الحديث ج19 ص215 وطبقات
المحدثين بأصبهان ج3 ص34 وتهذيب الكمال ج22 ص344 وميـزان
الإعتـدال ج3 ص340 وسير = = أعلام النبلاء ج3 ص123 وفتوح
البلدان ج3 ص582 وتاريخ الأمم والملوك ج8 ص186 والبداية
والنهاية ج6 ص189 وج8 ص128 ووقعة صفين للمنقري ص220 والشفا
بتعريف حقوق المصطفى ج2 ص197 والمناقب للخوارزمي ص11 وجواهر
المطالب في مناقب الإمام علي «عليه السلام» لابن الدمشقي ص218
وسبل الهدى والرشاد ج10 ص215 والنصائح الكافية لمحمد بن عقيل
ص123 و 202 و 261.
([28])
تذكرة الخواص ص201 والغدير ج10 ص169 عنه، والبحار ج30 ص296
وج33 ص208 وكتاب الأربعين للماحوزي ص103 و 374 وعن ربيع
الأبرار للزمخشري ج4 ص400 ومناقب أهل البيت «عليهم السلام»
للشيرواني ص465 و 467 وشرح النهج للمعتزلي ج15 ص175.
([29])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص73 وإمتاع الأسماع ج2 ص90 والعبر
وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص52.
([30])
تاريخ الخميس ج2 ص140.
([31])راجع:
تاريخ الخميس ج2 ص140 وصحيح البخاري باب ما يكره من الصلاة على
المنافقين من كتاب الجنائز ج2 ص100 وج5
ص206،
ومسند أحمد ج1 ص16 وكنز العمال ج1 ص247 ح (4403) و (ط مؤسسة
الرسالة) ج2 ص418 و 419 ح (4392) عمن تقدم، وعن ابن جرير، وابن
أبي حاتم، وابن مردويه وغيرهم. وراجع: الكامل في التاريخ ج2
ص199 والدر المنثور ج3 ص264 عن أحمد، والبخاري، ومسلم،
والترمذي، والنسائي، وابن أبي حاتم، والنحاس، وابن حبان، وابن
مردويه، وأبي نعيم في الحلية، وابن المنذر، وأبي الشيخ،
والبيهقي في الدلائل وراجع: الميزان للطباطبائي ج9 ص353 وفتح
القدير للشوكاني ج2 ص542 و 545 وتفسير
القرآن العظيم لابن كثير ج2
ص379 والمحلى لابن حزم ج11 ص209 وعين العبرة في غبن العترة
للسيد أحمد آل طاووس ص20 والبحار ج30 ص572 ومناقب أهل البيت
«عليهم السلام» للشيرواني ص340 و 385 والنص والإجتهاد للسيد
شرف الـدين = = ص188 وسنن الترمذي ج4 ص343 وسنن النسائي ج4 ص68
والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص199 وفتح الباري ج8 ص253 وعمدة
القاري للعيني ج8 ص192 وج18 ص273 ومنتخب مسند عبد بن حميد ص36
والسنن الكبرى للنسائي ج1 ص638 وج6 ص357 وكنز العمال ج1 ص170
وج2 ص6 و 419 وجامع البيان للطبري ج10 ص261 وأسباب نزول الآيات
للواحدي النيسابوري ص173 وتفسير البغوي ج2 ص317 وأحكام القرآن
لابن العربي ج2 ص556 والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
لابن عطية الأندلسي ج3 ص67 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج2
ص393 وتفسير الآلوسي ج10 ص154 وتاريخ المدينة لابن شبة النميري
ج3 ص864 وإمتاع الأسماع للمقريزي ج2 ص90 و 232 والسيرة الحلبية
ج2 ص24.
([32])
الآية 84 من سورة التوبة.
([33])
راجع: صحيح البخاري (ط دار الفكر) ج2 ص76 وراجع: سنن النسائي
ج4 ص37 ومسند أحمد ج2 ص18 والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص199 وعمدة
القاري ج8 ص53 والسنن الكبرى للنسائي ج1 ص621 وج6 ص357 وصحيح
ابن حبان ج7 ص447 والإستيعاب ج3 ص941 وتفسسير ابن ابي = = حاتم
ج6 ص1857 وسبب نزول الآيات للواحدي النيسابوري ص173 وأحكام
القرآن لابن العربي ج2 ص557 وزاد المسير ج3 ص326 وأسد الغابة
ج3 ص198 والوافي بالوفيات ج17 ص10.
([34])
الآية 80 من سورة التوبة.
([35])
راجع: صحيح البخاري باب الكفن في القميص (أبواب الجنائز) وراجع
كتاب اللباس. وراجع: الكامل لابن الأثير (ط دار الكتاب العربي)
ج2 ص199 والدر المنثور ج3 ص266 عن الطبراني، وابن مردويه،
والبيهقي في الدلائل، والبخاري، ومسلم، وابن أبي حاتم، وابن
المنذر، وأبي الشيخ، وراجع: تاريخ الخميس ج2 ص140 وراجع:
الميزان (تفسير) ج9 ص377.
([36])
راجع: صحيح البخاري باب: استغفر لهم أو لا تستغفر، ودلائل
الصدق ج3 ق2 ص65 عن الجمع بين الصحيحين، والدر المنثور ج3 ص266
عن البخاري، ومسلم، وابن أبي حاتم، وابن المنذر، وأبي الشيخ،
وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل وراجع: إعانة الطالبين ج2
ص153 والبحار ج30 ص342 وفتح القدير ج2 ص390 والأحكام لابن حزم
ج3 ص273 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص660 وراجع: البداية
والنهاية ج5 ص42 وإمتاع الأسماع ج2 ص231 والسيرة النبوية لابن
كثير ج4 ص65 ونهج الحق وكشف الصدق ص338 وإحقاق الحق (الأصل)
ص284.
([37])
مسند أحمد ج1 ص16 والمحلى لابن حزم ج11 ص209 وسنن الترمذي ج4
ص342 ومنتخب مسند عبد بن حميد ص35 وكنز العمال ج2 ض418 وجامع
البيان للطبري ج10 ص261 وأسباب نزول الآيات للواحدي النيسابوري
ص173 وأحكام القرآن لابن العربي ج2 ص556 و تفسير القرآن العظيم
ج2 ص393 وتاريخ المدينة لابن شبة ج3 ص863 والسيرة النبوية لابن
هشام ج4 ص979.
([38])
راجع: الدر المنثور ج3 ص266 عن أبي الشيخ، وابن ماجة، والبزار،
وابن جرير، وابن مردويه، والطبراني، والبيهقي في الدلائل،
وراجع: تاريخ الخميس ج2 ص140 وتفسير الميزان ج9 ص365 وعمدة
القاري ج8 ص56 وتخريج الأحاديث والآثار ج2 ص93 وجامع البيان
ج10 ص262.
([39])
راجع: تاريخ الخميس ج2 ص140 والدر المنثور ج3 ص266 عن أبي
الشيخ، وابن ماجة، والبزار، وابن جرير، وابن مردويه،
والطبراني، والبيهقي في الدلائل. وراجع: تفسير السمرقندي ج2
ص79.
([40])
الآية 2 من سورة الحجرات.
([41])
النص والإجتهاد ص188.
([42])
صحيح البخاري (ط دار المعرفة) ج4 ص19 وعمدة القاري ج8 ص165
وج14 ص257 وتحفة الأحوذي ج8 ص397 وتخريج الأحاديث والآثار ج2
ص94 وتفسير البغوي ج2 ص317 وتاريخ الخميس ج2 ص140 عن ابن عيينة.
([43])
النص والإجتهاد ص189 عن كنز العمال برقم (4404) عن ابن أبي
حاتم، ومنتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد)، وراجع: الدر
المنثور ج3 ص264 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج2 ص419 وتفسير
الميزان ج9 ص355 و 365 وتفسير ابن أبي حاتم ج6 ص1853.
([44])
راجع: الإصابة ج4 ص134 و 185.
([45])
الدر المنثور ج3 ص266 عن أبي الشيخ، وراجع: فتح الباري ج8 ص254
وعمدة القاري ج18 ص273 وتحفة الأحوذي ج8 ص398 وتخريج الأحاديث
والآثار للزيلعي ج2 ص93 وجامع البيان ج10 ص262 وتفسير الثعلبي
ج5 ص79 وأسباب نزول الآيات للواحدي النيسابوري ص174 وتفسير
البغوي ج2 ص317 وتفسير الآلوسي ج10 ص154 وزاد المسير ج3 ص326
وتاريخ الخميس ج2 ص140 و 141.
([46])
الوسائل (ط دار الإسلاميـة) ج2 ص770 و (ط مؤسسة آل البيت) ج3
ص71 = = والبحار ج22 ص125 وجامع أحاديث الشيعة ج3 ص325 وجواهر
الكلام ج13 ص50 والمعتبر ج2 ص351 والكافي ج3 ص188 وتهذيب
الأحكام ج3 ص196 ومنتقى الجمان ج1 ص276.
|