من سرايا السنة الثامنة
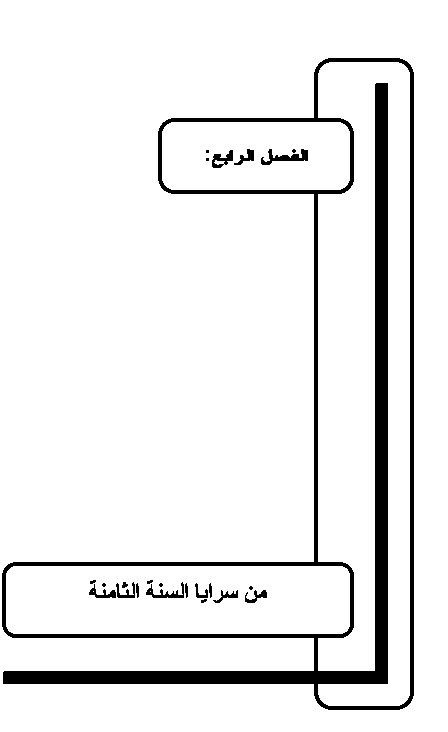
قد نبهنا أكثر من مرة، ونعود على تأكيد التنبيه على أن
السرايا التي كان يرسلها رسول الله «صلى الله عليه وآله» في مختلف
الإتجاهات لم تكن سرايا غازية، تهدف إلى قتل الناس وقهرهم، وتقويض
أمنهم، أو سلب حريتهم، وسبي ذراريهم ونسائهم، والإستئثار بأموالهم
والإستيلاء على ديارهم..
لأنه «صلى الله عليه وآله» كان قبل كل شيء نبياً
رسولاً، ومن أهم واجبات الأنبياء والرسل، هو: إبلاغ الناس بأمر نبوتهم،
وإيقافهم على حقيقة دعوتهم، وإقامة الحجة عليهم، فإذا حالت فئة ظالمة
بينهم وبين هذا الأمر، فلا بد من ردعها عن ظلمها وبغيها هذا، فإذا لجأت
إلى العنف والقتال، ولم يكن بد من التصدي ورد التحدي، فلا بد من إسقاط
مقاومتها، إذا توفرت القدرة على ذلك.
وهذا بالذات هو ما كان يجري مع سرايا رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، فقد كانت في أكثرها سرايا دعوة، لا سرايا حرب وقتال،
وكان باقيها عمليات وقائية، تهدف إلى صد عدوان قد أعد الآخرون له
العدة، وجمعوا الجموع للقيام به..
وهذا حق مشروع؛ إذ لا مجال للإنتظار والتراخي حتى يورد
العدو ضربته، ويرتكب جريمته، ويحقق أهدافه، فإن هذا سوء في الرأي، وعجز
في التدبير، وفشل في السياسة، وتفريط في الأمانة، يصل إلى حد الخيانة..
وقد صرحت النصوص في الموارد
المختلفة:
بأن السرية الفلانية كانت سرية بلاغ ودعوة، وسنجد في
هذا الفصل بعضاً من هذه التصريحات أيضاً.. فإلى ما يلي من أحداث
ومطالب.
قال ابن سعد:
قالوا: لما أراد رسول الله «صلى الله عليه وآله» المسير إلى الطائف،
بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين، صنم من خشب، كان لعمرو بن حُمَمَة
الدَّوْسي، ليهدمه.
وأمره أن يستمد قومه، ويوافيه بالطائف.
فخرج سريعاً إلى قرية، فهدم ذا الكفين، وجعل يحش النار
في وجهه ويحرقه، ويقول:
يـا ذا الـكَـفَـين لست من
عبَّادكـا مـيـلادنـا أقــدم مـن مـيـلادكــا
إنــي حـشـوت الـنـار في فـؤادكـا
وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعاً، فوافوا رسول الله
«صلى الله عليه وآله» بالطائف، بعد مقدمه بأربعة أيام، وقدم بدبابة
ومنجنيق.
وقال:
«يا معشر الأزد من يحمل رايتكم»؟
فقال الطفيل:
من كان يحملها في الجاهلية، النعمان بن الرازية اللهبي.
قال:
«أصبتم»([1]).
وقد كان ذلك في شوال سنة ثمان([2]).
ونقول:
1 ـ
قد تقدم: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أرسل في
حنين علياً «عليه السلام» لهدم الأصنام، فهدمها، ثم وافاه في الطائف..
فلماذا لم يهدم ذا الكفين؟
وهذا يجعلنا نشك كثيراً في صحة هذه المزاعم.
2 ـ
قولهم: إنه قدم معه أربع مائة رجل سراعاً. لو فرضنا أنه
صحيح، فهو لا يعني أنهم قد أسلموا، فقد قال مغلطاي: «وقدم معه أربعة
مسلمون»([3]).
بل كلام مغلطاي هذا يدل على:
أن جميع من قدم معه هو أربعة نفر فقط، لا أربع مائة..
3 ـ
وبعد أن أورد النبي «صلى الله عليه وآله» ضربته بغطفان،
على يد علي أمير المؤمنين «عليه السلام»، وانقسمت فلولهم إلى ثلاثة
أقسام، فإنه «صلى الله عليه وآله» لم يكن بحاجة إلى المدد، خصوصاً من
قوم مشركين؟! ما دام أن المشركين أصبحوا في حالة ضعف وانكسار، ولم
يتكبد المسلمون في تلك الحرب خسائر يحتاجون معها إلى طلب المدد من
غيرهم..
4 ـ
قد أظهرت حرب حنين:
أن الجيش الذي كان يزيد على عشرة الآف مقاتل لم يغن
شيئاً، بل انهزم كله عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»..
وأن هزيمة المشركين إنما كانت على يد رجل واحد، وهو علي
بن أبي طالب «عليه السلام» وحده.. فلماذا يصر رسول الله «صلى الله عليه
وآله» على طلب المدد من الدوسيين المشركين؟!
وذكروا في جملة أحداث سنة ثمان:
سرية كعب بن عمير إلى ذات أطلاح من الشام، فأصيب هو
وأصحابه([4]).
وبما أننا قد تحدثنا عن هذه السرية في الجزء الثامن عشر
من هذا الكتاب، فإننا نحيل القارئ على ذلك الجزء، إن أحب الإطلاع على
تفاصيل ما جرى..
قال ابن إسحاق:
لما رجع رسول الله «صلى الله عليه وآله» من الجعرانة
سنة ثمان بعث قيس بن سعد بن عبادة إلى ناحية اليمن، وأمره أن يطأ صداء،
فعسكر بناحية قناة في أربع مائة من المسلمين.
فقدم رجل من صداء، فسأل عن ذلك البعث، فأخبر به، فجاء
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقا ل: «يا رسول الله، جئتك وافداً
على من ورائي فاردد الجيش، فأنا لك بقومي».
فردهم من قناة.
وخرج الصدائي إلى قومه، فقدم منهم بعد ذلك خمسة عشر
[رجلاً] فأسلموا.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«إنك مطاع في قومك يا أخا صداء».
فقال:
بل الله هداهم. ثم وافاه في حجة الوداع بمائة منهم.
وهذا الرجل هو الذي أمره رسول الله «صلى الله عليه
وآله» في سفر أن يؤذن، ثم جاء بلال ليقيم، فقال رسول الله «صلى الله
عليه وآله»: «إن أخا صداء هذا أذَّن، ومن أذَّن فهو يقيم»([5]).
واسم أخي صداء هذا:
زياد بن الحارث([6]).
وفي سياق آخر ذكروا:
أنه بعد أن ضمن زياد بن الحارث للنبي «صلى الله عليه
وآله» إسلام قومه كتب إليهم كتاباً، فقدم وفدهم بإسلامهم([7]).
وذكروا أيضاً عن زياد هذا:
أنه قال للنبي «صلى الله عليه وآله»: «وقلت: ألا تؤمرني
عليهم؟
فقال:
بلى.
فكتب إلي كتاباً يؤمرني.
قلت:
مر لي بشيء من صدقاتهم، فكتب.
وكان في سفر له، فنزل منزلاً، فأتاه أهل ذلك المنزل
يشكون عاملهم، فقال: لا خير في الأمارة لرجل مؤمن.
ثم أتاه آخر، فقال:
اعطني.
فقال:
من سأل الناس عن ظهر غنى، فصداع في الرأس، وداء في
البطن.
فدخل في نفسي من ذلك شيء، فأتيته بالكتابين([8]).
وهناك روايات أخرى ذكرت:
أن (حبان بن بَحّ) الصدائي قال: إن قومي كفروا، فأخبرت
أن النبي «صلى الله عليه وآله» جهز إليهم جيشاً، فأتيته، فقلت: إن قومي
على الإسلام.
فقال:
أكذلك؟
قلت:
نعم.
قال فاتبعته ليلة إلى الصباح، فأذنت بالصلاة لما أصبحت،
وأمَّرني عليهم، وأعطاني صدقتهم.
فقال النبي «صلى الله عليه وآله»:
لا خير في الأمرة.. قال: إن الصدقة صداع في الرأس،
وحريق في البطن، أو داء.
فأعطيته صحيفتي، أو صحيفة إمرتي وصدقتي»([9]).
ونقول:
1 ـ
إن الإختلافات بين هذه النصوص ظاهرة بأدنى تأمل، فلا
حاجة إلى الإفاضة فيها..
2 ـ
قد يقال: إنه لا مجال لقبول ما ذكر آنفاً: من أن زياداً
طلب من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يؤمره على قومه، فأمره عليهم..
لأن النبي «صلى الله عليه وآله» هو الذي يقول جواباً
على طلب مشابه لرجلين من الأشعريين: إنَّا لا (لن) نستعمل على عملنا من
أراده([10])،
فكيف يولي زياداً هذا العمل بعد ان طلبه منه زياد؟!
إلا أن يقال:
إن المقصود هو: أنه «صلى الله عليه وآله» لا يولي عمله
ذلك الشخص الذي يريد أن يتخذ من منصبه ذريعة للحصول على المنافع
والإمتيازات.. وأما من يطلب العمل، لأنه يرى في نفسه القدرة على حل
مشكلة، أو إنجاز مهمة لا يعود نفعها إليه كشخص، فلا يقصده النبي «صلى
الله عليه وآله» بكلمته تلك..
ولعل مما يشير إلى هذا المعنى:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد قال: «من يطلبه»، أي أنه
يسعى جاهداً للحصول عليه ويظهر الحرص، ويجعل كل همه للوصول إليه..
وليس المقصود:
من طلبه سؤاله ولو مرة واحدة، لعارض عرض اقتضى أن يتبرع
بإنجاز مهمة، وتحمل مسؤولية، رأى أنه قادر على تحملها..
3 ـ
وأما طلب زياد من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يكتب
له بشيء من صدقاتهم، فقد جاء مبهماً، ولم يبين إن كان المطلوب هو أن
يحدد له نسبة من تلك الصدقات، مثل الربع أو النصف، أو نحو ذلك، أو أنه
طلب شيئاً منها لا يزيد على نفقته، أو أجرة عمله!!
فإن كان المطلوب هو الأول ـ كما قد يستظهر من سياق
الكلام ـ فإن استجابة النبي «صلى الله عليه وآله» لطلبه تصبح في منتهى
الغرابة، بل طلبه هذا لابد أن يدعو النبي «صلى الله عليه وآله» إلى
إعفائه من المهمة التي رشح نفسه لها..
وإن كان المطلوب هو الثاني، فهو مقبول، ومعقول.. في
بادئ الأمر، غير أننا نقول:
إن المتوقع أن يبادر النبي «صلى الله عليه وآله» إلى
هذا الأمر، من دون حاجة إلى أن يطلب زياد ذلك منه.
ولعل ما ذكر في آخر الرواية:
من أنه حين سمع من النبي «صلى الله عليه وآله» ما سمع
جاءه بالكتابين طالباً إعفاءه من مهمته، يؤيد: أن يكون قد طلب الإمارة
لنفسه، وطلب من الصدقات أكثر مما يحتاج إليه، ولو على سبيل الأجر الذي
يستحقه أمثاله في الأحوال المشابهة.
4 ـ
أما رواية حبان بن بَحّ فقد ذكرت: أن النبي «صلى الله
عليه وآله» كتب إليه بصدقة قومه، وبالإمارة عليهم..
وذلك غير معقول ولا مقبول، فإن الصدقة ليست للأمير، ولا
للعامل وحده، فإن القرآن قد عيّن لها مصارفها، فما معنى أن يكتب له
بصدقات قومه؟!
5 ـ
إنه قد يستظهر من رواية حبان بن بح: أن سبب إرسال الجيش إلى الصدائيين
أنهم ارتدُّوا عن الإسلام، فأخبروا النبي «صلى الله عليه وآله» بأمرهم،
فجهز لهم جيشاً ثم أخبروه بعودتهم إلى دينهم، فصرف ذلك الجيش عنهم.
ولعل سبب المبادرة إلى إرسال الجيش هو:
أن شيوع ارتداد أية قبيلة من شأنه أن يترك آثاراً سلبية
على غيرها، من حيث إنه يجعلهم يستسهلون أمر الإرتداد، خصوصاً إذا ظهر
لهم أن ذلك لا يحمل لهم أية سلبية أو معاناة..
وتصبح قضية نشر الدين في مأزق حقيقي، ولاسيما لجهة
اختلال الثقة في مجتمع أهل الإيمان، وترقب الإرتداد من أي كان من
الناس، في أي وقت.. الأمر الذي يوجب ضعف، وانحلال رابطة الأخوة الدينية
فيما بينهم.
وهذا يوجب المبادرة لمواجهة حالات الإرتداد، لأنها لا
يمكن أن توصف بالبراءة أبداً.
فإن من يفعل ذلك، يكون مارس الخديعة أو الخيانة بأبشع
مظاهرها. لأنه إما أن يكون هذا المرتد ممن قامت عليه الحجة بالأدلة
البرهانية، أو بالقناعة الوجدانية عن طريق المعجزة، فآمن.. فلا مبرر
لارتداده بعد هذا، بل ارتداده خيانة للدين، ولأهل الإيمان.
وإما أنه لم يبلغ درجة القناعة الوجدانية، ولا أقنعته
الحجة البرهانية، فيكون دخوله في الإسلام في هذه الحال خداعاً وتدليساً
ونفاقاً. وارتداده بعد ذلك إقراراً عملياً بهذا الخداع.. فلا بد من
محاسبته على هذا الأمر أيضاً، لأن الأمر خرج عن كونه مسألة شخصية،
ليصبح اعتراضاً على الدين، وطعناً في حقائقه، وتكذيباً لآياته، وجحوداً
لمعجزاته..
6 ـ
على أن ثمة تساؤلاً يحتاج إلى الجواب المعقول والمقبول،
وهو: أنه لماذا بادر «صلى الله عليه وآله» لتجهيز ذلك الجيش، قبل أن
يستيقن الأمر بالطرق المعروفة والمألوفة..
وقد يجاب عن ذلك:
بأن نفس مبادرة النبي «صلى الله عليه وآله» إلى هذا، لا
يعني أنه أراد أن يوقع بأولئك الناس قبل التثبت من الأمر.. فإن تجهيز
ذلك الجيش قد كان علنياً وظاهراً، ولا بد أن يبلغ خبره إليهم.. فإن كان
الخبر صحيحاً، فسيكون ردهم على هذا الإجراء هو الإستنفار، والتهبوء
للحرب.
وإن كان الخبر باطلاً، فإنهم سيبادرون إلى إظهار
الإسلام وتكذيب الخبر، وسيتجنبون المواجهة مع ذلك الجيش.
7 ـ
إن تجهيز هذا الجيش قد جاء بمثابة رسالة أريد أن يفهم
مراميها ومعانيها كل من تسوِّل له نفسه أمراً من هذا القبيل.
ويدل على ذلك:
أنه بمجرد ان جاء رجل واحد من تلك القبيلة، وتكفل بعودة
قومه إلى جادة الصواب.. أو بمجرد أن أخبره حبان بن بَحّ بأن قومه على
الإسلام، صرف ذلك الجيش عنهم، وأعاده إلى قواعده بسلام وأمان..
8 ـ
وعن الحديث الذي يقول: من سأل الناس عن ظهر غنى، فصداع
في الرأس، وداء في البطن، نقول:
إن هذا الحديث لا يبرر انصراف زياد عن أخذ ما طلبه من
الصدقة، حتى لو كان غنياً.
فإن زياداً قد طلب إعطاءه نصيباً من صدقات قومه، وبما
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أجاب طلبه، فذلك يعني: أنه أعطاه ما
يستحقه، فإن كان فقيراً فإنما يعطيه بمقدار ما يستحقه كما يعطي غيره مع
الفقراء.. وإن كان غنياً (أو فقيراً أيضاً) فإنه يعطيه ما يستحقه من
أجرة على العمل، أو على المهمة التي يتصدى لها..
ولا يدخل ذلك تحت عنوان:
«من سأل الناس عن ظهر غنى»، إذ المقصود بالسؤال: هو طلب
ما لا يستحقه.
والمفروض:
أن الأمر ليس كذلك هنا، إذ لو كان كذلك لم يكتب له،
النبي «صلى الله عليه وآله» بشيء من الصدقات، لأنه لا يعطي أحداً ما لا
يستحقه.
فإذا كان قد ردَّ كتاب الصدقة إلى النبي «صلى الله عليه
وآله»، فالمتوقع: أن يسأله النبي «صلى الله عليه وآله» عن سبب ذلك، ثم
يوضح له: أنه قد أخطأ في فهم ما يرمي إليه «صلى الله عليه وآله»، وليس
فيما بأيدينا ما يشير إلى سؤال أو جواب للتصحيح أو التوضيح..
9 ـ
أما ما زعمه زياد: من أن أصحاب النبي «صلى الله عليه
وآله» بدأوا في مسيرهم مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» يستأخرون
وينقطعون عنه، حتى لم يبق معه أحد غير زياد، وحتى استغرق لحوقهم به
وقتاً طويلاً قد يصل إلى نحو عشر دقائق على أقل تقدير، فهو غير مقبول،
بل ولا معقول أيضاً، إذ لا يمكن أن نصدق أن يُبقي المسلمون نبيهم في
ذلك الليل البهيم يسير وحده في صحراء قاحلة لا يجد فيها قطرة من ماء،
وليس فيها حسيس ولا أنيس. مع ما نعلمه من حرصهم على الكون بقربه،
والسير في ركابه التماساً للبركة منه..
10 ـ
يضاف إلى ذلك: أن تلك الروايات تضمنت: أن النبي «صلى
الله عليه وآله» قد سار بأصحابه الليل بكامله، من العشاء حتى الفجر..
وهذا أيضاً أمر مستغرب.. لاسيما، مع عجز الروايات عن الإفصاح لنا عن
وجهة سيره «صلى الله عليه وآله»، وأنها كانت إلى أي قوم!! وفي أية
جهة!! فإن غزوات النبي «صلى الله عليه وآله» معروفة، ومسيره إليها ليس
بالأمر المجهول، فقد وصفه الرواة لنا، وسجله المؤرخون، وحفاظ السيرة..
11 ـ
إن الرواية تفيد: أن الأذان قد حصل قبل طلوع الفجر،
وانه «صلى الله عليه وآله» لم يرض من زياد بأن يقيم حتى تحقق «صلى الله
عليه وآله» من طلوع الفجر.. فما هو الداعي إلى هذا التقديم، ما دام أن
الأذان بعد تحقق طلوع الفجر لا يفوِّت فضيلة الصلاة في أول الوقت؟!
12 ـ
إن زياداً يزعم: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال:
«يا أخا صداء، لولا أني أستحي من ربي عز وجل لسقينا واستقينا ناد في
أصحابي من له حاجة في الماء».
فكيف يستحي «صلى الله عليه وآله» من ربه أن يسقي ويستقي
هو ومن معه، ثم يطلب من زيادٍ أن يدعو من أصحابه من له حاجة في الماء؟!
أليس هذا سقياً واستسقاءً؟! فلماذا يناقض القول بالفعل، بل لماذا يكون
الكلام متناقضاً في نفسه، فإن هذا وذاك مما نجلُّ عنه مقام رسول الله
«صلى الله عليه وآله»..
وفي ذي القعدة سنة ثمان بعث رسول الله «صلى الله عليه
وآله» عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد ابني الجلندى، فأخذ الصدقة من
أغنيائهم وردها على فقرائهم([11]).
ونوضح ذلك كما يلي:
إن جَيْفَر وعبداً كانا ملكي عمان، وهما ابنا الجلندى
بن المستكبر بن الحراز الأزدي، ولعل الجلندى كان قد شاخ ففوض الأمر إلى
ولديه هذين.
وقد بعث النبي «صلى الله عليه وآله» عمرو بن العاص إلى
ولديه بكتاب يدعوهما فيه إلى الإسلام، ولعل أباهما قد اطّلع على هذا
الكتاب، أو لعله «صلى الله عليه وآله» كان قد أرسل إلى أبيهما الجلندى
نفسه كتاباً آخر، فإن ابن إسحاق قد ذكر: أن النبي «صلى الله عليه وآله»
بعث ابن العاص إليه([12]).
ومهما يكن من أمر، فإن نص الكتاب الذي كتبه لهما كما
يلي:
«بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندى: سلام
على من اتبع الهدى.
أما بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، أسلما تسلما،
إني رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حياً ويحق القول على
الكافرين، وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا
بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما، وخيلي تحل بساحتكما، وتظهر نبوتي على
ملككما».
وختم رسول الله «صلى الله عليه وآله» الكتاب، وكتب أبي
بن كعب([13]).
ويقولون:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» بعث أبا زيد الأنصاري
(وهو قيس بن السكن، وقيل: اسمه ثابت بن قيس، وقيل غير ذلك) وعمرو بن
العاص بكتاب منه إلى ابني الجلندى، يدعوهما فيه إلى الإسلام، وقال
لهما: إن أجاب القوم إلى شهادة الحق، وأطاعوا الله ورسوله، فعمرو
الأمير، وأبو زيد على الصلاة، وأخذ الإسلام على الناس، وتعليمهم القرآن
والسنن([14]).
وقال المسعودي:
إن إرسال عمرو إلى جيفر وعبد ابني الجلندى قد كان في
السنة الحادية عشرة([15]).
وقيل:
إنه «صلى الله عليه وآله» أرسل أبا زيد الأنصاري بكتابه
إلى عبد وجيفر سنة ست، ووجه عمرو سنة ثمان.
وقد أوصى النبي «صلى الله عليه وآله» أبا زيد (في سنة
ثمان) بأن يأخذ الصدقة من المسلمين، والجزية من المجوس([16]).
وقد كانت النتيجة هي:
إسلام جيفر وعبد ابني الجلندى، وأسلم معهما خلق كثير([17]).
وقد حكى لنا عمرو بن العاص حواراً وتفاصيل زعم أنها جرت
له مع جيفر، وعبد ابني الجلندى، والقصة هي التالية:
قال عمرو:
فعمدت إلى عبد، وكان أحلم الرجلين، وأسهلهما خلقاً،
فقلت: إني رسول رسول الله «صلى الله عليه وآله» إليك وإلى أخيك بهذا
الكتاب.
فقال:
أخي مقدم عليّ بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ
كتابك. ثم قال: وما تدعو إليه؟
قلت:
أدعوك إلى الله وحده، وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن
محمداً عبده ورسوله.
قال:
يا عمرو إنك ابن سيد قومك، فكيف صنع أبوك ـ يعني العاص
بن وائل ـ فإن لنا فيه القدرة؟([18]).
قلت:
مات ولم يؤمن بمحمد «صلى الله عليه وآله»، وودت له لو
كان آمن وصدق به، وقد كنت قبل على مثل رأيه حتى هداني إلى الإسلام.
قال:
فمتى تبعته؟
قلت:
قريباً.
فسألني أين كان إسلامي؟
فقلت:
عند النجاشي، وأخبرته أنه قد أسلم.
قال:
فكيف صنع قومه بملكه؟
قلت:
أقروه واتبعوه.
قال:
والأساقفة؟
قلت:
نعم.
قال:
انظر يا عمرو ما تقول، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح من
كذب؟
قلت:
وما كذبت، وما نستحله في ديننا.
ثم قال:
ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي.
قلت له:
بلى.
قال:
بأي شيء علمت ذلك يا عمرو؟
قلت:
كان النجاشي يخرج له خراجاً، فلما أسلم النجاشي وصدق
بمحمد «صلى الله عليه وآله» قال: لا والله، ولو سألني درهماً واحداً ما
أعطيته.
فبلغ هرقل قوله، فقال له أخوه:
أتدع عبدك لا يخرج لك خراجاً، ويدين ديناً محدثاً؟
فقال هرقل:
رجل رغب في دين واختاره لنفسه ما أصنع به، والله، لولا
الظن([19])
بملكي لصنعت كما صنع.
قال:
أنظر ما تقول يا عمرو.
قلت:
والله صدقتك.
قال عبد:
فأخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه؟
قلت:
يأمر بطاعة الله عز وجل، وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر
وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان، وعن الزنى وشرب الخمر، وعن عبادة
الحجر والوثن والصليب.
فقال:
ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني لركبنا
حتى نؤمن بمحمد «صلى الله عليه وآله» ونصدق به، ولكن أخي أضنّ بملكه من
أن يدعه ويصير ذَنَبَاً.
قلت:
إنه إن أسلم ملَّكه رسول الله «صلى الله عليه وآله» على
قومه، فأخذ الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم.
قال:
إن هذا لخلق حسن، وما الصدقة؟
فأخبرته بما فرض رسول الله «صلى الله عليه وآله» من
الصدقات في الأموال، ولما ذكرت المواشي، قال: يا عمرو، ويؤخذ من سوائم
مواشينا التي ترعى في الشجر وترد المياه؟
فقلت:
نعم.
فقال:
والله، ما أرى قومي في بعد دارهم، وكثرة عددهم يطيعون
بهذا.
قال عمرو:
فمكثت أياماً بباب جيفر، وقد أوصل إليه أخوه خبري، ثم
إنه دعاني، فدخلت، فأخذ أعوانه بضبعي، قال: دعوه.
فذهبت لأجلس، فأبوا أن يدعوني، فنظرت إليه، فقال:
تكلم بحاجتك.
فدفعت إليه كتاباً مختوماً، ففض خاتمه فقرأه.
ثم دفعه إلى أخيه، فقرأه، ثم قال:
ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟
فقلت:
تبعوه، إما راغب في الدين، أو راهب مقهور بالسيف.
قال:
ومن معه؟
قلت:
الناس قد رغبوا في الإسلام، واختاروه على غيره، وعرفوا
بعقولهم مع هدي الله إياهم أنهم كانوا في ضلال مبين، فما أعرف أحداً
بقي غيرك في هذه الخرجة، وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه تطأك الخيول،
وتبيد خضراؤك، فأسلم تسلم ويستعملك على قومك، ولا تدخل عليك الخيل
والرجال.
قال:
دعني يومي هذا، وارجع إلي غداً.
فلما كان الغد أتيت إليه، فأبى أن يأذن لي، فرجعت إلى
أخيه فأخبرته أني لم أصل إليه.
فأوصلني إليه، فقال:
إني فكرت فيما دعوتني إليه فإذا أنا أضعف العرب، إن
ملكت رجلاً ما في يدي، وهو لا تبلغه خيله ههنا، وإن بلغت خيله ألفت
قتالاً ليس كقتال من لاقى.
قلت:
وأنا خارج غداً.
فلما أيقن بمخرجي خلا به أخوه، فأصبح، فأرسل إلي، فأجاب
إلى الإسلام هو وأخوه جميعاً، وصدقا وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم
فيما بينهم، وكانا لي عوناً على من خالفني، وأسلما وأسلم معهما خلق
كثير([20]).
وتوفي رسول الله «صلى الله عليه وآله» وعمرو بعمان([21]).
ونقول:
إن هذه الرواية التي يظهر عمرو فيها نفسه أنه أدار
الحوار بصورة راقية، وقوية، وأورد لنفسه جملاً تحمل معاني جليلة،
ولمعات جميلة، إنها رواية مكذوبة بلا شك، فلاحظ ما يلي:
1 ـ
إن عمرو بن العاص لم يكن لا في ذلك الوقت، ولا قبله،
ولا بعده من أهل هذه المعاني، ولا من الذين يقدرون على مثلها.
2 ـ
إن روايته قد تضمنت بعض الأكاذيب، كقوله: إن إسلامه كان
عند النجاشي في الحبشة، حين ذهب في طلب جعفر وأصحابه، أي قبل الهجرة
بحوالي ثماني سنوات..
وهذا كذب واضح، فإنه أسلم سنة ثمان بعد الهجرة كما
تقدم؛ بل إنه هو نفسه قد ذكر ما يناقضه قبله مباشرة، حيث قال: إنه إنما
تبع النبي «صلى الله عليه وآله» قبل يسير، أي في السنة الثامنة بعد
الهجرة مباشرة.. فإن كان قد أسلم منذئذٍ، فلماذا تأخر اتباعه للنبي
«صلى الله عليه وآله» إلى هذا الوقت؟!
وهل يمكن أن يعتقد بنبوة النبي «صلى الله عليه وآله»
ويكون مسلماً، ثم يحاربه كل هذه السنين؟!
3 ـ
إن ما زعمه من إسلام قوم النجاشي غير ظاهر، فإنهم قد
حاربوه، وجرى له معهم أمور يطول ذكرها.
4 ـ
وأما حديثه عن هرقل والنجاشي، وأن هرقل لم يطالب
النجاشي بالمال الذي كان قد فرضه عليه، فهو لو كان صحيحاً لشاع وذاع،
ولبلغ ملك عمان، ولم يخفَ عليه أمر بهذه الأهمية..
5 ـ
كما أنه لو صح قوله: إنه لولا أنه يضن بملكه لكان قد
أسلم، لا ينسجم مع حربه لرسول الله «صلى الله عليه وآله» في مؤتة وفي
غيرها بتلك الشراسة والحدة..
6 ـ
والأهم من ذلك: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أخبر
بما سيجيب به ابنا الجلندى أيضاً، ولكنّ مؤرخيهم تجاهلوا ذلك، ولكن ابن
شهرآشوب ذكره لنا، فقال:
وكتب «صلى الله عليه وآله» إلى ابن
جلندى وأهل عمان، وقال:
أما إنهم سيقبِّلون كتابي، ويصدقوني، ويسألكم ابن
جلندى: هل بعث رسول الله معكم بهدية؟
فقولوا:
لا.
فسيقول:
لو كان رسول الله بعث معكم بهدية لكانت مثل المائدة
التي نزلت على بني إسرائيل وعلى المسيح.
فكان كما قال «صلى الله عليه وآله»([22]).
ونقول:
إننا نذكر هنا ما يلي:
ربما يقال:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» الذي كان ينظر إلى الغيب
بستر رقيق كان يعلم أن عمرو بن العاص سوف يحاول الإستفادة من مهمة حمله
للكتاب لابني الجلندى في تسطير بعض الفضائل لنفسه والظهور في حالات
استعراضيه.. وانتفاخات بهلوانية عن ذلك ليكون إخباره «صلى الله عليه
وآله» هذا من موجبات إسقاط دعاويه، وإظهار أنه كاذب مفتر فيها، وهذا ما
حصل بالفعل.
وقد رأينا:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد وزع المهمات بطريقة لها
مغزاها ومرماها.
فهؤلاء أناس يدخلون في الإسلام للتو، فهم بحاجة إلى أن
يتذوقوا طعم الإسلام في روحانيته، وفي إنشاء العلاقة مع الله، وأن
يعرفوا شيئاً من حقائق هذا الدين، واحكامه، وسننه، وتعاليمه.
وقد كان أبو زيد أقدر على إنجاز هذه المهمة، وأعرف
بجزئياتها وتفاصيلها، وأميل إلى تحقيق الغاية المرجوة.
أما عمرو بن العاص فقد لا يهتم بهذا الأمر كثيراً، بل
قد يكون أبعد الناس عن المعرفة بتفاصيل الدين، بل وبكلياته أيضاً، لأنه
قد أسلم أو تظاهر بالإسلام في نفس تلك السنة، فهو يحتاج إلى ما يحتاجون
إليه.
وأما الإمارة التي تعني تدبير الأمور الدنيوية، فهو
أكثر اندفاعاً إليها، ورغبة بها وحرصاً عليها..
يضاف إلى ذلك:
أنه لا مجال للإطمئنان إلى أنه كان يملك المواصفات التي
تخوله لحمل أمانة الصلاة بالناس.. أو أنه كان أميناً على دين الناس
بالقدر الذي يسمح بإفساح المجال له لتعليمهم أحكامه، حتى لو كان على
علم بها.
وكان «صلى الله عليه وآله» ـ كما يقولون ـ كلما أرسل
رجلاً من المهاجرين قرنه برجل من الأنصار، وهكذا فعل في هذه المناسبة
أيضاً.
وقال:
ذكروا أيضاً أن الجلندى حين جاءه
كتاب النبي «صلى الله عليه وآله» قال: «والله، لقد دلني على هذا النبي
الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول من أخذ به، ولا ينهى عن شر إلا كان
أول تارك له، وأنه يَغْلِبُ فلا يبطر، ويُغْلَبُ فلا يضجر (يهجر)، وأنه
يفي بالعهد، وينجز بالموعود (بالوعد)، وأنه لا يزال سراً قد اطلع عليه
يساوى فيه أهله، وأشهد أنه نبي»([23]).
ثم أنشد أبياتاً منها:
أتـاني عـمـرو بـالتي ليس بعدها
من الحـق شـيء والنصيح نصيح
فقلت له: ما زدت أن جئت بالتي جلنـدى عـمان فـي عـمان
يصيح
فيا عمرو قد أسلمـت لله جهـرة ينـادي بهـا في
الـواديـين فصيح([24])
وقد تضمن الكتاب المذكور:
الكثير من الإشارات والدلالات التي ينبغي التوقف عندها
لاستفادة السلوك والموقف، والمفهوم الإيماني والسياسي منها. وبما أن
كتابنا هذا ليس محل ذكر ذلك، فإننا نكتفي بالإلماح إلى ما ذكره بعضهم
منها، وهو كما يلي:
ذكر العلامة الأحمدي «رحمه الله» عدة نقاط مفيدة هنا،
وهي:
1 ـ
«وتظهر نبوتي الخ..» هذه الجملة تعطينا درساً إضافياً،
ومعنى حقيقياً كاملاً عن السلطنة والفتوحات الإسلامية، إذ المستفاد
منها: أن الفتوحات الإسلامية يجب أن تكون فتحاً إلهياً، وظهوراً
روحانياً، تحكم على القلوب، وتفتح الضمائر والصدور، محفوفة بالإيمان،
ومشفوعة بالتقوى (قبل أن تكون مغالبة القدرة الظاهرة بالقوة، ورباط
الخيل) لا مغالبة على الدنيا، كما قال أمير المؤمنين «عليه السلام»:
«اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منافسة في سلطان،
ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، ونظهر
الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك»([25]).
وقال الحسين «عليه السلام»:
«إني لم أخرج أشراً ولا بطراً، وإنما خرجت أطلب الإصلاح
في أمة جدي محمد «صلى الله عليه وآله»، أريد أن آمر بالمعروف، وأنهى عن
المنكر الخ..»([26]).
وسلطنة الإسلام سلطنة عقيدة وإيمان، وروحانية ونبوة،
وليست ملكاً وإمبراطورية مادية، والفرق بينهما واضح لمن عقل وتدبر،
وكذلك الحكومات التي أسسها الأنبياء العظام، صلوات الله عليهم.
وإذا شئت أن تعرف الحقيقة فقس بين
فتوحات ملوك العالم، والفتوحات التي وقعت في عصر النبي «صلى الله عليه
وآله»، ولاحظ حكومة علي «عليه السلام» ومعاوية، هذا يعفو عن أعدى
أعدائه، وذاك يقتل على الظنة والتهمة»([27]).
2 ـ
وقال العلامة الأحمدي «رحمه الله» أيضاً: «لأنذر من كان
حياً» أي فهماً عاقلاً، كنى عن العاقل بالحي، إيعازاً إلى أن الذي لا
يعقل ولا يفهم فهو كما قال تعالى:
{إِنَّكَ
لَا تُسْمِعُ المَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء}([28])
و {إِنَّ
اللهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاء وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ}([29]).
3 ـ
في الكتاب تصريح بعموم دعوته بقوله «صلى الله عليه
وآله»: «إني رسول الله إلى الناس كافة»، وأنه لا تختص نبوته بالعرب، أو
أم القرى ومن حولها.
4 ـ
ثم وعدهما ببقاء ملكهما إن أسلما وذهابه إن لم يسلما،
وأخبر بأن خيله تحل بساحتهما، وتغلب نبوته على ملكهما([30]).
ونضيف إلى ما تقدم:
ألف:
إنه «صلى الله عليه وآله» لم يقل لهما: إني أزيل
ملككما، بل قال: إن ملكهما زائل عنهما، ولم يحدد لهما من الذي سيزيله،
أو هل سيزول بسبب مرور الزمان، وبسنّة الموت والحياة؟! أو أنه سيزول
على يد من يسلبهما إياه!!
ب:
ولكنه أشار إلى أن استكبارهما سوف يسقط حرمتهما،
ويجعلهما في معرض التحدي، ولابد أن يواجها الحرب لإسقاط ذلك الإستكبار،
وإزالة ما يمارسونه من الظلم والقهر، والتسلط على الآخرين بما يملكونه
من قوة..
ج:
إنه لم يقل لهما: إنه هو سيظهر عليهما، بل تجاوز الحديث
عن شخصه، وعنهما كأشخاص، ليتحدث عن مقام النبوة المرتبط بالله، الذي
يريدان أن يستبدلاه بموقع الملك والسلطان، وانه إذا كان التحدي بين
هذين، فإن الغلبة لابد أن تكون للنبوة، لأنها هي التي ترتبط بالله
تعالى، وتستمد قوتها منه.
د:
ويلاحظ: أنه تحدث عن مقام النبوة، لا عن الرسولية، في
إثارة وجدانية، وإيقاظ للشعور الفطري الصافي والصادق، النابع من أعماق
النفس الإنسانية بعيداً عن المؤثرات الخارجية، والصوارف المادية
والأهوائية..
روى الواقدي، عن الزّهري، وعبد الله بن يزيد، عن سعيد
بن عمرو، قالا: لما رجع رسول الله «صلى الله عليه وآله» من
الجِعِرَّانة قدم المدينة يوم الجمعة لثلاث ليال بقين من ذي القعدة،
فأقام بقية ذي القعدة وذي الحجة، فلما رأى هلال الُمحَرّم بعث
المُصَدِّقين.
فبعث بريدة بن الحُصَيب إلى سليم ومُزَينة.
وبعث رافع بن مَكِيث إلى جُهَينة.
وبعث عمرو بن العاص إلى فزارة.
وبعث الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب.
وبعث بسر بن سفيان الكعبي إلى بني كعب.
وبعث ابن اللُّتْبيَّة الأزدي إلى بني ذُبيان.
وبعث رجلاً من بني سعد إلى هُذَيم على صدقاتهم([31]).
وفي سنة ثمان بعث عيينة بن حصن الفزاري إلى بني العنبر،
من تميم، فأغار عليهم، وسبى منهم نساء([32]).
ومن السرايا التي تذكر هنا سرية الضحاك بن سفيان
الكلابي إلى القرطاء، وحيث إننا ذكرناها حين ترقيع الدلاء بكتب رسول
الله «صلى الله عليه وآله، فإننا نكتفي بما ذكرناه هناك، فنرجوا من
القارئ الرجوع إلى ذلك الموضع للوقوف على ما جرى.
ويقولون:
إنه في شهر ربيع الآخر من سنة تسع كانت سرية عكاشة بن
محصن إلى الجباب (وهي أرض عذرة وبلي)([33])
وهما قبيلتان من قضاعة.
وقيل:
إلى أرض فزارة وكلب، ولعذرة فيها شركة([34]).
وقد ذكرها ابن سعد، وتبعه اليعمري وغيره، ولم يبينوا
سببها، ولا عدد من ذهب فيها، ولا ما جرى([35]).
فهل كان فيها ما يوجب الطعن على بعض من يُتَّهم الرواة
بالتستر عليه، وإبعاد الشبهات عنه؟ أم أنه لم يكن في تلك السرية حدث
يستحق الذكر، أو نشاط يحسن التنويه به؟! أو يفيد في إعلاء شأن من يهمهم
إعلاء شأنه؟! إلى غير ذلك من أسباب تدعو إلى الإهمال والكتمان!!
كل ذلك محتمل والله العالم بحقائق الأمور..
([1])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص210 والسيرة الحلبية ج3 ص200 وتاريخ
الخميس = = ج2 ص109 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص112 ومعجم
البلدان ج4 ص471 و 472 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص157
وراجع: تاريخ مدينة دمشق ج25 ص17 وعيون الأثر لابن سيد الناس
ج2 ص229 والبداية والنهاية ج3 ص124 وإمتاع الأسماع ج2 ص21
والسيرة النبوية لابن هشام ج1 ص258 والسيرة النبوية لابن كثير
ج2 ص75.
([2])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص210 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص157
وعيون الأثر لابن سيد الناس ج2 ص229.
([3])
تاريخ الخميس ج2 ص109 عن المواهب اللدنية.
([4])
البحار ج21 ص184 ومستدرك سفينة البحار ج5 ص36 ومكاتيب الرسول
ج1 ص40 والكامل في التاريخ ج2 ص272 و 273 وراجع: معجم ما
استعجم للبكري الأندلسي ج3 ص893.
([5])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص211 عن ابن إسحاق، وقال في هامشه: أخرجه
أبو داود (514) والترمذي (199) وابن ماجة (717) وابن سعد في
الطبقات ج1 ق2 ص63 والطحاوي في معاني الآثار ج1 ص142 والبيهقي
في الدلائل ج4 ص127 وراجع: الإستيعاب (ط دار الجيل) ج2 ص531
وأسد الغابة ج2 ص213 والوافي بالوفيات ج15 ص6 وراجع: السيرة
النبوية لابن كثير ج4 ص163 والبداية والنهاية ج5 ص98.
([6])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص211 وتحفة الأحوذي ج1 ص508 وفيض القدير
ج2 ص530 وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج7 ص503 والمعجم
الكبير ج5 ص263 وناسخ الحديث ومنسوخه ص263 والمجموع للنووي ج3
ص121 ومكاتيب الرسول ج1 ص217.
([7])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص349 والخرائج والجرائح ج2 ص513 والبحار
ج18 ص34 ومكاتيب الرسول ج1 ص226 وبغية الباحث عن زوائد مسند
الحارث ص187 ودلائل النبوة للأصبهاني ج1 ص282 وكنز العمال ج13
ص399 وتاريخ مدينة دمشق ج34 ص345 وتهذيب الكمال ج9 ص446 وفتوح
مصر وأخبارها للقرشي المصري ص533 والسيرة النبوية لابن كثير ج4
ص161 والبداية والنهاية ج5 ص97 وإمتاع الأسماع ج10 ص136.
([8])
راجع مكاتيب الرسول ج1 ص226 وأشار في هامشه إلى المصادر
التالية: البحار ج18 ص34 و 35 عن الخرائج، والإستيعاب ج1 ص567
وأوعز إليه في الإصابة ج1 ص557/2850 وراجع: أسد الغابة ج2 ص213
قال: وأخرجه الثلاثة، والمطالب العالية ج4 ص11 والسيرة الحلبية
ج3 ص267 و 268 وكنز العمال ج7 ص38 و (في ط أخرى) ج16 ص12 و 13
والبداية والنهاية ج5 ص83 ومجمع الزوائد ج5 ص203 و 204 وحياة
الصحابة ج1 ص187 و 188 عن بعض من تقدم وعن البيهقي، وأحمد،
والطبراني، والبداية، والبغوي، وابن عساكر، ومسند أحمد ج4 ص169
ومجموعة الوثائق السياسية: 277 و (في ط أخرى): 326/ 242 عن أبي
عمر، وابن الأثير، وراجع: رسالات نبوية ص19 ومعجم القبائل ج2
ص636 والمعجم الكبير للطبراني ج5 ص303.
وراجع: الخرائج والجرائح للراوندي ج2 ص514.
([9])
راجع مكاتيب الرسول ج1 ص227 وأشار في هامشه إلى المصادر
التالية: مسند أحمد ج4 ص168 و 169 والإصابة ج1 ص303 / 1555 عن
البغوي، وابن أبي شيبة، والبارودي، والطبراني، وفي الإستيعاب
(بهامش الاصابة) ج1 ص364: «حيان بن مج الصدائي» ثم أوعز إلى
القصة، وأسد الغابة ج1 ص365 والمطالب العالية ج4 ص6 ومجموعة
الوثائق السياسية: 326 ومجمع الزوائد ج5 ص199.
وراجع: والمعجم الكبير ج4 ص36 وكنز العمال ج12 ص372 وأسد
الغابة ج2 ص68 وفتوح مصر وأخبارها للقرشي المصري ص532.
([10])
مواهب الجليل ج8 ص85 و
ميزان
الحكمة ج4 ص3692 و
مسند
أحمد ج4 ص409 وصحيح البخاري ج3 ص48 وج8 ص50 و
صحيح
مسلم ج6 ص6 وفتح الباري ج4 ص363 وج8 ص49 وج12ص242وج13 ص120وعون
المعبود ج8 ص106 وعن السنن الكبرى للنسائي ج1 ص13 و 65 ومسند
أبي يعلى ج13 ص214 والمعجم الأوسط ج1 ص216 والمعجم = = الكبير
ج20 ص42 ومسند الشهاب ج2 ص177 والجامع الصغير ج1 ص386 وكنز
العمال ج6 ص47 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج9 ص216 والأحكام
لابن حزم ج6 ص764 والضعفاء للعقيلي ج3 ص190 ولسان الميزان ج4
ص324.
([11])
البحار ج21 ص184 عن الكامل في التاريخ ج2 ص185 وراجع: مكاتيب
الرسول ج2 ص369 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص362 والكامل في
التاريخ (ط دار صادر) ج2 ص272 وإمتاع الأسماع ج2 ص36.
([12])
الإصابة ج1 ص262 وراجع: الشفاء لعياض ج1 ص484 ومكاتيب الرسول
ج2 ص364 و 365.
([13])
مكاتيب الرسول ج2 ص361 وقال في هامشه: كما في زاد المعاد،
ونشأة الدولة الإسلامية، والوثائق، ودحلان، وراجع: السيرة
الحلبية ج3 ص284 والسيرة النبوية لدحلان (بهامش الحلبية) ج3
ص76 وصبح الأعشى ج6 ص365 و 366 وأعيـان الشـيـعـة ج2 ص14 و (في
ط أخرى) ج1 ص245 وأعـلام = = السائلين ص26 ورسالات نبوية ص133
وجمهرة رسائل العرب ج1 ص41 عن: صبح الأعشى ج6 ص380 والمواهب
اللدنية ج3 ص404، وراجع: نشأة الدولة الإسلامية ص331 وزاد
المعاد ج3 ص62 وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ج3 ص353. وراجع:
الطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ق2 ص18 و ج4 ق2 ص188 وفتوح البلدان
ص87 و (في ط أخرى) ص104 والإصابة ج1 ص576 في ترجمة زبيد بن
الأعور بن جيفر الجلندى الأزدي، وص264 في ترجمة جيفر، وص262 في
الجلندى، والتنبيه والإشراف ص240 والسيرة النبوية لابن هشام ج4
ص254 والمناقب ج1 ص114 والكامل في التاريخ ج2 ص232 و 272 و 352
وتاريخ الأمم والملوك للطبري ج2 ص645 وج3 ص29 و 95 وتاريخ
اليعقوبي ج2 ص67 وحياة الصحابة ج1 ص102 وتاريخ الخميس ج2 ص116
و 118 والبحار ج18 ص138 و ج21 ص184 وأسد الغابة ج1 ص313
والشفاء للقاضي عياض ج1 ص484 ونسيم الرياض ج2 ص447 وشرح الشفاء
للقاري (بهامش نسيم الرياض) ج2 ص447 والإستيعاب (بهامش
الإصابة) ج1 ص261 والبداية والنهاية ج4 ص374 والتراتيب
الإدارية ج1 ص201 والروض الأنف ج3 ص304 والمنتظم ج4 ص10
ومجموعة الوثائق السياسية 161/76 عن جمع ممن ذكرناه، وعن
المواهب اللدنية ج1 ص294 وصبح الأعشى، ومنشآت السلاطين لفريدون
بك ج1 ص33 والوفاء لابن الجوزي ص741 وكتاب النبي للأعظمي، ونصب
الراية للزيلعي ج4 ص423 والمصباح المضيء ج2 ص306 عن الهدى
المحمدي، ومدينة البلاغة ج2 ص291 وقال: انظر اشپرنكر ج3 ص382
وزاد: يقول المؤلف (حميد الله): رأيت عند بعض الإخوان في باريس
في السنة 1400ه 1980م فصيلة من جريدة يومية عربية من تونس
فيها تصوير أصل مكتوب النبي «عليه السـلام» إلى جيفر وعبـد
ابني الجلندى، ولكـن لم = = يعرف اسم الجريدة ولا تأريخها.
وفيما علقت عليه الجريدة التي نشرته: «عثر علماء الآثار على
النسخة الأصلية... جاء هذا أثناء زيارة الأستاذ الإسماعيلي
الرصاصي السفير العماني السابق لدى إيران لبعض البلدان
العربية، وقد وجد الأصل في حوزة هاوي آثار وتحف لبناني
الجنسية... الشخص المذكور رفض تسليم المخطوط لسعادة السفير إلا
أنه سمح له بتصويره. ووعدنا سعادة سفير عمان في باريس أن يبحث
فيه فجزاه الله خيراً.
([14])
فتوح البلدان ص103 و 104 و (ط مكتبة النهضة) ج1 ص92 وتاريخ
الكوفة للسيد البراقي ص265 ومكاتيب الرسول ج2 ص369.
([15])
التنبيه والإشراف (ط دار صعب) ص240 مكاتيب الرسول ج2 ص396 عن
التنبيه والإشراف.
([16])
راجع: فتوح البلدان ص105 ونشأة الدولة الإسلامية ص178.
([17])
راجع: تاريخ الأمم والملوك للطبري ج2 ص520 وج3 ص258 والكامل في
التاريخ ج2 ص352 والطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ق2 ص18 ونسيم
الرياض ج2 ص448 والسيرة النبوية لدحلان ج3 ص78 والفتوح لابن
أعثم ص104 ونشأة الدولة الإسلامية ص197 والإصابة ج1 ص264 وج3
ص234 وتاريخ الخميس ج2 ص183.
([18])
كذا في الأصل، ولعل الصحيح هو «القدوة».
([19])
كذا في الأصل، ولعل الصحيح هو «الضنّ»، ويشهد له قول عبد فيما
يأتي: «ولكن أخي أضنّ بملكه».
([20])
مكاتيب الرسول ج2 ص370 ـ 372 وقال في هامشه: راجع في تفصيل قصة
عمرو مع جيفر: السيرة الحلبية ج3 ص284 والسيرة النبوية لدحلان
(بهامش الحلبية) ج3 ص75 والطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص262 و(في
ط أخرى) ج1 ق2 ص18 و ج4 ق2 ص188 وفتوح البلدان للبلاذري ص104
ونسيم الرياض ج2 ص448 والتراتيب الإدارية ج1 ص201 وزاد المعاد
ج1 ص62 وأعيان الشيعة ج1 ص245 والمصباح المضيء ج2 ص306 ـ 311.
([21])
مكاتيب الرسول ج2 ص372 وقال في هامشه: تاريخ الأمم والملوك
للطبري ج2 ص520 وج3 ص258 والكامل في التاريخ ج2 ص352 والطبقات
الكبرى لابن سعد ج1 ق2 ص18 ونسيم الرياض ج2 ص448 والسيرة
النبوية لدحلان ج3 ص78 والفتوح لابن أعثم ص104 ونشأة الدولة
الإسلامية ص197 والإصابة ج1 ص264 وج3 ص234 وتاريخ الخميس ج2
ص183.
([22])
البحار ج18 ص138 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص114 و (ط المكتبة
الحيدرية) ج1 ص100.
([23])
الإصابة ج1 ص262 و (ط دار الكتب العلمية) ج1 ص637 والروض الأنف
ج4 ص250 والشفا لعياض ج1 ص484 وراجع: نسيم الرياض ج2 ص447 و
448 وشرح الشفا لملَّا علي القاري (بهامش نسيم الرياض) في نفس
الجزء والصفحة. وراجع: مكاتيب الرسول ج2 ص364 و 365.
([24])
الإصابة ج1 ص262 و (ط دار الكتب العلمية) ج1 ص637 وراجع:
مكاتيب الرسول ج2 ص364 و 365.
([25])
مكاتيب الرسول ج2 ص366 عن: نهج البلاغة (بشرح عبده) خطبة 129
وشرح النهج للمعتزلي (ط بيروت) ج8 ص264 و (البحراني) ج3 ص148.
([26])
مكاتيب الرسول ج2 ص366 عن: المناقب لابن شهرآشوب (ط قم) ج4 ص89
وراجع: مقتل الحسين «عليه السلام» للخوارزمي ج1 ص188 ونفس
المهموم ص37 والبحار ج44 ص329 ومكاتيب الأئمة «عليهم السلام»
ج2 ص40 ولمعة من بلاغة الحسين «عليه السلام» ص106 وشرح إحقاق
الحق = = (الملحقات) ج11 ص602.
([27])
مكاتيب الرسول ج2 ص366 و 367.
([28])
الآية 80 من سورة النمل.
([29])
الآية 8 من سورة فاطر.
([30])
راجع ما تقدم في: مكاتيب الرسول ج2 ص365 و 366.
([31])
المغازي للواقدي ج3 ص973 وراجع: تاريخ مدينة دمشق (ط دار الكتب
العلمية) ج20 ص14 و (ط دار الفكر) ج18 ص23.
([32])
البحار ج21 ص184 عن الكامل في التاريخ ج2 ص182 ومستدرك سفينة
البحار ج5 ص36 وراجع: الكامل في التاريخ (ط دار صادر) ج2 ص273.
([33])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص220 عن ابن سعد وعن العيون، والمورد.
وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص164 وعيون الأثر ج2 ص240
وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص624
([34])
معجم ما استعجم للبكري الأندلسي ج2 ص395.
([35])
راجع: شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج4 ص50.
|