|
وفادات غير معتادة
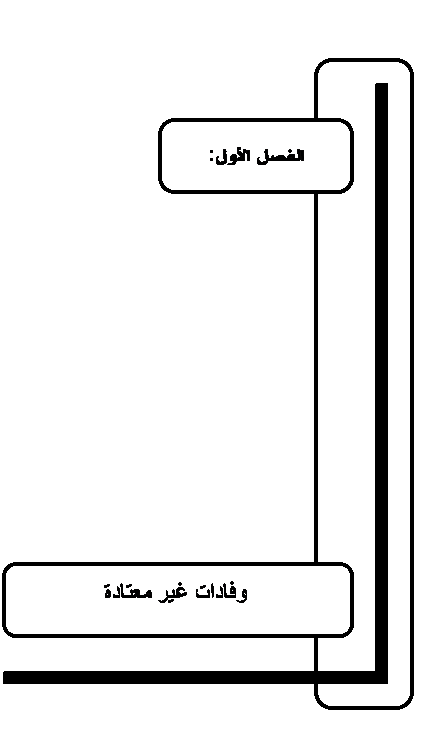
سبق وتحدثنا في كتابنا هذا عن عدد من الوفود على رسول
الله «صلى الله عليه وآله» لاقتضاء المناسبة ذلك.. فنحن سوف لا نعيد
الحديث عن هذه الوفود اكتفاءً بما ذكرناه عنها سابقاً.. ومن هذه الوفود
التي تحدثنا عنها:
1 ـ
وفد بني عبس.
2 ـ
وفد بني تميم.
3 ـ
وفد هوازن.
4 ـ
وفد صداء.
5 ـ
وفد بلال بن الحارث في أربعة عشر رجلاً من مزينة.
6 ـ
وفادة عدي بن حاتم.
7 ـ
وفادة كعب بن زهير.
عن عمرو بن عوف:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان في المسجد، فسمع
كلاماً من ورائه، فإذا هو بقائل يقول: اللهم أعنّي على ما تنجيني مما
خوفتني.
فقال
رسول الله «صلى الله عليه وآله» حين سمع ذلك:
«ألا يضم إليها أختها».
فقال الرجل:
اللهم ارزقني شوق الصالحين إلى ما شوقتهم إليه.
فقال النبي «صلى الله عليه وآله»
لأنس:
«اذهب إليه فقل له: يقول لك رسول الله «صلى الله عليه
وآله» تستغفر له».
فجاءه أنس فبلغه.
فقال الرجل:
يا أنس، أنت رسول رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلي؟
قال:
نعم.
قال:
اذهب فقل له:
إن الله عز وجل فضلك على الأنبياء بمثل ما فضل رمضان على سائر الشهور،
وفضل أمتك على سائر الأمم بمثل ما فضل يوم الجمعة على سائر الأيام،
فذهب ينظر إليه فإذا هو الخضر «عليه السلام»([1]).
وعن أنس، قال:
خرجت ليلة مع النبي «صلى الله عليه وآله» أحمل الطهور
فسمع [منادياً ينادي، فقال لي: «يا أنس صه» فسكت، فاستمع فإذا هو]
يقول: اللهم أعنّي على ما ينجيني مما خوفتني منه.
قال:
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «لو قال أختها
معها».
فكأن الرجل لقن ما أراد النبي «صلى
الله عليه وآله» فقال:
وارزقني شوق الصالحين إلى ما شوقتهم إليه».
فقال النبي «صلى الله عليه وآله»:
«يا أنس، دع عنك الطهور، وائت هذا فقل له: أدعُ لرسول
الله أن يعينه على ما ابتعثه الله به، وادع لأمته أن يأخذوا ما أتاهم
به نبيهم من الحق».
قال:
فأتيته [فقلت: رحمك الله، ادع الله لرسول الله أن يعينه
(على ما ابتعثه) به، وادع لأمته أن يأخذوا ما أتاهم به نبيهم من الحق.
فقال لي:
ومن أرسلك؟
فكرهت أن أخبره ولم أستأمر رسول الله «صلى الله عليه
وآله». فقلت له: رحمك الله ما يضرك من أرسلني؟ ادع بما قلت لك.
قال:
لا، أو تخبرني من أرسلك.
قال:
فرجعت إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقلت له: يا
رسول الله، أبى أن يدعو لك بما قلت له حتى أخبره بمن أرسلني.
فقال:
«ارجع إليه فقل له: أنا رسول رسول الله».
فرجعت إليه فقلت له.
فقال لي:
«مرحباً برسول [رسول] الله، أنا كنت أحق أن آتيه، اقرأ
على رسول الله مني السلام وقل له: الخضر يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن
الله تعالى فضلك على النبيين كما فضل شهر رمضان على سائر الشهور، وفضل
أمتك على الأمم كما فضل يو م الجمعة على سائر الأيام».
قال:
فلما وليت
سمعته يقول: «اللهم اجعلني من هذه الأمة المرشدة المرحومة، المتاب
عليها»([2]).
ونقول:
إن هذه الرواية موضع شك كبير، فلاحظ ما يلي:
ألف:
قد ذكرت
الرواية الأولى: أن النبي
«صلى الله عليه وآله» أرسل أنس بن مالك إلى الخضر ليطلب
منه أن يستغفر له.. فنظر إليه أنس، فإذا هو الخضر «عليه السلام»..
ونحن لا نشك في عدم صحة هذه الرواية:
أولاً:
إذا كان الخضر «عليه السلام» قد سمع صوت النبي «صلى
الله عليه وآله»، وضم لتلك الكلمة أختها، فلماذا لم يكلمه النبي «صلى
الله عليه وآله» مباشرة، بل أرسل إليه أنس بن مالك يطلب منه أن يستغفر
له..
ودعوى:
أنه أراد أن لا يعرِّف الناس أنه «صلى الله عليه وآله»
يطلب الإستغفار.. لا تنفع، فإنه «صلى الله عليه وآله» كان يجاهر في مثل
هذا الأمر..
ثانياً:
من أين عرف أنس بن مالك أن الذي يكلمه هو الخضر «عليه
السلام»، فإن أحداً لم يخبره بذلك، فهل كان قد رآه من قبل؟! ومتى؟
وأين؟!
ثالثاً:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» معصوم عن الزلل، لا
يحتاج إلى استغفار أحد..
رابعاً:
لقد أجابه الخضر «عليه السلام» بأن الله فضل رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، وفضَّل أمته، ليقنعه بأنه لا يحتاج إلى
الإستغفار، ولا شك في أن هذا كان معلوماً لدى رسول الله «صلى الله عليه
وآله» كما كان معلوماً لدى الخضر «عليه السلام»، فلماذا لم يكتف به عن
هذا الطلب الذي تعقبه ذلك الرد؟!
خامساً:
لماذا بقي الخضر«عليه السلام» بعيداً عن النبي «صلى
الله عليه وآله»، ولم يقترب إليه، ولم يلتق به، بل اكتفى بلقاء أنس؟!..
أليس تذكر الروايات أنه كان يلتقي النبي «صلى الله عليه وآله» في أكثر
من مورد ومناسبة؟!
سادساً:
قال الصالحي
الشامي: «قال الشيخ في النكت البديعات: «أورده البيهقي من طريق عمرو بن
عوف المزني، وقال: فيه بشير بن جبلة عن أبيه، عن جده، نسخة موضوعة،
وعبد الله بن نافع متروك الخ..»([3]).
2 ـ
أما الرواية الثانية فيرد عليها مع ضعف سندها جميع ما
قدمناه آنفاً باستثناء الإيراد الثاني والثالث.
يضاف إلى ما تقدم:
أولاً:
ما معنى قوله: إنه «صلى الله عليه وآله» سمع منادياً
ينادي: «اللهم أعنّي على ما ينجيني الخ..»؟!
فهل كان الخضر «عليه السلام» يصرخ بدعائه، وينادي به؟!.
وإذا كان ينادي بدعائه، فلماذا سمعه النبي «صلى الله
عليه وآله» وحده، ولم يسمعه أنس، حتى اضطر «صلى الله عليه وآله» إلى
إسكات أنس ليستكمل سماع ذلك النداء؟!
وهل سمع هذا النداء أحد من المسلمين من أهل المدينة غير
أنس، وغير رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!..
وإذا كانوا قد سمعوا ذلك، هل خرجوا لرؤية ذلك المنادي؟
أم أن موقفهم كان هو الإهمال وعدم المبالاة أم غير ذلك؟!..
ثانياً:
ما معنى قول أنس: فكأن الرجل لقن ما أراد النبي «صلى
الله عليه وآله» ؟!
ولماذا لا تكون هذه الكلمات مما يعرف العالمون بها
ارتباطها ببعضها، فلا يفصلون بين فقراتها؟!
على أنه ليس في كلام النبي «صلى الله عليه وآله» ما
يشير لأنس، ولا لغيره أنه يقصد خصوص الفقرة التي قالها الخضر «عليه
السلام»، فلعله قصد بكلمة أختها فقرة أخرى غيرها.
إلا أن يقال:
إن هذا هو مقتضى المقابلة مع ما خوّف به في الفقرة
الأولى، تقابل ما يحوّف به مع ما يشوّق إليه ويرغّب فيه. على نسق قوله:
خوفاً وطمعاً.. فلاحظ.
ثالثاً:
ما نسبته الرواية إلى الخضر «عليه السلام» من أنه قال:
أنا كنت أحق أن آتيه ليس له مبرر، إذ لماذا ترك الخضر «عليه السلام»
العمل بهذا الأولى والأحق.. ولم يعتذر بشيء عن هذا الترك؟!
ولماذا لم يتلافَ هذا التقصير الذي أحس به حتى بعد أن
قال هذا القول؟! وقد كان بإمكانه أن يذهب إليه، ويتشرف بلقائه، ويتلافى
ما فرط منه.
رابعاً:
إن رواية أنس تريد أن تروي لنا نفس ما تضمنته رواية
عمرو بن عوف.. مع أن المقارنة بين الروايتين تعطي: أنهما متناقضتان في
كثير من فقراتهما..
فإن كان لهذه القضية أصل، فلا شك في أن الأيدي الأثيمة
قد نالت منها، وشوّهتها وأفسدتها، حتى بدت عليها معالم التزوير
والتحوير، حسبما أوضحناه..
قال أنس:
قال لي إلياس: من أنت؟
قلت:
أنا أنس بن مالك خادم رسول الله «صلى الله عليه وآله».
قال:
فأين هو؟
قلت:
هو يسمع كلامك.
قال:
«فأته فأقرأه مني السلام، وقل له: أخوك إلياس يقرؤك
السلام».
قال:
فأتيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» فأخبرته: فجاء
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ودنا معه حتى إذا كنا قريباً منه تقدم
رسول الله «صلى الله عليه وآله» وتأخرت. فتحدثا طويلاً.
وفي لفظ آخر:
«حتى جاءه فعانقه، وسلم عليه، ثم قعدا يتحدثان.
فقال إلياس:
«يا رسول الله، إني إنما آكل في السنة يوماً، وهذا يوم
فطري، فآكل أنا وأنت».
فنزل عليهم من السماء شبه السفرة.
قال ابن أبي الدنيا:
فيها كمأة، ورمان، وكرفس.
وقال الحاكم:
عليها خبز
وحوت وكرفس. فأكلا وأطعماني وصليا، ثم ودعه، وجاءت سحابة فاحتملته.
وكنت أنظر إلى بياض ثيابه تهوي به قبل الشام»([4]).
ونقول:
إن هذا الحديث لا يصح، وذلك للأمور التالية:
بالنسبة لسند هذا الحديث نكتفي هنا بما ذكره الصالحي
الشامي، فقد قال:
الحديث في سنده يزيد بن يزيد الموصلي التيمي [مولى لهم]. قال ابن
الجوزي والذهبي: إنه حديث باطل، واتهما به يزيد. قال الذهبي: أما استحى
الحاكم من الله تعالى أن يصحح مثل هذا الحديث؟!
وقال في تلخيص المستدرك:
هذا موضوع، قبح الله من وضعه، وما كنت أحسب أن الجهل
يبلغ بالحاكم أن يصحح مثل هذا، وهو مما افتراه يزيد الموصلي.
قلت:
كما أن البيهقي ذكره في الدلائل وقال: هذا الذي روي في
هذا الحديث في قدرة الله جائز، وما خص الله به رسوله من المعجزات
يثبته، إلا أن إسناد هذا الحديث ضعيف بما ذكرته ونبهت على حاله.
ورواه ابن شاهين، وابن عساكر بسند فيه مجهول عن واثلة
بن الأسقع أطول مما هنا، وفيه ألفاظ منكرة. وعلى كل حال لم يصح في هذا
الباب شيء.
قال الشيخ في النكت البديعات:
أخرجه الحاكم،
والبيهقي في الدلائل وقال: إنه ضعيف([5]).
وذكروا:
أن وفد الجن
جاء إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» في سنة إحدى عشرة من النبوة([6])،
فعن الزبير بن العوام قال: صلى بنا رسول الله «صلى الله عليه وآله»
صلاة الصبح في مسجد المدينة، فلما انصرف قال: «أيكم يتبعني إلى وفد
الجن الليلة»؟
فخرجت معه حتى خنست عنا جبال المدينة كلها، وأفضينا إلى
أرض، فإذا رجال طوال كأنهم الرماح، مستثفرين ثيابهم من بين أرجلهم.
فلما رأيتهم غشيتني رعدة شديد ة حتى ما تحملني رجلاي من الفرق.
فلما دنونا منهم خطّ لي رسول الله «صلى الله عليه وآله»
بإبهام رجله خطا، فقال: «اقعد في وسطه»، فلما جلست ذهب عني كل شيء كنت
أجده من ريبة، ومضى رسول الله «صلى الله عليه وآله» بيني وبينهم، فتلا
قرآناً، وبقوا حتى طلع الفجر، ثم أقبل. فقال: «الحقني».
فمشيت معه فمضينا غير بعيد، فقال
لي:
«التفت وانظر هل ترى حيث كان أولئك من أحد»؟
فخفض رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى الأرض
(فتناول) عظماً وروثة، ثم رمي بهما وقال: «إنهم سألوا الزاد، فقلت لهم:
لكم كل عظم وروثة»([7]).
عن علقمة قال:
قلت لابن مسعود: هل صحب النبي «صلى الله عليه وآله» من
أحد ليلة الجن؟
قلت:
ما صحبه منا أحد، ولكن فقدناه ذات ليلة فالتمسناه في
الأودية وفي الشعاب، فقلنا: اغتيل؟ استطير؟ ما فعل؟ فبتنا بشر ليلة بات
بها قوم.
فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء.
فقلنا:
يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم.
فقال:
«إنه أتاني داعي الجن، فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن».
قال:
فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم.
وسألوه الزاد فقال:
«لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما
كان لحماً، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم»
قال:
«فلا تستنجوا بهما، فإنهما زاد إخوانكم من الجن».
وقال الشعبي:
وكانوا من جن
الجزيرة([8]).
عن ابن مسعود قال:
سمعت رسول
الله «صلى الله عليه وآله» يقول: «بت الليلة أقرأ على الجن واقفاً
بالحجون»([9]).
وقوله:
إنه لم يكن مع النبي «صلى الله عليه وآله» أصح مما رواه
ابن جرير على الزهري قال: أخبرنا أبو عثمان بن سنة ـ بفتح المهملة
وتشديد النون ـ الخزاعي أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: إن رسول الله
«صلى الله عليه وآله» قال لأصحابه وهو بمكة: «من أحب منكم أن يحضر
الليلة أثر الجن فليفعل». فلم يحضر معهم أحد غيري.
قال:
فانطلقنا فإذا
كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطاً ثم أمرني أن أجلس فيه، ثم انطلق حتى
إذا قام فافتتح القرآن [فجعلت أرى أمثال النسور تهوي وتمشي في رفرفها،
وسمعت لغطاً وغمغمة، حتى خفت على النبي «صلى الله عليه وآله»، وغشيته
أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته، ثم طفقوا يتقطعون مثل
قطع السحاب ذاهبين([10]).
وقال أبو نعيم:
كان إسلام الجن ووفادتهم على النبي «صلى الله عليه
وآله» كوفادة الإنس فوجاً بعد فوج، وقبيلة بعد قبيلة، بمكة، وبعد
الهجرة.
عن ابن مسعود قال:
إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجلاً، وتركت، فأخذ بيدي
رسول الله «صلى الله عليه وآله» ومضى إلى حجرة أم سلمة، ثم انطلق بي
حتى أتينا بقيع الغرقد، فخط بعصاه خطاً ثم قال: «اجلس فيها ولا تبرح
حتى آتيك».
ثم انطلق يمشي، وأنا أنظر إليه من خلال الشجر، حتى إذا
كان من حيث أراه ثارت مثل العجاجة السوداء، فقلت: ألحق برسول الله «صلى
الله عليه وآله» فإني أظن هذه هوازن مكروا برسول الله «صلى الله عليه
وآله»، ليقتلوه، فأسعى إلى البيوت فأستغيث بالناس، فذكرت أن رسول الله
«صلى الله عليه وآله» أمرني ألا أبرح مكاني الذي أنا فيه.
فسمعت رسول الله «صلى الله عليه
وآله» يقرعهم بعصاه ويقول:
«اجلسوا». فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح، ثم ثاروا
وذهبوا.
فأتى رسول الله «صلى الله عليه
وآله» فقال:
«أولئك وفد
الجن، سألوني المتاع والزاد، فمتعتهم بكل عظم حائل، وروثة وبعرة، فلا
يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أكل، ولا روثة إلا
وجدوا عليها حبها الذي كان يوم أكلت»([11]).
ونقول:
إننا لا نستطيع أن نؤيد صحة النصوص المتقدمة، لأسباب
كثيرة مثل:
1 ـ
إن أسانيدها تحتاج إلى بحث وتدقيق، لا سيما وأنها لم
تُرو عن المعصومين «عليهم السلام»، كما أن في أسانيدها من لا مجال
للإطمئنان إلى صدقه، أو إلى ضبطه.
2 ـ
إن رواية علقمة عن ابن مسعود صريحة في نفي حضور أحد من
الصحابة مع النبي «صلى الله عليه وآله» ليلة الجن في مكة، فهي تنفي صحة
رواية ابن مسعود الأخرى التي تقول: إنه حضرها مع النبي «صلى الله عليه
وآله» في مكة، بل هي تنفي صحة رواية حضور الزبير أيضاً، حتى لو صرحت
روايته بأن ذلك كان في المدينة، وتنفي صحة رواية حضور ابن مسعود لوفدهم
في المدينة أيضاً، وذلك لسبب بسيط، وهو أن العناصر التي اشتملت عليها
الروايات كلها متشابهة بدرجة كبيرة، كما يظهر بالمراجعة والمقارنة،
وذلك يدل على أن الرواة يتصرفون في نص واحد تارة ينسبونه لهذا، وأخرى
ينسبونه لذاك، وتارة يجعلونه في هذا البلد، وأخرى في ذاك.
فراجع وقارن لتقف على مدى تأثير الأهواء في صياغة
النصوص، وفي محاولات تحريفها.
أما الآيات القرآنية فقد صرحت بما يشير إلى مجيء نفر من
الجن إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» لاستماع القرآن، قال تعالى:
{وَإِذْ
صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآَنَ
فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى
قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ}([12]).
ولم تصرح الآيات بأنهم قد كلموا رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
أو
أظهروا له أنفسهم، وإن كان النبي «صلى الله عليه وآله» قد علم بهم،
بوحي من الله تعالى، قال تعالى:
{قُلْ أُوحِيَ
إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا
سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً، يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ
وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً}([13]).
وهذا المقدار لا يبرر اعتبار ذلك
وفادة منهم على رسول الله «صلى الله عليه وآله».. إلا إذا استندنا في
ذلك إلى الروايات، لكن المروي منها في مصادر غير الشيعة لا مجال للوثوق
به أيضاً. لكثرة وجوه الإختلاف فيه([14])
مع سقوط أسانيده عن الإعتبار: ولكثرة ما يرد عليه من مآخذ كما يُعلم
بالمراجعة.
وعن الروايات حول وفادات الجن، الواردة في كتب الشيعة
نقول:
ذكر القمي:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» خرج من مكة إلى سوق عكاظ
يدعو الناس، فلم يجبه أحد، ثم رجع إلى مكة، فلما بلغ وادي مجنة تهجد
بالقرآن في جوف الليل، فمر به نفر من الجن فسمعوا قراءته، فولّوا إلى
قومهم منذرين، فجاؤوا إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» وأسلموا،
وآمنوا. وعلمهم شرائع الإسلام (ونزلت سورة الجن بهذه المناسبة).
وكانوا يعودون إلى رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، في كل وقت، فأمر «صلى الله عليه وآله» علياً أمير
المؤمنين «عليه السلام» أن يعلمهم ويفقههم([15]).
وذكر نص آخر عن الإمام الكاظم «عليه
السلام»:
أن تسعة من جن
نصيبين واليمن استمعوا القرآن. فأقبل إليه من الجن أحد وسبعون ألفاً،
فاعتذروا له وبايعوه([16]).
وتجد في كثير من كتب الحديث المروي عن أهل البيت «عليهم
السلام» وكذلك في الكتاب الشريف بحار الأنوار([17])
للعلامة المجلسي (رفع الله مقامه) ـ تجد ـ أحاديث كثيرة تتعرض لوفادات
كثيرة لأفراد ولجماعات من الجن على رسول الله، وملاقاتهم له «صلى الله
عليه وآله».. وهي مروية عن أهل البيت «عليهم السلام» وشيعتهم، وهي أكثر
سداداً من الروايات الأخرى.. فياحبذا لو أن كتَّاب السيرة استفادوا من
تلك الروايات في تدوينهم للسيرة النبوية الشريفة، فإن أهل البيت أدرى
بما فيه، وهم المأمونون على هذا الدين وعلى سيرة سيد المرسلين..
النبي
 مبعوث
للإنس والجن: مبعوث
للإنس والجن:
قال المجلسي «رحمه الله»:
«لا خلاف في
أن الجن والشياطين مكلفون، وأن كفارهم في النارهم معذبون»([18]).
وفي تفسير القمي:
سئل العالم «عليه السلام» عن مؤمني الجن يدخلون الجنة؟!
فقال:
لا، ولكن لله
حظائر بين الجنة والنار، يكون فيها مؤمنو الجن، وفساق الشيعة([19]).
وقال العلامة المجلسي «رحمه الله»:
«ولا خلاف في
أن نبينا «صلى الله عليه وآله» مبعوث إليهم، وأما سائر أولي العزم، فلم
يتحقق عندي بعثهم عليهم نفياً أو إثباتاً، وإن كان بعض الأخبار يشعر
بكونهم مبعوثين عليهم»([20]).
ذكرت الروايات المتقدمة:
أن ابن مسعود
كان من أهل الصفة، وورد التصريح بذلك في مصادر أخرى([21]).
غير أننا نقول:
إن علينا أن نأخذ بنظر الإعتبار الأمور التالية:
1 ـ
إن الرواية
تفيد: أن قضية ابن مسعود أنه كان من أهل الصفة حتى بعد زواج النبي «صلى
الله عليه وآله» بأم سلمة، ومن المعلوم: أن زواجها به «صلى الله عليه
وآله» قد كان في السنة الرابعة من الهجرة([22])
والذين قالوا أن زواجه منها كان في السنة الثانية مخطئون قطعا لأن
زوجها أبو سلمة بن عبد أسد قد جرح في معركة أُحد ومات من جراحاته([23])
ثم تزوجها رسول الله «صلى الله عليه وآله» بعد انقضاء عدتها منه.
2 ـ
إن النبي «صلى
الله عليه وآله» لما قدم المدينة أقطع الدور، لأصحابه وأقطع ابن مسعود
في من أقطع([24]).
وقال ياقوت:
«لما قدم «صلى
الله عليه وآله» مهاجراً إلى المدينة أقطع الناس الدور والرباع، فخط
لبني زهرة في ناحية من مؤخر المسجد، وكان لعبد الرحمن بن عوف الحش
المعروف به. وجعل لعبد الله وعقبة ابني مسعود الهذليين الخطة المشهورة
بهم عند المسجد»([25]).
وقد حدد المؤرخون موضع دار ابن مسعود، وأنها مقابل أول
باب للمسجد من أبواب الشام مما يلي المشرق.
وجعلوا في موضع دار ابن مسعود الدار المعروفة بدار
المضيف. وهي إلى جنب دار أبي الغيث ابن المغيرة، التي جعلوا في موضعها
الرباط المعروف برباط الظاهرية والشرشورة([26]).
3 ـ
الصفة: مكان
في مؤخرة المسجد النبوي مظلل، أعد لنزول الغرباء فيه، ممن لا مأوى لهم
ولا أهل، وأهل الصفة هم أناس فقراء لا منازل لهم، فكانوا ينامون في
المسجد لا مأوى لهم غيره([27]).
وفي بعض النصوص:
لا يأوون على
أهل ولا مال، ولا على أحد([28]).
فهل بقي ابن مسعود بلا بيت، وبلا دار، وبلا مال طيلة
هذه السنوات؟!
وإذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» قد أقطعه داراً في
أول الهجرة، فلماذا لم يستفد منها في إيجاد محل يأوي إليه؟! في حين أن
بناء البيت لا يحتاج إلى بذل أموال، أو استئجار الرجال، بل كان يمكنه
هو أن يجمع بعض الحجارة ويبنيها، ثم يسترها بما يجده من سقف أو سواه،
ثم يأوي إليه..
على أن لنا سؤالاً آخر، وهو:
أين كانت عائلة ابن مسعود، وأخواته، وأمه و.. و.. طيلة
هذه المدة هل كانوا معه في الصفة أيضاً؟!
إن ذلك كله يشير إلى أن عدّه من أصحاب الصفة، وكذلك
غيره ممن يشبه حاله حال ابن مسعود يبقى غير مفهوم.
ورووا:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان على جبل من جبال
تهامة خارج مكة، إذ أقبل شيخ متوكئ على عصا ـ وفي لفظ: بيده عصا ـ فسلم
على رسول الله «صلى الله عليه وآله» فرد عليه السلام، وقال: «نغمة الجن
ومشيتهم» ـ وفي رواية: «جني ونغمته ـ من أنت»؟
قال:
أنا هامة بن الهيم بن لاقيس بن إبليس.
قال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«ليس بينك وبين إبليس إلا أبوان»؟!
قال:
نعم.
قال:
«فكم أتى عليك الدهر»؟
قال:
قد أفنت الدنيا عمرها إلا قليلاً. كنت ليالي قتل قابيل
هابيل غلاماً ابن أعوام، أفهم الكلام، وأمر على الآكام، وآمر بإفساد
الطعام، وقطيعة الأرحام، وأُأَرِّش بين الناس، [وأغري بينهم].
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«بئس لعمر الله عمل الشيخ المتوسم، والفتى المتلوم».
قال:
دعني من اللوم، فقد جرت توبتي على يدي نوح «عليه
السلام»، وكنت معه فيمن آمن به من قومه، فلم أزل أعاتبه على دعوته على
قومه حتى بكى عليهم وأبكاني.
وقال:
لا جرم، إني على ذلك من النادمين، وأعوذ بالله أن أكون
من الجاهلين.
وكنت مع هود «عليه السلام» في مسجده مع من آمن به من
قومه، فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى عليهم وأبكاني، فقال:
لا جرم، إني على ذلك من النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
(وذكرت
رواية القمي وغيره:
أنه عاتب صالحاً أيضاً على دعائه على قومه).
وكنت أزور يعقوب، وكنت مع يوسف بالمكان المكين.
وكنت ألقى إلياس في الأودية وأنا ألقاه الآن.
وكنت مع إبراهيم خليل الرحمن لما ألقي في النار، فكنت
بينه وبين المنجنيق، حتى أخرجه الله منه.
ولقيت موسى بن عمران فعلمني من
التوراة وقال لي:
إن أنت لقيت عيسى ابن مريم فأقرأه مني السلام.
وكنت مع عيسى فقال:
إن لقيت محمداً فأقرئه مني السلام.
وأنا يا رسول الله قد بلغت وآمنت بك.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«وعلى عيسى السلام» ـ وفي لفظ: ـ «وعليك يا هامة، ما
حاجتك»؟
فقال:
موسى علمني من التوراة، وعيسى علمني من الإنجيل، فعلمني
من القرآن.
فعلمه رسول الله «صلى الله عليه وآله» سورة المرسلات،
وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت، والمعوذتين، وقل هو الله أحد.
وفي لفظ عمر:
إذا وقعت الواقعة.
وفي رواية:
علمه عشر سور.
وقال له «صلى الله عليه وآله»:
«ارفع إلينا حاجتك يا هامة، ولا تدع زيارتنا».
وقال عمر بن الخطاب:
فقبض رسول
الله «صلى الله عليه وآله» ولم ينعه إلينا، ولسنا ندري أحي هو أو ميت([29]).
ونقول:
لقد ذكر البعض هذا الحديث في جملة الوفود على رسول الله
«صلى الله عليه وآله».
ولا يخالجنا شك في كونه من الأحاديث الموضوعة، فتابعناه
وذكرناه، لكي نؤكد للقارئ الكريم على هذه الحقيقة، مستدلين عليها بما
يلي:
أولاً:
لقد حكم غير
واحد على هذا الحديث بأنه مكذوب أو ضعيف، وقد أورده ابن الجوزي في
الموضوعات، فراجع([30]).
ثانياً:
إن هذه الرواية تتضمن الإساءة لأنبياء الله سبحانه
وتعالى، وتنسب إليهم الخطأ والندم عليه.
ثالثاً:
إنها تنسب الخطأ أو الجهل، أو الظلم إلى الله تبارك
وتعالى.. لأن إغراق قوم نوح وإهلاك قوم هود وصالح، إذا كان خطأً، فإما
أن يكون الله تعالى كان جاهلاً بهذا الخطأ، فنسبته ذلك إلى الله تبارك
وتعالى جريمة عظمى، ومعصية كبرى..
وإما أن يكون تعالى قد علم بالخطأ في حقهم، ثم فعله،
فذلك ظلم منه سبحانه لهم.. وهو ينافي ألوهيته، وتؤدي نسبته إلى العزة
الإلهية إلى الكفر بالله سبحانه، فإذا كان هود ونوح قد اعتقدا بأن
قومهما قد ظُلِمُوا بما جرى عليهم، فذلك يعني أنهما ينسبان إلى الله
تبارك وتعالى، إما الظلم أو الجهل.. وهذا يؤدي إلى نسبة الكفر لهذين
النبيين الكريمين العظيمين.
رابعاً:
إذا كان حفيد إبليس قد عرف خطأ نوح وهود في دعائهما على
قومهما، ولم يعرفا هما ذلك، فإنه يكون أحق بالنبوة منهما، وأولى
بالتقدم عليهما.
خامساً:
إن ظاهر كلام حفيد إبليس هو: أنه قد كرر عتابه لنوح
وهود، حتى فاز بما يريد، وأنهما «عليهما السلام» لم يقبلا منه إلا بعد
لأي.. فلماذا احتاج حفيد إبليس إلى تكرار العتاب لهما؟ هل لأن حجته لم
تكن كافية؟! أم أنهما رفضا الإعتراف بالخطأ على سبيل العناد واللجاج؟!
وهل يستحق اللَجوج العنيد مقام النبوة؟!
إن حفيد إبليس قد ادَّعى أنه كان مع هود في مسجده مع من
آمن من قومه([31])،
مع أن الآيات القرآنية تقول: إن قوم هود قد هلكوا عن بكرة أبيهم ولم
ينج منهم إلا هود وأهله، باستثناء امرأته فإنها هلكت مع من هلك.
فكيف يدعي حفيد إبليس أنه كان مع هود جماعة مؤمنون من
قومه؟!
وقد أضافت النصوص المروية في كتب
الشيعة:
أنه لما طلب من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يعلمه
شيئاً من القرآن قال «صلى الله عليه وآله» لعلي «عليه السلام» علِّمه،
فقال هام: يا محمد، إنا لا نطيع إلا نبياً أو وصي نبي، فمن هذا؟
قال:
هذا أخي، ووصيي، ووزيري، ووارثي علي بن أبي طالب.
قال:
نعم، نجد اسمه
في الكتب إليَّا، فعلمه أمير المؤمنين، فلما كانت ليلة الهرير بصفين
جاء إلى أمير المؤمنين «عليه السلام»([32]).
ونقول:
أولاً:
هناك زيادة طويلة ذكرها في رواية روضة الكافي، وفيها ما
يناقض هذا الذي ذكر آنفاً، حيث صرحت: بأن النبي «صلى الله عليه وآله»
سأل حفيد إبليس إن كان يعرف وصيه، فقال: إذا نظر إليه يعرفه بصفته
واسمه الذي قرأه في الكتب.
فقال له:
انظر، فنظر في الحاضرين، فلم يجده فيهم.
وبعد حديث طويل سأله فيه النبي «صلى الله عليه وآله» عن
أوصياء الأنبياء «عليهم السلام»، وأجابه، ووصف له علياً «عليه السلام»،
ثم جاء علي «عليه السلام» فعرفه بمجرد أن وقع نظره عليه.
ثم تذكر الرواية:
أن الهام بن
الهيم بن لاقيس قتل بصفين([33]).
ثانياً:
إن نفس اعتراض هذا الجني على رسول الله «صلى الله عليه
وآله» حين طلب من علي «عليه السلام» أن يعلمه شيئاً من القرآن يدل على
خلل أساسي في إيمانه، لأن الإيمان برسول الله «صلى الله عليه وآله»
معناه الطاعة له، والإستسلام لأوامره ونواهيه، ومن يرفض ذلك لا يكون
كذلك.
ثالثاً:
ما الذي جعل لهذا الجني الحق في أن لا يطيع ما عدا
الأنبياء وأوصياءهم، حتى حين يأمرهم الأنبياء والأوصياء بذلك؟ وما الذي
يميزه عن غيره من بني جنسه في ذلك؟!
1 ـ
عن أبي هريرة قال: جاء ذئب إلى رسول الله «صلى الله
عليه وآله» فأقعى بين يديه، وجعل يبصبص بذنبه، فقال رسول الله «صلى
الله عليه وآله»: «هذا وافد الذئاب، جاء يسألكم أن تجعلوا له من
أموالكم شيئاً».
فقالوا:
لا والله يا رسول الله، لا نجعل له من أموالنا شيئاً.
فقام إليه رجل من الناس، ورماه بحجر، فسار وله عواء([34]).
2 ـ
وعن حمزة بن أبي أسيد قال: خرج رسول الله «صلى الله
عليه وآله» في جنازة رجل، فإذا ذئب متفرشاً ذراعيه على الطريق، فقال
رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «هذا معترض فافرضوا له».
قالوا:
ما ترى يا ر سول الله.
قال:
«من كل سائمة شاة في كل عام».
قالوا:
كثير، فأشار
إلى الذئب أن خالسهم، فانطلق الذئب([35]).
3 ـ
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: بينا رسول الله
«صلى الله عليه وآله» جالس بالمدينة في أصحابه، إذ أقبل ذئب فوقف بين
يدي رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فعوى [بين يديه]، فقال رسول الله
«صلى الله عليه وآله»: «هذا وافد السباع إليكم، فإن أحببتم أن تفرضوا
له شيئاً لا يعدوه إلى غيره، وان أحببتم تركتموه وتحررتم منه، فما أخذ
فهو رزقه».
فقالوا:
يا رسول الله، ما تطيب أنفسنا له بشيء.
فأومأ إليه النبي «صلى الله عليه
وآله» بأصابعه:
أن خالسهم،
فولى وله عسلان([36]).
4 ـ
عن رجل من مزينة أو جهينة قال: صلى رسول الله «صلى الله
عليه وآله» الفجر، فإذا هو بقريب من مائة ذئب قد أقعين. [وكانوا] وفود
الذئاب.
فقال لهم رسول الله «صلى الله عليه وآله»:
«هؤلاء وفود الذئاب، سألتكم أن ترضخوا لهم شيئاً من
فضول طعامكم، وتأمنوا على ما سوى ذلك».
فشكوا إليه حاجة.
قال:
«فادنوهن».
فخرجن ولهم عواء([37]).
5 ـ
عن سليمان بن
يسار مرسلاً قال: أشرف النبي «صلى الله عليه وآله» على الحرَّة، فإذا
ذئب واقف بين يديه، فقال: «هذا يسأل من كل سائمة شاة». فأبوا، فأومأ
إليه بأصابعه، فولى([38]).
قد يقول قائل:
إن افتراس الذئاب للغنم ولغيرها لم يبدأ في زمن النبي
«صلى الله عليه وآله»، ويكفي أن نذكر ما تعلل به أخوة يوسف «عليه
السلام» لإخفاء مكرهم بأخيهم يوسف حيث ادَّعوا أن الذئب قد أكله،
وجاؤوا على قميصه بدم كذب..
كما أن الذئاب كانت تفترس ما تقدر عليه طيلة سنوات
كثيرة بعد بعثة رسول الله «صلى الله عليه وآله» قبل وفادة الذئاب عليه،
فما معنى أن تأتي أخيراً هذه الذئاب إليه «صلى الله عليه وآله» لتتقدم
بهذا الطلب حتى تخرج بتلك النتيجة التي ذكرتها الروايات السابقة؟!
والجواب:
أن كل ذلك صحيح، ولكنه لا يمنع من أن يكون الله سبحانه
أراد أن يظهر الكرامة لنبيه «صلى الله عليه وآله» بتكليم السباع له،
وظهور معرفته بلغة الحيوانات، وطاعتها له، وتعريف الناس بأن لنبينا
«صلى الله عليه وآله» ميزة على كل أنبياء الله «عليهم السلام» الذين
سبقوه، تمثلت في عرض تقدمه هذه الذئاب بالتخلي حتى عن طباعها المتأصلة
فيها على مدى آلاف السنين، والرضا بما يفرضه الناس لها من نصيب في
مواشيهم والتعهد بعدم التعرض لسواه، وذلك إكراماً لرسول الله «صلى الله
عليه وآله»، وتمييزاً له عن جميع البشر..
أما هذا الإختلاف الذي يظهر في الروايات المتقدمة..
فيمكن معالجته، بأن من الجائز أن يكون الحدث قد تكرر في المواضع
والأزمنة، والحالات المختلفة، وقد حضر في كل مرة أناس غير الذين حضروا
في المرات الأخرى، وبذلك نفسر أيضاً الإختلاف في عدد الذئاب التي حضرت،
وغير ذلك من أمور وتفاصيل.
([1])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص436 عن ابن عدي، والبيهقي، وقال في
هامشه: ذكره السيوطي في اللآلئ ج1 ص164 ووضعه والإصابة لابن
حجر ج2 ص258.
([2])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص436 عن الدارقطني في الإفراد، والطبراني
في الأوسط، وابن عساكر، وذكره السيوطي في اللآلئ ج1 ص85 وابن
الجوزي في الموضوعات ج1 ص194 والإصابة لابن حجر ج2 ص259.
([3])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص437.
([4])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج6 ص435 عن الحاكم، وابن أبي الدنيا
وراجع لسان الميزان ج6 ص295 وميزان الإعتدال ج4 ص441 و295 وفتح
القدير للشوكاني ج4 ص412 و فتح القدير للشوكاني ج4 ص412.
([5])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص435.
([6])
الدر المنثور ج6 ص45 عن أبي نعيم في دلائل النبوة، والواقدي
وعمدة القاري ج6 ص37 وج16 ص309 والدر المنثور للسيوطي ج6 ص45
وتفسير الآلوسي ج26 ص32 وج29 ص83 وسبل الهدى والرشاد ج2 ص443.
([7])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص434 عن أبي نعيم، وقال في هامشه: ذكره
الهيثمي = = في المجمع ج1
ص215، وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، والبحار ج60
ص294 والسيرة الحلبية ج2 ص60 وراجع: السيرة الحلبية ج2 ص64.
([8])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص434 عن أحمد، والترمذي، ومسلم، والدر
المنثور ج6 ص44 عنهم وعن عبد بن حميد، والبحار ج60 ص294 وراجع:
صحيح مسلم ج2 ص36 وسنن الترمذي ج5 ص59 وسنن الكبرى للبيهقي ج1
ص109 وضعيف سنن الترمذي للألباني ص415 وتفسير البغوي ج 4 ص174
وأحكام القرآن لابن العربي ج4 ص316 وتفسير القرطبي ج1 ص315
وج19 ص4 و6 وتفسير إبن كثير ج4 ص176 وأضواء البيان للشنقيطي ج4
ص121.
([9])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص434 عن ابن جرير، وقال في هامشه: أخرجه
الطبري في التفسير ج26 ص21، وأحمد في المسند ج1 ص416، وذكره
ابن كثير في التفسير ج7 ص275 وفي (ط دار المعرفة ـ بيروت) ج4
ص177 وراجع: مسند أحمد ج1 ص416 ومسند أبي يعلى ج8 ص474 وصحيح
ابن حبان ج14 ص224 و225 وموارد الظمآن للهيثمي ج5 ص448 وكنز
العمال ج6 ص144 وجامع البيان للطبري ج26 ص43 وتفسير ابن كثير
ج4 ص177 والدر المنثور للسيوطي ج6 ص44.
([10])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص435 عن ابن جرير، وقال في هامشه عن:
المستدرك للحاكم ج2 ص503 وعن دلائل النبوة (129). وراجع:
البحار ج60 ص295= = وراجع: مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب
ج1ص44 والدرر لابن عبد البر ص59 وجامع البيان للطبري ج26 ص43
وتفسير البغوي ج4 ص173 وتفسير القرطبي ج16 ص212 ووتفسير ابن
كثير ج4 ص177 وتهذيب الكمال ج34 ص68.
([11])
سبل الهدى والرشاد ج2 ص445 وج6 ص433 عن أبي نعيم، وفي هامشه
عن: نصب الراية ج1 ص145 وعن تفسير ابن كثير ج7 ص282 وفي (ط
دارالمعرفة ـ بيروت) ج4 ص182 وراجع: صحيح البخاري ج4 ص241 وفتح
الباري ج7 ص132 ومسند الشاميين للطبراني ج4ص115 وجامع البيان
للطبري ج26 ص42 وتفسير الثعلبي ج9 ص21 وتفسير البغوي ج4 ص174
وتفسير القرطبي ج13 ص183 وج16 ص212 والسيرة الحلبية ج2 ص64.
([12])
الآية 29 من سورة الأحقاف.
([13])
الآيتان 1 و2 من سورة الجن.
([14])
راجع: الدر المنثور ج6 ص44 و 45 وراجع المصادر التي سلفت.
([15])
البرهان (تفسير) ج4 ص 177 و 178 والبحار ج18 ص90 وج60 ص81
وتفسير القمي ج2 ص300 والتفسير الصافي للكاشاني ج5 ص18 وج6
ص461 وتفسير نور الثقلين ج5 ص435 وتفسير الميزان ج18 ص220.
([16])
البحار ج60 ص97 و 98 عن الإحتجاج وراجع: ج 10 ص44 وج 16 ص415
وج17 ص292.
([17])
راجع: البحار ج 60 ص42 ـ 130.
([19])
البحار ج8 ص335 وج60 ص82 و291 ومستدرك سفينة البحار ج8 ص203
وتفسير نور الثقلين ج5 ص19 و 437 وتفسير الميزان ج18 ص220 وج20
ص48 والتفسير الصافي ج5 ص18 وج6 ص461 وتفسير القمي ج2 ص300
والتفسير الأصفى ج2 ص1170.
([21])
راجع: سبل الهدى والرشاد ج6 ص433 وتفسير السمعاني ج2 ص107 ونصب
الراية ج1 ص215 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج1 ص64.
([22])
السيرة الحلبية ج3 ص369 وعمدة القاري ج3 ص216 وفتح الباري ج1
ص324.
([23])
تهذيب التهذيب ج12 ص405 وسير أعلام النبلاء ج1 ص150 والإكمال
في أسماء الرجال للخطيب التبريزي ص103 والطبقات الكبرى لابن
سعد ج8 ص217 وغيرها.
([24])
المعجم الكبير ج10 ص374 والمبسوط ج3 ص274 وجواهر الكلام ج38
ص55 والأم للشافعي ج4 ص50 وعن الطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ق1
ص107 وراجع ص108 وراجع: معجم البلدان ج5 ص86 ومسالك الأفهام،
كتاب إحياء الموات ووفاء الوفاء ج2 ص718 وبيل الأوطار للشوكاني
ج6 ص59 ومكاتيب الرسول للاحمدي ج1 ص355 ومجمع الزوائد ج4 ص197
والمعجم الأوسط للطبراني ج5 ص163 وامعجم الكبير للطبراني ج10
ص222.
([25])
وفاء الوفاء ج2 ص718 ومعجم البلدان ج5 ص86.
([26])
راجع: وفاء الوفاء ج2 ص695 و 728 وكانت تدعى دار القراء وخلاصة
الوفا باخبار دار المصطفى ج1 ص170 و220.
([27])
وفاء الوفاء ج2 ص 453 و 454 وميزان الحكمة للريشهري ج4 ص3226
وفتح الباري ج11 ص244 وعمدة القاري ج4 ص198 ومسند ابن راهويه
ج1 ص28 والطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص255.
([28])
وفاء الوفاء ج2 ص455 و مناقب الإمام أمير المؤمنين «عليه
السلام» محمد بن سليمان الكوفي ج1 ص73 وسنن الترمذي ج4 ص61 و62
وفتح الباري ج11 ص243 وتحفة الأحوذي للمباركفوري ج7 ص150 ورياض
الصالحين للنووي ص276 وتاريخ مدينة دمشق ج67 ص319 و320.
([29])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص438 و 439 عن ابن الجوزي في الموضوعات
واللآلي المصنوعة، والنكت البديعات، وعن عبد الله بن أحمد في
زوائد الزهد، والعقيلي في الضعفاء، وابن مردويه في التفسير،
وأبي نعيم في حلية الأولياء والدلائل، والبيهقي في الدلائل،
والمستغفري في الصحابة، وإسحاق بن إبراهيم المنجنيقي، والفاكهي
في كتاب مكة، والبحار ج60 ص303 و 83 ـ 84 وج38 ص54 ـ 57 وج27
ص14 ـ 17 وج18 ص84 عن أسد الغابة وعن تفسير القمي وبصائر
الدرجات ص27.
([30])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص439.
([31])
البحار ج27 ص16 وبصائر الدرجات ص118 ومدينة المعاجز ج1 ص128
وجامع احاديث الشيعة للبروجردي ج14 ص330 وكنز العمال ج6 ص165=
= وضعفاء العقيلي ج1 ص99 وطبقات المحدثين بأصبهان لابن حبان ج3
ص 267 والموضوعات لابن الجوزي ج1 ص207 وميزان الإعتدال ج1 ص187
ولسان الميزان ج1 ص356 والبداية والنهاية لابن كثير ج5 ص113
والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص186.
([32])
تفسير القمي ج1 ص376 وتفسير الصافي للكاشاني ج3 ص107 والبحار
ج60 ص84 وج27 ص14 و 16 وج18 ص84 عن تفسير القمي وتفسير نور
الثقلين ج3 ص8.
([33])
البحار ج38 ص54 ـ 57 وج27 ص15 ـ 17 وأشار في هامشه إلى الروضة
ص41 و 42 وبصائر الدرجات ص27 و الروضة في فضائل أمير المؤمنين
لابن جبرئيل القمي ص223.
([34])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص440 عن سعيد بن منصور، والبزار، وأبي
يعلى، والبيهقي، وقال في هامشه: انظر البداية والنهاية ج6
ص166.
([35])
البداية والنهاية لابن كثير ج6 ص161 وسبل الهدى والرشاد ج6
ص440 عن أبي نعيم، والبيهقي.
([36])
البداية والنهاية ج6 ص166 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص440 عن ابن
سعد، وأبي نعيم، وقال في هامشه: أخرجه ابن سعد في الطبقات 1ج
ق2 ص86، وأبو نعيم في الدلائل (133)، وانظر البداية والنهاية
ج5 ص95. والعسلان: هو السرعة وراجع: أسد الغابة ج2 ص172 وإمتاع
الأسماع للمقريزي ج5 ص235.
([37])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص440 عن الدارمي، وابن منيع في مسنده،
أبي نعيم.
([38])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص440 عن الواقدي، وأبي نعيم.
|