|
أشخاص عُلم تاريخ وفادتهم
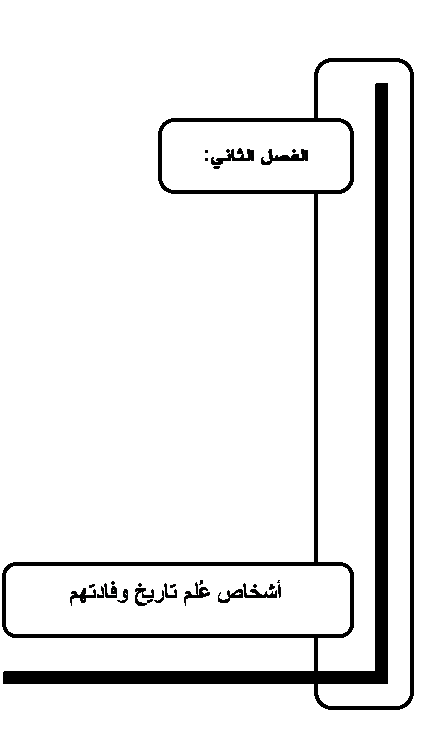
عن ذابل بن الطفيل بن عمرو الدوسي:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قعد في مسجده منصرفه من الأباطح، فقدم
عليه خفاف بن نضلة بن عمرو بن بهدلة الثقفي، فأنشد رسول الله «صلى الله
عليه وآله»:
كم قد تحطمت القلوص في الدجى في مـهـمـه
قـفـر مـن الـفـلـوات
فـل من التـوريـس ليس بقـاعـه نـبـت من الأسـنـات
والأزمــات
إنـي أتـانـي في المـنـام مســاعـد مـن جـن وجـرة كـان
لي ومـوات
يـــدعــــو إلـيـــك لـيــالـيـا ثـم احـزألَّ، وقــال
لـست بــآت
فـركـبــت نـاجــيـة أضر بنـيها جـمـز تجـب بـه عـلى الأكـــمات
حتى وردت إلى المـديـنـة جاهداً كـيـما أراك مـفـرج الـكــربــات
قال:
فاستحسنه رسول الله «صلى الله عليه وآله» وقال: «إن من
البيان كالسحر، وإن من الشعر كالحِكَم»([1]).
ونقول:
قد تضمنت هذه الأبيات أمورا:
أهمها: أنه يرى أن النبي «صلى الله عليه وآله» مفرج
الكربات في الأزمات، وقد تحدثنا عن ذلك فيما سبق، فلا نعيد.
عن محجن بن وهب قال:
قدم أبو ثعلبة الخشني على رسول
الله «صلى الله عليه وآله» وهو يتجهز إلى خيبر، فأسلم وخرج معه فشهد
خيبر، ثم قدم بعد ذلك سبعة نفر من خشين، فنزلوا على أبي ثعلبة، فأسلموا
وبايعوا ورجعوا إلى قومهم([2]).
هناك وفاداتان لأناس من ثقيف،
إحداهما:
وفادة شخصية، بمعنى: أن الوافدين لم يكونوا مبعوثين من
قبل قومهم، ولا يتكلمون باسمهم، بل هم يعلنون البراءة منهم، والعداء
لهم، ويقطعون صلتهم بهم.
وهي وفادة رجلين قدما على رسول الله «صلى الله عليه
وآله» قبل إسلام ثقيف، بل ربما قبل فتح مكة أيضاً، كما قد يستفاد من
تشدد ذينك الرجلين في قطع صلتهما بقومهما، وإظهار براءتهما منهم، فقد
قالوا:
كان أبو المليح بن عروة، وقارب بن الأسود قدما على رسول
الله «صلى الله عليه وآله» قبل وفد ثقيف، حين قتل عروة بن مسعود يريدان
فراق ثقيف، وألا يجامعاهم على شيء أبداً، فأسلما، فقال لهما رسول الله
«صلى الله عليه وآله»: «توليا من شئتما».
فقالا:
نتولى الله ورسوله([3]).
أي أنهما قد وطّنا النفس على قطع أية علاقة مع معسكر
الكفر والشرك، حتى لو لزم من ذلك البراءة من الأهل والعشيرة.. ولأجل
ذلك أفسح «صلى الله عليه وآله» لهما المجال ليتوليا من شاءا، وتكون
بينهما وبينه علاقة الولاء ـ أعني ولاء ضمان الجريرة، ليمكن التوارث
بينهما، فاختارا ولاء الله ورسوله..
وإنما يصح ولاء ضمان الجريرة فيما إذا لم يكن للمضمون
وارث.
روي عن الزهري وثابت، وشريك بن عبد الله كلاهما عن أنس،
وابن عباس ما ملخصه ومضمونه:
أن أنس في رواية ثابت قال:
«نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله «صلى الله عليه
وآله» عن شيء. كان يعجبنا أن نجد الرجل من أهل البادية العاقل، فيسأله
ونحن نسمع».
وفي حديث أبي هريرة:
«بينا النبي «صلى الله عليه وآله» مع أصحابه متكئاً، أو
قال جالسا في المسجد، إذ جاء رجل على جمل، فأناخه في المسجد، ثم عقله».
وفي حديث ابن عباس قال:
«بعث بنو سعد بن بكر، ضمام بن ثعلبة وافداً إلى رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد، ثم
دخل المسجد ورسول الله «صلى الله عليه وآله» جالس في أصحابه، وكان ضمام
رجلاً جلداً، أشعر ذا غديرتين، فأقبل حتى انتهى إلى رسول الله «صلى
الله عليه وآله»..».
قال أنس في رواية شريك:
«فقال: أيكم محمد»؟ أو «أيكم ابن عبد المطلب؟ والنبي
«صلى الله عليه وآله» متكئ بين ظهرانيهم.
فقلنا له:
هذا الأبيض المتكئ».
أو قالوا:
هذا الأمغر المرتفق.
قال:
فدنا منه، وقال: إني سائلك فمشدد عليك، أو فمغلظ عليك
في المسألة، فلا تجد عليّ في نفسك.
قال:
«لا أجد في نفسي، فسل عما بدا لك».
قال أنس في رواية ثابت:
فقال: يا محمد، أتانا رسولك فقال لنا: إنك تزعم أن الله
تعالى أرسلك؟
قال:
«صدق».
قال:
فمن خلق السماء؟
قال:
«الله».
قال:
فمن خلق الأرض؟
قال:
«الله».
قال:
فمن نصب هذه الجبال، وجعل فيها ما جعل؟
قال:
«الله».
فقال:
«فأنشدك الله إلهك وإله من قبلك، وإله من هو كائن
بعدك».
أو قال:
«فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال»، «آلله
أمرك أن نعبده وحده، ولا نشرك به شيئاً، وأن ندع هذه الأنداد التي كان
آباؤنا يعبدون؟
قال:
«اللهم نعم».
قال:
«وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا».
قال:
«صدق».
قال:
فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن
بعدك، آلله أمرك أن تصلي هذه الصلوات الخمس؟
قال:
«اللهم نعم».
قال:
«وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا».
قال:
«صدق».
قال:
أنشدك بالله، آلله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا
فترده على فقرائنا؟
فقال:
«اللهم نعم».
قال:
«وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا».
قال:
«صدق».
قال:
«وأنشدك الله، آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«اللهم نعم».
قال:
«وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً».
قال:
«نعم».
وفي حديث ابن عباس:
«ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، فريضة الزكاة
والصيام، والحج، وشرائع الإسلام كلها، ينشده عن كل فريضة منها كما
ينشده عن التي قبلها، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله،
وأشهد أن محمداً رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض، وأجتنب ما تنهينِّي
عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص».
وفي رواية شريك:
«آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا
ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر».
وفي حديث أبي هريرة:
«وأما هذه الهناة، فوالله إن كنا لنتنزه عنها في
الجاهلية».
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«إن صدق ليدخلن الجنة».
وفي حديث أبي هريرة:
«فلما أن ولى قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «فقه
الرجل».
وقال:
«فكان عمر بن الخطاب يقول: «ما رأيت أحداً أحسن مسألة،
ولا أوجز من ضمام بن ثعلبة».
فأتى بعيره فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه
فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به: بئست اللات والعزى.
فقالوا:
مه يا ضمام! اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون.
قال:
«ويلكم»! إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله قد
بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً، فاستنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وقد جئتكم
من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه».
قال:
«فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره رجل أو امرأة
إلا مسلماً».
زاد ابن سعد:
«وبنوا المساجد، وأذنوا بالصلوات».
قال ابن عباس:
فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة([4]).
قال أبو الربيع:
اختلف في الوقت الذي وفد فيه ضمام هذا على رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، فقيل: سنة خمس، ذكره الواقدي وغيره، وقيل: سنة
تسع، (قال الزرقاني: في سنة تسع على الصواب، وبه جزم ابن إسحاق، وأبو
عبيدة وغيرهما، خلافاً لما زعم الواقدي أنه سنة خمس كما أفاده الحافظ)([5]).
وبه جزم ابن حبيب أيضاً.
ونقول:
أولاً:
قال في البداية: وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن
ضماماً رجع إلى قومه قبل الفتح، لأن العُزَّى هدمها خالد بن الوليد
أيام الفتح.
وقد يناقش في ذلك:
بأن ذكر العُزَّى بالسوء، حتى بعد هدمها على يد خالد
كان كافياً لإحداث الخوف لدى أصحاب النفوس الضعيفة. من الإصابة
بالجنون، والجذام، و.. و.. الخ.. فلا يدل ذكرها على أن هذه الحادثة قد
حصلت بعد هدمها، ونرد على هذه المسألة: بأن هذا الإحتمال بعيد، لأن
العزى لم تستطع أن تدفع الهدم عن نفسها، ولا استطاعت أن توصل لمن تولى
هدمها أي سوء. فهل يمكن أن نتوقع منها أن يبتلى من يشتمها بجنون، أو
بجذام، أو بغير ذلك؟!
ثانياً:
إن ضماماً قد وفد على رسول الله «صلى الله عليه وآله»
سنة تسع، لأن ابن عباس يقول في روايته لما جرى: «فقدم علينا»([6]).
فيدل لك على أنه كان حاضراً في هذه المناسبة.
ومن الواضح:
أن ابن عباس إنما قدم المدينة بعد فتح مكة.
زعم أنس:
أن القرآن قد نهاهم عن أن يسألوا رسول الله «صلى الله
عليه وآله» عن شيء، فكانوا يعجبهم مجيء الرجل من البادية، فيسأله،
ويسمعون..
ونقول:
إن ذلك غير مقبول، بل غير معقول..
أولاً:
إنهم قد زعموا أن القرآن قد نهاهم عن سؤال النبي «صلى
الله عليه وآله»، والذي نهاهم القرآن عنه هو السؤال عن بعض الأشياء
التي لو أبديت لهم لساءتهم، فكان يجب أن يصبروا حتى ينزل القرآن
ببيانها، لكان خيراً لهم.
ثانياً:
لو فرضنا أنهم يزعمون: أن النبي «صلى الله عليه وآله»
قد فسر لهم النهي عن توجيه أي سؤال له «صلى الله عليه وآله» فنقول: إن
هذا غير معقول، لأن الله تعالى قد أمرهم بسؤال أهل الذكر، فقال:
{فَاسْأَلُواْ
أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}([7])،
فلا معنى لأن ينهاهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» عما أمرهم الله
تعالى به! وإن كان النهي عن ذلك قد صدر عن غير النبي «صلى الله عليه
وآله»، أي أن بعض الصحابة نهاهم عن ذلك، أو فسر لهم النهي القرآني بما
يفيد العموم، فالسؤال هو: لماذا أطاعوا ذلك الناهي لهم في أمر يخالف به
القرآن؟ بل لماذا لم يشتكوه إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، ليرشده
إلى الحق ويحمله عليه؟! أو على الأقل لماذا لم يسألوا النبي «صلى الله
عليه وآله» عن صحة ما قيل لهم؟!
ولو فرضنا أنه قيل لهم ذلك، فلماذا لا يأخذون بما روي
عنه «صلى الله عليه وآله» من أنه قال: سائلوا، وخالطوا الحكماء،
وجالسوا الفقراء([8]).
وعن
الإمام الصادق «عليه السلام»:
«إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون»([9]).
وعنه «عليه السلام»:
«إن هذا العلم عليه قفل مفتاحه السؤال»([10]).
وكان الإمام السجاد «عليه السلام»
إذا جاءه طالب علم قال:
مرحباً بوصية رسول الله «صلى الله عليه وآله»([11]).
ثانياً:
إن في تعليم العلم، وإجابة السائلين مثوبات لا يرغب
عنها الإنسان المؤمن؛ فكيف برسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!
فقد
روي عنه «صلى الله عليه وآله» أنه قال:
«العلم خزائن، ومفتاحه السؤال، فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر فيه
أربعة: السائل، والمعلم، والمستمع، والمجيب لهم».
وعن الإمام الصادق عن أبيه «عليهما السلام» نحوه([12]).
وهناك الأحاديث المثبتة لعقوبة من كتم علماً نافعاً،
فعنه «صلى الله عليه وآله» قال: من كتم علماً نافعاً جاء يوم القيامة
ملجماً بلجام من نار([13]).
ثالثاً:
لماذا يُنهى أصحاب النبي «صلى الله عليه وآله» عن
سؤاله، ويباح للأعراب وأهل البادية أن يسألوه؟ ألا يشير ذلك إلى أن
الذين نُهُوا عن سؤاله «صلى الله عليه وآله» هم أشخاص بأعيانهم؟!
بل لماذا لا يقال ـ كما أثبتته
النصوص ـ:
إنه «صلى الله عليه وآله» كان ينهى بعض الناس أو كلهم
عن السؤال تعنتاً؟! أو لأجل أنهم كانوا يسألونه «صلى الله عليه وآله»
عن أمور لا يصح السؤال عنها مطلقاً، أو إلا حين يحين وقتها. إذ لو
أجيبوا عنها قبل ذلك كان فيه مضرة عليهم، ويشير إلى ذلك قوله تعالى:
{يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ
لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ
الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا
كَافِرِينَ}([14]).
وقد قال الخضر لموسى «عليهما السلام»:
{فَإِنِ
اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ
مِنْهُ ذِكْراً}([15]).
وفي هذا دلالة على أن هناك أسئلة لا يرى المسؤول مصلحة في الإجابة
عليها في وقت أو في مرحلة معينة..
وربما كانوا يسألون عن علم يضرهم علمه، أو يسألون عن
علم لا يضرهم جهله، ولا ينفعهم علمه، فقد روي عن النبي «صلى الله عليه
وآله» قوله في من وُصِفَ له بأنه علّامة، لعلمه بأنساب العرب، ووقايعها
وأيام الجاهلية، وبالأشعار والعربية: «ذاك علم لا يضر من جهله، ولا
ينفع من علمه»([16]).
وعن الإمام الكاظم «عليه السلام»،
أنه قال:
«فلا تشغلن نفسك بعلم ما لا يضرك جهله»([17]).
وقد تقدم:
أن ذلك الوافد قال: أيكم محمد؟! فدلوه عليه..
وهذا يدل على:
أنه «صلى الله عليه وآله» لم يكن يمتاز في مجلسه عن
غيره من جلسائه.
وإن نور النبوة، وجلال الإيمان، وإن كان يحتم على كل
قادم أن ينشدَّ إليه، وينبهر بإشراقة وجهه، ويؤخذ بهيبته، ويأسره
وقاره.
ولكن ذلك لا يعفيه من السؤال عنه، على قاعدة:
{..قَالَ
أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي..}([18]).
لا سيما وأن هؤلاء الوافدين لم يعتادوا على مساواة الرؤساء أنفسهم
بعامة الناس..
ولعل علياً «عليه السلام» كان حاضراً، وهو أخو رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، فأثار ذلك لدى ذلك الوافد بعض الإلتباس،
فاحتاج إلى تحصيل السكينة عن طريق السؤال..
الرسول
 يتكئ بين
أصحابه: يتكئ بين
أصحابه:
وزعموا:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان متكئاً بين
أصحابه.. ونحن نشك في صحة ذلك، فقد روي: أنه «صلى الله عليه وآله» ما
اتكأ بين يدي رجل قط([19]).
وقد قرأنا في النص السابق مناشدات ضمام لرسول الله «صلى
الله عليه وآله» واستحلافه له على صدق ما يقول، وأنه أسلم بعد أن أخبره
«صلى الله عليه وآله» بصحة ذلك كله..
ونحن وإن كنا نرى أن ثمة قدراً من العفوية لدى أهل
البادية، الذين لا يجدون الكثير من الحوافز لديهم للإستفادة من أساليب
المكر، أو اتخاذ مواقف التزلف، والمحاباة والرياء، غير أن مما لا شك
فيه أن ضمام بن ثعلبة لم يكن ذلك الرجل المغفل والساذج، ولا مجال
للإستهانة بالطريقة التي أسلم بها. بل هي أسلوب له دلالات ذات قيمة
كبيرة، وأهمية بالغة، حيث إنها عبرت عن صفاء الفطرة، وعن حسن الإدراك،
إذ لا شك في أن هذا الرجل لم يجد في هذه التعاليم أي شيء يصادم فطرته،
ويرفضه عقله، أو يأباه ضميره ووجدانه، بل هو لم يجد فيها أي غموض أو
إبهام يستحق حتى الإستفهام عن معناه أو مغزاه، أو عن مبرراته.
بل غاية ما احتاج إليه هو مجرد تحصيل السكون والطمأنينة
إلى مصدر هذه التعاليم، وأنها تنتهي إلى الوحي الإلهي..
وأما عن اكتفاء ضمام بشهادة رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، على النحو الذي تقدم، فإننا نقول:
إن هناك عوامل عدة تفرض على ضمام أن ينصاع لما يقرره
النبي «صلى الله عليه وآله»، فهو يعرف موقع بني هاشم في الأمة،
ومكانتهم في قريش، والعرب، ومكة، ويعرف أيضاً ما كان من عبد المطلب في
عام الفيل. بالإضافة إلى معرفته بسيرة النبي الأعظم «صلى الله عليه
وآله»منذ طفولته حتى كهولته، ولا شك في أن أحداً لم يكن يجهل معجزات
رسول الله «صلى الله عليه وآله» طيلة أكثر من عشرين سنة، والقرآن
الكريم معجزة حاضرة لهم في كل زمان ومكان.. بل إن معجزات علي «عليه
السلام» ومنها اقتلاعه باب خيبر، وهي الأخرى معجزات للنبي «صلى الله
عليه وآله»، ومن دلائل صحة النبوة. ولم يكن ذلك كله ليخفى على أحد في
المنطقة العربية بأسرها..
وهذا كله يعطي أن مطلوب ضمام هو الحصول على السكينة
والطمأنينة، باتصال النبي «صلى الله عليه وآله» بالله عن طريق جبرئيل
من نفس رسول الله «صلى الله عليه وآله»، بعد أن حصل على القناعات
العقلية الكافية، من خلال جميع ما أشرنا إليه وسواه.
وواضح:
أن ما كان يخشاه هؤلاء من اللّات والعُزَّى هي أمور حتى
لو حصلت فعلاً، فإنه لا يمكن إقامة الدليل على أن لتلك الأصنام صلة
بها.
بل إن هذه الوفادة إن كانت قد حصلت بعد فتح مكة، فإن
هدم علي «عليه السلام» الأصنام التي كانت في الكعبة، وغيرها مما هدمه
«عليه السلام» منها بعد ذلك وعدم حصول أي شيء له طيلة هذه المدة يكفي
لإثبات عدم صحة الزعم بقدرة الأصنام على شيء من ذلك.
والمفارقة هي:
أن هؤلاء يستندون إلى وهم هنا، وخيال هناك. ولكنهم
يرفضون الإنصياع لما تقضي به فطرتهم، وتحكم به عقولهم، ألا وهو
التوحيد، وسائر الإعتقادات الحقة، والتعاليم الصحيحة، رغم تأييدها
بالمعجزات والكرامات، وكل شواهد الصدق ودلائله.
عن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي
قال:
لما سمعوا بخروج النبي «صلى الله عليه وآله» وثب ذباب ـ
رجل من بني أنس الله بن سعد العشيرة ـ إلى صنم كان لسعد العشيرة يقال
له: فرَّاض، فحطمه، ثم وفد إلى النبي «صلى الله عليه وآله» وقال:
تبعت
رسـول الله إذ جـاء بالهدى وخلـفـت فـرَّاضـاً بــدار
هــوان
شـددت عـلـيـه شـدة فـتركـتـه كـأن لم يكـن والـدهـر ذو
حدثـان
ولمــــا رأيــت الله أظــهر ديـنـه أجـبـت رسـول الله
حـين دعــاني
فأصبحت للإسلام ما عشت ناصراً وألـقـيـت فـيـه كـلـكـلي
وجراني
فـمن مبلغ سعـد العشـيرة أنـني شـريـت الـذي يبقى
بـآخر فاني([20])
وعن عبد الله بن شريك النخعي، قال:
كان عبد الله بن ذباب الأنَسِي مع علي بن أبي طالب
«عليه السلام» بصفين، فكان له غَنَاء([21]).
وقالوا:
إنه قبل المسير إلى تبوك وفد واثلة بن الأسقع الليثي
على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقدم المدينة ورسول الله «صلى
الله عليه وآله» يتجهز إلى تبوك، فصلى معه الصبح، فقال له: «ما أنت؟
وما جاء بك؟ وما حاجتك»؟
فأخبره عن نسبه، وقال:
أتيتك لأؤمن بالله ورسوله.
قال:
«فبايع على ما أحببت وكرهت».
فبايعه ورجع إلى أهله، فأخبرهم،
فقال له أبوه:
«والله لا أكلمك كلمة أبداً، وسمعت أخته كلامه، فأسلمت
وجهزته.
فخرج راجعاً إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فوجده
قد صار إلى تبوك، فقال: من يحملني عقبه وله سهمي؟
فحمله كعب بن عجرة حتى لحق برسول الله «صلى الله عليه
وآله»، وشهد معه تبوك، وبعثه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، مع خالد
بن الوليد إلى أكيدر، فغنم، فجاء بسهمه إلى كعب بن عجرة، فأبى أن
يقبله، وسوغه إياه وقال: إنما حملتك لله([22]).
وفي نص آخر:
عن ابن جرير عن واثلة بن الأسقع قال: خرجت من أهلي أريد
الإسلام، فقدمت على رسول الله «صلى الله عليه وآله» وهو في الصلاة،
فوقفت في آخر الصفو ف وصليت بصلاتهم. فلما فرغ رسول الله «صلى الله
عليه وآله» من الصلاة انتهى إليّ وأنا في آخر الصلاة. فقال: «ما
حاجتك»؟
قلت:
الإسلام.
قال:
«هو خير لك».
ثم قال:
«وتهاجر»؟
قلت:
نعم.
قال:
«هجرة البادي أو هجرة الباني»؟
قلت:
أيهما خير؟
قال:
«هجرة الباني أن يثبت مع النبي، وهجرة البادي أن يرجع
إلى باديته».
وقال:
«عليك بالطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك».
قلت:
نعم.
فقدم يده وقدمت يدي.
فلما رآني لا أستثني لنفسي شيئاً،
قال:
«فيما استطعت».
فقلت:
فيما استطعت، فضرب على يدي([23]).
وعن واثلة بن الأسقع قال:
لما أسلمت أتيت النبي «صلى الله عليه وآله»، فقال لي:
إذهب، فاحلق عنك شعر الكفر، واغتسل بماء وسدر([24]).
ونقول:
1 ـ
إننا نرتاب فيما ذكرته الرواية الأولى: من أن واثلة قد
أسلم حين كان «صلى الله عليه وآله» يتجهز إلى تبوك، فقد ذكروا: أنه كان
من أصحاب الصفة، وأنه خدم النبي «صلى الله عليه وآله» ثلاث سنين([25])،
وغزوة تبوك إنما كانت في سنة تسع.
2 ـ
إن أمر النبي «صلى الله عليه وآله» واثلة أن يحلق عنه
شعر الكفر، يشير إلى أنه «صلى الله عليه وآله» يريد أن يجعلهم يتحسسون
قبح ما كانوا عليه، وسوء آثاره حتى على أجسادهم، علماً بأن الآثار على
الأرواح والأجساد لا تنحصر بما يتعاطى الإنسان معه من أمور مادية، بل
يتجاوز ذلك ليصبح لنفس التصورات، وللإعتقادات التأثير الكبير والعميق
على الروح، والنفس، وعلى البدن أيضاً، ولذلك طلب منه أن يحلق عنه شعراً
نبت ونما في زمن كفره، لأنه يحمل معه قذارات معنوية، يريد رسول الله
«صلى الله عليه وآله» أن ينزهه عنها.
قال ابن عباس:
أهدر رسول الله «صلى الله عليه وآله» دم أسيد بن أبي
أناس (أو إياس) لما بلغه أنه هجاه، فأتى أسيد الطائف فأقام بها. فلما
فتح رسول الله «صلى الله عليه وآله» مكة خرج سارية بن زنيم إلى الطائف،
فقال له أسيد: ما وراءك؟
قال:
«قد أظهر الله تعالى نبيه ونصره على عدوه، فاخرج يا ابن
أخي إليه، فإنه لا يقتل من أتاه».
فحمل أسيد امرأته، وخرج وهي حامل تنتظر، وأقبل فألقت
غلاماً عند قرن الثعالب، وأتى أسيد أهله، فلبس قميصاً واعتم، ثم أتى
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وسارية بن زنيم قائم بالسيف عند رأسه
يحرسه، فأقبل أسيد حتى جلس بين يدي رسول الله «صلى الله عليه وآله»
وقال: يا محمد، أهدرت دم أسيد؟
قال:
«نعم».
قال:
تقبل منه أن جاءك مؤمناً؟
قال:
«نعم».
فوضع يد ه في يد رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، فقال:
«هذه يدي في يدك، أشهد أنك رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، وأشهد ألا إله إلا الله».
فأمر رسول الله «صلى الله عليه
وآله» رجلاً يصرخ:
أن أسيد بن أبي أناس، قد آمن، وقد أمَّنه رسول الله
«صلى الله عليه وآله».
ومسح رسول الله «صلى الله عليه وآله» وجهه، وألقى يده
على صدره.
فيقال:
إن أسيداً كان يدخل البيت المظلم فيضيء.
وقال أسيد:
أأنـت الـفـتى تهـدي معداً
لربهـا بـل الله يهـديهـا وقـال لـك أشهـد
فـما حملت من ناقـة فوق كورهـا أبَّــر وأوفـــى ذمــــة
مـن محمـد
وأكسى لبرد الحـال قبـل ابتذالـه وأعـطـى لـرأس
السـابـق المتجرد
تـعـلـم رسـول الله أنـك قـــادر عـلى كــل حي متهمين
ومـنـجـد
تعـلـم بـأن الركب ركب عويمر هم الكـاذبـون المخلفـو كل موعد
أَنَّـبـوا رسـول الله أن قـد هجوته فـلا رفـعـت سـوطي
إلي إذا يدي
سـوى أنني قد قلـت يا ويح فتنة أصيبوا بنحس لا يطـاق
وأسـعـد
أصابهـم مـن لم يكـن لـدمـائهم كـفـيـئـاً فعزَّت حسرتي
وتنكـدي
ذؤيـب وكـلـثـوم وسلم وساعد جمـيـعـاً فـإن لا تدمع العين
تكمد
فلما أنشده:
«أأنت الذي تهدي معداً لدينها»، قال رسول الله «صلى
الله عليه وآله»: «بل الله يهديها».
فقال الشاعر:
«بل الله يهديها وقال لك اشهد»([26]).
ونقول:
ولسنا بحاجة إلى تفنيد ما زعمته الرواية من أن سارية بن
زنيم كان قائماً على رأس النبي «صلى الله عليه وآله» بالسيف يحرسه..
فقد ذكرنا بعض ما يفيد في إظهار زيف هذه الإدعاءات في موضع سابق من هذا
الكتاب، فراجع..
تقدم:
أن الأشعار المذكورة هي لأسيد بن أبي أناس (إياس).
ولكنهم ذكروا في مورد آخر:
أنها لأنس بن زنيم([27]).
وحاول العسقلاني أن يقول:
إنه يحتمل وقوع ذلك لهما([28]).
غير أننا نقول:
إن ذلك وإن كان ليس مستحيلاً عقلاً لكنه مما لا يتفق
عادة، ولا سيما إذا كانت قصيدة مطولة، فإن احتمال أن تكون قد قيلت من
قِبَلِ رَجُلين، من دون تغيير يذكر، سفه من القول، ولا مجال لتصور
وقوعه، ولا يُقْبَل من أحد الحديث عنه، فضلاً عن الإستناد إليه..
تقدم قول أسيد بن أبي أناس (أو إياس):
تعلم بأن
الـركـب ركـب عويمر هم الكـاذبـون المخلفو كـل موعد
ولم تذكر أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» زجره عن
قوله هذا، فكيف سكت «صلى الله عليه وآله» عن هذه الجرأة على قوم
مسلمين؟!
قالوا:
قال دعبل بن علي في طبقات الشعراء قوله:
فـما حمـلت من
ناقـة فـوق كورها أعـف وأوفـى ذمــة مــن محـمـد
هذا أصدق بيت قالته العرب([29]).
النبي
 لا يقتل
من أتاه:
لا يقتل
من أتاه:
إن نفس أن يظهر للناس أنه «صلى الله عليه وآله» لا يقتل
من أتاه، قد أسهم في إقبال الناس على الاستفادة من هذه الحالة في إصلاح
أوضاعهم، وإنهاء مقاومتهم لدين الله، وحربهم على رسول الله «صلى الله
عليه وآله» وعلى المسلمين، بل وصيرورتهم له أتباعاً وأعواناً ومناصرين،
بعد أن كانوا له أعداءً محاربين ومنابذين.
إن نفس أن يبحث هؤلاء الذين أهدر النبي «صلى الله عليه
وآله» دمهم لافترائهم على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وصدهم عن
سبيل الله عن طريق الأكاذيب، وإكذابهم أنفسهم، وقبولهم بالإدانة على ما
اقترفوه من ظلم وبغي في حق أهل الإيمان ـ إن ذلك نفسه ـ كان مطلوباً
لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، لتطمئن بعض النفوس الضعيفة، ولينقطع
أمل من يداجي وينافق ويتآمر، ولكي تزول أية شبهة عن الإسلام وأهله يمكن
أن تؤثر على الأجيال اللاحقة.
إن من المضحك أن يتصرف أسيد مع رسول الله «صلى الله
عليه وآله» على أساس أنه «صلى الله عليه وآله» لا يعرفه.. مع أنه «صلى
الله عليه وآله» قد أظهر لهم في مفردات تعد بالمئات طيلة أكثر من عشرين
سنة أنه مشرف على الغيب، وهو يرفد إيمانهم بالكرامات الباهرة والدلالات
الظاهرة وقد صرح القرآن الكريم: بأن الأنبياء «عليهم السلام» قادرون
على إخبار الناس حتى بما يأكلون، وبما يدخرونه في بيوتهم، وبأنه سبحانه
قد أرسل النبي «صلى الله عليه وآله» شاهداً على قومه.. ولهذا البحث
مجال آخر.
وقدم وفد غسان على النبي «صلى الله عليه وآله» في شهر
رمضان سنة عشر، وهم ثلاثة نفر، فأسلموا وقالوا: لا ندري أيتبعنا قومنا
أم لا؟ وهم يحبون بقاء ملكهم، وقرب قيصر، فأجازهم رسول الله «صلى الله
عليه وآله» بجوائز، وانصرفوا راجعين، فقدموا على قومهم، فلم يستجيبوا
لهم، وكتموا إسلامهم([30]).
ونلاحظ هنا:
1 ـ
أن هؤلاء القوم يرون أن دخولهم في الإسلام يُذهب ملكهم
عنهم، مع أن الأمر ليس كذلك، فقد رأينا أنه «صلى الله عليه وآله» يريد
للناس المزيد من القوة والشوكة والسعادة، ولم يسلب أحداً ممن أسلم
ملكه، بل زاده الإسلام شوكة وعظمة ونفوذاً، وأصبح كل من يدخل منهم في
الإسلام يجد في سائر الأمم التي أسلمت عوناً له، وقوة، وعامل ثبات
وبقاء..
أما قيصر، فكان يريدهم لنفسه، فهو يريد أموالهم لا
ليقسمها في فقرائهم، ولا ليستفيد منها في إقرار الأمن، وإشاعة العدل،
وبناء المجتمعات على القيم، والمثل العليا، كما كان يفعل رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، بل ليصرفها على شهواته وملذاته، ولكي توجب له
المزيد من القوة على الظلم والتعدي، وإشاعة الإنحراف، والموبقات
والمآثم..
ويريد رجالهم ليكونوا وقوداً لحروبه التي يخوضها لتوسعه
ملكه، وبسط نفوذه، وحماية شخصه، وتلبية رغباته، والإستجابة لنزواته.
وأما رسول الله «صلى الله عليه وآله» فيريدهم مجاهدين
لا في سبيل شخصه بل في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين، ينشرون دينه بين
عباده.
2 ـ
إن هؤلاء الأشخاص قد كتموا إسلامهم حين رجعوا إلى
قومهم، حيث دعوهم فلم يستجيبوا لهم. فيكونون بذلك قد مارسوا مبدأ
التقية، الذي يدرك الإنسان بفطرته، وبعقله السديد، ورأيه الرشيد صحته،
وصوابيته، تماماً كما فعل عمار بن ياسر حينما استعمل التقية مع
المشركين.
فهذا المبدأ إذن هو مما ترشد إليه الفطرة، ويحكم به
العقل، وقد أيده القرآن والنصوص الشريفة، فما معنى إنكاره من بعض الذين
لا يحتاجون إليه، بعد أن جعلوا أنفسهم أتباع الحكام، ووعاظ السلاطين؟!
ثم إنهم حين يحتاجون إليه يمارسونه، ويغوصون فيه إلى الأعماق، كما
أظهرته وقائع التاريخ، وقد ذكرنا بعض مفردات ممارستهم للتقية، في أوائل
هذا الكتاب.
عن جرير بن عبد الله البجلي قال:
بعث إلي رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأتيته، فقال:
«ما جاء بك»؟
قلت:
جئت لأسلم.
فألقى إلي كساءه وقال:
«إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه».
وقال
«صلى الله عليه وآله»:
«أدعوك إلى شهادة ألا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن تؤمن بالله
واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة
المفروضة، وتصوم شهر رمضان، وتنصح لكل مسلم، وتطيع الوالي وإن كان
عبداً حبشياً»([31]).
عن جرير بن عبد الله البجلي قال:
لما دنوت من مدينة الرسول «صلى الله عليه وآله» أنخت
راحلتي وحللت عيبتي، ولبست حلتي، ودخلت المسجد، والنبي «صلى الله عليه
وآله» يخطب، فسلمت على رسول الله «صلى الله عليه وآله» فرماني الناس
بالحدق، فقلت لجليسي: يا عبد الله، هل ذكر رسول الله «صلى الله عليه
وآله» عن أمري شيئاً؟
قال:
نعم، ذكرك بأحسن الذكر، فبينا هو يخطب إذ عرض لك فقال:
«إنه سيدخل عليكم من هذا الباب ـ أو قال من هذا الفج ـ من خير ذي يمن،
وإن على وجهه لمسحة ملك». فحمدت الله على ما أبلاني([32]).
وروى البزار، والطبراني عن عبد الله بن حمزة، والطبراني
عن البراء بن عازب قال: بينا أنا يوماً عند رسول الله «صلى الله عليه
وآله» في جماعة من أصحابه أكثرهم اليمن إذ قال رسول الله «صلى الله
عليه وآله»: «سيطلع عليكم من هذه الثنية ـ وفي لفظ: من هذا الفج
ـ
خير ذي يمن، على وجهه مسحة ملك».
فما من القوم أحد إلا تمنى أن يكون من أهل بيته، إذ طلع
عليه راكب، فانتهى إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فنزل عن
راحلته، فأتى النبي «صلى الله عليه وآله» فأخذ بيده وبايعه وقال: «من
أنت»؟
قال:
جرير بن عبد الله البجلي.
فأجلسه إلى جنبه، ومسح بيده على رأسه ووجهه، وصدره
وبطنه، حتى انحنى جرير حياء أن يدخل يده تحت إزاره، وهو يدعو له
بالبركة ولذريته، ثم مسح رأسه وظهره وهو يدعو له، ثم بسط له عرض ردائه
وقال له: «على هذا يا جرير فاقعد». فقعد معهم ملياً ثم قام وانصرف.
وقال النبي «صلى الله عليه وآله»:
«إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»([33]).
وعن جرير بن عبد الله البجلي قال:
أتيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» فقلت: يا رسول
الله، أبايعك على الهجرة.
فبايعني رسول الله «صلى الله عليه وآله»، واشترط عليّ
النصح لكل مسلم، فبايعته على هذا.
قال ابن سعد:
وكان نزول جرير بن عبد الله على فروة بن [عمرو] البياضي([34]).
وقد ذكرت الرواية المتقدمة:
أنه «صلى الله عليه وآله» أرسل إلى جرير، فلما جاءه قال
له: ما جاء بك؟
فقد يقال:
إن هذا التصرف متناقض، لا يصدر عن النبي «صلى الله عليه
وآله»، إذ معنى إرساله إليه أنه قد جاء تلبية لدعوته، وأن دعوته له هي
السبب في مجيئه، فما معنى أن يسأله عن سبب مجيئه ويقول له: ما جاء بك؟
ويمكن أن يجاب:
بأنه لا مانع من أن يدعوه، ولكنه حين يأتيه، لا يكون
إتيانه طاعة واستجابة له، بل لداع آخر، فأراد «صلى الله عليه وآله» منه
أن يصرح بما دعاه إلى ذلك، ولعله توطئة واستدراج له ليظهر ما يستحق به
الأكرام والثناء..
ولكن هذا الجواب، وإن كان صحيحاً في نفسه، ولكن ليس
محله هنا، بل الصحيح هو: أن الصالحي الشامي اختار النص المحرَّف الذي
أورده البيهقي([35])
وفضله على نص آخر، ظاهر البطلان أيضاً، وهو مروي أيضاً عن جرير بن عبد
الله البجلي.
قال:
>لما
بعث النبي «صلى الله عليه وآله» أتيته فقال: ما جاء بك؟! الخ..<([36]).
إذ يرد على هذه الرواية:
أولاً:
قال العسقلاني: «حصين فيه ضعف»([37]).
يضاف إلى ذلك: أن هذا الخبر مروي عن جرير نفسه، الذي يجر النار إلى
قرصه..
ثانياً:
هناك فاصل كبير بين البعثة وبين وفادة الوفود، يصل إلى
عشرين سنة، فقد بعث النبي «صلى الله عليه وآله»، ثم دعا إلى الله في
مكة ثلاث عشرة سنة، ثم قدم المدينة، ثم حارب قريشاً وغيرهم، ثم فتح مكة
في أواخر سنة ثمان، ثم وفدت عليه الوفود مع أن جريراً لم يكن قد اسلم
طيلة هذه المدة، فقد جزم ابن عبد البر بما روي عن جرير نفسه، بأنه أسلم
قبل وفاة النبي «صلى الله عليه وآله» بأربعين يوماً([38]).
وجزم الواقدي:
بأن جريراً وفد على النبي «صلى الله عليه وآله» سنة عشر
في شهر رمضان([39]).
وحتى لو كان قد وفد عليه قبل ذلك، وقبل سنة سبع، فإن
حديثه عن أنه قد وفد على النبي «صلى الله عليه وآله» حين البعثة يبقى
بلا مبرر معقول أو مقبول.
وأجاب العسقلاني عن ذلك:
بأن المقصود به المجاز. أي لما بلغنا بعثة النبي «صلى
الله عليه وآله»، فلعله بلغه ذلك في سنة سبع أو ثمان أو تسع أو عشر، أو
يحمل على المجاز بالحذف أي لما بعث «صلى الله عليه وآله»، وجرى كذا
وكذا منه ذلك الوقت إلى سنة عشر أتيته الخ..([40]).
ونقول:
إنه كلام لا يصح أيضاً، أما بالنسبة لحمل الكلام على
المجاز. فلأن النبي «صلى الله عليه وآله» قد حارب المشركين واليهود،
وغزا الروم في تبوك، ومؤتة، وأرسل السرايا في مختلف الجهات قبل سنة
عشر، فلا يعقل أن لا تصل أخبار بعثته إلى بجيلة إلا بعد اثنتين أو ثلاث
وعشرين سنة. أو قبل وفاته «صلى الله عليه وآله» بأربعين يوماً.
وأما بالنسبة للمجاز في الحذف فهو مجاز مخل بإفهام
المعنى هنا، فلا يصار إليه، ولا يصح الإعتماد عليه في بيان المقاصد.
وذكرت الروايات التي رواها جرير لنفسه:
أولاً:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» دعاه ليؤمن بالقدر خيره
وشره.. ومن المعلوم: أن مراد التيار الأموي بهذا النوع من التعابير هو
ما ينتهي إلى الإعتقاد بالجبر الإلهي، حسبما أشرنا إليه في موضع آخر من
هذا الكتاب..
وأما إذا كان المراد بهذه العبارة هو ما يصيب الإنسان
بسبب أمور خارجة عن اختياره، كالذي يصيبه بسبب الكوارث الطبيعية، مثل
الزلازل ونحوها فلا إشكال فيه..
ثانياً:
ورد: أن مما أخذه «صلى الله عليه وآله» على جرير أن
يطيع الوالي وإن كان عبداً حبشياً، فإن كانت هذه دعوة لطاعة الطواغيت
والظالمين فهي تتناقض مع مبادئ الإسلام والقرآن.
وإن كان المقصود هو أن يلزمه بطاعة الإمام الذي يعينه
الله ورسوله أياً كان ذلك الإمام، حتى لو كان عبداً حبشياً، فهو كلام
صحيح ولا غبار عليه.
غير أن من الواضح:
أن ورود هذا الكلام على لسان رجل أعلن رفضه لنهج أهل
البيت «عليهم السلام» وخطهم، والتزم بنهج وخط أعدائهم يعطي: أن المطلوب
هو تأييد النهج المناوئ لأهل البيت، وتقوية حكومة الظالمين، وإلزام
الناس بطاعة جبابرة بني أمية، من خلال ما نسبوه للنبي «صلى الله عليه
وآله» من أنه أمرهم بطاعة كل والٍ، ثم اعتبار ذلك من القضاء الإلهي،
الذي لا خيار لأحد فيه، ولا مناص منه.
وقد تقدم:
أن جريراً سأل جليسه إن كان رسول الله «صلى الله عليه
وآله» ذكره في خطبته.. وهذا عجيب من جهتين:
إحداهما:
أن المفروض: أنه ورد على قوم لا يعرفهم ولا يعرفونه،
فما معنى طرحه هذا السؤال على جليسه من دون أن يعرّفه بنفسه.
الثانية:
لماذا يتوقع جرير أن يذكره النبي «صلى الله عليه وآله»
في خطبته، ويخبرهم بأمره؟ فحتى لو كان هذا الرجل يعظمه كسرى أو قيصر،
فإنه لا يتوقع أن يذكره النبي «صلى الله عليه وآله» في خطبته.
إلا أن يقال:
لعل القرائن ـ وهو أمر غير بعيد ـ قد دلت جريراً على أن
رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد تقدم إلى الناس فيه بشيء، فقد ذكرت
الرواية: أنه «صلى الله عليه وآله» بيّن لهم صفة من يدخل من الباب،
وأنه من خير ذي يمن، على وجهه مسحة ملك.
ويمكن أن يعرفوا الداخل بسمات أهل اليمن، وبسمة الملك
المذكورة، وعهدهم بصدق رسول الله «صلى الله عليه وآله»، مضافاً إلى
إمكان تقدم ذكر أمور أخرى أدلّ وإن لم تنقلها الرواية، فلما دخلوا
نظروا إليه جميعاً، فأحس بأنه قد كان جرى له ذكر بينهم.
قد تضمنت الروايات المتقدمة ثناءً على جرير بن عبد الله
البجلي، وأنه «صلى الله عليه وآله» ألقى إليه كساءه، وأنه قال: «إذا
جاءكم كريم قوم فاكرموه»، وأنه ذكره بأحسن الذكر، وأن على وجهه لمسحة
ملك، وأنه خير ذي يمن الخ..
ونقول:
إن ذلك كله لا يمكن أن يصح، ونعتقد أنه من مصنوعات جرير
لنفسه، لأنه في أكثره مروي عنه أو عن أعداء أهل البيت «عليهم السلام»،
وخصوصاً أصحاب النزعة الأموية من موظفي معاوية لوضع الأحاديث، في الحط
من علي «عليه السلام»، وذم أصحابه وأوليائه، ورفع شأن مناوئيه، وإطراء
أعدائه..
والسبب في ذلك:
أن جريراً هذا قد فارق علياً «عليه السلام» ولحق
بمعاوية([41]).
وقد خرب علي «عليه السلام» داره بالكوفة([42]).
ونهى أمير المؤمنين «عليه السلام» عن الصلاة في مسجده([43])،
وهو من المساجد الملعونة([44]).
وقد بايع هو والأشعث بن قيس ضباً([45]).
وكان يبغض علياً «عليه السلام»([46]).
وقد مدحه عمر بن الخطاب بقوله: جرير يوسف هذه الأمة([47]).
وقدمه عمر في العراق على جميع بجيلة([48]).
وقال عمر:
ما زلت سيداً في الجاهلية سيداً في الإسلام([49]).
([1])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص329 عن البيهقي في دلائل النبوة، وعن
أبي سعيد النيسابوري في شرف المصطفى، ونقله في هامشه عن صحيح
مسلم 4/2055 (7/2670) وعن البخاري 10/537 (6145) وكنز العمال
ج3 ص860.
([2])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص334 عن ابن سعد، عن الواقدي، والإصابة
ج4 ص30 والطبقات الكبرى ج1 ص329 وج7 ص416 وتاريخ مدينة دمشق
ج66 ص100.
([3])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص297 وعيون الأثر ج2 ص273 والسيرة
النبوية لابن هشام ج4 ص968 وإمتاع الأسماع ج14 ص30 والإصابة ج5
ص306 وأسد الغابة ج4 ص187 وج5 ص304 والطبقات الكبرى لابن سعد
ج5 ص504 والدرر لابن عبد البر ص249.
([4])
راجع ما تقدم كلاً أو بعضاً في المصادر التالية: سبل الهدى
والرشاد ج6 ص353 و 354 و 355 عن البخاري، ومسلم، وأحمد،
والترمذي، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجة، وأبي القاسم البغوي،
وابن سعد، وراجع: المواهب اللدنية وشرحه للزرقاني ج5 ص192 ـ
202 والإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج2 ص215 ـ 217 والإصابة ج2
ص210 و 211 ومسند أحمد ج1 ص265 وسنن الدارمي ج1 ص167 والمستدرك
للنيسابوري ج3 ص55 وعمدة القاري ج2 ص22 والإستيعاب ج2 ص753
وتاريخ المدينة للنميري ج2 ص523 وتاريخ الطبري ج2 ص384 والكامل
في التاريخ ج2 ص290 والبداية والنهاية لابن كثير ج5 ص73
والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص997 وسبل الهدى والرشاد ج6
ص355.
([5])
شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج5 ص193 و 197.
([6])
شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج5 ص197 عن أحمد والحاكم.
([7])
الآية 43 من سورة النحل والآية 7 من سورة الأنبياء.
([8])
البحار ج1 ص198 عن نوادر الراوندي.
([9])
البحار ج1 ص198 عن منية المريد والحدائق الناضرة ج1 ص78
والكافي ج1 ص40 وجامع أحاديث الشيعة ج1 ص95.
([10])
البحار ج1 ص198 عن منية المريد والكافي ج1 ص40 ومنية المريد
للشهيد الثاني ص175 و259 والبحار ج1 ص198 وجامع أحاديث الشيعة
ج1 ص102.
([11])
سفينة البحار ج6 ص348 والبحار ج1 ص168 وج46 ص62 و63 والمجموع
للنووي ج1 ص27 وروضة الطالبين للنووي ج1 ص74 والخصال للصدوق
ص518 والأمالي للطوسي ص478.
([12])
البحار ج1 ص196 و 197 عن صحيفة الرضا «عليه السلام»، وعن
الخصال.
([13])
سفينة البحار ج6 ص358 والتحفة السنية للجزائري ص11 وأمالي
الطوسي ص377 ومنية المريد للشهيد الثاني ص369 والبحار ج2 ص68
وج7 ص217 والغدير ج8 ص153 ومسند أحمد ج2 ص296 و499 و508 ومجمع
الزوائد ج1 ص163 والمعجم الأوسط للطبراني ج2 ص382 وج5 ص108
و356 والمعجم الكبير للطبراني ج11 ص117 والكفاية في علم
الرواية للخطيب البغدادي ص54 و جامع بيان العلم وفضله لابن عبد
البر ج1 ص4 و5 و38 وتخريج الأحاديث والآثار للزيلعي ج1 ص254
وكنز العمال ج10 ص196 و216 وتفسير الصافي ج1 ص163 وتفسير نور
الثقلين ج4 ص518 وتفسير الميزان ج3 ص75 وتفسير القرآن للصنعاني
ج1 ص64 وأحكام القرآن للجصاص ج1 ص122 وتفسير الرازي ج1 ص184
والدر المنثور للسيوطي ج1 ص162 وتفسير الآلوسي ج2 ص26 والطبقات
الكبرى لابن سعد ج4 ص331 وضعفاء العقيلي ج1 ص74 وج4 ص160
والكامل ج3 ص455 وج4 ص312 وج5 ص212 وج6 ص341 وكتاب الضعفاء
للأصبهاني ص50 وتاريخ بغداد ج7 ص418 وج14 ص325 وتاريخ مدينة
دمشق ج43 ص541 وميزان الإعتدال للذهبي ج2 ص582 وغيرها.
([14])
الآيتان 101 و 102 من سورة المائدة.
([15])
الآية 70 من سورة الكهف.
([16])
سفينة البحار ج6 ص244 عن أمالي الصدوق وتحرير الأحكام للحلي ج1
ص40 وعوائد الأيام للنراقي ص551 والكافي ج1 ص32 والأمالي
للصدوق ص340 ومعاني الأخبار للصدوق ص141 والوسائل (ط مؤسسة آل
البيت) ج17 ص327 و (ط دار إحياء التراث العربي) ج12 ص245
ومستطرفات السرائر لابن إدريس الحلي ص627 ومشكاة الأنوار
للطبرسي ص242 وعوالي اللئالي ج4 ص79 والبحار ج1 ص211 ومعارج
الأصول للمحقق الحلي ص23.
([17])
سفينة البحار ج6 ص244 عن إعلام الدين وعمدة الداعي للحلي ص68
ومستدرك سفينة البحار للشاهرودي ج7 ص 349 وأعلام الدين في صفات
المؤمنين للديلمي ص305.
([18])
الآية 260 من سورة البقرة.
([19])
راجع: عيون اخبار الرضا ج1 ص197 والبحار ج49 ص91 وموسوعة
أحاديث أهل البيت ج5 ص206 وإعلام الورى ج2 ص63 والوسائل (ط
مؤسسة آل البيت) ج12 ص209 ومستدرك الوسائل ج8 ص439 وجامع
أحاديث الشيعة ج15 ص556 ومسند الإمام الرضا ج1 ص45 ومستدرك
سفينة البحار ج3 ص187.
([20])
سبل الهدى والرشاد ج2 ص211 وج6 ص338 عن ابن سعد، والإصابة (ط =
= دار الكتب العلمية) ج2 ص336 وج7 ص105، وج1 ص481 عن ابن
شاهين، وفي وابن مندة في دلائل النبوة، والمعافي في الجليس،
والبيهقي في الدلائل، وابن سعد، وكنزالفوائد للكراجكي ص92،
والبحار ج18 ص102، والطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص342، وأسد
الغابة ج2 ص136، وأعيان الشيعة ج8 ص52.
([21])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص338 عن ابن سعد، والإصابة ج1 ص481،
والطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص342، وأعيان الشيعة ج8 ص52.
([22])
سبل الهدى والرشاد ج11 ص373 وج6 ص402 عن الطبقات الكبرى لابن
سعد (ط دار صادر) ج1 ص305، وتاريخ مدينة دمشق ج62 ص353،
والبداية والنهاية لابن كثير ج5 ص106، وأعيان الشيعة ج1 ص241،
والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص176.
([23])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص433 وفي هامشه عن: مجمع الزوائد ج5 ص255
وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات، وكنز العمال ج16 ص676،
وتاريخ المدينة للنميري ج2 ص486.
([24])
قاموس الرجال ج9 ص240 عن تاريخ بغداد (ترجمة منصور بن عمار)
وفي (ط مؤسسة النشر الإسلامي) ج10 ص421، وكنز العمال ج1
ص94،تاريخ بغداد ج13 ص73، وتاريخ مدينة دمشق ج62 ص355، و356،
وذكر أخبار إصبهان ج2 ص38.
([25])
الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج3 ص643 وراجع: قاموس الرجال ج9
ص239، والإستيعاب ج4 ص1563، وشرح مسند أبي حنيفة للقاري ص590،
أسد الغابة ج5 ص77، وتاريخ الإسلام للذهبي ج6 ص216، والوافي
بالوفيات ج27 ص243، وتاريخ مدينة دمشق ج62 ص347 و349، والجرح
والتعديل للرازي ج9 ص47.
([26])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص271 و 365 و 366 عن ابن شاهين، عن
المدائني، وابن عساكر، والإصابة ج1 ص47 عن المدائني وابن
شاهين، وتاريخ مدينة دمشق ج20 ص22، وإسد الغابة ج1 ص89 و90،
والوافي بالوفيات ج9 ص238، والإصابة ج2 ص336.
([27])
راجع: الإصابة ج1 ص69 و390،
وسبل
الهدى والرشاد ج5 ص263، وج6 ص271 عن الواقدي، والطبراني،
وتصحيفات المحدثين للعسكري ج3 ص929 و931، وشرح النهج للمعتزلي
ج17 ص282، والوافي بالوفيات ج9 ص237، والبداية والنهاية لابن
كثير ج4 ص356، والسيرة النبوية للحميري ج4 ص879، والسيرة
النبوية لابن كثير ج3 ص589.
([28])
راجع: الإصابة ج1 ص47 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص271 و 272.
([29])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص271 و 272، والإصابة ج1 ص272، وخزانة
الأدب للبغدادي ج6 ص429.
([30])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص391 عن زاد المعاد وشرح المواهب اللدنية
للزرقاني ج5 ص223، وعيون الأثر ج1 ص316، والطيقات الكبرى لابن
سعد ج1 ص339، وتاريخ مدينة دمشق ج68 ص94، والسيرة الحلبية ج3
ص277.
([31])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص311 عن الطبراني، والبيهقي، وابن سعد
وقال في هامشه: أخرجه ابن سعد في الطبقات ج2 ص110، والبحار ج21
ص371، والطبقات المبرى لابن سعد ج1 ص347.
وراجع: الإصابة ج1 ص232 والإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج1
ص233.
([32])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص311 عن أحمد، والبيهقي، والطبراني،
وراجع: الإصابة ج1 ص232 والإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج1
ص233، وفضائل الصحابـة للنسائي ص60، والمستدرك للنيسابـوري ج1
ص285، = = والسنن الكبرى
للبيهقي ج3 صص222، والمصنف ج7 ص538 وج8 ص455، و بغية الباحث عن
زوائد مسند الحارث ص308، والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص82، وصحيح
ابن خزيمة ج3 ص149، وصحيح ابن حبان ج16 ص174، والمعجم الكبير
للطبراني ج2 ص353، وكنز العمال ج13 ص327.
([33])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص311 عن أحمد، والبزار، والبيهقي،
والطبراني برجال ثقات، وقال في هامشه: أخرجه ابن ماجة (3712)
والبيهقي في السنن ج8 ص168، والطبراني في الكبير ج2 ص370 و325،
والحاكم في المستدرك= = ج4 ص292، وأبو نعيم في الحلية ج6 ص205،
وابن عدي في الكامل ج1 ص181، والمجموع لمحيى الدين النووي ج14
ص43، ومستدرك الوسائل للميرزا النوري ج8 ص396، ومستدرك سفينة
البحار للشاهرودي ج9 ص106، ومجمع الزوائد للهيثمي ج8 ص15،
ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ص34، والأحاديث الطوال
للطبراني ص21، والمعجم الأوسط للطبراني ج5 ص262 و369 وج6 ص240،
والمعجم الصغير للطبراني ج2 ص12، والاستيعاب ج1 ص 237 وج3
ص928، وتاريخ بغداد ج1 ص201 وج7 ص97، وأسد الغابة ج1 ص279،
وسير أعلام النبلاء ج2 ص532، وغيرها.
وراجع: الإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج1 ص233 والإصابة ج1
ص232.
([34])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص312 عن الطبراني برجال الصحيح، والطبقات
الكبرى لإ بن سعد ج1 ص347.
([35])
سبل الهدى والرشاد ج6 ص312.
([36])
الإصابة ج1 ص232 و582، وسبل الهدى والرشاد ج6 ص311 وج9 ص388،
وأعيان الشيعة ج4 ص72، ومسند الشهاب لابن سلامة ج1 ص445، وكشف
الخفاء للعجلوني ج1 ص75، وتهذيب التهذيب ج2 ص64.
([37])
الإصابة ج1 ص232 وفي (ط دارالكتب العلمية) ج1 ص582، و وسبل
الهدى والرشاد ج6 ص312، وأعيان الشيعة ج4 ص72.
([38])
الإصابة ج1 ص232 والإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج1 ص233 وسبل
الهدى والرشاد ج6 ص312، و تهذيب التهذيب ج2 ص64، والذريعة
للطهراني ج8 ص51، و أعيان الشيعة ج4 ص72، وتاج العروس ج14 ص44.
([39])
الإصابة ج1 ص232، وفتح الباري ج1 ص193 وج7 ص99، و عمدة القاري
ج15 ص144، و شرح مسند أبي حنيفة للقاري ص66، و إرواء الغليل
للألباني ج1 ص139، و الإكمال في أسماء الرجال للخطيب التبريزي
ص35، و الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة للذهبي ج1
ص291، والمعارف لابن قتيبة ص292.
([40])
الإصابة ج1 ص232، وسبل الهدى والرشاد ج6 ص312.
([41])
راجع: مروج الذهب ج2 ص 373 وتذكرة الخواص ص84 والإصابة ج2
ص232، و نيل الأوطار للشوكاني ج1 ص223، وشرح النهج للمعتزلي ج3
ص118 وج4 ص75.
([42])
راجع: قاموس الرجال ج2 ص585، و بحار الأنوار ج32 ص381، وشرح
النهج للمعتزلي ج3 ص118، وتاريخ مدينة دمشق ج57 ص442، وانساب
الأشراف للبلاذري ص277، وأعيان الشيعة ج1 ص471، ووقعة صفين
للمنقري ص60.
([43])
الخصال ج1 ص300، والكافي ج3 ص490، وروضة الواعظين للنيسابوري
ص336، والوسائل ( ط مؤسسة آل البيت) ج5 ص250 و (ط دار
الإسلامية) ج3 ص520، والبحار ج97 ص438.
([44])
تهذيب الأحكام للطوسي ج3 ص250، وتذكرة الفقهاء (ط.ق) للحلي ج1
ص90 و (ط.ج) ج2 ص426، ومنتهى المطلب (ط.ق) للحلي ج1 ص387، و
نهاية الإحكام للحلي ج1 ص354، وكشف الغطاء (ط.ق) للشيخ جعفر
كاشف الغطاء ج1 ص212، والكافي ج3 ص490، وروضة الواعظين
للنيسابوري ص336، والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج5 ص249، و (ط
دار الإسلامية) ج3 ص519، ومستدرك الوسائل للنوري ج3 ص397 و399،
والغارات ج2 ص486، وأمالي الطوسي ص169، وفضل الكوفة ومساجدها
للمشهدي ص18، والمزار للمشهدي ص118، والبحار ج80 ص361 وج97
ص438، وجامع أحاديث الشيعة للبروجردي ج4 ص543.
([45])
راجع: شرح النهج ج4 ص75، والبحار ج109 ص60.
([46])
راجع: قاموس الرجال ج2 ص585، وأعيان الشيعة ج4 ص75.
([47])
راجع: الإصابة ج1 ص232 وأسد الغابة ج1 ص279 والإستيعاب (مطبوع
مع الإصابة) ج1 ص233، وشرح النهج للمعتزلي ج3 ص118، وسير أعلام
النبلاء ج2 ص535، والمعارف لابن قطيبة ص292، وتاريخ الإسلام
للذهبي ج4 ص187، والوافي بالوفيات ج11 ص58، والبداية والنهاية
لابن كثير ج8 ص61، وتاج العروس ج14 ص44.
([48])
الإصابة ج1 ص232 وفي (ط دار الكتب العلمية) ج1 ص583، وخزانة
الأدب ج8 ص22.
([49])
الإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج1 ص234 وفي (ط دار الجيل) ج1
ص238، وأعيان الشيعة ج4 ص72.
|