فـي طـريـق الـعــودة
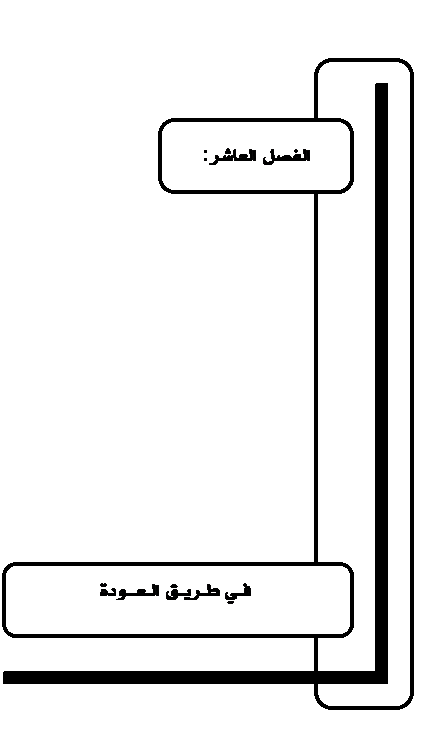
عن أبي هريرة، وعمر بن الخطاب
وغيرهما:
لما أجمع رسول الله «صلى الله عليه وآله» السير من تبوك
أرمل الناس([1])
إرمالاً، فشخص على ذلك من الحال.
قال أبو هريرة:
فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فننحر نواضحنا
فأكلنا وادَّهنا؟
قال شيوخ محمد بن عمر:
فلقيهم عمر بن الخطاب، وهم على نحرها فأمرهم أن يمسكوا
عن نحرها، ثم دخل على رسول الله «صلى الله عليه وآله» في خيمة له، ثم
اتفقوا، فقال: يا رسول الله، أأذنت للناس في نحر حمولتهم يأكلونها؟
قال شيوخ محمد:
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «شكوا إليّ ما
بلغ منهم الجوع، فأذنت لهم، بنحرِ الرَُّفِقَةِ([2])
البعير والبعيرين، ويتعاقبون فيما فضل منهم، فإنهم قافلون إلى أهليهم».
فقال عمر:
يا رسول الله لا تفعل، فإن يك في الناس فضل من الظهر
يكن خيراً، فالظهر اليوم رقاق. ولكن يا رسول الله ادع بفضل أزوادهم، ثم
اجمعها، وادع الله تعالى فيها بالبركة، لعل الله تعالى أن يجعل فيها
البركة.
كما فعلت في منصرفنا من الحديبية حين أرملنا، فإن الله
تعالى مستجيب لك.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«نعم».
فدعا بنطع فبسط ونادى منادي رسول الله «صلى الله عليه
وآله»: من كان عنده فضل من زاد فليأت به.
فجعل الرجل يأتي بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء
الآخر بكسرة. فيوضع كل صنف من ذلك على حدة، وكل ذلك قليل، وكان جميع ما
جاؤوا به من السويق والدقيق والتمر ثلاثة أفراق حزراً ـ والفرق ثلثة
آصع([3]).
قال:
فجزأنا ما جاؤوا به فوجدوه سبعة وعشرين صاعاً. ثم قام
رسول الله «صلى الله عليه وآله» فتوضأ وصلى ركعتين، ثم دعا الله تعالى
أن يبارك فيه، ثم قال: «أيها الناس، خذوا ولا تنتهبوا».
فأخذوه في الجرب والغرائر، حتى جعل الرجل يعقد قميصه
فيأخذ فيه.
قال أبو هريرة:
وما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، وأكلوا حتى شبعوا،
وفضلت فضلة.
قال بعض من الصحابة:
لقد طرحت كسرة يومئذٍ من خبز، وقبضة من تمر، ولقد رأيت
الأنطاع تفيض، وجئت بجرابين، فملأت أحدهما سويقاً، والآخر خبزاً، وأخذت
في ثوبي دقيقاً كفاني إلى المدينة. قال: فأخذوا حتى صدروا.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يأتي بها
عبد غير شاك فيحجب عن الجنة».
وفي لفظ:
«لا يأتي بها عبد محق إلا وقاه الله حر النار»([4]).
وقال جابر بن عبد الله كما رواه ابن سعد أقام رسول الله
«صلى الله عليه وآله» بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة([5]).
وقيل:
بضع عشرة ليلة([6])..
وعن فضالة بن عبيد:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» غزا غزوة تبوك، فجهد
الظهر جهداً شديداً، فشكوا ذلك إليه، ورآهم يزجون ظهرهم، فوقف في مضيق
والناس يمرون فيه، فنفخ فيها وقال: «اللهم احمل عليها في سبيلك فإنك
تحمل على القوي والضعيف، والرطب واليابس، في البر والبحر».
فاستمرت فما دخلنا المدينة إلا وهي تنازعنا أزمتها([7]).
ونقول:
إننا بالنسبة لما تقدم نذكر ما يلي:
قد أظهر النص المتقدم:
أن نبي الإسلام «صلى الله عليه وآله»، الذي صنعه الله
على عينه، كما صنع موسى «عليه السلام»، وهو عقل الكل، وإمام الكل،
ومدبر الكل، وهو أكمل الخلق وأفضلهم، أظهر أنه ـ والعياذ بالله ـ ضعيف
الإدراك، قاصر النظر، يصدر لأصحابه تعليمات خاطئة، من شأنها أن تودي
بحياة ألوف من الناس.. حتى احتاج إلى رجل من أتباعه ليعلمه كيف يتصرف،
ويسدده ويرشده على ما يصنع، رغم أن هذا المعلم لم يمنعه عقله من اعتقاد
الشرك، ومن عبادة الأحجار والأصنام، طيلة عشرات السنين، كما أنه قد عاش
في جاهلية، لم يعرف فيها شيئاً من العلوم، ولا اطلع على شيء من
المعارف.
على أن التعليل الذي قدمه عمر لم يتضمن ما يقنع سوى أنه
ذكر هزال الإبل، وهذا ليس تعليلاً يستحق الوقوف عنده، لأن حاجة الناس
إلى الطعام هي المشكلة، وهم يعرفون ويرون هزال تلك النواضح، فيصبح هذا
التعليل بلا معنى، ويصبح المطلوب هو تنفيذ أوامر عمر، الذي يريد
التسويق لقرار اتخذه، وأمر أصدره، فقد قال: «إن يك في الناس فضل من ظهر
يكن خيراً، فالظهر اليوم رقاق»([8]).
غير أننا لا نمنع أن يكون الناس قد نحروا من الإبل
بعضها، بعد أخذهم الإجازة من رسول الله «صلى الله عليه وآله»..
ولعل هذا التطفل على رسول الله «صلى الله عليه وآله»
محاولة لإظهار أنه قد أخطأ في إجازته للناس بنحر الظهر. ولم يؤد إلى
نتيجة، ولعله «صلى الله عليه وآله» لم يستجب لطلب عمر بإلغاء الإذن..
واما حديث جمع الأزواد، والدعاء بالبركة فيها، فلعله
كان في يوم جديد احتاجوا فيه للطعام، فبادر «صلى الله عليه وآله» إلى
صنع هذه الكرامة لهم، من دون أن يكون هناك ارتباط بين الأمرين..
عن أبي قتادة قال:
بينا نحن نسير مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» في
الجيش ليلاً، وهو قافل وأنا معه، إذ خفق خفقة، وهو على راحلته، فمال
على شقه، فدنوت منه فدعمته فانتبه، فقال: «من هذا»؟
فقلت:
أبو قتادة يا رسول الله، خفت أن تسقط فدعمتك.
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»:
«حفظك الله كما حفظت رسوله».
ثم سار غير كثير، ثم فعل مثل ذلك،
فدعمته، فانتبه، فقال:
«يا أبا قتادة، هل لك في التعريس»؟
فقلت:
ما شئت يا رسول الله.
فقال:
«انظر من خلفك».
فنظرت، فإذا رجلان أو ثلاثة، فقال:
«ادعهم».
فقلت:
أجيبوا رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فجاؤوا، فعرسنا
ـ ونحن خمسة ـ برسول الله «صلى الله عليه وآله» ومعي إداوة فيها ماء
وركوة لي أشرب فيها، فنمنا فما انتبهنا إلا بحر الشمس، فقلنا: إنا لله
فاتنا الصبح.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«لنغيظن الشيطان كما غاظنا».
فتوضأ من ماء الإداوة، ففضل فضلة
فقال:
«يا أبا قتادة، احتفظ بما في الإداوة والركوة، فإن لهما
شأناً».
وصلى «صلى الله عليه وآله» بنا الفجر بعد طلوع الشمس،
فقرأ بالمائدة، فلما انصرف من الصلاة قال: «أما إنهم لو أطاعوا أبا بكر
وعمر لرشدوا».
وذلك أن أبا بكر وعمر أرادا أن ينزلا بالجيش على الماء،
فأبوا ذلك عليهما، فنزلوا على غير ماء بفلاة من الأرض.
فركب رسول الله «صلى الله عليه وآله» فلحق الجيش عند
زوال الشمس ونحن معه. وقد كادت أعناق الخيل والرجال والركاب تقطع
عطشاً، فدعا رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالركوة، فأفرغ ما في
الإداوة فيها. ووضع أصابعه عليها، فنبع الماء من بين أصابعه.
وأقبل الناس فاستقوا وفاض الماء
حتى روُوا، وروَوْا خيلهم، وركابهم، وكان في العسكر اثنا عشر ألف بعير،
والناس ثلاثون ألفاً، والخيل اثنا عشر ألف فرس، فذلك قول رسول الله
«صلى الله عليه وآله»: «احتفظ بالركوة والإداوة»([9]).
النبي
 يلعن
أربعة سبقوه إلى الماء: يلعن
أربعة سبقوه إلى الماء:
قال ابن إسحاق، ومحمد بن عمر:
وأقبل رسول الله «صلى الله عليه وآله» قافلاً حتى إذا
كان بين تبوك وواد يقال له: وادي الناقة ـ وقال ابن إسحاق: يقال له:
وادي المشقق ـ وكان فيه وشل، يخرج منه في أسفله قدر ما يروي الراكبين
أو الثلاثة، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «من سبقنا إلى ذلك
الوشل فلا يستقين منه شيئاً حتى نأتيه».
فسبقه إليه أربعة من المنافقين:
معتب بن قشير، والحارث بن يزيد الطائي حليف في بني عمرو
بن عوف، ووديعة بن ثابت، وزيد بن اللصيت.
فلما أتاه رسول الله «صلى الله عليه وآله» وقف عليه فلم
ير فيه شيئاً.
فقال:
«من سبقنا إلى هذا الماء»؟
فقيل:
يا رسول الله، فلان وفلان.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«ألم أنهكم»؟
فلعنهم، ودعا عليهم، ثم نزل ووضع يده تحت الوشل، ثم
مسحه بإصبعيه حتى اجتمع منه في كفه ماء قليل، ثم نضحه به، ثم مسحه
بيده، ثم دعا بما شاء الله أن يدعو، فانخرق منه الماء ـ قال معاذ بن
جبل: والذي نفسي بيده لقد سمعت له من شدة انخراقه مثل الصواعق.
فشرب الناس ما شاؤوا، واستقوا ما شاؤوا، ثم قال رسول
الله «صلى الله عليه وآله» للناس: «لئن بقيتم. أو من بقي منكم» ـ
لتسمعن بهذا الوادي وهو أخصب مما بين يديه ومما خلفه([10]).
قال سلمة بن سلامة بن وقش:
قلت لوديعة بن ثابت: ويلك أبعد ما ترى شيء؟ أما تعتبر؟
قال:
قد كان يفعل بهذا مثل هذا قبل هذا.
ثم سار رسول الله «صلى الله عليه وآله»([11]).
النبي
 يسقي
الجيش من قربة واحدة: يسقي
الجيش من قربة واحدة:
وعن جماعة من أهل المغازي قالوا:
بينا رسول الله «صلى الله عليه وآله» يسير منحدراً إلى
المدينة، وهو في قيظ شديد، عطش العسكر بعد المرتين الأوليين عطشا
شديداً، حتى لا يوجد للشفة ماء قليل ولا كثير، فشكوا ذلك لرسول الله
«صلى الله عليه وآله»، فأرسل أسيد بن الحضير في يوم صائف، وهو متلثم،
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «عسى أن تجد لنا ماء».
فخرج أسيد وهو فيما بين تبوك والحجر في كل وجه، فيجد
راوية من ماء مع امرأة من بلي، فكلمها أسيد، وأخبرها خبر رسول الله
«صلى الله عليه وآله».
فقالت:
فهذا الماء، فانطلق به إلى رسول الله «صلى الله عليه
وآله» وقد وصفت له الماء وبينه وبين الطريق هنيهة.
فلما جاء أسيد بالماء دعا فيه رسول الله «صلى الله عليه
وآله» ودعا فيه بالبركة، ثم قال: «هلم أسقيتكم». فلم يبق معهم سقاء إلا
ملأوه، ثم دعا بركابهم وخيولهم، فسقوها حتى نهلت.
ويقال:
إنه «صلى الله عليه وآله» أمر بما جاء به أسيد فصبه في
قعب عظيم من عساس أهل البادية، فأدخل رسول الله «صلى الله عليه وآله»
فيه يده، وغسل وجهه، ويديه، ورجليه، ثم صلى ركعتين، ثم رفع يديه مداً،
ثم انصرف وإن القعب ليفور، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» للناس:
«رِدوا».
فاتسع الماء، وانبسط الناس حتى يصف عليه المائة
والمائتان فارتووا، وإن القعب ليجيش بالرواء، ثم راح رسول الله «صلى
الله عليه وآله» مبرداً متروياً([12])..
ونقول:
إن عدداً من القضايا والمزاعم التي تضمنتها النصوص
المتقدمة قد تم بحثها في ثنايا هذا الكتاب، ولعل بعضها قد بحث أكثر من
مرة أيضاً، فلا حاجة إلى الإعادة هنا.
ومن الأمور التي بحثت سابقاً:
1 ـ
حديث نومه «صلى الله عليه وآله» عن صلاة الصبح.
2 ـ
حديث سقي الناس الماء الذي نبع من بين أصابعه «صلى الله
عليه وآله».
3 ـ
حديث الذين خالفوا نهي رسول الله «صلى الله عليه وآله»
عن الإستقساء من عين كانت على الطريق، فخالفه بعضهم، فلعنهم «صلى الله
عليه وآله» ودعا عليهم.
غير أننا نحاول أن نثير هنا بعض التساؤلات، أو نعرض عن
بعض البيانات الأخرى، فنقول:
النبي
 مال إلى
شقه فأسنده: مال إلى
شقه فأسنده:
ذكر في ما تقدم:
أن النبي «صلى الله عليه وآله»، خفق خفقة، فمال إلى شقه
فدعمه أبو قتادة..
ونقول:
ألف:
إن المتوقع لمن ينام على راحلته أن يسقط عنها، لا مجرد
أن يميل على شقه، لأن المفروض: أنه لم يربط عليها، بحبل، ولا بغيره..
ب:
وزعم أبو قتادة: أنه قد دعم رسول الله «صلى الله عليه
وآله» لكي لا يقع. والسؤال هو: كيف دعمه؟!
هل كان أبو قتادة راكباً على راحلة، أو كان ماشياً؟!
فإن كان على راحلته فكيف استطاع أن يصل إليه لكي يدعمه؟ إلا إذا كانت
ذراع أبي قتادة بطول مترين أو أكثر..
وإن كان ماشياً على قدميه، فهل كان أبو قتادة طويل
القامة بحيث يوازي ارتفاع الراحلة، أو أكثر من ذلك؟!
ج:
ماذا لو أن أبا قتادة لم يلتفت إلى رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، ووقع عن ظهر الراحلة؟! ألا يعد ركوبه الراحلة، وهو يغالب
النوم مخاطرة لا يحسن أن تصدر من مثله «صلى الله عليه وآله»؟!.
د:
ولماذا لم يبادر إلى التعريس من المرة الأولى، بل بقي
على ظهر راحلته حتى عرض نفسه للخطر مرة أخرى؟!
هـ:
قد صرحت النصوص: أن النبي «صلى الله عليه وآله» إنما
تنام عيناه ولا ينام قلبه..
وفي نصوص أخرى:
أنه «صلى الله عليه وآله» يعرف ما يجري حوله.
وقد تقدم طرف منها في هذا الكتاب، فراجع.
وقد زعمت رواية نوم النبي «صلى الله
عليه وآله» عن صلاته:
أنه «صلى الله عليه وآله» طلب من أبي قتادة أن ينظر
خلفه، فنظر، فلم يجد سوى ثلاثة فعرسوا وهم خمسة فقط، ثم ناموا، فلم
ينتبهوا إلا بحر الشمس، وفاتتهم صلاة الصبح..
ونحن لا نريد أن نتحدث عن عصمة النبي «صلى الله عليه
وآله» عن السهو والخطأ والنسيان.
ولا عن شدة اهتمامه بصلاته، ومراقبته لأوقاتها.
ولا عن أن الله تعالى قد أمره بقيام الليل، وأوجبه
عليه، فلا يعقل أن يصلي صلاة الليل التي يكون أفضل أوقاتها وقت السحر
القريب من الفجر، ثم ينام بعدها لتفوته صلاة الصبح..
إلى غير ذلك من ملاحظات سجلناها فيما سبق من هذا الكتاب
على روايات تحدثت عن حدوث هذا الأمر في العديد من الموارد..
ولكننا نريد أن نسأل:
لماذا لم يكن هناك إلا ثلاثة أشخاص؟! وأين ذهب، أو أين
ضاع الجيش المؤلف من ثلاثين ألفاً؟! ولماذا لم يسأل أحد منهم عن مكان
وجود رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟! ولماذا تأخر أولئك الثلاثة
أيضاً عن سائر الجيش؟!
وإذا كان الجيش موجوداً، فلماذا لم يوقظ أحد منهم هؤلاء
الخمسة للصلاة؟!.
والحقيقة هي:
أن الجيش كان قد تقدم عليه، كما صرحت به الرواية، حيث
قالت: «فركب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فلحق بالجيش عند زوال
الشمس».
وهذا معناه:
أن المسافة، بين النبي «صلى الله عليه وآله» وبين جيشه
كانت شاسعة جداً، احتاجت إلى ساعات كثيرة قد تزيد على ست ساعات من
السير الحثيث لقطعها، فإن غزوة تبوك كانت في أيام قيظ شديد..
فكيف يترك هذا الجيش نبيّه في قلب الصحراء، مع أربعة
أشخاص فقط، بل مع شخص واحد، ألا يخشون على النبي الأعظم والأكرم «صلى
الله عليه وآله» من عدو، أو من حيوان مفترس، أو من أن يضل الطريق..
ويموت جوعاً وعطشاً؟!
وقد أمعنت هذه الرواية في جرأتها على رسول الله «صلى
الله عليه وآله» حين زعمت: أن النبي «صلى الله عليه وآله» يعترف بأن
الشيطان هو الذي تسبب بنومه عن صلاة الصبح، وذلك حين زعمت: أنه «صلى
الله عليه وآله» قال: «لنغيظن الشيطان كما غاظنا»([13])..
وهذا يتناقض مع حكم العقل، ومع قوله تعالى:
{إِنَّهُ
لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ}([14])..
وآيات كثيرة أخرى..
بالنسبة لما زعم:
من أن ثلاثين ألفاً من الناس رفضوا النزول على الماء،
وواصلوا مسيرهم حتى اضطروا للنزول على غير ماء بفلاة من الأرض، نقول:
أولاً:
لماذا لم يتدخل النبي «صلى الله عليه وآله»، فيأمر جيشه
بالنزول على الماء؟ وكيف جاز له أن يجاريهم ويفرط بثلاثين ألفاً،
ويعرضهم لخطر الموت عطشاً في تلك الفلاة؟
ثانياً:
كيف لم ينتبه أحد من الثلاثين ألفاً إلى صحة مشورة أبي
بكر وعمر، وهم يعرفون أن حياتهم مرهونة بالماء، وخصوصاً في تلك الصحراء
القاحلة؟!
ثالثاً:
إن هذا الجيش نفسه قد سلك هذا الطريق، وعرف مواضع الماء
فيه، وميزها عن غيرها، حين قدم إلى تبوك قبل أيام، فما معنى أن يرفض
ثلاثون ألفاً أن ينزلوا على الماء، وأن يفضلوا عليه النزول في الفلاة،
رغم تذكير أبي بكر وعمر لهم؟!.
فهل اختاروا الإنتحار على الإستمرار في الحياة؟!.
عن أبي الطفيل، وحذيفة، وجبير بن
مطعم، والضحاك:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لما كان ببعض الطريق
مكر به ناس من المنافقين، وائتمروا بينهم أن يطرحوه من عقبة في الطريق.
وكانوا قد أجمعوا أن يقتلوه، فجعلوا يلتمسون غرته، فلما
أراد رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن يسلك العقبة أرادوا أن يسلكوها
معه.
وقالوا:
إذا أخذ في العقبة دفعناه عن راحلته في الوادي، فأخبر
الله تعالى رسوله بمكرهم.
فلما بلغ رسول الله «صلى الله عليه وآله» تلك العقبة
نادى مناديه للناس: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أخذ العقبة فلا
يأخذها أحد، واسلكوا بطن الوادي، فإنه أسهل لكم وأوسع: فسلك الناس بطن
الوادي إلا النفر الذين مكروا برسول الله «صلى الله عليه وآله» لما
سمعوا ذلك استعدوا وتلثموا.
وسلك رسول الله «صلى الله عليه وآله» العقبة، وأمر عمار
بن ياسر أن يأخذ بزمام الناقة ويقودها، وأمر حذيفة بن اليمان أن يسوق
من خلفه.
فبينا رسول الله «صلى الله عليه وآله» يسير من العقبة
إذ سمع حسّ القوم قد غشوه، فنفروا ناقة رسول الله «صلى الله عليه وآله»
حتى سقط بعض متاعه.
وكان حمزة بن عمرو الأسلمي لحق برسول الله «صلى الله
عليه وآله» بالعقبة، وكانت ليلة مظلمة، قال حمزة: فُنوِّر لي في أصابعي
الخمس، فأضاءت حتى جمعت ما سقط من السوط والحبل وأشباههما.
فغضب رسول الله «صلى الله عليه وآله» وأمر حذيفة أن
يردهم، فرجع حذيفة إليهم، وقد رأى غضب رسول الله «صلى الله عليه وآله»
ومعه محجن، يضرب وجوه رواحلهم وقال: إليكم إليكم يا أعداء الله تعالى.
فعلم القوم أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد اطلع
على مكرهم، فانحطوا من العقبة مسرعين حتى خالطوا الناس.
وأقبل حذيفة حتى أتى رسول الله «صلى
الله عليه وآله» فقال:
اضرب الراحلة يا حذيفة، وامش أنت يا عمار، فأسرعوا حتى
استوى بأعلاها، وخرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» من العقبة ينتظر
الناس، وقال لحذيفة: هل عرفت أحداً من الركب، الذين رددتهم؟
قال:
يا رسول الله، قد عرفت رواحلهم، وكان القوم متلثمين فلم
أبصرهم من أجل ظلمة الليل.
قال:
«هل علمتم ما كان من شأنهم وما أرادوا»؟
قالوا:
لا والله يا رسول الله.
قال:
«فإنهم مكروا ليسيروا معي، فإذا طلعت العقبة زحموني
فطرحوني منها، وإن الله تعالى قد أخبرني بأسمائهم، وأسماء آبائهم،
وسأخبركم بهم إن شاء الله تعالى».
قالوا:
أفلا تأمر بهم يا رسول الله إذا جاء الناس أن تضرب
أعناقهم؟
قال:
«أكره أن يتحدث الناس ويقولوا: إن محمداً قد وضع يده في
أصحابه»، فسماهم لهما، ثم قال: «اكتماهم»؛ فانطلق إذا أصبحت، فاجمعهم
لي.
فلما أصبح رسول الله «صلى الله عليه
وآله» قال له أسيد بن الحضير:
يا رسول الله، ما منعك البارحة من سلوك الوادي؟ فقد كان
أسهل من العقبة؟
فقال:
«أتدري يا أبا يحيى، أتدري ما أراد بي المنافقون، وما
هموا به؟
قالوا:
نتبعه من العقبة، فإذا أظلم عليه الليل قطعوا أنساع
راحلتي، ونخسوها حتى يطرحوني عن راحلتي».
فقال أسيد:
يا رسول الله، قد اجتمع الناس ونزلوا، فمر كل بطن أن
يقتل الرجل الذي همَّ بهذا، فيكون الرجل من عشيرته هو الذي يقتله، وإن
أحببت ـ والذي بعثك بالحق ـ فنبئني بأسمائهم، فلا أبرح حتى آتيك
برؤوسهم.
قال:
«يا أسيد، إني أكره أن يقول الناس: إن محمداً قاتل بقوم
حتى إذا أظهره الله تعالى بهم أقبل عليهم يقتلهم».
وفي رواية:
«إني لأكره أن يقول الناس: إن محمداً «صلى الله عليه وآله» لما انقضت
الحرب بينه وبين المشركين وضع يده في قتل أصحابه».
فقال:
يا رسول الله، فهؤلاء ليسوا بأصحاب.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله»؟
قال:
بلى [ولا شهادة لهم].
قال:
«أليس يظهرون أني رسول الله»؟
قال:
بلى. ولا شهادة لهم.
قال:
«فقد نُهِيْتُ عن قتل أولئك»
([15]).
وقال ابن إسحاق في رواية يونس بن
بكير:
فلما أصبح رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال لحذيفة:
«ادع عبد الله» أبي سعد.
(قال
البيهقي:
أظن ابن سعد بن أبي سرح.
وفي الأصل:
عبد الله بن أبي سعد بن أبي سرح، لم يعرف له إسلام كما
نبه إليه في زاد المعاد).
قال ابن إسحاق:
وأبا حاضر الأعرابي، وعامراً، وأبا عمر، والجلاس بن
سويد بن الصامت، وهو الذي قال: لا ننتهي حتى نرمي محمداً من العقبة،
ولئن كان محمد وأصحابه خيراً منا إنا إذاً لغنم وهو الراعي، ولا عقل
لنا وهو العاقل.
وأمره أن يدعو مجمع بن جارية، وفليح التيمي وهو الذي
سرق طيب الكعبة([16])
وارتد عن الإسلام، وانطلق هارباً في الأرض فلا يدرى أين ذهب.
وأمره أن يدعو حصين بن نمير، الذي أغار على تمر الصدقة
فسرقه([17])،
فقال له رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «ويحك، ما حملك على هذا»؟
قال:
حملني عليه أني ظننت أن الله تعالى لم يطلعك عليه، أما
إذا أطلعك عليه، فإنى أشهد اليوم أنك لرسول الله، فإني لم أؤمن بك قط
قبل الساعة، فأقاله رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وعفا عنه بقوله
الذي قاله.
وأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» حذيفة أن يأتيه
بطعمة بن أبيرق، وعبد الله بن عيينة، وهو الذي قال لأصحابه: اشهدوا هذه
الليلة تسلموا الدهر كله، فوالله ما لكم أمر دون أن تقتلوا هذا الرجل،
فدعاه رسول الله «صلى الله عليه وآله» فقال: «ويحك، ما كان ينفعك من
قتلي لو أني قتلت يا عدو الله»؟
فقال عدو الله: يا نبي الله، والله ما تزال بخير ما
أعطاك الله تعالى النصر على عدوك، فإنما نحن بالله وبك، فتركه رسول
الله «صلى الله عليه وآله».
وقال لحذيفة:
«ادع مرة بن الربيع»، وهو الذي ضرب بيده على عاتق عبد
الله بن أبي ثم قال: تمطى، أو قال: تمططي والنعيم كائن لنا بعده، نقتل
الواحد المفرد، فيكون الناس عامة بقتله مطمئنين.
فدعاه رسول الله «صلى الله عليه
وآله» فقال:
«ويحك، ما حملك على أن تقول الذي قلت؟
فقال:
يا رسول الله، إن كنت قلت شيئاً من ذلك فإنك العالم به،
وما قلت شيئاً من ذلك([18]).
فجمعهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» وهم اثنا عشر
رجلاً الذين حاربوا الله تعالى ورسوله، وأرادوا قتله([19])،
فأخبرهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» بقولهم، ومنطقهم، وسرهم
وعلانيتهم، وأطلع الله نبيه «صلى الله عليه وآله» على ذلك، وذلك قوله
عز وجل:
{وَهَمُّوا
بِمَا لَمْ يَنَالُوا}([20]).
ومات الاثنا عشر منافقين محاربين الله تعالى ورسوله.
قال حذيفة كما رواه البيهقي:
ودعا عليهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» فقال:
«اللهم ارمهم بالدبيلة».
قلنا:
يا رسول الله، وما الدبيلة؟
قال:
«شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك»([21]).
وعن حذيفة:
«في أصحابي اثنا عشر رجلاً منافقاً لا يدخلون الجنة حتى
يلج الجمل في سم الخياط، ثمانية يكفيهم الدبيلة: سراج من نار يظهر بين
أكتافهم حتى ينجم من صدورهم»([22]).
قال البيهقي:
وروينا عن حذيفة أنهم كانوا أربعة
عشر([23])
أو خمسة عشر([24]).
ونقول:
إنه لا بد لنا من التعرض لأسماء هؤلاء المجرمين أولاً،
ثم نعطف الكلام إلى أمور أخرى، ربما يكون تسليط الضوء عليها مفيداً
سديداً، فنقول:
قد ذكرت النصوص المتقدمة:
أسماء جماعة زعموا: أنهم هم الذين اشتركوا في المؤامرة
على حياة رسول الله «صلى الله عليه وآله»..
غير أننا نشك كثيراً في صحة هذه الأسماء، لأن النصوص
المختلفة تبين أن ثمة تزويراً متعمداً في هذا المجال.. وأن ثمة مساعِيَ
لإخفاء الأسماء الحقيقية، وطرح أسماء بديلة عنها.
والذي يبدو لنا هو أن هذا التلاعب قد جاء لمصلحة
القرشيين منهم، وإبعاد الشبهة عمن شارك منهم في هذه الفعلة الشنعاء،
والفضيحة الصلعاء، حتى لقد قيل: «ليس فيهم قرشي، وكلهم من الأنصار»([25]).
لكن يكذّب هذا الإدعاء ما روي عن الإمام أبي جعفر محمد
بن علي الباقر «عليهما السلام»: أنهم «ثمانية من قريش، وأربعة من
العرب»([26]).
وقيل:
ستة أو سبعة من قريش، والباقي من أفناء الناس([27]).
وقيل:
إثنا عشر من بني أمية، وخمسة من سائر الناس([28]).
وقيل:
تسعة من قريش، وخمسة من سائر الناس([29]).
تقدمت لائحة بأسماء أشخاص زعموا أنهم هم المنفّرون
برسول الله «صلى الله عليه وآله»، وهم على ما ذكره الطبراني:
1 ـ
معتب بن قشير بن مليل، من بني عمرو بن عوف.
2 ـ
وديعة بن ثابت بن عمرو بن عوف.
3 ـ
جدّ بن عبد الله بن نبيل (نبتل) بن الحارث من بني عمرو
بن عوف.
4 ـ
الحارث بن يزيد الطائي.
5 ـ
أوس بن قيظى، من بني حارثة.
6 ـ
الحارث بن سويد.
7 ـ
سعد بن زرارة من بني مالك بن ماتت.
8 ـ
قيس بن قهد من بني مالك بن ماتت.
9 ـ
سويد من بني بلحبلى.
10 ـ
داعس من بني بلحبلى.
11 ـ
قيس بن عمرو بن سهل.
12 ـ
زيد بن اللصيت.
13 ـ
سلامة بن الحمام. (وهما من بني قينقاع)([30]).
لكن ابن القيّم، والسيوطي، والصالحي الشامي، قد ذكروا
قائمة أخرى، هي التالية:
1 ـ
عبد الله بن أبي (سعد).
2 ـ
سعد بن أبي سرح.
3 ـ
أبو خاطر (حاضر) الأعرابي.
4 ـ
عامر.
5 ـ
أبو عامر (أبو عمر).
6 ـ
الجلاس بن سويد بن الصامت.
7 ـ
مجمع بن حارثة (جارية).
8 ـ
فليح (مليح) التيمي.
9 ـ
طعمة بن أبيرق.
10 ـ
عبد الله بن عيينة.
11 ـ
مرة بن الربيع.
12 ـ
حصين بن النمير([31]).
واللافت هنا:
أن ابن قيّم الجوزية نفسه لا يرتضي صحة هذه القائمة
الثانية، بل أورد عليها بما يلي:
أولاً:
إن «سعد بن أبي سرح» لم يعرف له إسلام..
ونقول:
إن الصالحي الشامي ذكر «عبد الله بن سعد بن أبي سرح»([32]).
ثانياً:
إن عبد الله بن أُبي([33])،
وكذلك الجلاس بن سويد([34])،
كانا قد تخلفا عن غزوة تبوك، فما معنى ذكرهما في جملة المشاركين في
قضية العقبة؟!.
كما أن أبا عامر لم يحضر غزوة تبوك أيضاً، لأنه خرج إلى
مكة، ثم إلى الطائف، ثم إلى الشام، فمات طريداً([35]).
ثالثاً:
إن النبي
«صلى الله عليه وآله»
أسرَّ أسماء المنفِّرين به إلى حذيفة، وكانوا لا يُعْرَفُون. وكان عمر
لا يصلي على من لم يصل عليه حذيفة([36]).
كما أن ثمة إشكالات على القائمة الأولى، أعني قائمة
الطبراني:
فأولاً:
إن هذه القائمة كانت سراً عند حذيفة.
ثانياً:
إن أوس بن قيظى، كان من المتخلفين عن تبوك([37]).
ثالثاً:
إن الذين أرادوا قتل النبي
«صلى الله عليه وآله»
كانوا يطمعون بالحصول على الدنيا، وكانت لهم مكانة تؤهلهم بنظر الناس
إلى طلب هذا الأمر. وكانوا مرهوبي الجانب حتى لقد أخفى حذيفة أسماءهم
خوفاً منهم، ورهبة منه لجانبهم.
والذين وردت أسماؤهم في القائمة لا يملكون أية موقعية
تخولهم ترشيح أنفسهم لهذا الأمر.
ولم يذكروا لنا سبب تعمُّد إخفاء النبي «صلى الله عليه
وآله» لأسمائهم إلا عن بعض أصحابه، فلعله لأجل أنه كان لا يريد أن تنشأ
عن ذلك مشكلة في حياته، حيث يصبح ذلك ذريعة لهم لمحاولة التأثير على من
يتصل بهم، لإخراجه عن دائرة الإيمان، بالإضافة إلى أنه قد يتسبب
بمشاحنات، ومشكلات، وانقسامات عميقة بينهم وبين أقوامهم، وربما يتخذ
ذلك أهل الأهواء ذريعة لإثارة الفتن، والعبث بالبنية الإجتماعية،
والإخلال بتماسكها وبانضباطها..
أما بعد استشهاد رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
فرغم معرفة حذيفة وغيره بأسمائهم، فإنه لم يجرء أحد على التفوه
والإعلان بها. ولا شك في أن هذا التكتم قد كان خوفاً من بطش السلطة بمن
يفشي هذا السر، حيث قد يلحق إفشاؤه أضراراً جسيمة بالإسلام وأهله، لأن
ظواهر الأمور تعطي أن مرتكبي هذه الجريمة لم يكونوا من الناس العاديين،
بل كانت لهم مكانتهم المرموقة، ولهم قوتهم وشوكتهم التي لا مجال لأحد
لمواجهتها.
إلا أن بعض الأسماء الحقيقية قد أفلتت من بين تلك
الأسماء، ربما لأنها كانت هي الأضعف من بين تلك المجموعة..
وممن أفلت اسمهم أبو موسى الأشعري، فقد ورد اسمه في
المصادر التي ألفها الفريق الذي لا يدين بالولاء للحكام كما سيأتي.
لكن المصادر الموالية لهم لم تستطع الإفصاح عن اسمه سوى
ما روي عن أبي يحيى حكيم، قال: كنت جالساً مع عمار، فجاءه أبو موسى،
فقال (يعني عمار): مالي ولك؟.
قال:
ألست أخاك؟
قال:
ما أدري غير أنني سمعت رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
يلعنك ليلة الحملق.
قال:
إنه استغفر لي.
قال عمار:
قد شهدت اللعن، ولم أشهد الإستغفار([38]).
ونقول:
1 ـ
حملق ـ كما في كتب اللغة ـ: فتح عينيه ونظر شديداً([39])،
فإن لم يكن المقصود بها الكناية عن ليلة العقبة، باعتبار أن الحملقة قد
وقعت فيها لكشف حقيقة المعتدين على رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
فهي تصحيف لكلمة العقبة، عمداً، أو سهواً.
ويشير إلى ذلك:
1 ـ
أن الوارد في بعض المصادر هو:
«الجمل» أو «الجبل»، وذلك بملاحظة: أنهم أرادوا تنفير الناقة به «صلى
الله عليه وآله» في الجبل (العقبة)، أو بملاحظة إرادتهم إلقاء النبي
«صلى الله عليه وآله» عن ظهر الجمل من العقبة إلى الوادي([40]).
2 ـ
روى الشيخ المفيد «رحمه الله» هذه الرواية، وفيها: أن
عماراً قال لأبي موسى:
«سمعت
رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
يلعنك ليلة العقبة، وقد هممت مع القوم بما هممت، الخ..»([41]).
3 ـ
أن أبا موسى كان متَّهماً بالنفاق على نطاق واسع، قال
أبو عمر بن عبد البر:
«وكان
لحذيفة قبل ذلك ـ أي قبل ما ظهر منه ـ فيه كلام»([42]).
وقد ذكرت لائحة أخرى بأسماء المجرمين،
في مصادر أخرى لجماعة لا تهتم برضا رموز السلطة، التي حكمت الناس من
دون نص من رسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
ولا تخشى من الجهر بالنقد لمن يستحق النقد، سواء أكان في السلطة، أم في
خارجها..
وقد ذكرت الأسماء في تلك المصادر على النحو التالي:
قال حذيفة فيهم:
1 ـ
أبو بكر.
2 ـ
عمر.
3 ـ
عثمان.
4 ـ
طلحة.
5 ـ
الزبير.
6 ـ
أبو سفيان.
7 ـ
معاوية.
8 ـ
عتبة بن أبي سفيان.
9 ـ
أبو الأعور السلمي.
10 ـ
المغيرة بن شعبة.
11 ـ
أبو موسى الأشعري.
12 ـ
أبو قتادة.
13 ـ
عمرو بن العاص.
14 ـ
سعد بن أبي وقاص([43]).
وفي نص آخر:
الثمانية من قريش هم: (سعد بن أبي وقاص، معاوية، وأبو
بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة). بالإضافة إلى:
15 ـ
عبد الرحمن بن عوف.
16 ـ
أبو عبيد بن الجراح.
والذين هم من غير قريش:
17 ـ
أوس بن الحدثان.
18 ـ
أبو هريرة.
19 ـ
أبو طلحة الأنصاري.
20 ـ
أبو موسى الأشعري([44]).
وذكر ابن جرير بن رستم الطبري:
أن النبي
«صلى الله عليه وآله»
أمر حذيفة أن لا يخبرنا باسم الشيخين الجليلين([45]).
وذكر أبو الصلاح الحلبي:
عثمان، وطلحة، والزبير، وسعداً، وعبد الرحمن بن عوف([46]).
وقد ذكرت مصادر أخرى منها ما ينتمي للفريق المحامي عن
السلطة والحاكم، ومنها ما ينتمي إلى الفريق الآخر أسماء اتخذت صفة
الكناية عن الأسماء الحقيقية.
فمن ذلك نذكر:
1 ـ
ما روي عن الإمام الباقر
«عليه
السلام»
أنه عدَّ منهم: أبا الشرور، وأبا الدواهي، وأبا المعازف، وابن عوف،
وسعداً، وأبا سفيان، وابنه، وفعل، وفعيل، والمغيرة بن شعبة، وأبا
الأعور السلمي، وأبا قتادة الأنصاري([47]).
وزاد في نص آخر:
بعد أن ذكر عدداً من الأسماء المتقدمة عن أكثر من مصدر:
21 ـ
سالم مولى أبي حذيفة.
22 ـ
خالد بن الوليد.
وذكر فيه أيضاً:
أبا المعازف.
23 ـ
وأباه([48]).
وذكر نص آخر بالإضافة إلى بعض
الأسماء المتقدمة:
صاحبي البصرة (يعني: طلحة والزبير).
24 ـ
وأبا مسعود([49]).
ويلاحظ هنا:
أن العدد قد انتهى إلى أربعة وعشرين، وقد جمعناه من
الروايات المختلفة.
وهو ما صرحت به بعض الروايات حيث
ذكرت:
أنهم كانوا أربعة وعشرين([50]).
ونود أن نذكِّر القارئ الكريم:
بأن الله تعالى هو الذي أعلم النبي
«صلى الله عليه وآله»
بأسماء أولئك المجرمين، فأعلم بها حذيفة..
وهذا معناه:
أنه علم غير ميسور للبشر بما هو متوفر لديهم من وسائل.
إذن..
فليس للنبي
«صلى الله عليه وآله»
أن يؤاخذهم..
ولأجل ذلك لم يستجب لطلب حذيفة ـ حينما طلب منه ذلك.
وزعمت رواية الصالحي الشامي
المتقدمة:
أن أسيد بن حضير هو الذي طلب قتل المتآمرين..
ولكننا نشك في صحة ذلك، فإن النبي
«صلى الله عليه وآله»
كان يتحدث مع حذيفة، وعمار، ولم يكن أسيد حاضراً، وقد أمر
«صلى الله عليه وآله»
حذيفة وعماراً بالكتمان، بعد أن جرى بينه وبينهما ذلك، كما تقدم([51])..
بل صرحت بعض الروايات:
بأن حذيفة هو الذي قال للنبي
«صلى الله عليه وآله»
ذلك، فراجع([52])..
وقد زعم حمزة بن عمرو الأسلمي أنه لحق برسول الله
«صلى الله عليه وآله»
بالعقبة.. وأنه قد جمع الذي سقط من المتاع بسبب تنفيرهم برسول الله
«صلى الله عليه وآله»،
بعد أن نوّر الله له أصابعه..
ونقول:
1 ـ
إن هذا مشكوك
فيه، فإن النبي
«صلى الله عليه وآله»
بعد أن أعلمه الله تعالى بالمؤامرة، قد أمر الناس بأن لا يمر منهم أحد
بالعقبة، وأمر الناس كلهم بسلوك بطن الوادي([53]).
2 ـ
إن تنوير أصابع هذا الرجل كلها لا ضرورة له، إذ كان
يكفي تنوير إصبع واحد له بحيث يجعله يضيئ له الدنيا بأسرها..، بل هو لا
يحتاج إلى نور أصلاً، إذ إن حذيفة يقول: إنه سمع حسّ القوم، فالتفت
فرأى قوماً ملثمين، فلم يعرفهم، لكنه عرف رواحلهم([54]).
وهذا معناه:
أن الظلام لم يكن دامساً بحيث يحتاج إلى تنوير خمس
أصابع..
قالوا:
وحين رجوع الجيش من تبوك، كان في طريقهم عقبة صعبة، لا
يجتاز عليها إلا فرد رجل، أو فرد جمل، وكان تحتها هوة مقدار ألف رمح،
فمن تعدى عن المجرى هلك من وقوعه في تلك الهوة.
وقد كانت غزوة تبوك، والعسكر يسير في الليل فراراً من
الحرِّ.
فسبق بعضهم إلى تلك العقبة، وكانوا قد أخذوا دباباً
كانوا هيأوها من جلد حمار، وضعوا فيها حصى، وطرحوها بين يدي الناقة([55]).
ولعلهم إنما وضعوا الحصى في تلك الدباب من أجل أن تصدر
منها أصوات تفاجئ الناقة، وتوجب نفورها، بالإضافة إلى تعثرها بتلك
الدباب..
غير أن النصوص المتقدمة قد ذكرت:
أنه
«صلى الله عليه وآله»
أخبرهم بأن المتآمرين أرادوا أن يقطعوا أنساع ناقته، ثم ينخسوها لكي
تلقيه..
فلعل هذا كان هو التدبير الأول لهم، ثم لما وجدوا أن
النبي
«صلى الله عليه وآله»
قد منع الناس من سلوك طريق العقبة، لم يعد يمكنهم الإقتراب منها،
فهيأوا الدباب، وسبقوه إلى المكان، ثم نفَّروا به الناقة، فسقط بعض
المتاع، ولم يتم لهم ما أرادوا..
ثم إن معظم المصادر قد ذكرت هذه القضية في غزوة تبوك،
لكن هناك سياق آخر يقول: إنها كانت بعد حادثة الغدير في حجة الوداع.
وإنهم إنما فعلوا ذلك خوفاً من أن يأخذ البيعة لعلي
«عليه
السلام»
منهم مرة أخرى في المدينة.
ولا نستطيع أن نجزم بكذب أي من الروايتين، غير أننا
نقول:
إن الأعرف بين المؤرخين سنَّةً وشيعة، هو أنها كانت في
تبوك.
إن هذا النصر الذي سجَّله رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
في تبوك، حيث ظهر لكل أحد رعب قيصر الروم من حركة المسلمين باتجاه
بلاده، بالإضافة إلى أمور أخرى جرت في تبوك وأكَّدت ورسَّخت مكانة
المسلمين، ليس في منطقة الحجاز وحسب، بل في المحيط العربي كله، ثم
تجاوز ذلك أيضاً حتى بلغ بلاد الروم ـ إن ذلك ـ يطرح سؤالاً عن سبب
لجوء هؤلاء الناس إلى هذه المؤامرة..
ولعل الإجابة الأقرب إلى القبول هي:
أن هؤلاء الناس قد رأوا في تبوك تباشير مستقبل عظيم
الأهمية، لا بد من أن يكون لهم نصيب فيه، ومن الواضح أن وجود النبي
«صلى الله عليه وآله»
سيكون مانعاً لهم من التصرف وفق ما تشتهيه أنفسهم، فكيف وهم يرون أنه
لم يزل يؤكد إمامة وخلافة علي
«عليه
السلام»
من بعده، وهم يعلمون أن حالهم مع علي
«عليه
السلام»
سوف لن تختلف عن حالهم مع النبي
«صلى الله عليه وآله»،
فإنه نسخة طبق الأصل عنه..
ولربما أصبحوا يخشون من أن يبادر «صلى الله عليه وآله»
إلى عمل يحرجهم، ويعرقل خططهم الرامية إلى الإستئثار بالأمر من بعده،
فكانت هذه المبادرة المخزية منهم..
وقد ذكرت بعض الروايات:
أن المنافقين كانوا قد دبروا لقتل علي «عليه السلام» في
تبوك كما دبروا لقتل النبي «صلى الله عليه وآله» في العقبة، وذلك بأن
حفروا في طريق علي «عليه السلام» في المدينة حفيرة طويلة بقدر خمسين
ذراعاً، وقد عمقوها ثم غطوها بحصر، ثم وضعوا فوقها يسيراً من التراب،
فإذا وقع فيها كبسوه بالأحجار حتى يقتلوه.
وقد أنجاه الله تعالى من كيدهم بكرامة منه، وعرَّفه
أسماء تلك الجماعة التي فعلت ذلك، وأعلنها له، وكانوا عشرة، كانوا قد
تواطأوا مع الأربعة والعشرين، الذين دبروا لقتل رسول الله «صلى الله
عليه وآله» في العقبة.
ثم تذكر الرواية حديث العقبة، وأن النبي «صلى الله
عليه وآله» قد نزل بإزائها، وأخبر الناس بما جرى على علي «عليه
السلام».. ثم أمرهم بالرحيل، وأمر مناديه فنادى: ألا لا يسبقن رسول
الله «صلى الله عليه وآله» أحد على العقبة ولا يطأها حتى يجاوزها رسول
الله «صلى الله عليه وآله».
ثم أمر حذيفة أن يقعد في أصل العقبة، فينظر من يمر به،
وأمره أن يتشبه بحجر، فقال حذيفة: يا رسول الله، إني أتبين الشر في
وجوه رؤساء عسكرك، وإني أخاف إن قعدت في أصل الجبل، ثم جاء منهم من
أخاف أن يتقدمك إلى هناك، للتدبير عليك، يحسّ بي، فيكشف عني، فيعرفني،
وموضعي من نصيحتك، فيتهمني ويخافني فيقتلني.
إلى أن تذكر الرواية:
أن حذيفة رأى الأربعة والعشرين رجلاً على جمالهم، يقول
بعضهم لبعض: من رأيتموه ها هنا كائناً من كان فاقتلوه، لئلا يخبروا
محمداً بأنهم قد رأونا هنا، فينكص محمد، ولا يصعد هذه العقبة إلا
نهاراً، فيبطل تدبيرنا عليه.
فسمعها حذيفة، واستقصوا فلم يجدوا أحداً.
ثم تذكر الرواية دحرجتهم للدباب، وأن الله تعالى قد حفظ
نبيه «صلى الله عليه وآله» وجاز العقبة، وأرسل حذيفة إليهم، فضرب وجوه
رواحلهم، فنفرت بهم، وسقط بعضهم، فانكسر عضده، وبعضهم انكسرت رجله،
وبعضهم انكسر جنبه.
فلأجل ذلك كان حذيفة يعرف المنافقين.. انتهى ملخصاً([56]).
ونقول:
إنه يستوقفنا في هذه الرواية الأمور التالية:
إن المدينة كانت قرية صغيرة، وكان سكانها قليلين،
وبيوتها متراكمة ومجموعة، غير منتشرة، فإذا كان علي «عليها السلام»
والياً على المدينة، ويمر من ذلك الطريق. فإن كان يمر منه في كل يوم
فمعنى ذلك: أن هذه الحفرة قد حفرت في أقل من يوم واحد، والمفروض: أن
طولها كان خمسين ذراعاً، فكيف تمكنوا من حفر هذا المقدار في هذه المدة
القصيرة؟!
ومن الذي هيأ الأمور بحيث لا يمر أحد من تلك الطريق ممن
يمكن أن يخبر علياً «عليه السلام» بما يجري؟!
ولماذا لم يتساءل الأطفال، والنساء، والرجال الساكنون،
أو الماروّن من هناك عن سبب حفر تلك الحفرة؟!
وهل لم يكن أحد من أهل الإيمان ومن بني هاشم يسكن في
ذلك الحي كله، فيخبر علياً «عليه السلام» بالأمر؟!
وهل كان علي «عليه السلام» مفرطاً في أمور ولايته إلى
حد أن تحفر حفيرة عميقة بطول خمسين ذراعاً في طريق عام، ولا يدري بها؟!
إننا لا نملك جواباً مقبولاً أو معقولاً على هذه
الأسئلة، يخفف من وطأة حيرتنا..
لقد أكدت روايات عديدة على أن النبي «صلى الله عليه
وآله» أمر الناس أن لا يطأوا العقبة حتى يجاوزها هو «صلى الله عليه
وآله».
وهذا إجراء لافت لا بد من فهمه، ومعرفة ما يتوخاه «صلى
الله عليه وآله» منه..
ولنا أن نبادر إلى القول:
بأن المقصود هو فضح المؤامرة، والتمكين من تحديد هوية
فاعليها، فإنه لو سار الجيش بأكمله في تلك الطريق لم يمكن ذلك. ولكان
قد أعطى الفرصة للمتآمرين لارتكاب جريمتهم، ثم يغيبون في خضم تلك
الجموع الغفيرة، لتصبح هي الغطاء الطبيعي لهم، وسيجدون
فيها من يساعدهم على إخفاء أنفسهم، ولربما يدَّعون أن الزحام هو السبب
في سقوط النبي «صلى الله عليه وآله» إلى الوادي، وقد يأتون هم إلى مسرح
جريمتهم بعد ارتكابها في لهفة واستنكار، وبكاء واستعبار، فيساهمون في
تشييع جنازة من قتلوا، ويشاركون في البحث عن القاتل إمعاناً منهم في
المكر والتضليل.
إنه «صلى الله عليه وآله» بإجرائه هذا قد أفردهم عن
الجيش، ووضعهم أمام أعين رقبائه الذين رتبهم في مواضع قريبة، ولم يعد
هناك أي فرصة للإيهام نتيجة للإختلاط بالآخرين، فإن الشبهة ممنوعة.
يضاف إلى ذلك:
أن هذا الإجراء نفسه سوف يوقع الكثيرين في الحيرة،
ويدعوهم للتساؤل عن سببه، فإذا تبين لهم الحق بعد ذلك، فستجدهم مسارعين
لقبوله، وسوف لن يثور أي جدل حول صحته وواقعيته، وسوف توصد الأبواب
أمام الشائعات، والتكهنات، والتشكيكات، بل تبقى الحقيقة بكل حيويتها،
ووضوحها، وسيعرفها الناس، وسينقلونها للأجيال اللاحقة، وهي على ما هي
عليه من الصفاء والنقاء، والإشراق والبهاء، وسيترك هذا الحدث أثره في
العقل والقلب والوجدان، لأنه اقترن بمعجزة نبوية، وتسديد رباني، كان هو
السبب في إبطال كيدهم، وافتضاح أمرهم.
ويلاحظ هنا أيضاً:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أمر حذيفة أن يقعد في
أصل العقبة، وأن يتشبه بحجر، أي أنه يريد منه أن ينطوي على نفسه بطريقة
تظهر للناظر أنه يرى حجراً، ولا يرى إنساناً.
وذلك لأن الوقت كان ليلاً، وكان المطلوب منه هو أن
يتعرف على أشخاص المتآمرين، ولا يتيسر له ذلك في الليل إلا إذا كان
قريباً جداً من الهدف حتى لو كان نور القمر موجوداً، ولو في بعض
درجاته.. وقد كان «صلى الله عليه وآله» يعرف كما كان حذيفة يعرف أيضاً:
أن هؤلاء المجرمين سوف لن يمكّنوا احداً من اقتفاء اثرهم، أو التعرف
على اشخاصهم، وأنهم سوف يتخلصون من كل من يصادفونه بالقتل، إن لم
يمكنهم ابعاده، أو ابعاد أنفسهم عن الأنظار..
وقد قال حذيفة لرسول الله «صلى الله
عليه وآله»:
«إني اتبين الشر في وجوه رؤساء عسكرك»، ثم ذكر له: أنه
يخشى ان يراه هؤلاء الرؤساء المتآمرون ويقتلوه..
وهذا يدل على عدم صحة الرواية التي تتضمن اسماء مجهولة،
لا يعرف عنها احد شيئاً..
غير أن هذه الحقيقة ستكون مؤلمة جداً، وتجعل الشجى
يعترض حلق الإنسان المؤمن، وسيندى جبينه الماً وخجلاً من أن يكون
الرؤساء هم الأعداء والمتآمرون، وليس لنا إلا ان نقول:إنا لله وإنا
اليه راجعون.
([1])
أي: فقد زادهم وافتقروا.
([2])
أي: الناقة التي ورم ضرعها، والتي تقرّح إحليلها أو انسد فإذا
كان ذلك قيل بها رَفَقٌ أو ناقة رَفِقَة.
([3])
كذا في المصدر وهو جمع صاع كما في مجمع البحرين.
([4])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص462و463 عن مسلم وإسحاق بن راهويه، وأبي
يعلى، وأبي نعيم، وابن عساكر، والواقدي، والمغازي للواقدي ج3
ص1083 وراجع: إمتاع الأسماع ج2 ص70 و71 وج5 ص151 و 152وج9 ص264
و 265.
([5])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص463 وج 8 ص233 عن ابن سعد، وابن حزم،
والواقدي وغيرهم، وراجع: تذكرة الفقهاء (ط.ج) ج4 ص388 و (ط.ق)
ج1 ص190وفتح العزيز للرافعي ج4 ص450 والمجموع للنووي ج4 ص361
والمبسوط للسرخسي ج1 ص237 وج10 ص75 والجوهر النقي ج3 ص150
وكشاف القناع للبهوتي ج1 ص627 والمحلى لابن حزم ج5 ص25 وج7
ص149وتلخيص الحبير ج4 ص450 وسبل السلام ج2 ص40 ونيل الأوطار ج3
ص256 ومسند أحمد ج3 ص295 وسنن أبي داود ج1 ص276 والسنن الكبرى
للبيهقي ج3 ص152ومجمع الزوائد ج2 ص158والمصنف للصنعاني ج2 ص532
والمصنف لابن أبي شيبة ج2 ص342 ومنتخب مسند عبد بن حميد ص345
وصحيح ابن حبان ج6 ص456 و 459 والمعجم الأوسط ج4= = ص185
ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ج2 ص435 وتنقيح التحقيق في
أحاديث التعليق للذهبي ج1 ص272 ونصب الراية ج2 ص223 وموارد
الظمآن ج2 ص265 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج1 ص212 وكنز
العمال ج8 ص236 وأضواء البيان للشنقيطي ج1 ص276 وشرح السير
الكبير للسرخسي ج1 ص241 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص643 والعبر
وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص50 وإمتاع الأسماع للمقريزي ج2
ص70.
([6])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص464 عن ابن إسحاق، وابن عقبة، وراجع:
السنن الكبرى للبيهقي ج3 ص152و أضواء البيان للشنقيطي ج1 ص277
والثقات لابن حبان ج2 ص98 وإمتاع الأسماع ج5 ص113 وراجع:
السيرة الحلبية ج2 ص265 وج3 ص119 والدرر لابن عبد البر ص242
وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص373 والكامل في التاريخ ج2 ص281
والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق1 ص224 والسيرة النبوية لابن
هشام ج4 ص953 وعيون الأثر ج2 ص260.
([7])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص465 وفي هامشه عن: الطـبراني في الكبـير
ج11 = = ص301 وابن حبان، وذكره الهيثمي في الموارد (1706)
وانظر المجمع ج6 ص193 والبيهقي في الدلائل ج6 ص155 وابن كثير
في البداية ج6 ص186 وراجع: مناقب الإمام أمير المؤمنين «عليه
السلام» للكوفي ج1 ص92 ومسند أحمد ج6 ص20 والآحاد والمثاني ج4
ص132 وصحيح ابن حبان ج10 ص535 والمعجم الكبير ج18 ص301 وكتاب
الدعاء للطبراني ص265 ومسند الشاميين للطبراني ج2 ص68 وموارد
الظمآن ج5 ص351 وراجع: كنز العمال ج9 ص70 وإمتاع الأسماع ج2
ص53 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص124.
([8])
إمتاع الأسماع ج5 ص151 وج 9 ص265 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص463
والمغازي للواقدي ج2 ص417 و425 وج3 ص1038.
([9])
سبل الهدى والرشاد جص464 عن الواقدي، وأبي نعيم والمغازي
للواقدي ج3 ص1040 والسيرة
الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص112وإمتاع الأسماع ج2 ص72 وج5
ص98.
([10])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص464 و465 عن الواقدي وابن اسحاق
والمغازي للواقدي ج3 ص1039 ومعجم البلدان ج5 ص135وتاريخ الأمم
والملوك ج2 ص373 والبداية والنهاية ج5 ص23 وإمتاع الأسماع ج5
ص113 وعيون الأثر ج2 ص260 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص32.
([11])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص465 وإمتاع الأسماع ج2 ص72 وج5 ص114
وراجع: البحار ج21 ص250.
([12])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص465 عن أبي نعيم والواقدي، وإمتاع
الأسماع ج2 ص73 وج5 ص107.
([13])
تهذيب الكمال للمزي ج21 ص81 وميزان الإعتدال للذهبي ج3 ص148
وتهذيب التهذيب ج7 ص322 وإمتاع الأسماع ج2 ص72 وج 9 ص98
والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص112 وسبل الهدى والرشاد
ج5 ص464.
([14])
الآية 99 من سورة النحل.
([15])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص466و467 عن أحمد، والبيهقي، وابن سعد،
وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، ومحمد بن إسحاق، والواقدي، وقال في
هامشه: أخرجه البيهقي في الدلائل ج5 ص257 وانظر المغازي
للواقدي ج3 ص1043 و1044 والدر المنثور ج3 ص259 عن ابن أبي
حاتم، وأبي الشيخ، والبيهقي في الدلائل، وابن كثير في البداية
ج5 ص19 وخلاصة عبقات الأنوار ج9 ص30 وإمتاع الأسماع ج2 ص75
والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص121 والصوارم المهرقة
للتستري ص7 وكتاب الأربعين للشيرازي ص135والبحار ج21 ص247
وإعلام الورى ج1 ص245 .
([16])
المعارف لابن قتيبة ص343 والبداية والنهاية ج2 ص367 وإمتاع
الأسماع ج2 ص76 وعيون الأثر ج1 ص75 والسيرة النبوية لابن كثير
ج1 ص275.
([17])
المعارف لابن قتيبة ص343 وإمتاع الأسماع ج2 ص76 والإصابة (ط
دار الكتب العلمية) ج2 ص80.
([18])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص467 ودلائل النبوة للبيهقي ج5
ص258وإمتاع الأسماع ج14 ص345.
([19])
سبل الهدى والرشاد 5 ص468 ومجمع البيان ج5 ص91، وتفسير القرآن
للصنعاني ج2 ص372 و 373 والبداية والنهاية ج5 ص19.
([20])
الآية 74 من سورة التوبة.
([21])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص467 و 468 ودلائل النبوة للبيهقي ج5
ص258 وراجع: العمدة لابن البطريق ص341 والصراط المستقيم ج3 ص45
وكتاب الأربعين للشيرازي ص137 وخلاصة عبقات الأنوار ج9 ص30
والمعجم الأوسط ج8 ص102 وتخريج الأحاديث والآثار للزيلعي ج2
ص84 وتفسير البغوي ج2 ص307 والجامع لأحكام القرآن ج8 ص207
وتفسير القرآن العظيم ج2 ص387 والدر المنثور ج3 ص260 وتفسير
الآلوسي ج10 ص139 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص648 والبداية
والنهاية ج5 ص25 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص36 والسيرة
الحلبية ج3 ص121.
([22])
سبل الهدى والرشاد ج5 ص468 عن مسلم وقال في هامشه: أخرجه مسلم
في صفات المنافقين (9) وأحمد ج5 ص390 والبيهقي في الدلائل ج5
ص261 وفي السنن الكبرى ج8 ص198 وانظر البداية ج5 ص20.
وراجع: العمدة لابن البطريق ص332 و 334 و 337 وكتاب الأربعين
للشيرازي ص136و ص138ومكاتيب الرسول ج1 ص606 وصحيح مسلم ج8 ص122
والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص198 وشرح مسلم للنووي ج17 = = ص125
والديباج على مسلم ج6 ص137 والآحاد والمثاني ج2 ص466 والجامع
الصغير ج2 ص225 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص387 وتاريخ الإسلام
للذهبي ج2 ص649 والبداية والنهاية ج5 ص26 والسيرة النبوية لابن
كثير ج4 ص37 وتقوية الإيمان لمحمد بن عقيل ص79. وراجع: المحلى
لابن حزم ج11 ص220والعمدة لابن البطريق ص333 وصحيح مسلم
النيسابوري ج8 ص123و الديباج على مسلم لجلال الدين السيوطي ج6
ص137.
([23])
دلائل النبوة للبيهقي ج5 ص258 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص468 عنه،
وعن السيرة النبوية لدحلان (بهامش الحلبية) ج2 ص375 والبداية
والنهاية ج5 ص26 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص37 وراجع:
الخصال ص398 والمسترشد للطبري ص595 والبحار ج31 ص522.
([24])
دلائل النبوة للبيهقي ج5 ص258 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص468
والمغازي للواقدي ج3 ص1042و1044 وعن السيرة الحلبية ج3 ص162
ومجمع البيان ج5 ص51 والبداية والنهاية ج5 ص19 و 26
وعن السيرة النبوية (بهامش الحلبية) ج2 ص375 والصراط
المستقيم ج3 ص44 والخصال ج2 ص499 والسيرة النبوية لابن كثير ج4
ص37 وراجع: المسترشد للطبري ص595.
([25])
الدر المنثور ج3 ص260 عن ابن سعد، والمنار ج10 ص553 وراجع:
مكاتيب الرسول ج1 ص599 وتفسير الآلوسي ج10 ص139 وتاريخ
مدينة دمشق ج12 ص277 وتهذيب الكمال ج5 ص505 وإمتاع الأسماع ج9
ص328.
([26])
راجع: جمع الجوامع ج2 ص70 ومجمع البيان ج5 ص51 والبرهان
(تفسير) 2 ص540و245 والتبيان ج5 ص303 والصراط المستقيم ج1 ص316
وروح المعاني ج10 ص139 والبحار ج17 ص184.
([27])
البحار ج21 ص233و 248 وج31 ص631 ومكاتيب الرسول ج1 ص599.
([28])
الخصال ص398 والبحار ج21 ص222 وج 31 ص522 عن الخصال.
([29])
البحار ج28 ص100 والدرجات الرفيعة للسيد على خان ص299 والفوائد
الرجالية للسيد بحر العلوم ج2 ص175 وطرائف المقال ج2 ص207.
([30])
مكاتيب الرسول ج1 ص600 عن المنار ج10 ص555 عن الطبراني، وراجع:
= = تفسير القرآن العظيم ج2 ص387 والمعجم الكبير للطبراني ج3
ص166 ـ 167.
([31])
راجع: مكاتيب الرسول ج1 ص600 والدر المنثور ج3 ص260 وسبل الهدى
والرشاد ج10 ص262.
([32])
زاد المعاد ج3 ص8 و 9 والدر المنثور ج3 ص259 وسبل الهدى
والرشاد ج5 ص467.
([33])
الحديث عن أنه قد عاد مع جماعته إلى المدينة.
([34])
أسد الغابة ج1 ص292.
([35])
تقدم ذلك في بداية الحديث عن غزوة تبوك .
([36])
راجع فيما تقدم: زاد المعاد ج3 ص8 و 9 ومكاتيب الرسول ج1 ص600.
([37])
الدر المنثور ج3 ص247 ومكاتيب الرسول ج1 ص601 عنه .
([38])
الكامل لابن عدي ج2 ص772 ومكاتيب الرسول ج1 ص604 وكنز العمال
ج13 ص608 وتاريخ مدينة دمشق ج32 ص93.
([39])
راجع: أقرب الموارد ج1 ص233 ومستدرك سفينة البحار ج8 ص211
وكتاب العين للفراهيدي ج3 ص322 والصحاح للجوهري ج4 ص1465 ومعجم
مقاييس اللغة ج2 ص147 ولسان العرب ج10 ص69 والقاموس المحيط ج3
ص224وتاج العروس ج13ص99.
([40])
راجع: كنز العمال ج13 ص608 وتاريخ مدينة دمشق ج32 ص93 ولسان
الميزان ج5 ص290 وتنزيه الشريعة المرفوعة ج2 ص9 واللآلي
المصنوعة ج1 ص391.
([41])
الأمالي للشيخ الطوسي ص184 (182) والبحار ج33 ص305 و 306
ومكاتيب الرسول ج1ص605.
([42])
الإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج4 ص175و(ط دار الجيل) ج4 ص1764
ومكاتيب الرسول ج1 ص603.
([43])
البحار ج82 ص267وج28 ص100.
([44])
البحار ج28 ص100 ومكاتيب الرسول ج1 ص102 عن الصراط المستقيم ج3
ص44 وطرائف المقال ج2 ص207.
([45])
المسترشد ص591 ومكاتيب الرسول ج1ص606 عنه.
([46])
تقريب المعارف ص357 والبحار ج31 ص311 وج32 ص218 ومكاتيب الرسول
ج1 ص601 .
([47])
مكاتيب الرسول ج1 ص602 والصراط المستقيم ج3 ص44 عن مسند
الأنصار.
([48])
الخصال ج2 ص499 والبحار ج21 ص223.
([49])
المسترشد للطبري ص596.
([50])
البحار ج21 ص231 والتفسير المنسوب للإمام العسكري «عليه
السلام» ص380 و 389 والإحتجاج ج1 ص128.
([51])
الدر المنثور ج3 ص259 عن البيهقي في الدلائل.
([52])
مجمع البيان ج5 ص46 والبحار ج21 ص196و 234 عنه وعن الخرايج
والجرايح.
([53])
راجع: البحار ج17 ص184 ومجمع البيان ج5 ص51 وعن الإحتجاج ج1
ص129 وتفسير العسكري ص380 ـ 389
([54])
الدر المنثور ج3 ص259 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص466 والسنن
الكبرى للبيهقي ج9 ص33.
([55])
البحار ج28 ص99 و 100 وج37 ص115و 135
ومكاتيب الرسول ج1 ص602 عنه.
([56])
راجع: البحار ج21 ص223 ـ 232 والإحتجاج ج1 ص116 ـ 132 وج1 ص64
ـ 65 والتفسير المنسوب للإمام العسكري ص380 ـ 389.
|