في حدود الزمان والمكان
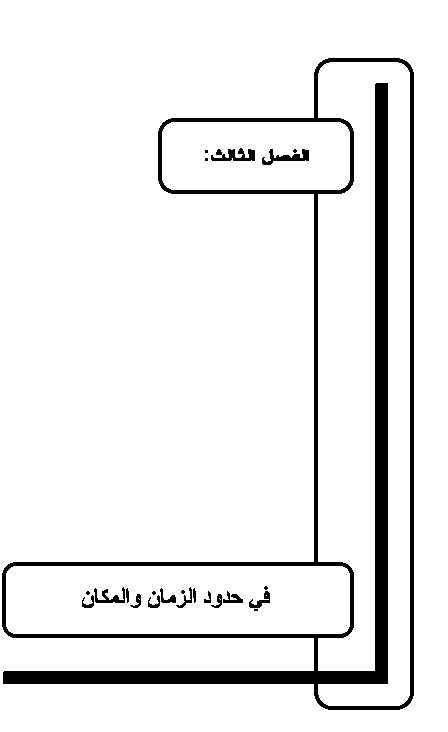
إلفات
النظر إلى أمرين:
وقبل أن نواصل الحديث، فيما نريد التأكيد عليه،
نلفت النظر إلى أمرين:
فقد اختلفت الروايات حول المكان الذي أورد فيه
النبي «صلى الله عليه وآله» خطبته هذه في حجة الوداع. فذكرت طائفة
منها: أن ذلك كان في عرفات.
وفي إحدى الروايات تردد فيها الرواي بين عرفات
ومنى.
وهناك طائفة من الروايات عبّرت بـ «المسجد»([1]).
وسكتت روايات أخرى عن التحديد. مع أنها جميعاً قد
تحدثت عن حدوث فوضى وضجيج، لم يستطع معه الراوي أن يسمع بقية كلام
الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله»؛ وتوجد روايات أشارت إلى عدم
فهم الراوي، ولكنها
لم تشر إلى الضجيج.
فهل كرر النبي «صلى الله عليه وآله» ذلك في عدة
خطب، في المواضع المختلفة؟! فكان يواجه بالضجيج والفوضى!! ويكون
المقصود بالمسجد، هو: المسجد الموجود في منى، أو عرفة؟! إن لم يكن
ذِكْرُ مِنى اشتباهاً من الراوي. أم أنه موقف واحد، اشتبه أمره على
الرواة والمؤرخين؟!
أم أن ثمة يداً
تحاول التلاعب والتشويش بهدف طمس الحقيقة، وإثارة الشبهات حول هذا
الموضوع الهام والحساس جداً. ألا وهو موضوع الإمامة بعد رسول الله
«صلى الله عليه وآله»؟!
قد يمكن ترجيح احتمال تعدد المواقف، التي أظهرت
إصرار فئات الناس على موقف التحدي، والخلاف. وذلك بسبب تعدد
الناقلين، وتعدد الخصوصيات والحالات المنقولة.
وقد صرحوا بأنه «صلى الله عليه وآله» قد خطب في
حجته تلك: خمس خطب. واحدة في مكة، وأخرى في عرفات، والثالثة يوم
النحر بمنى، ثم يوم النفر بمنى، ثم يوم النفر الأول.
وحتى إن كان ذلك قد جصل في موقف واحد، فإن الذي
نرجحه هو أن يكون ذلك في عرفات..
وستأتي بعض الروايات التي صرحت:
بأن الله تعالى أمر نبيه «صلى الله عليه وآله»
بإبلاغ أمر الإمامة في عرفات، ولم تنزل العصمة، ثم في مسجد الخيف
ولم تنزل العصمة، ثم في كراع الغميم ولم تنزل، ثم نزلت في غدير خم،
ثم نزلت وهو في طريقه إلى المدينة..
فلعل النبي «صلى الله عليه وآله» كان يبادر إلى
خطبة الناس في كل مرة، فإذا أحس الناس انه يريد أن يصرح بالأمر
واجهوه بالضجيج المانع له من أداء مهمته، فلما نزلت العصمة:
{واللهُ
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}([2])
لم يجرؤ أحد على شيء من ذلك.
قد ذكرت الروايات أنه «صلى الله
عليه وآله» قال:
«كلهم من قريش»..
والسؤال هو:
هل قال رسول الله «صلى الله عليه وآله» ذلك حقاً؟!
وإذا كان قد قاله، فما هو السبب في ذلك؟
ألا يمكن أن يعتبر بعض قاصري النظر أن ذلك نوع من
التخفيف من لهجة رفض المنطق القبلي؟
أضف إلى ذلك:
أن
ما تقدم من حقيقة الموقف الظالم لقريش، ومن هم على رأيها،
وخططهم التي تستهدف تقويض حاكمية خط الإمامة،
قد يشجع على استبعاد صدور كلمة
«كلهم من قريش»
منه «صلى الله عليه وآله».. وترجيح أن تكون
العبارة التي لم يسمعها جابر بن سمرة، وأنس، وعمر بن الخطاب، وعبد
الملك بن عمير، وأبو جحيفة، بسبب ما أثاره المغرضون من ضجيج،
هي
عبارة:
«كلهم من بني هاشم».
كما ورد في بعض النصوص([3]).
وهي الرواية التي استقر بها
القندوزي الحنفي، على أساس:
أنهم «لا يحسّنون خلافة بني هاشم»([4]).
غير أننا نقول:
إننا نرجح أن
يكون «صلى الله عليه وآله» قد قال الكلمتين معاً،
أي
أنه «صلى الله عليه وآله» قال: «كلهم من قريش، كلهم من بني هاشم».
ويكون ذكر الفقرة الأولى توطئة وتمهيداً لذكر الثانية.
ولكن قريشاً قد عرفت ما يرمي إليه «صلى الله عليه
وآله»، خصوصاً بعد أن ذكر لهم حديث الثقلين،
فثارت ثائرتها هي وأنصارها، وعجوا وضجوا، وقاموا وقعدوا!!
وإلا.. فإن قريشاً، ومن يدور في فلكها لم يكن
يغضبهم قوله «صلى الله عليه وآله»: «كلهم من قريش» بل ذلك يسرهم،
ويفرحهم، لأنه هو الأمر الذي ما فتئوا يسعون إليه بكل ما أوتوا من
قوة وحول، ويخططون ويتآمرون، ويعادون،
ويحالفون من أجله، وعلى
أساسه،
فلماذا الهياج والضجيج؟! ولماذا الصخب والعجيج، لو كان الأمر هو
ذلك؟!.
ولا نشك في أن طائفة الأخيار، والمتقين الأبرار من
صحابة النبي «صلى الله عليه وآله» كانت تلتزم بأوامره «صلى الله
عليه وآله»، وتنتهي بنواهيه، وتسلم له «صلى الله عليه وآله» في كل
ما يحكم ويقضي به.
ولكن هؤلاء كانوا فئة قليلة إذا قيست بالفئة
الأخرى، المتمثلة بأصحاب
الأهواء، وطلاب اللبانات، وذوي الطموحات، ممن لم يسلموا، ولكنهم
غلبوا على أمرهم، فاستسلموا، وأصبح كثير منهم يتظاهر بالورع،
والدين والتقوى، والطاعة والتسليم لله، ولرسوله، متخذاً ذلك ذريعة
للوصول إلى مآربه، وتحقيق أهدافه.
أما هؤلاء، الذين كانوا يظهرون خلاف ما يبطنون،
ويسرون غير ما يعلنون، فقد كان لا بد من كشف زيفهم وإظهار خداعهم
بصورة أو بأخرى.
وقد رأينا:
كيف أن هؤلاء الذين كانوا يتبركون بفضل وضوء رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، وحتى ببصاقه، ونخامته، ويدّعون الحرص
على امتثال أوامر الله سبحانه بتوقيره، وبعدم رفع أصواتهم فوق صوته([5])،
وبالتأدّب
معه، وبأن لا يقدموا بين يدي الله ورسوله و..
و..
لقد رأينا أن هؤلاء بمجرد إحساسهم بأنه «صلى الله
عليه وآله» يريد الحديث عن الأئمة الاثني عشر، وبيان مواصفاتهم
ـ
ويتجه
نحو
تحديدهم بصورة أدق، وأوفى وأتم
ـ كيف ثارت ثائرتهم. وأن خشيتهم من إعلان
إمامة من لا يرضون إمامته، وخلافة من يرون أنه قد وترهم، وأباد
خضراءهم في مواقفه المشهورة،
دفاعاً عن الحق والدين ـ ألا وهو علي أمير المؤمنين «عليه السلام»
ـ إن ذلك ـ قد أظهر حقدهم، فعلا
ضجيجهم، وزاد صخبهم، والتعبيرات
التي وردت في الروايات واصفة حالهم، هي مثل:
«ثم لغط القوم وتكلموا»([6]).
فلم أفهم قوله بعد «كلهم»، فقلت لأبي: ماذا قال؟! الخ..
أو:
«وتكلم الناس فلم أفهم»([7]).
أو:
«وضج الناس»([8]).
أو:
«فقال كلمة أصمّنيها الناس»([9]).
أو:
«صمّنيها الناس»([10]).
وفي نسخة:
«صمّتنيها الناس»([11]).
أو:
«فصرخ الناس، فلم أسمع ما قال»([12]).
أو:
«فكبر الناس، وضجوا»([13]).
أو:
«فجعل الناس يقومون، ويقعدون»([14]).
نعم،
لقد كان هذا هو
موقفهم من الرسول، وهم الذين يدعي البعض لهم مقام العصمة عن كل
ذنب، ويمنحهم وسام الاجتهاد في الشريعة والدين (!!).
وتوضيحاً لما جرى نقول:
لقد أعلن النبي «صلى الله عليه
وآله» في سنة عشر من الهجرة:
أنه يريد الحج، وأرسل إلى الآفاق يخبرهم ويدعوهم
إلى ذلك.
ونفر إليه الناس سراعاً من كل حدب وصوب واجتمعت في
ذلك الموسم عشرات الألوف من كل بلد وحي وقبيلة، ليحجوا مع أكرم
مخلوق، وأفضل نبي، ثم يرجعون إلى
بلادهم
من سفر محفوف بالأخطار، وبعد طول انتظار، ويحدثونهم
بما جرى لهم وصار.
وسيصغي الناس إليهم بشغف وبتلذذ، فإن للحجاج
أحاديثهم وذكرياتهم، التي يرغب الناس في سماعها حتى لو كانت لا
تعني لهم شيئاً في الظروف العادية، فكيف إذا كانت هذه
الأحاديث
لها
علاقة بأفضل وأكمل، وأقدس، وأعزِّ،
وأغلى، وأشرف إنسان في الوجود؟ وسيحدثونهم عن كل لفتة وبسمة، وعن
كل كلمة وحركة، وغير ذلك مما لا بد أن يبقى محفوراً في قلوبهم..
طيلة حياتهم..
أما إذا حدث أمام أعينهم ما لم يكن في الحسبان،
وكان الحدث
قد صنعه
أناس يدَّعون
القرب منه «صلى الله عليه وآله»، والإثرة
لديه، فإن ذلك سوف يكون له وقع الصاعقة عليهم، خصوصاً إذا وجدوا
فيه مساساً بقداسته، وتقويضاً لهيبته، وإبطالاً لتدبيره «صلى الله
عليه وآله»..
نعم..
لقد حج النبي «صلى الله عليه وآله»، في تلك السنة،
فاجتمع إليه مائة ألف وأربعة عشر ألفاً، أو مائة وعشرون ألفاً، أو
تسعون ألفاً، أو سبعون ألفاً.. ليحجوا معه، وقيل غير ذلك..([15]).
وأما قول بعضهم:
«إنهم كانوا أربعون ألفاً»([16])،
فلعله نظر إلى من سار مع النبي «صلى الله عليه وآله» من المدينة،
لا من اجتمع معه في مكة وفي المشاعر ممن جاء من مختلف البلاد. كما
يشير إليه قولهم: وقد كان هناك من أصحابه نحو من أربعين([17])ألفا.
وكان معظم الناس بمن فيهم سكان مكة وما والاها قد
أسلموا، أو أرسلوا وفوداً إلى المدينة ليعلموه بإسلامهم بعد فتح
مكة، وبالتحديد في سنة تسع ـ سنة الوفود ـ وسنة عشر.
وأما المسلمون عدا هؤلاء، ومنهم أهل المدينة
أنفسهم، وشراذم قليلة موزعة في محيط المدينة، أو في غيرها فكانوا
قلة قليلة جداً، حتى إن النبي «صلى الله عليه وآله»، قال لهم في
سنة ست:
«اكتبوا لي كل من تلفظ بالإسلام»
فكتب له حذيفة ألفاً وخمس مئة رجل..([18]).
وفي رواية أخرى:
«ونحن ما بين الست مئة إلى السبع مئة»([19]).
ولا شك أن فيهم من كان صحيح الإيمان، ومنهم من لا
يبالي بأمر الدين، بل يهتم بمصالحه الشخصية، وفيهم الهمج الرعاع
الذين يميلون مع كل داع، وينقادون لكل راع، وفيهم المدخول والمنافق
قال تعالى:
{وَمِمَّنْ
حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ
المَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ}([20]).
ومن الواضح:
أن الذين تلفظوا بالإسلام آنئذٍ كانوا منتشرين في
المدينة وحولها، وفي الحبشة أيضاً، وفي غير ذلك من المناطق.
وقد فرض الإسلام وجوده، وهيبته في تلك السنين التي
كانت زاخرة بالتحديات، وسمع به القاصي والداني..
وكان المسلمون في المدينة، فريقين:
أحدهما:
الأنصار، وهم أهل المدينة أنفسهم.
والآخر:
القرشيون المهاجرون من مكة ـ بصورة عامة ـ.
ومن البديهي:
أن جميع الناس لم يحجوا مع رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، إذ لا يعقل أن يتركوا جميعهم مواشيهم، وزراعاتهم،
وبيوتهم، وديارهم خاوية من كل أحد، فإن ذلك يجعلها عرضة للمتربصين
للسلب والغارة في ذلك المجتمع الذي يرى أن ذلك من وسائل عيشه.
كما أن من الواضح:
أن الناس كانوا بين محبين عرفوا الحق، والتزموا به،
وبين مناوئين اختاروا طريق النفاق والتآمر الخفي، وما أكثر هؤلاء،
أي أن أفاضل الصحابة وأماثلهم من أمثال سلمان، وعمار، والمقداد،
وأبي ذر، وأبي الهيثم بن التيهان، وبني هاشم، وسواهم، كانوا من
محبي علي، ومن أنصاره.
وكان المهاجرون هم الذين يناوئون علياً «عليه
السلام»، ويسعون في إبطال أمره، ويدبرون لإبعاد الخلافة عنه بعد
رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وقد تعاهدوا وتعاقدوا على ذلك..
وكان المراقب لتصرفاتهم في مختلف الموارد يدرك مدى
انحرافهم عن الإمام علي «عليه السلام»، وأنهم تكتل واضح المرامي
والأهداف، ظاهر التباين والاختلاف، لا مجال لأن يفكر بالإنصياع
للتوجيهات النبوية، ولا حتى للقرارات الإلهية فيما يرتبط بأمر
الإمامة والخلافة في أي من الظروف والأحوال..
وقد حج مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» من
المهاجرين الذين هم في هذا الإتجاه بضع عشرات، قد لا يصلون إلى
المئات.. ولكن كان فيهم رجال مجربون، كانوا على درجة كبيرة من
الحنكة والدهاء، وكان ثقلهم الحقيقي في مكة، التي أظهرت في السنة
الثامنة من الهجرة، الإستسلام للإسلام، بالإضافة إلى ما حولها من
البلاد والعباد، الذين يخضعون لنفوذها، ويلتقون في مصالحهم معها..
ولأجل ذلك وجد المهاجرون الطامحون، في قريش، وفي
مكة وما والاها، عضداً قوياً، وسنداً لهم، شجعهم على مواجهة رسول
الله «صلى الله عليه وآله»، بهذه الحدة والشدة التي سلفت الإشارة
إليها..
وبعد أن فعلوا فعلتهم الشنيعة تلك، وظنوا أنهم قد
ربحوا معركتهم ضد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، بمنعهم إياه من
الإعلان على الحجيج تنصيب علي في مقام الإمامة، بما أثاروه من صخب
وضجيج، كان لا بد لهم من التوجه نحو محاولة غسل هذا العار عنهم،
ولو بادعاء أنها مجرد غلطة صدرت، وقد ندم مرتكبوها على ما فرط
منهم، وقد يدَّعون: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد عفا عنهم
وسامحهم. ثم قرَّبهم إليه حتى جعلهم موضع سره، وأوقفهم على ما دبره
وقرره..
وقد يدَّعون أيضاً:
أنه أعلمهم بأن ما أراد النبي «صلى الله عليه وآله»
بيانه في عرفات وسواها لم يكن هو ولاية وإمامة علي «عليه السلام».
إلى غير ذلك مما قد يكون سبباً في بلبلة الأفكار، الذي قد يسهم في
تضييع الحق..
فجاء التخطيط النبوي الحكيم ليقضي، بأن يخرج النبي
«صلى الله عليه وآله» من مكة فور انتهاء مراسم الحج مباشرة، ومن
دون إبطاء أو تفريط ولو بساعة، بل دقيقة واحدة من الوقت، فنفر في
اليوم الثالث عشر من منى بعد الزوال([21]).
ولم يطف بالبيت، ولا زاره كما أسلفناه([22]).
وإن كانت بعض المصادر قد زعمت خلاف ذلك([23]).
وذلك، لأن أي تأخير، سوف يكون معناه أن يخرج أشتات
من الناس إلى بلادهم، ولا يتمكن النبي «صلى الله عليه وآله»، من
إيصال ما يريد إيصاله إليهم..
وحين يخرج النبي «صلى الله عليه وآله» معهم فمن
الطبيعي أن يتقيد الناس في مسيرهم بمسير رسول الله، والكون في
ركبه، إما حياءً، أو طلباً لليسر والأمن، والبركة، والفوز بسماع
توجيهاته.
هذا..
وقد قطع «صلى الله عليه وآله» المسافة ما بين مكة
والجحفة، حيث غدير خم، وهي عشرات الأميال، في أربعة أيام فقط، ثم
يأتي التهديد الإلهي للمتجرئين بالعودة إلى نقطة الصفر، وخوض حروب
طاحنة معهم تشبه حرب بدر وحنين،
{وَإِن
لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ واللهُ يَعْصِمُكَ
مِنَ النَّاسِ}([24]).
فجمعهم «صلى الله عليه وآله» في غدير خم، ونصب علياً «عليه السلام»
هناك إماماً للأمة، وبايعه حتى أشد الناس اعتراضاً على رسول الله
«صلى الله عليه وآله» في عرفات وغيرها. ولم يجرؤا على التفوه ببنت
شفة إلا همساً..
لأنهم وجدوا أنفسهم أفراداً قليلين، لا يتجاوز
عددهم بضع عشرات من الناس بين عشرات الألوف، فقد خلفوا حماتهم، وهم
أهل مكة وما والاها، وراء ظهورهم، وأما اليمن، فقد أسلمت طائفة من
أهلها قبل أيام يسيرة على يد الإمام علي «عليه السلام»، الذي لحق
برسول الله «صلى الله عليه وآله» في مكة مع بعض من أسلم على يديه..
وربما كان السبب في هذه الجرأة الظاهرة، والوقاحة
السافرة التي تجلت في حجة الوداع؛
هو شعور هذا الفريق من مهاجري قريش بالقوة وهم في بلدهم، وبين
أنصارهم ومحبيهم
ـ
أي في محيط
مكة وما والاها
ـ وقد لاحظنا أن هذا التعاطف معهم كان يظهر منهم بين الفينة
والفينة حتى حين كانوا يحاربون الإسلام وأهله وهي حروب
لم تخبُ نارها إلا في فتح مكة قبل مدة يسيرة، حيث اضطرت قريش إلى الإنكفاء
عن الصراع السافر إلى التدبير التآمري الماكر.
لقد أدركت قريش:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» بصدد الإعداد لأمر
عظيم، لا تريد أن ترى نفسها راضية به.
ألا وهو إبلاغ الأمة بأسرها بإمامة علي «عليه السلام»، وخلافته
لرسول الله «صلى الله عليه وآله»..
وأن هذا الإبلاغ يتم بصورة لا تترك لها أية فرصة
للتخلص والتملص، والمناورة، وتصبح مقهورة على تجرع الغصة وتفوت
منها الفرصة..
ولعل قريشاً حين تجرأت على النبي «صلى الله عليه
وآله» في عرفات، أو
في منى، أو فيهما معاً
ظنت أنها قد أفلحت في درء خطر عظيم، وتلافي خطب جسيم، كان قد أوشك
أن يلم بها..
ولكن الله خيب فألها، وأبار كيدها، وأبطل مكرها..
ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين..
إنه «صلى الله عليه وآله» كان
يعرف:
أن معظم الناس قد أعلنوا الإسلام بعد فتح مكة، أي
في السنتين الأخيرتين من حياته
«صلى الله عليه وآله»،
وأن إسلام الأكثرين منهم كان سطحياً، بل صورياً، فرضته الظروف التي
نشأت في المنطقة بعد فتح مكة، حيث لم يكونوا يعرفون عن هذا الدين
الشيء الكثير، لأنهم كانوا يعيشون في بواديهم، ووفق مناهجهم
الجاهلية، وعاداتهم القبلية، ولم يكن زعماؤهم يسمحون للمبلغين
المسلمين بأن يصلوا إليهم، أو أن يحدثوهم بشيء عن هذا الدين
وأحكامه، ومفاهيمه، وتفاصيله، و.. و..
وحتى الذين أسلموا منهم، فإنهم قد عاشوا حياتهم
بمفاهيم الجاهيلة أيضاً. ولم يفارقوا عاداتها،
ولم يتربَّوا بعد على معاني الإيمان والإسلام. بل
كان زعماؤهم هم الذين يتحكمون بهم، ويسيَّرون أمورهم، ويهيمنون على
حركتهم..
ومن جهة أخرى:
فقد كان هناك طامعون وطامحون قد أذكى طموحهم هذا
التوسع السريع والهائل، الذي كان من نصيب أهل الإسلام في فترة
وجيزة جداً.. وهو توسع قد هيأ لهم المال الوفير والجاه العريض،
والنفوذ، والقوة.. وما إلى ذلك من أمور لم يكونوا يحلمون بها..
ومن جهة ثالثة:
فقد كان في المدينة وحولها، من لم يرق لهم الانصهار
في المجتمع الإسلامي والذوبان فيه، والانطلاق به في الحياة..
فكانوا يكيدون في الخفاء، ويشاركون في كل ما يلحق بالإسلام ضرراً
مهما كان حجمه ونوعه.. وقد وجد هؤلاء في كثير من مسلمة الفتح سنداً
وعضداً في هذا الإتجاه أيضاً..
هذا..
عدا عن غيرهم من الفئات التي ما أسلمت ولكنها
استسلمت، فلما وجدت الفرصة لإظهار أمرها لم تتوانَ في ذلك..
وكل هذا الذي ذكرناه من شأنه أن يصعِّد من درجة
الخطورة التي يواجهها الإسلام، والمخلصون من أهله بعد وفاة رسول
الله
«صلى الله عليه وآله»..
وكان الهدف الأعظم والأهم هو حفظ تعاليم هذا الدين،
وصيانة عقائده ومفاهيمه، وتمكينها من اختراق هذه السدود، واجتياز
هذه الجدود، وتذليل كل العقبات التي تواجهها، وتمنع من حصول
الأجيال الآتية عليها.
وهذا بالذات هو ما فعله رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
في حجة الوداع، وفي العديد من المفاصل الحساسة بعدها..
وهذا ما يفسر لنا جمعه لهذه الجموع العظيمة
والهائلة، التي جاء بها إلى أقدس مكان، في أقدس زمان، مع أقدس
إنسان خلقه الله تعالى، لأداء شعيرة عبادية هي من أعظم الشعائر.
وجاء معه أولئك الذين يدبرون في الخفاء ما يدبرون.
وكان
«صلى الله عليه وآله»
يعلم أن مكة وما والاها؛ من حزبهم، وإلى جانبهم، بالإضافة إلى أن
طائفة من أهل المدينة وما حولها كانت تتعاطف معهم، وتميل إليهم..
فكان ما كان مما تقدم بيانه.
ونحن في نطاق فهمنا لموقف النبي «صلى الله عليه
وآله» في حجة الوداع في منى وعرفات، ومنع قريش له من نصب علي «عليه
السلام» إماماً للأمة، نسجل النقاط التالية:
إن يوم عرفة هو يوم عبادة ودعاء وابتهال، وتوبة
وانقطاع إلى الله، سبحانه، ويكون فيه كل واحد من الناس منشغلاً
بنفسه، وبمناجاة ربه، لا يتوقع في موقفه ذاك أي نشاط سياسي عام،
ولا يخطر ذلك له على بال.
وهو يوم لا نظير له في تاريخ حياتهم، لأنهم يحجون
مع أكرم وأعظم نبي في فرصة وحيدة ونادرة في تاريخ البشرية.
وهو أفضل الأيام، وأكثرها انسجاماً مع أجواء التقوى
والإنضباط مع القرارات الإلهية، والخضوع لمشيئته، وتنفيذ أوامره
تعالى، وقد لفت النبي «صلى الله عليه وآله» نظرهم إلى هذا الأمر
حين قررهم «صلى الله عليه وآله» في خطبته، فأقروا بفضل هذا اليوم
عند الله([25]).
فإذا رأى الإنسان المؤمن أن النبي الأكرم «صلى الله
عليه وآله» يبادر إلى عمل من هذا القبيل، فلا بد وأن يشعر: أن هناك
أمراً بالغ الخطورة، وفائق الأهمية، فينشدّ لسماع ذلك الأمر،
والتعرف عليه، ويلاحق جزئياته بدقة ووعي، وبانتباه فائق. فإذا رأى
تمرد أصحابه عليه، وعاين إساءة الأدب معه، من قبل المدَّعين
للإخلاص في الإيمان، والمظهرين للإستعداد للجهاد والتضحية، فإن ذلك
سيشكل مفاجأة له إلى حد الصدمة.
وسيتمكن كل من حضر الحج من مشاهدة ومعرفة ما يجري،
فإن الجميع يكونون في هذا اليوم مجتمعين في صعيد واحد.
أما في منى، أو في سواها، فالحجاج يكونون منصرفين
إلى أعمال، وموزعين في جهات مختلفة: هذا يرجم الجمرات، وذلك يحلق
أو يقصر، وآخر يريد أن يذبح أضحيته، وقد يكون هناك من لا يزال في
الطريق، كما أن هناك من فرغ من ذلك كله، وذهب إلى خيمته للإستراحة،
أو ذهب إلى الحرم ليطوف، أو ما إلى ذلك.
ثم إن جميع الحجاج في موقف عرفة على حالة الإحرام،
الذي بدأوه بتلبية داعي الله تعالى، وأعلنوا براءتهم من الشرك
ورفضهم له، وأقروا بأن كل شيء مملوك له تبارك وتعالى، وصادر منه
وعنه، وهو وحده له الحمد، والنعمة، والملك..
وفي الإحرام يمارسون الإمتناع عن الملذات، وعن كثير
مما يحل لهم، وهم يخوضون تجربة السيطرة على دوافعهم الغريزية، ومن
ذلك امتناعهم عن النساء وما إلى ذلك، وهم يمتنعون حتى عن إيذاء
النملة والقملة، فهل يمكن أن يؤذوا رسول الله «صلى الله عليه
وآله»؟! أو هل يقدمون على مخالفة أوامره ونواهيه؟!
كما أنهم يشعرون بمساواة غنيهم لفقيرهم، وعالمهم
بجاهلهم، وكبيرهم بصغيرهم، وملكهم وسوقتهم، وحرهم ومملوكهم أمام
المحكمة الإلهية العادلة إلى غير ذلك مما لا يخفى.
3
ـ لماذا في موسم الحج؟!:
وإذا كان موسم الحج هو المناسبة التي يجتمع فيها
الناس من مختلف البلاد، على اختلاف طبقاتهم، وأجناسهم، وأهوائهم،
فإن أي حدث متميز يرونه ويشاهدونه فيه لسوف تنتشر أخباره بواسطتهم
على أوسع نطاق، فكيف إذا كان هذا الحدث يحمل في طياته الكثير من
المفاجآت، والعديد من عناصر الإثارة، وفيه من الأهمية ما يرتقي به
إلى مستوى الأحداث المصيرية للدعوة الإسلامية بأسرها.
4
ـ وجود الرسول
 أيضاً:
أيضاً:
كما أن نفس وجود الرسول «صلى الله عليه وآله» في
موسم الحج، لا بد أن يضفي على هذه المناسبة المزيد من البهجة،
والارتياح، ولسوف يعطي لها معنى روحياً أكثر عمقاً، وأكثر شفافية.
وسيشعر الحاضرون بحساسية زائدة تجاه أي قول وفعل يصدر من جهته «صلى
الله عليه وآله»، وسيكون الدافع لديهم قوياَ لينقلوا للناس
مشاهداتهم، وذكرياتهم في سفرهم الفريد ذاك.
فكيف إذا رافق ذلك إعلام النبي «صلى الله عليه
وآله» لهم أن لقاءهم به سيكون يتيماً، إذ إنه يوشك أن يفارقهم
فراقاً أبدياً، لا لقاء بعده، فإن مشاعرهم سوف تتوهج، وقلوبهم
ستمتلئ شغفاً بكل حركة، أو لفتة، أو كلمة ينطق بها، وسيعودون إلى
بلادهم بأغلى الذكريات واعزها، وأجملها، وأفضلها.
كما أن الناس الذين يعيشون في مناطق بعيدة عنه «صلى
الله عليه وآله»، ويشتاقون إليه، لسوف يلذ لهم سماع تلك الأخبار،
وسيجهدون في تتبعها بشغف، وبدقة وبانتباه زائد؛ ليعرفوا كل ما صدر
من نبيهم، من: قول، وفعل، وتوجيه، وسلوك، وأمرٍ، ونهي وتحذير،
وترغيب وما إلى ذلك.
ثم إن الحدث الذي سمعه هؤلاء الناس من نبيهم
وسينقلونه إلى من وراءهم، هو حدث مثير وخطير في حد ذاته، ويمثل
صدمة كبيرة وخطيرة لمشاعرهم، وخيبة لكل أمل كان يراود خواطرهم.
وحدث كهذا لا بد ان ينتشر في البلاد وبين العباد،
وسينتقل في الأجيال اللاحقة جيلاً بعد جيل، وستتداوله الفرق، وتهتم
له المذاهب، وسيثور الجدل حوله بين أربابها، لأنه الحدث الذي تقوم
به الحجة على كل عاقل لبيب، وأريحي أريب، وألمعي أديب، فلله الحجة
البالغة على البشر كلهم، والناس هم الذين يختارون مع أي فريق
يكونون، وأي طريق يسلكون.
وقد لوحظ هنا أيضاً:
أن الله تعالى قد أظهر لهم المعجزة في منى، حيث كان
«صلى الله عليه وآله» يخطبهم، ويصل صوته إلى كل من كان في منى كما
تقدم.
ولكنه حين خطبهم في عرفات لم يظهر لهم هذه المعجزة،
فقد ذكرت النصوص:
أنه
«صلى الله عليه وآله»
كان يخطبهم وكان علي
«عليه
السلام»
يقف في مكان آخر، ويوصل كلامه إلى من هم في الجهة الأخرى، وقد
تحدثنا عن ذلك في ما سبق([26]).
ويمكن أن نستفيد من هذا:
أن رسول الله
«صلى الله عليه وآله»
كان في المواضع المشابهة من حيث كثرة الحاضرين، يمارس هذه الطريقة
لإبلاغ كلامه للآخرين، ولعل هذا هو ما جرى في غدير خم أيضاً.
6
ـ الذكريات الغالية:
وقد قلنا آنفاً:
إن كل من رافق النبي «صلى الله عليه وآله» في هذا
السفر العبادي، لسوف يحتفظ في ذاكرته بأدق الذكريات، لأنها ستكون
ذكريات عزيزة وغالية على قلبه، تبقى حية غضة في روحه وفي وجدانه،
على مدى الأيام والشهور، والأعوام والدهور، ما دام أن هذه هي آخر
مرة يرى فيها رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
أعظم
وأكرم، وأغلى رجل وجد ويوجد على وجه الأرض.
والذي نريد أن نضيفه هنا هو:
أن العلاقة بالحدث حين تتخذ بعداً عاطفياً، يلامس
مشاعر الإنسان، وأحاسسيه، فإنها تصبح أكثر رسوخاً وحيوية، وأبعد
أثراً في مجال الإلتزام والموقف، ولا شك في أن هذا كان من أهم
الأهداف التي كان النبي «صلى الله عليه وآله» يرمي إلى تحقيقها من
خلال اختياره لخصوصية الزمان والمكان.. وغير ذلك من حالات وأوضاع.
7
ـ الناس أمام مسؤولياتهم:
وقد عرفنا:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد اختار الزمان ـ يوم
عرفة ـ لأنه يوم العبادة والإنقطاع إلى الله سبحانه.
واختار المكان، وهو نفس جبل عرفات،
لأن الكل يجتمعون في صعيد واحد، وعلى حالة واحدة، بالإضافة إلى
خصوصيات أخرى ذكرناها فيما سبق.
ثم اختار أسلوب الخطاب الجماهيري، لا خطاب الأفراد
والأشخاص كما هو الحال في المناسبات العادية ـ لقد اختار «صلى الله
عليه وآله» ذلك كله ـ لأنه أراد أن يضع الأمة
أمام
مسؤولياتها، ليفهمها: أن تنفيذ هذا الأمر يقع على عاتقها؛ فليس
للأفراد أن يعتذروا بأن هذا أمر لا يعنيهم، ولا يقع في دائرة
واجباتهم، كما أنهم لا يمكنهم دعوى الجهل بأبعاده وملابساته، أي أن
الجميع أصبحوا مطالبين بإنجاز هذا الواجب، ومسؤولين عنه، وليس
خاصاً بفئة من الناس، لا يتعداها إلى غيرها، كفئة المهاجرين أو
الأنصار، أو بني هاشم، أو أهل المدينة، أو ما إلى ذلك..
وبذلك تكون الحجة قد قامت على الجميع، ولم يبق عذر
لمعتذر، ولا حيلة لمتطلب حيلة.
8
ـ إحتكار القرار:
وهذه الطريقة في العمل قد أخرجت القضية عن احتكار
جماعة بعينها، قد يروق لها أن تدَّعي:
أنها وحدها صاحبة الحل والعقد في هذه المسألة، لتصبح قضية الأمة
بأسرها، من مسؤولياتها التي لا بد وأن تطالِب، وتطالَب بها، فليس
لقريش بعد هذا، ولا لغيرها: أن تحتكر القرار في أمر الإمامة
والخلافة، كما قد حصل ذلك بالفعل.
ولنا أن نعتبر هذا الأمر من أهم إنجازات هذا
الموقف، وهو ضربة موفقة في مجال التخطيط لمستقبل الرسالة، وتركيز
الفهم الصحيح لمفهوم الإمامة لدى جميع الأجيال، وعلى مر العصور.
حيث كان لا بد لهذه القضية من أن تخرج من يد أناس
يريدون أن يمارسوا الإقطاعية السياسية والدينية، على أسس ومفاهيم
جاهلية، دونما
أثارة
من علم، ولا دليل من هدى،
وإنما من منطلق الأهواء الشيطانية،
والأطماع الرخيصة، والأحقاد المقيتة والبغيضة.
9
ـ تساقط الأقنعة:
ولعل الإنجاز الأهم هنا، هو:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد استطاع أن يكشف زيف
المزيفين، وخداع الماكرين، ويعريهم أمام الناس، حتى عرفهم كل أحد،
وبأسلوب يستطيع الناس جميعاً أن يدركوه ويفهموه على اختلاف
مستوياتهم،
وحالاتهم،
ودرجاتهم في الفكر، وفي الوعي، وفي السن، وفي الموقع، وفي غير ذلك
من أمور..
فقد رأى الجميع:
أن هؤلاء الذين يدَّعون:
أنهم يوقرون رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ويتبركون بفضل وضوئه،
وببصاقه، وحتى بنخامته، وأنهم يعملون بالتوجيهات الإلهية التي
تقول:
{لا
تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ}([27]).
{لا
تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا
تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ}([28]).
{مَا
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}([29]).
{أَطِيعُواْ
اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ}([30]).
وغير ذلك من آيات تنظم تعاملهم، وتضع الحدود، وترسم
معالم السلوك معه «صلى الله عليه وآله»، مما يكون الفسق والخروج عن
الدين، في تجاهله،
وفي تعديه.
هذا إلى جانب اعترافهم بما له «صلى الله عليه وآله»
من فضل عليهم،
وأياد لديهم، فإنه هو الذي أخرجهم ـ بفضل الله ـ من الظلمات إلى
النور، ومن الضلال إلى الهدى، وأبدلهم الذل بالعز، والشقاء
بالسعادة، والنار بالجنان.
يضاف إلى ذلك كله:
ادِّعاء هؤلاء أنهم قد جاؤوا مع هذا الرسول الأكرم
والأعظم، في هذا الزمان الشريف، إلى هذا المكان المقدس ـ عرفات ـ
لِعبادة الله سبحانه، وطلب رضاه، معلنين بالتوبة، وبالندم على ما
فرطوا به في جنب الله، منيبين إليه سبحانه، ليس لهم في حطام الدنيا
مطلب، ولا في زخارفها مأرب.
وهم يظهرون أنفسهم بمظهر من يسعى لإنجاز عمل صالح
يوجب غفران ذنوبهم، ورفعة درجاتهم.
نعم، رغم ذلك كله:
فإنه «صلى الله عليه وآله» استطاع أن يري الجميع
بأم أعينهم: كيف أن حركة بسيطة منه «صلى الله عليه وآله» قد
أظهرتهم على حقيقتهم، وكشفت خفيّ مكرهم، وخادع زيفهم، وقد رأى كل
أحد كيف أنهم:
قد تحولوا إلى وحوش كاسرة، ضد نبيهم بالذات، وظهر كيف أنهم
لا يوقرون رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ويرفعون أصواتهم فوق
صوته، ويجهرون له بالقول أكثر من جهر بعضهم لبعضهم، ويعصون
أوامره.. و.. و.. كل ذلك رغبة في الدنيا، وزهداً في الآخرة، وطلباً
لحظ الشيطان، وعزوفاً عن الكرامة الإلهية،
وعن طلب رضى
الرحمن.
10
ـ وعلى هذه
فقس ما سواها:
ولا بد لكل من عاين هذه الأحداث أن يطرح على نفسه
السؤال التالي: إذا كان هؤلاء لا يتورعون عن معاملة نبيهم بهذا
الأسلوب الوقح والقبيح، فهل تراهم يوقرون من هو دونه، في ظروف
وحالات هي أقل بكثير من حالاتهم معه «صلى الله عليه وآله»؟!.
وماذا عسى أن يكون موقفهم ممن طفحت قلوبهم بالحقد
عليه، ولهم قِبَلَهُ ترات وثارات أسلافهم
الذين
قتلهم على الشرك،
وهو أمير المؤمنين الإمام علي
بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه..
وسيجدون أن الإجابة لن تكون في صالح هؤلاء
المتجرئين على نبيهم «صلى الله عليه وآله».
وهكذا..
فإنه يكون «صلى الله عليه وآله» قد أفقدهم، وأفقد
مؤيديهم كل حجة،
وحرمهم من
كل عذر، سوى البغي والإصرار على الباطل، والجحود للحق؛ فقد ظهر ما
كان خفياً، وأسفر الصبح لذي عينين، ولم يعد يمكن الإحالة، على
المجهول، بدعوى: أنه يمكن أن يكون قد ظهر لهم ما خفي علينا.
أو أنهم ـ وهم الأتقياء الأبرار ـ لا يمكن أن
يخالفوا أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولا أن يبطلوا
تدبيره، ويخونوا عهده، وهو لماّ يُدفن.
أو أن من غير المعقول:
أن تصدر الخيانة من أكثر الصحابة؟! أو أن يسكتوا
عنها بأجمعهم.
وما إلى ذلك من أساليب تضليلية،
يمارسها البعض لخداع السذج والبسطاء،
ومن لا علم لهم بواقع أولئك الناس، ولا بمواقفهم.
فإن كل هذه الدعاوى قد سقطت، وجميع تلكم الأعذار قد
ظهر زيفها وبطلانها، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر.
11
ـ القرار الإلهي
الثابت:
والذي ساهم في قطع كل عذر،
وبوار كل حجة:
أن
النبي «صلى الله عليه وآله»، قد تابع طريقته الحكيمة في فضح أمر
هؤلاء المتجرئين، بما ستأتي الإشارة إليه، في أمور فاجأهم بها، مثل
قضية تجهيز جيش أسامة،